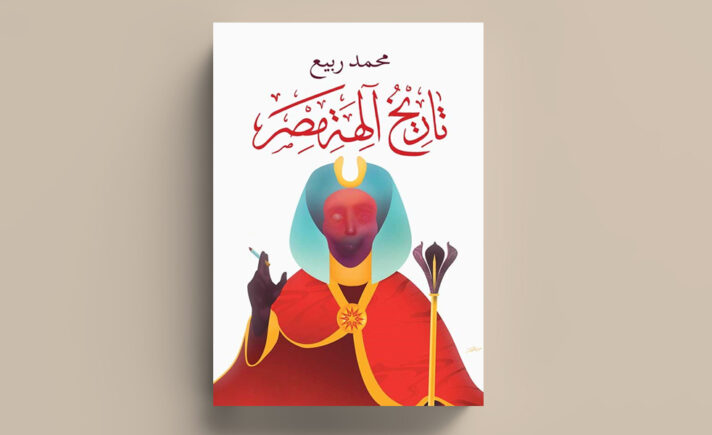أنظر بتعجُّب وربما بإعجاب، منذ بداية الثورة السورية، إلى كل من يستطيع الكتابة والرثاء والمراجعة والتفكير بالرؤى بشكل شبه فوري وآني، بالتزامن مع الحدث أو الكارثة أو الفقد. ما زلتُ غير قادرة على رثاء والدتي التي فقدتُها منذ ما يقارب الثماني سنوات، وما زلت غير قادرة على التشافي أو تقبُّل رحيلهاو ولا على تذكُّرها في كل يوم دون بكاء لا متناهٍ أو شعور بالذنب والفشل والخذلان. قرأت خبر وفاة الكاتب خالد خليفة في ليلة رحيله، وتتالت بعدها مقالات الرثاء والألم والفقدان من أصدقائه وصديقاته ومحبيه. لم أستطع استيعاب هول الحدث والفاجعة. بحثتُ عن صورة وحيدة لنا معاً علَّني أجدها في هاتفي. حاولتُ تتبُّعَ المرات المحدودة جداً التي التقينا فيها. بعد ساعات من البحث وجدتُ صورة لنا في أول مرة اجتمعنا فيها، في كوبنهاجن في آذار 2013، في احتفالية صغيرة عن الأدب والفن السوري. لا أذكر ماذا دار من حديث بيننا آنذاك، ولكنني أُسِرتُ بتواضعه وبساطته.
رأيته في تشرين الأول عام 2014 عندما كنت في زيارة قصيرة، وغير معلنة، إلى دمشق لظرف عائلي قاهر. تواصلتُ معه لترتيب لقاء، واتَّفقنا على اللقاء في كافيه بيجز. كان كريماً بما يكفي لأن يُخصِّصَ الوقت للقائنا، انتظرتُه ساعة كاملة لكنه لم يصل، وكتبتُ له معاتبة بمحبة وربما بغضب بسيط:
- «يعني إذا كاتب مشهور وكتاباتك حلوة بتنطِّر العالم وما بتجي. نطرت ساعة. انشالله نلتقي قبل ما سافر. يومك حلو».
- «بتسمعي بكف العدس، هادا أنا كف عدس، لكن مهما كانت الظروف أنا بعتذر وليس من عادتي».
التقينا بعد يومين مساءً وتحدثنا مُطوَّلاً عن كل شيء، وعن دور المثقفين والمثقفات في صناعة القرار السياسي في سوريا، وسألته عن دور الكتّاب والأدباء في إيجاد حلّ للمعضلة السورية. حدَّثني عن كرهه لتقديم الفيزا الشينغن أو أية فيزا أخرى، وعن دمشق والمدن الأوروبية، وعن الآلام في قدميه وعن أرقه المتواصل. حدَّثني عن بعض تجاربه وبعض مغامراته المضحكة وسط ذهولي لمشاركته إياها معي بكل أريحية وثقة، مُعبِّراً عن آرائه السياسية بصراحة وشجاعة كعادته وسط دمشق آنذاك. ربما لا أذكر تفاصيل أحاديثنا في ذلك اللقاء، لكنني أمام دهشتي برحيلك الآن لا أعي كيف استطعت أن تجعلني أحتفظ بذلك الشعور بالغبطة والسعادة والحميمية لمجرد الوجود في المكان العام ذاته معك، وأن تجعلني قادرة على استعادة الشعور ذاته بمُجرَّد تذكره. سخرتَ مني مُطوَّلاً عندما أردتُ الذهاب لأن الوقت تأخَّرَ قليلاً ولا أريدُ المرور على الحواجز في وقت متأخّر، وأخفيتُ أنني لم أكن قد شاركتُ زيارتي إلى دمشق مع أحد وأن مخاوفي حقيقية.
قرأتُ روايتك مديح الكراهية في العام 2008، وكانت صديقةٌ لي قد أخبرتني عنها. بحثتُ عن روايتك في مكتبة نوبل في دمشق آنذاك، ولكن صاحب المكتبة تردَّدَ وقال لي بتوجس: لا، ليست موجودة لدي. ثم نظر بعد ذلك ليتأكد من أنه لا يوجد أحد غيري، وهمسَ لي باعتبار أنني كنتُ أتردد إلى المكتبة من وقت لآخر: «تعالي بعد كم يوم، بأمنلّك الرواية». رجعتُ بعد أيام ليعطيني الرواية مغلفة بكيس بلاستيكي حتى لا يراها أحد. لم أستطع ترك الرواية. أعترفُ أنني قليلة القراءة، لكني شعرت أنني أريد التهام الأحداث والمفردات آنذاك لشدة قوة السرد. عشتُ تفاصيلها الكثيرة بكل جوارحي، شعرتُ ببطلة الرواية وتفاعلتُ مع طرفَي النقيض، وتذكرتُ ذلك جلياً بعد الثورة السورية والحرب، حين اتخذ كثيرون وكثيرات مساراً أقصى معاكساً لقناعاتهم أو اتجاهاتهم المعتادة، واتجهوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين وبالعكس.
بحثت في الرسائل القليلة التي تبادلناها وشعرتُ بالامتنان الكبير لها. كنّا نتحدث كثيراً في وقت من الأوقات. تلك الرسائل المتباعدة، والمكثَّفة في آن، امتزجَ فيها كثيرٌ من المرح والعفوية والأريحية والدفء وكسر الحواجز، ربما لأنك لا تجيد بناء الحواجز مع الآخرين أياً كانوا، ولأنه لديك الملَكَة اللازمة لتُشعِرَ كل شخص تلتقي به أو بها بالخصوصية والتمايز والتقارب. بعثتَ لي عن سَير رحلاتك في أوروبا علَّنا نلتقي في مكان ما في إيطاليا أو أي بلد آخر، وطلبتَ مني أن آتي لزيارتك في أميركا حيث كنت تشعر بالملل الشديد هناك. أخبرتكَ أنني قضيتُ سهرة رأس السنة 2016 وحيدة وأنا أقرأ روايتك الأخيرة، والحديثة آنذاك، الموت عمل شاق. أولُ ما قُلتَه لي أنه مؤسفٌ أن أقضي رأس السنة في قراءة هكذا رواية شديدة الألم. حدَّثتكَ كم أثَّرتْ روايتك بي ولامَسَتني بعنف، وذكَّرَتني برحلة والدتي من دمشق إلى درعا لدفنها في مثواها الأخير قبل أقلّ من شهرين من حديثنا. أخبرتكَ أني دونتُ باللغة الإنكليزية عن شيء شبيه بتلك الرحلة في الموت عمل شاق، وعن اكتشاف الذات. طلبتَ مني أن أنسى اللغة الإنكليزية وأترجم ما كتبته إلى اللغة العربية، ولم أفعل.
تحدَّثنا عن البلد وعن شعوري المرير بأن البلد ليس لي، وأنه ربما لن يكن في يوم من الأيام لي، وأخبرتك عن فقديَ الأزلي للانتماء، وأن ما كان يربطني حقيقةً بالوطن هو والدتي وإعادة تعريفي لذلك الرابط وللوطن الذي لم أجده في أي مكان بعد رحيلها. رددتَ مُعاتِباً وغاضباً:
رغم كل الحقارة المحيطة بعمري ما حسيت حالي هالوطن ما هو إلي.
هاد البلد إلي غصباً عن الجميع
وهادا ما في نقاش بالنسبة إلي.
إي خوختي الجميلة خليك قوية وهي بلدنا وإلنا. صحيح وأنا عمبكتبلك قطعوا النت بس ما بقدر غير أتحدى هالكلاب
وتعالي لهون
هون محلك وبيتك وأرضك وبلدك وأحبتك وهم الغزاة والغرباء
والله على قلع عيني مالي تاركلهن ياها
لا أريد الادعاء أنني كنتُ صديقة مقربة منك، ولكن بالتأكيد كان يمكن لذلك أن يحدث. دفعني الألم الغامر للبحث عن أحقيتي في رثائك وفي الكتابة عنك، وكذلك لقاؤنا والتواصل البسيط والحوارات القليلة التي دارت بيننا والرسائل المكثفة التي تبادلناها في أوقات قليلة ومتباعدة. وما زال الشعور طاغياً بأن أياً مما قد أكتبه غير كافٍ، وغير جدير بك لأنك أكبر من أي رثاء.
ذكَّرني رحيلك بالفقد الذي أشعر به، بالغصة بحجم الوطن التي لا تنتهي، بالمحاولات العبثية لإيجاد النهايات والإغلاقات لكل الأحداث التي تمر معنا. ذكَّرني رحيلك بالعزلة والوحدة التي فرضتُها على نفسي طوال الأحد عشر عاماً الماضية. كنا نتحادَث، وكنتُ في كل مرة سعيدة بالسماع منك وتبادل الآراء والمزاح، ولكنني قررتُ فجأة وبدون سبب التوقُّفَ عن التواصل منذ سنوات دون أي سبب، وبالغتُ في عزلتي وفرضي الرحيلَ عن كل شيء، ورغبتي أن أكون غير مرئية في هذا العالم. لم أستطع مسامحة نفسي، ولم أستطع تبرير ما فعلت. ربما لم يؤثر عدمُ وجودي بك، والأرجح أنك لم تلاحظه حتى، ولكنني الآن عندما أدركتُ ما فعلته وعدتُ إلى مراسلاتنا التي نسيتها تماماً، أودّ الاعتذار منك ولو أن اعتذاراتي تبدو بلا معنى. وجدتُ نفسي أكتبُ هذه الأسطر ربما لشعوري بأني أفتقدكَ مرتين، مرة برحيلك، ومرة بغيابي ورحيلِ ذاتي. أعرف أنك كنت صديقاً للجميع، وأخبرتك في إحدى الرسائل أنني في المرة القادمة التي سنجتمعُ فيها سأطلب منك أخذَ صورة سوياً دون خجل، فأنا لا أحب عادةً أخذ الصور مع الشخصيات المشهورة والمعروفة. قرأتُ كل رثاء ومقال كُتِبَ عنك في الفترة الماضية، وحسدتُ المقربين والمقربات منك. شعرتُ بالغيرة وبالألم لأني لم أكن في بيروت أو برلين للمشاركة في تذكُّركَ خلال فرصة الحزن الجمعي، ولأني كغيري لم أستطع أن أكون في دمشق معك. بكيتكَ دون توقف في هذه الأيام، وظللتُ أتساءل ما الذي كنت تفكر وتشعر به في الدقائق الأخيرة، ما حجم الألم، ما الذي أردت أن تكتب عنه وأجَّلته كمخزون كما قلتَ في أحد مقابلاتك. تخيلتكَ مبتسماً وقاهراً للموت، غير خائف، بل وربما فاتحاً ذراعيك له.
أكتبُ ما أكتب الآن ببساطة وعفوية وصدق، فقط لأنكَ أحببت الحياة وأحببت الكتابة، ولأنكَ أخبرتني يوماً أن عليَّ الكتابة دوماً. ربما غبطتك لأنك رحلت في دمشق، ولأن وداعك كان في المدينة التي أحببت. لأنك كنت دوماً محاطاً بالحب والصداقات الحقيقية والتواصل، وقادراَ على بث الفرح والطاقة والحميمية، لأنك حافظت على بوصلتك ببقائك في دمشق وعودتك إليها دوماً، أما أنا فقد فقدتُ بوصلتي وفقدتُني يوم سافرتُ من دمشق لثلاثة أيام فقط دون أن أدرك أنها ستمتد إلى كل أيام العمر. أكتبُ لأنك الأقدرُ على توصيف الشعور بالوحدة والعزلة رغم أنك منفيٌ في بيتك، أما نحن فمنفيون ومنفيات خارج أوطاننا، في ذواتنا، في آلامنا، في ذكرياتنا. أكتبُ وأنا مازلت ما بين مسافتين. أكتبُ الآن لأنك أَشعرتني بالمسؤولية عندما ذكرتَ أننا نحن السوريات والسوريين سنكتب ونروي ما حدث لآلاف السنين، وأنا التي أُخفي ما أكتب طيَّ الكتمان. أكتبُ ربما لأرمِّمَ جزءاً صغيراً من ذاكرتي التي فقدت، والجزءَ الآخرَ الذي تَشوَّه. أكتبُ الآن، لعلّي أجد بعضاً من الأمان وبعضاً يسيراً من العدالة وأنا ما زلت أتساءل: لماذا ترحل أنت ويبقى الطاغية؟