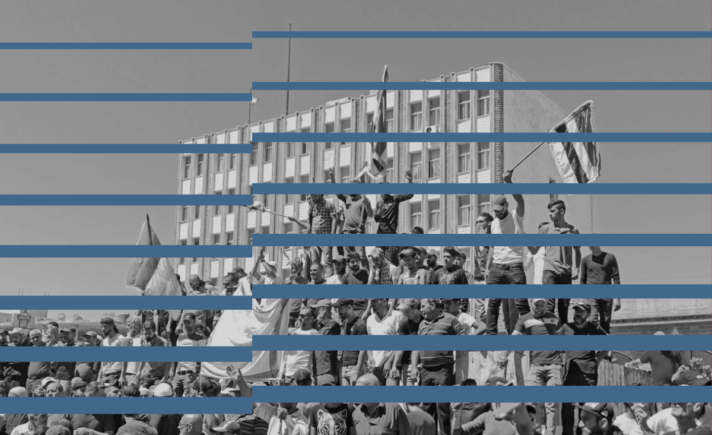عندما يَمَّمتُ وجهي إلى حلب، حَملتُ معي من بيروت روايةَ مديح الكراهية. وفي حيِّ طريق الباب وتَحتَ ضوء قنديلٍ مُرهَقٍ وقصفٍ جنوني وأصوات معارك محتدمة على خطوط الجبهات، أَهديتُها للصديق الكاتب والناشط خليفة خضر. كان شعورٌ دافئٌ يَغمُرنا في منزل عائلة الغجر، حيث اعتدنا اللقاء هناك لننسج أحلاماً عن لحظات النصر. وكنتُ اقرأ حينها رواية الصخب والعنف لفوكنر، ولم أفهم ما كان يرمي إليه في الرواية على لسان إحدى الشخصيات عندما قال: «وما النصرُ إلا من أوهام الفلاسفة والمجانين»، فهل كنتَ قد فهمتها فتجاهلتَ رغبتنا الشديدة بالنصر، ورحتَ تتأمل بهدوء أقدارنا ومصائرنا لتكتُبها؟
كانت المسافة من بيت عائلةِ خضر في حيّ الجزماتي إلى بيت عائلةِ الغجر في طريق الباب، تُقارب المسافة من بيت «زرزور» في الميسات حتى بار القصبجي، حيث التقيتُ للمرةِ الأولى بالكاتب والسيناريست خالد خليفة. خَرجتُ من المعتقل لأتخفّى في أحياء المدينة، حيث تشكَّلتْ دائرةٌ من الأصدقاء والكتاب والمثقفين والمخرجين كانت تدعم وتساعد الشباب المشاركين في المظاهرات على التخفّي، وكان خالد أحد أهمّ أركانها. كان يُحب أن نناديه بالخال بتواضع لا مثيل له، وكان كريماً سخياً في كل شيء.
«يجب اعتياد الحياة دون بهارات قلتُ لنفسي مصممةً على ألّا أموت»؛ كانت محاولاتي بائسةً لاعتياد الحياة خلال الاثنتي عشرة سنةً من الثورةِ والحرب، مثلما حاولت بَطلةُ الروايةِ في مديح الكراهية. اعتدنا الموت والفقد بكلِّ أشكاله حتى بدت الحياة غريبةً. لكنَّ رحيلكَ المفاجئ أعاد إليّ اليقين بأنَّ الحياةَ لا تستقيمُ دون بهارات، دون ضحك، وهزل، ودون روتين وسياقات بسيطة مع الأهل والأصدقاء والأحبّة، دون رقص وموسيقى. وهذا ما عَكفتَ على فعله في علاقتكَ مع الآخرين، حيثُ كنت تُضفي عليها بهاراتك الخاصة التي جعلت منها مذاقاً لذيذاً لا يمكن نسيانه.
الطّريقُ إلى حلبَ كان شاقاً وطويلاً، وفيها تَحوَّلَ عنوانُ روايتك لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة إلى لازمةَ نَستخدِمها للسخريةِ من التناقضاتِ العاصفةِ بالمدينة، ثم دأبنا على استخدامها للسخرية من التطرّف ورحنا نقول: «لا نساءَ في مطابخ هذه المدينة»، ثم تَحوَّلَت الرواية إلى شيء من النبوءة.
رَفعنا الجثث المتفحّمة إلى سيارة السوزوكي، وفيما كانت الأرض بين أقدامنا تَهتزُّ خَنقتنا العبارات ولم نستطيع حتى تَبادل عبارات العزاء. وكانَ دُخان المعاركِ يَتصاعدُ من جميع أحياءِ المدينة حتى بدا أن «الموت يمتد موحشاً في شوارع حلب إلى درجة لا تطاق» ثُم تَوالت الجنازاتُ الصّامتة. وكان القصف قد قضى على نصف سكان المدينة ودفع النصف الآخر للهروب خارجها، والقلة القليلة المتبقية قد أرهقتها طقوس الوداع الآخير، حتّى خَرجت جُثةٌ من حي طريق الباب يُشيعها خَمسة شبانٍ فقط، لم يستطيعوا البكاء الصامت أو المشي وراء الجثة لتوديعها في مثواها الأخير. وضعنا الجثة في سيارة السوزوكي وحيدةً، واكتفينا بتشييعها بأعيننا وغابت في صمتِ الحيَّ الذي لفَّنا كما يلفّ الصمت مقبرةً جماعية. هل كان قدرُنا روائياً وتراجيدياً إلى هذه الدرجة؟ عند المساء جلسنا والحزن يعصف بأرواحنا. وكنا نُحاول الابتسام لنخفِّفَ من وطأةِ الموت اليومي الاعتيادي. كان الموت عملاً شاقاً للأحياء، فكيف يمكن أن يتحول الموت إلى فعل يومي تَفقد فيه الحياةُ معناها، لا كما اعتدنا أن يُعطي الموت معنىً للحياة؟
قُلتَ: «الموت هو اكتمال الذكريات» فَهل أكملتَ ذكرياتك الآن؟ ها أنتَ تفتحُ برحيلك سيلاً من الذكريات عن المدن التي عشنا قِصّتها مرتين، مرةً في الرواية ومرةَ على أرضِ الواقع. أعترفُ لك أنّني شعرت في كثيرٍ من الأحيان أن وجودي في حلبَ كان روائياً، وكنتُ أتتبع مصائرنا بدهشة كما لو أنني أقوم بقراءة إحدى روايتك، حيث اتخذتْ مصائرنا مساراً عشوائياً يَدفعُ للإيمانِ الشديد والكُفر الشديد. وها نحن في المنفى الآن. هل كان خيارك صائباً بالبقاء في دمشق والموت فيها؟ كَرهتُ دمشق وخرجتُ منها ساخطاً نحو درعا ثم توجّهتُ إلى حلب، لكنني تُهت بعد ذلك تيهاً لم يعرف هدأة الرجوع. فهل كنتَ تعرف أن الرحيل عن دمشق سَيورثُ كلَّ تلك الآلام والعبرات، فاخترت البقاء فيها والأوبَ إليها حتّى وإن قَست عليك، أليس ذلك ما يكونُ عليه العاشق؟ كُنتَ محظوظاً بِقُربها وكنّا تُعساءَ ببعدها، وها نحن في أقاصي الدنيا يُوجعنا الحنين إليها.
قبل عشرينَ سنة حَلمتُ بأن أكونَ كاتباً، وأن أصنعَ مِن اللغةِ عالماً مثالياً خليقاً بتجميل شقاء اليومي في بلادنا. لكنني كَفرت باللغة والكتابة مُنذ سالت أولى الدماء في المظاهرات، وتُهت في محاولة إيجاد المعنى في كل ما حدث ورحتُ أسأل عن جدوى الكتابة، فكنتُ أعود إلى وصيتك التي كتبتها لي في رسائلنا المستمرة رغم المسافات:
«أتمنى أن تعرف بأنك يجب أن تذهب إلى الكتابة بكل ما تملك من قوة،
ولن أسامحك شخصياً إن فعلت غير ذلك
هذا ليس كلام من عبث رغم أنني أعرف بأن الكتابة في زمن الحروب قد تكون عبثاً، لكن يا صديقي ليس دوماً نستطيع العثور على أناس قادرين على التقاط العالم.
أتمنى أنك تفهم قلقي كما تقبلُه من أخ أو صديق عابر
نعم اذهب إلى الكتابة يا عروة بكل ما يعنيه الذهاب، ولا تحرق قلب أحبتك وأصدقائك».
لمَ أُقدِّر نصيحتكَ حقَ قَدرِها. وكُنتُ محظوظاً بالنجاة من الموت، ولم أحرق قلبَ أحبتي وأصدقائي، لكنني أعترف لك: أنَّ قلبي قد احترق بعدد المراتِ التي اقتربتُ فيها من الموت ونجوت، فالنجاة تتحوّل إلى عبء لا يطاق. فهل كُنتُ مقامراً أم أرعناً ولم أستطِع الإنصات؟ الرواية التي وعَدتُك بإكمالها لم تكتمل. قرأتُ ملاحظتك على المسودةِ الأولى مراراً وتكراراً:
«خال يجب أن تكتب العمل وتذهب له
إلى الآن العمل جيد ولكن لا تَخَف، افرد شخصياتك، دعها تحلم وتعيش وتموت،
لا تخف من الكتابة ولا تفكر بأي شيء سوى باللعب مع الشخصيات
بالنسبة لما قلت سأفكر وأكتب لك شيئاً
احترِس قليلاً»
وبقيتُ خائفاً من الكتابة. كان من السهل عليَّ الانغماس في معارك متعددة على أن أكتبَ سطراً واحداً. خمس مسودات لروايات مختلفة كتبت أجزاء متفرقة منها وعَدَلتُ عن إكمالها. لكن صوتك كان يتردد في داخلي ليعيد لي قليلاً من الإيمان:
« ياخال اكتب
أعود لأقول لك صدقني بأن الكتابة عالم سحري يوازي البندقية بل وأكثر».
*****
كُنت في بيروت عندما قَرأتُ للمرةِ الأولى الموت عمل شاق. وفي اللحظة التي وقعت عينيَّ على الرواية في مكتبةِ أنطوان، عادت إليَّ ذكريات القصبجي و«بيجز» وجلسات منزل الميسات والضحك والرقص والحزن، وبياض شعرك الذي بدأ يُذكِّرُني بِحصار الجُغرافيا واللّغة والقربِ المستحيلِ من دمشق، حيث اعتدتَ حَملها معكَ في زياراتكَ المتقطعة. كنتُ أَغبُطكَ أحياناً لقدرتكَ على الرجوع إليها، فيتملّكني حزنٌ شديدٌ لذلك الالتباس الذي تَخلقهُ بيروت. عَكفتُ على قراءةِ الرواية في غرفتي الصغيرة في حي الجعيتاوي دفعةً واحدة.
أثارَ فصلها الأخير الذُعرَ في روحي. يغطي الذباب جثة الأب في السرفيس، حيث كان يرقد في انتظار دفنه المُشرّف في مثواه الأخير، الأب الجميل الذي اتخذ خياراً أخلاقياً في الوقوف إلى جانب الثورة، يتنازع أولاده في رحلة طويلة وشاقة لدفنه متناسيين جسده المتفسخ خلال رحلتهم الطويلة. كانت نِهايةُ الروايةَ مثل مرآةٍ تعكس ما كانَ يَحدثُ على أرض الواقع في الثورة. أليسَ ذلكَ ما يفعلهُ الأدب العظيم؟ أن يُكثّف الواقع بلغةٍ بسيطةٍ وساحرة، ورمزيةٍ عالية تختصر ما يُمكن شَرحهُ بمئاتٍ من المقالات والتحليلات؟ ألم يكُن النزاع الذي دار بين أبناء الثورة أشدُّ تدميراً من جميع المؤامرات التي حيكت ضدها؟ وها هو الذباب ما زالَ يبتلعُ كلَّ يومٍ ما تبقى لنا من صورةٍ طاهرةٍ ونقيةٍ نحاول قدرَ استطاعتنا الحفاظَ عليها والتذكير بها.
ماذا تَعني الكتابة؟
ماذا تستطيع أن تغير الكتابة؟
بَقيَتْ تلكَ الأسئلة تَشغل بالي في السنوات الماضية، وكانَ الجوابُ يتبدّى أحياناً ويَخنسُ في كثيرٍ من الأحيان. لكن الموت، وكعادته، كفيلٌ بأن يُجلي لنا الحقائقَ المتواريةِ من أمامٍ أَعيُنِنا. في اللقاء الأخير في رواق بيروت، وفي صخب الأنخاب المرفوعة، صرختَ بي عالياً ولعنتَ الصورة وصناعة الأفلام وقلت لي: «اكتب، الكتابة وحدها من تنجي».
عدتَ وكتبتَ لي مرةً أخرى:
«المهم أن تكتب
وأرسل ما يطيب لك
المهم أن تبقي بخير
اكتب يا خال اكتب ما يحلو لك
ولا تنتظر، الموت بعيد
مازال الموت بعيد
انتظرناه وقتاً طويلا ولم يأت».
لكنّ الموتَ كان قريباً منك هذه المرة يا خالد وسرقك مُبكراً. ليس الموتُ وحده عملاً شاقاً يا خال، إنما الكتابة أيضاً عمل شاق.