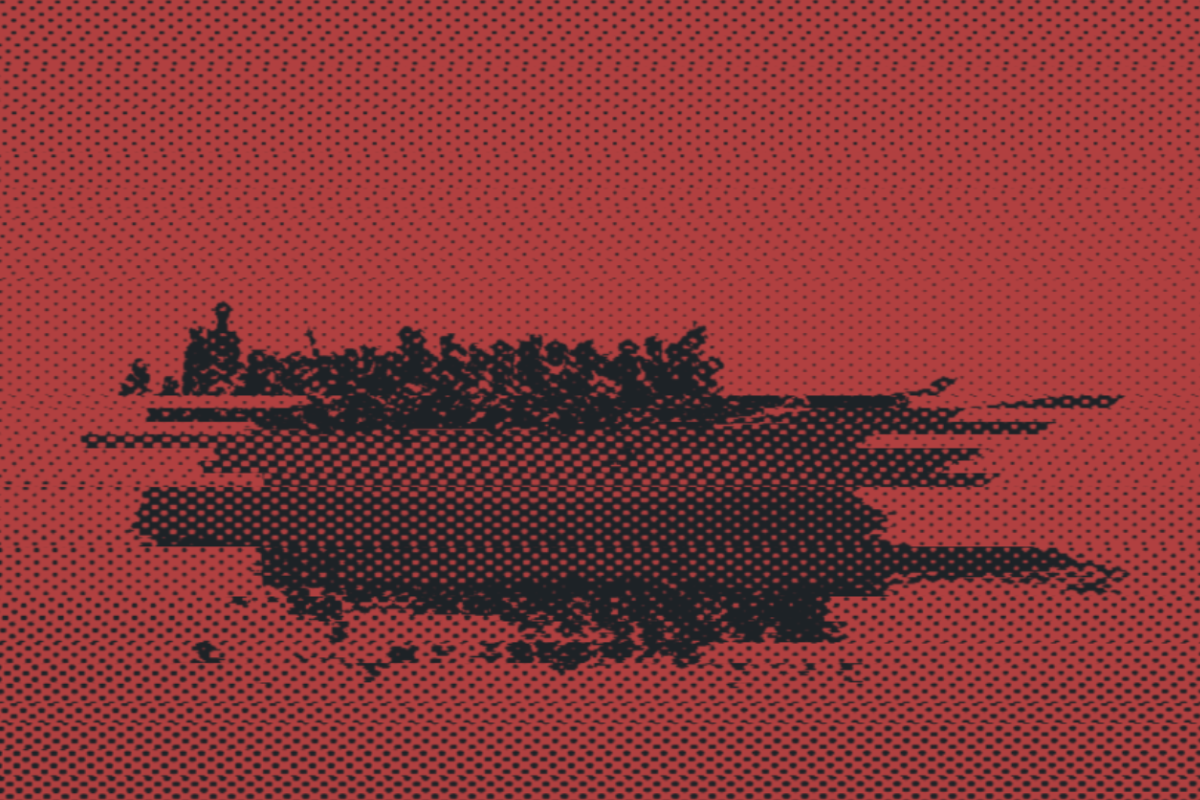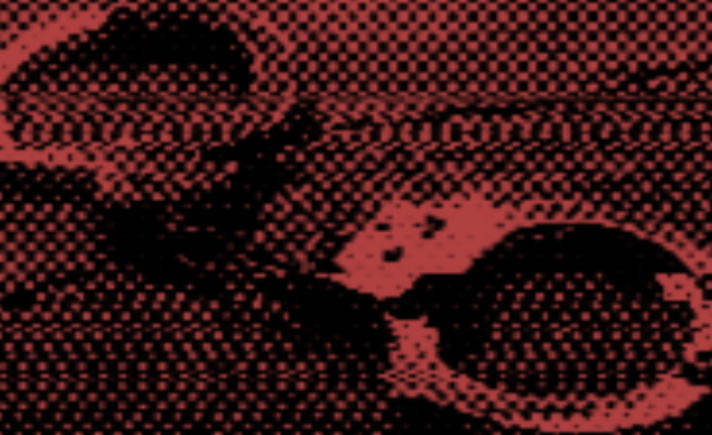الفهرسالفصل الأول: السلطة |
يتابع الفصل السابع السوريين الذين خرجوا من بلدهم بحثاً عن ملجأ آمن سواء كان قريباً في بلدٍ مجاور، أو بعيداً في قارة أخرى. مع حلول عام 2017، قُدّرت أعداد السوريون الذين أُجبروا على ترك منازلهم بنصف التعداد السكاني البالغ 22 مليون نسمة عام 2011. نزح نحو 7 ملايين سوري داخلياً، ولجأ ما يقارب 4,9 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، أما من طلبوا اللجوء في أوروبا فبلغوا مليون سوري.
نزح كثير من السوريين داخل سوريا وتنقلوا من مدينة لأخرى قبل أن يغادروا الحدود نهائياً، لأن الرحيل كان دوماً قراراً صعباً ومؤلماً لهم. أُجبر الناس على ترك منازلهم التي أفنوا أعمارهم ومدخراتهم في بنائها، وغادروا أحياءهم التي ترعرعوا فيها. بعضهم غادر مع عائلته والبعض رحل تاركاً خلفه عائلته كاملة.
أولى محطات اللاجئين كانت غالباً إحدى الدول المجاورة، وفيها لم يحصلوا لا على اللجوء ولا على إقامة دائمة تمنحهم بعض الحقوق. حوالي نصف الأطفال اللاجئين، المقدّر عددهم الكامل بمليون ونصف مليون، محرومون من المدرسة. نسبة صغيرة من اللاجئين في تلك الدول استطاعت الحصول على إذن مزاولة العمل، أما الذين استطاعوا الحصول على عمل في السوق السوداء، فقد كانوا يتحملون عادةً ظروف عمل قاسية ومعاشات زهيدة لا يقبل بها أبناء البلد. بقية اللاجئين بمن فيهم النساء والأطفال كانوا يتسولون في الشوارع أو يبيعون البسكويت.
كان صعباً على تلك الدول المضيفة تحمل تدفق اللاجئين إليها، كما كان صعباً على هؤلاء اللاجئين توفير حياة كريمة فيها. أُنشئ مخيم الزعتري في الأردن بشكل عشوائي، ويمكن تصنيفه رابع أكبر مدينة في الأردن، وهو يقع في وسط الصحراء، لذا كان عرضةً للعواصف الرملية في الصيف، وللفيضانات في الشتاء. شكّل اللاجئون السوريون رُبع عدد السكان في لبنان، مئات الآلاف منهم استأجروا أكواخاً أو نصبوا خياماً في أراضٍ خاوية وقذرة، لعدم وجود مخيمات رسمية لهم. أما تركيا فقد كان لها النصيب الأكبر من أعداد اللاجئين، ووفّرت لثلاثة ملايين لاجئ على أراضيها ما يسمى بالحماية المؤقتة، ممّا أعطاهم حق العمل وكسب الرزق. ورغم هذا، لم يخل الأمر بالطبع من عوائق وصعوبات تتعلق بالتعليم والقوانين.
تحمل أولئك اللاجئون مصاعب الحياة، لكن أيضاً عانوا ما عانوه على حدود بلدهم وهم يتابعون الأخبار يومياً، وأملهم الوحيد هو العودة الآمنة إلى وطنهم. ومع مضي الوقت وقصور برامج المساعدات الدولية عن تغطية أبسط احتياجاتهم، تطلع اللاجئون إلى حلول أو بدائل طويلة الأمد تحقق لهم الاستقرار. يحق للسوريين التقدّم بطلب لجوء في أوروبا، لكن الوصول إلى هناك كان تحدياً هائلاً. قلة من المحظوظين حصلوا على التأشيرة وانتقلوا بطريقة قانونية إلى هناك، أما البقية فقد حاولوا بشتى الطرق والحيل الهروب والتسلل إليها أملاً بالعيش في مكان أكثر أمناً. دفع الأغنياء مبالغ طائلة للحصول على جوازات سفر وتأشيرات مزورة للوصول إلى أوروبا بالطائرة. أما الأغلبية فقد صرفوا كل مدخراتهم وباعوا كل ما يملكون بل استدانوا أيضاً ليتمكنوا من الدفع للمهرّبين ليقطعوا بهم البحر المتوسط بالقارب.
كانت الرحلة طويلة وشاقة تبدأ من ليبيا أو مصر وتنتهي في إيطاليا، لكن في عام 2015 رفعت مقدونيا بعض القيود، ما مكّن اللاجئين من الوصول إلى غرب وشمال أوروبا عن طريق اليونان والبلقان. هذا المعبر البري المفتوح شجع اللاجئين على الذهاب إلى اليونان من تركيا، وبعدها قطع ممر بحري قصير وآمن وأقل تكلفة يوصلهم إلى أوروبا. وهكذا، نشأت تجارة تحقق أرباحاً عظيمة بملايين الدولارات، تجارة بالبشر عبر ملء قوارب مهترئة أو مطاطية بلاجئين يائسين يريدون الخلاص بأي ثمن. غرق الآلاف في البحر، أما من اختاروا البر فقد مات بعضهم على الطريق أيضاً. عثر على سبعين لاجئاً مخنوقين في شاحنة كانت في طريقها إلى النمسا.
سجلت أوروبا 1.3 مليون طالب لجوء عام 2015، واعتبر أولئك الأوفر حظاً، قدموا من مختلف بقاع العالم، وشكل السوريين 30 بالمئة منهم. جاؤوا عبر طرق مختلفة، مشياً على الأقدام أو بالسيارات والباصات والقطارات السريعة، قضى اللاجئون خلال تلك الرحلات أسابيع من النوم في الشوارع والمشي في الوحل تحت المطر، بعضهم يحمل أطفالاً على يديه، يحاولون من جهة تفادي شرطة الحدود خوفاً من الاعتقال، ومن جهة أخرى تفادي المجرمين وقطاع الطرق. توجه أكثر من ثلث اللاجئين إلى ألمانيا بعد أن أعلنت مستشارتها أنجيلا ميركل فتح حدود بلادها لهم، واستثنت السوريين من معاهدة دبلن التي تنص على بقاء اللاجئين في أول بلد أوروبي يصلون إليه. الحقوق والميزات التي يحصل عليها اللاجئ في السويد جعلتها الوجهة الثانية المفضلة للاجئين، حيث سجلت وصول عشرات آلاف اللاجئين أسبوعياً.
البدء من الصفر، وتكوين حياة جديدة في أوروبا كانت الصدمة الثالثة التي يعيشها السوريون في سلسلة الصدمات التي مروا بها، بدءاً بصدمة الحرب، مروراً بصدمة رحلة الموت التي قطعوها ليصلوا إلى بر الأمان في أوروبا. وبينما كان اللاجئون غارقين في دوامة العقبات القانونية والاقتصادية في مستقرّهم الجديد، كانت الصحف الأوربية تمتلئ بأخبار وأسئلة حول هؤلاء القادمين الجدد، وبرزت مخاوف صعوبة الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة بسبب خلفياتهم الثقافية والدينية المختلفة. الانتظار هي الكلمة المثلى التي تختصر حياة اللاجئ في أوروبا. انتظار بطاقة الإقامة وغيرها من الأوراق العالقة في بيروقراطية الجهات الحكومية، انتظار الانتقال من الملاجئ المؤقتة التي كان بعضها مصحات عقلية منعزلة في الغابات أو مستودعات طيران لمطارات أغلقت مثل مطار برلين، انتظار تعلم اللغة الجديدة ليبدأ اللاجئ رحلة البحث عن عمل، انتظار لم شمل عائلته التي تشتت في قارات مختلفة، وأخيراً انتظار خبر مُبشّر من الوطن.
أغلقت أوروبا حدودها عام 2016 بوجه ما يقارب 60 ألف لاجئ عالقين في اليونان، ينتظرون الحصول على حق اللجوء لأي دولة في القارة أو الترحيل. البلدان المجاورة لسوريا، الأفقر والأكثر استقبالاً للاجئين، أصدرت الكثير من القوانين المجحفة بحقهم. أما أولئك الذين علقوا على الحدود داخل سوريا – وقدّروا بعشرات الآلاف – فقد تهاوت أجسادهم من الجوع والفقر. كانت كارثة اللاجئين السوريين جزءاً من كبرى الكوارث البشرية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي شهر آب عام 2016 قبلت أميركا استقبال عشرة آلاف لاجئ سوري فقط.
تاليا، مراسلة تلفزيون (حلب)
كانت الليلةُ التي سبقتْ سفري أطولَ ليلة في حياتي، كنت وحدي مع أطفالي، ولم يتوقّف الطّيران طوال الليل. كان صوتُ الطائرات أفظعَ من البراميل، لأنّك تسمعه ولا تدري متى ستسقط، فالانتظار أقسى من الهجوم. لم أكن أعلم إن كنت سأسافر في اليوم التالي أو سأموت. شاهدتُ العديدَ من الأطفال الذين أصبحوا أشلاءً، لكنّني لم أكن قويّة كفاية لأشاهد أطفالي في تلك الحالة، كان يجب أن أطمئنّ أنّهم بأمان.
أيقظتُ الأطفالُ وجهّزتُهم، ثم كتبتُ أسماءنا وأرقامنا على بطاقات وضعتُها في جيوبهم ليتمكّن الناس من معرفة هويّاتهم في حال قُتِلَ أحدُهم. انتظرتُ السائق خارجاً، وقبّلتُ الجدران في الشارع. كنت أعلم أنّني لن أراها مجدّداً لأنّني لن أعود أبداً.
غسّان، فنّان (مخيم خان الشيخ)
ترك جدّي فلسطين عام 1948، واستقرّت العائلة في مرتفعات الجولان، وبدؤوا مِن الصفر. ودخلت إسرائيلُ الجولانَ عام 1967، وغادرْنا أيضاً، وبدأنا من الصِّفر مجدّداً. انتقلْنا بالتدريج إلى منطقة مخيم خان الشيخ لأنّها منطقة فقيرة وبمقدورنا شراء أرض هناك وبناء منزل عليها.
تركتُ المدرسةَ في الصفّ الحادي عشر، لطالما أحببتُ الخطَّ والرّسم. عملتُ في البداية خيّاطاً، وبعدها عملت في الإعلانات وتصميم الجرافيك. خلال عشر سنوات أنشأتُ عملاً ونجحتُ، ووصلت إلى مرحلةٍ أستطيع بها إكمال دراستي. أنهيتُ الثانوية، وبدأت أدرس في أكاديمية الفنون الجميلة. كان ذلك عام 2011 حينها كان عمري ثمانية وثلاثين عاماً، وعندي أربعة أطفال.
حُوصرتْ خان الشيخ، واتّخذ الجيشُ الحرّ المنطقةَ قاعدةً لعمليّاته. فجّر النظام المنطقة بالمدنيين ليجبر الجيشَ الحرَّ على الانسحاب. جرت معركة كبيرة، وكان عليّ أن أنتقل وأبتعد عن زوجتي وأطفالي، فسكنت فترةً في منزلٍ مع ثمانية وعشرين شخصاً.
مضى الوقتُ وأنا آمل أن يسقط النّظام خلال هذا الشّهر أو الذي بعده أو الذي بعده. ذهب إخوتي إلى ألمانيا، لكنّني لم أرغب في الرحيل، شعرتُ أنّني لا أستطيع العيش في أوروبا والبدء من جديد. ما حقّقته في سوريا قد لا يكون رائعاً، لكنه بالنسبة لي كان إنجازاً عظيماً. أنشأت عملي الخاص، وأصبح لديّ اسم وسمعة، بالإضافة إلي حلمي الدراسي. تركُ سوريا يعني خسارة كلّ شيء بالنسبة لي والبدء من الصّفر مجدّداً.
أنهيتُ السنة الأولى في الفنون الجميلة، وانضمّت إليّ زوجتي وأطفالي، حيث استأجرتُ شقّة في إحدى المناطق وسكنّا معاً مجدداً. تغيّر أطفالي كثيراً عن آخر مرّة رأيتهم فيها. هناك مرحلة عمريّة يتغيّر فيها الطفل كثيراً خلال سنة واحدة. بدا أطفالي أكبر بكثير، كان عمر طفلي اثنتا عشرة سنة، لكنه كان طويلاً بشكل ملحوظ.
مضت الشهور، وتطلّب مني التصميم الكثير من الأعمال في المنزل، لكنني لم أستطع القيام بها بسبب انقطاع الكهرباء. أخذتُ إجازةً من الجامعة، وبعتُ سيّارتي واشتريتُ واحدةً أصغر. عملت عليها كسيارة أجرة. أوقفت أعمالي لأنّ العمل على سيّارة الأجرة حينها كان أكثر استقراراً.
التحق أطفالي بمدرسة جديدة، وكنت أوصلهم بسيارتي. في كل كيلومتر كان ثمة حاجز للنظام، وفي إحدى المرّات طلب أحد العناصر هويّة ابني، قلت له إنّ عمره اثنتا عشرة سنة، لم يصدّقني الجندي حتّى أخرجت له إثباتاً من مدرسته. تكرّر ذلك الأمر مرّاتٍ عديدة لأنّ العناصر كانوا يدقّقون جداً على موضوع العمر. يهمّهم أن يعرفوا إذا كان الولد في عمر كافٍ لأداء خدمته العسكريّة الإلزاميّة. فكّرت «ماذا إن أوقفه أحد هذه الحواجز ولم أكن معه؟ لن يصدقّوا أن عمره اثنتا عشرة سنة» كنت أخاف من أن يأخذوه، كان ذلك كابوساً بالنسبة لي.
قرّرتُ أن علينا الرحيل، كنت أريد أن أبقى في سوريا بسبب ما حقّقته هنا، لكن ذلك كان أنانيّةً مني. لم أستطع أن أغامر بمستقبل أطفالي. شعرت أنّني أبيع جزءاً منّي حين بِعتُ المعدّاتِ في مكتبي. الشيء الوحيد الذي أخذتُه معي كان ريش الرسم والأقلام.
أم خالد، أم (حلب)
دُمّر منزلنا وهُدم فوق رؤوسنا، وقضينا سنة ونحن ننتقل من مكان إلى آخر في سوريا. صرفنا كلَّ أموالنا، في البداية ذهبنا إلى الريف. كنا خمسة وثلاثين فرداً، النساء كنّ ينمْنَ في غرفة، بينما ينام الرجال في الغرفة الأخرى، وحين يبدأ القصف نختبئ في الملجأ تحت الأرض، ويكون عددنا حينها نحو ثلاثمئة فرد.
كانت «حياة» صغرى بناتي في الصفّ الأوّل تستيقظ ليلاً مذعورة تبكي فيحتضنها والدها. في النهاية قال لي: «لن تحتملوا هذا الوضع أكثر، ستُدمَّرون كلّياً، أريدكم أن تخرجوا من هذه البلد نهائياً».
قلت: «تعال معنا».
قال: «لا.. أريد أن أؤمّن عليكم فقط». لم يكن يريد مرافقتنا لأنّه لا يريد ترك ابنتي الكبرى في سوريا، فهي متزوّجة ولديها أربعة أطفال.
لذا غادرنا، وقدمنا إلى لبنان، وبقي هو مع ابنتي في سوريا. كنت أكلّمه وأطلب منه الخروج من هناك لكنّه يرد: «ما زالت لديك ابنة في سوريا وأريد أن أبقى مطمئناً عليها، وإخوتك وإخوتي وأبناؤهم ما زالوا هنا أيضاً. الأهمّ من ذلك كلّه أنّكم في لبنان بأمان وأنا مطمئنّ عليكم». كان يسألني عن حالي إن كنت بخير، وأجيبه أنّني بخير كي لا أشغل باله، لكنّني في الحقيقة لم أكن بخير أبداً.
وجدنا مخزناً لنعيش فيه، وبعتُ بعضَ ذهبي لأدفع أجرتَه. لا يوجد في المخزن ماء ولا كهرباء، لا شيء أبداً سوى أنّه مكان ننام فيه أنا وأطفالي وأحفادي وأحد أصهاري الذي كان يعاني من مرض الكلى. كنت ربّة منزل فيما مضى من عمري، وليس لدي أيّ خبرة في العمل. لكنّني وجدتُ عملاً لستّة أشهر في أحد المصانع دون أن أخبر زوجي.
بعدها تلقّيتُ خبر وفاة سبعة أشخاص بإحدى القنابل الجويّة التي كنّا نُقصَف بها هناك. كان زوجي واحداً من أولئك السبعة. لا أعلم إن كان حينها في المنزل أو خارجه لأنّ المنزل تفجّر كلّياً. حاولتُ أن أسأل لأحصل على أيّة معلومة عن تفاصيل موته. قال لي الناس إنّه قُتل مثلما يُقتل الجميع هناك، تكون في الشارع وفجأة يأتيك صاروخ أو أيّاً كان ويقتلك. أرسلوا لي صورةً من مراسم دفنه كي أصدّق أنه مات.
مضى على موته الآن ثلاث سنوات، حينها كان عليّ أن أقضي فترة العدّة بعد وفاته، هذا ما يفرضه علينا دينُنا، لذا توقّفتُ عن العمل، ولزمتُ المنزل، ولم يكن لدينا طعام أو شراب. أحضرت باقي بناتي من سوريا والله وحده يعلم كيف. إحداهنّ كانت حاملاً في شهرها الثامن، ولم يسمحوا لزوجها بالعبور، عانت كثيراً، وكانت تدوخ حين تقف، وكنت أبكي عليها من خوفي أن تموت.
وجدتُ عملاً آخر، كنت أشطف أدراج البنايات والمرائب، حينها أصبح مجموعُنا ثمانية عشر في المخزن، بناتي الأربع المتزوجات وثلاثة من أصهاري وأطفالهم التسعة وابنتي حياة وأنا. في الشتاء كنت أفرش لحافاً خفيفاً على الأرض وأغطّي به الأطفال، وحين يستيقظون أتغطّى أنا به.
كانت حياة تستيقظ في منتصف الليل وتصرخ: «أمّي لقد قتلوا أبي» فأقول لها: «لا تقلقي صار في رحمة الله».
أما أحفادي فقد كانوا يصرخوا خائفين من الفئران، يقولون: «جدّتي، انظري لهذا الفأر»، فأردّ: «لا تخافوا، لن يفعل شيئاً».
صفاء، أُم (حمص)
لم يعد هناك أمان في حمص، حصار مستمرّ وإطلاق نار لا يهدأ، ولا يوجد خبز ولا ماء ولا كهرباء، أصبحت المدينة لا تصلح مكاناً للعيش.
الحمد لله أنّنا جئنا إلى لبنان، لكنّ الحياة هنا مأساويّة أيضاً. نعيش في حيّ مكوّن من مجموعة أكواخ، وتنقصه النظافة، وهذا يؤدّي إلى إصابة الأطفال بالأمراض من كثرة الجراثيم. حين تمطر تتسرّب المياه عبر الأسقف المعدنيّة، كما تتسرّب الأدخنة وشظايا الخشب من المدافئ وتنتشر في المنازل، بالإضافة إلى أنّ ماء الصنبور ملوّث ولا يصلح لغسل الخضراوات. أصبح ابني يعاني من الحساسية بسبب القذارة، كما أُصِيبَت أذنُ زوجي بعدوى وأصبحت تفرز قيحاً. أمّا البعوض فحكاية أخرى! لدينا أنواع الحشرات كلّها في الصيف.
تعود كلّ البيوت في هذا الحيّ إلى مالك واحد، ويقوم المُلّاك بالتّلاعب بالإيجارات حسب مزاجهم. كان إيجار منزلي هذا حوالي 230 دولاراً. كان الحمّام قذراً ولا يوجد مطبخ، لذا صرفتُ مدّخراتي كلّها في إصلاح المنزل. بعدها رفع صاحب البيت الأجرة علينا لـ 300 دولاراً بسبب التحسينات التي أجريتها عليه. قال لنا «إذا لم تعجبكم الأجرة يمكنكم الخروج للعيش في الشوارع».
استفاد الجميع باسم السوريّين، فإذا ذهبت إلى المستشفى فإنّهم يسجّلون اسمَك وزيارتك من دون أن يقدّموا لك العلاج، لكي يطالبوا الأمم المتّحدة بالمصاريف. يرتزقون باسم السوريين ويتذمّرون منهم. تقوم المنظّمات بتوزيع بعض التبرّعات على النّاس، لكنّها تحتفظ بالباقي. في إحدى المرّات أرسلت دولة الكويت ملابس مساعدة للّاجئين، أقسم بالله أنّ المنظمات أخذت تلك الملابس الجديدة ووزّعت علينا ملابس مستعملة ومهترئة. يتصارع السوريّون على التبرّعات، بينما يضجّ اللبنانيون فهم يرون أنّ تلك التبرّعات يجب أن تذهب إليهم.
لا يقبل اللبناني أجرةً أقل من 20 دولاراً في اليوم، لذا يقوم أصحاب العمل بطردهم وتوظيف السوري مقابل 10 دولارات، زاد ذلك من التوتُّر بين الفقراء من كلا الجنسيتين. استطاع زوجي توفير عربة لبيع القهوة في الشارع، يخرج في الرابعة صباحاً من المنزل ويجول باحثاً عن الزبائن، وإذا توقّف في أيّ مكان، يطالبه اللبنانيّون بالرّحيل، لذا لا يستطيع الوقوف طويلاً أينما كان.
يعمل أخي ناطوراً في أحد الأبنية، ولا يعطوه راتباً، يعطونه غرفة ليعيش فيها فقط. كان يملك درّاجة ناريّة، لكنّها سُرِقَت منه. وصاحب البناء يعرف السّارقين فهم من الحي ذاته، وحين ذهب أخي ليشكو أمر السرقة إلى الشرطة قالوا له «خذها نصيحة منّا، لا تزعجهم، فلن تستفيد شيئاً على الإطلاق، بل من الممكن أن يدبّروا لك تهمةً أيضاً».
كانت الأمم المتحدة تصرف لنا 30 دولاراً للفرد، بعدها أعلنوا أنّ تمويلهم توقّف. كانت هناك امرأة لديها أطفال وتريد أن تسجّل عندهم لأخذ المساعدة، لكنّهم استمرّوا في المماطلة ومطالبتها بالانتظار. إذلال بشع، كانوا يتركونها تنتظر لساعات وساعات في الخارج تحت الشمس، ويقولون لها «غداً.. أو بعد غد». إلى أن سكبت على نفسها البنزين وأشعلت النار بنفسها، هناك عند مبناهم.
لا يوجد ما يحمينا، لا دولة ولا حكومة ولا قانون، ولا حقوق إنسان. حتى الحيوانات تملك حقوقاً أكثر منّا.
بشرى، أُم (التل)
أطفال اليوم يفكّرون بالعكس، أي أنّهم لا يفكرون أن يلتحقوا بالمدرسة للحصول على وظيفة يوماً ما، بل يفكرون بالبحث عن العمل على أمل أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة يوماً ما. أكبر أحلام أطفالنا اليوم هو الحصول على عمل أو العيش في منزل حقيقي.
أذهب أحياناً إلى مركز مجتمعي يقدم خدمات للنساء، وفي إحدى المرّات رافقتني ابنتي الصغرى، كانت في غاية الحماس. فبعد العيش في خيمة لمدة طويلة أخذت تندهش من الحيطان والبلاط والأرضيات الحقيقية، قالت لي «أمّي، خذي لي صورة مع الحائط».
عبد العزيز، معلم (ريف درعا)
تعتبر منطقة الزعتري منطقة ميتة في الأردن. وجدوا مكاناً في الصحراء حيث لا يوجد شجرة ولا حيوان يستطيع العيش فيها، ووضعوا السوريين فيها. مرّةً رأينا فراشة، فدُهِشَ الجميع، وصرخنا متحمّسين ونحن ننظر إليها: «تلك الفراشة المسكينة التائهة، كيف أضاعت طريقها وانتهى بها الأمر هنا؟».
إياد، خرّيج جامعي (داريا)
تعتقد أنّك تعيش، لكن الحقيقة غير ذلك.
كان العيش صعباً في مصر، كان رؤسائي في العمل يشتمونني، لذا استقلتُ من عملي أخيراً. وبعد سبعة أشهر من وصولي إلى مصر أخبرني صديق أنّ هناك رجلاً يهرّب الناس إلى أوروبا عبر القوارب. في البداية اعتقدتُ أنّها مزحة لكن تبيّن في النهاية أنّ الأمر جدّي. تكلفة الذهاب حوالي 4000 دولار للشخص ما يعادل راتب سنة كاملة أو أكثر في مصر.
أنا وأصدقائي استدنّا الأموال من هنا وهناك، لكنّ اثنين منّا فقط استطاعا توفير المبلغ المطلوب والذهاب. حسدتُهما حين وصلا إلى أوروبا، وتمنّيت لو تمكّنت أيضاً من الذهاب معهما.
بعد ثلاثة أشهر عرض عليّ صديقٌ آخر أن نذهب معاً، وهذه المرّة كان المبلغ متوفّراً معي، فتحدّثنا مع المهرّب، وكنّا عشرة شباب، فقال لنا: «لن أستطيع مساعدتكم في حال قُتِلتم بالرصاص على الطريق، لكن إذا لم تصلوا إلى إيطاليا خلال 20 يوماً فسأعيد إليكم نقودكم». حزمنا حقائبنا وانتظرنا. اتّصل بنا المهرّب بعد حين وقال «تعالوا الآن، يوجد باص لأخذكم». قلت مع السلامة لإخواني وأخواتي، كانت إحداهنّ تبكي وتقول لي: «لا ترحل، بربك»، قلتُ لها: «أنا راحل، وهذا أمر محسوم»، لكنها استمرّت في التوسُّل لي أن أبقى وهي تبكي. رميتُ حقيبتي واتّصلت بأصدقائي وقلت لهم إنّني لن أذهب معهم.
ذهبوا ومرّت بهم عاصفة في الطريق وأدّت إلى أن يضرب أحدهم رأسه، فدخل في غيبوبة لخمسة أيّام. كانت رحلة صعبة جداً، لكنّهم وصلوا في النهاية. قلت لنفسي حينها أيضاً «ليتني ذهبتُ معهم».
فكّرت في السفر إلى أوروبا للمرة الثالثة حين اقترح أحد أصدقائي الذهاب عبر ليبيا، لأن ذلك الطريق أوفر كلفةً وأسرع. أخبرتُ عائلتي بأنّي مسافر، حينها كان مضى على وجودنا في مصر أربعة عشر شهراً، لذا جميعهم وافقوا على رحيلي، ولم يبكِ أحدٌ هذه المرّة.
ماهر، معلّم (ريف حماه)
أُعفيتُ من الخدمة العسكرية لكوني طالباً، وحين لم أعد قادراً على دفع رسوم الماجستير تركتُه، ولم يعد لديّ أيُّ عذرٍ للتخلُّف عن الجيش. أعطوني فترة سماح مدّتها شهر قبل الالتحاق بهم. استغلّيتها في رسم خطّة رحلتي من سوريا. بحثتُ أنا وأصدقائي عبر الانترنت على فرص التهريب من المغرب والجزائر والسودان. وجدنا قوائم لأرقام مهرّبين، وتواصلنا مع بعضهم، وبعدها قرّرنا الذهاب عبر السودان، فهي الدولة الوحيدة التي تستقبل السوريين بجوازات سفرهم دون تأشيرة.
الرّجل الذي أوصلني إلى المطار حذّرني أنّ الجميع هناك عناصر مخابرات، حتى عمّال النظافة. ونبّهني ألّا أتحدّث مع أيّ أحد حتى لو حاول أحدهم فتح حديث معي.
انتظرتُ حتّى أعلنوا عن رحلتي، نظر العسكريّ إلى جواز سفري ووجد ورقة مكتوب عليها «انتبه على نفسك» وفي الخلف مكتوب «أحبّك». كانت الورقة من زوجتي ولم يكن لديّ أيّ علم بها. نظر إلي العسكري بتوجُّس، فقلت له وأنا متوتّر «هذه زوجتي، تعلم حركات النّساء» أجابني «صدقني لولا كلمة أحبّك التي في الخلف لكنتَ الآن في ورطة كبيرة» بعدها سمح لي بالعبور.
حين وصلتُ إلى السودان، أقسم لكِ أنّها كانت المرّة الأولى التي أشعر بها بالأمان منذ خمس سنوات. لم أعد أخاف من الحواجز أو من أن تداهم الشرطة منزلي.
رفض المهرّب التحرّك قبل أن ندفع له، كان المبلغ 3500 دولار للوصول إلى الشاطئ و500 دولار أخرى لقطع البحر المتوسط. ركبنا سيّارات جيب لنقطع الصحراء السّودانيّة وبعدها الصحراء المصريّة وأخيراً الليبية. غرزت السيّارة بالرمل أحياناً، وكان علينا النزول لدفعها. لم يطلق أحدٌ النّار علينا، لكن الجيش المصري أطلق النّار على السيّارات التي انطلقت بعدنا وقُتل اثنان.
في القارب كان عددنا 180 شخصاً، جلس الأفارقة على أرضيته، وجلس السوريّون على سطحه. أخبرونا أنّ علينا تتبُّع نجمة في السّماء والإبحار باتّجاهها. ذهب المهرّب الليبي، واستلم أمر القارب المهرّب التونسي. بعدها تركنا التونسيُّ أيضاً وقال لنا: «يا شباب عليكم تدبُّر أموركم بأنفسكم».
صادق، مساعد بيطري (ريف السويداء)
كنّا أربعين شخصاً على متن قارب مطّاطي مصمَّم لحمل عشرة. كان علينا أن نصعد بسرعة على متن القارب لأنّ خفر السواحل التركي كان يقوم بدوريّة. ساعدنا النساء والأطفال ليصعدوا أولاً. عليك أن تحافظ على وضعية جلوسك ثابتة على متن القارب لضيق مساحته.
هناك شعرت حقّاً أننا سوريّون، كنّا جميعاً يعتني بعضنا ببعض رغم أنّنا من مناطق مختلفة في سوريا. أنا مثلاً من السويداء، وكنت أجلس بجانب أمّ من الزبداني مع أطفالها الثلاثة. علق والدهم في الطرف الآخر من القارب، ولم يستطع تغيير مكانه والاقتراب منهم. حملتُ الأطفال خلال الرّحلة وكنت مسؤولاً عنهم، كنّا جميعاً سوريين كعائلة واحدة.
نبيل، موسيقي (دمشق)
سرّبت قناة الجزيرة 93 ألف اسم لمطلوبين لدى المخابرات السّورية. كان اسمي من بين هذه الأسماء، وكان عليّ مغادرة سوريا بأسرع ما يمكن، لكن ليس قبل أن تخرج زوجتي. فهي طالبة مجتهدة في كلّيتها، وكانت طيلة حياتها الدراسيّة من الأوائل. لذا لم أرغب أن أغامر في مستقبلها. بحثنا عن مِنَحٍ دراسيّة، وحصلت على منحة دكتوراه في البيولوجيا في البرتغال. أمّا أنا فبقيتُ متنقّلاً بين لبنان وتركيا لمدّة أربعة عشر شهراً، أعزف الموسيقى وأقدّم طلبات للحصول على التأشيرة واللحاق بها. لكن كلّ الطلبات جاءت بالرفض، وقررتُ الذّهاب عبر البحر.
قرأتُ لمدّة سنتين عن رحلة البحر، لآخذَ فكرةً عمّا يُتَوقَّع مواجهته خلال الرحلة، وما سيلزمني هناك، وإلى أين أذهب، وكيف أتحدّث مع المهرّبين، وكيف سأنام في الفندق، وكيف أضع هاتفي النقال داخل كيس نايلون حين أركب الزورق. هذه التفاصيل شاركها الذين سافروا ووصلوا إلى برّ الأمان عبر الإنترنت، ليستفيد منها المُقبلين على مثل هذه الرحلة.
يمكنك أن تعرف كلّ القوانين الخاصّة باللّجوء في الدّول الأوربيّة، نوع السّكن، والأوضاع القانونيّة، والمدّة المتوقّع أن تقضيها في المخيّم، ومدّة صدور الإقامة…إلخ. إذا كنتَ ترغب في الحصول على الجنسيّة بسرعة فعليك بالسويد، أمّا هولندا فهي خيار الشّباب الذين يحبّون المتعة، وألمانيا هي الخيار الأمثل لمن يريدون الدّراسة والعمل. دول جنوب أوروبا مرحّبة باللّاجئين، وثقافتهم قريبة من الثّقافة السوريّة، لكنّهم يعانون مشاكلَ اقتصاديّةً، كما أنّهم ما زالوا يواجهون صعوبات في التّعامل مع موجات اللّجوء السّابقة.
تجارب ورحلات خاضها هؤلاء الناس على مدار سنتين أو ثلاثة، أي أنّه لم تغب عنهم أيّة معلومة.
نور، خبيرة تجميل (حلب)
انتهى عمل زوجي في لبنان بعد عامين، لذا عدنا إلى حلب. لكننا وجدنا الأوضاع أسوأ ممّا تركناها عليه. كان علينا إيجاد مكان آخر للعيش، فقرّرنا الذهاب إلى تركيا، وبعدها ذهبنا إلى الساحل. جهّزتُ حقيبةً للمستلزمات الضروريّة، كإثباتاتنا الشخصيّة، وجوازات سفرنا، والماء، وحبوب الأسبرين، ومسحات الكحول، ومعجون أسنان، وبدل ملابس وبسكويت للأطفال. أخبرَنا المهرّبُ أنّه لا يوجد متّسع لهذه الأشياء، وأنّ علينا ترك كلّ شيء.
وصل القارب وكان الصعود إليه كأنّنا نرمي أنفسنا في حفرة مظلمة. نظر زوجي إليّ وقال: «هل علينا الرجوع؟» قلت له: «إلى أين؟».
بدأنا نمشي في الأراضي اليونانية، وحمل زوجي طفلَنا طيلة رحلة الأسابيع الثلاثة بينما أمسكت بيد بنتي. ذهبنا من اليونان إلى مقدونيا ثم إلى صربيا وهنغاريا والنمسا قبل أن نصل أخيراً إلى ألمانيا. حاول الجميعُ جنيَ الأرباح على حسابنا طيلة الرّحلة. كان الجوُّ لهيباً في النّهار وثلجاً في الليل. نزفتْ قدماي، وكلُّ ما كنت أتمنّاه هو أن أنام.
بعد كلّ مرحلة نتخطّاها في الرّحلة، كنّا نجد أنفسنا نترحّم على المرحلة السابقة. عندما نمنا في الشوارع قلنا «كان القارب أرحم بكثير»، وحين نمنا في الحقول – حيث كان آلاف الناس ينتظرون لأيّام لعبور الحدود من بلد إلى بلد – قلنا «كم كان النوم في الشارع جميلاً» حين بدأنا الرحلة لم يعد التراجع ممكناً، وكأنّنا نمشي على خيط يُقطَع خلفنا كلّما تقدمنا. تماماً مثلَ أفلام الرّسوم المتحرّكة حين تقوم الشخصيّات بعبور جسرٍ ينهار من تحتهم.
مرّةً قابلتُ صحفيّة خلال انتظاري موعداً في إحدى الجهات الحكوميّة، فقالت لي «المهم أنّك الآن بأمان». قلتُ لها: «لم نأتِ إلى هنا بحثاً عن الأمان، نحن أساساً لم نعد نخاف الموت».
حقيقة لم تعد مشكلتُنا اليوم مع الموت، مشكلتُنا العيش بلا كرامة، لو كنّا نعلم ما ينتظرنا هنا لَما جئنا، لكنّنا جئنا، ولا نستطيع العودة.
يسرى، أُم (حلب)
لم ألتحق بمدرسة في حياتي، ولم أتعلّم القراءة ولا الكتابة. تزوّجت في الخامسة عشرة من عمري، وأصبح لديّ طفل، بعدها مرض زوجي بالسّرطان وتُوفِّي. كنت لا أملكُ نقوداً، لذا ترك ولدي المدرسةَ وبدأ يعملُ وهو في العاشرة من عمره. وعندما كثرت مشاكلُنا ومصاعبُ الحياة قال لي: «أمّي عليكِ أن تتزوّجي». لكن عندما كان أحدهم يتقدّم لخطبتي يقول: «هذا الشخص لا يصلح، شعرتُ بذلك بمجرد النّظر إلى عينيه».
وفي يوم كان أحدُهم يسأل عني، وتحدّث معه طفلي، وبعدها أحضره إلى المنزل، وقال لي: «وجدتُ لك الزوج المناسب، وهو رجل صالح وفي عينيه طِيبة». بعد أن تزوّجنا قال لي ولدي إنّه يريد إخوة «كلّ ما أريده هو العائلة، لا أريد أن أكون وحيداً». لديه الآن أخت وأخ، حين بدأت الأحداث كان عمر الأولى أربع سنوات والثاني سنتان.
بدأ الناس يخرجون في المظاهرات، وبدأ إطلاق النار، ظنّنا أنّ الأمر لن يطول، لكن بعدها بدأ القصف أيضاً. كان ابني ذو السنتين يتجمد تماماً حين يسمع صوت الانفجارات، تتسع عيناه ويتسمّر كالشجرة. أخذ وقتاً طويلاً حتى استطاع الكلام، فلم ينطق إلا بعمر الأربع سنوات، ولم يقل حينها سوى «باه» و «ماه».
خفتُ جدّاً على صغاري، وهربنا إلى الأردن. نقلتْنا سيّارة إلى منتصف الطريق، وبعدها أكملنا الطريق مشياً على الأقدام في منتصف الليل. دفعْنا مالاً إلى الجيش الحرّ ليدلّونا على الطريق، وكان جيش النظام يُطلِق النّار كلّما سمع صوتاً، شعرنا أننا على وشك الموت.
مكثنا في الأردن قرابة السنتين، بعدها لم نعد نحتمل صعوبة الأوضاع. لا يوجد عمل هناك، وصرفنا كلّ مدخراتنا. كان زوجي ما يزال يعمل في دمشق، أخبرتُه أنّ علينا إيجادَ حلٍّ آخر. كان زوجي قد عمل في ألمانيا في السبعينات، لذا قال لي: «ألمانيا جميلة وترعى حقوق النّساء والأطفال». يعاني زوجي من ضغط الدّم، ولديه مشاكل في القلب أيضاً، لذا لم يكن باستطاعته تحمُّل متاعب الرّحلة، فأخبرتُه أنّني سأخوض الرّحلة بنفسي.
حملتُ طفليّ وابن اخي ودخلْنا تركيا. مشى فينا المهرّبون من مكان إلى آخر، قطعْنا الوديان نزولاً وصعوداً في اللّيل والنّهار لنصل إلى القوارب، لكنّنا لم نتمكن من ذلك، لأنّ الشرطة كانت تمسك بنا كلّ مرة. وفي مرّة أمسكوا بنا وحبسونا تحت الشّمس في ساحة لا يوجد فيها شيء ولا حتى شجرة نستظلّ بها. لم يكن لدينا ماء، وأُصِيبَ الأطفالُ بالحمّى وكادوا يفقدون وعيهم.
ذهبنا بعدها إلى أزمير، واستمرّت محاولاتي بالذّهاب بالقارب، كنّا كلما وصلنا إلى هناك نجد الشرطة فنعود، حتى نجحنا أخيراً، وصعدنا في الزورق، ووصلنا بعد ساعتين إلى اليونان. قلت لنفسي حينها «أخيراً لم يعد هناك صعوبات أكثر، وسنصل أخيراً إلى ألمانيا»، لم أكن أعلم أنّ صعوبات الرّحلة الحقيقيّة قد بدأت للتوّ.
سافرْنا مع نحو مئتي شخص. ذهبنا بالقارب إلى سالونيكا، ثمّ بالباص إلى مقدونيا، وبعدها بدأنا بالمشي. مشينا لتسعة وعشرين يوماً. تُهْنا مرّاتٍ كثيرةً وكانت العصابات واللصوص يهاجمون النّاس ليلاً، لذا كنّا ننام خلال النّهار فقط، ويبقى الشباب منّا مستيقظين ليحمونا. لكنّهم قالوا لي مرّة «لا تعلمي ما قد يحدث، لذا عليكِ أن تكوني قويّة وتحملي سلاحاً» فاشتريتُ سكّيناً وعصا.
دخلنا مونتينيغرو ليلاً، ورأينا الشرطة مباشرة. وهنا انقسمت الآراء في المجموعة، أراد بعضهم أن يغيروا الطريق ويكملوا عبر النّهر، معظمهم كانوا شباباً ويستطيعون السباحة. أمّا أنا فقد خفت أن يضيع أحد أطفالي هناك في الظلام، لم أكن لأخاطر بهم، لذا انفصلتُ عن المجموعة.
وتابعتُ المشي مع أطفالي، وفجأة سلّطت الشرطةُ الضوءَ علينا وصرخوا بنا «الشرطة الشرطة». وضعتُ حدَّ السكّين على رقبتي، وقلتُ لهم: «إذا اقترب أحدكم منّي فسأقتل نفسي». ترجمت لهم إحدى النّساء ما قلتُه، فقالوا «نحن فقط نحاول حمايتكم من العصابات في المنطقة».
كانوا صادقين لأنّهم لم يؤذونا، على العكس قدّموا لنا الماء والبسكويت، وسمحوا لي بالنوم داخل كهف بعد أن رأوا كم أنا متعبة. حرسونا ساعتين ليتأكّدوا أن لا خطر حولنا، وبعدها قالوا لي إنّ عليّ متابعةَ المشي.
بعد مرور الوقت وصلنا إلى بودابست، وكان أطفالي في حالة يُرثَى لها. لم يعودوا يشعرون بأيِّ شيء، كانت ثيابهم مبلّلة وقد أصيبوا بالإسهال. أخيراً وصلنا إلى الفندق، واغتسلنا، وسألتهم ماذا يودّون أن يتناولوا، فأجابوا: دجاج. ذهبت وأحضرته لهم، وعندما بدأنا بالأكل طرقت الشرطة الباب وأخذتْنا. كان صاحب الفندق قد بلّغ عني.
قذفونا في مركز الشرطة من مكتب إلى آخر وهم يشتموننا، بعدها وضعوني في غرفة، ووضعوا أطفالي في غرفة أخرى، تعبت عيناي من البكاء، وكنت أسمع أطفالي يبكون في الغرفة المجاورة أيضاً. أفرجوا عنا في الصباح التّالي، وعدنا إلى الفندق. الحمدُ لله وجدْنا سوريّين آخرين كانوا سينطلقون في تلك الليلة، فخرجْنا معهم، وبعد مدّة وصلنا إلى ألمانيا.
أتممتُ العام ونصف العام هنا، وانضم إليّ زوجي منذ أشهر. لا أندم على شيء صدّقيني، ولو عاد بي الزّمن لقطعتُ الرحلة من جديد. حتى لو بقيتُ في هذا المخيّم، إن شاء الله سأعمل وأعيش حياة كريمة. أجمل شيء هنا هو المدارس، لأنّهم يعلّمون الأطفال حتى يفهموا. أتمنّى أن تصبح ابنتي طبيبة أو مهندسة يوماً ما. حتى أنا أصبحت أذهب إلى المدرسة وأتعلّم الحروف، أخطئُ أحياناً وتضحك عليّ ابنتي، لكنّني سأتحسّن شيئاً فشيئاً. كما تعلّمت ركوب الدراجة، وقعتُ كثيراً في البداية لكنّني أُجيدها الآن.
أسامة، طالب (القصير)
كان كلُّ ما في الأردن يزعجني. عائلتي، الحكومة، سوء معاملة الأردنيين لنا. كان أبي مفقوداً في السجن، ولا نعلم أيَّ شيء عنه إلى اليوم. شخصياً أتمنّى لو يخبرني أحدهم أنّه ميت حتّى أطمئنّ وأرتاح من فكرة أنّه يتعرّض للتعذيب.
قضيتُ في الأردن سنتين، وقمت خلالهما بأعمال عدّة. كان النّاس يستغلّوننا لأنّهم يعلمون أنّنا محتاجون إلى العمل. وإذا ما تركتُ عملاً ما فلن أستطيع الحصول على غيره بسهولة، كما يُمكِن لمديري إبلاغ الشرطة عنّي، ببساطة لأنّ القانون هنا يمنعني مِن العمل، وإذا ما أمسكتْني الشّرطة فستعيدني إلى سوريا.
كنت سأقول إننّي أُعيل عائلتي لو كان ما أجنيه يساعدهم، لكنّ المشكلة أنّ المبلغ زهيدٌ جداً ولا يغيّر شيئاً. التحقتُ بالمدرسة مجدّداً لأُنهي الصفَّ التّاسع بعد أن تركتُه حين غادرْنا القصير. درستُ مدّة سنة كاملة، واجتزتُ امتحاناتي بنجاح، لكنّهم لم يمنحوني الشهادة.
لدي عمّ في الدنمارك، وقد ذكرت لأمّي أني أريد الذّهاب إلى هناك لأشقّ طريقي. ذهبتُ مع أخي، وصلنا أولاً إلى تركيا، وبعدها اتّفقنا مع أحد المهرّبين ليؤمّن لنا القارب الذي سنعبر به إلى إيطاليا. حاولنا مرتين أو ثلاثاً لكن الشرطة كانت تُمسك بنا كلّ مرة. وفي محاولة لاحقة، قام المهرّب برمينا في قارب صغير، وكنّا 313 شخصاً بعضنا فوق بعض. كانت هناك رائحة أسماك، والجميع كان متقزّزاً وعلى وشك التقيّؤ. لم يستطع أحد الذهاب إلى أي حمام طبعاً لأنه لم يوجد أي حمام، كما كنا نتقاتل على كأس الماء الذي كان متاحاً لكل واحد مرّة في اليوم. بعد خمسة أيام استبدلْنا بالقارب المعدنيّ قارباً خشبيّاً، كالذي يركبه السيّاح حين يرغبون في السباحة بعيداً عن الشاطئ.
ركبنا القارب جميعاً، وبدأ يغرق، لكن حمداً لله لم يمت أحد. كان القارب يمشي في البحر ولا ندري إلى أين وجهته، ولم يخبرنا المهرّبون شيئاً. لكنهم توجّهوا إلى مصر لحمل المزيد من الركّاب. اشتدّ الموج هناك في المياه المصرّية وكاد القارب ينقلب، وبعدها تسرّبت المياه إلى جزئه السفليّ، وأخذتْ ترتفع حتّى وصلت إلى المحرّك وأغرقت الخبز. أخرجنا الخبزَ، ونشرناه على السّطح ليجفّ، تحوّل لونه إلى عدّة ألوان لكن لم يكن لدينا ما نأكله غيره.
وصلنا إلى المياه اللّيبية، حينها لم نكن نعلم ذلك. ساعدتُ قائد القارب بإخراج المياه منه عبر الدّلاء لأحصل على كأس إضافيّ من الماء. قويت علاقتي بالكابتن، وأخذ يتحدّث معي، وأخبرني من ضمن الأحاديث أنّ القارب سيتحمّل حوالي ستّ ساعات فقط قبل أن يغرق.
مع حلول ذلك الوقت بدأنا نسمع صوت الخشب يتفكّك، وبدأ الناس يصرخون، أحدهم يدعو الله، وغيرهُ يصلّي، والآخرون يصرخون ويعلو صوتُ بعضهم على بعض ويتقاتلون على سُترات النّجاة. بعضهم يرتدي واحدة ويخبّئ أخرى، ذكّرني ذلك بسرقة الفصائل المقاتلة في سوريا بعضها من بعض. أنا وأخي لم نرتدِ أيّة سترة، لأنّه في حال غرق القارب فسيتهافت النّاس على نزعها منّا، لذا ارتأينا أن نغرق دونها لأنّها في الحالتين لن تنقذنا من الموت.
جاء اللّيل وفي الحقيقة أنا وأخي لم نكن على علاقة وثيقة قطّ مثلما كنّا في تلك الرحلة. كان أحدنا يجلس إلى جانب الآخر، وكان أخي يعانقني بشدّة، وكنّا ننظر إلى صور أهلنا ونودّعهم واحداً واحداً.
ثم ظهر لنا ضوء، واقترب منّا قارب كانوا يصرخون منه «خفر السّواحل الإيطالي». أخذنا نصيح لهم أيضاً، واكتشفنا أنّ أحدهم تواصل مع قناة الجزيرة وأنّ قاربنا ظهر في نشرة الأخبار. انتقلنا إلى السفينة الإيطاليّة وأعطونا الماء، شربنا الكثير لكنّنا لم نرتوِ. كنت قد قلتُ لأمّي إنّ الرحلة ستستغرق عشرة أيام، لكننا أمضينا أربعة عشر يوماً. حين وصلنا إلى إيطاليا اتّصلنا بعائلتي بعد أن ظنّوا أنّنا متنا.
في إيطاليا وُضعنا في مخيّم للاجئين، ولكنّنا استطعنا الهرب. عثرنا على شابّ سوريّ وافق أن يوصلنا إلى الدنمارك بسيارته مقابل 500 يورو للشخص. لكن سيّارتُنا أُوقِفَت في ألمانيا، وحُكِمَ على الشاب بالسجن لعشر سنوات، أمّا نحن فسُجِنّا ليومين.
تمكّنت من الوصول إلى الدنمارك، والتحقتُ بمدرسة داخلية هناك لمدّة سنة، كانت أجمل سنة في حياتي. واجهتُ صعوبة في البداية بسبب عدم تمكُّني من اللّغة، لكنّني كنت مُصرّاً على إجادتِها فبدأتُ أقرأُ وأستمع إلى الموسيقى الدنماركيّة. لا يتحدّث معك الدنماركيّون مالم تبادر أنت بالحديث إليهم، وهذا ما فعلته. أصبح لديّ صديقة دنماركية وعلّمتني الكثير من اللّغة، كما أقوم اليوم بتعليمها اللّغة العربيّة، حتى أنّها عرّفتني إلى عائلتها، واحتفلتُ معهم بالأعياد.
عزفت البيانو سنوات عدّة، لكنني كنت أعزف الموسيقى العربيّة فقط، اليوم أصبحتُ أعزف خليطاً من الأنغام العربيّة والغربيّة، أنا أعزفُ، وصديقتي تغنّي. كما أنّني أخيراً وبعد خمس سنوات حصلت على شهادة الصف التاسع، لخمس سنوات كنت خائفاً أو غاضباً أو حزيناً دوماً. لكنّي حظيتُ بفرصة لأكون إنساناً طبيعيّاً من جديد. أنا سعيد الآن. سيبقى دوماً هناك أمل.
عبد الرحمن، مهندس (حماه)
تركتُ حماه، وعدت إلى الجزائر، وخطبتُ حبيبتي. ورغم أنّنا كنّا سعداء إلا أنّني في عقلي كنت ما زلت أركض وأهتف «الحرّيّة لسوريا»، وكنت أقضي نحو عشر ساعات في متابعة الأخبار على الانترنت، وست ساعات بالدراسة، وأربع ساعات في محاضرات الجامعة. ظهرت ثعلبة في رأسي بسبب شدّة التوتّر، وبدأت أفقد شعري، بعدها وصل الأمر إلى حاجبي ورموشي أيضاً، ثم بدأت تتغيّر ملامح وجهي.
كان رئيس جامعتي يعرف أنّني ناشط، وبدأ يغلق الأبواب في وجهي، لأنه مؤيّد للحكومة الجزائريّة التي تدعم الأسد. كانت علاماتي العالية في الجامعة تؤهّلني مباشرة لبرنامج الدكتوراه، لكنّ إدارة قسمي أخبرتني بشكل مفاجئ أنّ عليّ تقديمَ امتحان قبول مثل البقيّة. قدّمتُ الامتحان، وحصلت على ثاني أعلى درجة لكن أساتذتي قالوا لي: «مستحيل أن تُقبَل في برنامج الدّكتوراه، رجاءً كُفَّ عن المحاولة وأفسح المجالَ لغيرك».
صُدِمْتُ حينَها لأنّني خسرتُ موردي الأساسي في الجزائر، كما أصبحت إقامتي فيها غير قانونيّة. بعدها قرأتُ في الأخبار أنّ الحكومة الجزائريّة سترحّل تسعة عشر ناشطاً سوريّا مؤيّدين للثورة إلى سوريا. أخبرتُ خطيبتي وأهلها أنّ الحلّ الوحيد لبقائي في الجزائر هو الزواج رسميّاً لأحصل على حقّ الإقامة، وافق الجميع عدا خطيبتي، شعرتُ أنّها تغيّرت، وأنّ هناك شيئاً ما غير صحيح. لكنّها كانت تقول إنني مَن تغّير، وقد يكون ذلك صحيحاً.
تزوّجنا، لكن سرعان ما انتهى هذا الزواج، رآها أصدقائي مع شخص آخر، وحين واجهتُها اعترفتْ لي أنّها تحبُّه فتطلّقنا. وهذا يعني أنّني خسرتُ إقامتي في الجزائر أيضاً. بدأتُ العمل في الصحراء الجزائريّة حيث لا يوجد الكثير من الشرطة هناك. بعدها تلقّيت مكالمة من سوريا أخبروني فيها أنّ أخي الأصغر استُشهد بغارة جويّة.
لم أعد أحتمل أكثر، خطرت في بالي فكرة الهرب إلى أوروبا، ورافقني صديق سوري. ساعدَنا المهربون بالعبور إلى ليبيا. كانوا كالعصابة المسلّحة، وأخذوا منّا كلّ شيء، وحبسونا داخل إسطبل ليلاً. وفي اليوم التالي أخذونا إلى مهرّب آخر، وهو بدوره قال كما يقول جميعهم دائماً: «قاربنا جميل وعددنا خمسون شخصاً فقط»، ليتحوّل هذا القارب بعد ذلك إلى قارب صيد خشبي طوله أربعون متراً ويحمل 350 شخصاً بعضهم فوق بعض.
بقينا في البحر اثنتي عشرة ساعة قبل أن يتوقف محرّك القارب وتتسرّب المياه إليه. بدأنا نغرق وسط البحر، لكن عثر علينا خفرُ السّواحل الإيطالي لحسن حظّنا. نقلونا إلى سفينة حربيّة كبيرة كانت تمتلئ بمهاجرين غيرنا. سألونا في صقلية إذا كنّا متعلّمين، مهندسين أو مدرّسين أو أطبّاء. إذا أجبتَ بنعم يأخذون بصمتك لتبقى في إيطاليا، أمّا إذا أجبتَ بـ لا يقولون لك أن تتابع طريقك إلى شمال أوروبا. كانت وجهتي إلى النّروج، لذا قلت لهم إنّي عامل.
تابعتُ رحلتي من ميلانو إلى النّمسا ثمّ إلى ميونيخ وبعدها هامبورج. انتقلتُ من قطار إلى لآخر، وكنت أختبئ في الحمّام كلّما صعدت الشّرطة لفحص الجوازات. حتّى وصلت إلى الحدود الألمانيّة الدنماركيّة حينها ظهر شرطيّ جمارك طويل القامة وطلب منّي أوراقاً تثبت شخصيّتي، فأعطيتُه جواز سفري السّوري منتهي الصلاحيّة، قلّب صفحاته باحثاً عن تأشيرة دخول، وبعدها نظر إليّ وسألني «كيف وصلتَ إلى هنا؟»، فبادرته بابتسامة عريضة: «بقارب صيد صغير عبر البحر»، تابع بصوت منخفض حتى لا يسمعه أحد: «وإلى أين أنت ذاهب؟»، أجبتُه «إلى النروج»، أعطاني جواز سفري وقال لي: حظّاً موفّقاً وغادر القطار.
توقّفت في الدنمارك لزيارة خالتي التي تعيش هناك، وأقنعتني بالبقاء هناك. لم يطل حصولي على حقّ اللّجوء سوى واحد وخمسين يوماً فقط. بعدها بدأت بخطّة الاندماج التي أخذت ثلاث سنوات. كنت طالباً مجتهداً في مدرسة اللّغة كما سجّلت في دورات عبر الانترنت لبرمجة الكمبيوتر. بعد شهرين فقط حصلت على فرصة تدريب مهني في إحدى الشركات الصناعيّة، بينما أمضى المتدرّبون هناك ثلاث أو أربع سنوات دراسة للحصول عليها. كنت متحمّساً جدّاً لتعويض سنوات عمري الضائعة، وربما كانت تلك طريقتي بالتخلُّص من التوتُّر والإحساس بالذّنب والمشاعر السلبيّة.
اليوم أنا موظّف في أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في الدنمارك، وراتبي أعلى من رواتب 66 بالمئة من الدنماركيين. وثقت هذه الشركة بي رغم أنّي لاجئ سوري واسمي عربيّ ومسلم، قد يكون اسمي أطول اسم في الدّليل الدنماركي.
بنينا مجتمعاً ثورياً سورياً هنا، الجاليّة السوريّة السابقة كانت تخاف الخروج في المظاهرات حتى في الدّنمارك، يخافون أن يقتلَهم مؤيّدو الأسد، لكنّنا اليوم نخرج.
أولى مظاهراتنا كانت خارج السّفارة الروسيّة. كان عددنا عشرة، وعاملَنا موظّفو السفارة كالكلاب، لكنّنا استمررنا في المظاهرة لأنّنا نملك تصريحاً قانونياً. جذبت آخر مظاهرة قرابة مئتي شخص، كانت الأولى من نوعها في كوبنهاجن. قدتُ أنا المظاهرة، وهتفتُ رغم بشاعة صوتي. كان شعوراً جميلاً جدّاً إلى درجة البكاء، بكيتُ لأنّني شعرتُ بالمشاعر نفسها حين كنت هناك في ساحة العاصي في حماه.
نريد أن نثبت للعالم أنّ الشعب السوري منفتح ومتحرّر وناجح ومنظّم. جئنا من الثورة، واستمررنا بدعمها في الخارج، لكنّني أشعر بالذنب. لستُ أنا فقط، بل جميعنا يشعر بالذّنب، ونعبّر عن ذلك كثيراً. كثير من الناس كانوا يعيشون حياتهم بسلام، لكنّهم أُقحموا في حلمنا. كان حلماً صادقاً للجميع، لكن نيّتنا الصادقة لا تكفي للوقوف أمام تواطؤ العالم علينا.
أحياناً أفكّر في العودة إلى الثورة، لكنّي أعرف أنّ عودتي لن تشكّل أيَّ فرقٍ لوطني. اعتقل الأمنُ ابنَ عمّي بعد رحيلي، واستُشهِدَ تحت التّعذيب. أصبحت مدينة حماه اليوم بلا رجال، فيها النّساء وكبار السّنّ فقط، «مدينة الأرامل» هكذا تُطلِق عليها أختي.
كريم، طبيب (حمص)
يخشى الأطباء الأردنيّون من المنافسة، لذا فمن المستحيل أن يحصل طبيب سوريٌّ على رخصة مزاولة المهنة. وهكذا فإنّنا نعمل وينسب الطبيب الأردنيُّ العمل إلى اسمه. لكن الوضع لم يكن مستقرّاً لأنّ الإشاعات وصلت إلى وزارة الصحّة، وبدأت بالتفتيش، لذا كان عليّ إيجاد البديل.
سألت هنا وهناك وسمعت أنّه يمكنني تقديم طلب الفيزا الأميركية مقابل 150دولاراً. قرّرت أن أجرّب حظّي، وخضعتُ للمقابلة وحصلتُ على الفيزا. لكن لاحقاً قدّمتُ طلباتٍ لزوجتي وأطفالي جاءت جميعُها بالرّفض.
بعدها خطرت في بالي فكرة وهي أن أحجز تذكرة رحلة لأميركا مع محطّة وقوف في ألمانيا كي أبقى فيها. لكن قوانين شركات الطيران وضوابطها تمنع التوقُّف في أوروبا في مسارات رحلاتها. فسافرتُ مباشرة إلى نيويورك، ومكثت عند صديق سوري هناك، وخلال تلك الفترة استشرت محامي هجرة وعرفت أنّ الحكومة الأميركيّة تمنح اللّاجئ رخصة العمل، وتتركه ليدبّر أمره بنفسه. كما يتعيّن عليّ الدراسة لسنوات قبل أن أتمكّن من مزاولة الطبّ مجدداً، وخلال تلك الفترة لا يمكنني كسب المال لإعالة عائلتي.
قرّرتُ أن آخذ الخيار الثاني وهو أوروبا. حجزتُ تذكرة إلى تركيا تتخلّلها محطّة انتظار لساعتين في فرانكفورت. جلستُ في مقهى في مطار فرانكفورت، وانتظرتُ حتّى أعلنوا عن رحلتي، ثمّ نادوا عدّة مرات للمسافر المتأخّر وبعدها راقبتُ طائرتي وهي تحلّق متوجهة إلى تركيا أخيراً. عندها توجّهت إلى أقرب شرطي وقلت له إنّي سوري أريد طلب الحماية.
حصلتُ على حقّ اللّجوء بعد شهر واحد، وخلال خمسة أشهر انضمّت عائلتي إليّ. تعلّمتُ اللّغة الألمانيّة على مدار شهور، وأصبحتْ جيّدة الحمد لله. وفي الوقت نفسه كنت زائراً مراقباً في المستشفيات الألمانيّة، وبعدها أخذتُ مهمّات أكبر في المستشفى بالتدريج. وقّعت أوّل عقد للعمل في مستشفى هنا بعد حوالي سنتين من وصولي، واليوم أنا طبيب مجاز مجدّداً.
رغم أنّ الحظّ كان معي إلّا أنّي كنت مضطرباً من الدّاخل بسبب الفرق بين رغد معيشتي هنا وبين ما يعانيه النّاس في وطني. ضميري يعذّبني لأنّني طبيبٌ وكان عليّ البقاء لمساعدتهم. نحن نحترم الناس كلّهم وضدّ الإرهاب، لكن لماذا لا يحمل هذا العالم سوى القليل جداً من التعاطف مع مَن يُقتَلون في سوريا؟ تستطيع طائرة روسيّة أن ترمي على البشر هناك قنابل فوسفور لأنّ العالم اعتاد موتنا، وكأنّ دماءنا رخيصة. ولم نرَ ممّن سمّوا أنفسهم «أصدقاء سوريا» سوى التراخي والجبن. سوريا ليس لها أصدقاء، تلك هي الحقيقة، كانت مجرّد رقعة شطرنج لتصفية حسابات قوى العالم.
تشتّتت عائلتي، وانتقل والداي للعيش مع أحد إخوتي في قطر، بينما أخي الثاني في مصر، والثالث كان طبيب أسنان عالقاً في سوريا ويحاول الخروج بشتى الطرق، إلى أن صدر قرار بسحبه إلى الجيش. رفضت السفارة الألمانية طلب الفيزا الذي تقدّم به، لذا جاء عن طريق البحر.
قضى طفلي أوّل سنتين من عمره داخل المنزل في حمص بسبب حظر التجوّل والقصف. ولم يكن له أيّ تواصل مع أحد سوى جدّيه وأنا وأمّه. كان عمره سنتين حين قابل طفلاً لأوّل مرة، أذكر أنّه اقترب منه وبدأ يتلمّس عينيه معتقداً أنّه دمية.
غيث، خرّيج جامعي (حلب)
كان على السوريّين أن يبدؤوا حياتهم من جديد، على الأقل مرتين. بعضهم ذهب واستقرّ في مصر وكوّن حياة جديدة فيها، وفجأة تغيّر النّظام السياسيّ هناك، وصار عليه الرّحيل مجدداً. فذهب إلى تركيا وتعين عليها الرحيل أيضاً، ثمّ إلى اليونان ورحل من جديد. وهكذا دواليك.
فتحت ألمانيا أبوابها لاستقبال اللّاجئين، ورحلتْ إليها أفواج كبيرة، وأنا منها. كمّية المعاملات البيروقراطية هنا لا تُصدّق، لقد كنت أذهبُ يومياً إلى مكتب اللاغيزو الخاص باللاجئين وأنتظر من الساعة السابعة وحتى الساعة الرابعة ولا يعطون أرقاماً للمراجعين لذا كان الناس يأتون منذ الليل ويحجزون أماكنهم في الخارج وينامون فيها بالدور حتى صباح اليوم التالي. استغرقت أربعين يوماً حتى تمكّنت من دخول المبنى فقط للحصول على رقم، وبعدها استغرقت ثلاثين يوماً أخرى ليظهر رقمي على الشاشة. لم يكن هناك تنظيم، فمثلاً رقمي 80 ورقمك 90 لكنهم قد يستدعون الرقم 100 قبلنا. كان عليّ الحضور يومياً لأنتظر أن يحين دوري وينادوا على رقمي. لكنهم لم يفعلوا، استمررتُ بسؤالهم عن سبب تأخيري، فاكتشفوا في النهاية أنّهم أضاعوا ملفّي كاملاً.
أحد أسباب تأخُّر المعاملات هنا هو أنّ العديد من المهاجرين يدّعون أنّهم سوريّون لاعتقادهم أنّ لنا الأولوية. كنت أساعد البعض خلال الرحلة في الترجمة للشرطة اليونانية، وأذكر أنّني سمعت عراقياً يتحدّث مع شرطي يوناني سأله: «من أين أنت؟»، فأجاب «من سوريا». سأله «من أية مدينة في سوريا؟»، فأجاب «من الموصل». هنا رد عليه الشرطي: «الموصل في العراق».
لذا يقومون الآن بالتحقّق جيداً للتأكّد أنّ الشخص سوريّ فعلاً، فيسألون عن الشارع الذي كنت تسكن فيه، ومن أين كنت تشتري مستلزماتك، وقد يقوم المحقّق أحياناً بفتح خريطة الأقمار الصناعية ويسألك مثلاً: «كم المدّة التي يستغرقها المشي من النقطة أ إلى النقطة ب في حلب؟».
عماد، خرّيج جامعي (سلميّة)
كان الجميع يقول لي: «غادر.. اذهب.. ارحل»، فرحلت في النهاية كالبقيّة. حتى أنّي وصلت إلى منتصف الرحلة دون أن تكون لي وجهة محدّدة، كنت فقط أتابع المسير مع المجموعة.
استغرقت الرحلة شهراً ونصف الشهر، وبعدها أُلقِي بي في سجن بهنغاريا، لكنّه كان أشبه بفندق خمس نجوم بالمقارنة مع السّجن الذي كنت فيه وأنا في سوريا، بالإضافة إلى أنّني كنت بحاجة إلى مكان دافئ لأنام فيه بعد تعب الرحلة.
ليس عندي أحلام ولا خُطَط مستقبليّة، بالكاد أفكّر في الساعة التالية. هل أعود إلى الجامعة بعد أن قامت الثورة وضاعت سنوات الدراسة ولم أحصل على الشهادة؟ كما أنّه لا صبر لي على تحمُّل عبْء البدء من الصفر، ثم إنّ ذوي الشهادات اكتشفوا أنّ شهاداتهم لا تساوي شيئاً هنا.
ربط الإعلامُ الثّورةَ بالإرهاب، وأصبح على السوريّ المعارض طالب اللّجوء أن يثبت أنّه ليس إرهابياً حين تسأله السُّلطات الأوربيّة أسئلة مثل: هل شهدتَ أيَّ حادثة قتل؟ هل كنتَ تتواصل مع أيّ إرهابيّ؟ ومن هو؟ تشعر وكأنّك متّهم بشيء ما، بينما أنت ترغب فقط بالحصول على الإقامة خوفاً من التّرحيل. لذا من الأفضل لك أن تقول إنّك هاربٌ من الحرب ببساطة دون ذكر الثّورة أو النّظام.
لكنّ المشكلة أنّنا بهذه الطريقة ندفن حقيقة الثّورة ونضيّعها، وسواء قصدنا ذلك أو كنّا غير مدركين للأمر إلّا أنّه يُعَدُّ جريمة بحقّ كلّ ما حصل في سوريا.
حكم، مهندس (دير الزور)
بدأت داعش بإقامة وزارات، وطلبت من حملة الشهادات الجامعيّة التعاون معهم، رفضتُ، فاعتقلوني وحبسوني لسبعة أيّام، ثمّ أطلقوا سراحي بأمر استدعاء لمحكمتهم التنفيذيّة. جميعنا يعرف ما يعني ذلك لذا هربتُ ليلتها إلى تركيا.
كان الأمر صعباً جداً عليّ لأنّي كنت متزوّجاً من سنة واحدة، وزوجتي حامل. أرسلتْ داعش رسالة إلى عائلتي حين هربتُ وقالوا لهم إنّهم سيعثرون عليّ في تركيا ويُنهون أمري هناك. نعلم جميعاً أنّهم يستطيعون الانتقام منّي بسهولة في تركيا. وقالوا أيضاً إنّهم سيقتصّون من زوجتي عوضاً عني.
نجحت بإخراج زوجتي من دير الزور إلى شمالي حلب حيث اختبأتْ مع أمّها وطفلتنا. وُلدت طفلتي بعد هروبي بثلاثة أشهر، عمرها الآن سبعة أشهر ولم أرَها بعدُ لأنّهم عالقون على الحدود السوريّة التركيّة. توقّفت تركيا عن منح الإقامات للسوريّين وأصبح السبيل الوحيد للدخول إليها بوساطة المهرّبين، لكن الجنود يطلقون النّار على السوريين الذين يحاولون قطع الحدود.
لديّ شهادة في الهندسة وخبرة اثنتي عشرة سنة في الصيدلة، رغم ذلك أجلس هنا في المخيّم بلا فائدة أو عمل. أصبحتْ حياتي عبارة عن شرب الشاي والتّدخين، وكلّ ما نفعله جميعاً هو الانتظار. تجدين الجميع مساءً يستمعون إلى الأخبار عبر جوّالاتهم، ويستيقظون في اليوم التالي لينتظروا مجدّداً. نسمع يومياً الأخبار ذاتها، والاختلاف الوحيد هو في أرقام الضحايا فقط.
لوكنت أعلم أنّ حياتي ستكون هكذا لبقيتُ في سوريا وأسلمتُ نفسي لداعش لتقتلني، لأنّه من الأفضل أن يموت الإنسان مرّة واحدة على أن يموت ببطء كلّ يوم. نحاول أن ننسى مأساتنا، لكن كيف تنسى زوجتك وطفلتك وعائلتك؟ بكيت مرّة واحدة في حياتي قبل أن أصل إلى هنا، حين توفّي والدي، أمّا اليوم فأنا أبكي كلّ يوم.
وائل، خرّيج جامعي (داريا)
دفعت إلى المهرب ليخبّئني في شاحنة خارجة من تركيا إلى اليونان. كنّا أربعة متمدّدين في مقصورة ضيّقة جدّاً كالكفن، يرتفع سقفها عن وجهي مقدار ذراع واحد فقط. في أحد الجوانب توجد ستارة تفصلنا عن السّائق، وعلى الجانب الآخر جدار. كان المكان ضيّقاً لدرجة أنّك لا تستطيع الحراك إلّا إذا تحرّك معك الشّخص المقابل، كما كان الجوُّ شديدَ الحرارة في الدّاخل لدرجة أنّي حين خرجتُ من الشّاحنة كنت مبلّلاً بالكامل من العرق. كان السائق يصرخ علينا لنسكت إذا ما تفوّهنا بكلمة، ولا نستطيع إصدار أيّ صوت حين توقف شرطةُ الحدودِ الشاحنةَ لفحص أوراقها.
قال لنا المهرّبون إنّ الرحلة تستغرق عشرين ساعة، لكنّنا أمضينا أربعين ساعة. لم تكن لدينا أيّ فكرة عن موقعنا حين وصلنا، وبعد أن شحنت هاتفي النقال اكتشفت أنّنا بالقرب من حدود السويد.
السويد تختصر كلّ ما حلمتُ به لسوريا يوماً ما، من حيث معاملة الناس فيها. يريد الجميع هنا تسهيلَ الأمور لا تعقيدها على الناس، بينما في سوريا عليك تقديم الرّشاوى لأجل أيّ شيء تريده. لن تحتاج هنا إلى دفع أيّة رشوة لتحصل على شيء هو من حقّك أصلاً. ببساطة إذا عملتَ بجهد تصل إلى مناصب عليا في الحكومة، وكلّ ما يهمّ هنا هو مؤهّلاتك ومهاراتك. هنا قد ترى الملكَ يقوم بملءِ سيّارته بالوقود بنفسه، ويشتري مستلزماته من البقالة، وهو شيء بعيد جداً عمّا زُرِع في عقولنا في سوريا أنّ بشار الأسد إله.
عدد سكّان المدينة التي أعيش فيها ستون ألفاً، وفيها مكتبة ضخمة جدّاً كالحلم، تجد فيها أيّ كتاب تريده، وإذا لم تجده يحضرونه إليك من مكتبة أخرى. حين دخلتُها أوّل مرّة للبحث عن كتاب تذكّرت مدينتي داريا، حيث يسكنها نحو 250 ألف إلى 300 ألف شخص وليس فيها مكتبة واحدة. تلك إحدى استراتيجيات الديكتاتور، أن يحافظ على أميّةِ الشّعب، لأنّ إنشاء مكتبه للشّعب يعني أنّه سيقرأ، وحين يقرأ سيفكّر، وعندها سيعرف حقوقه ويطالب بها.
مرّةً كنت أتمشّى مع زوجتي هنا في الشارع، فرأتْنا امرأة عجوز وقالت لزوجتي «لماذا ترتدين غطاءً على رأسك؟ عودوا من حيث جئتُم!». مؤكَّد أنّنا انزعجنا حينها، لكنّنا اكتفينا بشكرها وعدم الردّ عليها. صادفناها لاحقاً عدّة مرّات في الشارع نفسه، لذا سلكنا شارعاً آخر تجنّباً لها، فنحن لم نأتِ إلى هنا لافتعال المشاكل، مع أنّ تصرّفها عنصريّ، وليس من حقّها التدخّل فيما يرتديه الآخرون، بالإضافة إلى أنّ القانون هنا في صفّنا.
أضعتُ إقامتي المؤقّتة خلال أوّل شهر من وصولي إلى السويد، وقالوا لي «لا مشكلة.. كلّ ما عليك فعله أن تقدّم بلاغاً إلى الشرطة». تردّدت كثيراً حين سمعتُ كلمة «شرطة» لأنّي تذكرت ما حصل حين أضعتُ هويّتي في سوريا وقلتُ لنفسي: «يا ترى هل سيحصل هنا أيضاً نفس ما حصل في سوريا؟».
ذهبتُ إلى مركز الشرطة، وكنت متوتّراً للغاية مستعدّاً للصعوبات التي سأواجهها. حين دخلت قال لي الموظّف: «مرحباً.. ماذا تودّ أن تشرب؟» شرحتُ له أنّي أضعتُ إقامتي، فسألني عن اسمي والمكان الذي أعتقد أنّني أضعتها فيه. وبعدها قال: «حسناً.. شكراً لك».
سألتُه: «هل هذا كل شيء؟».
رد: «نعم».
بعدها أخبرته عمّا تعرّضت له في سوريا حين أضعتُ هويّتي، فقال لي:
«أنا آسف جدا لما مررتَ به، وهذا كلّ ما نحتاجه منك هنا، على كلٍّ يمكنك متابعة كلامك إن كنتَ ترغب في الحديث».
أتمنّى لو أنّ في سوريا 10 بالمئة فقط من النّظام الديمقراطي الموجود هنا، لو كان كذلك لما قامت ثورة.
لانا، مهندسة ذرّة (دمشق)
كنت بعيدة أشدّ البعد عن شخصيّة البنت السّوريّة النّمطيّة منذ مراهقتي. أمّي من عائلة مسيحيّة وأبي من عائلة مسلمة، وكلاهما منفتحان للغاية، لكنهم يتوقّعون مني دوماً أن أكون الفتاة الناعمة واللّطيفة والأنثويّة والمطيعة. نساء الطبقة المخمليّة في دمشق لا يذهبن إلى المقاهي أو المطاعم إلّا وهنّ بكامل زينتهنّ وجمالهنّ ويرتدين الأحذية ذات الكعب العالي، وفي عائلتي كلّ النساء أجرين عمليّات تجميليّة لأنوفهنّ.
أمّا أنا فقد ثُرتُ على ذلك كلّه، كنت أستمع إلى موسيقى ميتاليكا طوال اليوم، وارتديت اللون الأسود سبع سنوات، وكنت على خلاف دائم مع أبي حين أخرج أو أتأخّر أو حين قمتُ بوضع قرط في شفتي. لكن في الوقت نفسه كانت درجاتي مرتفعة في المدرسة وخاصةً في الفيزياء. عادةً لا تحبّ الفتيات دراسة الفيزياء، لكنّني كنت أرغب في إزعاج والديَّ.
سمعتُ عن برنامج دراسة الهندسة الذرّيّة في الأردن، وكان ذلك ما أريده تماماً. تشاجرتُ مع أبي لأنّه كان ضدّ قراري. سأكون فتاة تعيش وحدها هناك، وهكذا سأكون حديث الناس. في النهاية قال لي أبي جملة من قبيل: «سأغضب عليكِ طول عمري إذا ذهبتِ». لكنّني في النهاية ذهبتُ، وكان والداي يقولان «مهندسة ذرّيّة؟ بالتأكيد لن يتقدّم لها أيُّ عريس» استسلموا لاحقاً، كما انضمّت أختي الصغرى إليّ لتدرس في الأردن أيضاً.
كان ذلك عام 2008 وكنت وقتها أعود لزيارة أهلي في لدمشق كلّ أسبوعين. شرطة الحدود الأردنية كانوا يحترموننا جداً، بالنسبة لهم القادم من دمشق كأنّه قادم من سويسرا. لكن ذلك كلّه تغيّر عام 2011، حين تدفّقت أعداد هائلة من السّوريّين نحو الحدود الأردنيّة للّجوء إليها. تغيّر تعامل الشرطة الأردنيّة معنا، وأصبحوا يصرخون على القادم ويقولون «اذهبْ وقفْ هناك مع باقي السوريّين».
كان السوريّون يُعامَلون كأنّهم عبء، وهو أمر في غاية الإذلال. أنهيتُ جامعتي عام 2013، وكنت أخاف من أن أعيش في العالم العربي، وأردتُ الهرب إلى أيّ مكان. قدّمت طلباتٍ إلى أكثر من مئة برنامج خاصّ بالخريّجين في جامعات إيطاليا وأميركا وكندا، جميعها جاءت بالرّفض. سوريّة تعمل في مؤسّسة ذرّيّة!؟ ممنوع.
بعدها حصلتُ على قبولٍ في جامعة ألمانيّة، وذهبت إلى السّفارة لإجراء مقابلة الفيزا. كنت واقفة في الخارج أبكي من شدّة رغبتي في السّفر، لم أتمنَّ شيئاً في حياتي كما تمنّيتُ الرّحيل حينها.
حصلتُ على الفيزا وأنهيتُ دراسة الماجستير خلال سنتين، وبدأتُ أقدّم طلبات للحصول على وظيفة. قدّمت 260 طلباً، وأجريت اثنتي عشرة مقابلة عمل، خضعتُ لاختبارات الأمان كلّها، وجميعهم أحبّوني لكن كان توظيفي صعباً. في إحدى المرّات أخذتُ قطاراً لمدّة ثماني ساعات لأُجري مقابلة عمل، وقبلوني في الوظيفة. أذكر كيف طار قلبي من السعادة، ولكن حين سألوني عن جواز سفري وقالوا «أنتِ أردنيّة صحيح؟» وحين علموا أنّي سوريّة غيّروا رأيهم، وأخذتُ قطار العودة لثماني ساعات أخرى وأنا محطّمة تماماً.
أخيراً حصلتُ على الوظيفة التي أعمل فيها حالياً. ما زلتُ جديدة هنا، لذا أقوم بمهمّات تقنيّة فقط ككتابة الشّيفرات وإجراء الحسابات لتجهيز المفاعلات في حالة حدوث خطب في المولّدة أو المضخّة. يحترم الألمان كوني قويّة ومستقلّة، لكنّي اكتشفتُ هنا كم أنا سورية بطريقة تعاملي مع النّاس، وبكيفيّة إدخالي بعضَ الأصدقاء في حياتي. هذه سوريا، وهذه ثقافتنا العربيّة.
أصدقائي المقرّبون هنا جميعهم سوريّون، ما كنت أعتقد يوماً أن تتقاطع دروبُ حياتنا لو كنّا في سوريا. أحدهم شابّ من أقلّيّة دينيّة تدعى الإبراهيميّة، وآخر أصدر كتاباً في ألمانيا، وآخر شابّ مثليّ وأفضل راقص شرقيّ على الإطلاق. شخصيّاتنا مجنونة، وكأنّنا مجموعة وجوهٍ خارجةٍ من الحرب بأمراض جديدة. بعضهم عقول رائعة تحاول الحصول على فرص جديدة، والبعض كان يعمل في الثّورة وهو مدمَّر الآن. كثيرون مصابون باكتئاب شديد ويلجؤون إلى المخدرات للتأقلم. لم يعودوا يؤمنون بأيّ شيء.
أنا وأصدقائي جميعنا حزينون من الداخل، لكن لا نتّحدث عن هذا الموضوع. لدينا قناعة مشتركة وهي: إذا أردتَ أن تتحدّث عن الحرب فعليك فعلُ شيء أو تقديم شيء، كأن تخرج في مظاهرة مثلاً، أمّا إذا لم يكن لديك ما تقدّمه فعليك إغلاق فمك.
يبدو الأمر انفصاماً في الشخصيّة، لكنّه في الوقت نفسه طريقة ناضجة للتّعاطي مع مشاكلنا، لأنّنا جميعاً نبحث عن الاستقرار ونحاول أن نحيا.
لو لم أذهب للدراسة خارج سوريا لما أنهيتُ جامعتي أبداً أو وصلتُ إلى ما أنا عليه اليوم. حتّى أبي، رغم أنه أعند منّي، كان واعياً بذلك. هو ليس من أولئك الذين يمكنهم التعبير عن مشاعرهم بقول «أحبك» مثلاً. لكنه في أحد الأيام، بعد بدء الحرب، ناداني واستطاع أن يقول لي: «شكراً لأنّكِ تشبّثتِ برأيك ورحلتِ، لقد أنقذتِ نفسَك وأختَك أيضاً».
ياسمين، خبيرة تعليم (مخيم اليرموك)
قلنا وداعاً لبلدنا، لن أعود قبل أن يصبح وطناً لي. ما هو الوطن؟ ليس الوطن أشجاراً وحجارةً، هو النّاس التي تبني الأرض، وهو المكان الذي تشعر فيه بالانتماء والأمان. الوطن هو ذلك الصديق الذي تعمل معه وتشاركه شرب القهوة كلّ صباح، وهذا الصديق غدر بي مقابل حفنة مال أو منصب أفضل. ما إن اشتدت الحرب حتى بدأ الناس يكتبون تقارير للأمن. إذا كان أحدهم يحمل حقداً على أحد، أو يرغب في الانتقام من أحد، سيقوم ببساطة بالوشاية به. قام أحد زملائي بالعمل بكتابة تقرير عنّي واستدعاني الأمن، ثمّ حقّقوا معي واكتشفوا أنّي لم أقم بشيء فأطلقوا سراحي. نجوتُ هذه المرّة منهم، لكن من يدري ما سيحصل المرة المقبلة إذا تكرّر الأمر.
لم أخن وطني، لكنّه خانني ودفعني إلى مغادرته. حين تحوّلت الثورة على الفساد إلى حرب عالمية، لم يعد هناك وطن، بل قبر نموت فيه ببطء. في بلدي أقوم بأداء واجباتي ولا أحصل على حقوقي، لكن هنا في السّويد الأمر مختلف، تؤدّي واجباتك وتحصل على حقوقك في المقابل، وهذا تماماً ما يعنيه الوطن.
أصبح أبنائي الثلاثة يحملون جنسيّات أوروبية، تلقّى ابني الأكبر دعوةً إلى مؤتمر في السّويد، وبقي فيها، وهو الآن ينهي سنتَه الثالثة في الجامعة هناك. وتلقّى ابني الأوسط دعوةً من صديقه الإسبانيّ ليزوره في إسبانيا، وهو اليوم يدرس هناك، ويحمل الجنسيّة الإسبانيّة. وحصلت ابنتي على منحة لإكمال دراستها في قطَر، وهناك استطاعت الحصول على فيزا سياحيّة بسهولة إلى هولندا واستقرّت هناك.
في المستقبل سيتحدّث أحفادي الهولنديّة والسويديّة والإسبانيّة، ولن يستطيعوا التواصل فيما بينهم إذا لم يتعلّموا العربيّة، ولن يكون لهم أيّة صلة بالبلد الذي جاؤوا منه، فهم لم يعودوا سوريّين. أمّا أنا فسأكون امرأة عاشت في المنفى وماتت فيه.
إيمان، مهندسة (حرستا)
بعد شهر من وصولنا إلى تركيا، سجلنا أسماءنا مع الأمم المتحدة بهدف العثور على ملجأ جديد. استمرّت المقابلات والتّدقيق الأمني لسنتين، سألونا عن كلّ ما حصل لنا في حياتنا، واستفسروا عن كلّ تفصيل صغير فيها وبدقّة. قابلوني أنا وزوجي في غرفتين منفصلتين، وكنّا تحت ضغط نفسيّ وتوتّر كبير خوفاً من أن ننسى شيئاً وتختلف أقوالنا، خاصّةً حين يتعلّق الأمر بالتواريخ. معظمنا لا يتذكر التواريخ بدقة، مثلاً قال زوجي إنّنا هربنا من المنزل في أول تموز، بينما قلت أنّنا تركناه في آخره حين أصبح القصف شبه يوميٍّ.
بعد المقابلات بدأت مرحلة الانتظار، كنت على حافّة الانهيار من التوتّر. لا تعلم إن كنتَ ستحصل على مستقبل أو لا. أملك شهادة في الهندسة لكن ربّما لا أستطيع العمل بها أبداً. كنت محظوظةً، وحصلت على عمل في تركيا في منظّمة للاجئين، كنت أعلّم الأطفال كيف يتعاملون مع الكمبيوتر. معظم الناس هناك لا يستطيعون الحصول على عمل.
كنّا نعيش على ذلك الأمل لسنتين، وكنت أنظر إلى هاتفي يوميّاً منتظرة اتصالهم. زوجي طبيب يدير عيادة بالقرب من منزلنا، وكان مثلي ينتظر تلك المكالمة يومياً. وفي يوم من الأيّام اتّصلوا بنا أخيراً وقالوا إنّ تذكرتنا إلى أميركا صدرت، وإنّ رحلتنا حُدّدت بتاريخ 23 أيلول. أُصِبت بحالة من الإنكار، لم أستطع استيعاب ما كان يقوله الموظف.
كان الوضع صعباً جدّاً في أميركا في البداية، لكون كلّ شيء كان مختلفاً. كنت أتمزّق من الداخل حين تتكلّم معي الاختصاصيّة الاجتماعيّة لأنّي لم أكن أفهم كلمة ممّا تقوله لي. سجّلت في دورة لتعلّم اللّغة الإنكليزيّة خلال أسبوعين. أردتُ التعلُّم بشدّة، ودرست ليل نهار.
لا زلتُ أحلم بالعودة إلى سوريا. كنّا متزوجين حديثاً، وسكنّا في منزلنا الجديد لشهرين فقط قبل أن نضطرّ إلى تركه ونهرب. أذكر كيف اخترتُ كلَّ شيء فيه بعناية، من الأثاث والستائر وألوان الجدران. أحلم أن أعود إليه يوماً ما، لكنّ زوجي لا يرغب في العودة أبداً، ولديه الحقّ كلّه بموقفه هذا بعد ما عاناه في السجن هناك. النسيان نعمة كبيرة بالنسبة لأولئك الذين عانوا مثله.
أحمد، ناشط (درعا)
سجلنا كمنظمة غير ربحيّة لإرسال المساعدات من الأردن إلى سوريا. بدأت أتعبُ في بداية خريف عام 2014، وكان النّظام يهدّد باغتيالي داخل الأردن. كنت أملك فيزا للولايات المتحدة وقرّرتُ وزوجتي أن نذهب ونحاول العيش هناك. رحلتُنا الأولى كانت من عمّان إلى إسطنبول ثم واشنطن. لكنّهم أوقفوني في مطار إسطنبول، وأعادوني إلى عمان بسبب تقرير رفعه النّظام السوري باسمي إلى الإنتربول. حاولنا السّفر مجدداً لكن برحلة مباشرة إلى نيويورك لكن تعرقل الأمر مرّة ثانية. في المرّة الثالثة منحتْني السفارة الأميركية فيزا استثنائيّة، وتمكنت مع زوجتي من اللّحاق بعائلتي التي كانت تعيش مسبقاً في فيرجينيا.
قدّمت طلب لجوء حالَ وصولي، كان ذلك منذ ثمانية عشر شهراً، وما زلت منتظراً حتى الآن أن يردّوا على طلبي، لكن حتى اللحظة لم تأتِ إجابة، وليس لديّ سوى الانتظار. على الأقل حصلت زوجتي على رقم يثبتُ استلامهم طلبَها، لذا استطاعت الحصول على تصريح وإيجاد عملٍ في تخصّصها، تصميم المواقع والجرافيك. لكن أنا لم استلم شيئاً مع أنّي قمتُ بإرسال معلوماتي كلّها ثلاث مرّات، من دون أن يصلني أيّ رد. أشعر أنّي عالقٌ هنا بلا جواز سفر للعودة أو حتى تصريح لأبدأ العمل، عالقٌ فقط، ووضعي هو: لا شيء.
منذ بدأت الانتخابات التي فاز فيها دونالد ترامب ونحن نفكر: «ماذا الآن؟». الجميع خائفون ويفكّرون: «ماذا إن طردونا؟ إلى أين سنذهب؟». بدأنا نسمع أشياء بشعة مثل رسائل على الأبواب تقول للسكّان: «اترك الحيّ إذا كنت مسلماً». لديّ صديق يعيش في غرب فيرجينا منذ خمس سنوات، وزوجه ترتدي الحجاب طول حياتها، لكنّها قرّرت التخلّي عنه وهي حزينة جداً، لأنّها شعرت أنّ الوضع الحالي يحتّم عليها ذلك. أسوأ ما في الأمر أنّ أولئك الناس هربوا من بلدانهم التي تهدّدهم ليعيشوا بحرّيّة. جاؤوا إلى الولايات المتّحدة ليعيشوا الديمقراطيّة ويشعروا أنّهم حقّقوا شيئاً ما. تغيّرت نظرتهم إلى الأمور الآن.
لكنّني ما زلتُ أحبّ هذه البلاد. لم نتعرّض أنا أو زوجتي لأيّ مشاكل حتى الآن، ونأمل أن يستمرّ الحال هكذا. بل إنّني دُهِشت بمدى لطف الناس حولنا هنا. يتحدّث إليك النّاس في الشارع عن حياتهم اليوميّة ومشاكلهم الزوجيّة، أحببتُ ذلك كثيراً، وذكّرني بالنّاس في درعا لأنّهم يفعلون الشيء ذاته هناك.
بدتْ لنا بعض الأمور معقّدة في البداية، مثلاً في بلدي النّاس يتعاملون بالعملات النقديّة، لذا كان علينا أن نعتاد بطاقاتِ الصّرف والائتمان والسّجل الحسابي والنقاط الائتمانيّة. أيضاً من الأمور الجديدة علينا هنا أن تطلب منك المحلّات بريدك الالكتروني ليرسلوا إليك الإعلانات، مثل آلاف الرسائل التي تصلني يومياً من محلّ «هوم ديبو».
أذكر أيضاً في أوّل فترة انتقالي إلى هنا أنّي استأجرت سيّارة، وخلال قيادتي وقفت على الإشارة وحين أصبحت خضراء استدرت يساراً. أوقفني شرطي المرور وقلت له «لقد كانت الإشارة خضراء» فشرح لي أنّه تعيّن عليّ انتظار إشارة السهم. لم تكن عندي أدنى فكرة عن ذلك السّهم لأنّنا لا نعرفه في سوريا. اليوم أنا أنتظر تلك الإشارة، ومهما استمرّ الشّخص الذي خلفي بالتزمير، لا آبه.. فأنا أنتظر السهم.
هادية، معالجة (دمشق)
جئنا إلى أميركا عام 2010 ضمن برنامج فولبرايت، كنا اثني عشر طالباً من سوريا. كنّا سعيدين بهذه الفرصة، ونريد العودة لديارنا بعد انتهائها، لم تكن لدينا أيّ نيّة بالبقاء هنا.
انطلقت الثورة وأنا هنا، كنت أبذل قصارى جهدي لتقصّي التفاصيل التي تحدث هناك من أخي ومن أبناء عمومتي في دمشق. كنت متعطّشة لمعرفة كلّ ما يدور هناك لأشعر أنّي أعيش معهم قصصهم ولحظاتهم. لربما أستطيع يوماً ما تقبُّل سبب عدم وجودي معهم حين جرت كلّ تلك الأحداث. في الجامعة كان الجميع يقولون لي باستمرار «على الأقلّ أنتِ هنا بأمان». هذه الكلمة بالذات كانت تثير جنوني «أمان»! كنت أرغب في الصراخ قائلة «أنتم غير مدركين أنّ هذه لحظات تاريخيّة وكان عليّ أن أشهدها».
أخي وأمّي حصلا على فيزا لحضور تخرّجي هنا في الولايات المتّحدة. كان المفترض أن تبقى أمّي شهراً وتعود بعدها، لكن خلال زيارتها عندي بدأ النظام يقصف ضواحي دمشق والتي لا تبعد سوى دقائق عن منزلنا. لذا أجّلنا موعد تذكرة عودتها عدّة مرات، لم نعتقد أنّها ستبقى هنا هذه المدة كلّها. كما اعتادت أمي القول «جئت بحقيبة واحدة ودون أن أودّع أحداً».
خلال تلك الفترة كان أخي يعمل مع مؤسسة خيريّة لجلب الطعام إلى المناطق المحاصرة حول دمشق. اعتُقِل العديد من أصدقائه، لأنّ تأمين الخبز يُعَدُّ جريمة هناك. حين يعتقل أحدهم يأخذون هاتفه النقال ويعتقلون كلِّ من يمتّ إليه بِصِلَة. لم يبقَ سوى ثلاثة أيّام على نهاية مدّة الفيزا الخاصة به، وكان عليه أن يقرّر السفر والمجيء إلى هنا قبل انتهاء هذه المدّة، لذا أصرّينا عليه، وسافر أخيراً.
حين وصل، كان يمكن تلمّس ملامح الرضوض النفسية على وجهه نتيجة ما عاشه وشهده هناك. كان يقضي يومه كلّه على الإنترنت يتواصل مع الناس ويحاول مواكبة الأحداث وإطلاق حملات التبرّع لتأمين اللّوازم الطبّية وغيرها.
حلّ الشتاء وقلتُ لأمي «لنذهب إلى السوق ونشتري لكِ معطفاً».
قالت «لا أستطيع التسوّق والناس في بلدي تموت وليس لديهم ما يدفئهم».
لأقول لها «شيكاغو باردة وعليكِ شراء معطف».
لتقول «لكن لدي الكثير من المعاطف في بيتي هناك».
تصبح تلك التفاصيل الصغيرة كالحجر على صدرك، وتتمنّى إزاحتها عنه. لا تستطيع منع نفسك من التفكير بثمن السندوتش الصغير حين تشتريه، يا ترى ماذا سيساوي لو أرسلت ثمنه إلى سوريا؟
دوري مختلف عن أولئك الذين في الدّاخل، كان عليّ فعل شيء ما. أشعر أنّه من مسؤوليتي أن أتحدّثَ عنهم وأنقلَ القصّة إلى الجميع وأشرحَ للعالم ما يجري على الجانب الآخر منه.