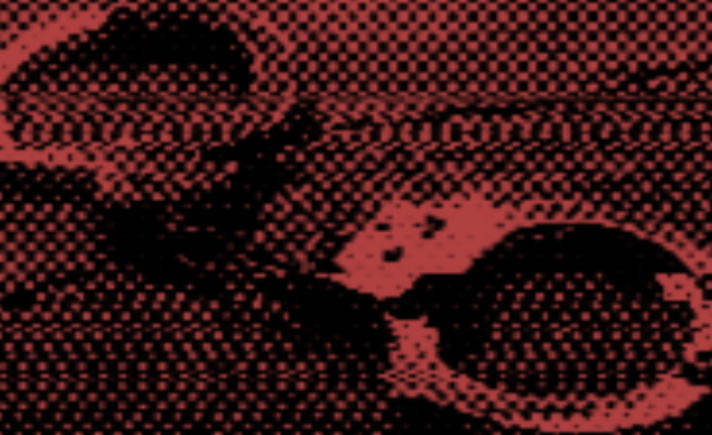الفهرسالفصل الأول: السلطة |
يتناول الفصل الخامس فترة تسليح الثورة، التي بقيت من شهر آذار إلى أيلول عام 2011 محافظة على سلميَّتها رغم سقوط ما يقارب الألفي قتيل. بعدها حمل ثوار ومنشقون عن الجيش بالتدريج السلاح للدفاع عن المتظاهرين وبعض المناطق، وفي النهاية قاموا تحت راية الجيش السوري الحر بشن هجمات على أهداف في جيش النظام. وبسبب غياب الشبكات والبنى التحتية، لم يكن الجيش الحر قوة منظمة أو منضبطة بل أقرب إلى عنوان ينضوي تحته مئات الكتائب المستقلة. أُنشئ المجلس العسكري الأعلى واتخذ تركيا مقراً له، لكنه فشل في فرض قيادته على الكتائب. كما قامت شخصيات معارضة في الخارج بتشكيل مؤسسة تمثلهم أطلقوا عليها اسم «المجلس الوطني السوري»، وشكّلوا بعدها «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة». كلاهما فشل في تأسيس قيادة رسمية للثورة.
استطاع الثوّار طرد قوات النظام من عدة مناطق في سوريا، وردّ النظام بدكِّ تلك المناطق بالمدفعية والصواريخ والقصف الجوي مستخدماً سياسة الأرض المحروقة. وعندما تمكن الثوار من السيطرة على معظم مناطق حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا، قصف النظام المدينة عشوائياً مخلفاً فيها دماراً هائلاً. بعدها تمت محاصرة المقاتلين وآلاف المدنيين في حمص القديمة، بقي هؤلاء على مدار سنتين بلا طعام ولا دواء إلى أن وافق النظام على إخلائهم.
نشأت مجموعات مسلحة كان لدى كثير منها أيديولوجيا إسلامية، أبرزها جبهة النصرة التابعة للقاعدة، والتي أعلن عنها في كانون الثاني 2012. تعود جذور جبهة النصرة إلى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما سهل الأسد تدفق المقاتلين الإسلاميين نحو العراق لمحاربة القوات الأميركية، لكنه حين أدرك خطرهم على نظامه أيضاً، اعتقلهم فور عودتهم إلى سوريا. وفي بداية الثورة حينما كانت ماتزال في طورها السلمي، أطلق النظام سراح معظمهم بعفو رئاسي عام. وهكذا، استطاع أن يلصق تهمة الأسلمة بالثوار ليُبرِّر كذبة محاربته للإرهاب. في شهر نيسان عام 2013، أُعلن عن ولادة تشكيل آخر تابع للقاعدة، هو الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي يعرف بتنظيم «داعش» وهو أكثر تطرفاً من سابقه. تمتّع كلا تنظيمي النصرة وداعش بالدعم، واتسما بالانضباط، وانضمَّ إلى صفوفهما أعداد هائلة من العناصر الأجنبية. ساعدت كل تلك العوامل في انتشارهم على الأرض بقوة أخذت تنمو على الأرض على حساب انتشار الجيش السوري الحر.
طرحت مبادرات كثيرة لحل هذا النزاع الدموي، كإرسال مراقبين دوليين وخطط لوقف إطلاق النار ومحاولات لعمليات سلام، لكنها باءت جميعها بالفشل. اكتفت الحكومات الغربية بإدانة الأسد، ولم تستجب لنداءات المعارضة بفرض منطقة حظر طيران أو دعمها بأسلحة مضادة للطيران لحماية المدنيين من القصف. حظي الثوار بدعم وتمويل من بعض الدول كأميركا والسعودية وقطر وتركيا، كما تلقوا تمويلاً من مؤسسات خاصة. لكن المؤسف أن التمويل كان يتم عبر مصادر مختلفة ولجهات مختلفة تحقيقاً لمصالح الجهات الداعمة. العديد من المتشكّكين في الثورة السورية انتقدوا هذا الانقسام وسوء التنظيم، وأرجعوا إليهما سبب التردّد في تقديم دعم أكبر. وقد أكد الثوار أن فوضى مصادر الدعم وتوزيع الموارد كانت السبب الأكبر للانقسام، ناهيك عن الفساد، في أوساط مقاتليهم.
على الجهة الأخرى تلقى الأسد أيضاً دعماً كبيراً من إيران وروسيا والعراق وحزب الله اللبناني. مدوه جميعاً بالمال والسلاح والمقاتلين أيضاً، والأخطر من ذلك كله كان الغارات الجوية التي شنوها دفاعاً عنه ضد أعدائه. أعطى ذلك الدعم قوة هائلة للنظام، كما كان له دور كبير في إشعال المنطقة بأكملها. توضّح الدور المتزايد لحلفاء النظام في الحملة على بلدة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، والتي كانت مهمة للغاية في خطوط الإمداد. في محاولته استعادة هذه البلدة، تعاون الجيش بشكل علني مع حزب الله وقوات الدفاع الوطني (وهي مجموعة مسلحة تأسست بمساعدة من إيران وحزب الله) وقد كان ذلك منزلقاً هائلاً للحرب السورية نحو السياسات الإقليمية.
قبطان، مقاتل (حلب)
تأتي قوّات الأمن حال بدءِ المظاهرة، كنّا نرميهم بالحجارة وكانوا يستخدمون الغاز المسيل للدّموع ضدّنا. بعدها يفتحون النّيران علينا. وحين تحوّل الأمر إلى إطلاق الرّصاص أصبحنا بحاجةٍ إلى السّلاح أيضاً. أصبح الوضعُ إجراميّاً، وكان علينا مهاجمة مَن يهاجمنا.
كنّا نهتف فقط في الشّوارع، وكان من الممكن أن نقضي عمرنا في الهتاف دون أن يلتفت إلينا أحد. لكن حين بدأ النّظام بمهاجمتنا انضمّ كثير من الناس ممّن كانوا يكتفون بالمتابعة من بعيد إلى المظاهرات. الدّم هو ما دفع النّاس إلى المشاركة وحرّكهم، الدّم هو قوّة الثّورة.
عزيزة، مديرة مدرسة (حماه)
حضر السّفيران الأميركيّ والفرنسيّ مظاهرة الـ 500 ألف شخص في حماه. وهناك تمّ التّرحيب بهما بحرارةٍ عالية. خرج النّساء والرّجال والأطفال في تلك المظاهرة حاملين أغصانَ الزّيتون والورود. لا تتخيّلين حجم السّعادة والأمل اللّذين كانا لدى النّاس، كانوا يعتقدون أنّ الغرب يدعمهم.
زوجي من مدينة حمص، وأصبح قائداً للمظاهرات هناك. ازدادت وتيرة العنف في حمص، لكن المتظاهرين استمرّوا بالهتاف «واحد واحد واحد / الشّعب السّوري واحد»، وحين ازداد الوضع سوءاً هتفوا: «يا علوي حط إيدي بإيدك / بيت الأسد ما ح يفيدك».
الرستن إحدى قرى ريف حمص، معظم أهلها إسلام سنة محافظون. ذهب زوجي ليقدّم لهم التّعازي بعد أن استُشهِد بعضُ شبابهم. قال لهم: «يريدون تقسيمنا إلى مجموعات دينيّة، لكنّ الدّين لله، والوطن للجميع»، ردّد أهالي الرّستن بعدَه: «الدّين لله، والوطنُ للجميع».
كلّما استطاع الشّعبُ تخطّي الطائفيةِ والتعاملَ معها زاد بطشُ النّظام ووحشيته. كان يرسل الشبّيحة ليقتحموا بيوتَ النّاس ويخطفوا الفتيات أمام أعينِ ذويهن. قال الرّجال إنهم يحتاجون أسلحةً للدفاع عن أنفسهم، عارضت ذلك كثيراً وقلت: «هم يريدون جرَّكم إلى القتل» وسألتُهم: «هل تملكون دبّابات أو طائرات؟ النّظام أعدَّ جيشاً كاملاً لسنين على أساس أنّه لمحاربة إسرائيل.. ليس لديكم أيُّ فرصة لمجابهته»، ليقولوا: «صبرنا كثيراً، وتحمّلنا أكثر، إنّهم يخطفون بناتنا من أيدينا ويغتصبونهنّ، هل علينا أن نقف متفرّجين؟».
أبو سمير، ضابط منشق (دوما)
كنت في دوما، وشهدتُ مجزرةً مِن شبّاك منزلي. كانت هناك مظاهرة، وحين شارفت على الانتهاء، فتح النّظام النّار على المتظاهرين. هناك طرائق قتل رحيمة، لكن ما رأيته كان مختلفاً وقاسياً جداً. قُتل النّاس العُزّل بشكل وحشي، هشّموا رأسَ أحدهم على الأرض، وسحلوا الجُثَث في الشارع.
تحدّثت مع أخي زوجتي في اليوم نفسه، وطلبت منه أن يجمع لي رجالاً أقوياء. شكّلنا مجموعة مسلّحة. كانوا سبعة، وأنا الثّامن، ثلاثة منّا يحملون كلاشينكوف، والبقيّة يحملون بنادق صيد. طلبنا المال من هنا وهناك، وبعدها ذهبنا إلى مناطق مهرّبي الأسلحة في سوريا ولبنان لنشتري السّلاح والذّخيرة.
بدأنا نتحرّك ونعمل ليلاً، ونقوم بعمليّات ضد حواجز النّظام ومُنشَآته العسكريّة ونعود. عارضَنا الكثيرُ من الأقارب والأصدقاء، كانوا خائفين من أن تقودنا تلك العمليات إلى نهاية دمويّة. لكنّني كنت أقول لهم «دوماً إنّ نظامَنا دمويٌّ، وسيقتلنا جميعاً، لذا علينا إمّا الدفاع عن أنفسنا وعن عائلاتنا أو..».
عابد، ضابط منشقّ (تدمر)
كنّا أربعة ضبّاط في الجيش السّوريّ، ونحمل أوراقنا الثبوتية، لذا كنّا نملك حرّيّة التّنقُّل بين جميع المحافظات السّوريّة، وهذا ما جعلنا قادرين على مساعدة المتظاهرين. وزّعنا المساعدات الإنسانيّة والأغذية والإمدادات الطبّيّة على المناطق المحتاجة.
لا تخضع سياراتنا للتّفتيش. عندما أمرّ بأيّ حاجز أو نقطة عسكريّة أُخرِجُ هوّيتي للعسكريّ ليحيّيني ويقول: «تحيّاتي.. تفضّل سيّدي». إذا كنتَ ضابطاً في الجيش السوري فإنّك تنالُ احتراماً كبيراً، فأنتَ فوقَ الجميع. تقف في طابور الانتظار؟ مستحيل. هكذا كانت الأمور في سوريا، ونحن كنا نعي ذلك تماماً.
انطلقت الثورة في آذار، وحمل المدنيّون والمقاتلون السِّلاح في آب. قلتُ لهم من البداية إنّ النّظام لن يرحل إلّا بقوّة السّلاح، لذا فإنّكم ستحملونه في كلّ الأحوال سواء رغبتم أم لا. خرجت المظاهرات السّلميّة كلَّ يوم، وكلّ يوم كان يستشهد خمسة أو ستة وأحياناً عشرة. بتلك الطريقة لن نصل إلى أيِّ هدف أو نحقّق شيئاً. كان علينا أيضاً أن نكفّ عن انتظار دعم العالم لنا والاعتراف أخيراً بأنّ ذلك الدّعم ما هو إلا خرافة كبيرة.
بدأ الخناق يضيق علينا في نهاية 2011، وبدأ الضبّاط الآخرون يشكّون في أمرنا. فشلت خططُ النّظام ومناوراتُه باستمرار، فشعر أنّ المتمرّدين لديهم أذرعاً داخليّةً.
كانت مهمّاتي بعيدة عن القاعدة في تلك الفترة. وذات يوم جاءني ملازمٌ أرسله إليّ ضبّاطٌ في القيادة ليقول لي إنّهم يريدون منّي أن أرسلَ إليهم تقارير. تفاجأتُ حينها وسألتُه: لماذا لم يتواصلوا معي مباشرة؟ فقال إنّه لا يعلم.
لم أطمئنّ إلى الأمر، لذا طلبتُ من الملازم أن أستخدم هاتفَه النقال متذرعاً بأنّ هاتفي انتهى رصيدُه. كنت أريد أن أتّصل من هاتفه لأسمع ما سيقوله الضابط، وعندما أمسكتُ الهاتف وصلته رسالةٌ من الضابط نفسِه تقول «ابقِ عينيكَ على عابد، نحن قادمون لأخذه»،
أجبتُ على الرسالة: «عُلِمَ» وبعدها مسحتُها، وأعدتُ الهاتفَ إلى الملازم، وشكرتُه. أخذتُ حقيبتي على الفور، وخرجتُ مسرعاً من هناك، وبعد شهرٍ غادرتُ البلد.
أشرف، فنّان (القامشلي)
لو تدّخلت القوى العالميّة لوقف النّظام منذ البداية لما وصلنا إلى هذه النقطة، ولو فرضوا منطقة حظر طيران فقط لكانت الأمور أقلَّ بؤساً. المصيبة أنّ العالم لم يكتفِ بالصمت على قتلِنا، بل كان يقول لنا «انهضوا وثوروا، نحن معكم». أعلن الرّئيس الترُّكيّ رجب الطّيّب أردوغان أنّ قصف حمص خطٌّ أحمر، بينما صرّح أوباما أنّ الأسلحة الكيماويّة خطٌّ أحمر. تحمّس النّاس للتّظاهر والانضمام إلى الثّورة لأنّهم ظنّوا أنّ خلفهم داعمينَ دوليّين، وحين تجاوز النّظامُ كلَّ تلك الخطوطِ الحُمْر لم يتّخذوا أيَّ خطوة ضدّه. وتُرِكَ الشّعب في حالة يأسٍ تامّة، وأدركَ حينها أنّه يجب أن يعتمد على نفسه فقط.
عبد الرحمن، مهندس (حماه)
تشعر في تلك المظاهرة في حماه كأنّك في الجنة، كانت قوّة أصوات الناس كالزّلزال. نصفُ مليون حرٍّ وحرّةٍ معاً. هربت قوّات الأمن حينها، أي أنّنا حرّرنا حماه بعددنا الكبير، ليس بالسّلاح. أقام كلّ حيّ حاجزاً ليمنعَ قوّات الأمن من العودة. كنّا نعلم أنّها مسألة وقت فقط إلى حين وصول الجيش ليقتحم الجموع، كان علينا حماية أنفسنا.
أصبحتُ خبيراً بالمولوتوف، جمعنا التبرّعات، وذهب ابن عمّي مع آخرين لتهريب الأسلحة من شمال لبنان. كانت لدينا قائمة بالأسلحة التي نستطيع شراءها، AK-47 بقيمة 150 ألف ليرة، ورشاش PKC بقيمة 175 ألف ليرة، وعلبة رصاص PKC بقيمة 15 ألف ليرة. كما اشترينا ذخيرةً من عناصر في الأمن السّوري. كان لدينا جواسيس داخل الأمن السّوري يطلعوننا على أحدث قوائم أسماء المطلوبين للنّظام.
قبل ذلك كنت أدّخرُ مالي للزّواج من خطيبتي، لكنّني وقعتُ في حيرة ما بين حياتي الشّخصية ورغبتي في الحصول على سلاح لحماية أهلي. لطالما حلمتُ بذلك صدقاً، لكن كان عليَّ الانتظار، إذ توجد قائمةٌ طويلة لمن يرغبون في حمل السّلاح، ولم أكن على رأس تلك القائمة، لأنني لم أُؤَدِّ خدمتي العسكرية مثل الآخرين، لذلك لم أملك الخبرة الكافية في حمل الأسلحة واستخدامها.
بدأ النّظام يقصف المدينة في 31 تموز الساعة 6:30 صباحاً. كان بإمكانك أن تشمّ رائحة نار المدفعيّة وتسمع ارتجاجها. أغلقَ النّاسُ الشّوارعَ بالصَّخر. لم يكن في حيّنا كلّه سوى بندقيتين من طراز AK-47 وثلاثة مسدسات، كما كانت توجد قنبلة يدويّة مع شخصٍ لا أدري من أين حصل عليها. بدأنا بتعبئةِ المولوتوف وتوزيعه على الحواجز. كنّا نظنّ أنّ بمقدورنا إيقاف أيّ شيء.
كانت أصواتُ المحرّكات تقترب، وفجأة قصفونا. كنّا اثني عشر شخصاً على الحاجز، قُتِل منّا سبعة، وهرب خمسة بجروحهم، كنت منهم. كان حيُّنا ضعيفاً، ودُمِّرَتْ دفاعاتنا، لم نفعل أيَّ شيء، بل لم نتمكّن من البدء بذلك.
قاومتْ حماه في اليوم الأوّل من الحصار، لكن في اليوم الثّاني لم تحدث أية مقاومة. اجتاحت قوّات النّظام المدينةَ، وقتلت 309 أشخاص، بعدها انسحبت. وفي صباح اليوم الثّالث كان القصف شديداً، استيقظتُ على صوتِ بكاءِ أختي، وبدأت أمّي تتلو وصيّتها. كانوا يتوسّلون إليّ لمغادرة حماه، وكنت رافضاً حتّى ذلك الحين، وعندما قرّرنا الرّحيل مع الجميع لم يكن أحدُنا يعلم إلى أين الوجهة.
ذهبنا إلى دمشق وبقيتُ فيها خمسة عشر يوماً حتّى عُدْتُ أخيراً إلى حماه لأجد المدينة تغيّرت تماماً. انتشرت حواجز النّظام والمدافع الكبيرة، وعُلِّقَت صُور بشّار الأسد في كلّ مكان. مشيتُ في شوارع مدينتي وأنا أقرأ ما كُتِبَ على الجدران مِن عبارات مثل «لا إله إلا الأسد» و «الأسد أو نحرق البلد». استمرّ النّاس بإبداء قليلٍ من المقاومة عبر تحرّكات صغيرة، كعصيان المحلّات التّجاريّة، ليقولوا للنّظام «نحن ما زلنا هنا».
في ذلك الوقت بدأت فكرة إنشاء الجيش السّوري الحرّ، بينما كان اسمي ما يزال قيد الانتظار على قائمة حمل السّلاح. حينها علم ابن عمّي أنّني على قائمة المطلوبين لدى النّظام، لذا كنت أنام كلَّ يوم في بيت مختلف لمدّة شهرٍ كي لا يقبض علي وأُعتَقل.
كنا نترقّب أيّة أخبار سعيدة من المدن الأخرى، انتصارات أو دعم قد يرفع قليلاً من الضغط عن حماه. أخبرني ابن عمّي أنّني مطلوب على نطاق مدينة حماه، أي أنّه ما تزال لديّ فرصة الهرب إلى أيّ مدينة أخرى في سوريا، لكن عليّ أن أُسرِعَ وأغادرَ فوراً. كانت الثّورة كلَّ أحلامي، لم أكن جباناً، وأردتُ من كلِّ قلبي أن نُنهي ما بدأناه، لكنّ أهلي أصرّوا عليّ، وأقنعوني بالمغادرة. كتبتُ آخرَ شعار لي على الجدران في 15 أيلول، كتبتُ «الحرّيّة لحماه» و «غداً سيكون أفضل».
عبد الحليم، مقاتل (حمص)
كنت أتخصص في قسم اللّغويّات في الجامعة، وبعدها بدأت خدمتي العسكريّة الإلزامية في 2010. حين بدأت الثّورة كنت أعتقد أنّ النّظام سيدافع عن الشّعب. نحن لا نتابع في الجيش سوى القنوات السّوريّة التّابعة للنّظام، والتي تقوم بالدّعاية له. وحين عُدْتُ إلى حمص رأيتُ الدّمارَ الحاصل للمدينة. انشققتُ عن الجيش، وقدّم أهلي بلاغاً بأنّني مفقودٌ ومخطوفٌ من إرهابيّين. هكذا يضمنون ألّا يتأذّوا بسبب انشقاقي.
انضممتُ إلى الجيش السّوري الحرّ، وعُيِّنْتُ محاسباً للإشراف على الموارد والإمدادات. كبُرتْ مجموعتُنا، وأصبح عددنا نحو 150 شخصاً، وبدأنا نخرج في المعارك. أُصِبْتُ بطلقةٍ في قدمي، وأراد والدايّ أن أذهب للعلاج في تركيا، لكنّني رفضتُ المغادرة. أحببتُ جداً ما كنّا عليه كمجموعة، كنّا كالأخوة تماماً بل أكثر، كنّا كشخص واحد. تلك الذّكريات هي أكثر ما يؤلمني اليوم.
دخل الجيش بعد ذلك إلى حمص، قالوا إنّهم يريدون فقط تفتيشَ المنازل بحثاً عن الإرهابيّين وبعدها سيغادرون، لكنهم بقوا وهكذا بدأ الحصار.
هرب السكّان من المدينة، لكنّنا بقينا. في أوّل شهرين أو ثلاثة تناولنا كلّ ما تركه السكّان من طعام في منازلهم. طبعاً لم تغادر بعض العوائل، لذا كان علينا حمايتهم وحماية أنفسنا. حين اعتدى علينا الجيش قاومنا وهاجمنا في معارك مات فيها كثيرون. كانت تصلنا التّعزيزات والإمدادات والمساعدات عبر خطوط المَجَاري.
في الأشهر الستّة الأولى كان الوضع ما يزال جيداً، بعدها انقطعنا من وقود السّيارات والكهرباء، لذا خُصّصت مولّدة كهرباء لكلّ كتيبة. اعتقدنا أنّ هذا الحال سيبقى لشهر أو اثنين على أبعد تقدير، لكنّنا عشنا في تلك الظروف لمدّة سنتين. اعتنى بنا الأطبّاء في المستشفيات الميدانيّة قدر المستطاع، لكن لم يكن باستطاعتهم تقديم أكثر من ذلك في ظلّ انقطاع الأدوية. لم تكن غرفة العمليّات مؤهَّلة، وهي غير معقّمة. لذا حين كان يصاب أحدهم بطلق في يده كانت تُبْتَرُ على الفور كي لا يسوء حاله أكثر. الأمر ذاته ينطبق على مَن يصاب في رجله أو قدمه أو عينه.
بدأت المجاعةُ، وأصبح النّاس يخرجون لجمع أوراق الشّجر والنّباتات، يسلقونها بالماء ويضيفون إليها البهارات ومكعّبات المرق. كانوا يقومون بأقصى جهدهم لتبدوا الوجبة منوّعة وغنيّة، لكنّها في النّهاية وجبة حشائش. في البداية لم نشعر بنقص العناصر الغذائيّة، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر من الحصار أصبحنا بالكاد نستطيع المشي. بالتدريج نفدتْ أوراق الشجر كلّها، لم نعد نعرف مصدر الماء الذي نشربه، كنّا نشعر أنّه قادم من قرب الجُثث المدفونة في الطين.
في البداية كنّا في الجيش الحرّ عبارة عن مجموعة أصدقاء، لم يكن هناك قادة ومجنّدون. بعدها بدأت الدّولارات تتدفّق في جيوب القادة، قُتِل الجيّدون أو استُبعدِوا، بينما أُعطِيَت الصّلاحيّاتُ ومناصبُ القوّة للفاسدين. كانوا يتمتعون بالتدفئة، ويُخفُون حصصَ الغذاء، بل أيضاً كانوا يتعاونون مع جيش النّظام للحصول على السّجائر. واجهْنا أيضاً مشكلةً مع تصوير الفيديوهات. في البداية، كنّا نصوّر ما نفعله لنوثّق ما عشناه ونحتفظ بذاكرة لنا حوله، لكنّ بعد ذلك صار القادة يصوّرون مقابل المال: كانوا يذهبون إلى الأماكن الفارغة، ويطلقون قذائف الهاون ليصوّروا ويقولوا إنّهم يهاجمون جيش النظام، ثم يرسلون تلك الفيديوهات لقادتهم الخارجيّين في تركيا أو قطر، الذين بدورهم يدفعون لهم المال مقابل عرضها على التلفزيون.
أصبحنا نكره كلمة «قادة» وكلّ ما يمتّ لها بصلة، حتى أنّنا خرجنا مرّة في مظاهرة ضدّهم جميعاً. أرجعتْنا الأموالُ إلى الخلف، وأصبح الأمر كما كان عليه تحت سلطة بشّار أو حتّى أسوأ. كان هدفنا التخلُّص من الفساد، لكن القادة أفسدوا كلّ شيء. كان بيننا عملاء ومخبرون للنّظام أو ربّما لقيادة الجيش الحرّ، لم نعد نعلم مَن معنا ومَن ضدّنا. أصبحتُ أنتظر موتي فقط، كنت أحاول تهدئةَ نفسي وطمأنتها عبر قراءة القرآن والصّلاة، وأكثر ما كان يريحني هو الحديث مع أبي وأمّي عبر سكايب.
قرّر بعض الشباب الاستسلام، ذهب أحدُهم وتحدّث مع جيش النّظام، وتبعه الآخرون. بالنسبة إلينا كانت تلك خيانةً، أن أصافح مَن قتلوا إخوتَنا وأخواتنا. بالإضافة إلى أنّني حين انشققتُ عن الجيش أبلغت عائلتي الجيش أنّني مفقود، وإذا علموا الآن أنّني كنت تحت الحصار مقاتلاً في الجيش الحرّ لمدّة سنتين فسيقضون على عائلتي فوراً.
لغّمت مجموعة من الشباب سيّارةً ليرسلوها إلى الجيش في عمليّة انتحاريّة، لكنّ السيّارة انفجرت في منطقتنا قبل الوصول إليهم. قُتِل كثيرون في تلك العمليّة، منهم أصدقاء لي. ذهبتُ لرؤيتهم للمرّة الأخيرة في المستشفى. في إحدى الزوايا تجمعّت أشلاء خمسة أشخاص لم يستطيعوا التعرُّف عليهم فدفنوهم معاً.
تراكمت علينا المصائب، واشتدّ علينا الخناق. شعرتُ بسوداويّة وإحباط كبيرين. بعدها طُرِحَتْ مبادرةٌ لإخلائنا من حمص القديمة إلى الريف، عارض بعضُ المقاتلين وقالوا إنّهم لم يخسروا كلَّ شيء ليغادروا أرضَهم في النهاية. لكن الأغلبيّة وافقتْ، لأنّ الجميع يريد فقط الخروج من المأساة التي كنّا نعيشها في ظلّ ظروف الحصار المأساوية، حيث كان النّاس بالكاد يستطيعون تحريك أجسادها لقلّةِ الغذاء. وافق قائدُ الكتيبة على المبادرة، وكان على الجميع قبول قراره، حيث كانت الشخصيّات الكبرى فقط تتّخذ القرارات، أمّا نحن فمجرّد بيادق في أيديهم.
جرى الإخلاء في 24 أيار عام 2014 بحضور محافظ حمص والجيش والمصوّرين. كما نُشِر القنّاصون فوق سطوح الأبنية. أذكر صدمتهم حين خرجنا بأجسادنا الهزيلة، كانوا يفكّرون «هل هؤلاء هم الذين كنّا خائفين من الدخول لمهاجمتهم!».
كانت أجسادُنا ضعيفةً، لكنّنا خرجنا بكرامتنا فقد قدّمنا جُلَّ ما استطعنا، عزائي أنّني قدّمتُ شيئاً لله ولعائلتي، قلتُ مع السّلامة لكلّ شيء، ورحلتُ. عشتُ سنتين في تلك المنطقة حتّى أصبحتْ جزءاً منّي كعيني، نظرتُ إلى حمص للمرّة الأخيرة، وفكّرت أنّني لن أراها مجدّداً، وذلك ما حصل فعلاً، رحلتُ ورحلتْ عنّي حمص إلى الأبد.
أبو فراس، مقاتل (ريف إدلب)
لكلّ فعل ردّة فعل في المقابل، حين يقتل النّظام بتلك البشاعة يتحوّل النّاس إلى ما نسمّيهم نحن «جهاديين» وما تسمّونه أنتم «إرهابيّين». أقسم لكِ أنّني لا أحمل تجاهك سوى الاحترام فقط، ولا يهمّني مذهبك أو دينك أو جنسيّتك. لكن حين تُعتَقل أختي وتُغتَصب فلا شيء يمنعني من اقتحام أيِّ مكان في العالم بسيّارة محمّلة بالمتفجرات لألفت انتباههم إليّ، ولا دولة في العالم تكترثُ لمصيبتي أو تقوم بأيّ خطوة لحمايتي أو لأحصل على أبسط حقوقي كإنسان يعيش على هذه الأرض. فضمير العالم ليس نائماً، بل معدوم.
خليل، ضابط منشقّ (دير الزور)
كنت ضابطاً في إحدى فرق الجيش السوري، وتم إرسالي لإخماد المظاهرات في عدد من البلدات المحيطة. قال لنا الضابط إنّنا نقاتل عصابات مسلّحة، وكنت أعلم أنّه كاذب، لكنّها أوامرُ عسكريّة لا تُنَاقش. استخدمنا في أوّل أسبوعين الهراوات وعساكر المخابرات والقنّاصين، لكنّهم أعطونا أوامر بإطلاق النّار على أرجُلِ المتظاهرين، وبقتلِهم في حالِ اقتربوا أكثرَ من مئتي متر.
عندما شاهدتُ مظاهرةً للمرّة الأولى شعرتُ بالنّشوة، كنت سعيداً جدّاً في داخلي، لكنّني أيضاً كنت أشاهدُ بعيني غضبَ الجيش واستياءَه. أذكرُ حين ذهبْنا لاقتحامِ منزلِ شخصٍ متّهمٍ بدعم المظاهرات، ضرب العساكرُ الرَّجُلَ، وحين تدخّلت زوجته لتدافعَ عنه ضربوها أيضاً، وضربوا ابنتَهم الصغيرةَ حتّى اصطدمت بالحائط.
كان قلبي مع النّاس منذ اليوم الأوّل، لكنهم في الجيش يقتلونك حال شعورهم بنيّتك بالانشقاق. كان عليّ أن أضمن سلامة زوجتي وأطفالي قبل انشقاقي، وحالما أمّنتُهم اخترعتُ سيناريو يوحي للجيش أنّني اختُطِفتُ، وبعدها اختفيت. لم يكن واضحاً للجيش إن كنت اختُطفت أو انشققت، لكنّهم بعد فترة اعتقلوا أبي وأخي. ثمّ أفرجوا عن أبي بعد أيّام قليلة، لكنهم أبقوا على أخي لمدّة أطول. بعدها ذهب النّظام إلى منزلي في دمشق، وسرقوا ما استطاعوا سرقته، ثمّ أحرقوه، ثم فعلوا الشيء ذاته بمنزل أهلي في دير الزور.
لم أبكِ على خسارة المنازل، لكنّني بكيتُ لأنّه لم يعد لديّ مكان أرجع إليه. رصدوا مكافأة لكلّ من يزوّدهم بأيّ معلومة عن مكان وجودي، ومكافأة أكبر لمن يقتلني. كنت أتنقّل ليلاً فقط، ثم انضممتُ إلى الجيش الحرّ.
بعدها ظهرت جبهة النُّصرة، وذهبت للتحدّث معهم في حزيران 2012، اعتبرتُهم تهديداً لأمنِنا، كانوا يرفعونَ علمَ القاعدة الأسود، قلت لهم «هذه ثورة شعبيّة، لماذا لا ترفعون علم الثّورة؟»، قالوا «ذلك العلم للكَفَرة، نحن نرفع علم رسول الله». قلتُ: «حسناً الرّسول في قلوبنا جميعاً، لكن هذا العلم سيسبّب لنا العديد من المشاكل، لماذا تقومون بذلك الآن؟». قالوا: «نحن نحارب النّظام من قبل الثّورة بكثير، لكننا كنّا في المعتقل». سألتُهم: «في أيّ معتقل؟»، أجابوا: «سجن صيدنايا، وأُطلِق سراحنا في نيسان». بعدها سألتهم: «ما كانت تهمتُكم؟» قالوا: «أنشطة ضد النّظام». هنا اتّضح لي أنّهم ممّن سمح لهم النّظام بالذّهاب إلى العراق لقتال الأميركان، وحين عادوا اعتقلهم، وأطلق سراحهم الآن ليستخدمهم حجّةً قويّة لجرائمه. قلت لهم: «أطلق بشّار سراحكم ليقول إنّه يحارب الإرهاب»، قالوا «إرادة الله فوق كلّ شيء، وهو الذي أراد أن يتّخذ بشّار هذا القرار».
كنّا نتقدّم في نشاطاتنا كلٌّ على حدة. نقوم – نحن الجيش الحرّ – بمهاجمة موقع للنّظام، فينسحب النّظام، وننتقل لمهاجمة موقع جديد لهم، في حين تأتي خلفنا جبهةُ النّصرة، وتفرض سيطرتها على الموقع الذي حرّرناه. كنّا منشغلين في محاربة النّظام بينما كانوا يحتلّون الأراضي!
معظمُ عناصر الجبهة كانوا مقاتلين أجانب، سعوديين وقطريين وتونسيين. كان الجيش الحرّ يضمّ عدداً أكبر من المقاتلين لكنّنا كنّا نتلقّى دعماً قليلاً فلا نتمكّن من الدّفع للرّجال سوى مرّة واحدة، بينما في جبهة النّصرة كانوا يحصلون على رواتب شهريّة، بالإضافة إلى أسلحةٍ حديثة وعالية الجودة. كانت النّصرة توزّع الخبز على النّاس لتحصد دعمهم، كان الناس يأخذون خبزهم لأنّهم جائعون، لكنّهم يخرجون ضد الجبهة في أوّل فرصة للتظاهر.
بعدها برزت داعش. كان أبو محمّد الجولانيّ قائداً للنّصرة التي تُعدّ فصيلاً من القاعدة، وأنشأ أبو بكر البغداديّ تنظيم داعش، وانتسب إليه بعض عناصر الجبهة. قامت داعش أيضاً بدفع رواتب للمقاتلين في صفوفها، كما وفّرت لهم الأسلحة والذخيرة، واتّخذوا من مدينة الرّقّة مقرّاً رئيسيّاً لهم من دون أيّ قتال مع النظام أو مقاومة، سلّمهم النظامُ المدينةَ وخرج. سجنت داعش المئات من مقاتلي الجيش الحرّ والمدنيين. في إحدى المرّات كنّا ننقل إمدادات الذّخيرة من المجلس العسكريّ الأعلى للجيش الحرّ في تركيا إلى دير الزّور، وكان علينا المرور بالرّقّة. اعتقلت داعش السائقَ، واستولت على الذخيرة. كنّا في أمس الحاجة لتلك الذّخائر. اتّصل بي المقاتلون وقالوا «أخبرْنا إن كنّا سنحصل على ذخيرة أو لا، لأنّنا في حال لم نحصل عليها فمِن الأفضل حينها أن نستسلم لداعش».
رفضنا داعش لأنّنا خرجنا ضد ديكتاتوريّة الأسد، ولن نقبل أن تأتي مكانه دكتاتوريّة أخرى. مَن أعطاهم الحقّ في تكفير الناس؟ قتلت داعش طبيباً ألمانيّاً كان يعمل في مستشفى ميدانيّ، قالوا إنّه كافر. إذا كان هذا الطبيب الذي جاء مِن قارّة أخرى لعلاج المصابين كافراً، فمِن الأفضل لنا أن نصبح جميعاً كفّاراً مثله.
حسين، كاتب مسرحي (حلب)
شنّ الجيش الحرُّ هجوماً على حلب، ودخلت المدينة في طور الثّورة المسلّحة. انقسمت إلى قسمين، مناطق للنّظام ومناطق محرّرة. سيطر الجيش الحرّ على الأحياء الفقيرة التي تشكّل أكثر من نصف المدينة. كان النّاس قلقين حول كيفيّة العيش والنجاة، لذا كان علينا – الثوّار والناشطين – تأمين كلّ ما نستطيع توفيره لهم بوصفنا بديلاً عن النّظام. كان علينا توفير الطعام والسّكن والخدمات لهم، لذا قمنا ببناء نظام، وعليه كان علينا إجراء انتخابات للمجالس المحلّيّة لتمثّل حلب المدينة والمحافظة ككلّ.
تلك الانتخابات كانت الأولى من نوعها في سوريا، وواحدة من أهمّ التجارب في حياتي، أذكر أنّني حاولت المساهمة بكل خبرتي السياسيّة لإنجاح تلك الانتخابات. أردنا أن نبني مؤسّسات حقيقية تساهم في تقدُّم البلد. المنافسة الكبيرة كانت بيننا – الثوّار – وبين جماعة الإخوان المسلمين حيث كانوا منظّمين جداً ويملكون الكثيرَ من المال، بينما نحن لم نملك سوى كلماتنا، كنّا ندور بين الأحياء طول اليوم نشرح للنّاس أهدافنا ومبادئنا، حينها بدوا مهتمّين وراضين، لكن عندما بدأت مساعدات الإغاثة تتدفّق عليهم لم يعودوا مكترثين بنا. الآن لو ذهبت وحدّثتهم عن قيم الثّورة لطردوني فوراً.
في تلك الفترة ترك الكثيرُ من السكّان منازلَهم في حلب، فقامت الكتائبُ المسلّحة ببساطة بالسكن فيها. نحن – النّاشطين – كنّا حريصين على استئذان أصحاب البيوت. سمح لنا رجل حلبي يعمل في السعودية بالسكن في منزله، والذي تحول مع الوقت إلى مركز أنشطة أشبه بخليّة نحل. كان أكثر مِن ثلاثين منا ينامون على الفرشات في الأرض. كنّا نتناوب في أعمال التّنظيف والطبخ، كان أحدنا غنيّاً يشتري لنا الكباب، أمّا الفقراء فكان بمقدورهم طهي البيض فقط.
حين يذهبون جميعاً إلى الصلاة، كنت أبقى منشغلاً بما بين يديّ، لم يحدث أن ضغط عليّ أحدهم للصّلاة معهم. كانوا يعلمون أنّني علمانيّ ويعاملونني باحترام كأيّ شخصٍ كبير في السّنّ ترك عائلته لينضمّ إلى الثورة. كان أحد الناشطين سلفيّاً وملتحياً، وكان يعيش في حيٍّ بعيدٍ يصعب عليه المجيء لأن المشي ليلاً كان خطراً شديداً بسبب انقطاع الكهرباء والظّلام. وقد أخبر الملتحي الجميع بأنّني موكل بالتصويت عنه في حال عدم تمكّنه من حضور الاجتماعات. لم يكن هناك متعصّبون دينياً في تلك الفترة، وأخذ الأمر وقتاً وجهداً كبيراً لجرّ الناس نحو التطرّف. أعتقد أنّ تلك الجهود كانت خارجيّة، وأجزم أنّ الدافع الأكبر كان المال والسلاح.
قمنا بأوّل حركة ضد الإسلاميّين حين قتلوا طفلاً في الرابعة عشرة من عمره. كان الطفل يبيع القهوة والشاي في الشارع، وأراد ثلاثة شباب إسلاميين – مصري وتونسي وسوري – أن يشتروا منه بالدَّيْن، فقال لهم «لو بينزل محمّد ما ببيع بالدين». فعدّوا ذلك كفراً وقتلوه. أطلقْنا على الحركة اسم «كفى»، وبدأنا بتنظيم حملات مدنيّة صغيرة، أسمينا واحدة «لا تكن جزءاً من الفوضى» لتنهى الناس عن قيادة السيّارات بلا لوحاتٍ مرخّصة. وأخرى أسميناها «أريد مدرستي» تطلبُ من الكتائب إعادة المدارس التي احتلّوها وحوّلوها إلى مقرّات عسكريّة لهم.
في تلك الفترة وصلت داعش إلى حلب، وبدأت بخطف الصحفيين والناشطين، منهم أبو مريم أحد قادة المظاهرات. لم يبقَ منّا سوى القليل، لكنّنا نظّمنا اعتصاماً أمام مقرّ داعش الرئيسي في حلب نطالبهم بالإفراج عن أبي مريم. كنّا نشعر بالأمان نسبياً، فحينها لم تكن داعش بالقوّة والنفوذ كما هي اليوم. وعند عودتنا إلى المنزل تبعتنا سيّارة تابعة لهم، وكانت تسدّ الطريق على سيّارة الأجرة التي تقلنا. هكذا أرسلوا إلينا رسالةً أنّ عيونهم علينا.
لذا بدأنا نعمل في السّرّ. انتقلتُ للسَّكن في حيّ آخر يقوده أمير حرب، عُرف عنه أنّه قاتل وحشيّ. لم يسمح لداعش بدخول الحيّ، ووعد أن يحمي جميع مَن هم تحت حمايته وسيطرته. هنا عشتُ في دوّامة، لأنّني لم أرغب أن أتبع أيَّ فصيل مسلّح، لكنّني قبلت حماية مجرم وحشيّ قد يحسبني النّاس من جماعته. عند تلك النقطة أدركتُ أنه لم يعد عندي ما أقدّمه، ولم يعد عندي أيّ سبب للبقاء، وقرّرت الرّحيل عن سوريا.
كنده، ناشطة (السويداء)
أُنشئ الجيشُ الحرّ، وظهرتْ جبهة النّصرة وغيرُها من المجموعات عام 2012. وقع كثير من الأحداث البشعة، بعدها أعلنوا هدنة، لكن لم يلتزم بها أحدٌ طبعاً.
اجتمعنا أنا وأختي مع بعض الصديقات لنرى ما يمكننا فعله، وخرجْنا بفكرة رائعة، وهي أن نرتدي نحن الأربعة فساتين فرح بيضاء. كان مشهداً جميلاً، فساتين عرس وطرحات بيضاء. كانت رسالتنا للطرفين: «أوقفوا القتل».
كان والداي داعمين لنا، ووقفا إلى جانبنا، رغم معارضة الكثير من أقاربنا لنا وقطع علاقتهم معنا، مثل معظم الدروز. بدأنا بصنع الفساتين فاشترينا الأقمشة وماكينة خياطة، وطلبنا المساعدة من إحدى الخيّاطات. قلت لنفسي إذا متُّ مرتديةً ذلك الفستان الأبيض في المظاهرة أكون قد متُّ بكرامتي وعلى أرض سورية. سيعلم العالم أجمع أنّنا لسنا إرهابيّين.
استغرقت التحضيراتُ خمسةً وعشرين يوماً. أقمنا حفلة في الليلة التي سبقت خروجنا في المظاهرة. تزيّنا بالياسمين كما يفعل النّاس في الأعراس في دمشق. جهّزنا لافتات إحداها تقول: «أنا سوريّ ميّة بالميّة»، وأخرى تقول «سوريا للجميع»، ولافتة ثالثة تقول «المجتمع المدنيّ يطالب بإنهاء جميع العمليّات العسكريّة على الأراضي السّوريّة».
في اليوم التالي توجّهنا إلى سوق مدحت باشا. كان علينا تجاوز حواجز ونقاط تفتيش للوصول، لذا ارتدينا عباءات سوداء فوق الفساتين. التقينا أصدقاءنا هناك في السّوق، وكانوا متفرّقين بين الحشود، كانت الخطّة أن ننطلق معاً فور بدءِ المظاهرة. بدأت واحدة منّا بالعدّ: واحد.. اثنان.. ثلاثة، لنخلع العباءات السوداء. ظهرت الفساتين البيضاء، وارتدينا الطّرحات، ورفعنا اللّافتات، وقفنا هناك لمدّة سبع دقائق. صُدِمَ النّاس بنا، أربع عرائس يقفن وسط السّوق، وأوقفناه. كان مشهداً رائعاً، يبقى ذلك اليوم هو الأجمل في حياتي.
بعدها مشينا في السّوق، وترك أصحابُ المحلّاتِ محلّاتهم ليتفرّجوا علينا، الجميع كانوا يصوّروننا بهواتفهم النقالة، لكنهم كانوا صامتين. أردت تحفيزهم فقلت لهم: «لماذا لا تزغردون لعرائس سوريا؟» زغردتُ أنا، وزغردت الحشودُ بعدي، وصفّقوا لنا. أذكر أنّ رجلاً مسنّاً كان يبكي، لم نسمع أيّة شتائم من أحد، على العكس تماماً كان النّاس يقولون لنا «الله يحميكن، أنتنّ بطلات سورية».
اقترب منّا عنصر أمن يحمل مسدساً بيده، وقال لي: «أنزلي اللّافتة دون إحداث أيّة مشكلة» فرفعتها أعلى. أصبحنا أكثر تصميماً وإصراراً، تشعر بأنّك وجهاً لوجه مع جلادك، إمّا أنت أو هو.
استمرّت المظاهرة لنصف ساعة قبل أن تصل فرقة أمنيّة كاملة وتعتقلنا. هدّدونا وشتموا أمّهاتنا وإخواننا. استمرّوا في سؤالنا: «مَن خلفكم؟ لصالح مَن تعملون؟» بعدها أخذونا إلى فرع الأمن. كنّا نسمعهم يتحدّثون عنّا ويقولون: «لماذا تخرج هؤلاء العاهرات القذرات؟ هل تبحثنَ عن أحدٍ لينكحكنّ؟ لما لا نرسلهنّ إلى الجهاديّين؟ عروس لكلِّ مئة جهادي.» كان ذلك تعذيباً نفسيّاً مرعباً، يمتلئ رأسك بالشكوك والأفكار، هل سيقومون بذلك فعلاً؟
أبقونا منتظرات في الممرّ حيث ترى بقع الدم على الحائط وتتساءل: يا ترى لمن هذه الدماء؟ وترى رجالاً مسنّين حفاةً يجلسون القرفصاء على الأرض. فتتساءل: يا ترى كم لبثوا على هذه الحال؟ ترى أيضاً شباباً رؤوسهم مغطّاة يضربهم العناصر كيفما شاؤوا، وشباباً مكبّلين ومعلّقين بالأكبال حتى غُرِس الحديدُ في لحمهم. أذكر ذلك الشاب كان يقول للعنصر «يا أبي أتوسّل إليك.. أقبّل يديك أنزلني إلى الحمّام لثلاثين ثانية فقط» ليردّ عليه «لا.. وإن تبوّلت على نفسك سأجعلك تشرب بولَك».
بعد فترة أخذونا للتحقيق كلّ واحدة على حدة، واستمرّ التحقيق من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة صباحاً في اليوم التالي، بعدها أنزلونا إلى الزنزانة. كنّا نسمع صوت طلقات الإعدامات الميدانيّة كلّ يوم، مرضْنا وأصابَنا القمل. كانت معنا في الزنزانة مريضةُ صرعٍ، وأخرى مريضةُ ربوٍ، وثالثةٌ مصابةٌ بسرطانِ المبيض. كنّا في غرفة صغيرة فيها 25 مرضاً. كانت أختي على حافّة الموت لخمسة عشر يوماً، كنت أضرب الباب وأصرخ فيهم «أنا لست بحاجة، أختي إذا ماتت فستكون ماتت في سبيل سوريا، لكنكم ستحاسبون». خافوا لأنّنا من أقلّيّة دينيّة، وفي اليوم التالي جاء الطبيب، وأُطلِق سراحنا بعد شهرين خلال عمليةِ تبادُلِ مُعتقَلين.
ذهبتُ بعد خروجي إلى سوق مدحت باشا، وسألتُ أحدَ أصحاب المحلّات عن حادثة العرائس، فقال: «نعم أذكرهن، لقد اعتقلوهنّ»، أخبرتُه أنّني واحدة منهنّ، فعانقني وبكى. قال لي «هل تعرفين ما حصل في اليوم التالي هنا؟» أخبرني أنّه كان هناك بائع ألعاب مسنّ في السوق، يعرض ألعابه على عربته، فجاء الأمن في اليوم التالي، وأفرغوا عربته، ووضعوا فيها دمى بفساتين عرائس، أربع عرائس فقط.