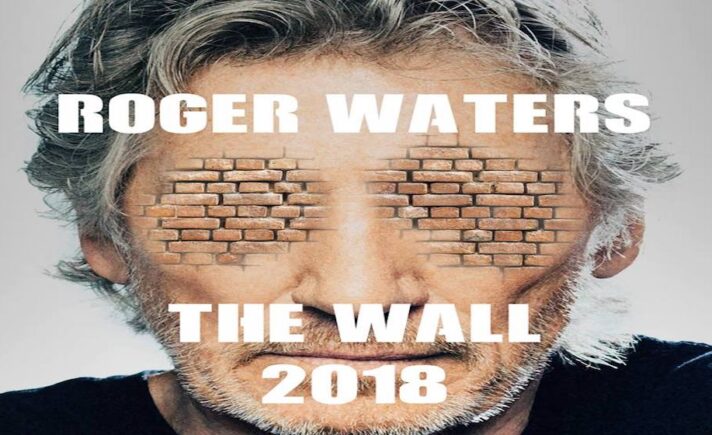«لا بدّ أنّكَ أتيتَ إلى فرنسا للاستفادة من الرعاية الصحيّة المجّانية. أليس كذلك؟». كان هذا التساؤل الأصعب ربّما، والأكثر استفزازاً، مُذ أصبحتُ لاجئاً في الوثائق الرسميّة الفرنسية، قبل حوالي ثلاثة أعوام.
كان وجه فاسيلينا يجمع بين الغباء والجمود وهي تترقّب الإجابة على التساؤل الذي طَرَحَته أثناء العمل. فاسيلينا، التي تبلغ من العمر خمسةً وعشرين عاماً، تهتمّ بالموسيقى والرّسم. تعزف بإتقانٍ على البيانو والغيتار، وتُسجِّل بين الحين والآخر بعض الفيديوهات الغنائية بصوتها.
قبل ذلك بيومين فقط، كانت والدتي قد أرسلتْ لي تسجيلاً مُصوّراً يتجاوز الدقيقة بقليل. أرفقَته بشيءٍ من الغموض: «هل تستطيع التعرّف عليه؟ هذا ما تبقّى منه». كان مُصوِّرُ التسجيل يُمسِك برأسي بدل هاتفه المحمول. يَشدّه بحركاتٍ فجائيّةٍ نحو اليمين تارةً، وأخرى نحو اليسار. يرفعه عالياً ويهوي به دون سابق إنذار. يدور حول نفسه وتدور ذكرياتي معه فأتوقّف عن المُشاهَدة. يتغلّب الفضول، أو شيءٌ لا أعرفه، أخيراً على قسوة الخراب. أُعيد المُشاهدة مرّةَ أخرى، وأخرى بعدها. كانت والدتي ما تزال في الانتظار، في انتظار أن أُرسِل لها شيئاً ما بعيداً عن الغموض ربّما. «هذا بيتُنا، أو ما تبقّى منه على الأقل». كتبتُ ذلك بتردّد، بأصابع مرتعشة. انتظرتُ بدوري ردّاً آخر منها، لكنّها اكتفتْ بما دار بيننا، وفضّلتْ الصّمت حينها. تفحّصتُ التسجيل مُجدّداً. هذه المرّة لديّ الوقت الكافي: الحطام في كلّ مكان، السواد يُغلّف الجدران، النيران شبعت حدّ التّخمة هناك. في أيّة غرفةٍ تسير هذه الخطوات؟ إلى أين يقود هذا الممرّ؟ كان من الصعب في البدء معرفة هذه التفاصيل. تملّكني الشكّ والغضب. هل هذا بيتنا بالفعل؟ هو بذاته. هذه حديقة البيت الداخلية، كان فيها شجرتا ليمونٍ وأربع أشجار برتقال. جميعها كانت مُثمِرة. كان والدي يُراقبها ويقوم على رعايتها باستمرار؛ يسقيها كلّ يوم جمعة، يمدّها بالسّماد مرّةً كلّ عام، يُقلِّمُها بإتقان. على امتداد السُّور الذي يَحدُّها ويرتفع عن سطح التراب قليلاً، تتجاور نباتاتٌ منزليةٌ صغيرة وأنواعٌ مختلفة من الورود. الأحمر والأصفر والزهري والأبيض. ألوانٌ ساحرة تكيّفتْ مع لهيب شمسٍ صحراوية، كما تكيّفنا نحن منذ زمنٍ طويل. كنتُ بعيداً عن الاهتمام بأمور البَستنة، لكن تلك الحديقة الجميلة كانت تبعث الطمأنينة في داخلي. كثيراً ما كنتُ ألجأ إليها وحيداً، أُراقب النجوم وأُدخّن السجائر وسط الظلام. الآن، صرتُ خبيراً في تفاصيل الزراعة وقِطاف الثمار، وفي أسرار البيوت البلاستيكية حتّى، لكن ما الفائدة؟ الموت مرّ من هناك وحوّل حديقتنا الصغيرة إلى صحراء قاحلة.
تدور الكاميرا من جديد. تصبح الحديقة البائسة في الخلف. على اليسار، يوجد المطبخ. في الوسط، هناك غرفة الجلوس. اختارَ المُصوِّرُ، الذي لا أعرفه، النقطة الأقرب إليه على ما يبدو لبدء جولته، غرفة والداي، في أقصى اليمين. لا أبواب ولا نوافذ مُتبقّية. الجدران تبدو متشابهةً بندوبها. في الزاوية البعيدة هناك، كثيراً ما جلستُ وحيداً، مُتمرِّداً. كان ذلك قبل نحو أربعةٍ وعشرين عاماً، كنتُ حينها أخالف أوامر حاكم البيت؛ أتسلّل بهدوء، وأُشعِل التلفاز الصغير. أجلسُ بخِفّة طائر وأُشاهِد حلقةً جديدة من لويس وكلارك: مغامرات سوبر مان (كانت تُعرَض على القناة الأرضية الثانية مساء كلّ ثلاثاء، حسب ما أذكر). كنتُ أكتفي بقراءة الترجمة ومتابعة الأحداث (المُشوِّقة)، أما الصوت، فلا مشكلة بإلغائه خوفاً من افتضاح أمري. كان ذلك يحدث خلال فترة الامتحانات المدرسيّة. يُنقَل التلفاز، ويُمنَع الجميع من متعة مشاهدة القناتين الأرضيّتين، الخيار الوحيد المُتاح آنذاك. بعدها بسنواتٍ عديدة، صرتُ أتسلّل إلى الغرفة ذاتها، لكن بحذرٍ أكبر. أُفتّش في جيوب قمصان والدي. أسرق القليل من النقود وأذهب لشراء السجائر.

تَظهَرُ أقدام المُصوِّر فجأةً. يشقّ طريقَه خلال الممرّ وبين الرُّكام. ينتقي بعنايةٍ موضعَ قدمه وكأنه يسير في حقل ألغام. يختصر ذكريات سنواتٍ مُتراكِمة بخطوة. يجتاز الغرفة وسط البيت سريعاً. لا يعلم ذلك الفضولي أنّنا اجتمعنا هنا للمرّة الأخيرة. تلك المكتبة الممتدّة على اتّساع الجدار كانت تشعر بالدفء حين تداعبها الأيادي. تزدهر جمالاً أمام نظرات العابرين أيضاً. كانت أشبه ما تكون بصندوقٍ أسود يطوي الزمن في صفحاتٍ وصور، بكتْ كثيراً حين سَرَت النيران في عروق خشبها العتيق، استسلمتْ في الآخر لتصبح رماداً تدوسه أقدام المليشيات وصائدي المنازل.
بدا الفضوليُّ حائراً هذه المرّة. توقّف للحظاتٍ وفقدَ بوصلته. صرتُ أناديه: نحو اليسار يا غبي! إلى اليسار! لا أعلم لماذا أصبحتُ حاقداً عليه. تقدّم خطوتين نحو اليمين، عاد بعدها وأدخل الكاميرا عبر نافذةٍ مُنصهرة. آآآه… ما كلّ هذا؟! ليته لم يَعُد أدراجه. ظهرتْ غرفتِي الصغيرة وكأنّها مطليّةٌ بالأسود. حتّى الأرض فيها سوداء كالفحم. السرير المريح أسفل النافذة. صورة البورتريه الكبيرة المرسومة بقلم الرّصاص حين كان عمري عاماً واحداً. مكتب الكمبيوتر بجوار الباب. الخزانة بلونها البنّي الداكن. أمام تلك الخزانة، كان يجلس والدي ويُخرِج ثيابي بهدوء. يُعيد ترتيبها ويبكي فجر كلّ يوم. حين رجعتُ من عالم ما وراء القضبان، أخبرتني والدتي بذلك. أبدتْ دهشتها من بكاء والدي الذي لم يذرف دمعةً واحدةً حين مات والداه. والدي الآن يبلغ واحداً وثمانين عاماً. نازحٌ منذ ثماني سنوات. لم يعد يُطالِب بالعودة إلى المنزل كما اعتاد في سنوات النزوح الأولى. قَهَرَ الزمنُ إرادتَه وأصبح يَعُدّ الأيّام فقط. أرسلتُ لوالدتي: «غرفتي هي الأكثر احتراقاً، هل لاحظتِ ذلك؟». أجابت على الفور: «شاهدتُ ذلك. المهم أنّكم بخير يا ولدي».
منتصف شهر حزيران/يونيو لعام 2012، كان الموعد قد حان لإلقاء نظرةٍ أخيرة وتوديع المنزل الذي عَهِدناه طويلاً. الظلام حالكٌ في الخارج. جدران الغرفة البيضاء وسط المنزل، باتت رماديّة اللون ومسرحاً لوجوهٍ شاحبة تجمّعت حول ضوء مصباحٍ خافت. فَرَضَ الصمت هيبته، وهبط الخوف ثقيلاً. كانت جولةٌ جديدةٌ من القصف غير المسبوق قد انتهت للتوّ. تساقطت القذائف كالمطر على منازل الحي وحاراته العريضة. استقرّت إحداها في سطح منزلٍ في الجوار. تطايرت الشظايا وانطلقت كالسّهام. أصابت الأبواب والنوافذ المُغلَقة وأعمدة الإنارة والسيّارات وخزّانات المياه. صَدَحَت مآذن الجامع القريب بالتكبيرات. ارتعشت الأرض من تحتنا وألقى السقف بحمولته من الغبار. تعالت الصرخات. خرج البعض بعد هدوء العاصفة لمعاينة الأضرار. ساعات الليل بدت طويلةً وكأنّها الدّهر. في انتظار حلول الفجر، حُزِمَت بعض الأمتعة على عجل لرحلةٍ مجهولة. سنعود عمّا قريب. سنعود عمّا قريب، ربّما.
«يبدو أنّكَ كنتَ جُنديّاً في سوريا؟ هل كنتَ مُقاتِلاً في صفوف جماعةٍ إسلاميّة؟ كيف وصلتَ إلى هنا؟ هل صحيح أنّ بعض الإرهابيين فرّوا من سوريا وتسلّلوا إلى أوروبا بين جموع اللاجئين؟ ما الذي يجري هناك في بلدك (سوريا)؟ لماذا اخترتَ القدوم إلى فرنسا؟». أسئلةٌ كثيرة كانت لي بالمرصاد بين الحين والآخر. نظراتٌ ثاقبة تحاول اختراقي وتتفحّصني بعناية. «لاجئٌ من سوريا»، كان لهذه الجملة تأثيرٌ سحري! في دروس تعلّم اللغة الفرنسية، في الدورات التدريبية، في العمل المؤقّت هنا وهناك، في لقاءات التعارف القليلة، كنتُ أحاول الحفاظ على هدوئي والإيحاء بأنني غير مكترثٍ بهذه الأسئلة. الأسئلة التي تُولِّد في داخلي مزيجاً غريباً من السّخرية والانفجار. أُفكّر في إجاباتِ غيري مِن الذين هربوا من جحيم الحرب. كيف سيشرح هؤلاء ويلات ما عاشوه قبل وصولهم إلى «برّ الأمان»؟. كأسماكٍ ألقاها البحر على شاطئٍ صخري، غادروا «بلادهم» التي لفظتهم بين ليلةٍ وضحاها. أصبحوا حاقدين عليها الآن، لكنّ قلوبهم وذاكرتهم بقيت هناك. تتخبّط عقولهم في حلّ هذه المعادلة الصعبة. يفتقدون بساطة العيش واللقاءات العائلية. يستذكرون روائح حاراتهم وشكل منازل جيرانهم. لم يعد هناك حارات؛ دُمِّرَت. والروائح؛ ما تزال نتنة.
بابتسامةٍ عريضة من وراء زجاج مكتبٍ صغير، رحّب بي ذلك الموظّف في المطار. سألني قبل أن يضع ختم دخول الأراضي الفرنسية: «أتيتَ إلى فرنسا للدراسة؟ هل أنتَ طالب؟». كانت الساعة تُشير إلى الثانية بعد منتصف الليل. أجبته بثقة: لا، أنا لاجئ. قبل ذلك بساعاتٍ قليلة، كنتُ أُوقّع أوراق منع دخولي الأراضي التركية. لم أكترث حينها بفترة الحرمان، ولم يخطر في بالي حتّى سؤال ذلك الشرطي متجهّم الوجه. محاولتان فاشلتان في مطار «أتاتورك»، والثالثة كانت ناجحةً في مطار «صبيحة». كانت بحوزتي الوثائق اللازمة لصعود الطائرة بهدوء والالتحاق بموسم الهجرة إلى الشمال، لكنّ كلمة «سوري» على ما يبدو، عكّرت مزاج ذلك الموظّف اللعين. استرسل حينها في طرح الأسئلة وامتلأت نظراته بالتحدّي: كيف دخلتَ إلى تركيا؟ بشكلٍ غير شرعي! أنتَ خارجٌ عن القانون. ولا تمتلكُ بطاقة الحماية المؤقّتة (كيملك)؟ لن تستطيع المغادرة إذن! وجواز السفر هذا مُزوَّر، والفيزا بداخله مُزوّرةٌ أيضاً.

في الثامن من شهر آب/أغسطس لعام 2014، كان كلّ ما يهمّني في ذلك اليوم هو الوصول إلى الحدود التركية. كان سواد تنظيم داعش قد امتدّ سريعاً وأصبح خانقاً لكلّ شيء. نقاط التفتيش وحواجز التنظيم كان لها وقعٌ مُخيف في نفوس المُسافِرين. عند مدخل مدينة الرقّة، فُتِحَ على عجلٍ بابُ الحافلة الصغيرة وتهاطلت الأسئلة كالمطر: مسافرٌ إلى أين؟ ولماذا تغادر أراضي الخلافة؟ هل أتيتَ من مناطق الشعيطات المُرتدّين؟ ولماذا لم تجلب أهلكَ من أراضي الكافرين! عند منطقة تادف بريف حلب الشرقي، فُتِح الباب مرّةً أخرى. كان عنصراً وحيداً هذه المرّة. أمعنتُ النظر فيه وهو يُقلّب البطاقات الشخصية لأشخاصٍ خائفين، هاربين، مُتذمّرين. كان رثَّ الهيئة، سيّء الخلق، ثيابه الأفغانية ذات القطعتين قذرة للغاية، شعره المُجعّد مُتّصلٌ بلحيته المليئة بالأوساخ. أعاد البطاقات بعد أن اكتفى بالنظر إلى صور الأشخاص فيها. لا يُجيد القراءة، لكنه مُتعطّشٌ للدماء كما بدا واضحاً من عُدَّته القتاليّة وحزامه الناسف حول خصره. على جانب الطريق، كانت تتدلّى جثّةٌ من على عارضةٍ خشبيّة. بدا أنها مشنوقةٌ حديثاً. حبلٌ سميك حول رقبة صاحبها، وطيورٌ جارحة تحوم في السماء فوقها. هكذا تحوّلت بلادي إلى عالم «Westworld». «اجمعوا هواتفكم… ومَن يمتلك هاتفين ويعمل على إخفاء أحدهما سأقوم بإعدامه!». حذّرَ ذلك العنصر الجميعَ بلهجةٍ ليبيّةٍ أعادت إلى أذهاننا القذّافي. كنتُ أراقبه حين بدأ بتفحّص هاتفي. بدا تائهاً وهو يُلوِّحُ بإصبعه على الشاشة نحو اليمين ونحو اليسار. رَفع رأسه وتساءل عن صاحب الهاتف. أجبته بالإيجاب بعد أن استبدّ الخوف بي. اندفع نحوي وأشار بالهاتف إليّ: «اِفتح على الصور الخاصّة!». رددتُ وراءه بصورةٍ لا إراديّة وبصيغةٍ استفهاميّة مع القليل من الاستنكار: «الصور الخاصّة؟». زَجرني وعدّل بندقيّته من فوق كتفه الأيمن: «أي.. الصور الخاصّة.. ما تسمع!». هززتُ رأسي ومنحته ما يُريد. أعاد الهاتف بعد أن كحّل عيونه -المُكحّلة أصلاً- برؤية «الصور الخاصّة». أُغلِق الباب وعادت العجلات للدوران. بعد عشرات الأمتار، نَظَر السّائق في المرآة فوق رأسه وأخبرنا بأنّ ذلك الحاجز كان آخر نقاط التنظيم. تنفّس الجميع الصّعداء. كانت عيناه تراقبان وجوه الآخرين وردود أفعالهم. لم يهتمّ أحدٌ بذلك. خرجت بعض الهواتف المُخبّأة، حالها كحال السجائر التي اشتعلت على الفور. سادت أجواء السعادة في الحافلة وامتزجت بالأحاديث العابرة. الطريق نحو الحدود صار نُزهةً الآن.
في مثل هذه الأيّام من العام الفائت، ومع اقتراب أعياد رأس السنة، كنتُ أبحث عن هديّةٍ مُناسبةٍ لصديقي جوناثان. أردتها أن تكون شيئاً يَحمل رائحة عالمنا العربيّ الحزين، أن تتحدّث عن أولئك البؤساء المُحاصَرِين فيه، أن تروي قسوة العيش هناك ومعنى أن تُولَد في تلك المنطقة الملعونة. لم أُفكّر في هديّةٍ تقليديةٍ تجلب السّعادة، ربّما كما جرت العادة في مناسبات كهذه. احترتُ بين فرانكشتاين في بغداد لـ أحمد سعداوي، ومعرض الجثث لـ حسن بلاسم.
اخترتُ في الآخر فرانكشتاين في بغداد على اعتبار أنّها رواية. طلبتُ النسخة الإنكليزية منها وغلّفتها بعناية حين وَصَلَتْ. أسابيع قليلة بعد ذلك، وصلتني رسالة من جوناثان: «I just finished the book. A good story, although a bit depressing». «مُحبِطة بعض الشيء!».. الإحباط، ربّما تكون الكلمة مناسبة لوصف ذلك الشرق الحزين. هل تعلم يا صديقي أننا نادراً ما كُنّا نفرح ونضحك هناك من أعماقنا. الوجوه هناك رماديّة. الشّمس رماديّة. والتراب رماديّ أيضاً. في اللقاءات العائليّة، حين تتعالى أصوات الضحكات، كانت ترتسم على الوجوه في ذات الوقت إشارات التوجّس والخوف ممّا هو قادم. كان آباؤنا يستدركون الأمر بالقول: «الله يكفينا شرّ هالضحك»!
قبل أيّامٍ قليلةٍ من اختياري لـ «فرانكشتاين في بغداد»، كان جوناثان قد أخبرني أنه نال مُؤخّراً الجنسيّة الفرنسيّة، وهو الذي يحمل سابقاً الجنسيتين البريطانية والأميركية. راح يسرد قصّةً مُتخيَّلة. سألني بجديّة: «إذا كنتُ مُسافِراً في طائرة، وظهر فيها إرهابيٌّ فجأةً، هل من الأفضل لي أن أُظهِر جواز السفر البريطاني أم الأميركي أم الفرنسي؟». صمتُّ للحظات. نظرتُ نحوه بتركيزٍ شديد، وانفجرتُ ضاحكاً. ضحكَ هو الآخر، وبدا أنه ينتظر إجابةً ما.
حين أصبحت فاسيلينا على مقربةٍ منّي، كان وجهها بلا تعابير وكأنّه جدار. أجبتُها ببرود: خرجتُ من سوريا بسبب الحرب.