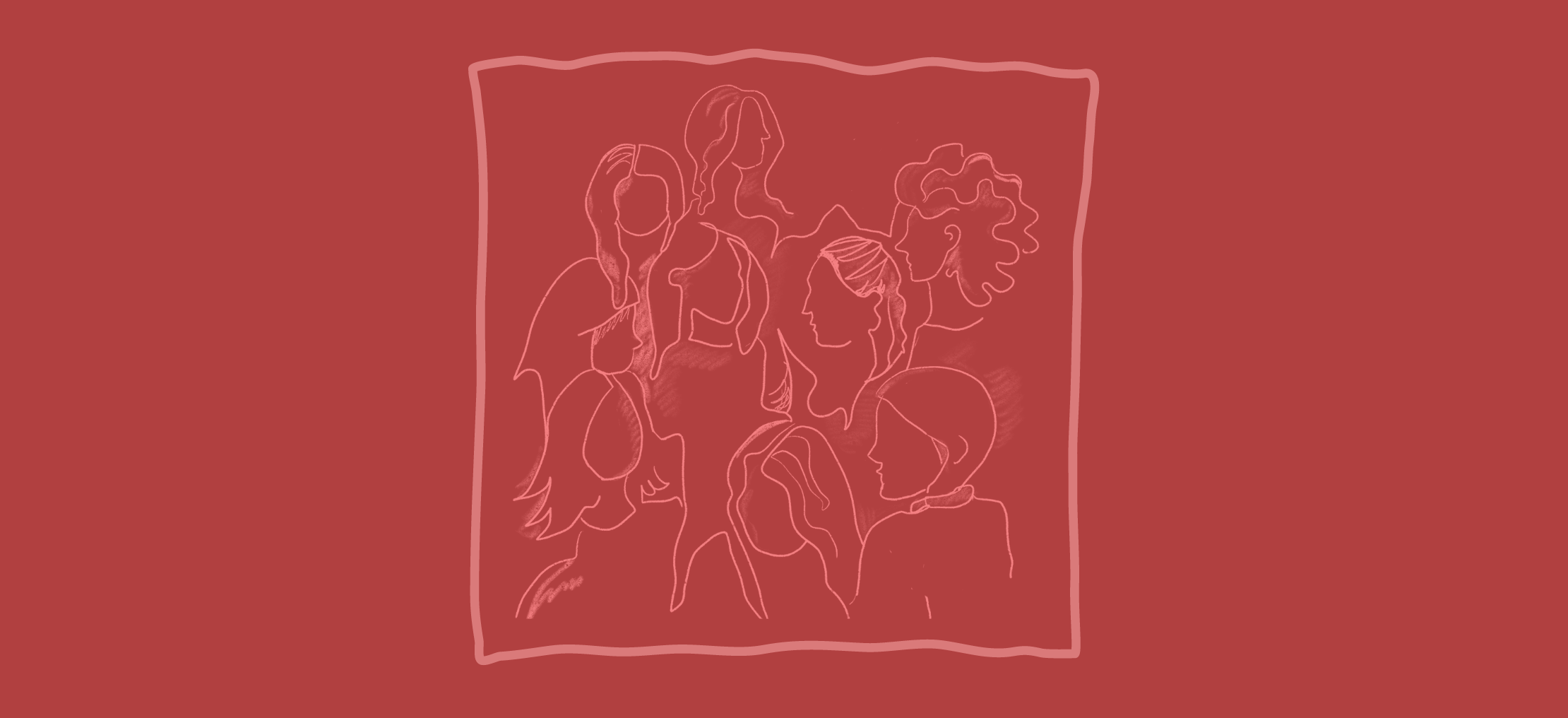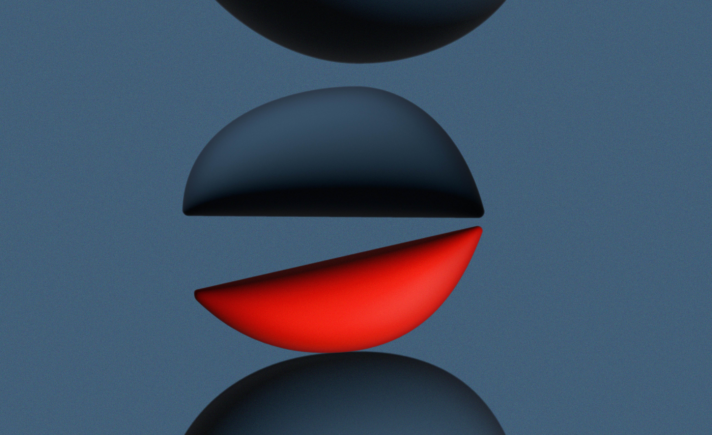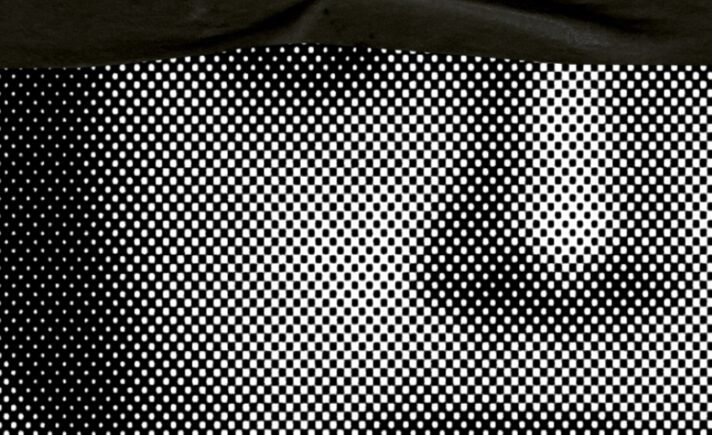يعيش في سوريا اليوم أكثر من 23 مليون نسمة، غالبيتهم العُظمى تحت خطر الفقر وفي مناطق نزاع، مع اضطرار أكثر من 13 مليون سوريّةٍ وسوري للنزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها قسراً، ليصل عدد اللاجئين السوريين في العالم إلى ما يقارب سبعة ملايين لاجئ. يكاد يكون في كل عائلة سورية إما قتيل-ة أو مغيب-ة أو معتقل-ة أو لاجئ-ة كنتيجةٍ مباشرةٍ للعنف السياسي، كما أن كلَّ فرد في سوريا مُعرّض-ة لانتهاك حقوقه-ا السياسية والمدنية والإنسانية من قبل النظام السوري وأطراف النزاع وسلطات الأمر الواقع، وتتعرّض النساء لفرص مضاعفة من هدر حقوقهن ويختبرن طبقاتٍ متعددةً ومتشابكةً من التمييز والضيم.
لا تزال كامل الحقوق السياسية والمدنية للنساء السوريات مسلوبة، ولا يزال المُشرّع السوري ينظر للنساء بوصفهنّ مواطناتٍ ناقصات الأهلية في كثيرٍ من بنود تشريعه. ذلك فضلاً عن السلطة الأبوية التي تتحكم بأدق تفاصيل حياة النساء، في دوائر تبدأ بالأسرة وتتسع لتشمل سلطة المجتمع أو سلطة المحاكم المذهبية والدينية. لهذه الأسباب، يزداد هشاشة وضع السوريات مع كلّ تراجعٍ في الوضع العام للبلاد، ويصبح تحصيل أي حق من حقوقهنّ، مهما صغُر، معركةً مع الفقر والمجتمع ومع القانون ومع القوى العسكرية المهيمنة. وكلّما ازدادت هشاشة النساء ارتفعت احتمالات تعرضهنّ للعنف.
التطبيع مع العنف المستهدِف للنساء
رصدَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حاجة حوالي 8.5 مليون شخص إلى المساعدة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، 93 بالمئة منهم من النساء والفتيات. وتعترضُ النساءَ مجموعةٌ من المعوقات قبل أن يُبلّغنَ عن تعرضهنّ لحالات العنف، وإذا أمكنَ اختصار هذه المعوقات في ثلاث نقاط فهي ستشمل كلاً من: التطبيع المجتمعي مع العنف الذي تتعرّض له النساء، والوصمة الاجتماعية في حال تجرأن على التبليغ عن المُعنِّف وما يترتب على ذلك من إجراءات، والترهيب وتخويف النساء اللواتي يرفضنَ العنف، وهنا يلعب غياب الحماية القانونية للنساء دوراً حاسماً في استمرار حلقة العنف.
ربما تكون حالات العنف المنزلي أشدّ الأمثلة وضوحاً على هذا، فهي تبدأ بالتطبيع مع عنف الزوج ضد زوجته، وخشية النساء من فضح الزوج ومن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المطلقات، أو الخوف من حرمانها من حضانة الأولاد وهو حق لا يكفله المشرع السوري للأم بعد بلوغ الأولاد سنّ الخامسة عشرة. وهنا لا بدّ من ذكر العنف الجنسي داخل إطار الزواج كأحد أكثر أشكال العنف المسكوت عنها، والذي تُرغَمُ النساءُ في حالاتٍ كثيرة على القبول به طالما أنه يحدث في إطار الزواج، إذ يُنظَرُ إليه كجزء من «الواجبات الزوجية». لا يُجرّم القانون السوري الاغتصاب الزوجي، لا بل يستثنيه من قانون العقوبات بحسب المادة 489 منه: « مَن أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل».
وكما في حالة معظم المجتمعات التي تحكمها سلطاتٌ أبوية، تُعتبر «سترة» النساء وسمعتهنّ و«شرفهن» قيماً عُليا، وأيُّ انزياح عنها قد يشكل خطراً وجودياً على حياتهنّ. فقانون العقوبات السوري، في المادة 508 منه، يوقف المُلاحقة والعقوبة عن مُرتكب جريمة الاغتصاب إذا تم عقد «زواج صحيح» بينه وبين المُعتدى عليها. وهنا الرسالة الأهم التي يكشف عنها القانون في هذا الشأن: أن سُترة النساء وسمعة العائلة المرتبطة «بشرف» النساء أهم من حمايتهنّ من العنف، حتى لو اقتضى ذلك أن يتم تزويجهنّ من المغتصب، أو حتى قتلهنّ.
بين عامي 2019 و2022 سجّلت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بالتعاون مع منظمتي مساواة وسارا لمناهضة العنف شمال شرقي سوريا، خلال الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير، ما لا يقلّ عن 185 جريمة قتلٍ راح ضحيتها نساءٌ وفتيات بذريعة «الدفاع عن الشرف». لا تعكس هذه الإحصائيات في الواقع إلا جزءاً ضئيلاً من جرائم قتل النساء التي تُرتكب على امتداد الجغرافيا السورية، والتي لا تُسجّل ولا تتم محاسبة المجرمين على ارتكابها في ظل وجود احتمالاتٍ للإفلات من العقاب بحجة الأعراف التي تجعل من جرائم قتل النساء بذريعة «الشرف» مقبولة اجتماعياً. ومن الجدير بالذكر أن انتشار السلاح والانفلات الأمني في مناطق كثيرة من سوريا هي أسبابٌ مباشرةٌ لازدياد جرائم قتل النساء.
استهداف فرص التعليم كمقدمة لسياسات إفقار النساء
قلّما تلجأ النساء السوريات للقانون بغرض حمايتهنّ من العنف المنزلي وجميع أشكال العنف الجنسي، لا بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته القانونية بما يخص حماية النساء في حالاتٍ كهذه وحسب، بل لنقص الوصول وعدم امتلاك المعرفة بحقوقهن، مما يؤثر على امتلاكهن لأهليتهن الذاتية والتسيّد على أجسادهن. وتزداد فداحة هذه المشكلة في الحالات التي يصل فيها انعدام التعليم مستوياته القصوى مع عدم قدرة النساء على الكتابة والقراءة.
لنلقي نظرةً على نسب تعليم الإناث في شمال غرب سوريا، فبحسب دراسةٍ لوحدة المعلومات في الخوذ البيضاء: بلغت نسبة الأمية 17 بالمئة بين 1,746 امرأة تم إجراء مقابلات معهن، في حين بلغت نسبة النساء المتعلمات 83 بالمئة، حيث حصلت 21 بالمئة فقط من المشاركات على التعليم العالي (جامعة أو معهد)، واقتصرت نسبة الحاصلات على الشهادة الثانوية على 12 بالمئة، والمرحلة الإعدادية على 22 بالمئة، كما أكملت 27 بالمئة من المشاركات المرحلة الابتدائية، وأبدت 43 بالمئة من النساء المُشاركات رغبتهنّ بمتابعة تعليمهن، في حين لم تبدِ 57 بالمئة منهن الرغبة بمتابعة التعليم. يشكل التفاوت في فرص التعليم بين الإناث والذكور واحداً من أكبر عوائق التمكين الاقتصادي للنساء، ومن أصعب الثغرات التي تنعكس على شكل فجواتٍ في الأجور بين الرجال والنساء، والتي تستفيد منها سياسات إفقار النساء. بموجب ذلك تُرغم النساء إما على القبول بأجور متدنية أو البقاء في البيت والقيام بأعمالٍ رعائيةٍ غير مأجورة، مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين في العائلة.
والجدير بالذكر أنه حتى عندما تلجأ النساء لحلولٍ ابتكارية بهدف تحسين أو تأمين الحد الأدنى من مقومات معيشتهن، كما هي الحال مع نساء قاطنات في المخيمات وفي أماكن اللجوء ذات الظرف الصعب، ممن يلجأن لتطبيق تيك توك للحصول على دعمٍ مادي – كما هي الحال مع كثيرين من مقدّمي المحتوى على التطبيق – يكنّ معرضاتٍ للتحوّل بسهولة إلى مادةٍ للتنمر أو الهجوم والتشهير، مع العلم أنّ المنصة الصينية، بحسب تحقيقٍ نُشر على منصة بي بي سي، تستحوذ أصلاً على ما يصل إلى 70 بالمئة من الأرباح التي تحققها لايفات التيك توك السورية من هذا النوع.
تزويج الطفلات: انتهاك مستمر بسندٍ قانوني
لنا أن نتخيل أن الطفلات اللواتي يتم حرمانهن من فرص التعليم سيكون الزواج المبكر بانتظارهن. وعلى الرغم من أن تزويج الطفلات هو انتهاكٌ لحقوق الطفل، إلا أنه كان أمراً مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً حتى قبل الحرب في عدة حالات. كما أن القانون السوري الذي حدد عمر الـ18 كشرطٍ لاكتمال الأهلية، قد شرّع أيضاً إمكانية زواج القاصر في حال «ادّعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج»، ليأذن به القاضي إذا «تبيَّنَ له صدق دعواهما واكتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية»، ولكن «شريطة موافقة الولي». وفي سياق الحروب، مثل التي تعيشها سوريا، تتعدد أسباب تزويج الطفلات، وتأتي الحاجة الاقتصادية في مقدمة هذه الأسباب. ففي حالات الفقر تلجأ العائلات لتزويج الطفلات حتى يتكفل الزوج بمصاريفهن، كما يمكن أن تجد العائلات فرصةً للاستفادة من المُقدّم (المهر) في بعض الحالات. أما الأسباب الاجتماعية المرتبطة بالحروب والنزاع، يمكن أن تعود إلى ظروف مثل وفاة الأب أو الولي، وبالتالي عند تزويج الطفلة تتبع لزوجها وتتخفّف العائلة من عبء مسؤولية حماية الابنة. ووفقاً لمسح المراقبة والتقييم المعياري للمساعدة الإنسانية 2023 الذي أجرته أوتشا في محافظتي حلب وإدلب، فإن واحدةً من كل خمس فتيات مراهقات بين 15 و19 لديها أطفال أو حامل أو مرضعة.
ببعديه الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن فهم تزويج الطفلات إلا على أنه عملية بيع وشراء أشبه بالمفاوضة على سلعة، تتم بالتراضي بين أهل الطفلة والزوج. وهناك من يجادل برغبة المراهقات تحت عمر الـ18 بالزواج، على اعتبار اكتمال بلوغ إحداهن الجنسي، مع العلم أنه حتى مع وجود رغبة واعية بالزواج، فإن اكتمال النمو الجسدي ليس كافياً، فهناك اكتمال النمو العقلي والعاطفي وازدياد الوعي والنضج لديهن مع إتاحة فرص التعليم والاستقلال المادي. فبدون توفّر الحد الأدنى من هذه الشروط، وهي لن تتوفر في طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة، سيكون تزويج الطفلات مقامرةِ بصحتهن الجسدية والنفسية.
ؤ
يظهر تقاطع العنف الاقتصادي مع العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكلٍ ملموسٍ ويومي عندما يتعلق الأمر بتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء، كتوفير وسائل التخطيط للحمل/لمنع الحمل، وتكاليف الفحوص الدورية لسرطانات الثدي والرحم ومتلازمة تكيسات المبايض. كما بدأ ينتشر ما يُعرف بفقر الدورة الشهرية، وهو صعوبة الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية للنساء أثناء الدورة الشهرية من فوط صحية ومسكنات ومياه نظيفة للاغتسال. وسطياً يُقدر سعر علبة الفوط الصحية، التي تحتوي على 7 فوط، إلى 9000 ليرة سورية. ووفقاً للتوصيات الصحية، فمن الأفضل تغيير الفوطة بعد مرور 4 إلى ست ساعات على استعمالها. في حصيلة هذا، إذا استمرت الدورة الشهرية مدة أسبوع، ستتجاوز التكلفة الشهرية أربعين ألف ليرة سورية، أي قرابة ربع راتب موظفة حكومية بحسب معدلات الأجور في سوريا. أما المسكنات التي تحتاجها النساء لتخفيف آلام الدورة الشهرية، فيصل ثمنها إلى 9000 ليرة سورية.
في شمال غرب سوريا، وبعد سنواتٍ من استشراس آلة العنف العسكري التي أدت إلى ازدياد معدلات النزوح وإلى تدهور الأحوال المعيشية وتدمير البنى التحيتة، يُجبر النازحون للعيش في الخيام أو في بيوتٍ تفتقر للتجهيزات الضرورية، بما في ذلك تجهيزات المرافق الصحية والوصول للمياه النظيفة وخصوصية الأفراد، وهو أمرٌ دائماً ما تشتكي منه النساء، لا سيما اللواتي يعيشن في الخيام. وبحسب تقرير هي مَن تدفع أغلى ثمن الذي أعدته منظمات إنسانية فاعلة في شمال غرب سوريا، فهناك 2.3 مليون امرأة وفتاة لا يستطعن الوصول بسهولة للخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
إن حرمان النساء من الوصول الآمن والمستقل لخدمات ومستلزمات الصحة الجنسية والإنجابية، يعرضهنّ لجملةٍ من المخاطر، منها ما يؤثر بشكلٍ مباشر على صحتهنّ الجسدية، ومنها ما يؤثر على صحتهنّ العقلية والنفسية بسبب الأثر الناجم عن الضيق والتوتر الذي تشعر به النساء أثناء بحثهنّ على حلولٍ بديلة تعوّض عن العوز الاقتصادي ونقص المعلومات والخدمات والدعم الطبي. ولا ننسى أن تلاحم العنف الاقتصادي مع الاجتماعي ضد النساء، يجعل حياتهنّ جحيماً في بعض الحالات الخاصة، مثل عندما تنوي المرأة الإجهاض، إذ ستُضطر حينها لخوض معركةٍ مع القانون ومع المجتمع ومع الجهاز الطبي. وحتى تنقذَ نفسها من كل هذه المعارك، غالباً ما تُجرى عمليات الإجهاض سراً، في أماكن مخبوءة وغير معقمة أو مجهّزة بمتطلبات السلامة، وتكون فيها المرأة وحيدةً في لحظاتٍ هي بأشد الحاجة فيها للدعم المادي والمعنوي.
يجرّم قانون العقوبات السوري الإجهاض عن قصد، وتُعاقَب عليه المرأة الحامل بالسجن، وكذلك كلّ من يساعدها في تأمين دواء الإجهاض أو تقديم الإشراف الطبي. لا يَستثني هذا التشريع حالةَ الحمل الناتج عن الاعتداءات الجنسية، إلاّ أن المرأة التي قامت بالإجهاض عن قصدٍ بهدف الحفاظ على «شرفها» تستفيد من عذرٍ مخفف، ويستفيدُ كذلك من «تخفيف العقوبة» مَن أجهض امرأةً للحفاظ على «شرف» إحدى قريباته حتى الدرجة الثانية، حتى وإن قام بذلك رغماً عنها.
يُجبر تجريم الإجهاض النساءَ الحوامل اللواتي لا يرغبنَ بإكمال الحمل على إجراءاتٍ طبية غير رسمية و«غير قانونية» وربما غير آمنة، أو على شراء عقاقير الإجهاض من مصادر أو مراكز غير مرخصّة وبأسعار مرتفعة جداً. كما يعرضهّن ذلك للابتزاز من قبل مُقدّمي الخدمات الطبية، ذلك عدا عن الأثر النفسي الذي تتركه هذه التجربة على صحة النساء، خاصةً عندما يرافقها إحساسٌ بخرق القانون. هذه القوانين لم تحدّ بالطبع من الإجهاض، بل منعت الكثيرات من الوصول إلى إجهاضٍ آمن. وبحسب تصريحاتٍ للطبيب هيثم عباسي أخصائي الجراحة النسائية، نقلتها إذاعة ميلودي إف إم السورية، أكد وجود ازدياد واضح في حالات الإجهاض. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة، إلا أنه يُقدّر النسبة بزيادة نحو 1000 بالمئة، لافتاً إلى أن عمليات الإجهاض التي تتم في الخفاء ازدادت بنفس النسبة أيضاً.
سطوة «لا يمكن مخالفتها»
في شرق سوريا، تعيش آلاف النساء من زوجاتٍ سابقاتٍ وحاليات أو قريباتٍ لمقاتلي تنظيم الدولة، ممن ينحدرن من 60 دولةٍ حول العالم، حياةً مجهولة المصير في مخيم الهول في البادية السورية، ويشاركهنّ هذه الحياة أطفالهن الذين تُقدر أعدادهم بأكثر من 6300 طفلٍ وطفلة. تعيش النساء المسجونات في هذا المخيم ظروفاً إنسانيةً قاسية، متعرضاتٍ للابتزاز والاستغلال للحصول على بعض الحقوق الأساسية، وهن أيضاً عرضةٌ دائمةٌ لاستغلال المهربين ووعودهم بإخراجهن من المخيم، وهي عملياتٌ قد لا تحصل أبداً بعد حصول المهرب على المال، وقد ينتهي معظمها بالفشل في حال المحاولة. ترفض غالبية الدول التي وُلدت فيها هذه النساء ويحملن جنسياتها عودتهنّ وأطفالهن حتى يخضعن لمحاكمةٍ عادلة. وكذلك يقع بعضهنّ ضحية العنف من قبل النساء الأكثر راديكاليةً في المخيم إن حاولن التعبير عن تخليهن عن أفكار التنظيم، ويعامل أطفال أولئك النساء كما لو أنهم قد ارتكبوا جرماً لأنهم وُلدوا لأبٍ أو أمّ من التنظيم، سواء انضمت هذه الأم عن قناعةٍ أو أجبرت على ذلك بالترهيب كما يحصل في معظم الحالات، ففي تنظيم إرهابي مثل داعش تتعزز السطوة الذكورية على النساء بالسطوة الدينية التي «لا يمكن مخالفتها».
وفي شرق سوريا أيضاً، تعمل قوات سوريا الديمقراطية وبعض التنظيمات الراديكالية القريبة منها، مثل الشبيبة الثورية «جوانن شورشكر»، على خطف القاصرات من أهاليهن وتجنيدهن. وكان تقريرٌ أممي صدر في حزيران (يونيو) من العام الفائت قد اتهم قسد بمسؤليتها عن نصف إجمالي عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، في حين قالت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إن قسد والشبيبة الثورية جندتا 23 قاصرة في عام 2023 لوحده. وعادةً ما تأخذ عمليات التجنيد شكل الخطف وحرمان الطفلة وأهلها من الالتقاء.
تتضافر عوامل وأسباب استهداف النساء على اختلاف مستوياتها من عنفٍ مباشرٍ يصل حد الأذية الجسدية والأسْر والتغييب مروراً بأشكال عنفٍ أكثر سلبية تؤثر على حياتها المعيشية وفرص التعليم والتوعية، وتظل هناك المساحة المخفيّة من العنف المُبطن الأقل مرئيةً، الذي تختبره النساء من ذوي المغيبين-ات قسراً، ومن الغائبين-ات عن عائلاتهم-ن من اللاجئين عبر حرمانهنّ من التواصل المباشر مع أفراد عائلاتهن ومن عيش حياة أسرية اعتيادية.