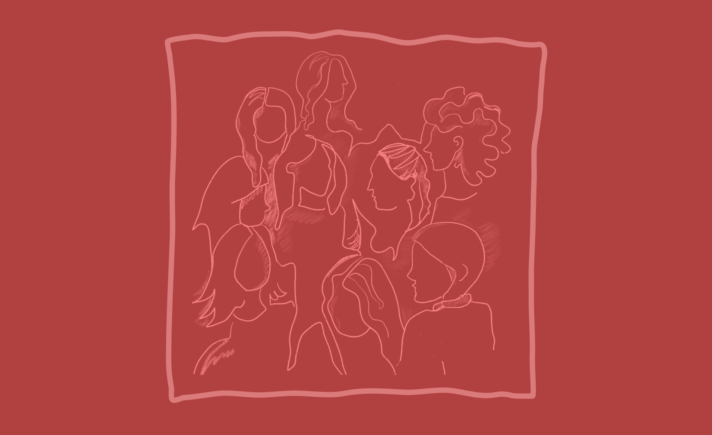يعيش الأطفال السوريون فصولاً متتاليةً من العنف والنزوح في عدة مناطق من البلاد، ويعيقُ نقصُ الوصول إلى الخدمات الأساسية حياتَهم، وتستمرُّ الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم. فقد وصل عدد القتلى من الأطفال إلى أكثر من 30.127 طفلاً منذ انطلاقة الثورة بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ويَذكُر بو فيكتور نيلوند، ممثل يونيسيف في سوريا، أنه «وُلِد حوالي 5 ملايين طفل في سوريا منذ عام 2011، ولم يعرفوا سوى الحرب والنزاع في أجزاء كثيرة من البلاد، وما زالوا يعيشون في خوفٍ من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب».
وفي العام الفائت، تسبّب زلزال السادس من شباط (فبراير) بدمارٍ كبيرٍ لمنازل آلاف العائلات، وتركَ العديد من الأطفال خائفين من العودة لمنازلهم مع استمرار الهزات الارتدادية.
تدفعنا هذه المعطيات إلى الوقوف عند أهم المشاكل التي تواجه أطفال سوريا، من سوء التعليم إلى سوء التغذية والمشاكل النفسية والجسدية التي يتعرضون لها، خصوصاً مع غياب أي أفقٍ واضحٍ لحل الأزمة، بل تفاقمها مع استمرار مقوّماتها.
الواقع التعليمي ومشاكله
لم يكن النظام التعليمي في سوريا قبل العام 2011 مثالياً في ظل سلطة نظام الأسد البعثي، التي كانت تكرّس كل دوائر الدولة بما فيها التعليمية لخدمة إيديولوجيّتها وترسيخ فكرة «القائد للدولة والمجتمع» في مناهجها، ومن خلال المنظمات الطلابية المنبثقة عن حزب البعث؛ كمنظمة الطلائع وشبيبة الثورة اللتين ليستا سوى أدوات لتدجين للأطفال واليافعين، وقولبة عقولهم بما يتناسب مع سياسة الأسد الأب ومن ثم الابن. وفي ذلك يرى الأستاذ في المناهج وأصول التدريس في جامعة باريس السابعة أمين إسكندر أن «النظام التربوي السوري الذي كان قائماً قبل الحرب لم يعمل على التقليل من حدة التناقضات بين مكونات المجتمع السوري، وقد تخرّجت أجيال على مدى عقود لا تؤمن بحرية التعبير، ولا احترام الرأي الآخر، وقد بُني على الرأي الواحد واللون الواحد، وأدى الإهمال داخل النظام التربوي إلى حالة تراكمية من المشاكل والتناقضات ساهمت في حالة الانفجار الذي أصاب المجتمع السوري».
اليوم، وبعد مرور 13 عاماً من الثورة والحرب، باتت غالبية المدارس السورية غير صالحةٍ للاستخدام بسبب تضرّرها أو تدميرها نتيجة القصف الذي طالها. وبحسب تقريرٍ لمنظمة يونيسيف، فإن أكثر من 4 آلاف مدرسة، أي ما يشكل 40 بالمئة تقريباً من المدارس، تعرّضت للضرر أثناء الحرب أو باتت تُستخدم لإيواء النازحين داخل البلاد، ومنها ما تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات المسلحة أو الميليشيات في جميع أنحاء سوريا. وقد زاد عدد المدارس المتضررة جرّاء الزلزال الذي ضرب سوريا بنسبٍ متضاربة، إذ سعى النظام إلى ضمّ المدارس التي تضرّرت نتيجة القصف إلى إحصائياته للمدارس التي ضربها الزلزال، وذلك بغية التغطية على جرائمه وتأمين ترميمها من قبل المنظمات الدولية أو بعض الدول التي فتحت قنواتٍ علنيةً للتواصل معه، وهذا ما سبب ضغطاً هائلاً على المدارس التي لم تتضرر أو التي قامت اليونيسف وبعض المنظمات الدولية بترميمها.
أبرز وجوه هذا الضغط متصل بعدد الطلبة في كلّ مدرسة؛ ففي بعض المدارس يُوضع حوالي 75 طالباً في القاعة الصفية الواحدة، والمقاعد لا تتسع لهم، فيُضطر قسمٌ منهم للجلوس على الأرض. أما في الشتاء، فيمكن تخيُّل الوضع بوجود الشبابيك والأبواب والمقاعد المُحطمة، وغياب الحكومة واعتمادها على المنظمات الدولية لتأهيل المدارس. يمكن أيضاً إضافة عامل الفساد المُستشري في المدارس ومديريات التربية التابعة للنظام في المحافظات التي يسيطر عليها، والذي يمنع بدوره وصول وقود التدفئة للصفوف.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، لم تعد العائلات السورية قادرة على تأمين مستلزمات الدراسة لأولادها من قرطاسية وملابس وحقائب، وحتى الكتب المدرسية التي من المفترض أن تُوزّع على الطلاب مجاناً، فقد قامت الوزارة بتدوير الكتب القديمة لأكثر من عام، ما جعلها مُهترِئةً وغير قابلة للتدوير في معظمها، إذ تتذرّع الوزارة بالعجز المالي عن طباعة ما يكفي من الكتب الجديدة، مع العلم أن هذه الكتب متوفرة في صالات البيع التابعة لوزارة التربية، ما يُضطر الأهالي لشرائها، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً عليهم، فقد يصل سعر النسخة إلى قرابة ربع الراتب الحالي للموظف الحكومي، وهو مكسبٌ مالي للوزارة التي لا تنفك تتشدق في الحديث عن مجانية التعليم على لسان مسؤوليها.
هذا، وغيره، أدى إلى زيادة التسرب من المدارس لعددٍ كبير من الأطفال، والتوجه إلى سوق العمل لتغطية حاجات أسرهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد اتسعت هذه الظاهرة لتصل مستوىً خطيراً، حيث كشف تقريرٌ لليونيسيف أن عدد الأطفال المتسربين من التعليم في عموم سوريا بلغ نحو 2.4 مليون طفل. هذا عدا عن الأطفال الذين لديهم قيود في المدارس وفي الحضور، ولكنهم في الحقيقة متسربون يدفع أهاليهم الرشوة لإدارة المدرسة لتغطية غيابهم وإرسالهم للعمل.
والحال إن التسرُّب من المدارس يعود، إضافةً لما سبق، إلى عوامل عدة منها ارتفاع معدلات الزواج المبكر بين الفتيات، في الداخل السوري وخارجه، وبوجهٍ خاص في مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان وتركيا، وتجنيد الأطفال في الأعمال القتالية على أيدي أطراف الحرب الدائرة في البلاد. ومن أسباب التسرُّب أيضاً عدم توافر الأمان في بعض المناطق، أو عدم توافر وسائل النقل للوصول للمدارس وارتفاع أجورها إن وجدت، والأهم من كل هذا عدم توافر مقومات الحياة الأساسية للتعليم كالكهرباء والتدفئة والإنترنت. يُضاف إلى ذلك انتشار الأمراض والأوبئة مثل الكورونا والملاريا على مستوى البلد بأكمله، فبات عدم إرسال الأطفال إلى المدارس أمراً روتينياً وتغيب عنه الرقابة.
ويسود سوء التعليم نتيجة قلّة الكوادر التعليمية في أغلب المحافظات، عدا الساحلية منها، التي تحوي اليوم فائضاً في الكوادر التعليمية، فنسبة المعلمين والمعلمات في هذه المحافظات مرتفعة وكانت ترفدُ المناطق الشرقية وريف حلب بالمدرسين، ولكنهم عادوا إلى مناطقهم مع بدايات الثورة. ونتيجة هذه القلة في الكوادر، قد تمر عدة أشهر على بدء العام الدراسي حتى يتم تأمين مُدرّسٍ لأحد المواد، وغالباً ما يكون طالباً في الجامعة لم ينهِ اختصاصه بعد، أو حاصلاً على الشهادة الثانوية فقط، وهو ما سبّب ضعفاً في الكفاءة. وإضافةً لتجمّع المدرسين-ات في محافظاتٍ مُحدّدة، جاءت هذه القلّة في الكوادر نتيجة التهجير الذي تعرّض لها أبناء وبنات البلد داخلياً وإلى خارج سوريا. كما يفتقر المعلمون-ات في معظم المناطق السورية إلى الموارد المادية والمالية التي يحتاجونها للتدريس بفاعلية، أو حتى تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم. وساهم عدم الاستقرار المادي هذا في عُزوف الكثير من المعلمين والمعلمات من سكان المدن عن التدريس في الأرياف، فرواتبهم لا تغطي أجور النقل. وساهم من جهةٍ أخرى في تقديم المعلمين لاستقالاتهم والاتجاه نحو الدروس الخصوصية والمعاهد التعليمية الخاصة المرخصة وغير المرخصة، والتي انتشرت بشكلٍ كبير لتحلَّ محلّ المدرسة التي فقدت دورها التعليمي.
علاوةً على ذلك، تزداد صعوبة المناهج مع حالةٍ من التخبّط والتغيُّر في محتواها، وكذلك تغيير نمط الأسئلة الامتحانية دون سابق إنذار ودون مراعاة الترتيب الهرمي في سير العملية التعليمية، ففي هذا العام قامت وزارة التربية بإصدار قرارٍ بأتمتة الأسئلة الامتحانية للثانوية العامة وإلغاء الدورة التكميلية، ما أثار ضجةً واسعةً بين الطلاب والأهالي والكوادر التعليمية على حدٍّ سواء، لأن الطلبة غير معتادين على هذا النمط من الأسئلة، وإن كان لا بدّ من التغيير فمن المنطقي البدء من الصفوف الدنيا نحو العليا، لا أن يُفرض القرار قبل الامتحان بخمسة أشهر. ولكن بعد إجراء امتحان نصفي تجريبي لبعض المواد، كانت نسبة النجاح متدنيةً جداً، ما اضطر الوزارة إلى تأجيل القرار للعام القادم.
هناك أيضاً رسوخ لأساليب التعليم التي تعتمد على التلقين والحفظ بعيداً عن الاستنتاج والجدل، ويترافق ذلك مع انهيارٍ في النظام الامتحاني والرقابة عليه، فتَسرّب الأسئلة الامتحانية وشراء مراكز أو قاعاتٍ امتحانيةٍ من قِبل بعض المدارس الخاصة أو المتنفذين في الدولة، بات أمراً طبيعياً ومتداولاً في العلن بعد كل دورةٍ امتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية.
كما أدى تقاسم النفوذ في المناطق السورية من أطراف محلية ودولية إلى وجود خمسة مناهج تعليمية مختلفة على الأقل، تدرّس تبعاً للقوة المسيطرة على هذه المنطقة أو تلك. وتتفاوت هذه المناهج في ما تقدمه من قيمة علمية ومعلومات أساسية، لكنها تتفق جميعها على تسخير التعليم لتعزيز سطوة الحُكم الميليشيَوي، كما نظام البعث قبل الحرب وبعدها.
من هذه المناهج نذكر المنهج الذي يفرضه النظام، الذي صار يسمح أيضاً بوجود مدارس تُقدّم منهجاً دينياً شيعياً بدأ يتغلغل عبر الحسينيات التي نشرتها إيران على الرقعة الجغرافية التي تقع تحت سيطرة النظام، وخاصةً في دير الزور والميادين والبوكمال وريف حمص الشرقي وريف دمشق، ويتضمَّنُ المنهَج تعبئةً لصالح الثقافة الإيرانية الرسمية وفكرها المذهبي عن ولاية الفقية.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام في الشمال السوري، تم تهميشُ المعايير العلمية والموضوعية في التعليم مع انتشارٍ متزايد للمدارس الدينية. وقد سارعت تركيا بدورها إلى فتح مدارس في مناطق سيطرتها شمالي سوريا لترويج لغتها وثقافتها. أما مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي، فقد فرضت منهجاً دراسياً خاصاً يعتمد اللغات الكردية والعربية والسريانية، لكنه لاقى رفضاً واسعاً، في دير الزور على وجه الخصوص، بدعوى أنه «يتنافى مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد ويدعو إلى أفكارٍ غريبة عن المجتمع». ومع عدم الاعتراف الدولي إلا بالشهادة الصادرة عن حكومة النظام السوري، باتت تلك المناهج لا تؤمّن مستقبلاً للأطفال، وزادت في الجزيرة السورية من الضغط والفوضى في مدارس المربعات الأمنية التابعة للنظام، أو دفعت العائلات لإرسال أبنائها وبناتها للعيش عند أقاربهم حتى يُتابعوا تعليمهم في مناطق سيطرة النظام، ما سبب أزمة تشتت جديدة للأطفال بعيداً عن أهلهم.
كل هذه العوامل مجتمعةً ساهمت بخروج سوريا بشكلٍ كاملٍ من التصنيف العالمي لجودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2021، وهو من أهم التصنيفات المتبعة عالمياً لتقييم المستويات التعليمية في دول العالم.
المخدرات على أبواب المدارس
إن أخطر ما يواجهه الأطفال في سوريا حالياً هو وصول المخدرات إلى أبواب المدارس وإلى داخل الصفوف، فقد ازداد تعاطي المخدرات في سوريا بشكلٍ واضحٍ، بعد أن غدت مركزاً اقليمياً ودولياً لتصنيعها وتهريبها إلى دول الجوار ودول الخليج وأوروبا، تحت إشراف الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لإيران، ما شكّل مصدر دخلٍ مهم للنظام وحاشيته وميليشياته. وقد كشف مدير برنامج اليونسكو لمكافحة المنشطات في سوريا صفوح سباعي عن «انتشارٍ مخيف للمنشطات والكبتاغون والترامادول والعديد من المواد المخدرة الأخرى بين طلاب المدارس والجامعات في مناطق سيطرة النظام، تحت مسمى ‘حب السهر’، وسعر الحبة يتراوح بين 700 إلى 1000 ليرة سورية فقط (0.05 دولار أميركي)، كما يتم الترويج لاستخدام أدوية النهايات العصبية بين الطلاب، والتي تكون بداية طريق الإدمان».
من كل ما سبق، ومن عِلمنا بأهمية التعليم ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الحياة الإيجابية والمساواة والسلام في المجتمع، والتقليل من معدلات الجريمة والعنف المجتمعي، ومن معرفتنا بواقع الحال التعليمي في سوريا من تجربةٍ شخصيةٍ مستمرة حتى اليوم، لا يمكن أن نكون إلا متشائمين حيال مستقبل البلاد الذي يبدو سوداوياً على المدى البعيد.
أطفال سوريا من الجوع نحو المجاعة
الواقع أن هذا الوضع الكارثي الذي وصلت إليه سوريا على جميع المستويات، وخصوصاً المعيشي منها، جعل الأمين العام للأمم المتحدة «يحذّرُ من تفاقم المشكلة بشكلٍ لا يمكن تداركه»، مشيراً إلى أن «90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و60 بالمئة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي». وقد انعكس هذا الواقع على الأطفال بالدرجة الأولى، حيث حذّرت يونيسف من أن «أكثر من 5 مليون طفل في سوريا في خطر متزايد من الإصابة بسوء التغذية». ووفقاً للتقارير الأممية التي استعرضتها يونيسيف، فإن أكثر من 609.900 طفلٍ دون سن الخامسة يعانون من التقزّم الناجم عن نقص التغذية المزمن، والذي يسبب أضراراً بدنية وعقلية لا يمكن التعافي منها، ويؤثر ذلك على قدرتهم على التعلم وعلى إنتاجيتهم في مرحلة البلوغ».
والواقع إن حكومة النظام السوري تخلّت عن مسؤولياتها تجاه الناس، وتركتهم يواجهون مصيرهم في ظل أزمةٍ اقتصاديةٍ غير مسبوقة وارتفاعٍ جنوني في الأسعار ناتجٍ عن فقدان الليرة السورية لقيمتها، وكذلك في ظل الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات ورفع الدعم عن الزراعة ومستلزماتها. وترتّب عن عدم كفاية الدخل أن باتت ملايين العائلات السورية تكافح لتغطية نفقاتها، وهذا ما أثّر سلباً على النظام الغذائي للأطفال والحالة التغذوية لديهم.
لا يحتاج الأمر إلى كثيرٍ من التفكير في حال الأطفال وأمنهم الغذائي في بلدٍ يفتقر أكثر من 12 مليون شخص فيه (نصف السكان تقريباً) إلى إمكانية الوصول المنتظم للغذاء الكافي، ويعتمد غالبيتهم على المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمية (wfp) الذي كان يقدم شهرياً مساعداتٍ غذائية إلى 5.6 مليون شخص في سوريا، ولكنه أعلن في حزيران (يونيو) من العام الماضي عن تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص، مُرجِعاً ذلك إلى أزمة نقصٍ في التمويل. وجاء هذا التخفيض رغم إقرار البرنامج الأممي في بيانه أن الأمن الغذائي للسوريين «أصبح أدنى من أي وقتٍ مضى». وهذا التخفيض لم يطل السوريين داخل البلاد فقط، بل شمل اللاجئين في المخيمات في دول الجوار، على أنّ الصدمة الكبرى تمثّلت بإعلان برنامج الأغذية العالمية عن توقّف مؤقت المساعدات الغذائية في جميع أنحاء سوريا في كانون الثاني (يناير) 2024 بسبب أزمة التمويل أيضاً، ومن ثم معاودة تقديم الدعم وفق خطة توزيعٍ ما زالت مجهولةً حتى الآن، ولكن حجمها أقل بكثير من حجم المساعدات التي كانت تصل خلال الشهور الأخيرة من العام الفائت، وهذا ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على ملايين العائلات وأطفالها، والتي تعتمد على هذه المساعدات الغذائية، ما قد يدفع الوضع السوري من مرحلة الجوع إلى المجاعة، بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة.
الصحة النفسية كشيء مهمل
لم ينجُ طفل في سوريا، وبوجهٍ خاص في المناطق التي شهدت فصولاً داميةً من القصف والمعارك، من رُهاب الحرب وضغطها النفسي في بلدٍ كان لا يزال ناشئاً في مجال الصحة النفسية قبل الحرب. وبإلقاء نظرةٍ على حجم الدمار المادي الناجم عن هذه الحرب، يمكن للمرء أن يبني تصوراً عن حجم الأهوال النفسية التي خلّفتها، فضلاً عن الضغط النفسي الذي خلّفه الزلزال الذي ضرب سوريا لاحقاً ليزيد المأزوم تأزماً. وتشير التقديرات إلى وجود معدلاتٍ مخيفة لانتشار الاضطرابات النفسية في البلاد، وتحديداً لدى الأطفال.
وفق دراسةٍ لمنظمة أنقذوا الطفولة، فإن «التعرُّض اليومي لأحداث صادمة يؤدي إلى ازديادٍ في اضطرابات طويلة المدى في الصحة النفسية، مثل اضطراب الاكتئاب الشديد واضطراب القلق المفرط واضطرابات ما بعد الصدمة. والأطفال الذين يتعرضون لأحداث صادمة غالباً ما يعانون من عدم التوازن العاطفي ومن صعوبة النوم والكوابيس المتكررة ومن فقدان الذاكرة، فضلاً عن صعوبات في التواصل مع الآخرين».
وفي الدراسة نفسها ترى المنظمة «أن سنوات الحرب في سوريا خلّفت آثاراً نفسية عميقة لدى الكثير من الأطفال، وزادت خطر الانتحار وأمراض القلب والسكري والاكتئاب وتعاطي المخدرات على المدى الطويل». وتؤكد المنظمة أيضاً أن «معظم الأطفال السوريين، الذين عانى ثلثاهم من فقدان قريب أو تعرضت مناطقهم للقصف أو أصيبوا، ظهرت عليهم أعراض اضطرابٍ شديدٍ في المشاعر تُعرف بـ’التوتر السام’، وتركُ هذه الحالة دون علاج له تأثيرٌ سلبي على الصحة القلبية والجسدية للأطفال».
والحال إن معظم الدراسات التي جرت عن الصحة النفسية لأطفال سوريا بعد العام 2011 تصبّ في الجانب نفسه لناحية البيئة المحيطة بهم وأنماط حياتهم غير المستقرة، والتي تجعلهم أكثر عرضةً للاضطرابات النفسية؛ كالاكتئاب والعنف والميول الانتحارية وحالات الصرع واضطراباتٍ في النمو والقدرة العقلية. ولكن ما يستلزم الوقوف عنده أن ما ساهم في تأزّم هذه الأوضاع النفسية هو تقصير الجهات المعنية من مؤسساتٍ ومنظماتٍ حكومية ودولية في توفير العلاج النفسي، واقتصار دورها على العلاج الجسدي، ورافق هذا التقصير قلة الوعي بمفهوم الصحة النفسية. وجعل عدم توفر الإمكانات المادية من بعض برامج الدعم النفسية غير كافية وخجولة، واتّسمت بمحدودية العلاج النفسي، ما صعّب الطريق نحو تخطي أولئك الأطفال لهذه الأزمات. زد على ذلك سوء معاملة الأطفال وأشكال العنف التي أصبحوا يتعرضون لها بفعل إفرازات الحرب، والتي تشمل الإساءات الجسدية والعاطفية والاعتداءات الجنسية والإهمال، وكافة أشكال الاستغلال التي تُسبّب الأذى لصحة الطفل وحياته أو تطوره العقلي، وتهدد، على نحوٍ ما، بقاءه على قيد الحياة.
هذا الواقع وغيره ما هو إلا نتيجةٌ متوقعةٌ لحرب تفرّدت عن نظيراتها في عدد النازحين واللاجئين، وفي طبيعة الشرخ الاجتماعي الذي أحدثتهُ، وما خلّفته من مفاهيم انفعالية أدى إلى استساغة العنف لفظاً وممارسة، بالتزامن مع حالة الفلتان الأمني وعدم الاستقرار. إن ما عرضناه ما هو إلا جزءٌ بسيطٌ من الذي حلَّ بهذا البلد، وعلى مستوى الطفولة فقط، والحال إن الصورة كاملةً هي أكثر مراراً وسوداوية.