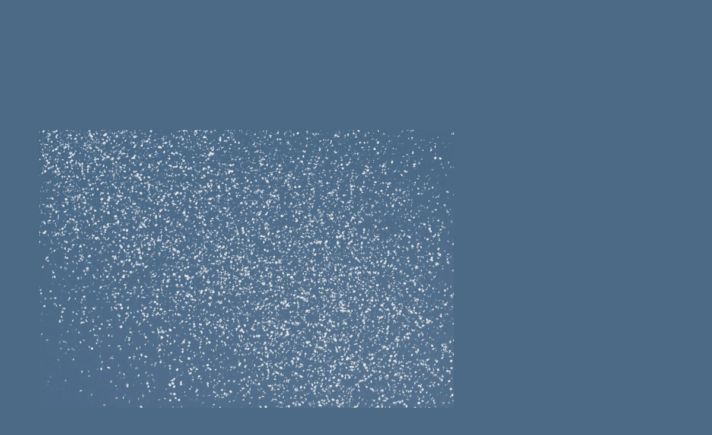للمرة الأولى منذ مئة يومٍ من الحرب، أسمع صوت العصافير صباحاً. كل ما اعتدنا سماعه سابقاً كان أصوات القصف أو الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو صوت الناس في هذا الملجأ الذي يجمعنا سوياً، أو حتى صوت النازحين الآخرين خارج سور المكان الذي نتواجد فيه. ربما لأنني استيقظت باكراً جداً، فالنشاط الإجباري هو سمةُ النزوح. لتبدأ يومك عليك الاستيقاظ مبكراً، فالكثير من المهام أمامك وأبرزها الوصول إلى الحمّام. إن استطعت قضاء حاجتك صباحاً في أقل وقتٍ من الانتظار على طابور الحمام، فأنت محظوظٌ جداً، وعليك ألا تتذمّر من طرْقِ باقي المنتظرين على باب الحمام، فهم بحاجته أيضاً. وعليك أن تنسى أن أجدادنا كانوا يسمونه يوماً ما «بيت الراحة»، فما عاد كذلك، والوصول إليه رحلة قد تستغرق بضع دقائق من المشي وأضعافها من الانتظار على بابه. يحين دورك فتكتم أنفاسك وتغمض عينيك في تلك اللحظات قبل أن تُفاجَأ ومن ثم تعتاد أن لا صابون ولا ماء في المكان، فتفعل كما فعل من سبقك، تترك مَن بعدَك يشقى بما سيجدُ من قذارة. أما عن فكرة الاستحمام، فلا داعٍ لأن تحلم بذلك. لا يذكر أحدنا متى كانت آخر مرةٍ استحم فيها بماءٍ دافئٍ ونظيف.
ثاني أثقل مهمة هي إشعال النار التي أرهقتنا جميعاً. هذه المهارة كانت معدومة، فقد كنا ننعمُ بالغاز الطبيعي في بيوتنا. كلما أشعلنا النار واستنشقتُ الدخان قلت: «كان عندي مطبخ حلو وعلى شباكه زرعت الريحان والأفوكادو». كنازح، لتشرب كوباً من الشاي أو القهوة باهظة الثمن إن وُجدت، أو لصناعة بعض الخبز أو الحصول على الدفء، يتوجب عليك التخطيط والتنفيذ وصناعة فريقٍ يرأسه المسؤول عن الإشعال ومساعده الذي يُبقي النار حيةً من خلال مسؤوليته عن توفير الحطب أو الكرتون أو الأكياس أو حتى أوراق الشجر، هذا إن تبقى شجرٌ في أماكن النزوح، فجميعها جرى قطعها وإشعالها. إن إشعال النار مهارةٌ لا بد منها على امتداد اليوم وظروف الطقس، ومهما حاولت الاستغناء عنها باختيار أكلاتٍ معلّبة، إلا أنك ستُشعلها مُرغماً.

مهمةٌ أخرى تحتاج للاستيقاظ صباحاً، وهي غسيل الملابس. يحتاج الغسيل في يومٍ مشمس نهاراً كاملاً ليجف، والسر هو شمس الظهيرة. لذا يجب غسل الملابس باكراً، وأن تُترك على الحبال تتصافى من الماء إلى أن يحين وقت الظهيرة لتسرّع من جفافها. وإن كنت محظوظاً وتتقن فن عصر الملابس وملابسك من الصوف أو مكررات البلاستيك، فإنها ستجفّ مع نهاية اليوم. أما إن كانت قطنيةً، فستحتاج ليومين، وكلما اختبرتَ درجة جفافها ستشعر أنها ما زالت مبللة! وعندما تجف ستكتشف أنها ما زالت متسخةً رغم كل جهودك في الفرّك والنقع والعصر.
يتشارك الجميع في هذه التجربة المريرة للنزوح، وأعني ذلك تماماً حين أقول الجميع. عُدنا إلى المرحلة الأولى من التطور الإنساني قبل صناعة الآلات ودخولها إلى المنازل، وقبل أن يحدّد المجتمع أدواراً اجتماعية يغلّفها بالممنوع والعيب. يمارس الجميع، بغضّ النظر عن جنسهم، أدواراً بعضها كان عيباً على نوعه الاجتماعي، ولكنّ كثيراً من النمطية تلاشت وأصبح من الطبيعي أن يعجن ويخبز الرجال، بينما تدقّ النساء أخشاب الخيمة أو تبيع على بسطةٍ مرتديةً بيجاما، فهي كل ما تملكه. الأمر يعتمد على مَن يمتلك المهارة المطلوبة فقط، ولا معايير أخرى.

المهام موزعةٌ على جميع أفراد الأسرة، حتى الصغار وكبار السن لهم مهامٌ أقل صعوبة مثل الانتظار في الطوابير للصغار؛ طابور تعبئة المياه أو الحصول على طعامٍ مطبوخ توزّعه هيئاتٌ إغاثية، أو تنظيف ما حول الخيمة من قمامة، أو جمع الكرتون والبلاستيك من الشارع لإيقاد النار وغيرها. أما مهام الكبار الأقل عافيةً، فيمكنهم المشاركة في إشعال النار، والذهاب للتسوق أحياناً، والتسجيل في نقاط توزيع المساعدات ومتابعة الأمر لأنه يحتاج وقتاً محروقاً، والمساهمة في شراء وغسل وتنظيف بعض مكونات الطعام إن وُجدت، والمشاركة في ترتيب الخيمة أو الغرفة أو مكان النزوح أياً كان.
الجانب الأكبر من العبء والمسؤولية يقعُ على عاتق الشباب في كلّ أسرة، وخاصةً إن كانوا أزواجاً شابة، فهم يساهمون بشكلٍ أساسي في كل المهام، ويتابعونها وينظمون الأدوار وهم مسؤولون عن الجميع. يراقبون تواجد جميع الأطفال أيضاً، فمن المصيبة أن يضيع طفلٌ بين الخيام، والذي لن يعرف طريق العودة سوى من خلال المناداة باسمه وسط المخيم عبر مكبرات صوت، أو الإمساك به والتجول بين الخيام: «هذا ابنكم/ بنتكم؟». يراقب الشباب صحة كبار السن واحتياجاتهم، ويطهون الطعام ويحرصون على تدفئة الجميع خوفاً من المرض، ويتأكدون من عدم تسرب المطر إلى الخيمة، إذ يفحصون دائماً النايلون الذي صُنعت منه الخيام، والذي كلّفهم شراؤه ثروةً بعد تضاعف سعره.
أمرٌ آخرٌ مهم يمارسه الشباب والشابات هنا، وهو جلب المال؛ تحصيله بأي طريقةٍ كانت. أشاهد أناساً يبيعون مخصصاتهم الغذائية وطرود الإغاثة التي يحصلون عليها، وأحياناً الخيام. يجوعون ليحصلوا على المال اللازم لتغطية احتياجٍ آخر، وأشاهد شباباً وأطفالاً يبيعون الخبز المنزلي والمعجنات التي حضَّرتها النساء في طرقات المخيم، وبعض الحلوى التي لا تحتاج لمقوماتٍ كثيرة ويمكن صنعها على نار الحطب؛ مثل المهلبية والفستقية والعوامة والحلب وغيرها. بعضهم صنع أفراناً من الطين ليخبز للنازحين مقابل المال، وبعضهم يشحن الهواتف المحمولة عبر بطارياتٍ موصولةٍ بألواحٍ شمسيةٍ محمولةٍ أيضاً. بعضهم لديه عربةٌ وحمارٌ صاروا مصدر رزقٍ مهم عبر نقل الناس أو الخضار والطرود والطحين وغيرها، أو سيارة ملّاكي يشغّلها صاحبها لتوصيل الناس مقابل المال. أشاهد شاحناتٍ كبيرةً كانت لنقل الخضار واللحوم والمواشي وصارت تُستخدم لنقل الناس. يقف العشرات في هذه الشاحنات ويدفعون المال للسائق. انتشرت أيضاً بعض بسطات القهوة والشاي، وهي تُغلى على الحطب، وسعيد الحظ من استطاع توفير جرة غازٍ لفعل ذلك.

مليون و800 ألف نازحٍ ونازحة يحاولون ابتكار طريقتهم للحصول على المال، فالاحتياجات ليست فقط في الطعام المُعلب والماء اللّذين يوزعان بكمياتٍ قليلة جداً، فهناك احتياجٌ للخضار والطحين والملابس والأدوية والاحتياجات الصحية للأطفال والنساء وغيرها، والأسعار تفوق الخيال، فبعض السلع تضاعف ثمنها من سبع إلى تسع مرات، وهذا أمرٌ لا تقوى عليه جيبةُ نازحٍ كان يعمل قبل الحرب في مهنٍ أجرها يومي وليس لديه مدخرات، فبطبيعة الحال كان الفقر شديداً قبل اندلاع الحرب، فكيف وهي مستمرة!أما عن نهاية يوم النازح المُتخَم بالمهام، فتبدأ مساءً مع بدء حلول العتمة وازدياد خطر التحرك، ومع آخر حطبةٍ يشعلها في موقده. تجتمع الأسرة في مكانها، ويستذكرون البيت ويَبكون كما أفعل أنا كل ليلة؛ أبكي البيت ويشتعل قلبي حسرةً. يستذكرون الأحبة من الشهداء، ويلعنون هذه الحرب قبل أن يناموا على فراشٍ متّسخٍ بالرمال التي تحاصرهم في المخيم، وعلى ضجيج سؤال: «هل سنعود؟». يومٌ قد يبدأ صدفةً بصوت العصافير، لكنه ينتهي حتماً بآهاتٍ ودموع، هذا إن لم توقظنا أصوات القصف والطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من مرةٍ خلال الليل ومع كل صباح. ننامُ على أمل أن تنتهي الحرب التي طالت وانتهكت كرامتنا وآدميّتنا، قبل أن نستيقظ في اليوم التالي بحثاً عن حمّاماتٍ قد يكون أقربها على بعد عشر دقائق من المشي. نلعن في كل خطوةٍ واقع نزوحنا، ومن ثم نعود لممارسة المهام ذاتها السابق ذكرها وزيادةً عليها، وهذا بدافع البقاء والنجاة إلى حين تنتهي الحرب… إلى حين عودتنا.