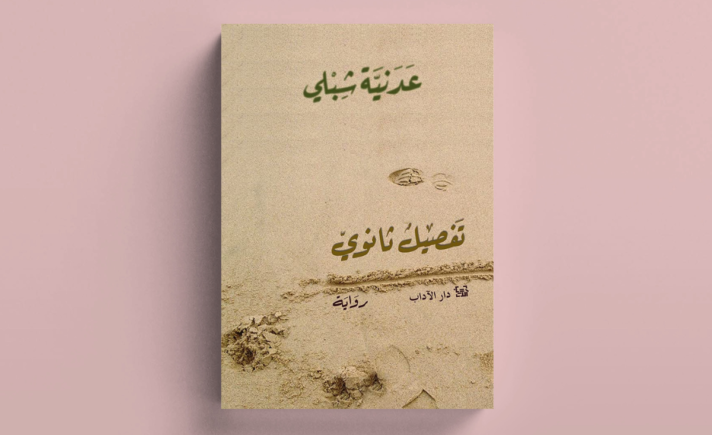قبل خمسين عاماً أقرّت المحكمة العليا الأميركية قانوناً يسري في جميع ولاياتها، ويقضي بحق المرأة في الإجهاض متى أرادت ودون مساءلة. وفي حزيران (يونيو) 2022 تراجعت المحكمةُ نفسها عن قرارها، وأحالته إلى السلطات المعنيّة في كل ولاية على حدة في أن تقرّ بحق المرأة في إجهاض جنينها، أو تحظر عنها هذا الحقّ. استلابُ هذا القرار من المرأة، وتسليمه إلى أهواء السلطة السياسية أو الدينية، يعني إيذاءها في أحد حقوقها الإنسانية، ويعني رفع الحماية القانونية عنها وتعريضها لأخطار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية. هذا مجرّد مثالٍ عن خطوةٍ أقلّ ما يمكن وصفها بأنها خطوةٌ إلى الوراء، وللمفارقة أنها حدثت في الولايات المتحدة الأميركية، أولى بلاد العالم الأول، التي تفخر أول ما تفخر بأنها موطن الحقوق وموطن الحلم؛ فما بالنا بواقع الحال في بلدان العالم الثالث، حيث لا تزال الحقوق الإنجابية مجرد أحلام؟
بدايات الاهتمام بالحقوق الإنجابية
منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تصاعد الاهتمام بصحة المرأة، الإنجابية على وجه الخصوص. صيغت لها خطط متكاملة تتضمّن توعية النساء وتقديم الرعاية الشاملة للحامل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، ونشر ثقافة تنظيم الأسرة كترشيدٍ للإنجاب، وتجنب الحمل غير المرغوب فيه.
لكنّ هذه الخدمات لم تتوفر في جميع البلدان النامية، ووصلت منقوصةً إلى بعضها ولم تشمل جميع شرائح النساء ولم تُشرك الرجال في برامجها، إضافة إلى المعضلات التنموية بعمومها وخصوصيتها في كل بلد، من الأمية إلى الفقر إلى تدني مستوى التعليم والبطالة، إلى آخر القائمة.
وحتى نهايات القرن العشرين، ومع توالي منجزات العلم، والطب على وجه الخصوص، والتغيُّر الهائل في حاجات الأفراد والمجتمعات، إضافةً إلى بقاء كثيرٍ من القضايا التنمويّة عالقة، وظهور قضايا وفئاتٍ مجتمعية جديدة؛ تفاقمت الحاجة إلى قوانين تنظم هذه القضايا مجتمعة، وتحمي الأفراد من الاستغلال المعنويّ والماديّ ومن سوء الخدمة.
تصدّرت هذه القضايا طاولةَ المؤتمر الدوليّ للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994. وكان سبقه مؤتمران شبيهان، الأول في بوخارست عام 1974، والثاني في مكسيكو سيتي عام 1984، إنما يُحسَب لمؤتمر القاهرة أنه كان الأول من نوعه، من بين الأنظمة التنموية الدولية، الذي كسر تابو «الحقوق الإنجابية» وسط معارضةٍ شديدةٍ من التيارات الدينية على اختلافها. توافق القادة الدوليون في مؤتمر القاهرة على تغيير وجهة محور التنمية العالمية: فإن كانت الجهود قد تركّزتْ من قبل باتجاه السيطرة على تفاقم النمو السكانيّ، فسوف تتركّز حالياً على حق الفرد في تخطيط أسرته، في اختيار ما يتعلق بصحة جسده وحقوقه الإنجابية كتعزيزٍ لحقوق الإنسان، وتكريس مساواة النوع الاجتماعي، والتصدي للعنف ضد النساء، والمساواة الكاملة في التعليم بين الإناث والذكور، وأولوية القضاء على الفقر، وتحقيق الاستقرار في النمو السكاني. والأهم في نواتج هذا المؤتمر أنه خصّص ميزانيةً سنوية لبرامج السكان والصحة الإنجابية في البلدان النامية.
وفي العام نفسه، وبعد سنواتٍ من النشاط غير الرسميّ، أعلنت مجموعةٌ من النساء الملوّنات عن نفسها باسم سيستر سونغ (sister Song)، كحركةٍ معارضة لمطالب التيار الرئيسيّ المدافع عن حقوق المرأة في أميركا.
موضوعُ الإجهاض كان نقطة الخلاف في الظاهر، فقد طالبت النساءُ البيض بقانونٍ يُجيز حقّ الإجهاض في جميع الولايات، وكان لحركة سيستر سونغ مطالب أبعد أفقاً، وانضمّت إليهن مجموعاتٌ من النساء البيض، وبعض الرجال، وأطيافٌ من ذوي الهويات الجندرية غير النمطية.
تركّزَ احتجاج حركة سيستر سونغ على أنّ تيّار حقوق المرأة يُركّز اهتمامه على صحة المرأة الأميركية البيضاء وحدها، ولا يقارب القضايا الإنجابية الملحّة للنساء ملونات البشرة، وكذلك يستثني الشرائح المستضعَفة من قائمة أولوياته، كالمهاجرين-ات، وذوي الدخل المنخفض، ومرضى الإيدز، والمشتغلين-ات بالجنس، وذوي الهويات الجندرية غير النمطية، وذوي وذوات الإعاقة، ولا يلتفت إلى ما يلحق بهذه الشرائح من إهمال واضطهاد ممنهج. على سبيل المثال لا الحصر، حقّ الإجهاض الذي تطالب به النساء البيض هو ذاته الذي تعاني النساء الملونات من فرضه عليهن بالتهديد، كما أنهنّ يعانين من صعوبة الوصول إلى الإجهاض الآمن حتى في الأماكن المسموح فيها قانوناً، وتتعرض كثيراتٌ منهن إلى التعقيم القسريّ والترويج القسري لحبوب منع الحمل، وتُختبَر العمليات أو التجارب على أجساد بعضهن قسراً لتدعيم الاكتشافات العلمية، ويرتفع بينهن معدل وفيات الأمهات بسبب صعوبة الوصول إلى خيارات الولادة الآمنة، ومياه الشرب في بيوتهن ملوّثة، والشرطة تعاملهنّ بوحشية، ودوائر الهجرة تتحيّز ضد عائلاتهن وتفصل الأطفال عن أهاليهم وما إلى ذلك.
في مطالبها، مزجت حركة سيستر سونغ ما بين «الحقوق الإنجابية» و«العدالة الاجتماعية»، وتقدّمت بها لا كمجرد مطالب، بل كقضية؛ أنها حق الإنسان في الحفاظ على استقلاله الجسدي الشخصي، وألا يُكتفى بتشريع هذا الحق، بل بتفعيله على الأرض لإحقاق العدالة.
وفي العام التالي، 1995، أطلق مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع للمرأة في بكين إعلان بيغين، القاضي بالدعم الكامل لجميع النساء، وتحميل الدول مسؤولية ضمان حقوق النساء ومن بينها الحق في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
أثمر مجموع هذا الحراك في صياغة مفهوم العدالة الإنجابية على أنها «حقّ النساء في الحفاظ على استقلالهن الجسدي، وفي قرار الإنجاب أو عدم الإنجاب، أو الإجهاض، أو متى يتم إنجاب الأطفال، والحق بتربية أطفالهن داخل مجتمعات آمنة، بما يضمن لهن الصحّة والحميمية والأمن المالي والسلامة المنظّمة والمستدامة، وتضمين هذا الحق في الإطار الدولي لحقوق الإنسان، غير القابلة للتصرف».
تُقارِب العدالة الإنجابية حق النساء في خيارات الإنجاب أو عدم الإنجاب، أو الإجهاض من خلال الاعتراف أولاً بحقيقة أن المرأة لا تستطيع ممارسة حقوقها الإنجابية ما لم تنل حقوقها الإنسانية الأخرى، وأولها الكرامة الشخصية. والكرامة هي حق الفرد في أن تكون له قيمة وأن يُحتَرم لذاته وأن يعامَل بطريقة أخلاقية لا تحطّ من قدْره. كل انتقاصٍ من كرامة الإنسان يؤذيه في إنسانيته كما تؤذي الجراحُ الجسد. ومفهوم الكرامة يتضمن حكماً الاعترافَ بكرامة الآخرين، وعدم استغلال أحدٍ ما لنقاط قوته في إيذاء الآخر الضعيف (التنمر)، فلا كرامة حقيقية لا تشمل الجميع. ولا تتحقق كرامة المرأة إلا بتمكينها الاقتصاديّ كأساسٍ لاستقلاليتها.
في سياقها التاريخيّ، تمّت إعادة إنتاج الدولة والأنظمة والعائلة والفرد بالسيطرة على الأجساد عبر إعادة الإنتاج الإنجابي، (أي إعادة إنتاج القوى العاملة، إنتاج المواطن الصالح للعمل)، من خلال الوظيفة الأهم، أي الوظيفة التناسلية والإنجابية. وهذا يعني أنّ فكرة التخطيط للأسرة أو تربية الأولاد أو تأمين خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية، تصبّ جميعها في كدح الإنسان أيّاً كان جنسه ووظيفته في إعادة الإنتاج الإنجابي وغير الإنجابي، ومن الطبيعيّ أن تتحمّل المرأة، بسبب امتلاكها للرحم، الكلفة الأكبر منه.
لكنّ العدالة الإنجابية لا تقتصر على النساء وحدهن كما قد يبدو من ظاهر التعريف، ولا على الصحة والحقوق الإنجابية وحدها للمرأة والرجل على السواء، بل هي حاجةٌ مجتمعيّةٌ وإنسانيّةٌ عابرة للدول، تشتبك فيها القضايا العالقة منذ أواخر القرن العشرين، بدءاً من العدالة الاجتماعية، إلى العدالة البيئية، إلى واقع المواطنة والهجرة والحدود، ومآسي اللجوء، ومعاناة الأطياف التي ترغب بتقديم نفسها بهويةٍ جندريةٍ غير نمطيّة، وذوي المهن المذمومة وذوي الإعاقة، وصولاً إلى الاضطهاد الإنجابي الذي تواجهه المجتمعات والمجموعات والأفراد، فالبلدان التي لا تكفل لنسائها حق إعطاء الجنسية لأبنائهن أو حق الحضانة هي ذاتها التي لا تشرّع حق الإجهاض ولا تشرّع الزواج المدنيّ، ولا تمنح الأوراق الثبوتية لذوي الهويات الجندرية غير النمطية، وهي التي تمنع اللاجئين-ات من العمل ومن حق الوصول إلى الرعاية الطبية وغيرها. وهي المنظومة التي تقدّم خدماتٍ صحيةٍ وإنجابية نخبوية، وتُفقِر المجموعات المستضعفة، وتُعرّضها لاعتداءاتٍ يومية على أجسادها واستقلاليتها الإنجابية وقدرتها الذاتية على التصرّف، أي تُسهِم في إمراضها وإمراض عائلاتها. هذه القضايا مترابطةٌ في بناها التحتية، وهي غير قابلة للتجزئة، وكذلك غير قابلةٍ للحلّ ما لم يتفكّك الظلم من جذوره.
وجوهٌ شتّى للتمييز
كثيرةٌ هي الأمثلة الواقعية التي توضِّح الصورة، وتُظهِر التمييز الذي يقع على فئةٍ ما فقط بسبب العرق أو الجنس أو الطبقة الاقتصادية والاجتماعية أو الجغرافيا التي تنتمي إليها، وبشكل خاص النساء والعابرات وحقوقهن الإنجابية والصحية:
* العنف الجنسـي والعنف القائم على اختلاف النوع الاجتماعي يصنع عدم المساواة بين الجنسين، ويُقصي النساء والفتيات من جميع مناحي التنمية، ويبقيهن تابعات.
* الفقر والعشوائيات والبيوت الرطبة بلا شمس والعيش قرب المزابل وفي المقابر وعدم الأمان والقلق وسوء التغذية جميعها عوامل مرتبطة بالإجهاض التلقائي، والولادة المبكرة، والعقم، والعيوب الخلقية في الأجنّة.
* يضع السياسيون اللوم في الزيادة السكانية والمشاكل البيئية الناجمة عنها على النساء الفقيرات والمهاجرات واللاجئات، المهمّشات بطبيعة الحال، وكأنما لا حقّ لهن بحمل آمن وتربية أطفالهن في بيئة صحّية أسوةً بباقي النساء. بينما قد تكمن الأسباب في سوء الإدارة الحكومي والصناعي الذي يُخلّف الضرر على مصادر المياه والتربة، وكذلك على الغذاء.
* لا ينظر المجتمع إلى الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس على أنها مرضٌ كباقي الأمراض، بل بصفتها وصمة (ستيغما)، وعقاباً على سلوك متهوّر وغير أخلاقي. والخوف من هذه الوصمة أو من التعرّض لمعاملةٍ سلبيةٍ من قبل الشريك الحميم، أو الأصدقاء أو الأسرة أو مقدّمي الرعاية الصحّية، يعيق رعاية هؤلاء المرضى لأجسادهم.
* تنميط الصورة عن النساء الفقيرات والمهاجرات واللاجئات أنّهن جاهلات، مهملات، بليدات، يمارسن الجنس أمام أولادهن في الخيمة الوحيدة التي تعيش فيها أسرُهن الكبيرة، ولا يعرفن كيف يستخدمن وسائل منع الحمل، وينجبن الأطفال ليزدن عدد الفقراء ويهدّدن أمن وموارد بلدهن أو البلد الذي لجأن إليه. وتسمع المرأة هذا الخطاب وتخشاه، وتحجم عن طلب الخدمة الصحية خوفاً من سخرية الموظف المسؤول، وقد تُخفي أنها حامل، أو تلد في البيت بسبب سوء المعاملة في المشفى، وإذا طلبت الخدمة الصحية فهي الأقلّ حظّاً في الحصول على خدمات التوليد والرعاية الصحية، وبالتالي فهذه المرأة وجنينها هما الأكثر عرضةً للموت عند الولادة أو بعدها، وهي أكثر عرضةً للأمراض، وللسرطان بالتحديد، واللاجئات لا يحظين بالرعاية الصحية الوقائية كما المستقرات، بما يشمل الكشف المبكر أو التداوي لعلاج نقص الخصوبة أو سائر الأمراض، وإذا توفرت الرعاية الطبية قريباً منهن فقد لا يستطعن دخول المشافي بسبب فقدان أوراقهن الثبوتية أو عدم القدرة على دفع الفاتورة. وقد تجبر اللاجئة على إنهاء حمل مرغوبٍ به حتّى لا تُلحق الضرر بفرصة عائلتها في الهجرة إلى بلدٍ يمنحها إقامة آمنة.
*استغلال النساء ذوات الإعاقة الجسدية بمصادرة قرارهن الشخصيّ وإخضاعهن للوصاية ورغبة الوصيّ بينما هن سليمات العقل، وعدم امتلاكهن لفرص العمل أو الزواج وحبسهن في البيت واعتبارهن عبئًا على العائلة.
*ختان الإناث الذي لا يزال سارياً في كثيرٍ من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط، كذلك في بعض مجتمعات المهاجرين في الدول الغربية، بعض كانتونات المهاجرين في بريطانيا على سبيل المثال.
*معاناة النساء المسجونات من إمكانية التعرّض للإيذاء الجسدي والجنسي، وغياب الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية بسبب عدم توافر أطبّاء أمراض النساء وعدم وجود أبسط الحاجات كالفوط الصحية.
*واقع اختلاف الأجور بين العاملين في مهنةٍ واحدة تتطلّب المجهود نفسه، يكسب الرجل فيها أجراً أعلى من أجر المرأة، وتكسب المرأة البيضاء أعلى من الملونة. فعلى المرأة البيضاء أن تبذل ضعف الجهد لأنها امرأة، وعلى الملونة أن تبذل ثلاثة أضعاف هذا الجهد لأنها امرأة ولأنها ملوّنة.
*الدعارة السريّة هي مأساة المشتغلين والمشتغلات فيها وليست عارهم، فهن-م غالباً ضحايا استغلال طبقةٍ أعلى. والدعارة المرخصّة مهنةٌ كباقي المهن، لكنّ المجتمع يعاملها بالنبذ، وهي غير محميةٍ بالقانون، ولا يتلقى المشتغلون فيها (من رجالٍ ونساء) اللقاحات أو الرعاية الطبية أو فحوص الكشف المبكر عن السرطان أو وسائل منع الحمل، ولا يفرض القانون على الزبائن ارتداء الواقي الذكري، وبدلاً من حماية الدولة لهذه الفئة، فإنّ أكبر استغلالٍ لها يأتي من رجال الدولة أنفسهم.
*الترويج لوسائل منع الحمل بعقليةٍ ذكوريةٍ تُركّز على إبطال خصوبة المرأة، ولا تشجّع على الواقيات الذكرية للرجال، فيرفضها أكثرهم، إضافة إلى استهتار الرجال بجزء المسؤولية المطلوب منهم في منع الحمل غير المرغوب حتى في أوساط العائلات القائمة على الزواج التقليديّ.
*غياب العدالة عن الجنسين بتشجيع المرأة أو الرجل على التعقيم (ربط القناتين الرحميتين للمرأة أو الأسهرين للرجل) دون شرحٍ واضحٍ وشامل لكيفية أو نتائج هذه العملية، أو عدم مراعاة أنّ مجتمعاتهم مسيّرةٌ بنظامٍ أبويّ يعتبر تعقيم الرجل انتقاصاً للرجولة وبالتالي فهو بالنسبة إليه إيذاءٌ صريحٌ لكرامته.
*في الحمل خارج إطار مؤسسة الزواج التقليدي أو الحمل الناجم عن العنف الجنسي (الاغتصاب) يقع التجريم الوحيد على المرأة، وتضطر هذه المرأة إلى الإجهاض كي لا تجلب العار لعائلتها، مع أنها قد ترغب بالأمومة. وقد يستغل بعض الأطباء خوفها ويطلبون منها مبالغ خرافية، فتُرغَم على الأمومة الإجبارية وتتخفّى وتعيش في رعبٍ دائم، أو تلجأ إلى الإجهاض غير الآمن فتفقد صحتها أو حياتها.
*استبعاد النساء الفقيرات و/أو غير المتزوّجات أو اللاجئات من برامج الأمومة الآمنة ورعاية ورفاه الأطفال التي تدعمها الدولة، فتدفعهن قسوة الظرف الاقتصادي أو الاجتماعيّ إلى الاضطهاد الإنجابي: أي أن تجبر هؤلاء النساء على الاختيار بين عيشهن وأطفالهن البيولوجيين، فيرسلنهم إلى التبنّي. والتبني بدوره خاضعٌ لسلطة الدين وليس للدولة. ففي حين لا يسمح الفقه الإسلامي بالتبنّي الكامل، فإنّ المسيحية تسمح به من خلال عدد من الشروط تضعها الكنيسة.
*دخول التقنيات المساعدة على الحمل مكّن النساء الراغبات في الأمومة وغير القادرات عليها بيولوجياً، كالمسنات، والمريضات، واللواتي بلا رحم، أو في حالة عقم الزوج،..) وحمل معه الحاجة إلى خدمة «الرحم البديل»، وخدمات الإرضاع من الثدي وسواها، جميعها تجري اليوم بتسييرٍ من السوق الرأسماليّ الذي يستغلّ النساء الفقيرات ويجبرهن على تقديم أرحامهن أو حليب أثدائهن مقابل أجورٍ بخسةٍ، مع غياب القوانين التي تنظم «الأمومة البديلة»، وتُنصف المشتغلات فيها بأجرٍ عادلٍ باعتبارها مهنةً نظامية.
*رهاب ذوي الهويات الجنسية غير النمطية من العبور الجنسي، ومن تحميل الأطبّاء مسؤولية العمليات الجراحية الفاشلة، ومن طلب خدمة تجميد البويضات أو السائل المنوي قبل إجراء جراحاتهم، والاضطهاد الجنسي الذي يتعرضون إليه بسبب اضطرارهم-ن إلى الاختيار بين بطاقة هوية تؤمّن الحماية القانونية والاجتماعية أو البطاقة التي تعبّر عن هويتهم الجندرية كما يشعرون بها، واضطرارهم إلى العيش مع عائلةٍ ترفضهم ووسط مجتمعٍ ينبذهم، وغياب حقوقيين يتبنون قضاياهم، أو قبول الحقوقيين لهذه القضايا وتركها معلّقة.
*والكادر الطبيّ نفسه لم يعد محميّاً في ظل تخلّف القوانين عن الحاجات الطبيّة المستجدة، وأبسط مثالٍ عليه أنّ قوانين بعض الدول تعاقب الطبيب بالسجن إذا وصف دواءً مانعاً للحمل لامرأةٍ وتمّ الادّعاء عليه وثبت اتهامه بدليل هذه الوصفة.
هذه بعض الحالات، عدا عن كثيرٍ غيرها، تكشف مدى الظلم الواقع على أصحابها، وغياب الإطار الناظم لهذه الفئات وسط شركائها في المجتمعٍ الكبير، بحقوقها ومسؤولياتها المستحقة، وقد تكون العدالة الإنجابية هي الإطار العملي لتفكيك هذا الظلم من جذوره، هي مشروع التغيير الاجتماعيّ الجذريّ والشامل، بشراكةٍ فعليةٍ بين واضعي السياسات والمجتمع المدني وجماعات التأييد، وتحييد سيطرة النظامين: الرأسمالي والأبوي، وتفعيل التنمية الاجتماعيـة، والصحة والتعليم أولاً، للوصول إلى مجتمعٍ مستقرٍ يعترف بحق جميع أفراده في الوجود والكرامة، من دون أيّ تمييزٍ جندريٍّ أو سواه.
أخيراً
الطريق إلى العدالة الإنجابية المنشودة طويلٌ وحافل، وسوء الحال على الأرض لا يجب أن يقود إلى الصمت عليه أو التسليم به أو تجنّب خوضه، بل لعله يحفّز على الإيمان بضرورة التغيير، وعلى امتلاك الإرادة للبدء والقوة والتحمل والصبر حتى إنجازه، وتلزمه المعرفة والوعي بالحرية كمسؤولية كما هي حق، وتوعية الرجال والنساء ليبادروا بأنفسهم إلى طلب المعلومة أو الخدمة التي يحتاجون إليها أكثر من سواها، وليطرحوا أسئلتهم الخاصة حول القضايا التي تشغلهم أكثر من سواها، لا أن يبقوا مجرد متلقّين لما يُعطى إليهم.