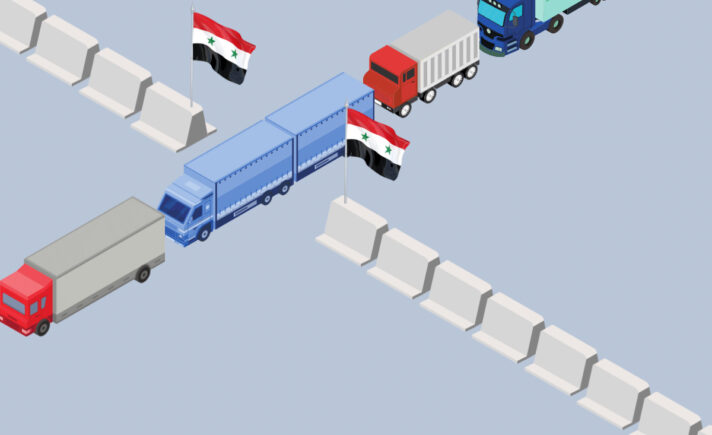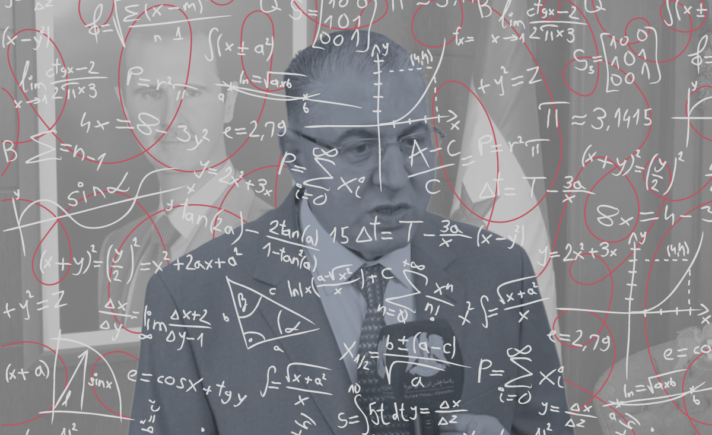لطالما اجتهد الجيش الإسرائيلي في صقل سمعته بخصوص البراعة التقنية ودمجها مع آلة القتل، كيف لا وهو جيش «الدفاع» عن «الدولة الناشئة» (The startup nation) أو «وادي السيليكون في الشرق الأوسط». وخلال عقود، قَدّمَ هذا الجيش ادعاءات جريئة حول تسخير التكنولوجيا في حروبه، بوصفها أسلحة تم اختبارها على أرض الواقع وعلى أجساد الفلسطينيين.
على سبيل المثال، بعد العدوان الذي استمر 11 يومًا على غزة في أيار (مايو) 2021، قال المسؤولون العسكريون في دولة الاحتلال إن إسرائيل خاضت «حربها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي»، باستخدام التعلّم الآلي والحوسبة المتقدمة. لكن الحرب الراهنة على غزة شكّلت قفزة نوعية في استخدام الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الأدوات في مسرح عمليات أوسع بكثير، وعلى وجه الخصوص، لنشر منصة «صُنع» الأهداف بواسطة الذكاء الاصطناعي التي تسمى باللغة العبرية «حبسورا» (وتعني الإنجيل)، والتي ساهمت في تسريع تصنيف وفرز الأهداف «العسكرية» من خلال ما وصفه المسؤولون بأنه «خط إنتاج للأهداف يشبه المصنع»، وفقًا لما كشفت عنه تحقيق استقصائي أجرته مجلة +972 بالتعاون مع موقع لوكال كول.
في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد «أكثر من 12 ألف هدفاً» في غزة من قبل ما يُعرف باسم «كتيبة إدارة الأهداف»، ووصفَ أحد المسؤولين آلية عمل الكتيبة التي تتسم بالسرية قائلاً: «نحن نعمل دون أي تنازلات في تحديد هوية العدو وماهيته. نشطاء حماس ليسوا مُحصَّنين، بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه». فيما زعمَ بيانٌ مقتضب للجيش الإسرائيلي أنه يستخدم نظام «حبسورا» القائم على الذكاء الاصطناعي في الحرب ضد حماس «لإنتاج الأهداف بوتيرة سريعة»، وأنه «من خلال الاستخراج السريع والمؤتمت للمعلومات الاستخباراتية»، أصدر النظام توصيات بأهداف مقترحة تُراعي المُطابقة الكاملة بين توصية الآلة والتحقُّق من شرعية الهدف بواسطة البشر.
وتم التأكيد على «دقة» الضربات التي أوصى بها «بنك أهداف الذكاء الاصطناعي» في تقارير متعددة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إذ ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن كتيبة إدارة الاستهداف «تتأكد قدر الإمكان من عدم وقوع أي ضرر للمدنيين»، كما قال مصدر عسكري إسرائيلي كبير سابق لصحيفة الغارديان إن الباحثين الذين يقفون وراء النظام يستخدمون قياسًا «دقيقًا للغاية» لمعدل إخلاء المدنيين للمبنى قبل وقت قصير من الغارة: «نحن نستخدم خوارزمية لتقييم عدد المدنيين المتبقين. إنه يعطينا اللون الأخضر والأصفر والأحمر، مثل إشارة المرور».
لكن المصادر المتنوعة داخل الجيش الإسرائيلي، التي أدلت بشهاداتها في التحقيق الصحفي المشار إليه أعلاه، أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يمتلك ملفات عن السواد الأعظم من الأهداف المحتملة في غزة، ومنها منازل المدنيين؛ ما يعني أن العدد محسوبٌ ومعلومٌ سلفًا لوحدات استخبارات الجيش الإسرائيلي، التي تَعرف قبل تنفيذ القصف العددَ التقريبي للمدنيين المؤكد قتلهم في كل هجوم. يقول أحد المصادر في حديثه عن استهداف الأبراج، والذي كان نمطًا واضحًا في الحرب الحالية على غزة: «وُضِعت تلك الأهداف بافتراض إجلاء الناس عن المباني الشاهقة، لذلك عندما باشرنا تجميع هذه الأهداف لم يُساورنا القلق بتاتًا بشأن عدد المدنيين المتضررين، فالافتراض الأوليّ كان دومًا خلو الأماكن المستهدفة منهم».
إن استهداف 12 ألفًا من الأهداف منزوعة الإنسانية هكذا، والمُحدَّدة بالألوان بواسطة الذكاء الاصطناعي، نتجَ عنه سقوط أكثر من 23 ألف ضحية، أكثر من نصفهم من الأطفال، وعشرات الأحياء المدمّرة بالكامل، وهو ما يشي تمامًا بمدى «دقة» تلك الأنظمة والغرض الذي صُمّمت لأجله. لكن رغم أن هذه المرة الأولى التي يُكشَف فيها عن استخدام إسرائيل نظامًا من هذا النوع بالتفصيل، يبقى استخدامها بيوتَ الفلسطينيين وأجسادهم وأدواتهم كحقل تجارب لتقنياتها التي تشكّل العمود الفقري لاقتصادها ليس بالأمر الجديد.
استراتيجيات وعروض «مغرية» للانضمام لآلة القتل
أطلق الجيش الإسرائيلي استراتيجيةً جديدةً مطلع العام الماضي لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جميع فروعه العسكرية، فيما وصفه بـ«التحول الاستراتيجي الأكثر شمولاً منذ عقود». وفي حزيران (يونيو) الماضي تفاخرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن الجيش يعتزم أن يصبح «قوة عظمى» عندما يتعلق الأمر بإدخال الذكاء الاصطناعي في مجال الحروب المؤتمتة.
وقال جنرال الجيش المتقاعد إيال زمير أمام مؤتمر هرتسليا، وهو منتدى أمني سنوي: «هناك من يرى أن الذكاء الاصطناعي هو الثورة القادمة في تغيير وجه الحرب في ساحة المعركة»، إذ يمكن أن تشمل التطبيقات العسكرية «قدرة المنصات على ضرب أسراب من الأهداف الجوية المعادية، أو قدرة الأنظمة القتالية على العمل بشكل مستقل… والمساعدة في اتخاذ القرار السريع، على نطاق أكبر مما رأيناه من قبل».
تُنتج صناعة الدفاع الإسرائيلية مجموعة واسعة من المَركبات العسكرية المستقلّة، بما في ذلك مَركبات آلية مُسلّحة تُوصَف بأنها منصات «قوية» و«فتّاكة» تحمل ميزة «التعرّف التلقائي على الأهداف». كما تمتلك غواصة ذاتية القيادة لجمع المعلومات الاستخبارية السرية، يطلق عليها اسم بلو ويل (أي الحوت الأزرق)، ما زالت تخضع لعدد من التجارب قبل الإطلاق.
ويُشكّل الفلسطينيون وأرضهم مخبر تجارب لمثل هذه التقنيات، حيث يُعتبرون بمثابة دليل على «إثبات المفهوم» للزبائن العالميين للأسلحة الإسرائيلية. عملاء إسرائيل الأكثر احتمالاً هم الدول المتورطة في حروب (مثل الإمارات التي شاركت لسنوات في الحرب في اليمن)، أو الدول القادرة اقتصاديًا ولم تَخُض اختباراتٍ عسكرية حقيقية منذ زمن (مثل المغرب).
ورغم أن تلك الأسلحة قد تعطي الأفضلية لمالكها في ساحة المعركة، ويدّعي مطوّروها أنها صُمّمت لتوليد أكبر عدد ممكن من الأهداف «المشروعة» لتقليص عدد الضحايا المدنيين كـ«أضرار جانبية»، إلا أنها في النهاية لم تؤدِ ذلك الغرض، إذ أُريقت دماء أكثر من 30 ألف فلسطيني في أول حربٍ تُستخدم فيها، أكثر من أي حربٍ مضت في هذا الصراع.
ولا يقتصر الأمر على منصات الإطلاق وقوائم الأهداف، إذ أنّ هناك تقنية إسرائيلية جديدة أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي نوليدج وِل (وتعني بئر المعرفة)؛ تُراقب الأماكن التي تُطلِق منها الفصائل المسلحة الفلسطينية صواريخها، ويمكن استخدامها أيضًا للتنبؤ بمواقع الهجمات المستقبلية، كما يدّعي الجيش الإسرائيلي.
ورغم أن مثل هذه الأنظمة تدّعي توفير الحماية للإسرائيليين من الأسلحة الفلسطينية، فإنها تعمل أيضًا على تمكين إسرائيل من التحوّل إلى آلة قتل افتراضية، تُطلق العنان لهجمات مرعبة ضد أهداف عسكرية ومدنية بشكلٍ عشوائي دون ردع، في حين أنها لا تنجح تمامًا بتحقيق أهدافها المرجوّة، إذ ما زالت صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق باتجاه مختلف المدن الإسرائيلية بين الحين الآخر بعد أكثر من تسعين يومًا على الحرب.
ولا تكتفي الجهات التي تقف وراء هذه الأنظمة بوعود وادّعاءات الدقة فحسب، بل تُضفي عليها صِبغة إنسانية «شاعرية» على فظاعة ما طُوِّرت لأجله. إذ يقول إيلي بيرنبوم، كبير خبراء الذكاء الاصطناعي في الجيش الإسرائيلي لرويترز: «ليس سرًّا أنني لا أستطيع التنافُس مع رواتب غوغل أو فيسبوك. ماذا يمكنني أن أقدم عوضًا عن ذلك؟ المعنى»، كما لو أن المشاركة في قتل الفلسطينيين من شأنها أن تبعث على الطمأنينة والقبول الفوري بالفرصة.
«المختبر الفلسطيني»؛ تقنيات مُختبَرة في «معارك» غير متكافئة
فلسطين هي واحدة من أكثر الأماكن الخاضعة للمراقبة على وجه الأرض. كاميرات المراقبة موجودة دائمًا في المشهد الفلسطيني الذي ترسمه أبراج الحراسة الإسرائيلية، وبعضها مُسلّح بمدافع آلية يتم التحكم فيها عن بعد. بينما تحلّق المسيّرات دون توقف في سماء الضفة، وهي قادرة على إطلاق الغاز المسيل للدموع، أو إطلاق النار مباشرة على الفلسطينيين الموجودين في الأسفل، أو توجيه النيران من قبل الأفراد الموجودين على الأرض. وفي غزة، تدب المراقبة المستمرة الصدمة والخوف في قلوب السكان، حتى في الأوقات التي لا تُلقي الطائرات فيها حمولاتها فوق رؤوسهم.
في أواخر العام الفائت، تم الكشف عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتركيب مدفع يتم التحكم فيه بواسطة الذكاء الاصطناعي على نقطة تفتيش عسكرية في شارع الشهداء المزدحم في مدينة الخليل الفلسطينية. وغرّدت مروة فطافطة، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة «Access Now» للحقوق الرقمية: صدقونا عندما نقول نحن معمل اختبارات مراقبة بكل معنى الكلمة».
وقالت فطافطة في حوار مع موقع كودا ستوري إن معظم، إن لم يكن كل، تقنيات المراقبة التي تُطورها وتُصدِّرها السلطات الإسرائيلية تنبع من الأراضي المحتلة، وإما أن الجيش الإسرائيلي هو الذي قام بإعداد النماذج الأولية واختبار هذه التقنيات، أو تقوم بذلك شركات خاصة أنشأها عناصر جيش ومخابرات سابقون. وتُضيف فطافطة أن «إسرائيل لا تعترف بأن التزاماتها بحماية حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي تمتد إلى الأراضي التي تحتلها. وفي الوقت نفسه، يرون في الأراضي المحتلة فرصة مُربِحة لوضع نماذج أولية ونشر واختبار وتعزيز جميع أنواع الأسلحة وتقنيات المراقبة».
كما تشرح باحثة الحقوق الرقمية والرقابة في جامعة دوك البريطانية صوفيا غودفريند كيف بدأت دولة الاحتلال باستخدام تقنيات المراقبة كعنصر أساسي في استراتيجية «تقليص الصراع» التي بدأها نفتالي بينيت، والتي تدعو القادة عبر الطيف السياسي الإسرائيلي إلى التخلي بشكل كامل عن طروحات توسيع أو إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والسعي للحفاظ على ما يسمى بالوضع الراهن بمساعدة التقنية.
إذ تعمل كاميرات التعرّف على الوجه عند نقاط التفتيش، وقواعد البيانات البيومترية، والمركبات الجوية بدون طيار في الفضاء الحضري، على تشغيل العديد من مكونات الحكم العسكري الإسرائيلي بشكل آلي، ومع استمرار الاحتلال واستشرائه، يقول الجيش الإسرائيلي إن مثل هذه التقنيات تجعل إدارة نظامه العسكري المستعصي أسهل.
ومع ذلك، فإن التقنيات يتم عرضها في المعارض الدولية كمعرض الدفاع الإسرائيلي (ISDEF) الذي يُعقد كل سنتين ويحضره الآلاف من شتى أنحاء العالم، والتي ترسم اتجاهات تكنولوجيا المراقبة في جميع أنحاء العالم، سَوَّقتها الشركات الإسرائيلية المُصنِّعة على أنها «حلول أمنية» لاحتواء فيروس كورونا، ودعم مبادرات الشرطة الذكية، ومراقبة الحدود الخالية من الصراع، بينما تمّ تطويرها وتحسينها داخليًا على حساب الفلسطينيين.
غالبًا ما تُروِّج شركات الأسلحة الإسرائيلية لمنتجاتها من خلال التأكيد على أنه «تم اختبارها في المعركة»، إلا أن تسويق الأسلحة بهذه الطريقة هو أمرٌ مضلل، من الناحية التسويقية على أقل تقدير، على اعتبار أن دولة الاحتلال لم تخض أي «معركة» مع جيشٍ نظامي، إذ اقتصرت صراعاتها العسكرية منذ نهاية حرب أكتوبر 1973، على حروب مع فصائل مسلّحة لا تمتلك التنظيم أو القدرات أو الأسلحة أو التكنولوجيا التي بحوزة الجيش الإسرائيلي.
وقد تم تعويض هذا النقص في المعارك من خلال وفرة المختبرات، والتي لم تكن سوى الضفة الغربية وقطاع غزة. في كتابه المختبر الفلسطيني: كيف تصدر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم، يرى أنتوني لوينشتاين، الصحفي والمؤلف الأسترالي اليهودي، أن احتلال فلسطين قد وفَّرَ لإسرائيل ساحة اختبار لا تُضاهى في تطوير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة.
وفي الوقت نفسه، كانت فلسطين أيضًا بمثابة قاعة عرض لآثار هذه الأسلحة، والتي يتم تصديرها بعد ذلك إلى جميع أنحاء العالم مما يولد إيرادات كبيرة ونفوذًا سياسيًا قيّمًا لإسرائيل، يعود عليها بمنافع دبلوماسية وليس اقتصادية فقط. وكما كتب لوينشتاين، فإن «المختبر الفلسطيني هو نقطة بيع إسرائيلية مميزة».
ولا يقتصر الأمر على السوق الإقليمية أو الدول الغربية الأكثر قربًا دبلوماسيًا من إسرائيل، كما أنه ليس سياسة حديثة، إذ يعود هذا السلوك إلى عام 1967 عندما انتهزت إسرائيل فرصة استيلاء الجنرال أجوي إيرونسي على السلطة في نيجيريا وقرب اندلاعٍ حربٍ أهلية لتعزيز العلاقات بين البلدين وترويج الأسلحة الإسرائيلية. كما كانت صفقات السلاح مدخلاً للتقرّب من أذربيجان خلال حربها الأخيرة مع أرمينيا، وتوطيد العلاقات التي انتهت بفتح سفارات في كلا البلدين مطلع هذا العام.
يشرح لوينشتاين كيف بدأ طريق إسرائيل لتصبح «قوة عسكرية» بعد حرب عام 1967، واصطفاف البلدان المتزايد مع واشنطن في سياق الحرب الباردة. وعليه، سرعان ما راكمت إسرائيل زبائن لأسلحتها، بدأت مع إيران في عهد الشاه في السبعينيات، ولم تنتهِ عند الهند وعدد من الدول العربية التي طبّعت، أو ما زالت في مرحلة المفاوضات، والتي لديها برامج دفاعية باهظة الثمن قد تُوفِّرها الشركات الإسرائيلية قريبًا. وبحلول التسعينيات، أرادت الحكومة الإسرائيلية أن تُصبح صناعتُها العسكرية أكثر استقلالاً عن الولايات المتحدة. تزامنَ ذلك مع خصخصة القطاع، الذي استمر رغم ذلك في تلقي دعم اقتصادي كبير من الدولة.
وفي مطلع الألفية الجديدة، استغلت صناعة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية ما يسمى بـ«الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، فلطالما اعتبرت إسرائيل أي نوع من المقاومة الفلسطينية بمثابة إرهاب. وعلى هذا، كانت في وضع جيد بطبيعة الحال عندما قفزت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى وصف المعارضين السياسيين لها بـ«الإرهابيين». وكما كتب لوينشتاين، فقد مُنحت إسرائيل فرصة عظيمة «لتسييل الاحتلال».
وفقًا لمركز ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI)، كانت إسرائيل من بين المصدرين العشرة الرئيسيين للأسلحة في العالم منذ عام 2004 على الأقل، وفي الفترة 2016-2020، كانت ثامن أكبر مُصدِّر عالميًا. وفي أعقاب «اتفاقيات إبراهيم» مع الدول العربية، حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا في حجم صادرات الأسلحة الذي بلغ 12.5 مليار دولار العام الفائت، ربعها تقريبًا كان من جيوب الدول العربية المطبِّعة، بواقع 1.4 في المئة من حجم صادرات الأسلحة عالميًا.
وخلال العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014، والمعروفة باسم عملية َ«الجرف الصامد»، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الأسلحة «ميبرولايت» الإسرائيلية أنه «بعد كل حملة من النوع الذي يجري الآن في غزة، نشهد زيادة في عدد العملاء من الخارج».
يُلقي كتاب المختبر الفلسطيني الضوء على الشركات الإسرائيلية الخاصة، التي يعمل فيها ضباط مخابرات إسرائيليون سابقون وتعمل في كثير من الأحيان بترخيص حكومي، والتي قَدَّمت، على سبيل المثال، طائرات استطلاع بدون طيار لروسيا (استخدمتها في تدخلها العسكري في سوريا)، وكانت قد اختبرتها سابقًا في غزة. ويوضح لوينشتاين أن هذه الشركات الخاصة غالباً ما تُنفّذ أوامر الحكومة الإسرائيلية، مما يؤدي إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين القطاعين العام والخاص.
ويروي القصة المعروفة لكيفية قيام مجموعة NSO الإسرائيلية ببيع برنامج «بيغاسوس» الشهير لاختراق الهواتف إلى العديد من الحكومات، بما في ذلك المكسيك والمغرب وأوغندا والمملكة العربية السعودية، للتجسس على منتقديها. ومع ذلك، كما يشير لوينشتاين، فإن غالبية الإسرائيليين لم يُعرِبوا عن غضبهم حتى استخدمت إسرائيل البرنامج للتجسس على مواطنيها اليهود.
فيما لم تهتم الولايات المتحدة لمخاطر تقنيات الشركة على الدبلوماسية السياسية إلّا عندما كُشف عن استخدامها للتجسس على دبلوماسيين أميركيين؛ ما دفع لوضعها على قائمة الشركات السوداء، ثم جاءت محاولات الشركة المتكررة للتواصل مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن للضغط عليه في سبيل إزالتها وتحسين صورتها، الأمر الذي لم ينجح حتى الآن.
إن وصف لوينشتاين لكيفية استخدام نتنياهو لبرامج التجسس هذه لتأمين مكاسب دبلوماسية، على وجه التحديد مع الدول العربية في الخليج، والتي بلغت ذروتها في «اتفاقيات إبراهيم» التطبيعية لعام 2020، لا يتوقف عند NSO، بل يشير إلى أن هناك العديد من الشركات الأخرى، من بينها بلاك كيوب وإلبيت وسيليبرايت، وهو ما أشار إليه تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز مطلع العام الفائت.
كما تم بيعُ تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية إلى وكالات مراقبة الحدود في دول غربية متواطئة في ما تنطوي عليه هذه التقنيات من انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ بيعت تكنولوجيا المراقبة التي تم تطويرها في إسرائيل، واختُبرت في مدن وبلدات الضفة الغربية، إلى الولايات المتحدة -التي لطالما لاحقها هاجس بناء جدار فصلٍ على حدودها الجنوبية يشبه ذاك في فلسطين- في هيئة أبراج مراقبة ممتدة على الحدود المكسيكية، وإلى الاتحاد الأوروبي، حيث استخدمت وكالته الحدودية «فرونتكس» تكنولوجيا مسيّرات «هيرون» الإسرائيلية لمراقبة اللاجئين، بعدما «نجحت» إسرائيل باختبارها في غزة.
وقالت منظمة العفو الدولية في أيار (مايو) الفائت إن السلطات الإسرائيلية تستخدم نظامًا تجريبيًا للتعرّف على الوجه يُعرف باسم «ريد وولف» (وتعني الذئب الأحمر) لتعقُّب الفلسطينيين وأتمتة القيود الصارمة المفروضة على حريتهم في الحركة. إذ وثقت كيف أن «الذئب الأحمر» جزءٌ من شبكة مراقبة متنامية تعمل على ترسيخ سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، يتم نشرها عند نقاط التفتيش العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يقوم بمسح وجوه الفلسطينيين وإضافتهم إلى قواعد بيانات المراقبة الواسعة دون موافقتهم.
كما وثقت منظمة العفو الدولية كيف تزايد استخدام إسرائيل لتكنولوجيا التعرّف على الوجه ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في أعقاب الاحتجاجات وفي المناطق المحيطة بالمستوطنات غير القانونية. وفي كل من الخليل والقدس الشرقية المحتلة، تدعم تكنولوجيا التعرُّف على الوجه شبكة كثيفة من كاميرات المراقبة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة شبه المستمرة فيما وصفته المنظمة بـ«الأبارتهايد الرقمي»، الهادف لتقليل تواجد الفلسطينيين في المناطق التي تعدها إسرائيل استراتيجية.
هناك أدلة قوية تشير إلى أن «الذئب الأحمر» مرتبط بنظامين آخرين للمراقبة يديرهما الجيش الإسرائيلي، وهما «وولف باك» (وتعني قطيع الذئاب) و«بلو وولف» (وتعني الذئب الأزرق). «قطيع الذئاب» عبارة عن قاعدة بيانات واسعة تحتوي على جميع المعلومات المُتاحة عن الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أماكن إقامتهم، ومن هم أفراد أسرهم، وما إذا كانوا مطلوبين لاستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية. أما «الذئب الأزرق» فهو تطبيق يُمكن للقوات الإسرائيلية الوصول إليه عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويمكنه سحب المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات «قطيع الذئاب» على الفور.
عندما يمرّ فلسطيني عبر نقطة تفتيش حيث يعمل «الذئب الأحمر» يتمّ مسح وجهه، دون علمه أو موافقته، ومقارنته بالإدخالات البيومترية في قواعد البيانات التي تحتوي حصرًا على معلومات عن الفلسطينيين. وتُستخدَم هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الفرد يمكنه اجتياز نقطة تفتيش، ويقوم البرنامج تلقائيًا بتسجيل أي وجه جديد يقوم بمسحه ضوئيًا، وإذا لم يكن هناك دخول سابق للفرد، يتم رفض مروره.
وثّقت منظمة العفو الدولية، من خلال الشهادات التي قدَّمها أفراد عسكريون، كيف أصبحت مراقبة الفلسطينيين مجرد لعبة. على سبيل المثال، قال جنديان متمركزان في الخليل في عام 2020 إن تطبيق «الذئب الأزرق» يُنشئ تصنيفات بناءً على عدد الفلسطينيين المُسجَّلين، حيث يقدم القادة الإسرائيليون جوائز للكتيبة الحاصلة على أعلى الدرجات. وبهذه الطريقة، يتم تحفيز الجنود الإسرائيليين لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة المستمرة.
كما أفادت صحيفة هآرتس بأنه يتم دمج برامج شركات مثل «Anyvision»، القادرة على تحديد أعداد كبيرة من الأفراد، مع تلك الأنظمة التي تحتوي على معلومات شخصية، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
لا جهود سياسية حقيقية لوقف المأساة
لم يكن من الممكن على الإطلاق تجنُّب الصعود العالمي للصناعة العسكرية-التقنية الإسرائيلية، لكن هناك إجراءات كان يمكن أن تمنع استخدام فلسطين كمختبر يغذي صادرات تلك الصناعة. وما ينقصنا، كما هو الحال في كثير من الأحيان، هو الإرادة السياسية الدولية.
في عام 2021، على سبيل المثال، فشلت عضوة البرلمان الفنلندي آنا كونتولا في تمرير مشروع قانون كان من شأنه أن يمنع واردات الأسلحة من دول، مثل إسرائيل، استخدمت الأسلحة التي تنتجها لانتهاك حقوق الإنسان. وكما يوثق لوينشتاين في كتابه، فإن إسرائيل لم تدفع أي ثمن لاحتلالها لفلسطين فحسب، بل استفادت منه اقتصاديًا من خلال نجاح صادراتها من الأسلحة.
إنها شبكة من التقنيات ترمي إلى السيطرة بهدف غرس الخوف والهلع وتعزيز الشعور باليأس، وكما قال صراحةً رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق رافائيل إيتان ذات مرة، فإن الهدف من هذه التقنيات هو جعل الفلسطينيين «يركضون مثل الصراصير المُخدَّرة في زجاجة»، أما بالنسبة للزبائن، فهُم «الأداة» اللازمة للوصول إلى منتجات مثالية تستحقّ ثمنها.