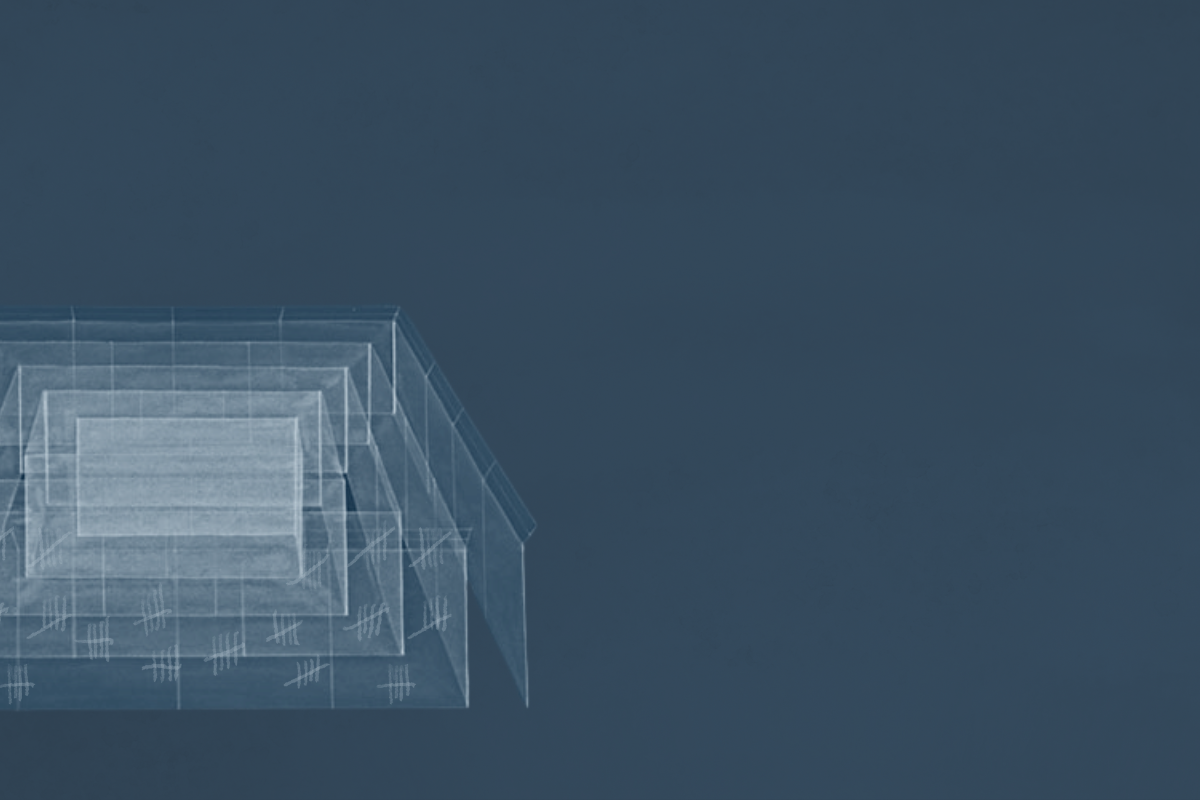من موقع في «المنفى» بعد أكثر من عشر سنوات، وفي ذكرى خروجي من السجن في مثل هذا اليوم من عام 1996، يبدو لي أنه يمكن التفكير بتجربة السجن من ثلاثة مواقع مختلفة أو أربعة: موقع السجين داخل السجن نفسه؛ موقع «الناجي» خارج السجن، لكن في بلد محكوم بالنظام نفسه ويحدث أن يُوصَفَ بأنه سجن كبير؛ فموقع اللاجئ بعيداً عن البلد الذي يحدث كذلك أن يُوصَف بأنه «منفى داخلي»؛ وربما موقع مُتخيَّل من سورية نالت استقلالها من «الأبد»، سورية حرة. هناك استمرارية بين المواقع الثلاثة الأولى: السجن جزءٌ من نظام ممارسات سياسية، ظلت مُخيِّمة في سورية بعد خروج أكثر معتقلي جيلي، وهو ما يعني أن شهية السجن ظلت مفتوحة، وما يعني كذلك أن الناجي لم يَنجُ، بل انتقل من سجن إلى سجن أكبر. واستمرارهُما معاً مُحقَّق مع المنفى الذي (وإن لم يعد عقاباً قانونياً) تجمعه بالشروط السياسية للسجن، صغيراً وكبيراً، علاقة تَوَلُّدٍ مباشرة. ما كان يمكن أن يؤول الأمر بجميع من أعرفهم ممن كتبوا عن السجن إلى «المنفى» لولا شرط «السجن الكبير». فهل يكون اللاجئ ناجياً أخيراً؟ إذا أخذنا بالاعتبار أن الأمر يتعلق بناشطين أو «مهتمين بالشأن العام» بصور مختلفة، فيصعب الكلام على نجاة ما دامت الأوضاع السياسية في البلد مثلما هي. المنفى، بالأحرى، هو السجن الأكبر، ونحن فيه مسجونون خارج بلدنا، لا نستطيع العودة إليه. قصتنا لا تكتمل دون هذه العودة، وهي لن تكون قصة نجاة دون العودة. ننجو فقط حين يتغيّر النظام السجّان، البنية السياسية التي تحكم بالاعتقال والتعذيب والسجن. وقتها، يُغلَق سجلٌّ ويبدأ سجلّ جديد، بمشكلاته وصراعاته وتحدياته، وكتابته كذلك. هذا الموقع الرابع للكتابة عن السجن قد يُتاح وقد لا يُتاح لأكثر من كتبوا عن السجن من جيلي، لكنه في كل حال على قطيعة مع شروط السجن الصغير والسجن الكبير والسجن الأكبر.
هذه المقالة تنظر في اختلاف صورة السجن بحسب اختلاف المواقع، ثم في استعارتَي السجن الكبير والمنفى الداخلي.
في عين السجين
حاولتُ الكتابة عن السجن وأنا في السجن، فلم أعرف. لم أجد الموضوع. ربما يتعلق الأمر بالافتقار إلى مسافة تُتيح الرؤية. وقد لَزِمَتْ نحو سبع سنوات بعد خروجي من السجن قبل أن أبدأ الكتابة عنه، أُتيحت لي خلالها مسافة للرؤية، زمنية ونفسية. ويبدو أن معظم ما كُتب ونُشر عن السجون السورية من قِبَلِ من خبروها بأنفسهم كُتب بعد سنوات من مغادرة السجن، ما يعني أن المسافة إلزامٌ عام، وليست معادلة شخصية تخصّ بعضنا. ثم أن ما كُتب، كتبه أناس فكروا في أنفسهم كـ«ناجين»، ولعله كان في الكتابة ضربٌ مُقنّعٌ من الاحتفال بالنجاة، إذ أن تجربة السجن التي ستبدو بنظرة راجعة مغامرة محفوفة بالمخاطر، جرى تجاوزها بنجاح. تجربة نجاة. إن كان من جاذبية لـ«أدب السجون» في نظر القرّاء فهي ربما تكمن في هذا، في قصة الخطر والمحنة والمجازفة، يجري التغلب عليها بعد صراع ومَشقّة، وتنتهي نهاية سعيدة من نوع ما.
فيما يتصل بكلا هاتين الخاصيتين لأدب السجون الذي كُتب بعد تجربة السجن بسنوات، أعني خاصيَّتي المسافة والنجاة، يمكن التساؤل: هل من مسافة كافية فعلاً؟ وهل نجونا فعلاً؟ وإجابتي عليهما معاً أقرب إلى النفي اليوم، لكن ما تُريد هذه المناقشة قوله هو أن الأمر في كل حال أمرُ موقعٍ ومنظور. فلا تبقى صورة السجن وتجربة السجين هي نفسها باختلاف مواقع النظر إليها والمسافات السياسية والنفسية، والسياقات التي نجد أنفسنا فيها.
قد تتسم كتابتنا السورية عموماً بنقص المسافة النفسية، وهو أمر يتصل بقوة المثيرات الانفعالية ودوامها، بالصفة الراضّة لتجاربنا، وعُسر استقرار أنفسنا على نَسَق غير مُرتَجّ لها. تَرُجُّنا ولا تكف عن رَجِّنا أوضاعٌ عدوانية، تُبقِي كتابتنا، حتى حين نجتهد في أن تكون مُتروّية، منفعلةً بما يحدث حولنا ولنا، فلا تكاد تنفصل عن تجاربنا المباشرة وعناء أنفسنا. الصدمات، الترومات، تمنع انقضاء الزمن، تُبقينا مشدودين إلى زمن الصدمة، لا نكاد نبتعد عنه. فالمسافة في كل حال علاقة ثلاثية بين المُثيرات الانفعالية حولنا، شدة ومدة وتواتراً، وبين أنفسنا ودرجات تَمرُّسها بالتجارب القاسية، وبين الزمن. كلما كانت التجارب أقسى لزمت مسافة زمنية أكبر للتعافي منها، بخاصة إن لم نكن متدربين بصورة ما على قسوة التجارب. يشبه الأمر تطعيماً من أمراض مُعدية، قد تكون قاتلة إن لم نكن مُطعمين.
والمسافة في كل حال لا ترتد حصراً إلى بُعد زمني أو مكاني عن التجربة الأولى، وإنما كذلك إلى ترتيب للنفس مرتبط بنوعية التجارب وشدَّتها ومُدتها. ورغم تفاوت بيننا في هذا الشأن، يبدو أن الطابع العام لشغلنا الكتابي أقل تَجرُّداً وبرودة من كتابة نظرائنا في الغرب. وهذا لأن المثيرات الانفعالية أقل حدة وشدة ودواماً في مجتمعاتهم، والأنفس استقرّت على تَطبُّعات اجتماعية أكثر تجرداً، انضباط نفسي له تعبيرات جسدية أثناء الكلام والجلوس والحركة مغايرة للمتوسط عندنا. المسافة هنا أكبر. لكن ربما يعرض نظراؤنا الغربيون درجات من العصبية والتعصّب مهولة لو فقدوا التحكم ودخلوا في مِحَنٍ بلا مخارج كحالنا. وقد رأينا بالفعل عينات من التعصب القَبَلي وعنف الخطاب بعد موقعة «طوفان الأقصى» والحرب على غزة، ممن كانوا أكثر تَحكُّماً بأنفسهم قبلها.
وبخصوص النجاة، لا يبدو أن أحداً ينجو. فإذا صح أن معظم «الناجين» الذين كتبوا أشياء عن تجربة السجن يعيشون اليوم في المنفى، ربما جميعهم دون استثناء، فهل كنا ناجين بعد السجن إذن؟ الأمور نسبية. كنا ناجين لتونا من الأسوأ، السجن، لكن كنا مُجرَّدين من السياسة وحرية التعبير مثلما كنا في السجن تقريباً. بعبارة أخرى، لم تكن نجاتنا سياسية، كانت نجاة أفراد من بعض أقسى تجارب حياتهم، دون أن يكون لهذه النجاة قيمة عامة، ودون أن تكون قابلة للتعميم، أو أن تصير مشروعاً سياسياً. هذه نقطة مهمة، ومفادها أن النجاة حين لا تكون عامة لا تكون حقيقية. وهذا لأن الشرط الذي يثير سؤال النجاة، شرط الاعتقال والتعذيب والحرمان المديد من التعبير الحر عن الرأي، هو شرطٌ عام.
لكن أريد العودة إلى سؤال الكتابة في السجن ذاته، لماذا كانت ممتنعة؟ في المقام الأول، حالت الشروط السياسية نفسها التي قادتنا إلى السجن دون أن نُمثّل تجاربنا بحرية، ودون رقابة ذاتية، رقابة مضاعفة في شروط السجن. لقد استطاع كثيرون، وأنا منهم، تهريب بعض ما كتبوا في السجن إلى الخارج، لكنها كانت عملية محفوفة بالخطر غالباً، تدفع المرء إلى الموازنة بين العواقب المُحتمَلة وبين ما يعتقده من قيمة لعمله، وقلّما يرسو الخيار على الكتابة عن حياة السجن نفسها لاعتقادنا بأن هذه التجربة لن تهرب منا، ستكون معنا دوماً.
لكنها لم تكن كذلك. بعد الخروج من السجن ننغمس في حياة جديدة، ولعلنا نكبت تجربتنا السابقة، فيضيع منها الكثير.
وقد يعود الأمر في المقام الثاني إلى عدم ثقتنا بالقدرة على التعبير عن أنفسنا بصورة واضحة ومفهومة. جميع من كتبوا عن السجن ممّن أعرفهم لم يكونوا كُتّاباً قبله، ربما باستثناء فرج بيرقدار (وكان شاعراً شاباً على كل حال وقت اعتقاله)، الذي يبدو كذلك أنه كتب خيانات اللغة والصمت في السجن. عموم من كتبوا عن السجن صاروا كُتّاباً بعد السجن، أما في سنواتهم فيه فكانت خبراتهم الكتابية متواضعة، إن لم تكن معدومة.
وأخيراً فإن السجن كتجربة مَعيشة مختلف تماماً عن السجن كتجربة مُستحضَرة في الكتابة، متأخرة عن التجربة الحية سنوات. كتجربة معيشة، السجن تقييد واختناق وغمّ، خوف وارتعاد وقنوط، فقدٌ للحب والعائلة، إذلال متفاوت الشدة، عَوَز متعدد الأوجه، من عوز متفاوت إلى الطعام، إلى عوز المشي في الشارع، إلى عوز الحب، إلى عوز الحياة. نخسر في السجن سنوات من شبابنا وبعض روابطنا الاجتماعية، ونخسر أحباباً يرحلون. لكن السجن كتجربة مُستحضَرة في الكتابة أشبه بقصة نجاة ونجاح كما تُقدَّم، تقرير شخصي عن معاناة مُنقضية، أخذت تبدو كثمن مقبول للنجاة، وهذا حتى حين نذكر فيما نكتب معظم أوجه العوز والفقد المشار إليها للتو.
في عين «الناجي»
الكتابة عن السجن بعد السجن بسنوات تجنح إلى أن تُزيل شوك التجربة وقسوتها، وإن – مرة أخرى – عبر إدراجها في قصة نجاة ونجاح، يشهد عليها نشر الكتابة ذاته. يبقى منها أثرها علينا بعد السجن. وبقدر ما إننا ناجون بصورة ما، فسيبدو السجن ما قبل النجاة ملحقاً بها ومنسوباً إليها، بل ومؤدياً إليها، ما يضفي على تلك التجربة المتجاوَزة قيمة نسبية. فكأننا نقيم استمرارية لا انقطاعاً بين السجن وما بعده، ندرج السجن في سير حياتنا، فيكفُّ عن كونه ضياعاً، خسارة، عبثاً. ولعل هذا ينطبق على كتابي، بالخلاص يا شباب، أكثر من غيره. فقد تكلّمتُ على السجن كطفولة ثانية، وعلى أنه كان تجربة انعتاق عبر «الاستحباس» والتعلّم والتغيّر الشخصي. سيبدو بالتالي أن السجن الذي قضيت فيه سنوات شبابي كان «أماً ثانية»، وأني مَدينٌ له بتحرّر ما. هذا لا يطابق تجربتي الفعلية في السجن، وقد تقْتُ بطبيعة الحال لانقضائها طوال الوقت، وكانت مؤلمة بصور متعددة، فضلاً عن أنها ابتدأت بتجربة تعذيب صادمة، وانتهت بعام مُعذِّب في سجن تدمر. لكن ما قلته في الكتاب هو بمثابة محصلة مجملة لتلك التجربة، كتبها شخص لم تتعثر حياته وقت كان يكتب الكتاب، أي بعد السجن بسنوات، تَعثُّراً كبيراً. بل لعله كان يتحكم بها لأول مرة في حياته. كان الكتاب دفاعاً عن الفاعلية الذاتية وتأكيداً لها، رغم الهزيمة السياسية العامة. ولعله من هذا الباب أضفى النسبية على معاناة ماضية، أو حتى أسبغَ صفة رومانسية على تجربة السجن. وهذا بالرغم من أني عملتُ في الكتاب على نزع الرومانسية عن المعتقل السياسي والمساهمة في تحطيم صورته المُأسطرة والمُؤمثلة، على نحو ما رسمتها كتب وروايات سابقة، كتبَ معظمها روائيون محترفون.
كان كتابي جهداً لإضفاء المعنى على تلك المعاناة، على نحو يُدرِجُ سنوات السجن القاسية في حياتي كمرحلة عضوية، أو كجزء من رحلة حياة واحدة متعددة الأطوار والامتحانات والبدايات. المعاناة كانت مُحقَّقة، لم نسعَ وراءها من أجل المعنى الذي قد يَتولَّدُ منها، وإن يكن بعضنا، أو كلنا، خلبت لبّهم قبل سنوات السجن أسطورة المعتقل السياسي. هذه الأسطورة تبخرت على حرارة التجربة الفعلية. وحين كتبنا، كان ثمة معاناة مُحقَّقة وراءنا، يمكن أن نختار أن تبقى صامتة، أو نستخلص منها معانٍ عامة تخاطب غيرنا وربما تسهم في بناء مجتمع عناية صغير.
ما أتحفّظُ عليه اليوم في تمثيلي لتجربة السجن يتصل بما هو مُضمَر في ذلك التمثيل من استنفاد المعاناة في المعنى الذي أعطيته لها؛ الانعتاق من سجون أخرى داخلية، وفي ميلي الثابت إلى نسبَنة قسوتها، وإنكار أو التخفيف من وقع الخسارة والضياع وما لا يُعوَّض. لقد أردتُ أن أُقيمَ استمرارية بين سنوات السجن وما بعدها، ما اقتضى نفي القطعية والتمزّق والضياع، وما أنتج رومانسيته الخاصة، حتى وهو يعترض على رومانسية صورة المعتقل السياسي.
اعترضتُ في الكتاب بقوة على فكرة السجن الكبير التي كان رياض الترك قد استخدمها في فيلم ابن العم لمحمد علي الأتاسي. بدت لي العبارة إهانة لتجربة السجن نفسها بمحو الفرق بينها، وهي ما هي عليه من قسوة، وبين حياة خارج السجن تُوفِّرُ، مهما تكن متعثرة، فُرَص حركة وعيش أوسع بما لا يقاس. وأُقدِّرُ أنها عبارة جارحة إذا أُتيحَ لمعتقل اليوم أن يقرأها في صيدنايا أو عدرا، معتقل يحلم بأن يخرج إلى السجن الكبير المزعوم. حيث أمكنَ لكاتب أن يكتب من السجن، مثل الكاتب والمناضل المصري علاء عبد الفتاح قبل أن يتعرض لاعتقال في الاعتقال عام 2019 ويُحرَم من الكتابة، فقد استاءَ من هذا التعبير. الأمر يُشبه أن تقرأ عن المنفى الباريسي أو البرليني بينما أنت في السجن، أو حتى في «المنفى الداخلي» (وسيجري تناول هذه الاستعارة الثانية أدناه).
لكن من وجهة نظر المثال السياسي الذي كنا نصبو إليه، حياة سياسية حرة، لا ريب أن استعارة السجن الكبير أكثر مُطابقةً. فلم تكن لنا حقوق سياسية في بلدنا، وكان أكثرُنا بلا جواز سفر، وممنوعين من المغادرة، يحكمنا النظام نفسه، ونضطر لممارسة أشكال متنوعة من الرقابة الذاتية للاستمرار في الحياة والكتابة، وهو ما يؤول على مدى أطول إلى تَبنيُنِ التزييف في كتابتنا أو تَحوُّل الرقابة الذاتية، وهي استبطان للرقابة الموضوعية (أي بنية النظام)، إلى تَكيُّف مع الأسوأ. تَكيُّف قد يُقاوِم الإقرارَ به بشراسة من يقال لهم أنهم متكيفون مع ما لا يُطاق، لأنه يُظهِرُ عملية التزييف الذاتي التي يقومون بها. تَرِدُ إلى البال أمثلة متعددة على هذا المسلك، ممارسو رقابة ذاتية صار النظام جزءاً عضوياً منهم ومن عالمهم، فلا يراد له أن ينهار لأن عالمهم ذاته يمكن أن ينهار بفعل ذلك. هذا أسوأ من سجن. إنه سجن ذاتي يحدث أن يكون أكثر عدائية للحرية من السجن الموضوعي.
لاستعارة السجن الكبير صلة بالنجاة والتعريف السياسي للنفس. رياض الترك عاد فوراً إلى العمل السياسي بعد نحو 18 عاماً من الاعتقال العرفي. العيش خارج السجن في سورية وقتها، وإلى اليوم، ليس نجاة لمن ينشطون سياسياً. إنه أقرب إلى نجاة بقدر ما لا نكون سياسيين، وقد يكون نجاة كاملة فقط في نظر أولئك الذين ابتعدوا كلياً عن أي نشاط سياسي بعد خروجهم من السجن.
الكاتب المصري أحمد ناجي يستخدم في كتابه حرز مكمكم استعارة السجن الكبير في وصف مصر بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجن، وكان بلا جواز سفر لبعض الوقت بعد خروجه منه. كنتُ في منزلة بين المنزلتين، أكثر إيجابية حيال الحياة خارج السجن فلا تبدو لي سجناً كبيراً، ولكن في موقع منازع للأوضاع العامة بأدواتي الجديدة، الكتابة أساساً.
عدتُ إلى اعتبار السجن الكبير استعارة مناسبة من مدخل تحليلي. إذ لمّا كان السجن علاقة سياسية أساسية في «سورية الأسد»، أو هو الشكل النموذجي لعلاقة السلطة في الحقبة الأسدية، فإنه، أي السجن، هو «سورية الأسد» الصغيرة، و«سورية الأسد» هذه هي السجن الكبير. «سورية الأسد» ليست سجناً مكانياً كبيراً فحسب، بل هي سجن زماني مستمر، يُعوِّلُ كبار السجانين فيه على أن يكون أبدياً، مثل «سجن عُرفي» لا ينتهي. بل إن سورية سجن مكاني كبير لأنها سجن زماني لا ينتهي.
في شباط (فبراير) من هذا العام، 2023، واتاني الحظ أن ألتقي السيد كانغ جونغ هون، وهو معتقل سياسي سابق في كوريا الجنوبية، ينحدر من الأقلية الكورية في اليابان. كان كانغ قد ذهب إلى وطنه الأم في السبعينيات للدراسة هناك، وبعد عامين اعتقله نظام الدكتاتورية العسكرية آنذاك بتهمة باطلة: التجسس لمصلحة كوريا الشمالية، وتعرَّضَ للتعذيب الشديد، ثم حُكِم عليه بالإعدام قبل أن يُخَفَّف الحكم إلى عشرين عاماً، ويُفرج عنه بعد 13 عاماً. بعد تحريره بسنوات، وبعد سقوط الدكتاتورية، عاد كانغ لزيارة كوريا الجنوبية، حتى أنه زار سجنه الذي تَحوَّلَ إلى متحف. كانت زيارة السجن مع أصدقائي حلماً من أحلامي، لأن السجن لا يخرج منك إلا بعد أن تزوره حراً وتخرج منه حراً، تذهب بعدها إلى مطعم أو مقهى، وتتباسط مع أصدقائك. من شأن ذلك أن يكون جهداً للشفاء، علاجاً نفسياً وسياسياً يطلق سراح الماضي الذي كان حبيساً في داخلك. هذا بالضبط ما فعله السيد كانغ، على ما روى لي بعد ندوة تَشاركنا الكلام فيها عن سجوننا في مدينة كيوتو في اليابان. علاقة الرجل بالسجن مختلفة. فيما يخصه، صار السجن تاريخاً، مرحلة مُنقضية من عمره ومن تاريخ بلده في آن. فيما يخصني، ليس السجن كذلك. إنه بنية وليس مرحلة، وهو علاقة مستمرة، وليس وضعاً مضى وانقضى. ثم هو بعد ذلك «الوطن»، وليس مساحات ضيقة معزولة ومسوّرة منه. كوريا الجنوبية ليست اليوم سجناً كبيراً للسيد كانغ أو لأي من مواطنيها، سورية لا تزال كذلك. لو سقط الحكم الأسدي أو انطوت صفحته بصورة ما لكفّت سورية عن كونها سجناً كبيراً لمن خبروا سجونها الصغيرة المديدة، المفتوحة الشهية دوماً.
تَوافَقَ تَحرُّرُ كانغ من السجن الصغير مع تَحرُّر كوريا الجنوبية من شروط السجن الكبير. هذا لم يكن حالَ ألوف المعتقلين السياسيين في سورية. ما يعطي أكبر وجاهة ممكنة لفكرة السجن الكبير هو أننا خرجنا في ظل النظام نفسه، دون أن يكون ذلك أحد أوجه تحرّر جمعي ووطني. الخروج من السجن طيبٌ في كل حال، لكن لا يكون الفارق نوعياً إلا إذا انطوت معه البنية السجّانة.
والقصد هو أنه لا ينبغي لتأكيد عبارة السجن الكبير أن يُفهَم حصراً كنسخ للاعتراض السابق على العبارة. المسألة مسألة موقع ومنظور، على ما تَقدَّمَ ذكره، وما يحاول توضيحه مثال السيد كانغ. فمن موقعٍ في السجن، ومن منظور التطلّع إلى الخروج منه، لا يمكن للعبارة أن تكون مقبولة، لكنها تحوز وجاهة أكبر من موقع خارج السجن، وبخاصة من منظور النضال السياسي من أجل طي صفحة السجن والتعذيب كعلاقة سياسية أساسية.
في عين «المنفي»
الموقع الثالث للتفكير في السجن هو المنفى، حين «تُحبَس» خارج بلدك فلا تستطيع العودة إليه. هنا نحن متحررون كلياً من الرقابة الذاتية والموضوعية فيما يخص شؤون بلدنا. وهنا في الواقع تبدو عبارة السجن الكبير في وصف بلدنا وجيهة أكثر، أقلّه لأننا ننعم بحريات في المنفى هي ما تَعثَّرَ نضالُنا كل التعثُّر لننعم بما يقاربها في بلدنا. وبصورة ما، تبدو صورة البلد من المنفى أقرب إلى صورة السجن من صورته من داخل السجن ذاته، وأبعد عن صورته من موقع «الناجي» المزعوم داخل البلد.
هل يعود الأمر فقط إلى زوال الرقابة الذاتية، إلى النظر إلى الواقع بعيون مجلوّة دون عدسات تُزيّف الرؤية؟ أم ربما بميل إلى إغراق واقع سيء بسوء متجانس غير واقعي؟ قد يكون أخطر خلل معرفي يصيب المنفيين هو فقدان حسّ الواقع، الميل إلى الإجمال بخصوص واقع بلدهم، بناء صور عامة قليلة التفاصيل لأن التفاصيل غير مُتاحة، ولأن المنفي ربما يشعر بذنب أقل إن كان الواقع الذي بارحه سيئاً جداً، غارقاً في سوء أسود بلا ألوان وتَدرُّجات.
في سنوات سجني، كانت كلمة المنفى، بخاصة في أوروبا، تبدو أقرب إلى سخرية ممن هم في البلد، يتطلع بعضهم على الأقل إلى أن يُنفوا منه إلى أوروبا. حتى إذا اضطروا بالفعل إلى ترك البلد، مثلما حدث لملايين السوريين، بذل كثيرون منهم كل الجهد من أجل الاستقرار في أوروبا. ولو بقي الباب مفتوحاً مثلما كان عام 2015، لربما أقام في أوروبا معظم الموالين للنظام ومعظم معارضيه في آن، ولما بقي فيه ربما غير بشار الأسد والمخابرات وقوى الاحتلال الأجنبي (ألا يمكن تَصوُّر حل سوري على هذه الأرضية الافتراضية لـ«سورية الخارجة»، أو التي في المنفى؟).
الأسباب نفسها التي تجعل من سورية سجناً كبيراً تجعل من السوريين غرباء في بلدهم، منفيين داخليين. لماذا نزلاء «السجن الكبير» منفيون داخليون وليسوا سجناء فحسب؟ لأن التعبيرين مترادفان حين يتعلق الأمر بالسجن الكبير، تُوحِّدهما الغربة السياسية والحرمان من الحقوق. كان تعبير المنفيين الداخليين، أو المهاجرين الداخليين، قد أُطلق على مثقفين ألمان التزموا الصمت في الحقبة النازية، أي نفوا أصواتهم أو هاجروا إلى الصمت، لأنهم لا يستطيعون قول ما يريدون قوله، ولم يشاؤوا قول ما يمكن قوله، أو بالطبع ما لا يريدون قوله. في سورية، كنا نتدبر أمرنا بصور مختلفة، تتراوح بين الصمت وبين استبطان الرقابة حتى تتعضّى في البعض، مروراً بمحاولات توسيع الهوامش ونطاقات ما يمكن القول فيه. شرط المنفى الداخلي مُحقَّق، وإن تكن استراتيجيات المنفيين الداخليين متفاوتة. فإذا طُرح اليوم سؤال عن الاستراتيجية الأنجع: مرواغة الرقابة داخل البلد، وتوسيع مساحات ما يقال وتسمية أشياء أكثر بأسمائها؛ أم التحرر الكلي من الرقابة، وتسمية جميع الأشياء بأسمائها، لكن خارج البلد؟ إذا تساوت الأمور الأخرى، أميلُ شخصياً إلى تفضيل الخيار الأول. فرغم ما ننعم به من حرية هنا، إلا أنه قلّما يكون لها قيمة عامة فيما يخصّ قضيتنا.
إلا أن الخيار الأول، مراوغة الرقابة وتوسيع مساحات القول والتسمية، ليس مضموناً ولم يكن يوماً مضموناً، وحين يحظى به أفراد بفعل شهرتهم أو ما يحظون به من رساميل رمزية، فعبر استثنائهم من القاعدة العامة التي تَحرمُ عموم مواطنيهم من حرية التعبير. وإلى ذلك قلّما تتساوى الأمور الأخرى بين المنفى والوطن، ومن أهمها في سياقنا هذا فُرَص التعلم، أو حتى الحصول على كتب والمشاركة في نقاشات وأنشطة عامة.
لا أعرف كيف كان يمكن لكتابي عن السجن أن يتغير لو كتبته دون أدنى رقابة ذاتية، ودون وهم الناجي. لعله كان سيُشبه، بصورة ما، كتب زملاء من جيلي، مثل معبد الحسون ومحمد برّو، كتبا بعد الثورة السورية وفي المنفى عن تجاربهما في الثمانينيات والتسعينيات، وليس في سورية بعد الخروج من السجن. كتاباهما ممتازان بالفعل، وهو ما يعود بقدر ما إلى التحرُّر من الرقابة الذاتية، ولكن كذلك إلى أن تجاربهما في سجن تدمر تفوق في الشدة تجربتي وتجربة معظم رفاقي.
في عين حرّة
كتبت هذه المقالة بغرض مُحدَّد: صورة السجن تختلف بحسب موقعنا منه، في السجن نفسه، بعده في «السجن الكبير»، بعده في المنفى. هناك موقع آخر، رابع، لم تتطرق إليه هذه المناقشة إلا بالإحالة إلى بلد آخر، بعيد: كوريا الجنوبية. يحتاج الأمر إلى خيال كي نتصور كيف سيُكتَب عن السجن الصغير إذا انطوى شرط السجن الكبير. السجن الكبير ليس موازين قوى سياسية فقط، وإنما هو بالقدر نفسه موازين قوى كتابية، تُعطي لكَتَبة التزييف ومُمارسي الرقابة على غيرهم قوة لا تنبثق من أي منطق كتابي مستقل، قوة مُشتقة من السلطة المخابراتية. إلى حين قد تُروى القصة الكاملة ذات يوم للرقابة وللرقباء في سورية، يحتاج المرء إلى تخيُّل كبير من أجل الاقتراب من تصور ذلك.
وجلُّ ما قد يأمله من عملوا منا للتحرّر من الطغيان والحكم السلطاني الوراثي هو أن يُنظَر إلى عملهم بعد انطواء الطغيان كمساهمة في التحرر وكشهادة على الصراع من أجله. من شأن ذلك أن يكون شفاء حتى لو جاء بعد انطواء صفحتنا نحن، غيابنا من الحياة. فكأن وطننا، عندها، هو الذي يزورنا بعد أن تعذَّرَ علينا نحن أن نزوره، أو كأنه خرج من حبسه ويعمل على إخراجنا من حبسنا خارجه.
«الوطن»
ليس من أغراض هذه المقالة الكلام على سورية والسوريين عموماً. لكن لعلَّ ما تقدَّمَ يصلح مقدمة من نوع ما لقول شيء محدد عن مفهوم الوطن: سورية هي ما تُحيل إليه ملايين القصص غير المكتملة، وعنوان لاكتمالها المحتمل. «الوطن» يعني لي، ولعله يعني لآخرين، اكتمال القصة. لدي قصة أريدُ اكتمالها، وهي لم تكتمل في تركيا ولا تكتمل في ألمانيا، ولن تكتمل في أكثر من 190 بلداً آخر في عالم اليوم. لا أجد تعريفاً للوطن أنسب من كونه مكانَ اكتمال القصة بعد أن كان بدايتها العارضة.
وهذا التصوُّر ذاته مبنيٌ على ملاحظة ذاتية صلبة: لا أستطيع أن أكتب عن سنواتي في «المنفى»، عن تعثراتها وتلعثماتها وأخطائها، وعن تعلمي وتغيري فيها، مثلما لم أستطع أن أكتب عن سنواتي في السجن وأنا سجين. لزم أن أخرج من السجن كي أكتب عنه، ويجب أن أخرج من المنفى كي أكتب أطرافاً من قصتي فيه. وليس هناك غير مكان واحد يمكن فيه الكتابة عن سنوات المنفى هذه التي جاوزت اليوم عشراً، فأكمل قصتي؛ مكان واحد «ينفي المنفى» بالفعل، سورية.