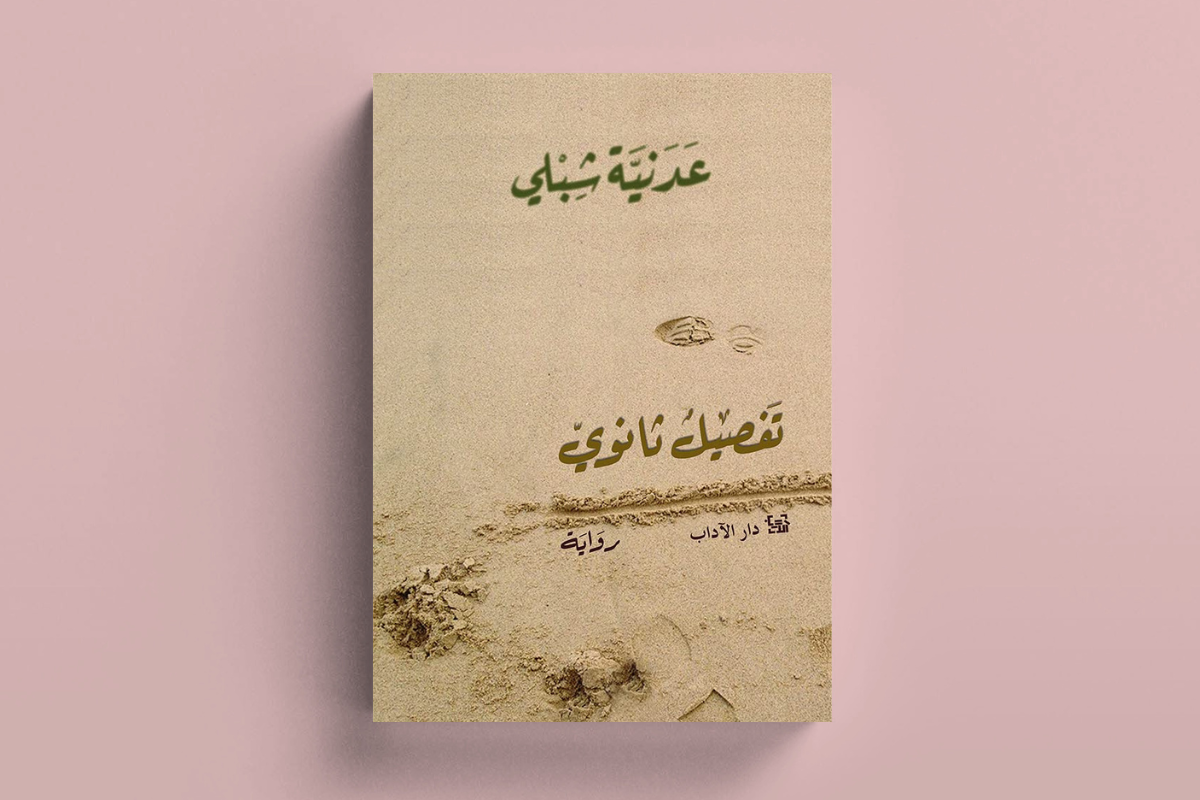لست أنت من سيتكلّم؛ دع الكارثة تتكلّم فيك، ولو بالصمت، ولو بالنسيان
موريس بلانشو، كتابة الكارثة
تتناول رواية تفصيل ثانوي (دار الآداب، 2017) للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جريمة اغتصابٍ وقتل، قامت بها كتيبة إسرائيلية بحق فتاة بدوية في النقب في العام الأول على النكبة، وكيف أُسقِطت تلك الحادثة من سردية الاستعمار الكبرى التي تنقُلها مؤسسات الذاكرة الرسمية. تتقصّى الراوية الفلسطينية المعاصرة تفاصيل تلك الحادثة دون جدوى، فستستقرّ الكارثة طيفاً يسكنُ جسدها ويعيث فيه خراباً.
لاقت الرواية موجةً من الترحيب في الأوساط الأدبية العالمية، بدءاً من وصولها إلى القائمة الطويلة لجائزة بوكر الدولية التي تمنحها مؤسسة مان بوكر في لندن، وليس انتهاءً بترجمة الرواية إلى أكثر من إحدى عشرة لغة أوروبية وعالمية. إلا أن الرواية لم تُترجَم إلى العبرية بعكس العديد من الروايات العربية الأخرى، لا سيّما تلك التي تتناول النكبة، ربما للأسباب نفسها التي دفعت منظّمي معرض فرانكفورت لإلغاء الحفل الذي كانت ستُمنح فيه عدنية شبلي جائزة ليتبروم الألمانية المخصصة لكاتبات من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والعالم العربي. برّر منظّمو المعرض إلغاء الحفل بـ«الإرهاب الهمجي الذي شنّته حماس على دولة إسرائيل»، فارتأوا «وبشكل عفوي، أن يخصّصوا مساحة المعرض للأصوات الإسرائيلية». على عكس ما أشيع، جاء ذلك القرار دون موافقة عدنية شبلي.
أثار تعليق حفل تكريم شبلي، كما التهافت الذي لحقه في الصحافة الألمانية، عدداً من المواقف الداعمة للروائية؛ كالرسالة المفتوحة التي وقّعها المئات، بينهم مترجمو عدنية شبلي وناشرو ترجماتها، كما البيان التضامني لمئات العاملين في الحقل الثقافي العربي والعالمي، بالإضافة إلى انسحاب كتّاب عرب من فعاليات المعرض احتجاجاً على الممارسات القمعية التي تحجب الروائية الفلسطينية كما سردية روايتها.
ليست تفصيل ثانوي رواية عدنية شبلي الأولى، وبالتأكيد ليست أولى الروايات العربية المترجمة التي تتناول سردية النكبة وتداعياتها. فلمَ تُقلق الرواية الحقل الثقافي الأوروبي الداعم لإسرائيل إلى هذا الحدّ؟
الجريمة مسرحاً
تستهلّ عدنية شبلي تفصيل ثانوي بالخراب والمراقبة. نحن في صحراء النقب، و«لم يكن هناك ما يتحرّك ما عدا السراب». المكان قد صُفّي من البشر، عدا ضابط إسرائيلي يحمل منظاراً يشرف من خلاله على التلال ليتأكّد ألا متسللين عرباً يحاولون استعادة منطقة لم يبقَ منها سوى بعض الأطلال، التي هي أيضاً قيد الزوال. يدعو الضابط جنود الكتيبة إلى اجتماع، فيتلو عليهم خطاباً فيه كل ركائز العقيدة الصهيونية: أرض بلا بشر، لبشر بلا أرض؛ ضرورة العمل والزراعة في سبيل تأهيل المساحات الصحراوية؛ وشرط مواصلة الكفاح المسلّح لصون مكتسبات الدولة الصهيونية الناشئة. في صحراء النقب التي أُخليت من البشر سردية إيديولوجية جديدة، وهناك سلاح يحميها.
في هذا الجزء من الرواية وصفٌ دقيق ومُركَّز لحركة الضابط داخل المعسكر وخارجه، وتمعُّن في تفاصيل جسده. وإن كان الضابط سيّد المكان وآمره، إلا أنه سيبقى مرتاباً من العالم الطبيعي الذي يبدو وكأنه مصدر خطر دائم عليه. يتصبّب الضابط عرقاً تحت شمس آب (أغسطس) الحارقة التي لم يكن قد اعتاد عليها بعد، ويحاول التغلُّب على ضيقٍ في نفسه من غبار الرمال الصحراوية والزوابع الرملية. تبدو الصحراء خالية من سكانها، ولكن رغم ذلك، لا مساحة آمنة للضابط الذي يلاحقه كلب ينبح بعصبية، وتلدغه الحشرات والنمل والعناكب التي لا يلبث أن يبيدها مزهواً، منتصراً. ولو أن أهل النقب قد هُزموا، إلا أن الطبيعة ستنتصر على الضابط الذي يتعرّض للدغة كائن صحراوي سيشلّ حركته ويجعله يرتجف من الألم.
يأتي بورتريه هذا الضابط بلسان راوٍ دقيق، يصف المشاهد، كما حركة الضابط وجنوده دون انفعال أو توصيف لحالتهم الشعورية، وذلك بنبرة منسحبة، باردة ورتيبة. الراوي المدرك للّحظة التاريخية التي يسردها، يسلسل التواريخ التي تقع فيها الأحداث، فنعرف مثلا أننا بين 9 و13 آب سنة 1949، أي بعد سنة واحدة على النكبة.
تُحيلنا جميع عناصر الجزء الأول من رواية «تفصيل ثانوي» إلى لغة التحقيقات الجنائية الباردة، الموكّلة بمهمة استحضار حيثيات زمنية وجغرافية وبشرية لجريمةٍ سيعرف القرّاء أنها لا بدّ أن تقع قريباً. وهكذا كان يعثر الجنود على «نفر من العرب» حول نبع قريب من المعسكر، فيطلقون الرصاص عليهم، قبل أن يسمعوا نحيباً مكبوتاً لفتاة «تكوّرت كخنفساء داخل ثيابها السوداء» (ص.26). لا الراوي ولا الجنود الطارئون على المكان يعرفون اللغة التي تتحدّث الفتاة بها، إلا أن الراوي يصف مشهد انتهاء الفتاة بين يد الضابط الإسرائيلي بدقته وأمانته المعهودتين:
التفت هو أخيراً إلى الكتلة المتكوّرة السوداء التي ما زالت تئنّ، ثم غار عليها ممكساً بها بكلتا يديه وهزّها بقوة، فعاد نباح الكلب يعلو، بينما ازداد علوّ نحيبها هي ليختلط بنباحه، فدفع برأسها نحو الأرض، مطبقاً يده اليمنى على فمها، والتي التصقت بها لزوجة اللعاب والمُخاط الذي سال من أنف الفتاة والدموع في عينيها، كما اجتاحت رائحتها أنفه، مُجبرة إياه على أن يدير رأسه إلى الناحية الأخرى. لكنه ما لبث أن عاد واستدار نحوها، قبل أن يقرّب يده الثانية من فمه واضعًا سبابته على شفتيه، محدّقًا في عينيها مباشرة. (ص.27)
ستصبح الفتاة البدوية أسيرة لدى جنود المعسكر تحت قيادة ضابط يطارده كلب لا يتوقّف عن النباح والنواح. يتململ الجنود من رائحة الأسيرة، فيمزّقون ثيابها ويدلقون على شعرها الوقود وعلى جسدها العاري الصابون والماء كي ينظّفوها من عرقها ورائحة خوفها. بعدها، سيقصّون شعرها ويُلبسونها بزّة عسكرية إسرائيلية، من دون أن يُسمَع لها صوت إلا نحيب مكتوم.
تكتمل جميع عناصر الجريمة في ما يبدو وكأنه تقرير جنائي: قرب معسكر بناهُ جنود إسرائيليون في صحراء النقب بعد سنة واحدة على قيام دولة إسرائيل، وعلى أطلال مخيم للبدو قُتِلت غالبية سكانه، أسرَ عناصر كتيبة من الجنود الإسرائيليين امرأة بدوية وتعدّوا عليها، ثم أمر ضابط الكتبية بغسلها بالصابون والماء والكاز، وعاد واغتصبها، قبل أن يأمر جنوده بأن يحفروا لها حفرة ويقتلوها ويدفنوها فيها.
في الجزء الأول من «تفصيل ثانوي» مسحٌ لمسرح جريمة فيه جثةٌ وفيه جانٍ وفيه شهود، إلا أن لا صوتاً مسموعاً للضحية، وبالتالي لا رواية لها.
التقصّي منهجيةً
يقفز الجزء الثاني من الرواية فوق سبعة عقود، وصولاً إلى اللحظة المعاصرة. نحن في رام الله والمشهد، كما في 1949، مشروط بالخراب والمراقبة. دورية إسرائيلية تطارد ثلاثة نشطاء فلسطينيين، فتُحاصر المبنى الذي يحتمون فيه قبل أن تبدأ بتفجيره. تسرد راويةٌ مجهولةُ الاسم وقائع المطاردة ثم التفجير، دون أن تكون معنية تماماً بعنف الأحداث التي تقع أمامها. فالراوية مأخوذة بمقال في صحيفة عبرية يسترجع «حادثة» وقعت مع كتيبة عسكرية إسرائيلية خسرت جنوداً في مواجهات مع القوات المصرية في النقب عام 1949. يُشير المقال إلى مقتل فتاة بدوية في سطر واحد يتيم. إلا أن مفارقةً غريبة تلفتُ الراوية: لقد وُلدت في الشهر واليوم نفسه الذي قتلت فيه البدوية، وهذا تفصيل كفيل بأن يسحب الراوية من محيطها ويجعلها معنيّة بهذا الحدث الذي يقع على هامش السردية الإسرائيلية الرسمية. تقول:
هذا التفصيل الثانوي الذي لا يمكن إلّا أن يستهين به الآخرون، سيلازمني إلى الأبد رغماً عني ومهما حاولت تناسيه، حيث ستبقى حقيقته تعبث بي بلا انقطاع، لما فيّ من ضعف وهشاشة…وربّما حقاً لا يوجد هنالك ما هو أكثر أهمية منه، هذا التفصيل الصغير، في سبيل الوصول إلى الحقيقة الكاملة التي لا تكشف عنها تلك المقالة بإغفالها رواية الفتاة (ص. 73).
ماذا حصل للفتاة البدوية يومها إذن؟ ولو تمكّنت من سرد قصتها، ماذا كانت لتقول؟
تُقرّر الراوية المتأثّرة بنقطة التلاقي مع الفتاة البدوية تقصّي مصير الفتاة وملابسات موتها. تبدأ تقصّياتها بالاتصال بالصحفي الإسرائيلي الذي نشر الخبر ولكنها لا تحصل على أي معلومة مفيدة، لأن التفصيل الثانوي لا يهمّ الصحفي الذي كتب المقالة، فهو معنيّ بنقل السردية الأساسية عن كيف استبسلت القوات الإسرائيلية في معركة دفاعها عن الأرض بوجه الجيش المصري. تدرك الراوية أن عليها البحث أولاً في أرشيف الجيش الإسرائيلي خارج تل أبيب، وثانياً في أرشيف المستوطَنة التي وقعت فيها الحادثة في النقب.
تعبر الراوية حاجز قلنديا وتدخل الأراضي الإسرائيلية مستعينة بهوية إسرائيلية استعارتها من صديقتها مراهِنةً على أن الجنود الإسرائيليين عاجزون عن التمييز بين وجوه الفلسطينيات. في يافا، تزور الراوية أرشيف الجيش الإسرائيلي الذي يحرسه العسكر، وتشاهد فيلماً وثائقياً عن بناء المستعمرات في الثلاثينيات والأربعينيات. يوثّق الفيلم الدعائي حياة المهاجرين اليهود الأوروبيين واحتفاءهم بالبناء والزراعة. تلتفت الراوية إلى أحد هذه الأفلام حيث يظهر المستعمرون وهم يبنون برجاً خشبياً، لوحة خشبية تلو الأخرى، حتى يكتمل البناء. عندها، يتحلّق المستوطنون ويبدأون بالرقص، يداً بيد، بمرحِ من تمكّنَ أخيراً من تطويع الطبيعة والبشر. التنافر المعرفي في ما يبديه هذا المشهد من فرح وتكاتف وما يكتنزه من عنف معنوي وإيديولوجي سيدفع الراوية إلى وضع إصبعها على الشاشة، فتُعيد المشهدَ إلى الوراء وتُحدّقُ به على عكس تسلسله الزمني، وتعيد الكرّة:
عندها، يبدأ المستوطنون بفكّ حلقة الرقص والرجوع إلى السقائف التي انتهوا من بنائها للتوّ، ويأخذون بتفكيكها وبتحميلها فوق العربات، ثم يخرجون من الكادر. أعود وأقدّم الشريط إلى الأمام ثانية. ثم أرجعه إلى الوراء. مرة تلو الأخرى أبني المستوطنات ثم أفكّكها (ص. 92)
«أبني المستوطنات وأفكّكها». تدرك الراوية فجأة أن التكنولوجيا البصرية قد وهبتها سلطة تكاد تكون إلهية على الدعاية الاستعمارية، فتتلذّذ بإرجاع الفيديو إلى نقطة البداية، تفكّك مستوطنة، ولو لبرهة، وتعبث بالتسلسل التاريخي الذي أدّى إلى الزمن المعاصر الذي تسكنه اليوم. تعبث الراوية بالأزمنة فتلغي، ولو مجازياً، ولو في خيالها فقط، أثر سبعة عقود من الكارثة.
في رحلتها الاستقصائية عن رواية الفتاة البدوية، على الراوية الفلسطينية أن تتخطّى مستوى إضافياً من العوائق المعرفية، لا سيما في تنقّلها عبر مساحة الجغرافيا الاستعمارية. في أي قرية فلسطينية ممحوّة هي بالضبط؟ وكيف تصل إلى مسرح جريمة انمحى بالكامل؟ تحمل الراوية خريطة إسرائيلية وأخرى لفلسطين التاريخية، فتزعزع الادعاءات الإيديولوجية لإسرائيل من خلال الإشارة إلى أن الأرض كانت مأهولة وأن لها تاريخاً سابقاً للاستعمار. كيف يمكن للراوية الوصولُ إلى مسرح الجريمة إن كان الأرشيف الرسمي، كما خريطة إسرائيل الرسمية، يحجبان الحقيقة؟
تُواصل الراوية الفلسطينية استقصاءاتها في النقب، فتصل تحديداً إلى مستوطنة نيريم القريبة من موقع الحادثة، والتي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الحدود الجنوبية لقطاع غزة. يخبرها أمين أرشيف المستعمرة أنه كان في المستعمرة عام 1949 وأنه يتذكّر حادثة مشابهة لامرأة بدوية قتلها ذووها، ودفنوها في بئر مجاور، كما في عادتهم أن يفعلوا مع نسائهم. لا حقيقة في الأرشيف الاستعماري، إذن، ليس لأنه يخفي الوقائع فحسب، بل لأنه يعمد على تشويهها، وتشتيتها، وخلق سردية مضادة تحجب الحقيقة وتعيق سردها.
يُقفَل الأرشيف الصحفي، ثم العسكري كما الاستيطاني، في وجه الراوية التي باتت تؤدي دور المحققة الجنائية، ليس لسبب سوى أنها ولدت في التاريخ نفسه لمقتل البدوية. ستدرك الراوية أنها لن تتمكّن من سرد قصة الفتاة البدوية لأن الأرشيف ليس إلا زيتَ الآلة الاستعمارية وقشرتها الإيديولوجية التي تشلّ المعرفة وتُعطّلها.
في ظلّ زيف الأدوات المعرفية الاستعمارية، كيف يمكن للراوية أن تتواصل مع قرينتها البدوية وتسمع قصّتها؟
الكارثة أطيافاً
منذ بداية سردها للأحداث التي شهدت عليها في رام الله، وصولاً إلى لحظاتها الأخيرة في مستوطنة نيريم، والراوية تتحدّث عن عجزها عن التآلف مع منطق الحدود. تعترف بأنها لا تعرف حدوداً لانفعالاتها في التواصل اليومي، وأنها قليلاً ما تشعر بالخطر فتقترب منه بإغفالٍ أخرق، وأنها غالباً ما تجازف عبر الحدود التي تحرسها معابر وحواجز إسرائيلية. استخفاف الراوية بمنطق الحدود يدفعها إلى التنقُّل بين رام الله وحيفا وصحراء النقب ببعض الورع وكثير من السهولة، هي الكائن الشفاف الذي يمرّ دون أن يُرى، يتنفس دون أن يصدر صوتاً، وكأنها إحدى الكائنات الصحراوية المتآلفة تاريخياً مع المكان، والتي يشكّل وجودها خطراً على محتلّيه الجدد.
وكأنَّ ما يدفع الراوية نحو الحدود، الحدود الجغرافيّة والحدود العسكرية، والأهم حدود إدراكها لماضيها بوصفها قرينة الفتاة البدوية القتيلة، هو طيفٌ قد أحكم السيطرة على جسدها وصار يتحكّم بحركتها.
يشكّل سرّ موت الفتاة البدوية، كما وجعها وصدمتها، كياناً شبحياً، طيفاً، يعود ليُقلق حياة القرينة المنقطعة عن ماضيها. تقوم الأطياف من أنقاض الأسرار المكبوتة للأجيال السابقة، وذاكرة العنف غير المُعتَرف به، والموت الذي مُنِعَ الحدادُ عليه، فتعود اليوم كي تلاحق الراوية الغافلة عن ماضيها. تسكن الأطياف جسدها وتحفر عليه قصتها، فيصبح جسد الراوية شاهداً، بمعنى الشهادة على العنف، ولكن أيضاً بمعنى الشاهد الذي يُنصب على القبر، أي المساحة الوحيدة والأخيرة المتبقية للتذكُّر والحداد. فإن كان لا يمكن للمرأة الفلسطينية أن تنقّب عن مقتل قرينتها في الأرشيفات الصهيونية الاستيطانية والعسكرية المحصنة، فإن جسدها سيتحوّل مكاناً للذاكرة، ذاكرة الكارثة العنيفة والمبتورة حيث ستعلن الأطياف عن نفسها من خلال عبثها بالجسد.
هكذا يصبح جسد الراوية مسرحاً لِطَيفِ قرينتها. يتعرّق جسد الراوية ويرتجف وتدمع عيناها ويسيل لعابها دون سبب واضح، وكأنها في حالة نزيف لسوائل الجسد، مُحاكيةً السوائل التي نزفتها الفتاة البدوية قبل سبعة عقود. تنضح من يدي الراوية، كما من ثيابها وشعرها، رائحة وقود عنيدة، المادة نفسها التي سكبها الجنود الإسرائيليون على شعر البدوية قبل أن يرموها بالرصاص. لا يُعلن طيفُ الفتاة القتيلة عن نفسه من خلال إفرازات جسد الراوية المعاصرة فحسب، بل يملي عليها خطواتها: يقودها الطيفُ إلى أرشيف الجيش الإسرائيلي، إلى الموقع الذي أُعدمت فيه البدوية، حتى إلى مدفن البدوية الذي لا شكلَ واضحاً له. وكأنَّ الطيف يؤدّي دوراً طفيلياً، فلا يكشف عن نفسه إلا من خلال الخراب الذي عرفه يوماً، والذي يعيد حفرَهُ على جسد الراوية وحركتها لعلها تدرك ماضيها.
يتحكّم عالمٌ من الانفعالات بجسد الراوية التي تبدو طوال رحلتها التنقيبية خائفةً وقلقة ومترقبة ومرتابة حد الهذيان. يتراءى للراوية ظلّ إمرأة سمراء تحدّق بها خلف باب مغلق، هل من يحدّق بها امرأة بدوية أم هي تهذي فعلاً؟ تعرض الراوية على مسنّة بدوية أن تُقلّها إلى مقصدها دون أن تسألها إن كانت تعرف شيئاً عن الفتاة البدوية المقتولة. تنظر إليها بصمت وهي مدركة أن الكلام لا ينبئ، فأمام قصور الكلام تحاول الراوية قراءة كفّ العجوز البدوية وشرايين يديها النافرة. وهناك كلب ينبح من بعيد ويلاحق الراوية أينما ذهبت، وكأنه الكلب ذاته الذي شهد على الجريمة الأولى، عاد ليذكّرها بمصير قرينتها.
تعجز الراوية عن الكلام، ربما لأنها تسكن المساحة الحدودية بين عالم الأحياء الذي لا تزال فيه وعالم الأموات الذي يناديها من بعيد. كلما دنت الراوية من موقع دفن قرينتها، كلما لاح لها الموت أكثر.
تختتم عدنية شبلي «تفصيل ثانوي» كما فعلت في جزأَيْ الرواية على وقع الخراب والمراقبة. هناك كلب يتبع الراوية بقلق دون سبب واضح، ويعوي عليها قُبيل دخولها إلى منطقة تدريب عسكرية خارج مستوطنة نيريم. تنتهي الرواية على الأرض ذاتها التي دُفنت فيها البدوية قبل خمسة عقود، فتمسح المشهد أمامها: روابٍ، وتلال، وقطيع وتَجمُّع عسكري. تسمع نداءات جنود إسرائيليين يأمرونها بأن تعود أدراجها. ولكنّ الراوية التي لا تدرك منطق الحدود، والمسكونة بطيف قرينتها، لا تلتزم بالنداءات وتواصل المشي. تشعر الراوية بحروق في رجلها ثمّ في صدرها، فيما تسمع دويّ إطلاق رصاص يقترب منها. في نهاية رحلتها مع الاستقصاء الجنائي، تبدو الراوية وكأنها تائهة في زمن معاصر مُعلَّق بين ماضي الكارثة المتمثّل بمقتل البدوية، ومستقبلها هي كامرأة فلسطينية أخرى في طريقها إلى أن تصبح في عداد الأموات.
تسكت الراوية في نهاية «تفصيل ثانوي»، فيبدو صمتها كأنه، هو أيضاً، تفصيلٌ ثانوي.
التفاصيل الثانوية قلقاً
يطرح التنقيب الذي يأخذ شكل التقصّي الجنائي في «تفصيل ثانوي» أسئلةً حول السرديات التاريخية الكبرى، التي تُقاس هيمنتها بمدى قدرتها على التزييف والمحو بواسطة سُلطتي السلاح ومؤسسات الذاكرة كالمتحف والأرشيف. إن كانت الحقيقة مفقودة داخل أسوار الأرشيف الإسرائيلي المحصّن بالجنود والعتاد، فإن تَسلُّل امرأة فلسطينية إليه وتلاعبها بالتسلسل التاريخي في سرديته في سبيل تخيّل ماضٍ خالٍ من المستوطنات، إنّما هو كفيلٌ بأن يتحوّل إلى حركة عصيان يقوده جسد هو ممنوع أصلاً، وبواسطة خيال يتجرّأ على تفكيك الكارثة.
ومع ذلك، هناك حدود لفاعلية تَخيُّلات الراوية التقويضية والتخريبية والتفكيكية، هي التي باتت تدرك أن جريمة اغتصاب وقتل الفتاة البدوية التي يقع جسدها على هامش السردية الصهيونية، وربما أيضاً على هامش السردية القومية الفلسطينية، ستظلّ معلقة، ممنوعة على الذاكرة، وعصيّة على الحداد. لذلك ترى راوية شبلي في التفاصيل الثانوية الخارجة عن مركزية الكلمة الاستعمارية والقومية والسلطوية مدخلاً للخلاص، وتجلّياً مُحتملاً للحقيقة: «أشدّ التفاصيل ثانويّة، كالغبار على المكتب أو خراء الذبابة على اللوحة، السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، إن لم تكن الدليل القاطع عليها» (ص. 70).
في غياب مؤسّسات الذاكرة التقليدية، بما أن قصور تلك المؤسسات هو شرط وجودها، يتحوّل جسد الراوية نفسه– لا لسانها أو خطابها– إلى شاهد على كارثة مصيرها النسيان والصمت. الكارثة التي لم تعشها الراوية ستتجلّى طيفاً يعيث خراباً في حواسها وانفعالاتها وحركة جسدها، كما أجساد قرينات أخريات غافلات عن التفاصيل الثانوية التي أسقطتها السرديات القومية والاستعمارية الكبرى.
إذا كانت رواية تفصيل ثانوي تعمل على زعزعة مركزية الكلمة والأرشيف والإدراك الواعي للتاريخ والتسلسل الانسيابي له، يبقى السؤال، لمَ هذا القدر من القلق الذي يحيط بالاحتفاء بالرواية؟ ولمَ الهلع من أن تصبح مُكرَّسة عالمياً، أن تدخل مدونة ذلك الكيان الأسطوري والهشّ في الآن نفسه، المُسمّى «الأدب العالمي»؟
يمكننا قراءة رواية عدنية شبلي في سياق روايات معاصرة أخرى تقوم على شرط التقصّي والتنقيب سبيلاً للكشف عن سرديات ناقصة ومعلقة ومبتورة، عن امرأة تبحث عن قرينة لها، ليس في الأرشيف الخاص والرسمي، أو في التاريخ الشفوي أو السرديات التاريخية الكبرى، بل في ما هو هامشيّ لها. تكاد تقدّم لنا «تفصيل ثانوي» منهجيةً للتقصّي عن مصائر نساء لا يمكن أن تُروى قصصهن إلا بواسطة التماثُل والتقصي اللذين تقوم بهما راويةٌ غافلة عن ماضيها، وذلك من خلال الغوص في التفاصيل الصغيرة العصية على الأدلجة والمحو فتصبح بعجزها وقصورها مكمناً للقول والدلالة. وكأن عدنية شبلي تومئ بذلك لإيمان مرسال، وكأن الفتاة البدوية تومئ لعنايات الزيات، امرأتان لا تجتمعان سوى على الموت، وعلى إسقاط الأولى من السردية الاستعمارية وإسقاط الثانية من المُكرَّس الأدبي، وكأن لا مؤسسات للذاكرة– لا متحف ولا قبر– يمكن لراوية شبلي ومرسال أن تلجأ إليهما في سبيل ترميم الذاكرة المنقوصة، فتبقى الذاكرة على جسد الراوية المعاصرة التي تحقق وتستقصي وتنقّب.
المقلق في رواية تفصيل ثانوي هو منهجيتها التنقيبية التي يبدو أنها تقول شيئاً عن منهجيات سابقة لحفظ الذاكرة الجمعية. إن كان التأريخ الشفوي أساساً لمنهجيات نسوية وطبقية وعرقية وقومية سابقة، فإن تلك المنهجية تبدو قاصرة اليوم، أولاً لأن الأموات لا يتكلمون إلا مواربةً، وثانياً لأن الأجيال اللاحقة لم يشهدوا على الكارثة، ولأنّ لا أرشيف لهم يخبرهم عن خساراتهم. لا إمكانية تحررية للتأريخ الشفوي عن كارثة الـ1948، أقله في الزمن المعاصر، فوجبت العودة إلى مستويات معرفية سابقة للكلمة وعابرة لها، أي الجسد والانفعال والحواس، الأدوات المعرفية الجديدة. ولئن كانت تلك المستويات خارجة عن مركزية الكلمة والمؤسسات التي تحرسها، ويصعب سبر قدراتها التخريبية وحصرها، فإنها ستتحول مصدر قلق لمن يخشى السرد.
تكتب عدنية شبلي في روايتها بحذر مَن تعرف أن لا سردية واحدة يمكنها أن تعطي الصوت للتفاصيل الثانوية، تلك الذوات الهامشية التي أُسقطت من السرديات الكبرى. تكتب قصة البدوية والمرأة التي تبحث عنها خارج منطق التأريخ الشفوي، متبنية لغة التحقيقات الجنائية الباردة بدلاً من جماليات الاستعارة، ربما لأنه كان هناك جريمة، دون أن يكون هناك سردية لها، وربما لأن الاستعارة قاصرة، كما التحقيق الجنائي. إلا أن حذر عدنية شبلي وتفرّدها بتلك النظرة إلى التاريخ وتفاصيله الثانوية هو في صلب كتابتها الروائية الجديدة، التي يبدو وكأنها تقول إن النكبة مستمرّة ولكن السرد التقليدي لها لم يعد كافياً.
فها هي عدنية شبلي تقدّم شكلاً روائياً معاصراً ليس لأدب النكبة فحسب، بل لأدب الكارثة بوصفه «أدباً عالمياً». ولأنه معاصر ولأنه يقوّض السرديات التاريخية المهيمنة والكرّاس الأدبي معاً، فإنه سيُخيف وسيقلق من يسعى إلى حصر سردية الكارثة الفلسطينية بمؤسسات الذاكرة الإسرائيلية أو بالأشكال الروائية التقليدية، ويمنعها أن تحجز لها مكاناً في كرّاس «الأدب العالمي».
يلتقي المحتفون بـ«تفصيل ثانوي» وأولئك الساعون إلى إسكاتها على أن أطياف الكارثة لا تزال تبحث عن صوت لها، وأنها لن تستكين إلى أن تحكي قصتها. ونحن نعرف مدى شهية الأطياف على العنف، والأذى الذي لطالما ألحقته بحُرّاس السرديات.