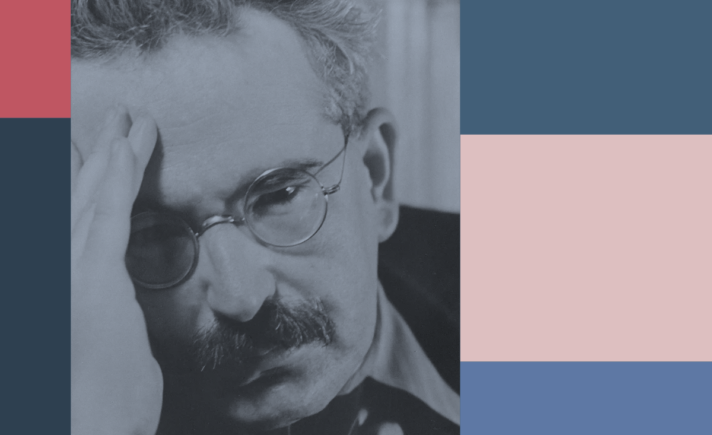عائلاتٌ بأكملها تُباد تحت القصف الإسرائيلي المتوحش لقطاع غزة، واستهدافٌ مباشر ومكتمل المشهدية لتجمعات سكنية عملاقة في قطاع تُحاصَر فيه إحدى أعلى الكثافات السكانية في العالم، في حين تتواصل إعلانات الدعم الكامل لإسرائيل في «حقها في الدفاع عن نفسها»، «الآن كما في المستقبل»، تُضيف أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إحدى تصريحاتها وتغريداتها العصبية المتلاحقة، وغير المتناسقة مع البرود والبراغماتية المُتوقَّعتين من منصبها، حتى في ما يخص خلافات تكون الدول الأعضاء، أو الاتحاد الأوروبي ككل، طرفاً فيها.
تستشرس ماكينة القتل العسكرية الإسرائيلية، وستستشرس أكثر، لتعويض ما فات، لكسر هَول أن عدد القتلى الإسرائيليين كان أعلى من القتلى الفلسطينيين لعدّة ساعات، ما عُدَّ خبراً يستحق النقل والتحليل والتوكيد. المُعتاد، «الطبيعي»، هو أن يكون عدد القتلى الفلسطينيين أضعاف أضعاف الإسرائيليين. كان هذا هو الحال منذ 1948، وهذا هو حال غزّة بالذات منذ فُرِضَ عليها واقع الحصار الشنيع منذ أكثر من عقدٍ ونصف. لكن حتى حينها، مع التفوق الساحق لآلة القتل الإسرائيلية، القائم على بنية مُزمنة من تكريس تفوّق إسرائيلي كامل، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، كانت تخرج تصريحات سياسية من الأطراف الأوروبية والأميركية تدعو «الطرفين» لضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات والتأكيد على الحل السلمي للصراع. الآن، يكاد المرء يحنّ لزمن «ضبط النفس» الجميل.
سياسياً، بل وبشرياً حتى، الخيار الوحيد المطروح على الفلسطينيين مؤخراً هو التلاشي. منذ زمن طويل لم يعد أمامهم حتى خيار القبول بحقوق منقوصة، كما حصل حين قبلوها في أوسلو قبل ثلاثة عقود بالضبط؛ ولم يعد الاستسلام والقبول بشرط الهزيمة المُطلَق فحسب معروضاً عليهم، كما هو مفروض منذ سنوات عديدة في أدنى تفاصيل الحياة اليومية، فنزوات المستوطنين المتوحشين في الضفة الغربية قادرةٌ على وقف هذه الحياة في أي لحظة، وبحماية عسكرية ورسمية وتمثيل وزاري وازن في الحكومة الإسرائيلية. شَهِدنا ذلك في الهجمات المتواصلة لجحافل المستوطنين في القدس والضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، وبمشاركة فعّالة من أتيمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي -أي أن حياة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري الإسرائيلي من صلاحياته رسمياً-، والذي قضى شطراً من حياته «الجهادية» عضواً في تنظيم اعتبرته الولايات المتحدة وإسرائيل إرهابياً. شهدنا ذلك أيضاً في هجمات حوارة، التي اعتبرتها جمعية للمقاتلين السابقين في جيش الدفاع الإسرائيلي «بوغرومات».
التلاشي، إذاً، هو الممكن الوحيد للفلسطينيين. يُري نتنياهو العالم خريطة مطبوعة من على منصّة الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أسابيع قليلة لا تُنكر كمية كبيرة من قرارات الأمم المتحدة نفسها فحسب، بل تنفي مُخرجات «عملية سلام» دخلتها إسرائيل منتصرة، وقبلت بها القيادة الفلسطينية رغم الحيف الهائل الذي كانت تعنيه على حقوق الشعب الفلسطيني. لم يعد هناك فلسطين وفلسطينيون حتى في مفهوم «عملية السلام» هذا، فالسنوات الأخيرة ذهبت نحو منطق إمكانية تَجاهُل فلسطين والفلسطينيين بالكامل، وتحويل الفكرة إلى عمليات تطبيع مع أنظمة عربية متنوعة، تلتقي مع إسرائيل في أولوية الأمننة التقنية والمشاكسة على محور الولايات المتحدة- الصين، وأولوية «استقرار» قائمٍ على قتل السياسة بالكامل، لكنه يقدّم وعداً مُغمغماً باستقرار اقتصادي لا يشمل الفلسطينيين بطبيعة الحال. لا أَبلَغَ من أن مسارات التطبيع هذه تتصرفّ بوضوح على أنها بلاطة ثقيلة صُنعت لتسدّ ما فتحته الثورات العربية قبل أكثر من عقد.
رأى أحد الأصدقاء مازحاً قبل سنوات أن الثورات العربية قد تحدّت، من بين ما تحدّته، مقولة أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولكن هزيمة الثورات لم تَعنِ فقط عدم قيام ديمقراطية راسخة ومقبولة في أيّ من الدول التي عاشت ثورات، بل عنت أيضاً فتحَ المجال لنتنياهو للحلم بأن يكون حاكماً مديداً كأقرانه العرب. لقد كانت مزحة غير مشغولة بأي عمق تحليلي، لكن متابعة الأزمة السياسية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة تُعاين ملامحَ ممّا قالته تلك المزحة، ولكنها أيضاً تُعاين أمراً أشد فداحة بكثير: طوال شهور كثيرة من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل ضد سعي نتنياهو لتقويض فصل السلطات وصلاحيات المؤسسات القضائية واستقلالها، احتجاجات حازت كثيراً من التعاطف الصريح في الأوساط الليبرالية والتقدمية في الغرب، بما فيها الحزب الديمقراطي الأميركي نفسه؛ لم يكن السلوك الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين موضوعاً على الطاولة على الإطلاق، لا في الاحتجاجات ولا في الأجواء المتعاطفة معها، بما في ذلك سلوك جحافل المستوطنين المنفلتة، والتي تتمثّل سياسياً في أحزاب فاشية هي عدوّة لدودة مُفترَضة لتلك الاحتجاجات، بل وداعية لاستخدام العنف المفرط ضدها. سحقُ الفلسطينيين، حتى في أدنى تفاصيل الحياة اليومية، هو شأن ما-دون طبيعي، ضربٌ من مَألَفٍ يمرُّ في روتينيات اليوم دون أن يستدعي أدنى انتباه.
التلاشي فحسب، هذا هو الممكن الوحيد فلسطينياً.
لقد كسرت هجمة الفصائل الفلسطينية بقيادة حماس انطلاقاً من غزة هذا الستاتيكو بشكل مذهل. لأول مرة تدخل قوى فلسطينية أراضٍ داخل خط 1948 بهذا الشكل، ولأول مرة تتلقى وحدات عسكرية إسرائيلية، يُفترض أن جزءاً وازناً منها هو من نُخَب قوات الجبهة الجنوبية، إذلالاً من هذا النوع. كثيرون لم يرتاحوا لمشاهد التعامل مع إسرائيليين غير مقاتلين من قتل وأسر، خصوصاً مسنين وأطفال، وهذا لا يعني أنهم متعاطفون مع إسرائيل؛ وآخرون يتساءلون عن الأبعاد الجيوسياسية للهجمة والدور الإيراني فيها، دون أن يكونوا عملاء للمخابرات الإماراتية. هذه نقاشات ستطول، ومن الضروري أن تطول، لكن شرط صلاحيتها هي أن تنطلق من نقاش أيِّ ستاتيكو كُسِرَ فجر السبت الماضي: الاستثناءُ الإسرائيلي؛ الحقّ المقدّس، والمقدّس بقوّة نفسه، في اكتساح الفلسطينيين طوال الوقت، دون أي شرط أو قيد، ودون أي اعتراض من الفلسطينيين، ودون وعد لهم بخيارٍ آخر غير أن يتلاشَوا فحسب. هذا الاستثناء الذي يُعجِب الأنظمة العربية كافةً، والذي تقترب منه بعض الأنظمة في عمليات «تطبيع» أملاً بالحصول على امتيازاتٍ نابعة منه، أو تقلّد لغته «الاستثنائية» أنظمة أخرى، كما يفعل بشار الأسد بدعمٍ روسيّ مباشر الآن، قاصفاً محافظة إدلب وأرياف حلب بوحشية منذ أيام، ومتسبباً بمقتل العشرات وتدمير عدد كبير من المشافي والنقاط الطبية.
لا حياة ممكنة في أيّ من بلداننا بوجود هذا الاستثناء الإسرائيلي، لا «الآن ولا في المستقبل»، بالاستعارة من فون دير لاين.