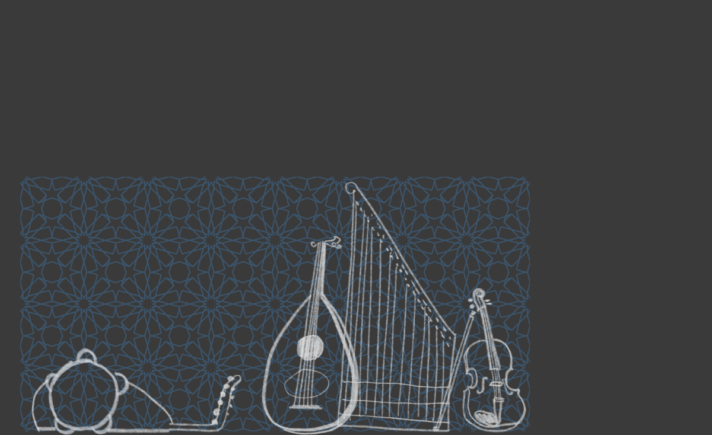إن قلّة، بل انعدام التدوين الموسيقي العربي المشرقي بعد صفي الدين الأرموي، قد أدى الى إهمال كبير في دراسة تطور هذه الموسيقى بالذات. ونقصد بـ«العربي المشرقي» هنا أساساً موسياقات القاهرة ودلتا مصر وبلاد الشام، وهما وحدة ثقافية من زمنٍ قديم، ولن نتطرق في هذه المقالة إلى موسيقات الجزيرة والعراق(1) وشمال أفريقيا والأندلس.
كما أدى ذلك إلى اعتبارها عالة على موسيقى البلاط العثماني عموماً، إما بناءاً على الرغبة في «التخلُّص من إرث عثماني» موهوم، أو إعجاباً بالموسيقى العثمانية بخاصة إزاء غنى المدونات الموسيقية التركية عبر القرون (مثل مدونات علي أفقي وديمتري كنتمير وعثمان دده وهامبارتسوم ليموجيان)،(2) وكذلك بالنظر الى هيمنة تركية غالبة على القوالب الموسيقية التي سجَّلها موسيقيون مصريون وشوام مطلع القرن العشرين من بشارف وسماعيات، وأخيراً بالنظر إلى تطور التنظير التركي للمقامات، الذي انفصل عن التنظير المنهجي أو النظامي(3) (التابع لمدرسة صفي الدين الأرموي ورغبته في منهجة استقصاء الاحتمالات والنسب) في التمييز بين المقامات الأساسية والفروع والشعب والأوازات، مُنتقِلاً إلى تكثير هائل في المقامات على أساس السير كما لدى ناصر عبد الباقي دده وانتهاءً بهاشم بيه (1814 ـ 1868) الذي هو حلقة الوصل مع التأثُّر بالتفكير الأوروبي، الذي سيزداد هيمنة بعد ذلك(4) خلال معظم القرن العشرين،(5) ذلك في مقابل غياب تنظير واسع ومُعقَّد في الموسيقى العربية الشرقية في الفترة العثمانية، قبل منتصف القرن التاسع عشر، حيث لم يصلنا من تلك الفترة إلا قليل من الكتابات التي تُشير إلى بعض الملامح النظرية المرتبطة أساساً بالمدرسة الأسبق (كما لدى الحلبيين ناصر العودي وعسكر الحنفي)(6)، بينما تمركزَ الاهتمام العربي العام بكتابات العصر العباسي المفترض ذهبياً، إلى جانب الأندلسي، في مقابل عهود تالية وُصِمَت خطأً بالانحطاط.(7)
وما زاد الطين بلَّة هو سعي عدد من «القوميين» المصريين إلى بناء هوية مصرية موسيقية، افترضوا أنها ينبغي أن تمر بالتخلص من الطابع العثماني المُفترَض لهذه الموسيقى، سواء تم نَسبُ هذا السعي الهوياتي إلى عبده الحمولي أو إلى سيد درويش،(8) ما ألقى كل مرة ظلال العثمانية على الموسيقى الأسبق. وهذا سعيٌ يكاد يكون هو مُلخَّصَ الرواية الرسمية حول الموسيقى المصرية.
والأرجح أن المسار التاريخي للعلاقة بين الموسيقى العثمانية وموسيقى الشام ومصر أعقد بكثير من هذه السيرة التبسيطية، كما أنه ظالمٌ لموسيقى عربية شرقية لا تزال شواهدها المسموعة (بخاصة الموشَّحات القديمة) موجودة ومُهمَلَة تمام الإهمال.
موسيقى البلاط العثماني: سيرة موجزة
على ما يُرجَّح، كانت الموسيقى الأولى في البلاط العثماني وأوساط الطبقة المقربة منه، أواخر القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن السادس عشر، تحت سيطرة عجمية أي فارسية المناخ، بما في ذلك من تأثُّر بنهايات المدرسة النظامية (كما عند عبد القادر المراغي) التي امتدت إلى القلب «التركي-الفارسي» في آسيا الوسطى، حيث كان يُنظَر بإعجاب كبير بخاصة إلى مدرسة هراة التيمورية في خراسان.(9)

بعد ذلك، في نهايات القرن السادس عشر وعلى مدى نحو قرن، في ما يسميه والتر فيلدمان، الباحث الأميركي المختص بالموسيقى العثمانية، «النهضة العثمانية الموسيقية»، برزَ موسيقيون عثمانيو النشأة وتطورت قوالب وأساليب أكثر محلية، وكذلك فُضِّلت آلات أكثر محلية مثل الطنبور التركي بأنواعه مثلاً والكمنتشه والناي والمسقال الذي أُهملَ لاحقاً. فسقطت تدريجياً خارج الاستعمال آلات مثل الجنك والشهرود(10) وقوالب فارسية أقدم (الشار مثلاً، الذي كان موجوداً في مصر المملوكية بحسب إشارة للباحث أوين رايت في كتابه عن ابن كر، أو التقسيم الغنائي غير الارتجالي) أو تم تطويرها وتغييرها (مثال البشارف الغنائية، والتقاسيم التي أصبحت ارتجالية، والكار في صيغته العثمانية وغير ذلك) أو ابتداع قوالب أحدث (المربع البسته والنقش وسواهما)(11) وضمها في «فاصل» موحد على أساس المقام مثلما كانت عليه حال النُوَب أو النوبات في العالمين العربي والفارسي على الأرجح،(12) أو في قالب الأيين الصوفي المولوي(13) وغيره من أشكال الإنشاد الديني، كما تم تطوير وتعزيز القوالب الآلية كالبشرف والسماعي في صيغهم الآلية، وكذلك لاحقاً أنواع من الموسيقى الراقصة كالزيبقلي وسواها.

أيضاً، مع تطور احترافية موسيقيي البلاط والتنافس بينهم، انتقلت مُقاربة الموسيقى البلاطية لهذه الأنغام من الاهتمام بالمزج إلى تثبيت كل تركيب في صيغة «سير» للمقام، حيث يخضع تتالي الانتقالات والمزج بين الأجناس إلى إطار دقيق وتسلسل محدد مسبقاً، ومن ثم بناء الفاصل على أساس سير المقام، فنتج عن ذلك ازدياد هائل في أعداد المقامات بناءاً على احتمالات التراكيب، بدل الاكتفاء بالتنظير الأقدم حول مقامات أساسية وأخرى ثانوية وفرعية وترك إمكانيات المزج بينها لكل موسيقي وملحن. وربما لعب التقسيم، بطبيعته الحرة الارتجالية، دوراً في الخروج عن قيود التنظير القديم، لكن نتج عن ذلك في نهاية الأمر تثبيت «السير» المقامي، وبهذا تولّدَ في النهاية تنظيرٌ حديثٌ متركز حول «السير» المحدد، أواسط القرن التاسع عشر، رغم أن البعض ينتقده باعتباره تأثُّراً بالنظرية الغربية كما أسلفنا.
أما على صعيد المقاربة الإيقاعية فقد كان التركيز دوماً على أن تُبرِزَ الجملة الموسيقية المفاصل الإيقاعية وتأتي على قياسها،(14) وإن كان ازدياد كثافة وعدد النغمات أو الزخارف في مرحلة لاحقة،(15) أو مجرد ازدياد تدوينها أو الاختلاف في قراءتها، قد أدى إلى تغشية هذا التطابق بين مفاصل الإيقاع ومفاصل الجملة الموسيقية بعض الشيء. وتجدر الإشارة إلى انتشار أوسع لنمط «الشرقي» جديد في القرن التاسع عشر، الذي احتلَّ مكانة متنامية في «الفاصل» العثماني، كبديلٍ راقٍ لأسلوب جديد كان بدأ ينتشر في الكازينوهات.
وفي القرن التاسع عشر أيضاً بدأت نزعة تركية طورانية تسعى الى امتلاك التاريخ بأثر رجعي، فاعتُبِرَ كل تاريخ الموسيقى في وسط آسيا، من حدود أفغانستان وسمرقند إلى اسطنبول، إرثاً عثمانياً، واختُرِعت أنسابٌ وهمية لقطع أقدم أو أحدث مثلما اعتُبر التنظير عنها جزءاً من تاريخ التنظير العثماني. أي بمعنى من المعاني، فقد تم اعتبار الأرموي البغدادي ـ عبر تأثيره على المراغي (ت. 1435 م) خصوصاً، كأحد المؤسسين لهذه الموسيقى، ونُسبت موسيقى إلى المراغي وغيره مثلما نسبت إلى أفلاطون والفارابي!(16)
وأدى هذا، في المرحلة اللاحقة، أي مع أتاتورك، إلى ردّ فعل عنيف اعتبرَ كل هذا التاريخ مبنياً على تنظير يوناني خاطىء، وأرادَ بناء الهوية التركية الحديثة على الموسيقى الشعبية الأناضولية! حيث هاجم أتاتورك شخصياً الموسيقى الشرقية، في خطاب شهير عام 1928، مُعتبِراً أنها لا تليق بحساسية وحيوية الشعب التركي. وتبدَّت ردة الفعل العنيفة مثلاً في كتابات ضیا گوک آلپ حول «مبادئ القومية التركية»، الذي رأى ضرورة تزويج الثقافة الوطنية المحلية إلى «حضارتنا الجديدة»، أي الغرب، بوصفها شرطاً للحديث عن موسيقى قومية.(17) ذلك قبل أن تتراجع الدولة عن المنع وتسمح بعودة الموسيقى العثمانية، لكن مع الأسف في صيغة متأوربةِ الفخامة والمهابة والإبطاء، بعيداً عن حيوية الموسيقى كما كانت تُعزَف في الكازينوهات وخارج الصالات الاحتفالية السلطانية، وربما كان هذا ما سمح لموسيقى «الأرابيسك» لاحقاً أن تحتل مساحة واسعة في الفضاء التركي الحديث، وتُعيدَ رسم خارطة النقاشات الموسيقية الحادة في داخل تركيا.(18)

التأثر والتأثير بين الموسيقى العربية المشرقية والموسيقى العثمانية
إن موسيقى البلاط العثماني ليست بالضرورة موسيقى كل المناطق والأقوام التركية والكردية واليونانية والأرمنية التي تقع الآن في تركيا الحالية، بل ربما أنها لم تكن بالضرورة دائماً الموسيقى الأوسع انتشاراً في العاصمة العثمانية نفسها.(19) في كل مراحل سيرة الموسيقى العثمانية، كان لهذه الأقوام المختلفة إسهامات متعددة في التدوين والتنظير والعزف والتلحين، سواء اليونان أو الأرمن أو غيرهم، وكذلك العرب وإن كان حضورهم أقلَّ وضوحاً، ربما لأنه كان من الأسهل على المسلمين منهم الاندماج في الإطار العثماني وربما أيضاً لعدم الاهتمام بتوثيق ذلك.
من المثبت أن عدداً من الموسيقيين، ممن يُنسَبون إلى أصول مصرية أو سورية، قد ساهموا أيضاً في مراحل مختلفة في هذه السيرة العثمانية،(20) كما أن للتأسيس البغدادي إسهاماً كما ذكرنا في التأسيس النظري.
لكن في الجانب العربي المشرقي لا نجد تأثيراً واسعاً للموسيقى العثمانية بخلاف ما هو شائع، بما يشمل تفضيلات جمالية استمرت في التنافر حتى فترة متأخرة. فينقل مراد أوزيلدريم انتقادات تركية غاضبة على دخول الأسلوب العربي إلى الذوق الغنائي في تركيا، وأبرز علامات اختلافه عدم الالتزام بالنغمات الطويلة، والإكثار من الزخرفات وتكرار اللوازم القصيرة وتفضيل الجوابات في الغناء.
كما أن المخطوطات المتوفرة حتى منتصف القرن التاسع عشر، والتي تجمع الآلاف من الموشحات والمواويل وبينها كم هائل من المعارضات والقدود، أي الكلام المكتوب على قدّ كلام لحن شائع آنذاك، ليس فيها سوى ما يُعَدّ على أصابع اليدين ممّا كُتب على قدٍّ تركي.(21) ويؤكد رايت (2000، ص. 424) ألّا دليل أبداً على استعارة «مواد مُغنَّاة» في هذا الإطار من الموسيقى العثمانية، حتى في المرحلة التي نعرف فيها عن دخول قطع آلية إلى الوصلة الخديوية. وفي مصر، كان «غناء الترك مثلاً لا يستلذه العرب»، على ما يقول عثمان الجندي في روض المسرات (المكتوب حوالي 1875، وإن نشر بعد ذلك بنحو عشرين عاماً، ص. 20)، على الرغم من إقراره بأن «أهل الأستانة والروم وبغداد لهم دراية بالفن زيادة عنهم»، مؤكداً إن «أعظم الألحان وأطرَبَها ألحانُ أهل مصر» على نسق ما أورد أحمد فارس الشدياق، في الساق على الساق، من أن غناء المصريين «أشجى ما يكون، فلا يمكن لمن أَلِفَه أن يطرب بغيره»، بل إن الشدياق في وصف مالطة (حوالي 1840) يقول إن المصريين لا يطربون لغناء أهل الشام حتى، رغم أن لدينا شواهد كثيرة على اشتراكهم في عدد كبير من الموشحات التي كانت شائعة في البلدين.
ومما يُشير إلى هذا الانفصال بين غناء العرب المَشارقة والغناء العثماني عناية الشدياق في وصف مالطة بالمقارنة بين غناء العرب «وإعلاء شأن غناء أهل مصر على سائر العرب والتمييز بين غناء المشارقة وغناء المغاربة» وغناء الإفرنج، وإهماله شأن الغناء التركي بالكلية.
أما الترنّم، أي قول كلام ليس من أصل القصيدة أو الموشح، لأغراض موسيقية أساساً، فكان على ما يقال في نهايات العصر العباسي يُستعمل عند العرب بمفردات «دير تان» و«تلللي» وغيرها، مثلما وردَ مثلاً في درة التاج لقطب الدين الشيرازي في تدوينه لحناً منسوباً إلى صفي الدين الأرموي «يا مليكاً به يطيب زماني»، واستمرَّت هذه الألفاظ وأُضيفَ إليها «جانم» و«عمرم» و«أمان» و«يا ليل» و«يا عين» و«يا سيدي»، وتعايشت جميعاً معاً. وليس في استمرار التعايش هذا تأثّر بالضرورة بالترنم التركي المختلف أحياناً (يار وتني تنني وتادير ناي وتنّنا.. إلخ). كما أن الموشحات العربية المشرقية لم تفرد قسماً خاصاً بالترنم، بل كثيراً ما أتى بديلاً عن اللوازم الموسيقية واستكمالاً لبنية الجملة أو لوظائف جمالية أخرى، ما يدلّ ربما على ضعف حضور الآلات في إنشاد الموشحات وتلحينها، وذلك بخلاف الكارات وبعض أنواع البستات التركية،(22) حيث قسم الترنّم مخصوص منفرد وأساسي في بنيتها (أوزكان، ص. 104 إلى 107)، سواء كان بألفاظٍ ذات معنى (مثل جانم وسلطانم، أي روحي وسلطاني) أو لا معنى لها (مثل تن نا وتادر ناي).
في المقاربة الإيقاعية، تجدر الإشارة إلى أن مؤلِّفاً واحداً، هو ناصر العودي الحلبي، كان يُميّزُ بين إيقاعات العرب وإيقاعات «العجم»، ولا ندري هل المقصود بذلك بالضرورة الفرس أم الأتراك، وذلك قرابة نهاية القرن السادس عشر ـ حين كان الموسيقيون الفرس أنفسهم مُقدَّرين بالغ التقدير في البلاط العثماني ـ والكبيسي الدمشقي وحده أشار في سفينته سنة 1200 هجرية (أي 1786 م.) إلى التمييز بين الأصولات التركية والأصولات العربية (وهذا، بالمناسبة، يشير الى اعتبار شوامٍ أنفسهم عرباً قبل القومية العربية بزمان طويل ودون حصر العروبة بالبدو على ما يقول البعض)، ذلك وإن كان الكبيسي ليس بالضرورة على حق في ما نسبه إلى الأتراك إن كان يقصد العثمانيين.(23) وفي الجانب العملي فإن ما انتشرَ واستمرَّ استعمالُه في الموسيقى المشرقية، أياً كان أصله، قد انطبع بمقاربتها هي للإيقاع وعلاقته بالجملة الموسيقية. وهذه مقاربة تقوم أساساً، بحسب ما يتبدَّى بوضوح من دراسة الموشَّحات بخاصة، على مخاتلة الايقاع والسنكوب وتغيير مواضع بدء الجملة وأطوال أقسامها. فهي إذاً مقاربة معاكسة تماماً لمقاربة البلاط العثماني لعلاقة الموسيقى بالإيقاع، ففي حين تهدف هذه الأخيرة عبر التوكيد على التكرار إلى إثارة نزعة صوفية تأملية، تهدف المقاربة المشرقية إلى المفاجآت المتكررة سبيلاً إلى الطرب والوَجد.
في مجال القوالب أيضاً لا نجد في معظم المخطوطات إلا القليل من «النواطق» (وهو نوع من التأليف، ربما يكون فارسيَ الأصل، يتنقل بين العديد من المقامات حيث يتغير المقام المستعمل إلى مقام آخر عندما يذكر اسم المقام الجديد في القصيدة)، وبعضها للحقيقة يعود إلى أواخر العصر المملوكي. (ولدينا نماذج عديدة عليها مثل ناطق العراق المنسوب إلى الصيداوي الدمشقي المتوفى حوالي 1505 م.(24) وقد أورده الصيداوي في كتاب الإنعام في معرفة الأنغام، مثلما ورد في المخطوط نفسه نصٌّ منسوبٌ للبابلي مطلعه «صلوا باهتمام على النبي التهامي» به اثنان وعشرون انتقالاً بين الأنغام). بالمقابل، وقد أشرنا من قبل إلى سبق وجود «النوبة» العربية والفارسية قبل الدخول العثماني وتكوين «الفاصل» العثماني (الهامش 11)، فإننا لا نجد قوالب تركية فعلاً (لا بسته او نقش او كار) ولا غناءً بالتركية ولا قوالب المولوية (أيين أو سواه، والطريقة المولوية نفسها كانت ضعيفة الحضور جداً في الفضاء العربي المشرقي بالمقارنة مع حضورها، لا سيما الموسيقي، في قلب الدولة العثمانية) في المخطوطات العربية، بل قوالب عربية هي امتدادٌ للقوالب الأقدم (البسيط والخفيف والنشيد في المخطوطات الأقدم كرسالة السيلكوني الآنفة الذكر، ثم الموشَّحات بأنواعها المختلفة بما في ذلك ما سمي «بشارف» غنائية أيضاً. وهذه الأخيرة، بخلاف قول كامل الخلعي الذي يخلط بينها وبين البشارف الآلية، ليست من صنعة أهل الأستانة، فالبشرف موروثٌ من أزمنة سابقة على العصر العثماني، وكان أهل مصر خصوصاً مقبلين عليه، وظلَّ استعمال هذه اللفظة في التصنيف شائعاً حتى نهايات القرن الثامن عشر في مصر والشام، بل وحتى قسطندي رزق يشير إلى ما يورده الحمولي من تغنٍ في «بشارفه وأدواره»،(25) فضلاً على إنشاد القصائد والأدوار (أغانٍ ذات مقطع واحد) والأغاني الشعبية والمواويل وبعض القطع الدينية.
أما الموسيقى الآلية المصرية فلا يبدو لها ذكرٌ قبل المدرسة الخديوية، بل إن الشيخ الشهاب لا يتصور وجودها أصلاً، ففي سفينة الفلك يورد أن الموشحات والبستات «مقرونة بكلام موزون على لغة من ربطها ولحنها من الترك والفرس» فاللحن بالنسبة له، في تعريف يراه جامعاً مانعاً، هو «ما رُكب من نغمات ورُتب ترتيباً موزوناً مقروناً بشيء من الشعر أو غيره من سائر الفنون السبعة» (ص. 8 من النسخة المطبوعة سنة 1893). واستعاد عثمان الجندي، في روض المسرات، هذه العبارة نصاً. وقوالب الموسيقى الآلية المحلية تبدو أكثر انحصاراً في الدواليب (مقدمات موسيقية بسيطة، ربما استوحيت من أقسام في الموشحات تسمى أيضاً بالدواليب وتتميز الدواليب في معنييها هذين بالقصر والتكرار) والتحميلات (وهي أعمال نصف مؤلفة ونصف ارتجالية، لا نعرف بالضبط تاريخ ظهورها ولا سبب تسميتها). ويبدو أن عزف فرقة المهتر الموسيقية العسكرية العثمانية، التي أشار إليها أوليا جلبي في كتاب أسفاره سياحتنامه في الربع الأخير من القرن السابع عشر، ارتبطت بمواكب الولاة العثمانيين الرسمية في مناسبات مخصوصة، أما الوجهاء المحليون والصوفيون فكان لهم فرق ومنشدون محليون على ما يبدو من كلامه أيضاً، بخاصة وأن آلات المهترخانة نفسها، كالزورنة والبورو من آلات النفخ وسواها، لم تدخل في الاستعمال المصري لاحقاً.(26)

وفي حين كانت هنالك آلات مشتركة، مثل الناي (مع بعض الاختلاف التقني)، فقد فضَّلَ العرب المَشارقة عموماً الاستمرار في استعمال العود على الطنبور التركي، وظلَّ القانون منتشراً عندهم، بينما مر بفترات كسوف في اسطنبول، كالقانون الذي يشير مراد أوزيلدريم (ص. 113) ورايت (2000، ص. 412) إلى انتعاشه في اسطنبول فقط في النصف الأول من القرن التاسع عشر بتأثير القانوني الدمشقي عمر أفندي (ت. 1870)، فضلاً عن عدم تبني العرب للآلات العثمانية الأخرى. فظلَّ التخت عندهم منحصراً قليل العدد. أما الآلات الأخرى التي وثقتها الحملة الفرنسية، فالإشارات التي أوردها فيوتو في وصف مصر تدلّ على أنها كانت عموماً موجودة في أوساط الجاليات الأجنبية فقط، فيذكر الكمنجة الرومي والطنبور البلغاري واللير الإثيوبي، ويحدد مثلاً عن الطنبور التركي أنه لا يُرى إلا بين أيدي الأتراك واليهود واليونانيين وأحياناً الأرمن، ولا يُرى أبداً بين أيدي المصريين (النسخة الفرنسية، ص. 862).
وبالمثل، ففي حين تزايدت المقامات العثمانية ذات السير المحدد حتى بلغت المئات على ما يقال، فقد استمرت المقامات العربية محدودة العدد في حدود 25 مقاماً بحسب نويباور (2000، ص. 323)، وبقيت أسماؤها (كالراست والعراق والنوروز والأصفهان والحسيني والحجازي والعشاق والنوى والأبوسليك) الموروثة من عهود أقدم من الدخول العثماني، حتى منتصف القرن التاسع عشر. وإذ تغيَّرَ مسمى هذه الأسماء أحياناً، فإنه تغيَّرَ بأشكال مختلفة بين العثمانيين والعرب المشارقة، فالعشاق مثلاً كان يشير إلى جنس العجم عند الأرموي، وتطور ليشير إلى جنس البوسليك (أو المينور) عند العرب، في حين تحوَّلَ إلى ما يشبه البياتي عند العثمانيين.

وفي مقابل سيل المقامات العثمانية، لا نجد في سفينة الشهاب مثلاً إلا نحواً من عشرين مقاماً، حتى باحتساب المقامات التي تمر عرضاً وليس عليها وصلات كاملة،(27) آخذين بعين الاعتبار أن المخطوطات الشامية والمصرية التي وصلتنا لا تتجاوز الخمسة وأربعين تقريباً(28) (وبينها متكررات بأسماء مختلفة). غير أن ما تبقى من الموشَّحات التي وصلتنا مُسجَّلة ومسموعة، مما ورد عند الشهاب وغيره، يدلّ على أن موشحات مقام واحد (الراست مثلاً أو الرصد كما كُتِب أحياناً) تغطي عدة مقامات بحسب التصنيف العثماني (كالراست والسوزناك والراست نوروز والسازكار..إلخ)، وتتناول المقام الواحد بأشكال مختلفة (فهنالك مثلاً في الموشَّحات القديمة راست هابط، وصاعد ـ هابط، وهنالك ثلاثة أنواع من الحجاز، فمنه ما يبدأ في الجواب ومنه ما يبدأ في القرار ومنه ما يبدأ في أوسط سُلَّمِه).
أي أن الموسيقيين العرب لم يتبنوا، على الأقل حتى منتصف القرن التاسع عشر، تنظير السير المقامي العثماني ولم يبنوا على مثل هذا التنظير ألحانهم، حتى بعد تجدد الاهتمام النظري وبرغم اطّلاع مشارقة على المقامات العثمانية.(29) فظلَّ عدد المقامات، بحسب ما يُرى من الموشحات ـ وهي الإنتاج الرئيسي في تلك الفترة قبل انتشار قالب الدور مع الحمولي ومحمد عثمان ـ محدوداً حتى في الشام بعد منتصف القرن التاسع عشر، ووصولاً في مصر إلى كامل الخلعي، مطلع القرن العشرين، الذي لا يُورِدُ إلا عدداً محدوداً من المقامات التي عليها موشَّحات.(30) وقد نأى العرب بأنفسهم نأياً تاماً طيلة العهد العثماني عن تدوين الأنغام بأي من الطرق التي استعملت في الأستانة (بالأحرف العربية، أو بالاستناد إلى أساليب الكنيسة الأرمنية أو البيزنطية).
يبقى هناك سؤالٌ لا تسمح المعارف الحالية بحسم إجابته: هل دخل التقسيم العزفي الارتجالي على الآلات من خلال الموسيقى العثمانية؟ حيث أن أقدمَ ذكر عثماني له بحسب فيلدمان (1993) يعود إلى مدونات كنتمير، بدايات القرن الثامن عشر، بينما لا ذكر له في مصر والشام قبل القرن التاسع بحسب فيلدمان. إلا أنه مخطئ في ذلك، إذ ورد التقسيم بمعنى العزف الآلي، ولسنا ندري إن كان ارتجالياً أم لا، في الباب العشرين من كتاب ابن الطحان الفاطمي حاوي الفنون وسلوة المحزون (تحقيق زكريا يوسف)، أي حوالي منتصف القرن الحادي عشر للميلاد حيث يشير إلى الطرب للغناء والطرب للتقسيم أي لسماع الآلات.
أما في العصر الحديث، فالواقع أن ذكر العازفين عموماً شديدُ الندرة في المخطوطات والكتب العربية في المرحلة العثمانية(31) بخلاف أخبارهم الكثيرة في العصر العباسي والمملوكي. غير أن ربطَ جدة التقسيم بكونه ارتجالياً يتجاوز السير التقليدي للمقام العثماني، لا تبدو ملامح غريبة على ملامح الموسيقى العربية الشرقية، حيث أن إنشاد القصائد والمواويل كان ارتجالياً على الأقل في جزء منه، وربما كان في تواصل العرب والعجم أيضاً اطلاعٌ على ما سُمّي «كل النغمات» (وهي تآليف فارسية، عرفها الأتراك أيضاً، تستعمل كل نغمات السلم الموسيقي، ويعيد البعض هذا الأمر حتى ما قبل إسحاق الموصلي مع ابن مسجح وقيل بن محرز، بحسب ما يورد ابن المنجم في كتاب النغم). كما ترد إشارات كثيرة إلى تَعدُّد المقامات في العمل الواحد، من أيام الصيداوي ونواطقه على ما ذكرنا وهو توفي حوالي 1505 م، وصولاً إلى ما يرويه أدهم الجندي في تحفة الزمن بتراجم أعلام الأدب والفن عن الحلبييَن مصطفى البشنك (1765 ـ 1855) وتلميذه محمد الورّاق، ومقدرتهما المذهلة في التنقل بين عشرين نغمة دون أن يشعر المرء بالانتقال ثم العودة إلى نغمة الأصل، وتؤكده التنقلات الكثيرة والمفاجئة أحياناً بين المقامات، لا سيما في خانات الموشَّحات المدونة في المخطوطات، وبعضٌ منها وَصَلنَا لَحنُهُ مُسجَّلاً في القاهرة وحلب. فضلاً على أن الارتجال في التلاوة القرآنية عامل مشترك أيضاً بين الموسيقَتين.
أخيراً، يُشير أحمد فارس الشدياق، الذي كان عازفاً على الطنبور، البغدادي على الأرجح، وكان أيضاً معاوناً في جريدة الوقائع للشيخ شهاب الدين الحجازي صاحب سفينة الفُلك، وأقام في مصر من 1828 الى 1834، إلى أنَّ لأهل مصر في العزف على العود «طرق وفنون تكاد تكون من المغيبات»، ما يوحي بأنه ليس يقصد فقط مرافقة المغنين بل في العزف المنفرد خصوصاً، وأنه أفردَ الإشارة الى العود دون غيره. وقد استعادَ عثمان الجندي، صاحب دور «في مجلس الأنس الهني»، في روض المسرات (ص. 23 ـ 24)، منتصف العقد الثامن من القرن التاسع عشر، هذه العبارة حرفياً وهو يشير أيضاً إلى تقاسيم آلية تتخلل غناء القصيدة، التي كانت على ما يبدو جزءً من وصلة انتقالية سبقت ظهور الوصلة الحمولية أو الخديوية (التي ركزت على دور أو قصيدة تَطاوَلَ غناؤهما بالارتجال)، وتتضمن موشَّحات ثم قصيدة تتخللها تقاسيم آلية، ثم قدود وتحاميل، ثم أدوار غزل أو مديح، والختام بموشَّح على إيقاع الدارج. وكثيرة هي الإشارات الأقدم في الأغاني وألف ليلة وغيرها إلى قيان كُنَّ يضربن بالعود قبل الغناء، وليس بيّناً هل كان ذلك ارتجالاً أم عزفاً لجُمل بسيطة مُلحَّنة كالطرائق التي ذكرها الأرموي.

لذا قد يكون مُحتمَلاً أن التقسيم الآلي كان موجوداً في مصر قبل العهد الخديوي، لكنه لم يكن جزءاً من الوصلة الموشَّحاتية بالضرورة، ولذا لم يُذكَر في المخطوطات التي لم تُعنَ إلا بهذا القالب أو بالمواويل والقصائد. غير أن المعارف المتاحة حالياً لا تسمح بالحسم في هذا.
متى دخلت الملامح العثمانية إلى الموسيقى العربية المشرقية؟
هل كانت القطيعة التامة ممكنة في ظل حكم واحد؟ ربما كانت الإجابة بالإيجاب غير مُستبعَدة ولا مُستَهجنة، بالنظر إلى ضعف الاختلاط العثماني بالمصريين والشوام عموماً، حتى على المستوى السياسي حيث ظل المماليك يحكمون مصر فعلياً لنحو ثلاثة قرون، بدور منحسر جداً للوالي العثماني، وكان هنالك عدد كبير من الأمراء المحليين، أو للدقة «المقاطعجية» المحليين، يحكمون أنحاءَ واسعة من الشام. ولدينا في فنون أخرى، كالمُنمنمات ورسوم المخطوطات التي لم تدخل الفضاء العربي، وتأخُّر أثر الخط والعمارة العثمانيين فيه، ما يعضد هذه الفكرة. لكن الواقع لا يدعم القطيعة التامة هذه في مجال الموسيقى، على الأقل ليس طيلة القرون الأربع التي احتل فيها العثمانيون هذه المنطقة.
إذ تظلّ هنالك ملامح لعلاقات ما بين هاتين الموسيقتين، وقد ذكرنا وجود موسيقيين من أصل مصري وشامي في اسطنبول في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر وربما لاحقاً ( مثل كماني خضر آغا الحلبي الدمشقي ثم الإستانبولي العثماني الموسيقي الذي توفي 1760 م. بحسب معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، والقانوني الدمشقي عمر أفندي ت. 1870)، كذلك دوّنَ علي أفقي في اسطنبول ألحاناً بكلمات عربية منتصف القرن السابع عشر (المخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنية الفرنسية). وكذلك ذكرنا إشارة الكبيسي في نهاية القرن الثامن عشر إلى الأصولات الإيقاعية التركية المستخدمة في الموشَّحات العربية، وورود ألحان تركية قليلة رُكِّبَ عليها كلام عربي وصولاً إلى منتصف القرن التاسع عشر، وأشرنا إلى مصاحبة «المهتار» للولاة العثمانيين في مواكبهم القاهرية. أي أن هذه العلاقة كانت متقطعة، ولم تنقطع تماماً في الاتجاهين عبر القرون، لكنها كانت ضئيلة التأثير جداً حتى ذلك الحين.
بالمقابل، نجد أثراً عثمانياً أكبر بكثير يحدث ما بين منتصف القرن التاسع عشر إلى الثلث الأول من القرن العشرين. حيث نعثر في مصر، مثلاً بحسب كتاب قسطندي رزق الموسيقى الشرقية والغناء العربي، على جوقٍ تركي في بلاط الخديوي إسماعيل تلقى عنه المصريون «بعض التلاحين والبشروات (البشارف) ومنهم عبده الحمولي ومحمد أفندي العقاد وأحمد أفندي الليثي وإبراهيم سهلون وأمين أفندي البرزي»، كما يذكر أن البزري تعلَّمَ على يد عازف مولوي تركي، ويشير إلى عازف تركي آخر اسمه عمر في بلاط الخديوي. كذلك يذكر أوزيلدريم (ص. 109) زيارات موسيقيين أتراك إلى مصر، مثل أندروني علي بك وولي أفندي وملكسات أفندي، الذين دعاهم الخديوي إسماعيل باشا، وكذلك زكائي دده وإقامته فيها لسنوات بدءاً من 1851 (أو ربما يكون الأدق أنها من سنة 1845 بحسب رايت)، عمل فيها مدرساً للموسيقى في قصر مصطفى فاضل باشا، حفيد محمد علي، كما تعلّمَ، وهو كان لا يزال فتى آنذاك، من الشيخ شهاب الدين الحجازي صاحب سفينة الفلك. وهنالك إشارات كثيرة إلى زيارات عبده الحمولي ويوسف المنيلاوي وغيرهما إلى الأستانة في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. ويبدو أن هذا التلاقُح أثّرَ أيضاً في الموسيقى في اسطنبول نفسها، حيث يذكر أوزيلدريم أن عودة هؤلاء الموسيقيين الأتراك إلى اسطنبول أدَّت إلى نشوء أسلوب متأثر بالموسيقى المصرية، وهو ما أثار اعتراضات أشرنا إليها أعلاه.
يصل رايت (2000) إلى نتيجة مشابهة، بأن التأثير العثماني حصل في نهايات العهد العثماني نفسه وفي زمن ضعف السلطنة، مُخالِفاً بذلك الفرضية التي اقترحها في مطلع مقالته، والتي بقي يُردًّدها في هذا المقال برغم إيضاحه مراراً وتكراراً غياب الأدلة عليها، أي فرضية انتقال التطورات من المركز السلطاني إلى الأطراف مع توسّع السلطنة واستقرارها ثم انحسار هذا التأثير في نهاية عهدها. إلا أنه يبرر النتيجة الأخيرة في خاتمة مقاله بسبب يورده على عجالة، لكننا نراه غير مقنعٍ، وهو رغبة العرب (المصريين والشوام) في التشبّه والاستعارة من ثقافة وموسيقى المركز السلطاني الثريتين والمُعقدتَين، سعياً وراء استقلاليتهم الثقافية (عنه؟) بعد قرون من العزلة والخضوع! ونرى ذلك غير مقنع لأنه لا يوضح سبب مثل هذه الرغبة المفاجئة، ولا كيف تشكلت أو من قام بها، ولا يقدم أدلة على مثل هذا السعي ولا كيف تتوافق الرغبة في الاستقلال «الثقافي» عن العثمانيين مع الاستعارة الغزيرة منهم.
أما في رأينا، فما يلوح وراء تعزيز العلاقة الموسيقية في الطور الأخير للسلطنة، إنما هو رغبات سياسية بتعزيز التواصل بين الأستانة والقاهرة، خصوصاً وأن أسرة محمد علي باشا (بمن في ذلك فاضل باشا وقد سبقت الإشارة إليه، لارتباطه بزكائي دده) لم تنقطع عن الأستانة، تماهياً وتنافساً وزيارةً وإقامة. ومن ذلك رغبة السلطان عبد الحميد الثاني في تعزيز العلاقة مع الجزء العربي من السلطنة في ظل الفقدان المتنامي للأراضي الأوروبية على امتداد القرن التاسع عشر، كما يبدو أن مستشار السلطان عبد الحميد، الدمشقي أحمد عزت العابد (1855 ـ 1924) الذي يقال إنه كان صديق أبي خليل القباني، وشيخ الإسلام ونقيب الأشراف أبا الهدى الصيادي (1848 ـ 1909)، لَعِبا دوراً إضافياً في هذا الاتجاه برعاية ودعوة مثقفين وفنانين ومغنين من أصول عربية إلى الأستانة، ومنهم على ما يُروى عثمان الموصلي وعبد الخالق الحمصي، وكذلك بحسب كامل الغزي في مقاله الموسيقى والموسيقاريون في حلب (مجلة المجمع العلمي العربي 1925، العدد العاشر) السيد أحمد بن عقيل والدرويش صالح قصير الذيل المؤذن الثاني للسلطان. ويذكر أدهم الجندي في تحفة الزمن أن أبا الهدى كان عليماً بالموسيقى والإيقاع حافظاً للموشَّحات. ومن ذلك أيضاً تعزيز الحضور العربي في الإدارة العثمانية نفسها، على ما يشتكي تكراراً فالح رفقي أطاي (جبل الزيتون، ترجمة أحمد زكريا وملاك دينيز أوزديمير، دار الرافدين، 2023، ص. 50 مثلاً)، منتقداً تَعرُّبَ الترك في مقابل عدم «تَترُّك» العرب فيها. كما يبدو أن نظام الخديوي، من الجهة المصرية، كانت لديه أيضاً رغبة بالتشبه بالأستانة كما بأوروبا في الوقت نفسه، ففي حين كانت اسطنبول تنشئ مدرسة للموسيقى العسكرية (سنة 1826 م.) وتستقدم دونيزيتي باشا (جيوزيبي دونيزيتي، برغامو 1788 ـ اسطنبول 1856، شقيق مؤلف الأوبرا المشهور)، كانت قاهرة محمد علي أيضاً تنشئ مدارس للموسيقى العسكرية على الطراز الأوروبي (1824 ـ 1834)، وتنشئ أيضاً داراً للأوبرا وتطلب من فيردي تأليفَ عمل لها، فيما ترسل المغنين إلى اسطنبول وتستقدم موسيقيين منها بخاصة في عهد الخديوي إسماعيل لاحقاً.
ويبدو لنا أن ذلك قد سمح، أخيراً، بقنوات للتواصل والالتقاء الثقافي، ففي حين تندرُ جداً أية إشارات إلى رحلات لموسيقيين بين الفضائين التركي والعربي في الفترة العثمانية قبل منتصف القرن التاسع عشر، أتاحت رعايةُ الأسرة الخديوية رحلاتٍ لموسيقيين مصريين إلى الأستانة من جهة واستقدامَ موسيقيين أتراكاً عاشوا في القاهرة من جهة أخرى، أما قبل ذلك فإن رعاية بعض مشايخ الصوفية وأمراء المماليك، في القرن الثامن عشر خصوصاً، كانت محصورة بوشَّاحين وموسيقيين محليين مصريين وشوام، حسب ما يَلوحُ لنا من قراءة الجبرتي والنابلسي وغيرهما. كما كان لالتفات الأسرة العثمانية نفسها، وإن متأخراً، إلى فضائها العربي (ومن رموز ذلك من ذكرناهم كأبي الهدى الصيادي وعزت العابد) أن أتاح أيضاً وجوداً أوسع لموسيقيين من العرب في عاصمتها.
على الصعيد العملي يبدو ذلك متوافقاً في مصر مع تفكك الوصلة الأقدم، المعتمدة على الموشَّحات أساساً. وتحولت هذه الوصلة تالياً الى الوصلة الخديوية الحمولية التي دخل عليها مقدمات وقوالب آلية (تقاسيم وبشارف وسماعيات) لم يكن لها أي ذكر من قبل، مما يسمح بالظن أنها دخلت بتأثير مباشر من وجود الموسيقيين الأتراك في البلاط الخديوي، فضلاً عن ظهور قالبين حديثَين (الدور في صيغته الحمولية- العثمانية نسبة إلى محمد عثمان) والقصيدة المُرتجَلة المُوقَّعة على إيقاع الوحدة غالباً (وينسب البعض ابتكارها إلى محمد سالم العجوز). كما ظهر هذا الأثر في دخول مقامات جديدة لم يكن لها حضور آنذاك في الفضاء العربي الشرقي، كالحجاز كار والحجاز كار كرد والنوى أثر وحتى النهوند في حلته الجديدة، إذ أشارت المصادر العربية الأقدم إلى النهوند كأحد أنواع الصبا ـ وكانت تسميه غالباً صبا نهوند، وليس الى النهوند بصيغته العثمانية المعروفة منذ القرن الثامن عشر، وهي التي انتقلت لاحقاً أواخر القرن التاسع عشر إلى مصر.
وأغلبُ الظن أن هذا التلاقح العثماني المصري المحدود نسبياً كان مسبوقاً بتلاقح عثماني شامي، ولا سيما حلبي، بسبب التقارُب الجغرافي وانتشار طرق صوفية متقاربة (بما يشمل المولوية الحاضرة في حلب ودمشق) والدراسة في اسطنبول (علي الدرويش مثلاً، الذي يذكر أوزيلدريم أنه تركي الأصل، درس في دار الألحان) وتبادل إقامات الموسيقيين فيها (يذكر كامل الغزي مثلاً إقامة الكمنجاتي نقولاكي الحجار ووفاته في حلب)، ما سمح بدخول إيقاعات جديدة من أصول تركية وكذلك بظهور أعمال من مقامات جديدة،(32) في الشام أولاً قبل وصولها إلى مصر (بما في ذلك من طريق أبي خليل القباني). وربما كان هذا ما يسمح بفهم انبهار الموسيقيين المصريين بمعارف انطون الشوا (والد سامي الشوا، والحديث عن الانبهار على ذمة هذا الأخير في مذكراته)، حيث كان أهل حلب أكثر اطّلاعاً على المقامات التركية المُنظَّر لها حديثاً بطرق السير وتفريعاتها من أهل القاهرة آنذاك، وأكثر اطّلاعاً على الرصيد الآلي العثماني من بشارف وسماعيات آلية واردة حديثاً إلى مصر، ربما بعد انقطاع لنحو قرنين أو أكثر (فيلدمان، 1993).
بعد ذلك، لا يمكن إنكار التأثير المتأخر والكبير، بعد الحرب العالمية الأولى، لبعض التسجيلات كتسجيلات جميل بك الطنبوري، التي ذكر محمد القصبجي أنه كان يعشق الاستماع إليها، وبعض المؤلفات الشهيرة كاللونغا المعروفة بلونغا يورغو، في مصر، ولا الأثر الهائل الذي أدخله في مرحلة لاحقة جداً الشريف محي الدين حيدر بتدريسه العود في بغداد، تقريباً في المرحلة نفسها التي كان فيها للإذاعة المصرية، وكذلك للأفلام الغنائية المصرية لا سيما أفلام محمد عبد الوهاب، أثر ضخم في اسطنبول وتركيا الحديثة (أوزيلدريم). أي أن نهاية السلطنة العثمانية نفسها لم تَعنِ نهاية عملية التأثُّر والتأثير بين الشعوب المتجاورة، لا سيما في ظل وجود وسائط حديثة تسمح بهذا التفاعل (التسجيلات، الإذاعة، السينما، وفي أيامنا الحالية الانترنت، واللجوء السوري بعد الكارثة الفادحة التي حلَّت بهذا البلد).
التهجين في فيء خطاب الأصالة
يُشير ما سبق إلى عزلة نسبية تطورت فيها الموسيقى العربية الشرقية، منذ الدخول العثماني إلى المنطقة مطلع القرن السادس عشر إلى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، حيث لم يتجاوز التفاعل بينهما على ما يبدو بعض الإيقاعات وعدداً ضئيلاً جداً من القدود الموضوعة على ألحان تركية. مع منتصف القرن التاسع عشر تعرضت أولاً حلب والشام ثم مصر إلى تأثيرات عثمانية/تركية حديثة، تجلَّت في إدخال مقامات وإيقاعات جديدة إليها فضلاً عن نقل قوالب آلية (البشارف والسماعيات الآلية)، مع وجود شك في تاريخ ظهور التقاسيم وأصلها. أُدمِجَ ذلك في وصلة حديثة أعلامُها عبده الحمولي ومحمد عثمان، ذلك بعد تفكُّك الوصلة الموشَّحاتية الأقدم في مصر، والتي تفككت لاحقاً في الشام على ما نرى من استدخال أدوار وقصائد ومواويل إليها، كما عند صبري مدلل وصباح فخري وحسن الحفار.

في تلك الفترة نفسها يمكن أيضاً رصد وجود الأوبرا الإيطالية، في اسطنبول وفي القاهرة، والموسيقى الأوروبية عموماً، فضلاً على أثرٍ أسبقَ للموسيقى النحاسية العسكرية على الطراز الأوروبي في الجيش العثماني وفي جيش محمد علي، وعن إنشاء مدارس للموسيقى العسكرية.
أي أن الفترة الأكثر تهجيناً (وليس هذا انتقاداً لها البتة) هي الفترة المتطابقة في مصر مع المدرسة الخديوية، التي بدأت بالتأثُّر بموسيقى عثمانية هي نفسها يزداد فيها الأثر الأوروبي (وملامح من الأسلوب المصري)، ثم تطورت مع تطور المسرح الغنائي بعد أبي خليل القباني مع مارشات وسلامات وتراجيديا سلامة حجازي، قبل ديالوغات سيد درويش وحوارات مجموعاته، ثم التغيُّر اللاحق المعروف مع القصبجي وعبد الوهاب خصوصاً. ويمكن رصد أثر مشابه قليلاً في الشام، مع زيادة الجرعات الدرامية في بعض موشحات عمر البطش، الذي كان عسكرياً في الفرقة الموسيقية بالجيش العثماني، بحسب ما يروي واصف جوهرية في مذكراته (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية 2003، ص. 193.)، فضلاً عن ما ذكرناه في شأن الإيقاعات والمقامات.(33)
وهكذا، ربما يكون الكلام عن تخليص الموسيقى العربية من عُجمتها وتُركيَّتها، ومن ثم «تنقيتها»، خطاباً ثقافياً قادماً من خارج الوسط الموسيقي، الذي لم يترك لنا كتابات كثيرة توضح تفكير الموسيقيين أنفسهم في تلك الفترة، قبل القرن العشرين. كذلك قد يكون هذا الخطاب إسقاطاً لأمنيات سياسية على الواقع، أو ذرَّاً للرماد في العيون لتبرير تغيير جذري كان يعصف بهذه الموسيقى على أيدي الموسيقيين أنفسهم، ممّن كان البعض يعتبرهم أعلاماً على هذه «التنقية». مثلُ هذه الأخطاء في الخطاب الثقافي سائدةٌ في تاريخنا وفي حاضرنا، حيث الحديث اليوم عن تنصيب الموسيقى التركية (وتنظيرها المتأخر) سيدةً وصيةً على الموسيقى العربية المَشرقية يتجاهل كل تاريخ هذه الأخيرة قبل منتصف القرن التاسع عشر. وشبيهٌ بذلك أيضاً ذاك الحديث الآخر الموهوم عن أن الموسيقى العربية المشرقية السابقة لعصر النهضة الحمولية منحطةٌ ورتيبة، لكن هذا يستحق بحثاً مطولاً ليس هذا موضعه.