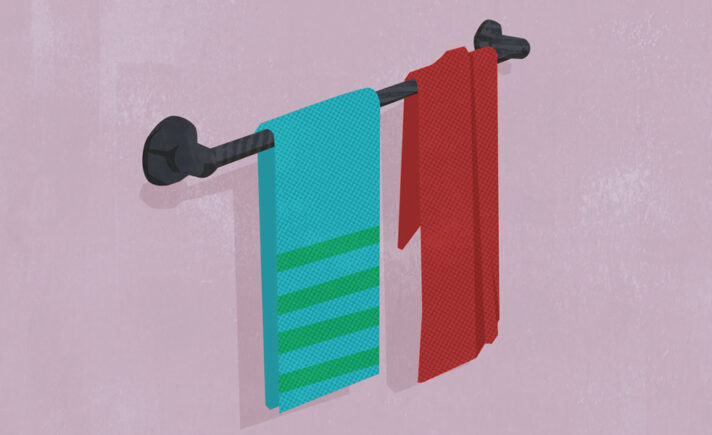«اكتملت دورة العمر يا غريب وكادت تغلق البوابات على بداياتها. كم بدت السنون بعيدة، وهذا العمر كم بدا قصيراً فظّاً! وها أنت تغادر ربما دون رجعة. ألهذا تمهّلت، أم لتتمسّك بيقين بقاء زرقةٍ في البحر تؤوي الشمس التي تتهاوى».
عماد شيحة، من رواية بقايا من زمن بابل
«لم يعد مُهمّاً كيف مات، المهمُّ حقاً أنّه عاش!»؛ اختتمَ عماد شيحة تأبينه لصديقه هيثم نعّال بهذه العبارة، ولعلّها من آخر العبارات التي كتبها، إذا كان التأبين قبل نحو ثلاثة أشهر من رحيله. وفضلاً عن أنه يصعب إيجاد عبارة أكثر بلاغة لقولها في وداع عماد شيحة نفسه، فإنها فوق ذلك عبارة ساحرة في قوّتها وفي تكثيفها لسؤال الموت وإحدى إجاباته المحتملة، وهي أيضاً تفتح الباب على اعتراف شخصي كان ينبغي أن يسمعه عماد مني، لكن ضِيقَ الوقت ونقصَ الجرأة منعاني من ذلك.
عرفتُ أن عماد شيحة في فرنسا بالصدفة، عندما كان في حفل الإعلان عن تأسيس جمعية سميرة الخليل في باريس. لم أكن أعرفه شخصياً، وقيلَ لي إنه وصل إلى فرنسا حديثاً للعلاج، وعرفتُ أن الترجيحات الطبية التقليدية لمرضه ليس من بينها توقعات بالشفاء. كنتُ أعرف أشياء قليلة جداً عن شيحة كشخص، وأشياء أكثر عن المنظمة الشيوعية العربية التي كان انضمامُه لها سبباً في اعتقاله ما يقارب الثلاثين عاماً. كان ورفاقه بالنسبة لي أبطالاً أسطوريين، متهورين، جعلَ حافظ الأسد من إعدام بعضهم والاعتقال المفتوح لآخرين أمثولة لترويع المعارضين السوريين.
لديَّ اعترافٌ أول هو أنني تعمّدتُ ألّا أقترب منه لأُلقي التحية في ذلك اليوم، بل حرصتُ على الهرب سريعاً كي لا تكون هناك فرصةٌ للتعارُف. سألتني زوجتي عن السبب، فقلتُ لها إنني لم أكُن مستعداً للقاء كل ذلك الألم دفعةً واحدة. بعدها بيوم أو يومين اتصل بي ياسين الحاج صالح مُقترِحاً لقاءً معه ومع زوجته السيدة رندة بعث. لم أستطع الرفض، والتقينا في ذلك اليوم وتَعارَفنا. أصبحنا أصدقاء لعماد ورندة سريعاً بعد لقاءات قليلة معدودة، أو هذا ما يحلو لي أن أقوله: أنَّ عماد شيحة أصبح صديقاً لنا أنا وزوجتي قبل أن يرحل عن هذا العالم.
الاعتراف الثاني هو أنني لم أجد عنده ذلك الألم الذي كنت خائفاً من مقابلته. صحيحٌ أنني وجدتُ صنوفاً من الألم في جسده وذاكرته، لكن ليس من بينها ما كنتُ خائفاً منه. فكّرتُ كثيراً: ما هو الشيء الذي كنتُ أريد أن أتفادى لقاءه؟ من أي ألم كنت أهربُ؟
حاولتُ مراراً أن أضع ذلك الألم الذي كنتُ خائفاً منه في كلمات، فأمكنني أخيراً تكثيفه كالتالي: عماد شيحة شخصٌ عرفَ الموت والألم الرهيب باكراً جداً؛ تم إعدام شقيقه وبعض رفاقه والحكم عليه مع رفاق آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة عندما كان في مطلع عشرينياته، ثم قضى ما يقارب ثلاثة عقود في المعتقلات (1975 – 2004)، أكثر من نصفها في جحيم سجن تدمر المُخيف، وها هو بعد خروجه من السجن بأقل من عقدين يواجه مرضاً عُضالاً. هذا كثيرٌ على حياة واحدة وجسد واحد وروح واحدة، وهو يطرح عليَّ دُفعةً واحدةً كلَّ الأسئلة المخيفة التي كانت تشتعل أصلاً في رأسى آنذاك: أيُّ معنىً يبقى لحياة عامرة بالألم؟ وأيُّ معنىً للحياة أصلاً ونحن لا ننتظر شيئاً في ختامها سوى الموت؟
من أحاديثنا القليلة التي خُضناها، لم يظهر لي أن عماد يتألم من حياة قاسية بلا معنى يُلاحقها موت عبثي، بل كان كل شيئ في حياته عامراً بالمعنى حتى أيامه الأخيرة. هذا ليس شعراً في مديح شخص لم يَعُد بيننا، بل هو ما تقوله كل جملة من تأبينه لرفيق سجنه هيثم نعّال، وما تقوله المَشاهدُ القليلة التي تحتفظ بها ذاكرتي من أحاديثه التي كنتُ شاهداً عليها. لقد مَنحتني معرفتي القصيرة بعماد شيحة تأكيداً عملياً لإجابة نظرية كنت أعرفها على سؤال معنى الحياة: الحياة لا معنى لها في ذاتها، بل نحن نمنحها المعنى بأنفسنا، ونجعلها أقل ألماً بالمعنى الذي نُضفيه عليها.
«ليس الموت هو ما يُخيف يا رباب، أنتِ أدرى بذلك من غيرك، تعرفينه دون لبس، وإنما ما بعد الموت .. ما وراءه من ذكر باقٍ سيُلاحقك أيّان كنتِ وأياً كانت حياتك! هل ستتركينهم يلوثون دمكِ على هذا النحو، هل سترتضين لنفسك أن تكوني مضغةً تلوكك الأفواه، ثم لا تلبث أن تلفظك وهي تنقل رفاتك التي لا تفنى من جيل إلى جيل؟».
رباب عبد الجبار، بطلة رواية موت مُشتهى
كتب عماد شيحة ثلاث روايات في سنوات سجنه بعد نقله من سجن تدمر إلى ظروف اعتقال أقل سوءاً، وتم نشرها تباعاً بعد خروجه من السجن. في موت مُشتهى يَحضُرُ الموت من أول الرواية إلى آخرها بوصفه مَخرجاً وحيداً من حياة قاسية لا تُحتمَل، بوصفه طريق نجاة من مصائر لا يحتملها أصحابها. تشتهي رباب عبد الجبار الموت مراراً في الرواية، ولم يكن ما بعد الموت بالنسبة لها مُخيفاً لما فيه من مجهول أو احتمالات عذاب أبدي في الجحيم، بل كان مخيفاً لأنها عالقةٌ في وضع سيجعل من ذكرها بعد الموت مُلوَّثَاً، وهي حتى عندما قرّرتْ إنهاء حياتها في المشهد الأخير، فعَلَتْ ذلك لتحمي نفسها وغيرها من أشياء تراها أسوأ من الموت.
يتحدث شيحة في موت مُشتهى عن حياة تنحدر فتصير جحيماً مستمراً لا مَخرج منه إلّا الموت، لكن رواية بقايا من زمن بابل تَعرضُ نظرة أخرى، تَرى في تَعاقُب الحياة ثم الموت، والسِعة ثم الضيق، والألم ثم السعادة، تَعاقُباً أبدياً محتوماً يُساعدنا بما فيه من أوضاع مُتعاكسة على صنع المعنى لحياتنا.
«بات الألم يصطدم بالألم فما من موضع فيك لم يستصرخ وجعاً حتى خَدِرتَ. حكوا عن الألم الضروريّ.. الألم المُطهِّر والألم النقيض، هذا الذي يشفي من الآثام ويُحلّ السكينة في الروح المُعذَّبة وذاك الذي يتموضع قطباً ضدياً للمسرّة، وفي الحالين يُستبدَل كثيرٌ أو قليلٌ منه بكثير أو قليل من السعادة تُشفي جراحاته أو بعضها وتُعِدُّ لتَحمُّلِ جرعات إضافية منه!».
بقايا من زمن بابل
لستُ أدّعي معرفةً بما كانت تعنيه الحياة وما كان يعنيه الموت بالنسبة لعماد شيحة، لكنني أعرفُ أنه في سجنه فكَّرَ كثيراً بالموت والحياة والألم والسعادة على ما تقول رواياته، وأنه عاش أصنافاً من هذه كلّها في السجن وبعده وقبله، وأنه رغم كل الألم الذي زخرت به حياته وكتاباته، عاش حياة حافلة بكل شيء، بالسعادة ونقيضها وبالألم وتجاوزه، وبالدفاع المستميت عن الحرية والكرامة والعدالة بوصفها ممكنات واقعية لا أحلاماً تدور في الرؤوس فقط.
ما زالت أسئلتي التي كنتُ أهربُ منها عندما تفاديتُ لقاءكَ بدون أجوبة واضحة في رأسي يا عماد، لكنكَ جعلتها أقلّ وطأة بابتسامتك الثابتة التي رأيتُها على وجهك مرات عدّة في تلك اللقاءات القليلة، وجعلتَ الأجوبة المحتملة على الأسئلة أقرب: يقتضي صُنعُ معنىً لحياتنا أن نُدافع ما استطعنا عن حَقِّنا في أكبر قدر ممكن من السعادة وأقل قدر ممكن من الألم، ثم أن نواجه الألم عندما يُفرَضُ علينا بأكثر ما نستطيعه من كرامة وثبات، لأنه مهما كانت طريقة موتنا مهمّة، فإن الأهم دائماً هو كيف عِشنا.