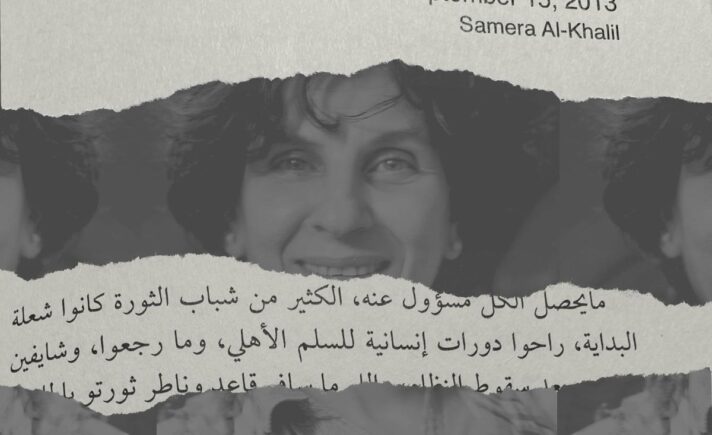قبل أن تنتحر أختي، لم أكن أعرف أنني أعيش في مجتمع بوليسي يمنع الشجرة أن تُزهر.. والقمر أن يطلع.. والنهد أن يتكوّر.. لم أكن أعرف أن صوت المرأة يمكن أن يكون عورة.. وكتاب الشعر يمكن أن يكون فضيحة.. وكتابة رسالة عشق يمكن أن توصل إلى حبل المشنقة.. بعد مصرع أختي.. قررتُ أن أنتقم لها بالشعر.
نزار قباني
كان على نزار مهمة مستحيلة، حققها بطريقة خارقة: أن يحب، لا أن يكره؛ أن يوزع العشق على الناس، لا أن ينتقم؛ أن يجعل من القَتَلة أصدقاء: أبوه، وأمه، وعائلته، ودمشق-الطبقة الوسطى، وسوريا كلها. جعل انتحار أخته، وهي صبية أكبر منه بقليل لم تتجاوز العشرين، وهو مراهق يراقب مذعوراً مقتلها، نقطة انطلاق لهذه المهمة التي استغرقت خمسين عاماً. انشطر نزار على نفسه مبكراً جداً، وانشطرت دمشق في أحلامه بين فردوس يوتوبيا حسّية، وكابوس مدينةٍ تقتل فتياتها بهمجية.
لم يُخفِ الحقائق يوماً: أمه متدينة مُتشدّدة، كما شرح في قصتي مع الشعر؛ وأبوه يسخر من النساء ويَراهُنَّ «أصل البلاء». لم يُخفِ يوماً عنّا أن هذه المدن المشرقية تخنق العشاق والعاشقات، وأنه لن يسكتَ ولن يستكين ولن يستسلم. خمسون عاماً قضاها في المنافي، كي يحرر روح أخته، وصال قباني، من القَتَلة في دمشق، وكي يزرع الحب في كل شبر حول قبرها الطاهر. وهذا الحب، ملأ روح نزار حتى فاضت به، فوزَّعه على النساء، وعلى المدن، وعلى التاريخ، وعلى المعاني.
وكي يوزع الحب مطمئناً إلى أن رسالته ستصل، أطلق نزار ثورةً لمّا تنتهي بعدُ في الشعر العربي، وهو مراهقٌ على مقاعد الدراسة. وعلى العكس ممّا يعتقد معظم القرّاء والنقاد، تكمن هذه الثورة في الواقعية لا في الرومانسية: ونزار يفخر بثورته الواقعية، ويُحلّلها ويُشرّحها. تجلّت الواقعية في اللغة والمضمون. الواقع: السيجارة، والجريدة، والفستان (أطلق عليه ناقد مصري ساخراً «شاعر الفساتين»)، والملل، والتعب، والوشوشة، والشهوة الحارقة، والنهد النافر، والانتظار المميت، والمآذن المُذهّبة، والقطط الغافية، والقهوة الساخنة، والقلق، والغيرة، والسجّاد الفارسي، والشهوة الضاربة في الروح-مرة أخرى. كان نزار أول شاعر في تاريخ العرب الحديث يكتب عن الواقع المباشر في الشعر: قبله، حتى الثورات المتعددة الشُجاعة، من البارودي إلى شوقي والرصافي- وحتى جبران، تابعت طرق الشعر التقليدي أو التجريدي؛ ولم يلتفت الشعراء اللبنانيون في بدايات القرن العشرين، الذين قَدَّرَهم نزار كثيراً، إلى السجائر والفساتين. نزار، وهو يقرأ بنهم على مقاعد الدراسة الشعرَ العربيَ الحديثَ كله، والقديم بأكمله، ويغرق في الشعر الفرنسي المعاصر، أشعل سيجارة، ثم كتب عنها. ودافع عمّا أسماه «اللغة الثالثة» بين الفصحى والعامية: وتبريره أنه يريد أن يصل إلى الناس، أن يكون معهم في قهوتهم الصباحية، في تعبهم اليومي، أن يخترق حُجُبَ العالم الفصيح البليغ، كي يجعل الشعر جزءاً من العادي. تمتلئ أشعار نزار بالكلمات العامية والأجنبية والشائعة، كأنه يُحدِّثنا وهو في مقهى الروضة، ضاحكاً بلباقة وطراوة. ونزار يؤمن بأن الشعر كُتب ليكون سهلاً بسيطاً مباشراً، كالقبلة شبه-البريئة: هذا ما جعله يُقدّر أبا نواس كثيراً؛ وفي الشعر المعاصر، اقترب من جاك بريفييه الفرنسي وتأثَّرَ به، كما ذهب إلى أقصى أشكال الحداثة العالمية تطرفاً كي يستعين بها ويستخدمها لفهم نفسه وشعره: ثورة إزرا باوند في شبابه، التي نادت بتكثيف الكلمات والصور، والتخلص من البلاغة الثقيلة.
إذن، على العكس من ثورة السيّاب العميقة في المضمون الكاشف لعمق الحياة بتكثيفها التاريخي، أتت ثورة نزار في المضمون لتكشف الوجه الآخر للحياة، الوجه اليومي العادي. توازت الثورتان في الشكل، عندما أَعلنتَا عصر قصيدة التفعيلة، كما أعلنها آخرون في مصر ولبنان، في الوقت نفسه. كان العالم العربي يغلي بالتغيُّرات، ونزار، من دمشق، يطبع على حسابه ثلاثمائة نسخة وهو تحت العشرين من قالت لي السمراء، كي يدعو إلى العشق في خضمّ ثورات الاستقلال والمظاهرات السياسية ضد المستعمرين التي شارك بها بحماسة.
أجاد نزار بطلاقة لغات ثلاث: الفرنسية والإنكليزية والإسبانية. وقرأ بكثافة الآداب العالمية من المشرق إلى أميركا. وما تعلّمه من الشعر العالمي، هو بالضبط ما تعلّمه من طفولته الدمشقية: أولوية الحواس على العقل. مثل مرسيل بروست، الذي كان معجباً به، كان نزار غارقاً في الذاكرة والماضي والطفولة طيلة عمره، وأيضاً، يشيد بحاسّة الشم كمفتاحٍ للفهم؛ فنزار، أولاً وقبل كل شيء، شاعرُ حَوَاسّْ. وهذه الحسّية المباشرة الصريحة جعلته هدفاً لسهام اليمين واليسار، المحافظين والثوريين، التقليديين والتقدميين. اتهموه جميعاً بأنه يُشيّء المرأة، ويعاملها كصنم جميل. بل في حواراته، يتكرر السؤال نفسه، عشرات المرات:
«كيف تجرأت وكتبتَ:
فصًّلتُ من جلدِ النساء عباءةً وبنيت أهراماً من الحلمات»؟
ولا بأس من أن نكرر جواب نزار: هذه القصيدة إدانة لهذا الرجل الشهواني. القسم الثاني منها يسخر من سُخفه. القصيدة كلها إدانة للذكورية السامّة، ولشهريار، ولتفاهة الرجال. المدهش أن النقاد والشعراء والقرّاء، لم يقرأوا القصيدة قبل إصدار اتهامهم السامّ.
إذن، ينبع الاتهام من خلط حسّية نزار مع تشييء المرأة. يهرب نزار من التجريد، ويعامل نفسه، والنساء، والكون، ودمشق، والدين، والفلسفة، بوصفها مواضيع حسّية، أولاً وأخيراً. يبدو هنا نزار حداثياً تماماً، مع نفحاتٍ من شعر الجاهلية (كلا التشابُهين مقتبسٌ من حواراته الذكية). الإنسان يتكون من جسدٍ، أولاً؛ فدعا إلى تحرير الجسد، والاعتراف به. أجل، سقط أحياناً في كليشيهات مبتذلة ذكورية؛ وكرَّرها في أكثر من مكان وأكثر من قصيدة وأكثر من حوار. ولكن، الفكرة الرئيسة المُوجِّهة لفلسفة نزار، واضحة وصافية ودقيقة: الحرية حريةٌ جنسية أولاً وأخيراً، فالحب حسّي في جوهره. وهذا، بالطبع، ما رفضه اليسار المتثاقف واليمين المحافظ. وحدهُ نزار دافع عن حداثةٍ تفيض باللمسات والروائح والطعوم، بدون تردد.
مفتاح فهم نزار وشعره وثورته يكمن في دمشق، في تولّهه لها: أَحبَّ عمارتها قبل كل شيء، مآذنها وقبابها ومساجدها وحدائقها، وأحب تاريخها. ودافع عن تُراثها الأموي بصراحة لا مثيل لها في التاريخ العربي الحديث (باستثناء سعيد عقل، قبل أن يكتشف أنه فينيقي). وقد يكون نزار قباني الشاعر العربي الوحيد الذي تغزّلَ بمعاوية بن أبي سفيان:
يا شـام، أيـن هما عـينا معاويةٍ وأيـن من زحموا بالمنكـب الشهبا
قرأ نزار قصيدته، «من مفكرة عاشق دمشقي»، التي يَرِدُ فيها هذا البيت، في دمشق، عارفاً بالتوتر المتصاعد في الوسط السني مع وصول علوي إلى حكم سوريا، وهو الخبير الدبلوماسي، الذي تابع الانقلابات وما حملتْه بقلب ثقيل منذ فشل الوحدة مع مصر، وعارفاً بأن دم الحسين أصبح موضوعاً أثيراً للشعراء العرب الماركسيين منذ الستينيات فصاعداً؛ ولكنه، بحنكةٍ لم تلازمه دوماً، استعاد تحديداً مَلِكَ دمشق الأشهر والأذكى: معاوية الأموي، ساخراً من الجميع، مطمئناً إلى أن التاريخ لن ينساهما.
وفي كل شعر نزار، تتردد مفردة «الأمويين»، كأنها تلخّص محبته لدمشق، إذ تكاد المدينة تدين للحكم القصير لأبناء عم الرسول بمكانتها الخاصة. ونزار، في قصائده العمودية، التي كتبها في السبعينيات، ويستعيد فيها التاريخ، يُجرِّبُ أن يتحدى الحداثة التي سادت، وينجح بشكلٍ مدهش: للمرة الأولى منذ عقدٍ، لا يكرر نفسه، وينجح في إعادة ألق الشعر العمودي، مؤقتاً، في أبياتٍ يعرف وحده كيف يسبكها؛ ليفتتح إحدى أشهر قصائده بنسيبٍ -على الأغلب- يُشير إلى ميسون بنت بحدل، زوجة معاوية، المسيحية اليعقوبية:
أتراها تحبّني ميسـون أم توهّمت والنساء ظنون
كم رسول أرسلته لأبيها ذبحته تحت النقاب العيون
يا ابنـة العمّ والهوى أمويٌ كيف أخفي الهوى وكيف أبين
يا زواريب حارتي خّبئيني بين جفنيكِ، فالزمان ضنين
واعذريني إذا بدوت حزيناً إن وجه المحب وجه حزين
ها هي الشام بعد فرقة دهر أنهر سبعـة وحـور عين
يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفونُ
قادم من مدائن الريح وحـدي فاحتضني، كالطفل، يا قاسيونُ
أهي مجنونة بشوقي إليها هذه الشام، أم أنا المجنون؟
وخاتمة هذه القصيدة الشهيرة، «ترصيع بالذهب على سيف دمشقي»، التي يشير فيها إلى حافظ الأسد، عقب حرب تشرين، لم أجدها في الطبعة التي اعتمدها بنفسه (الأعمال الكاملة الصادرة عن منشورات نزار قباني):
اركبي الشمس يا دمشق حصاناً ولك الله حـافظٌ وأميـنُ
هل حذفَ البيت، بعد أن اصطدم بالنظام مراراً؟ ولكن القصيدة نفسها فيها انتقادات حادة للنظام القائم وللطغيان، تشبه ما قاله منذ حزيران 67 وليست -مع احتفاليتها بحرب تشرين- تمجيداً للعسكر، بل تمجيداً للشام ولشَغفه بها. هل البيت موجودٌ فعلاً في النسخة التي قرأها في المهرجان؟
لاحقاً، سيُشير إليه باسم أبي لهب، كما في قصيدة بلقيس، زوجته العراقية التي قُتلت في تفجير السفارة العراقية في بيروت، حيث كانت تعمل موظفة في القسم الثقافي، تفجيرٍ قامت بها ميليشيات شيعية عراقية برعاية المخابرات السورية لتوجيه رسالةٍ إلى صدام حسين:
لا سِجْنَ يُفْتَحُ..
دونَ رأي أبي لَهَبْ..
لا رأسَ يُقْطَعُ
دونَ أَمْر أبي لَهَبْ..
بالطبع، لم يقتصر شعر نزار على الرموز السُنّية. تحفل أشعاره، كأشعار معاصريه اليساريين والثوريين، بالرموز الشيعية الكربلائية (والقُرمطية أيضاً) بما فيها قصيدة بلقيس، قصيدته الشخصية بامتياز. ولكن نزار لم يخشَ أن يعترف بالتاريخ بكل أبعاده، السُنّي وغير السُنّي؛ وقد سمّى أبناءه من بلقيس: زينب وعُمر.
وعلينا أن نقرأ القصائد العمودية هذه كما نقرأ الشعر القديم: أي أن نهمل القسم الثاني منها المختص بالأغراض الشعرية الهامشية (المدح والهجاء والفخر)، ونكتفي بالغزل والوقوف على الأطلال والحنين والحِكَم. هذا ما ينصحنا به أستاذنا يحيى حقي بخصوص ديوان البحتري، وهذا ما فعله أدونيس في مختاراته الخالدة ديوان الشعر العربي: المطالع الغزلية والشخصية أكثر أهمية، وأرقى، من الهجاء أو المدح الذي يتبعها. بهذا المعنى، قصائده العمودية القليلة، تشكل إحدى ذرى الشعر العربي الحديث والقديم معاً: فيها جزالة القدماء، وحساسية المعاصرين الشخصية.
أكثر من ذلك، على عكس نرجسيته المملة، وممالك العشق التي يحكمها على ما يقول لنا في حواراته وقصائد التفعيلة، يتساءل بحرقة في قصائده العمودية:
فرشتُ فوق ثراكِ الطاهر الهُدُبا فيا دمشقُ، لماذا نبدأ العتبا؟
حبيبتي أنت فاستلقي كأغنيةٍ على ذراعي ولا تستوضحي السببا
ثمّ:
أتراها تحبني ميسـون أم توهمت والنساء ظنون؟
ما وقوفي على الديار وقلبي كجبيني، قد طرّزته الغضون؟
لا ظباءُ الحِمى رَدَدْنَ سلامي والخلاخيلُ ما لهنَّ رنين
وأخيراً:
إني الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت بغنائه الأعشاب
أين اللواتي حبهنّ عبادة وغيابهنّ وقربهنّ عذاب؟
أحببتهنّ وهنّ ما أحببنني وصدَقتهنّ، ووعدهنّ كِذاب!
في القصائد العمودية، التي يُسائل فيها الحداثة، ينشطر نزار على نفسه، مذعوراً مُرهَقاً تَعِباً: هل كان النرجسي، الحاكم على القلوب، يتضعضع أمام القادم، وأمام الماضي؟ هل كانت نرجسيته مجرّد قشرة تفاحة، يخبّئ خلفها خوفه من دمشق، ومن نسائها، ومن نسيانها؟
ربما، كان يخافها ويخشاها ويرهبها. ينتمي نزار إلى عائلةٍ من أصول تركية -آقبيق، التي عُرّبت إلى قباني- كما هو حال الكثير من النخب العثمانية المدينية التي أصبحت عربية الثقافة وتبنّت القومية العربية (أحمد شوقي من أصول كردية، ومحمود سامي البارودي من أصول مملوكية، وغيرهما الكثير). قد يقول المرء إن نزار لا يعرف دمشق: غادرها وهو في الثانية والعشرين من العمر، ليعملَ ديبلوماسياً في وزارة الخارجية السورية، ولم يعد إليها إلا بعد خمسين سنة كي يُدفن فيها. تمسّكَ نزار بدمشق-طفولته، وحين يقول لنا إنه طفل، فهو حرفياً يعني ذلك: بقي يحلم بدمشق التي تفتّحَ فيها شعره، ورفض أن يعود إليها طالما يحكمها خصومه العسكر. في منتصف الستينيات، استقالَ من السلك الديبلوماسي، الذي أخذه إلى مصر وإسبانيا والصين وتركيا وفرنسا وبريطانيا، ليستقر -ليس في دمشق، بل في بيروت، التي أحبها وتزوّج فيها بلقيس الراوي؛ ثم غادرها، بعد مقتلها (1981) واجتياح الجيش الإسرائيلي لبيروت (1982)، إلى لندن (بعد فترة من التنقلات القلقة في مدن أوروبية)، التي أحبها أيضاً، ولكنه شعر فيها بالوحدة: بقي نزار يحلم بدمشق، ويلعن حكامها ليل نهار، ويكتب لها قصائد لا تشبهها كثيراً.
وقصة انقسام مثقفي سوريا بين الريف والمدينة مُعقَّدة، وتفتح جروحات تكررت كثيراً في ثورتنا الأخيرة المهزومة: في الحقيقة، كثرة المثقفين تنتمي إلى الأرياف، وإلى الأقليات. يعتقد البعض أن «مثقفي الأقليات والأرياف» انحازوا إلى السلطات اليسارية على حساب المدن السنّية، وفي هذا شيءٌ من الصحة. إذ، عقب الاستقلال، لم تُقدِّم المدن البرجوازية السنّية الحاكمة للأرياف السورية المُعدَمةِ التنميةَ، بل ولم تَعدِهُم حتى بها. على أية حال، يأتي نزار قباني هنا ليخلط ويخبط الأوراق: أشهر كاتب في تاريخ سوريا الحديث، دمشقي تماماً، من أصول سُنّية، ولكنه ثوري حتى النخاع، أكثر من اليساريين. لا يوجد، في حياته أو في شعره، ما يمثّل البرجوازية السنّية الدمشقية، أو الميول المحافظة التي يشتهر بها الدمشقيّون. يعترف نزار، في قصتي مع الشعر، بأن الثورة على الفرنسيين بدأت في الأرياف ثم وصلت المدينة: لا يوجد، على الإطلاق، ما يوحي بتعاليه على الريف، أو على أحد. ولكن، لا يوجد أية ميول ريفية في شعره، أيضاً. إذ يكتب نزار عن المدن، وليس عن الشعوب أو البلدان أو الأرياف: دمشق وبيروت، والقاهرة وبغداد، ولندن وباريس. نزار شاعر مدينة: شاعر مدينة لا يمثّلها، بل يمثّل الحب القتيل في شوارعها، شاعرٌ «وحّدَ من حوله مفارقات هائلة في التاريخ الراهن، على المستوى الشعري، والنثري»، بحسب سليم بركات، ابن الريف السوري بامتياز، والنقيض الكامل لنزار في لُغته وفي شعره.
شجاعة نزار الفائقة في حرب لبنان جعلته فريداً بحقّ: انقسمت البلد تماماً بين اليمين واليسار، ورفض نزار، كلياً، وبصلابة لم يَحِد عنها، أن ينحاز إلى اليسار: أدونيس، ومحمود درويش، وسعدي يوسف، وحيدر حيدر، ومظفر النواب، وسليم بركات، وعشرات غيرهم، ملأوا ساحات بيروت للدفاع عن منظمة التحرير. نزار رفض، رفض الانصياع لمنطق الحرب الأهلية. مدهشةٌ قدرة شاعر وحيد، بدون سلاح سوى محبة الجمهور له، على الصمود في وجه فاشيّة اليمين الماروني، وسطوة ياسر عرفات، وعنف حافظ الأسد: وحده، بقلمٍ مُتعب، وسنين أنهكت ظهره وقلبه، وأخذت أخته وابنه وزوجته منه، تحدّى العالم، ليدافع عن بيروت، ست الدنيا، بحسب الدمشقي المنفي فيها. كان باستطاعته أن يصمت، وأن يبقى يبيع عشرات آلاف النسخ من كتبه: ولكنه رفض الصمت، بل أخذ يُشهِّرُ بالقَتَلة، في بيروت، ويكتب في بيروت، ويقرأ شعره في بيروت. لا شيء يخيف نزار، لا شيء يوقف نزار، عندما يحبّ: وقد أحب بيروت، كما يحب مراهقٌ فتاةً لا يستطيع الصبر على قبلاتٍ يتبادلها معها في …
وبسبب بيروت، قُذفت في وجهه اتهامات بأنه برجوازي، وشاعر الجنس. تحوّلَ نزار إلى دريئة لشعراء ومثقفين لا يفهمون نبله وشهامته وشجاعته. لم يصمت نزار، وردَّ بِحدَّة صارخة: شاعرُ المرأة، لأن حرية المرأة قبل حرية الوطن؛ وأنتم ماركسيون، وشعوبكم تموت من الجوع؛ ماركسيون، وتكتبون ما لا يُفهَم؛ ماركسيون، وتتعيّشون على موائد سفاحين.
وبسبب بيروت، أيضاً، لم يُشِر إلى «الأحداث»، كما سمّت سلطة حافظ الأسد المعارك المسلّحة وغير المسلّحة بين 1978 و1982 في سوريا، أي تحطيم نظام الأسد للمقاومة المدنية بكل أشكالها، الذي ترافق مع صراع مسلّح بين «الطليعة المقاتلة» السُنّية والنظام بوجهه العلوي المُسلّح ممثلاً بعسكر رفعت الأسد، وتُوِّجَ بمجزرة حماة. لم يتطرق إلى هذا، بل شغلته حرب لبنان عن المجازر في بلده، في موقف كَرَّره معظم المثقفين السوريين والعرب تقريباً (باستثناء أحمد فؤاد نجم وناجي العلي، اللذين لا يسكتان على ضيم): سوريا اختفت من خرائطهم، وبقي اجتياح بيروت هَمَّهم الوحيد. حتى نزار قباني، الذي وعدنا بأن يجعل واقعنا هَمّه الأول والوحيد، أشاح بناظريه عن دمنا المسكوب غزيراً على النواعير.
معاركُه كثيرة، وكان يخرج منها نصف-منتصر. أشهرها، وأهمها، معارك متجددة مع نجيب محفوظ. ثلاث مرات تشابك الكاتبان: بعد اتفاقية كامب ديفيد، وبعد اتفاق أوسلو، والأهم -طبعاً- بعد جائزة نوبل. اختلف الكاتبان على اتفاقيتي السلام بشكل كامل، ولكن نزار فاجأ نجيباً وصحبه، عقب نوبل، بمقال ساحر: «رسالة حب إلى نجيب محفوظ»، يحتفي بالجائزة، بكل بلاغته ومبالغاته التي لا يستطيع ضبطها. التهمة السخيفة التي أطلقها يوسف إدريس وأمثاله، القائلة إن محفوظ حصل على الجائزة بسبب موقفه الداعم للسلام مع إسرائيل، لم يتوقف عندها نزار، الذي كان هو نفسه في طليعة منتقدي محفوظ بسبب موقفه المؤيد لاتفاقية كامب ديفيد قبل عقد من الزمن! في حين حركت الغيرة معظم مُجايلي محفوظ، وخصومه، وأدعياء المقاومة، احتفل نزار بصدق بالجائزة، وبمحفوظ؛ لم تمنعه خلافاته مع محفوظ من الموضوعية الصادقة: الإعجاب بأستاذ الرواية العربية، الإعجاب غير المحدود، الذي سفحه في مقاله ببهاء وعذوبة.
وقد تعرّضَ نزار إلى انتقادات دائمة وحادة بسبب دبلوماسيته ونبله وتَعفُّفه عن الشتائم. وربط البعض، بخبث، بين طبائعه الدمشقية الوسطيّة الشهيرة وبين دبلوماسيته: ألقى نزار قصائد في مهرجانات بغداد تحت ظل صدام حسين حتى منتصف الثمانينيات (قبل حملة الأنفال، ولم يعد إلى بغداد بعدها). تفاءل بحكم القذافي قليلاً في بداية السبعينيات، كما غازل غرور حكام الخليج، وأرضى غرور أنظمة أخرى -بما فيها النظام السوري- في نثره، وفي مقابلاته الصحفية والتلفزيونية. يبدو أنه ترك للنثر أن يقترب من المديح، حين يقتضي الأمر، لا الشعر. مُيوله العروبية، وعواطفه المُشتعلة، جعلته دوماً يتفاءل بنجاحات شكلية، ثم يعود عنها سريعاً، ما أن تتضح له الصورة. والأهم: حتى عند اقترابه من الحكام، لم يبتذل نفسه وشعره، بل بقي محافظاً على كرامته الشخصية والشعرية، ولم يتورط يوماً في قصيدة مدح حاكمٍ -باستثناء جمال عبد الناصر، بعد وفاته. وتمسَّكَ باستقلاله الكامل بين بيروت ولندن. كذلك، لم يُسمِّ القادة الذين ينتقدهم ويهجوهم؛ ولكن الإشارات إلى العقيد وأبي لهب والديك وإقطاعيات النفط وكافور، تكاد تنطبق -زمن كتابتها وفي رمزيتها- بشكل مباشر على معمّر وحافظ وصدام وفهد والسادات.
زار نزار، إذن، مراراً مدنه العربية، بعد أن هجا حكامها بقسوة. وفي دمشق، تُحكى أساطير عن قراءاته المتفرقة القليلة فيها منذ هجومه على حكامها عقب النكسة: استقبال وزير الدفاع مصطفى طلاس في المطار للشاعر، وملازمته له طيلة الزيارة (يتذوق طلاس الشعر، ويتمتع بسمعة المثقف الخليع المعتدلة المحيّرة، التي توازي سمعة فساده الشهير)؛ مدة الزيارة القصيرة جداً؛ عدد الجمهور وطبيعته؛ وغير ذلك. تمتّعَ نزار بذلك النفَس النبيل الدبلوماسي اللطيف الهادئ دوماً، وبأرستقراطية متأصلة في روحه، لا تتناسب مع ثورته العاصفة الدائمة. إذ تتعدد نفوس نزار، ولا تغلب دبلوماسيتُه الشهيرةُ ثورتَه: لم ينحنِ يوماً لأحد، ولا حتى للخالق، الذي صوره في نثره وقصائده على أنه شاعرٌ ملهِم.
محمود درويش، في خاتمة حياته، عاد إلى نزار: الصلة العائلية بين الرجلين معروفة (تزوّج درويش من ابنة أخ نزار لفترة قصيرة)، والأشهر، الرباط الرومانسي الوثيق: درويش رومانسي-حتى عندما يكتب بتجريدٍ. وعندما راجع تجربته في كهولته، في جوهرها: لماذا يعيش الشاعر؟ اكتشف أن جواب نزار الواضح المباشر أصدق من الصوت العالي للثوار المتفزلكين وللحداثة المتفلسفة؛ إذ بحسب نزار، الخاصُّ قبل العام، بل، لا يوجد تحرير على المستوى العام بدون تحرير على المستوى الخاص. ثار درويش على نفسه، وتحوّلَ نحو العشق كمبدأ حيوي للكون وللشعر ولفلسطين نفسها، بدءاً من ديوان سرير الغريبة حتى وفاته. وفي ديوانه الأخير، كتب لنزار قصيدة ناضرة، فيها يصف نزار نفسه، على لسان درويش: «أنا شاعر الضوء والفُلّ.. لا ظلَّ.. لا ظلَّ في لغتي».
بحسب نزار، الخاص قبل العام: في الجنس، والدين، والسياسة. وفي هذه الأمور الثلاثة، حافظَ نزار على رؤية ناصعة واضحة طيلة حياته.
يُفاجئنا نزار بعمقه، بوضوحه في الدفاع عن الحرية الجنسية: لا يختبئ خلف أقنعة علمانية ليقول ما يريد: بل يقوله مباشرة؛ ليس فقط في شعره، بل حتى في حواراته ومقابلاته، بجلاءٍ كامل وناصع، كأنه لا يخشى شيئاً، ولا حتى غضب جمهوره.
يدهشنا نزار بصراحته في نقد الدين: يرفض العفّة الشكلية، وتقييد الجسد والروح. بالنسبة إليه، الله شاعر، والكتب المقدسة متساوية، وكلها تعبيرات عن الجمال: من بوذية التيبيت إلى الرقص الإفريقي الطقوسي إلى صلوات الفايكنغ، وصولاً إلى نشيد الأنشاد في العهد القديم: يقدّم نزار صورةً جمالية للدين. لا يرفض نزار أن يصلي الناس، أو يصوموا، أو يتعبّدوا؛ ولكنه يرفض، بشكل جازمٍ، أن يفرضوا عليه، وعلى العاشقات والعاشقين، طقوسهم.
يصدمنا نزار بتمسكه الصلب بليبراليته الفردانية المتحررة القاطعة. وبها، واجه الأنظمة القائمة: الملكيّة والجمهورية. وهذا ما لم يفهمه نقاده اليساريون. تُذكرنا ليبراليته بنجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وطه حسين؛ ومثلهم، اقترب من ناصر وأَحبَّه وانتقد قمعه، ومال إلى اليسار حالماً بالعدالة الاجتماعية، ولم يلتزم بالماركسية على الإطلاق. بدون حزب وراءه، بدون كتائب فكرية، بدون نَوعَي الدعم المادي اللَّذين ساعدا الثقافة العربية المسكينة الفقيرة على الدوام: بدون دعم حكومي من مشايخ النفط أو الأنظمة المُتمركسة القومية، وبدون دعم غربي بمؤسساته الرسمية أو المستقلة؛ بل بدار نشر صغيرة في بيروت التي تأكلها الحرب، تحدى الموروث والحاضر والحلفاء والخلفاء والخصوم، بل وحتى جمهوره.
وتملُّقه للجمهور أمر محيّر: ذلك الذي ينتقد الدين، ويدعو إلى الحرية الجنسية، ويتمسّك بالليبرالية الفردانية، هو نفسه من يريد للناس، لكل الناس، أن تقرأ شعره. مرة أخرى، ينشطر نزار على نفسه، يتعدّد. وفي واحدةٍ من لمحاته الساحرة، يحدد جمهوره بدقة: أولئك الذي يحبون عادل إمام ودريد لحّام. هذه الدقة هي ما جعلته بالضبط الشاعر الأكثر مبيعاً. يفخر نزار بما فعله: يفخر بأن شعره يقرأه كل الناس، ويفهمه كل الناس، ويردده كل الناس؛ يفخر بأنه حوّلَ القصيدة إلى أغنية دارجة على كل لسان. يتجلى في هذا رغبة عميقة بدمقرطة الثقافة، وباستخدامها كرسالة لإصلاح العالم: لا يخفي نزار انحيازه إلى موقف يساري بشكل كامل في هذا الخصوص، في أن يجعل الفن في خدمة التغيير الاجتماعي.
ترك نزار للملحنين حرية التصرف في قصائده، بذكاء. الرومانسية المبالغ فيها شجعت حليم ونجاة وكاظم. وللأسف، يتعالى معظم المثقفين على نزار وحليم، كأن الرومانسية والجماهيرية عيوبٌ يجب تفاديها. وفي «قارئة الفنجان»، آخر ما غنّاه حليم قبل موته، حزنٌ غير مفهوم، ملحمي، ما ورائي، يُلائم مكانة حليم وصورته وصوته، وعبقرية ألحان محمد الموجي التجديدية الشجاعة. «زي الهوى» و«أي دمعة حزن» و«موعود»، يجب أن تُرفَقَ بالرسالة من تحت الماء وبالفنجان المقروء. في هذه الأغاني شجنٌ صادقٌ، يشبه جيلاً حلم بالكثير، وخسرَ تماماً في النهاية. لا يستطيع المرء ألا يفكر بارتباط حليم العضوي بثورة يوليو والثورات المجاورة، بأحلامها، بصعود طبقات مسحوقة جدية جديدة، بتحطُّم الأحلام كلها على صخرة القمع، ثم بحرب حزيران، ومنع نزار من دخول مصر عقب نشره هوامش على دفتر النكسة.
يكاد معظم شعر نزار يغلي حزناً. لم يلتفت النقاد إلى حزنه ووحدته، ولكن الجمهور حَدَسَ بما يدور في قلبه: ربما، بعد غربته عن دمشق، بعد انتحار أخته، بعد موت ابنه (سنة 1973، استسلم قلب توفيق قباني وهو في الثانية والعشرين من عمره)، بعد مقتل زوجته بلقيس، أصبح الحزن وجهه. حزنٌ وشَجنٌ على مقاس الكون. لطالما ترافقت الرومانسية الأوروبية مع حزنٍ مديد، وفي هذا، تتقاطع مصائب نزار الشخصية مع البعد العالمي الحزين للرومانسية.
بالإضافة إلى الحزن، تفيض القصائد بالعنف: الحب ذبّاح، والسيّافون متأهبون، والعشاق شهداء. وباستثناء بعض القصائد الناعمة، لا تشبه رومانسيةُ نزار الرومانسيةَ الغربيّة في هذا، بل تقتبس جزالة البلاغة العربية، لتجعل الحب حرباً لا هوادة فيها: حرباً، يطلب منا نزار، رجالاً ونساءً، أن نخوض فيها كل يوم، بدون تردد. فالحياة، والحب، حقول طاقة نعيشها بكل عنفوان ورغبة وتوتر.
كان نزار يتابع بحماسة التجارب الجديدة حوله، وكان معجباً بتجربة مجلة شعر الثورية، وبإبداعات أدونيس الغنية، وبقصيدة النثر التي قدمها أُنسي الحاج، ومتفائلاً بمستقبل سعدي يوسف، وعلى علاقة طيّبة أدبية وشخصية مع محمود درويش، وسليم بركات، وغيرهما. تحفّظَ على بعض ما قدّموه، وانتقدهم -بشدّة أحياناً- هنا وهناك، ولكنه كان مشجّعاً على العموم للتجارب الواثقة الجديدة والمثيرة. ونزار، الذي فتح باب قصيدة التفعيلة على مصراعيه، احتفى بقصيدة النثر، وكتبها، بعد سنواتٍ قليلة من قصائده العمودية الباهرة. ربما كان الوحيد في القرن العشرين الذي امتلك ناصية الأساليب الثلاثة بطلاقة لا مثيل لها: الشعر العمودي، وقصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر. محبته للشعر وللحب جعلته يكتب ويكتب ويكتب؛ ويُشرّع قلبه لكل أشكالهما وتجلياتهما.
لا أريد أن أبالغ كثيراً؛ معظم شعره مكرر، خصوصاً في العقدين الأخيرين من حياته. ولكن ثورة الدواوين المبكرة، ومعجزة القصائد العمودية، إنجازات باسقة. وسيرته الشخصية، قصتي مع الشعر، بصدقها الحار، وعمقها الرومانسي، وأصالتها غير المتكلفة، تستحق مكانة خاصة في فهم تاريخ سوريا الأدبي، وتكاد تضاهي أيام طه حسين أو خبز محمد شكري الذي لا يُشبِع. والحوار-الملحمة مع مجلة الكرمل، حوارٌ يتسلّى فيه نزار أمام أسئلة عميقة نزقة، جارحة ومُحبة في آن معاً، من شباب (سليم بركات ومحمد علي شمس الدين وبسام حجار وعلوية صبح ومحمد أبي سمرا) في عين الحرب الأهلية اللبنانية، يكاد يكون مرآةً صادقةً لنزار وخصومه والمُحتارين فيه. وهناك، بالطبع، دوره المحوري والاستثنائي، في اختراع الواقعية والرومانسية معاً، في الأدب العربي الحديث. وفوق كل ذلك، النبل الشخصي: نبيلٌ عندما يخالف الخصوم وعندما يعشق، لبقٌ مهذّب، أنيقٌ كطاووس أندلسي أو باريسي، رحيمٌ ليّن- بابتسامته التي تفتح حتى قلوب الكافرين بالشعر، وصوته الرخيم الدمث كراهبٍ طاويّ، وعينيه الزرقاوين كصباحاتٍ صيفية…
لم يتراجع نزار يوماً: لا أمام الأئمة، ولا أمام اليساريين، ولا أمام جماهيره، ولا أمام الحُكّام. وأصبح أمير الشعر العربي الأكثر جماهيرية، بلا منازع. مع ذلك، عاش عقده الأخير وحيداً مريضاً في لندن. رفضه اليسار واليمين، ولم تعترف به الحداثة العربية عموماً: احتلّ القادمون الجدد، الماركسيون والثوريون والمتحذلقون والموهوبون، مكانه.
جنازته فاجأت السلطات السياسية والدينية. الحضور النسوي السافر، الضخم، الواثق، منذ وصول النعش المطارَ إلى ما بعد مُواراته تحت التراب، أثبت أن دمشق لم تنسَ شاعرها. لم تخرج دمشق المكسورة عن بكرة أبيها لوداع ابنها البارّ، ولكن سرى فيها روحٌ شجيّ، كعودة نيسان، من الغوطتين إلى «مأذنة الشحم». ولأول مرة في تاريخ سوريا، نساءٌ في الجنازة، في التشييع، في المقبرة، يودّعنه بجسارة وحنان؛ مادَت المدينة وماجَت، استقبالاً للعائد إلى أنهره السبعة، والنعش يطفو، تشيّعه النساء والرجال اللواتي انتقمن بالحب والرفض؛ اختلطت الطبقات والأجيال والأنغام في صوتٍ متعدد متشابك صافٍ، يعلو ويعلو ويعلو: تُتلى قصائده الدمشقية العمودية، وتتسامى العراضات الشامية، وتُرتّل سور القرآن الكريم، في الجنازة التي طافت به من جامع بدر إلى مقبرة العائلة في «باب الصغير»- أمام أعين السلطات الجَزِعة، التي ملأت مخابراتها كل الشوارع، حائرةً خائرةً أمام ياسمينه، وقططه، وهُدُبه. وفي ساعات الجنازة القصيرة، أضحت دمشق بلا أسوار، أضحت كلها حديقة دار أبي المعتز وفائزة ووصال، بكل شوارعها وزواريبها ومساجدها وكنائسها ومكتباتها ومدارسها ومُخالفاتها وناسها، حديقة تفّاح ونوّارٍ وقدّاحٍ، من مداخل الزبداني إلى سعسع!
عاد نزار إلى دمشق، بعد خمسين عاماً في الغربة، ليغني موّاله الأخير:
لقدْ كَتَبْنا .. وأرسَلْنا المَرَاسيلا وقدْ بَكَيْنا .. وبَلَّلْنا المَناديلا
قُل للّذينَ بأرضِ الشّامِ قد نزلوا قتيلُكُم لمْ يَزَلْ بالعشقِ مقتولا
هواكَ يا بَرَدَى كالسَّيْفِ يسكُنُني وما مَلكْتُ لأمرِ الحبِّ تَبديلا
أيّامَ في دُمَّرٍ كُنّا .. وكانَ فَمي على ضفائرِها حَفْراً وتَنزيلا
والنهرُ يُسمِعُنا أحلى قصائدِه والسَّرْوُ يلبسُ بالسّاقِ الخَلاخيلا
يا مَنْ على ورقِ الصفصاف يكتبُني شعراً، وينقشُني في الأرضِ أيلولا
يا من يعيد كراريسي ومدرستي والقمحَ، واللوزَ، والزرقَ المواويلا
يا بلدةَ السبعة الأنهار .. يا بلدي ويا قميصاً بزهرِ الخوخ مشغولا
وددتُ لو زرعوني فيكِ مئذنةً أو علقوني على الأبواب قنديلا
مئذنةً أموية، يا نزار، مئذنةً ترفع ابتهالات حسّية، وعطراً، وعشقاً -سيأتي يومٌ- لن نخفيه، بعد كل ما قيلا.