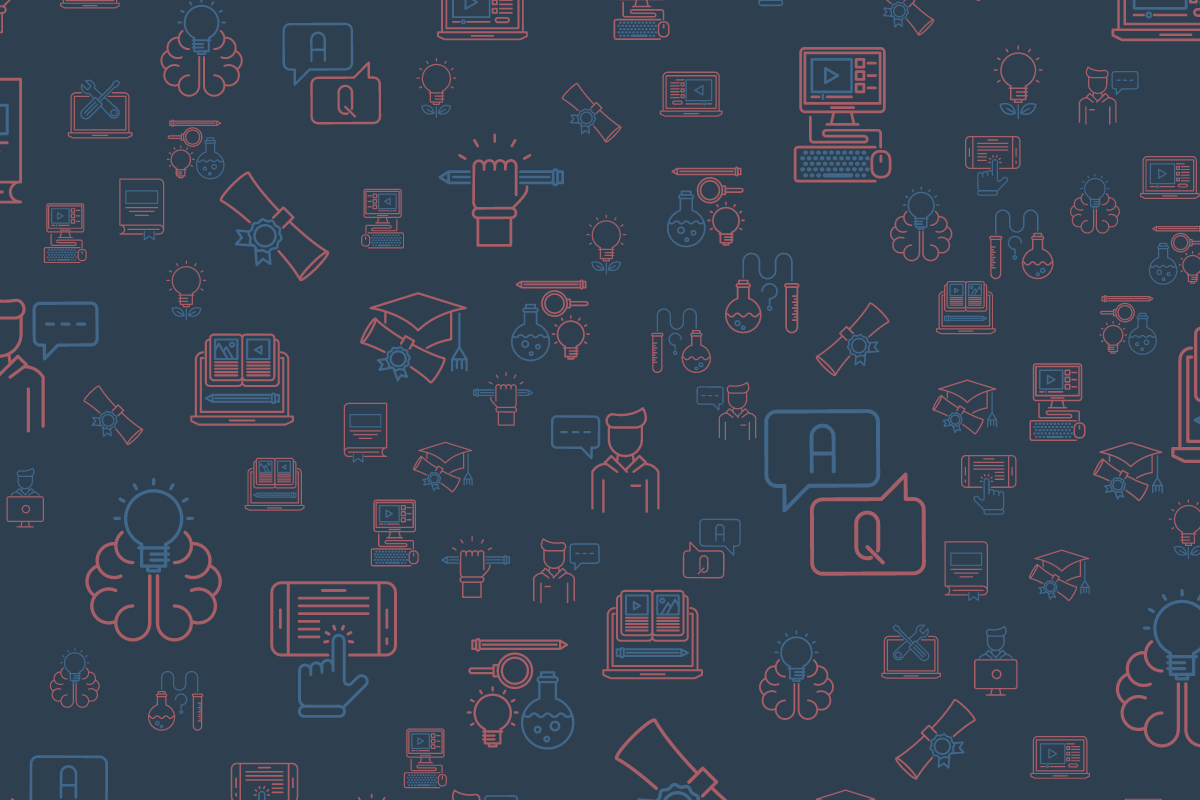عندما أفكر بشباب وشابات سوريا اليوم، فإن أول من أتصوّره هو الطفل الذي كان عمره أربع سنوات في 2011 وبلغ اليوم السادسة عشر من عمره، أو البنت التي كانت ذات اثني عشر عاماً في 2011 وصار عمرها اليوم أربعاً وعشرين. شباب سوريا اليوم هم حقاً ذريّة الحرب. عقولهم-ن، وشخصياتهم-ن، وشعورهم-ن بالانتماء جميعها شكّلتها مناظر العنف ومشاهد الدمار، والمصاعب التي مرّوا ومررنَ بها خلال سنوات النّماء المفصلية في مرحلة الطفولة. يقودنا هذا الواقع القاسي إلى التساؤل حول المعاني والأحاسيس التي تشكّلت لديهم خلال النمو في ظل الصراع. تخطرُ لي بعض الأسئلة الأساسية للغاية عندما أفكّر بالتجارب الحياتية التي شكّلت شباب سوريا اليوم، الذين يعيشون الأزمة المستمرة لبلد مزقته الحرب: ما نوع النكات التي يضحكون عليها؟ ما الأحلام التي تراودهنّ؟ ما الذي يلمس عقولهم-ن وقلوبهم-ن، ومن قدوتهم-ن؟ هل الحب موجود في حياتهم-ن؟ وفي هذا الواقع المضطرب والمحطم: ماذا الذي تعنيه سوريا لهم ولهنّ؟
إن مقولة غوته الشهيرة، التي تَبُتُّ بأن «مستقبل الأمّة يعتمد على شبابها» هي في الواقع مقولةٌ جدليّة واستفزازية في السياق السوري. فرغم بداهتها الظاهرية، إلى أي مدى تنطبق على الشباب السوري اليوم؟
يلعب الشباب – وضوحاً – دوراً حيوياً في بناء الأمّة. ولكن في دولة مُدَمّرة، أيُّ مستقبلٍ يمكن للشباب تحقيقه، وهم منسيّون، بلا صوت، وغير مجهزين بالقيم والمعارف والمهارات التي تسمح لهم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل؟ إن الحالة المُفزعة التي وصل إليها الشباب السوري حسبما أظهرت دراسة حديثة أجريت في إحدى عشرة منطقة من البلاد،(1) لها ثلاثة أوجه:
أولاً، إبطانُ الخوف: لقد أصبح الشباب السوري خاضعاً بشكل تام للواقع المعيشي بعدما فهمَوا أسباب العنف وانعدام الأمن والظلم والفقر المتزايدين، وفَشَل النظام الذي يحكم حياتهم اليومية. ولتجنُّبهم الواضح ذِكرَ الجهات المسؤولة عن هذا الوضع أو حتى الإشارة إليهم، فقد اكتشفَ الشباب السوري مصدر خوفهم الكبير، وتحوّلوا بذلك من جيل «التحرر» إلى جيل الخوف والقهر.
ثانياً، فقدان الإيمان بقيمة التعليم: إن إحدى أكثر التداعيات ضرراً على حياة الشباب السوري هي محدودية استجابات التعليم في حالات الطوارئ التي طبّقها القطاع الإنساني في سوريا، بقيادة وكالات الأمم المتحدة وشركائها من منظمات دولية ومحلية. نموذج الطوارئ في الأساس استجابةٌ تعليمية مقيَّدة، تركّز على «الوصول» إلى التعليم الابتدائي وتقديم الدروس الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات، على حساب «الجودة» وأيّ شكل من أشكال التكييف السياقي. كما أنها استجابةٌ تقطع استمرارية العملية التعليمية، ولا تُوفِّرُ المسارات والحلول اللازمة للفئات العمرية بعد المرحلة الابتدائية. الأسوأ من ذلك هو اتّباعُها نهجاً لاسياسيّاً في نموذجها، يُطبَّق للمفارقة ومعظم الوقت، في سياقات بالغة التسييس. يتعارض لاتسييسُ التعليم في حالات الطوارئ، وبشكل تام، مع الحاجة الماسّة إلى خلق التضامن ودعم التماسك الاجتماعي وتنمية قيم المواطنة والديمقراطية وبناء السلام، لأنَّه يحرم الشباب من الأدوات المعقدة التي تُعِدُّهم لمواجهة الانقسام المتزايد، والسلطة الأبوية، والقوى الأصولية. وبدلاً من ذلك، يضمن لهم تعليماً رديء الجودة وغير ذي صلة بمصاعبهم أو احتياجاتهم الخاصة. كذلك، من أخطر النتائج التي اضطر الشباب في سوريا إلى تحمّلها هو عدم اعتماد أو إقرار الشهادات الصادرة خارج مناطق سيطرة النظام السوري، الأمر الذي أعاق الكثير من المراهقين والمراهقات عن متابعة تعليهم-ن أو إيجاد أي قيمة في مواصلته، خصوصاً مع تدهور الوضع الاقتصادي، واتساع الفجوة بين التعليم والتوظيف. موضعُ تقصيرٍ مهم آخر هو إهمال التعليم الفني والمهني خلال الأزمة، والتهاون بأهميته كجسر وصل بين الدروس النظرية والمهارات اللازمة لتحصيل فرص كسب العيش.
الحقيقة الثالثة هي نتيجة الحقيقتَين المذكورتين أعلاه، وهي التهديد المتمثل بضياع جيل كامل. إن الشباب السوري اليوم وحيد، بلا صوت، أحلامه مطموسة، وإمكانياته مسلوبة. إنه جيل مُحاصَر، يلجأ إلى آليات تَكيُّف سلبية مثل تعاطي المخدرات والزواج المبكر وحمل السلاح، ويسعى الكثيرون من أفراده إلى الهرب ومغادرة البلاد فحسب. (2)
تكمن المعضلة التي يواجهها الشباب السوري اليوم في عجزهم عن التوفيق بين الهوية الفردية المحطّمة، والهوية المجتمعية التي تعاني من الاغتراب. تتشكل الهوية الفردية من عدة ذوات تشكّل معاً ذاتاً متكاملة لدى الإنسان، أما الهوية المجتمعية فتوسّع نطاق الهوية الفردية عبر الانتماء إلى الأرض أو اللغة المشتركة أو غيرها، وتساهم في تشكيل الديناميات الاجتماعية وإعادة بناء هوية جماعية موحدة. (3) لكن هويات الشباب والشابات الفردية في سوريا تشكّلت خلال سنوات من الصراع المدمِّر، وقامت على أُسس النجاة والبقاء على قيد الحياة في وسط الفظائع والخراب والحرمان، الذي بدلاً من أن يساعد على توحيد الهويات المجتمعية، أسفرَ عن مزيد من الانقسام والشعور بالخوف والعداء المتبادل. إن اللحظة التاريخية التي عاشها الشعب السوري في 2011 كانت بالأساس تحطيماً للخوف، بدَّدتها رؤية قصيرة النظر فشلت في تعزيز المطالب المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية عبر ترسيخ قيم وممارسات المواطنة وحقوق الإنسان في أسس العملية، ومنذ أولى مراحل النشاط الشعبي والمجتمعي؛ وفشلت بالتحديد في إشراك الشباب السوري وتمكينه، رغم أنه رأس المال الأكثر أهمية وفعالية لتحقيق التغيير المرجو.
لطالما اعتبرتُ قطاع التعليم، منذ أولى سنوات الثورة، أكثر من مجرد قطاع خدمي أو معوناتيّ، بل قطاعاً قوياً واستراتيجياً يمكنه التحريض على التغيير وتحدّي المعايير السائدة في المرحلة التاريخية التي يمرَّ فيها الشعب السوري. لكن هذا القطاع إذ وقع في أيدي أطراف الصراع وسلطات الوضع القائم في سوريا، أصبح جزءاً من اقتصاد الصراع، وأداة تُغذِّي العداوات والتفرقة والسُّلطة الأبوية عبر إنتاج مناهج مسيَّسة تخص كل منطقة تحت قيادة مختلفة. وكما يقول باولو فريري، إن التعليم محفّز للانعتاق وتحرير الشعوب من الاضطهاد، (4) إلا أن التعليم الذي يقصده يتطلب «بيداغوجيا تحرّرية» أكثر تقدمية وتعقيداً من «الاستجابة الطارئة» التي تخلو من أي موقف حيال خروقات حقوق الإنسان وعمليات بناء السلام. بهذا المعنى، فإن التعليم مسألة سياسية. إن التغيُّرَ الذي يصبو التعليم إلى تحقيقه عميقُ الجذور، يصل إلى المعتقدات والآراء والعقليات والثقافة السائدة لدى الناس، وخصوصاً الشباب. والتعليم الذي يفشل – خصوصاً في أوقات الصراع – في معالجة القيم والسلوكيات، سيفشل بلا شك في خلق تغيير على المستوَيين الاجتماعي والسياسي.
لذلك فإن البرامج التعليمية التي صُمِّمَت خلال عملي على مستوى القاعدة الشعبية للأطفال المهاجرين والمهاجرات في لبنان، لم تقتصر على المواد الأكاديمية أو الدعم النفسي الاجتماعي، بل تم تكييفها بناء على قصص واحتياجات الأطفال والمراهقين والمراهقات، وعالجت مواضيع ثقافية ومسائل من قبيل انعدام المساواة بين الجنسين، وقيم المواطنة، من خلال فعاليات تحاورية تستخدم المسرح والفن والموسيقى والقصة. الأهمُّ من ذلك أن الأطفال والمراهقين-ات تعلّموا كيفية العمل سوية، واحترام اختلاف الآراء، والاستماع إلى بعضهم البعض، والتعبير عمّا يعجبهم وما لا يعجبهم، والتحلي بالشجاعة الكافية للإفصاح عن مطالبهم وتطلعاتهم. ففي هذه الفترة الحرجة، لا يهمُّ أغلب الشباب والشابات ما إذا نجحوا أو رسبوا في امتحانات الثانوية أو غيرها، بل ما إذا حصلوا على الأدوات والمهارات التعليمية اللازمة وذات الصلة، التي تساعدهم على بناء واقع جديد. إن شبابنا وشابّاتنا بحاجة إلى إعادة التواصل مع العملية التعليمية أولاً، والإيمان مجدداً بقيمة التعليم. لذا، فإن أهم المهارات التي ينبغي منحهم-ن إياها، هي التفكير النقدي والتحمُّل. بهاتين المهارتَين، سيتمكنون من خلع التلقين العقائدي وعقلية الانقسام، ويتعلّمون تخفيف المخاطر وتجنّب خداع النفس. لستُ الأولى في تطبيق هذا النهج، فالكثيرون والكثيرات من المجتمع المدني في سوريا عملوا بكَدّ ليُقدِّموا تجارب تعليمية ذات معنى للأطفال والمراهقين-ات في سوريا. ولكن هذه المحاولات العديدة لم تُسفِر عن رؤية موحدة وتعليم يخلق كتلة حرجة تؤثر على صانعي القرار والجهات المانحة بخصوص الحاجة الماسة لنهج تعليمي تحولي وشامل.
من الضروري هنا أن نقف على مفهوم «المساحة» وأهميتها الحيوية في إعادة بناء النسيج المجتمعي وأشكال التضامن. لقد أدركت عدّة منظمات مجتمع مدني في سوريا وجود هذه الحاجة، فأنشأت مساحات جماعية آمنة تُحفّز الحوار والتضامن بين أبناء وبنات المجتمعات المحلية، وخصوصاً لدى فئة الشباب، وتسمح لهم بالتواصل والمشاركة وإعادة امتلاك الشعور بالانتماء، وبناء المؤازرة والتوصل إلى رؤية مشتركة للبلد التي يحلمون. هذه المساحات جزءٌ لا غنى عنه في أوقات الصراع؛ وأول خرق يمكنها تحقيقه هو تفكيك الخوف الذي يصبح في أوقات عدم اليقين مُعدياً مثل الوباء، خصوصاً عند محاولة الوصول إلى اليافعين واليافعات، أصحاب المناعات الضعيفة ضد التلوث بآليات القمع. إن إحدى أفضل الاستراتيجيات الوقائية من انتشار الخوف وتعزيزه هي إشراك الشباب والشابات في التغلّب على اقتصاد الصراع التنازلي، الذي لا يمكن تفكيكه إلا عن طريق اقتصاد مُغايِر، تصاعدي، مبني على التضامن، يعززه اعتماد التعليم والمساحات التحوّلية، عبر الاجتهاد في ممارسة الحوارات بين الأجناس والأجيال، والتحول من تمويل المعونات إلى تمويل فرص التطوير والاستدامة المعيشية. إن إحدى أهم التوصيات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني ليست إنشاء وتعميم هذه المساحات الحيوية فحسب، وإنما تجاوز التكتلات، واعتماد نهج مُدمج متشابك الخدمات يوفر الحماية والتعليم والثقافة المعيشية، ويعالج احتياجات المجتمعات المحلية. الأهم من ذلك، أن المجتمعات السورية التي تشمل النساء الشابات، بحاجة إلى التحول من مجتمعات تعتمد على المعونات إلى مجتمعات مُمَكَّنة مُسلَّحة بالمهارات والمعارف والقدرة على التحمُّل. بهذه الطريقة، تصبح تلك المساحات نقطة تحول وبذرة تُنمّي التضامن المجتمعي وقيم المواطنة والمساواة بين الجنسين، مما يمهد الطريق لصنع التغيير وإعادة امتلاك الحاضر والمستقبل.
إنني عندما أفكّر بشبابنا وشابّاتنا في سوريا اليوم، يخطر لي مفهوم «البطولة المأساوية» على حد تعبير الفيلسوفة الأمريكية مارثا نوسباوم،(5) والذي تتحدث عنه في سياق قوة الشخصية خلال أوقات الصراع كما وصلتنا في الأساطير ومآسي الحضارة الرومانية، والتي تُصوِّرُ العزم البشري الذي لا يضاهى في مواجهة اليأس. حكمة الدروس القاسية المستفادة، وعلاقتنا الحيوية بالأرض، بالإضافة إلى شوقنا البشري وعلاقاتنا ببعضنا البعض، هي التي ستساعدنا على استرجاع حقوقنا وصياغة انتمائنا. سوريا ليست بلداً مأساوياً ومحطماً فحسب، بل هي أرض سكّانها بشرٌ يسعون إلى إعادة بنائها عن طريق العمل والتضامن والحب. إن «أبطالنا وبطلاتنا المأسويين والمأساويات» على حد تعبير نوسباوم، هم من فهموا وفهمن منذ الصغر تعقيدات الأمل، وأنّه «رغم أن البلد قد تنبذ وتطرد أبناءها وبناتها، إلا أن الأرض هي التي ترجعهم وتجمعهم ببعض من جديد». ربما سنحتاج في إحدى المراحل، خلال شعورنا الوجودي والمدمّر بالعجز و«الخفة التي لا تُحتمل» على حد تعبير ميلان كونديرا، إلى الحاجة للتوقف وأخذ نفس طويل، وأن نتصرف بلطف مع أنفسنا ونذكِّرها بقوة الفعل البشري (لو مهما ضؤل)، وبإمكانية التسامي ودوام الأمل، كما عبّر عنها محمود درويش بقوله: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة». يكمن أملنا اليوم في إعادة إحياء روح العزم الشابة والعبقرية لدى الشباب والشابات السوريات، لكي يسترجعوا ويمتلكوا من جديد الحق بعيش حياة كريمة على أرضهم-نّ.