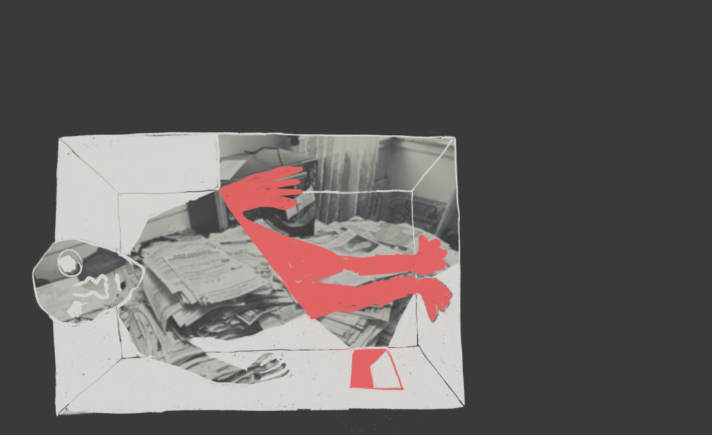Seek those images
W. B. Yeats
That constitute the wild,
The lion and the virgin,
The harlot and the child.
كنتُ أبني في الليل بيتاً كالجنّة يهدمه النهار. أستلقي بمفردي على سطحه. الأحبّ إليّ في الكون كوكبةُ الدب الأصغر، لا تُلحَظ إلا بلحظ العين. كنتُ أقتفي نجمةً تمشي وحدها، نورها نابضٌ كقلبي، حتى يمتزج هواء صدري بالهواء الكحليّ للمجرّات، فأغضب ممّن يذكّرني بخيبتي: «هذا قمر صناعي!».
بنيتُ بيتي من الطين الذي أعجنه بقدميّ، وأملّحه بعرقي، ويداي ترشّان فوقه تبنَ النجوم التي سرقها لصوصٌ من اصطبلات الآلهة، تساقطتْ من أكياسهم المثقوبة لترسم درب التبّانة. كان هزيمُ الرعد براميل فارغة تتدحرج في السموات، وأخشى سقوطها عليّ. كان دويُّ مسدّسات يعقب البروق. أليست هذه أنشودة المطر حين يلبّي الله صلواتِ الأطفال:
Baranê dayê dayê
teqreqa dimança ye
أحببتِ أنْ تفهمي كلماتهم هكذا: «المطر أمّي». كانوا يتشبثون بمخداتهم، حين يتوجّب الإسراع بنقل اللحف والفرش إلى الصالون، لأن العاصفة الرعدية تدنو في فجر آب، سحابٌ كالحبر يكشّر عن نيوب بروقه، زاحفاً من الشرق ليرشقهم بقطراتٍ كبيرة كحبات عنب أسود تهرسها العجلات.
كنتُ أقرف من الرذاذ الذي يتطاير من أيدي المتوضّئين، وهم يتمضمضون، ويستنشقون، ويستنثرون، ويتمخّطون، مشمئزاً من تبلُّل الأكمام، وأسافل الأثواب والسراويل. كنتِ تمسكين بحمّصة أنفي التي انتفختْ فيما بعد، حين نقَعتْها شهواتُ المراهقة بمائها، وتمشّطين غرّتي بأصابعك، وأنا أسمع قطّي يشحذ براثنه على سلّم السرير الصيفي. كنتِ تقولين إنّ صرير أخشابه كزقزقات «العاشق والمعشوق»، فأشتم في قلبي عصافيرَ النحس الخضراء تلك، وفي خيالي أطلق عليها النار، مثلما كنتُ أطلق نارَ خيالي على العصفور الذي أطلّ من الشباك وقال «يا نونو». كان للسلّم ثلاث درجات، صغيرات مزعزعات، يثبّته من الأعلى كلّابان معدنيان، معقوفان كخطاطيف العتّالين. بل لامعان كاليد الصناعية للمجرم الذي صلبه بروسْ ليْ، على بابٍ من مرآة، في قاعة المرايا.
كان قطّي يلعق قدمه ويغسل بلعابه وجهه، ليستقبل ضيفاً لم يزرنا أبداً، لأنه كان معنا دائماً، حاضراً بيننا كالهواء. كان يموء ويكاد يمزّق الناموسية بمخالبه. لم يكن يستطيع الدخول إلى قفص رحمتك، فتزجرينه. ما أرقَّ زجرك، بحركة خفيفة من ظاهر اليد، وأنا أشمّ في وبره رائحة الأقحوان، أو البابونج، أو عشب التفاح (لا أعلم أيّها الأصحّ). كان مسكب البابونج سرير قيلولته. كأنه يسمعك حين تقولين لي:
-لفرط ما داعبتُك ستظهر على جبينك، ساعةَ المحنة الكبرى، ثلاثةُ خطوط كالجدائل الثلاث للمذراة.
قد يقرأ عسكريّ تركي آثار يدك هذه في التجاعيد بين حاجبيّ الغليظين، أنا المكشّر دائماً، فلا يفهمها قبل أن يسدّد الطلقة بينهما. لا أحد يستطيع أنْ يقرأ السرّ بين تلك السطور في الجباه.
كانت في جبهة قطّي خطوط طولية كجباه النمور، أو كالخدوش التي تركتها اليد الفولاذية للمجرم على جسد بروس لي في «ادخلِ التنّين». لكنّي أعلم أنّ تلك علامات تركتها أصابع الرسول، عاشق القطط، لفرط ما داعب رؤوسها. أعلم أنّ البابونج شراب المؤمن المهزوم، يحتسيه ليهدأ روعه، ولا يقنط من رحمة ربّه. في غزوة أحُد، انكسرت إحدى أسنان الرسول الأمامية، وغطّاه صحابيّ لا أذكر اسمه حتى صار ظهره، تحت وابل النبال، كظهر قنفذ، و«پيخمبر» حيٌّ تحته، دامي الفم، ينزف عرقاً. قطرة عرق سالت من حاجبه إلى الأرض، فنبتت بين أحجار الجبل، في الصحراء، زهرة بابونج قطفها بطلُ أُحُد، خالد بن الوليد، وأخذ بذورَها معه إلى حمص. كنتُ أغتبط وأشمئزّ، في آن واحد، حين تجمعين بين عطر البابونج وعرق الرسول، الأمّيِّ مثلك، تحت سماءٍ صافية كمرآة درّاجتي ذات العجلات الثلاث، يبتعد فيها كلُّ شيء فيصير جميلاً.

بالنسبة إليك، كان كلُّ شيء صافٍ مرآةً. كنتِ تقولين إنّ مؤخّرتي العارية، الباردة، قمرُك البارد كالرخام، قمر المعجزة الذي قسَمَتْه إصبعُ الرسول إلى نصفين، وأنت تدهنين بالفازلين أنفك، ثم تدهنين به شرجي لتطردي «حشرات ذيابو»، بعدما استفحلتْ لأنني استرقتُ التهام الكثير من بذور عبّاد الشمس النيئة. كان جسدي يدور في نومه على فراشنا، كعقرب ساعة تدور في جوف الليل خارج الزمان، فأرفسك في نومي رفسَ البغال، كما رفستُ في ظلام رحمك، فتهدئينني، أو تهدّديني بأشهر تهويداتنا:
«نَم، بنيَّ، نمْ. قتلوا أباك، وهذا نواح أمك»
وفي الصباح، أول استيقاظي بين ذراعيك، تباعدين ردفيّ، وتضعين بينهما لاصقاً شفافاً تمزّقينه من البكَرة بأسنانك، إذ هكذا تكْشَفُ الديدان التي تقطع أمتاراً طويلة من ظلمات الأمعاء لتبيض في نور النجوم. كنت ترسمين بإصبعك عقربين على ردفيّ، وتقولين:
-بهذه الساعة سأقيس عمري. أهداها الله إليّ حين انتقلتَ من بيت جسدي إلى بيت جسدك.
وترتجف إصبعك المحنّاة كعقرب الثواني الأحمر لا يبرح موضعه، مترنّحاً داخل ساعة الحائط، لأن بطارية «برق» قد نفدت.

وقتذاك، لم تكن كلمة «الڤازلين» قد ارتبطتْ بتداعيات كريهة سمعتُ قصصها حين كبرت، ولا كنتُ أخشى البواسير التي أمضّت معظم أعمامي. ملّوا المراهم لاذعة الروائح. ملّوا الحقن الشرجية ذات المطاط البرتقالي. ولمّا يئسوا من الشفاء، باتوا يحشون شروجهم بالبنّ، ويمسحونها بالحصى. كان الدكتور قاسم، الدرعاوي ضيّق الصدر، الأصلع أعزب الدهر، يوبّخهم:
-لا حول ولا، ما هذا!؟ ناسور… باسور… زرزور… شحرور… والله، هذه عيادة، لا مقهى!
وبدلاً من فحصهم يقرأ لهم فألهم في مؤخّراتهم. رأيته معك يدخّن وحيداً، مطلاً على شارع الوحدة من نافذة غرفته في فندق هدايا، وقلتِ لي:
-سراويل أعمامك مدماة، كسراويل النساء في ميعادهنّ.
أتساءل لماذا أطلقتِ ذلك الاسم البدويّ «حشرات ذيابو» على الحرقص، مسيّل اللعاب من أفواه النائمين؟ لماذا، «بلا معنى»، نسمّي الشرج تابوتاً؟ «تا-بُو-ت»! لمتانته؟ أم هناك احتراسٌ ما، وراء تسميته وعاءً للموت، باسم مستعار من لغة أخرى؟ كانت ضحكتك خجولة، وأنت تغطّين فمك بخمارك، الموصلّي، النباتيّ، تشيحين برأسك حين تسمعين عن تجنّب الكرديات نطقَ المعوّذتين، إلا همساً في الصلاة: «قُلْ… وا ويلي!».
لو طاولتْ يداي الآن ذلك الشرطيّ الحقير الذي قال لك في مديرية الناحية:
-الثقب في طنبور ابنك وسخ كحفرة المرحاض.
لعلّقتهُ بحزامه الأبيض، وشنقتُه من خصيتيه النتنتين، فوق هذا الوادي السحيق أمامي. كان جهله اسمَ الآلة يغيظني أكثر من الشتيمة بحدّ ذاتها. طنبور! طنبور، يا أخو الشحتة! حسناً، سأهدأ. كنتِ تحكمين على البيوت من نظافة مراحيضها، ويزعجك الذهاب إليها في الشقق، لأنها تبقى قريبة، مهما احتال البنّاؤون والمهندسون، وتغضّين الطرف عن تلك الشحّاطة الخاصة بالمرحاض على ممسحة العتبة. كنت توبخينني:
-لا تقل «دورة المياه» بل «بيت الراحة»، ولا تقل «سأبول»، بل: «سأريقُ ماء».
ساخرةً ممن يستخدمون «تواليت»، لا لأنهم يدّعون التمدّن، بل لأنك كنتِ تظنين أنّ المفردة هي مرآة الزينة. بيت الراحة، بيت الأدب، بيت الخروج الكبير والخروج الصغير… كلّ هذه الكنايات تتحقّق في العراء، حيث أقضي حاجاتي كحيوانات الله، البكماء الصمّاء، مترحّلاً بين الأوكار، هارباً من كمين إلى كمين.

كان عمّي فيروشه كالغجر. حين يزورنا، لا يرفع إصبعه عن جرس الباب حتى يوشك أن يحترق. كان يستهلّ التحية بشتيمة صغيرة لأصلك وفَصْلك، وفي غمرة خجلك تتمكّنين من الردّ عليه، وتعيّرينه:
-أنت… يا منتظرَ الغمزة من سميرة توفيق، أنت… يا من يرى الفجل فاكهة الجنّة… يا من وجهه مَنْسف، وكلامه بلا طعم… الشماخ نظيف، والصابون بالدين…
فيضحك عالياً، ونهاية ضحكته «خخخخ» كصوت قطّ شدّوا ذيله. وعند خلعه عقاله وشماخه تظهر صلعته، بزغبها الأبيض المبعثر، فتبرز أسنانه أكثر، ويبدو شبيهاً بالمجرم في «شاهد ما شفشي حاجة»، فلا أكاد أتعرّفه. حاجباه يعلوان كذلك الممثّل، وعيناه تجحظان وتتجمّدان، حين يلمّحون له إلى قضاء الحاجات داخل البيت. كان قد هدّ المنتفعات في بيته ليبنيها من إسمنت، إلا المرحاض الذي لم يسمح فيه بالإضاءة الوقحة. استبْقاه، كما كان، من طين، يعتلي الحفرة الفنّية، لا سقف له ولا باب.
لا أنسى تلك الصورة اللعينة في كتاب العلوم، حيث نقاط التسرّب من الحفرة الفنية تلوّث مياهَ البئر. لا يزال بطني يوجعني حين أتخيّلها، كأنني طفل ابتلع قطعة نقود (كان مرسوماً في صفحة أخرى من ذلك الكتاب نفسه). لا أنسى هذه المعلومة، مثلها مثل الوجع الذي يسببه تراكم حمض اللبن في ربلات الدرّاجين. على صاحب الحاجة الأرعن، المسرِع من أقصى الباحة إلى أقصاها، أنْ يحذر العقارب إذا مدّ يده في العتمة إلى زرّ النوّاصة، فالملقطان كمّاشة والذيل منجنيق. على المقترِب أنْ يتنحنح: «دستور! دستور!» في النهار، أو إذا كانت الكهرباء مقطوعة، وإذا كانت تمطر، وتوجّس من الزكام، رفع المظلّة السوداء عن مسمارها، المدقوق في شجرة التوت، فيفتحها ليقي فانوس الكاز أكثر مما يقي رأسه. أنسى دوماً أن أتعوّذ من الخبث والخبائث. كان عليّ، عند الإسراع خائفاً من الظلام، أنْ أحذر عكّازَ الشيطان، ذا المقبض المعقوف كأنفي. لا أزال أحذّر نفسي من أنشوطة الشيطان التي يرمي بها إلى كواحل الملعونين وأعناقهم. كنتُ أخشى أن يجرّ عاقّاً مثلي إلى صفوف رعيّته، فيأخذني، وأطفالاً آخرين معه، إلى بئر الغرقى.
كنتُ أضع ذاك الفانوس على دكّة الطين، وأداعب زخارف حديده، كأنها زركشة ناعمة من الدانتيل في ثوب نوم. كانت حرارة لهبه البرتقالي تصعد إلى الفوهة، لافحةً بأمواجها وجهي، وأنا أكاد أحيط زجاجته براحتيّ، كأنهما لا تجرؤان على لمس فتاة عارية، ساخنة. في مساءات أيار، كنتً أنتظر «فراشاتِ الخير» التي لا يعلم أحدٌ من أين يأتين فيرفرفن حولي، يترنّحن ويدغدغن خدّي وجفوني؛ ضريرات آنسْنَ في ناري نهاراً، «فَقْريّات» سمراوات مثلنا، معوزات لم يرينَ الدنيا، صابراتٌ تكتنز أبدانهنّ في الوحشة، يكسوهنّ وبرٌ وغبار حزينان. الخير الذي يأتين به شحيح. تسرّع البدانة أجنحتهنّ القصيرة، غير القادرة على حمل أجسامهنّ، فلا تكاد تُرى، مثل جناحي الطنّان المسمّى «نيّاك الهواء» في دير الزور. لا تحليق في طيرانهنّ. لا علوّ. لا ابتعاد. كأنهن، بألوانهن الكابية، ينبثقن من تراب بيتنا وإليه يرجعْن، إذْ سرعان ما تختطفهنّ الخفافيش التي تنام فجراً، بين عوارض السقف، فوق درج المدخل الصغير. كنتُ أدير مفتاح الفانوس كعلبة موسيقا، فتطيل النارُ لسانها الصغير، ثم أبتعد خطوتين، لأتفرّج على الطائشات المتهافتات، فيبدو لي شقُّ الفتيل في قلب الزجاجة كالصّدْع في فرْج طفلة. كنتُ أترك فراشات الليل لمصائرهن، ثم أصفّف اللواتي يحترقن منهن في حلقة، مثل سوارٍ من السديم حول القمر، وأروح أتملّى ما رسمته النار على أجنحتهن المحترقة. كانت وجوههنّ المكفهرّة أقرب إلى وجوه الأسود.
كنتُ أرتمي منهكاً على الأريكة، فأسمع وشوشات أظنّها أفواهاً تلتهم أوراقاً في الظلام. كانت تلك الضجة الخافتة بيوض عثّ تفقس تحت رأسي. اليرقات رخوة، لا ماء في ولادتها. بزّاقات طائرة من رمل. كلها غبار. تُسحق كرماد سيجارة، ولا تكاد تترك أثراً. سهولة سحقها تعتصر بطني ووجهي. مرّة سحبت الصندوق الجرّار للأريكة، فانطلق سرب من فراشات الخير. كان يجب أنْ تسمَّى فراشات اللعنة. تناثرت في الهواء بودرة أسعلتني طويلاً. أثناء سعالي، رأيتهنّ بعيني الدامعتين، يتّجهن إلى المصباح البرتقالي، رحن يلطمن زجاجه الرقيق كيهود تائبين يخبطون بجباهم حائطَ المبكى، فهوتْ في تزاحمهنّ قطعة كلس متقفّعة على الجدار. كنا قد قبرنا في صندوق أريكتنا كراريس سياسية، ومنشوراتٍ بالية كانت توزّع باليد، وعشرات النسخ من مذكرات المخاتل في الجبال مسعود البرزاني، ذات الأجزاء الأربعة، ولكل غلاف لونٌ من ألوان علم كردستان. كانت فراشات الخير قد فرَمت الصفحات فرْماً. رفرفن مثل أعلام ممزّقة فوق بنايات مهملة، فتطاير حول المصباح هباءٌ ملوّن ببقايا الحبر. تساقطت من أجنحتهن حروفٌ وأرباع كلمات، مطبوعة على ورق أصفر، كالقشّ حين يتعفّن. لا نأمة سوى ذاك الرفيف الناعم، المثير للغثيان. حاولتُ إبعاد قصيراتِ العمر عن الموت الذي لا شيء يزحزحهنّ عنه. أزحتُ الستارتين البيضاوين، الطويلتين. شرعت مناخل الشبابيك، الخضراء العميقة، كأنني أنتظر أشباحاً تأخّروا عن الوصول، إذْ دعوتهم بقلبي من ليل البراري، ليتفرجوا معي على هذه المسرحية الصامتة.
يوم ارتقبتُ «الحدث الجلل»، مضطراً بُلتُ أسفل شجرة التوت، واقفاً، مباعداً ساقيّ، وأنا أتفرّج على السماء الواسعة الصافية. كانت الغرف قد ازدحمت بالضيوف، والأدراج الطينية الصغيرة بالكلاشات الديرية والأحذية التي طُويت مؤخّراتها. تحاشيتُ زوايا الحيطان، لكيلا ينعتني أحد صائحاً من خلفي: «يا ناكح الحائط!»، ولكيلا يهيّج زلال بولي العقاربَ التي كانت ساعة نزهاتها المسائية قد أزِفتْ، فتلدغ ما بين فخذيّ. كنتُ ساهياً حين انتهيت، فعضّتْ أسنان السحّاب قلفتي. حبس الألم أنفاسي. كاد قلبي يسكت، ويغيّبني عن الوعي. نزفت قلفتي التي تحسّرتُ على ضياعها في اليوم التالي. وددتُ لو دفنتها بيديّ تحت شجرة السرو، بعد حفل الختان الجماعي، في بيت عمّي فيروشه.

يوم فرّق الختان بيني وبينك، أفطرتِني عسلَ ديريك وقيمر جواميسها، وغدّيتني طبقاً من معجون التمر الديريّ، عائماً في السمن الحرّ، مغطّى بطبقة من عيون البيض، «الكرمانجي». كنتُ مقبلاً على ولادة ثانية: عقدتِ سواراً من خيط أخضر في أعلى ذراعي، كما يُعقد «خيطُ البرَكة» هذا أساورَ في أرساغ المولودين، وأقراطاً في آذان المولودات. كنت أعاف منظره، ذلك الخيط، فأقول لنفسي: «هذا الأخضر مشؤوم، أخضر جهنّم»، ثم يمضّني الندم فأتبرّك به. بدبوس إنكليزي ربطتِ إلى كتفي تميمة خضراء كوسادة دمية:
-لا تخفْ. لا كلمات هنا، فلا تفتحها.
كانت حشوتها قطعة صغيرة من فرج ذئبة. قلت:
-لم أجلبْ لك حجاباً مثلّثاً.
أردتِ لي الحظ والصبر، فما ينقصني ليس الشجاعة. خشيتُ دوماً تضييع هذه التميمة. تعذبني حين تختفي. إنها مخدة مخداتي كلها. غطاؤها مزقة من رفارف «الشيغ جبر»- طرّزته باسمي، غرزته فيه بخرز ناعم عقيقي كمحافظ المسجونين. كان مرقد الشيخ يلوح من بعيد مثل سفينة أشباح، غبراء الخضرة، ممزّقة الأشرعة، رسَتْ على كتف تلّة.

عصراً، أتى المطهّر، «مطبّقُ السنّة»، معتمراً عمامته البنفسجية، معه حقيبةٌ سوداء من جلد البقر كنتُ أكره أنْ تقارنوا حقيبتي المدرسيّة بها. كان يضع نظارة سوداء كسعيد كاباري. للوهلة الأولى، خشيتُ أنه أعمى، وقد يقطع بالنصل حشفتي، كأنها رأسٌ حليق لجنديّ فارّ يرقب المقصلة. راقبته كيف يسنّ الموس على قطعة جلد بنّية، ثم يجهّز أنبوباً نحاسياً، بدا لي خفيفاً كإبرة الحياكة، لم أدرك أنه سيولجه في إحليلي- أمسك به، طواه، رفعه، أخفضه، راز الخصيتين كبيضتي قطاة. ما كنتُ لأستأمنه أنْ يقصّ ظفري، وأنا مباعدٌ فخذيّ اللتين أمسكهما، بيديه القويّتين، الكريڤ حج علي (القصير ذا الوجنتين المنتبجتين كنافخي الزجاج. كنتُ إذا ناديته: «إسماعيل ياسين» نلتُ منك صفعة خفيفة خلف عنقي).
وضع الكريڤ كفّه على قلبي:
-طبل أم أسد؟
فتسارعت دقّاته أكثر. لا أحد سوانا نحن الثلاثة، لا شهود على عار الإغماء المحتمل. مازحني حج علي:
-اليوم، ستصير نوّاصتك مصباحاً فانتبه. الرأس حسّاس، رقيق. كُنْ معتدلاً كأخوالك. احذر اللمسة الباردة، لأنها خطر انفجار!
وضحك وحده، ماسحاً غرّتي التي التصقت بجبهتي:
-لا تهتمّ. دموع الشجعان تتحوّل إلى عرق.
استعددتُ للألم، الوشيك القادم، بالتنفس العميق، أحبسه وأزفره كالمرأة في الطلق. قال لي الكريڤ، مثبّتاً ساقيّ، مباعداً إياهما وأنا في حضنه، ليُلهيني عن ترقّب الألم الذي أبكى المنتظرين أدوارَهم بعدي، لأنّ البكر أوّل المختونين:
-الرجال لا يبكون، عفَّرِمْ! شرّفتَ أخوالك! كبشٌ أنت، خنزير برّي! انظُر، هناك فأر! هناك، هناك!
مشيراً بسبّابته إلى ثقبٍ في السقف، بين عوارض الخشب والقشّ، وفي تلك اللحظة هوى المطهّر بالنصل على قلفتي، الممطوطة في يده، وبترها. رشق دمي المخدةَ البيضاء، الطويلة. غلّف الأعمى جرحي بمنديل أبيض. سمعتُ صليلاً. ولدان يتبارزان بمقصات العنب الثقيلة. غنّتِ امرأة خلف النافذة. كان صوتها شجيّاً كتغريد الوروار. ما لبثت أنْ سكتت. لم أسمع الكلمات جيداً. لحن المزمار، ذي القصبتين القصيرتين، تحت العناقيد السوداء، كشف لي الأغنية:
عقدتُهُ فلا تفكّه يا فتى
أين قنديلي يا أسمر؟
لا أعرف مَن ألّف «منديل الفتى»، هذه الأغنية القصيرة الغامضة. القنديل والمنديل. قنديل مضاء في وضح النهار. المنديل ثلاثة مناديل، يبدأ ملوَّناً، ثم يحمرُّ فيسودُّ، كحياة الإنسان. مَن تخاطب الفتاة التي نسجت منديلها بيديها، خيطاً فخيطاً، وطرّزته بعقيق كلآلئ صغيرة من الدم؟ هل العقدة هي البرعم، وتفتُّحهُ بدايةُ موته؟ هل البقعة القانية على البياض هي القنديل، وزيته دمُ البكارة؟
القناديلُ الورقية ذات الوجهين، المعلّقة إلى أغصان الشجر، تقزّحت كالدموع، حزناً على وداع الطفولة، وفرحاً بوصول الرجولة. كان عليّ النهوض وحدي، والعيون مسلّطة على المتورّم بين فخذي. منشفة مقلّمة، مبلَّلة بالعرق، ملفوفة حول عنقي، كأني ذاهبٌ لأمسك برأس الكوڤند، ملوّحاً بالمنشفة كرايةٍ من أحد البلدان الأفريقية التي كنا نموّه بها علم كردستان خلال كأس العالم. كنتُ أعرف أعلام الكثير من البلدان. لوّحتُ بمنديلي لشمس حزيران وأنتِ تزغردين. لم أستطع الاحتجاج على زغرداتك التي ينقبض وجهي لدى سماعها. ودّعت بقعة دمي على بياض المنديل الذي عقدتُه، ثم علّقته كعلم اليابان إلى شجرة الورد، لأنه ذكرى من ذكَري، ذكرى من «وردتي» التي كنتِ توهمينني بأنّك ستخطفينها، وتأكلينها في لقمة واحدة: «عَمْ!». كانت وردتي برعماً لم يتفتّحْ، مثل رأس فيل في الشطرنج. خشيتِ مرةً ألا يتفتّح هذا البرعم أبداً، فتداويتُ بهذه الأغنية:
اخضرّت شجرتي.
استيقظ ألمي.
هبّتْ رياح الأجل على فانوسي.
تبعثرت بتلات وردتي.
باعدتُ الأوراق الخضراء العريضة لزنابقك الحمراء. كانت وراءها شجيرةُ الورد. علّقتُ إلى شوكةٍ خاتمَ جلدي. حلقة تامة تربط اللسان، فكلمتي، منذ هذه اللحظة، وعدٌ وميثاق. سيحرمني هذا الخاتم البكاء، إلا أذا أدمعتني الموسيقا أو الموت. ربما اختطفه أبو الحنّ، ومزّقه ليطعم فراخه. المقياس عندي أنّ ألذّ ما في الدجاجة جلدها. لا أدري إنْ كان هذا الضاري الصغير يأكل لحم البشر، لكنه كان يظهر، بالبقعة الصهباء على صدره كلحية شيخ محنّاة، حين تعزقين التراب لتبذري خضارك، منتظراً أنْ تلوح الفرائس، ديدان الأرض التي ظننتها عديمةَ الرؤوس، تتلوّى وقد آلمها النهار. اصطدته مرة. حبسته في صندوق بصل فارغ، ثم وضعته فوق النمليّة، تحت السجادة المعلقة إلى الجدار الجنوبي لحجرة المونة التي كنت أنعطف نحوها، كأني حصان تحرّكني يد القدر على رقعة شطرنج. لم يتوقّف تغريده الحادّ. ربما لأنه رأى شبيهه مرسوماً فوقه. سمّيته الحاجّ Qerabalix، وخاطبته ضاحكاً:
-ولكم في الحاج لقلق، والحاج حجيك، أسوة حسنة، فاعتبروا يا أولي الألباب.
كانت النسّاجات قد رسمن الملاك جبريل في السماء الكحلية لتلك السجادة، محلقاً بجناحيه العظيمين فوق مكة، حاملاً الكبش العظيم إلى أبينا إبراهيم، العملاق الأكحل العينين، ذي الضفائر الطوال واللحية المرسلة والعباءة الخضراء، رأسه مائل كأنه قد سمع صوتاً، لصق ركبته الجاثية كيسُ سكاكين على الأحجار، يمناه تضع النصل في نحر ابنه، إسماعيل معصوب العينين، موثق الرسغين، موثق الكاحلين؛ على مقبض السكين أبو الحنّ، يحدّق في العين الهلوعة للطفل الذي سيُذبَح. فجر شتوي يضيء وجنتي إبراهيم. الصحراء تترامى، وقد تورّدت رمالها. سيخضّب أبو الحن صدره الأبيض بالدم، ويمرّغه بالرماد الساخن للمحرقة على جبل المُريا، ثم سيحطّ على نصل السكين، ويغرّد لمن نجّاه ربّه. ستحشو هاجر لحافَ إسماعيل بصوف الكبش، وتوسّده مخدّة من ريش أبو الحنّ الذي رأيتُه مرّاتٍ، بعد توقف هطول المطر، يختطف ديدان الأرض الزاحفة بين الأحجار. كان يغرزها في أشواك ورودك، ثم يتركها هناك تتلوّى حتى الموت، كأنه يقدّدها.
كانت آكلات الورد الجوريّ يخجلن إذا بُوغِتْنَ وأفواههنّ طافحة بورقه الأحمر، الشافي من كلّ داء. كنتُ آكل الورد أيضاً، قبل أنْ ترشّيه بسكّر التموين الأسمر لتصنعي المربّى، مرتّلاً لك والبتلات في فمي:
نحن سُكاراكِ أيتها الوردة،
يا مَن كفافكِ في التراب
ماءٌ ونور.
بيد الأرملة سقاكِ السحاب
فطّرتْكِ الشمسُ وهجَ التفّاح
يُذيقك القمرُ شعاعاً من السكّر.
فُوحي بصمتِ أرواحنا، اَسكرينا.

ييبس الياسمين في ترابنا- الزهر الذي يسيّج جنّات عدن، لا يحتمل جهنّم شمسنا. رائحته تهدي المؤمنين إلى باب الفردوس في ليل القيامة. نجومه على سياج البيت، مصفرّة البتلات كقصاصات ورق بيضاء اندلق فوقها شاي ساخن. كانت وردتي هي عرف الديك، أبذرها معك في آذار. كنتُ، بالرقّة التي تستطيعها يداي، أمسّد عرف الديك، التيجان الأرجوانية على رأسه اللحمي القوام، ممسّداً مخمل أوراقه كأنها قلوب مسنّنة الحافات. بصمغ عصارته، الممزوج بحليب التين، داويتِ الجرحَ بين فخذيّ. مرّتْ عليّ أيام صيفية بطيئة، لم أعرف مثيلاً لنعمة طولها. أمضيتها ناقهاً، حبيس البيت، أفتح طاولة الزهر لألعب «المغربية» مع نفسي، متفيئاً، مثل قطّي، دواليَ العنب الشامي، ماضغاً، مثله، ما التفّ من أغصانها، اليانعة الحامضة، حول أعمدة السرير.
كنتُ أداعب قطّي حتى يعتصر الغثيان أحشائي، وأوشك أن أتقيّأ قبله. مرةّ، أبعدته عني فلمعت عيناه، كأنه قرأ نواياي. انهمك بنفسه، لاعقاً بطنَه، فخصيتيه المزغبتين كحبّتي حمّص في غلافهما الوبِر؛ بغتة، علا ذكَره فلعقه أيضاً، لعقه بهدوء، بلسانه الذي تدغدغني خشونته ودفؤه، حين يمسح به بقايا اللبن عن أصابعي. كان ذكَره مخروطاً أحمر، يتحلزن مثل برغي يُدفَع على مهل في جدار الهواء، أو مثل نسخة مصغّرة عن برج بابل رأيتُه في لوحة مصوّرة.
شاهدتُ ذكَر القطّ في مشهد لا يُنسى. كنتُ وحدي حين سمعت خبطات غريبة على باب الحوش. تلاها قرعٌ لجرس البيت الذي يجفلك دوماً، كأنّ كل رنّة منه تقتلع قلبك من بين ضلوعك. لم ينقطع الرنين. فكرتُ أنّ أولاداً قد ثبّتوا زرّ الجرس بلاصق، وهربوا. هرعتُ لأفتح الباب وقد راعني، في جهنّم الأصوات، مواء حادّ صداه لا يُحتمل. رأيتُ قطاً يحشرج، متدلياً من الكلاب الحديدي، المثبّت في المظلة الإسمنتية، تحت مصباح العتبة الذي فرضَت البلديةُ تعليقَه أمام كلّ بيت. كان المعلَّق في الهواء ينازع تحت تعريشة اللبلاب. خفتُ انقضاض هذا السنّوري عليّ، عينيّ وأوداجي على الخصوص. تعرّفت إليه- قطاً سائباً، قائمته الخلفية مشوّهة. كانت عادته أنْ يتشمّم أبواب البرّادات، المغلقة بالقفل والمفتاح، دون أمثاله هو والأطفال، فيحاول عبثاً فتحها برأسه وقدميه، ثم يرشقها ببضع قطرات بول وينصرف. كان أحياناً يتبرّز على لوح «كونتبلاك»، الموضوع أمام كل برّاد. كان علينا ألا ننسى وضع قدمنا فوق اللوح أولاً، ثم نلمس مقبض البرّاد، تجنّباً لأي تكهرب محتمل. كنتُ، بالأمس، قد أصبتُ القطّ الأعرج بفردة حذاء طائرة، حين رأيته يلعق بقايا اللحم عن سفافيد الشواء، المكوّمة تحت حنفية الباحة، بعد رحلة من رحلات الربيع في البراري. شنقه رذلاء أكبر مني. أتوا بسلك صدئ من بقايا الدواليب التي يحرقونها عشية النوروز، ونصبوا الفخ. كمنوا له. استدرجوه بقطعة جبن. ليتيقّنوا من مغادرته هذا العالم، أحرقوا شواربه الرادارات، ولاحت أطرافها المحروقة كالعقد في سيقان عنكبوت، ثم خنقوه حتى انتفش ذيله، ولمّا نعظ برجُ بابله قطعوه، فعثروا فيه على عظم صغير. ضحكوا:
-قطعة لحم فيها عظم! كنا نظنّها مزحة!

بالجرح بين فخذي انفتح باب مُتع أخرى. الآن صرتُ ملكاً لنساء أخريات لا أعرفهن. لن يغرقن وجهي بلعاب القبلات. لن أخمّن أبداً ما يضمرن لي. هنّ ألغاز مستقبلي، منقذاتي وأنا ابنهنّ. كنتُ أنهض ممسكاً بمنتصف جلبابي، مباعداً ساقيّ كفرخ القطا، وأمشي الهُوينى. نعم، الهوينى. كالسائر على البيض. كالمفضوضة.
تأخرتُ يوم تساقطت القلفات من بين أفخاذنا، كالسُّرر في اليوم العاشر. بزيت الزيتون طرّيتِ لي الشاش، الملتصق بعُرف ديكي. مشفقة عليّ وفرحة بي، قلت:
-رفقاً بما تملكه ولا أملكه. هكذا، من دون ألم، ستسقط القبعة البيضاء عن طاقيّتك الحمراء!
مختلياً بنفسي في غرفة الضيوف، تفحّصت برعمي بالمكبرة الروسية، كأنه زهرة فم السمكة أضغط جانبيها، فتفتح فمها لتقول شيئاً لا أسمعه. لم أبُحْ بهذا لأحد، لكيلا تلتصق بي تلك الكناية الرهيبة عن ضيق الأفق- أي كيلا أصير واحداً من الذين يرون العالم عبر ثقب إحليلهم، أو يجوبون الأيام كالفلاحين وصُلبُهم رفشٌ على كتفهم. وحدي، عاينتُ خسارة برعمي التي يتحسّر عليها الكبار، لأنها تفقده شيئاً من حجمه الإضافي، وتسرّع مجيء شهوتهم. مَن يستطيع الجزم بما يلزم التخلص منه؟ وهل قصّ الختّانُ ما يجب قصُّه حقاً، دون زيادة أو نقصان؟ هل اعوجّ «رجُلي»، وخرج عن السراط المستقيم؟ هل رضّت الشفرةُ إحليلي، فتضيّقَ ومال كربطة عنق في نهاية حفلة؟ هل تشوّه الصماخ ليتشعّب قوس البول كلسان الحية ويحرقني، أو ينجّسني ما يتطاير من رذاذه، فتأكل الاحتمالات دماغي حتى ترغمني على الاستحمام؟ كنتُ أقرأ مثل تلك التساؤلات، المرسلة من قبل مجهولين إلى بريد القراء، في أعداد قديمة منزوعة الغلاف من مجلة «طبيبك»، وأنا أختلس تصفُّحها في صالون «حلاق السعادة»، متظاهراً بأني أقرأ شيئاً آخر.
مَن يدري كيف تتكوّن العادات، ومتى تبدأ بالضبط؟ منذ ارتدائي جلبابَ الطهور، البارد، ناصع البياض، أحببتُ النوم من دون سروال تحتاني، ولا أزال حتى الآن، ما استطعتُ طبعاً. أتلذّذ ببرودة الشراشف أول اندساسي تحتها، وأحياناً أستيقظ عارياً في فراشي، دون أنْ أدري أيّ جنّي خلع لي ملابسي وأنا نائم.
تلك الأيام، صاحبني مذياع كونيون في الشبّاك. ظللتُ أستخدمه لسنوات طويلة مخفَضَ الصوت، مؤشّره لا يكاد يفارق إذاعة يريڤان. أشعله، فأسمع سوسكا سمّو على صوت كردستان، تغنّي عن بلبل غريب في الجبل؛ أغنية من أكراد القوقاز، ترقّ كخيطٍ يكاد ينقطع بين دمعتين، تلك الرجفة التي تكسّر نقاءَ الصوت في الحنجرة بكاءٌ مضى، أو بكاءٌ سيأتي.
كنتُ أمدّ هوائيّ المذياع إلى أقصاه لتقوية الإشارة، ثم أربطه بسلك إلى منخل الشباك ذي المضلّعات السداسية كمنازل النحل. كنتُ أدخل أصابع يديّ في تلك المضلعات، وأتفرّج على دبور أخير عند المغيب، جناحاه بلون الشاي، يشرب مما تقطّر من ماء حول البئر، ثم يحلّق إلى النوم، مرخياً قوائمه كأذرع السكارى. على الجانب الآخر من الباحة، أرى مَهْدي، معلّقاً إلى طرف عارضة من جذوع الحور التي تسقف البيوت، وتبرز أطرافها من الجدران، فتُعلّق إليها أشياء كثيرة فوق الرؤوس: سلالم، سلال تين، باقات ثوم، صناديق فارغة، عجلات، سلاسل الباميا الديريّة والباذنجان المجفّف…
المهود لا تُهدى، ولا تُشترى، ولا تُباع. إما أن تورَّث أو تُتْلَفْ. مَن يُسلَبْ مهده يبكِ، لإدراكه أنّ تلك الخسارة الأولى ستلحقه بالكبار الذين لم يكن يفهم، قبلئذ، لماذا هم حزانى إلى هذا الحدّ. القبر بشاهدتيه كالمهد يُوسَّد فيه الميت، وما مِنْ يد تهزّ ذاك السكون.
مهدي حديد أخضر. كانت تبطّنه سجادة صلاة، لأنّ الرضيع صَلاتهُ الابتسامة. قائمتا مَهدي مقوّستان كساقي عتّال، قاعه شبكة من أطواق الحديد المتقاطعة (تشبه الأطواق التي تُحزَم بها مكعبات ضخمة من أكياس الخيش، ويصنع منها الحدادون سيوفاً للأطفال). أرجَحَتُه هيّنة، إذْ كانت تكفي لمسة خفيفة من إصبعك، وأنت ناعسة تحدّقين باللهب في عين المدفأة، أو دائخة تحت وهج الشمس، تغطّين رأسك بمنشفة. لمستك تمرجحني، فترنّ الأجراس الثلاثة الصغيرة فوق رأسي، المعلقة إلى العارضة التي كنتِ تحملينني بها من قسوة الشمس إلى رحمة الظل، أو من تعاسة الظل إلى بهجة الشمس، خفيفاً، مقمّطاً بالكتّان. كان رنين الأجراس يُسكت بكائي، كما يهدئ روعك ناقوسٌ يتأرجح في برج كنيسة السريان، على الجانب الآخر من البلدة.

عشية السبت، كنتُ أنتظر أنْ يُبثّ برنامج الأبراج لإبراهيم حزبون على صوت إسرائيل، فأغيّر الإذاعة، مُدارياً لهفتي المشوبة بالقلق. يداي ترجفان قليلاً. ركبتاي المهتزّان لا تنصاعان لزجرك. مرة أبكرتُ، وأثناء دقائق الانتظار فوجئت بحديث إذاعي أتذكره بحذافيره، وإنْ فاتتني مقدمته. كان حاخام يتحدث، بالعربية الفصحى، عن الختان في مستشفيات تل أبيب. قال إنّ هذه العادة صحراوية. أخذها اليهود عن المصريين القدماء، إذْ كانت ذكورهم تلتهب حين تدخل حبات رمل طيات قلفاتهم، ولهذا أزالوها. قال أيضاً إنّ إسرائيل رائدة في مجال الدراسات العلمية للختان. هناك دراسة معمّقة في جامعة القدس، كشفت أنّ هرمون الشدّة، أي الكورتيزول (صحّحه المذيع: «الكورتيزون»، فصحّح الحاخام تصحيحه: «بل الكورتيزول»)، يرتفع في دم الرضيع، المختون عادةً بيد الحاخام خلال الأيام الأولى بعد الولادة. يبقى هذا الهرمون مرتفعاً لأسبوع كامل. هذا المنسوب يعادل بارتفاعه حادث سيارة، ولهذا لا ينسى الولد تفاصيل الختان أبداً، إذا كان واعياً بالطبع. إنه مثل كيّ اللحم بالنار. عضضتُ الستارة ندماً، ولم أنمْ جيداً لأيام، حين علمتُ أنّ القلفة المبتورة احتياطيُّ جلد، تُطعَّم به البشرة إذا احترقت، أو ضاع بعضها. مِن أيّ بنك استعار الحاخام فكرة «الاحتياطي» هذه؟ لمواساة المتأخّرين عن الختان المبكّر، أضاف أنّ هذه الخسارة مكسب، فهي تجعل مَن يجتازها صاحبَ كلمة. ختمَ بأنّ أول المختونين في التاريخ هو النبي إبراهيم. ختن نفسه بفأس في شيخوخته. كنت أتخيّل جدّنا النبيّ العجوز، طيفاً يمطّ في الخفاء قلفته بيسراه، على جذع الكينا المقطوع في باحة بيتنا، المتروك مثل لوح تقطيع في محلات القصّابين، ويمناه تطهّر بضربةِ فأس رأسَ ذكره. ربما كانت الفأس نفسها التي حطّم بها أصنام الكعبة.
كنتِ تقولين إنّ مثانتي ضيّقة، وخلقي ضيّق، وحلْقي ضيّق أتشردق بجرعة ماء. كنت أقرفص وأستعصي أحياناً في بيت الراحة، ذاك النائي عن الغرف، المفتوح على السماء، وربما اختلستُ هناك قراءة صفحات ممزّقة من «وليمة لأعشاب البحر»، حيث مارست فلّة بوعنّاب شهوتها بالقلم «حتى بكى فرجها». لا أنسى هذا التعبير. تساءلت: «هل هذا هو أسلوب الفرشاة في الممارسة؟»؛ أو ربما هتفتُ الكلمات الثلاث الممطوطة: «أهدافنا: وحدة حريــــــــــّـــــــــة اشتراكيـــــــــــــــــــــّــــــة»، فثالوث البعث يتحقق بتمامه في دورات المياه؛ أو غنّيتُ صادحاً «الوردة الحمراء»، فتتهادى أمامي في مكعب الطين ورقةٌ صفراء أرسلتها إليّ شجرة التوت في تشرين. كنتُ أشرد حتى تتخدّر قدماي، فأعرج عند خروجي كمَن أصابتْ شظيةٌ ساقه، أو يُنادى عليّ بالصراخ:
-اخرجْ، وإلا أتيتُك!
فيرتبك المراهق الذي كنتُه، في خلوته هناك، لم يميّز يمناه من يسراه عند الدخول، لا بابَ ليسارع إلى إقفاله على نفسه ويطمئنّ، وقد بدأتْ مياهُ الرجولة دورانَها في خصيتيه، فسقَتِ الوبرَ الأسود النجس في شاربيه، وشقّقتْ صوته، ونضحتْ من إبطيه. لا مناص من الشرود عند القرفصة، إذ يُحسَر الجلباب، أو الفستان، أو السروال، فيداعب النسيمُ الفخذين العاريتين، منعشاً ما يخفى، أو ينتأ، أو يتفتّح بينهما. العقل سارحٌ في برودة الظلال، وغناء الحشرات. كانت القرفصة الأمتع حين يكتمل القمر في سماء الربيع، منيراً ممشى الأحجار البيضاء، بين الغرف وباب الدار، وبينها يبرز الحجر الذي أنبّه الضيوف لكيلا يعثروا به، والخفافيش فوقنا تسبَح في الهواء كالسكارى، وتسبّح باسم ربّها الذي خلق.