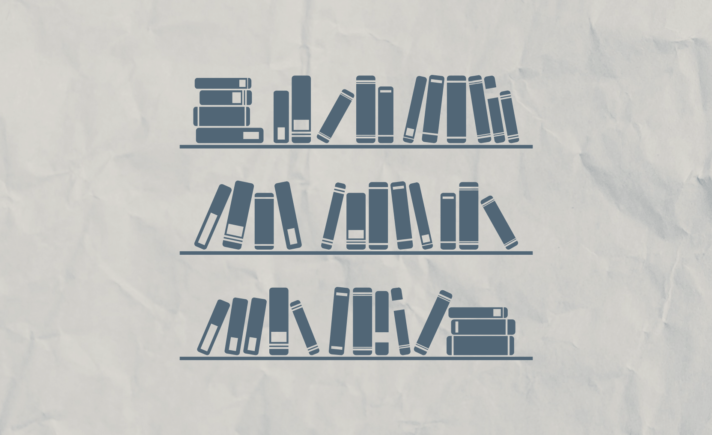Seek those images
That constitute the wild,
The lion and the virgin,
The harlot and the child.W. B. Yeats
حين فتحتُ عيني كنتُ غريباً عن كل شيء.
لا ألذّ من غفوةٍ لا فراش لها. قيلولة على رأس جبلٍ بضعَ دقائق، أو ربما دقيقة واحدة، أغنتني عن نوم ليلة كاملة. السِنةُ سَنة لمن آمن. للحظاتٍ لم أعِ أين أنا، ولو سئلتُ اسمي لما تذكّرته. عيناي ترمشان. جافتان قليلاً. أستدلّ بجفافهما إلى وصول أولى الهدايا من الشجر والزهور التي سيُخضِّبُ طلعُها بياضَ عيني، ويُسيِّل أنفي. تنمّلٌ في وجهي، وإبرٌ تخزُ أسفل فكّي. هل سُقيت سُمّاً، أو ترياقاً، وأنا غافٍ بشفتين منفرجتين؟ هل توفّاني «الملكموت» وأنا وسنان؟ ألمٌ خفيف يتيبّس معه أيسر عنقي لا يلبث أن يزول. حموضة خفيفة تفور من معدتي الفارغة. رأسي فارغ تحت السماء الصافية الواسعة. كأن هذه الصخرة التي اتكأتُ إليها قد امتصّت عقلي فنسيتُ كل شيء، وتبخّرت أفكاري في البخار المتصاعد من رؤوس الأشجار، فصفوتُ كأحجار هذه المرتفعات حولي، والتحمتُ بترابٍ أنا منه وسأكون فيه.
أخيراً، هَجرتُ كل الذين أعرفهم، المبعثرين مثلي. تركتُ المقاتلين وأهل السِلم، الشجعان والجبناء، الصامتين والمفوّهين، واختفيتُ مثلما حلمتُ على الدوام. أخيراً، اختليتُ بنفسي كحيوانٍ انزوى لأن ساعة أجله قد حانت. قدماي مكدودتان، ساخنتان. الهواء رقيق. آخذ نفساً عميقاً تتغلغل برودته في أحشائي حتى تبلُغَ الكعبين والأصابع، وأكاد أدوخ. نضحتُ عرقاً وأنا أستعجل المشي في وعورة هذه الشِعاب. جعبتي أثقل من كيس عدس. كتفاي متشنجتان ممّا حملت. سروال البشمركه الذي أرتديه مريح وسميك، بيج، أمتن من شوادر الخيام. أحياناً يطقطق كجلباب أحْمِه مجنون البطيخ، غاسل الوجه مرةً في الأسبوع. كان إذا قرفص خاف أن يتقصّف ثوبه كخبز المرقوق اليابس، بعدما تشرّب القماشُ عصيرَ البطيخ وتعفّر بالتراب، فقسا كالفخّار. كنتُ أتملّى ما يسيل من الماء الأحمر إلى نحره ومعصميه، فأمرّر إصبعي على خطوط العصير التي نشّفتها شمس الصيف على صدر جلبابه، وأقول:
-هذا شطّ العرب وخليج الفرس، وهنا بحر الخزر والبحر الأسود، وهنا المتوسط.
ثم أرسم له على تلك الخطوط بقلمي ذي الألوان الأربعة خريطةَ كردستان. كان يلحّ علي:
-غطّ بكردستان قلبي، وافتحها على البحر الأبيض، لتتعلّموا السباحة في المستقبل، ولا تكرهوا الاستحمام مثلي… صِلِ المحرومة بالبحر، حتى لو أكلت بعضاً من أراضي جيرانها هنا وهناك.

سروالي أطرى، فضفاضٌ كسراويل العتّالين الذين كان السِّماط يبري مغابنهم، القماش في منتصفها يتدلّى متجعّداً، مُهدهداً خصاهم في الحرّ (كانت هذه هي الصورة التي ترتسم أمام عيني، أو بالأحرى وراءهما، حين تصادفني كلمة «تدلّى»). كانوا يقولون إنّ لأحصنتهم معلفٌ احتياطي، فهذا الجيبُ الثالث، الواسع والمتدلّي، مستودعٌ أيضاً، يصلح كمكان دافئ معتم لتحمرّ البندورة الفجّة، بعد قطافها أواخر الصيف، تلذّ حموضتها لأسنانهم في عشاءات تشرين، وقد علقت بها ذرّاتُ تبن. أحياناً، كانت تفوح منهم كالأطفال رائحة بودرة تالْك. كانوا يرشّونها تحت آباطهم، وعلى شعر صدورهم وأصفانهم. كان العرق يضرّج وجوههم، وهم يرفعون بالكلاليب أكياسَ الحبوب على ظهورهم، خلف شاحنات سكانيا، ويصعدون بخطى وئيدة سلالمَ الخشب التي لا فراغات بين درجاتها، مشيّدين بيوتاً شاهقة من الحبوب، تحت شمسٍ تسلخ الرؤوس في حزيران وتموز. كنتُ أراهم من بعيد فأدوخ. أفكّر بدوار المرتفعات الذي بدأتُ أعاني منه هنا، وأخجلني ظهوره. أحياناً تبدو لي السفوح الشاهقة جدراناً تميل صوبي، تتداعى فوقي وتدفنني.

يفرِغُني الجبل من عقلي. يرميني في هاوية لا نهاية لها داخل نفسي. المهالك محيطة بي، وروحي بأمسّ الحاجة إلى قوّة جسدي وخفّته. لا غنى لي عن الخفّة، لتستمرّ أيامي المتبقّية هنا، وأنجو بجلدي. ما عاد لي سقفٌ مرفوع بأيدي البشر. النوم في العراء أخطر وأقصر، لكنه أعمق. مَن يستغرقه النوم تدكُن بشرته كالغرقى. خفيفةً تعود مخاوفي الأولى التي أرّقتني، وجهدت سدى لدحضها: الأحراش هي الشعر المنكوش لـ«سوداء الليل»، عيونها الحباحب- البرغش «أبو لمبة».
الحافات كارثة لمسرنمٍ مثلي. مرة أنهضني شلال. سار هديره بقدميّ. تثعبنَ الدرب الضيق حتى وقفتُ على شفير حفرة، بعيدة الغور، كما يُقال في مواضيع الإنشاء. لن تصدّقي أني نمتُ بعينين نصف مفتوحتين على الحافة، يهدهدني، طوال الليل، الخرير وارتطام الماء بالصوّان، حتى دفّأتني الشمس وأيقظتني. لاح أمامي جدار رمادي شاهق. حفرة لا قرار لها بالفعل. حدّقت بنصل حربتي، كصغيرٍ يتملّى وجهَهُ منعكِساً على قفلٍ لامع، فرأيتُ قسطاً ضئيلاً من الهاوية. تمليتها حتى دار العالم بي، بطيئاً مخيفَ الهدوء، كصقر يحوم في دوائر فوق هذه المرتفعات، قبل الانقضاض عليّ. غثتْ نفسي غثياناً شديداً كان سيدفع رفاقي للتشكيك في رجولتي. ثم بدأ الطنين. تخيلتُني أهوي دون بلوغ أيّ قرار، كأنّي الشلالُ وقد استحال قالبَ جليد عملاقاً. كيف للماء هادر الجريان أن يتجمّد؟ كأن المشهد كله جرى داخل جسدي، وأنا الحالم بسقوطٍ أستيقظ منه في الثواني الأخيرة، قبل ارتطامي بالقاع، فلا يلاقيني حتفي الذي يرافق كلَّ خطوة أخطوها على هذه الجبال. أظنّه دنوّ الموت ما يُدني الإنسان إلى طفولته، فكيف سأفارقها إذا لم يفارقني؟ ربما كل ما أراه قد وَلَدتْهُ أحلامي وكوابيسي، تجسّد حولي وأنا نائم.

كل شيء يحلم- الجمادُ، وما يتنفس من المخلوقات. مَن يحلم يسبّح، وثانية الحلم دهرٌ، كيوم من أيام خلق الكون. إذا كان بعض الأكراد أحلام الصخور، فبعضهم الآخر حلم كلب، أو حلم حصان، أو حلم شجرة. أنا حلمك. كم نهرتني عن صفاقة التحديق في وجه نائم، إلا إذا غشَتْه ستارةٌ رقيقة. النوم شرُّ وقتٍ لصبّ اللعنات. مرةً خلعتِ خمارك الشفيف، وغطّيتِ به وجهي، الغاطّ في النوم، لتهشّي ذبابة ملحاحة تتنقّل بين زاوية فمي وزاوية عيني، أذني متوسّدة راحتي، كأني عبد الباسط عبد الصمد موجوع التقاطيع، ولا شيء، لا شيء حتى أعجوبة النوم، بقادرٍ أنْ يشرح لي هذه الجهامة لتفارق وجهي. أفقتُ شامّاً فوحَ الغار في خمارك الذي تغسلينه بيديك، قادماً إليك من مكان بعيد داخل نفسي. عيناك العسليتان الواسعتان مفتوحتان فوقي. شرودك يخطرني أنك قد رأيتِ المنام نفسه قبلي بلحظات. كلانا نسيناه، ثم عاد إليك أولاً. لا تدرين في أيّ ظلمات تدور المنامات، خارج جسدك، أم في صندوق دماغك، أم عروق دمك. كنت ترين بؤبؤيّ يتململان، تحت ارتجافات جفني المسبَلين، يدوران كمكوك الحائك، فينسجان حلماً أنساه ما إنْ أفتح عيني. ذاك أوان المنامات في «نوم الريم» الخفيف. حسبته «نوم الغزال». تمسكتُ بخطئي، بعدما علمت أنّ المقصود من «ريم» هو حركات العين السريعة، كما يسجّلها تخطيط الدماغ، و«نوم الغزال» هو الصرع الصغير. آلات لا تفهمين تعقيدها تحجب الألغاز. لا أحد يستطيع أنْ يسترجع حلمه كاملاً. كنت أخاف حقاً دفتر إبليس، أو دفتر الملاك، ففيه تُدوَّن كلماتُ النائمين. على كتفيّ متلصّصان شرهان كأفاعي الضحّاك يلتهمان عقلي، يسجّلان ما سيفلته فمي المهمهم من فاضح الأسرار وأنا نائم، أو ربما، في أروع الأحوال، ينوّطان لحناً، أو كلمات أغنية تتلاشى فور استيقاظي، فيتآكلني الندم، ثم يعود بعضٌ من تلك الأغنية المنسية، بغتة في وضح النهار، فيتأكّد لي زيفها، ولا يردعني هذا عن الانبهار بها. لن يضيع أيّ شيء.كان «شيخ الكُتّان» كبير العتالين. «عدم المؤاخذة»، كنتِ تحبّين ترديد هاتين الكلمتين، مازحةً بالعربية ليخفّ ضيق صدرك إذا طالتْ محاولاتك التحدّثَ بها. عدم المؤاخذة، إنْ كنتِ لا تعلمين، كان اسمه يُلْفظ بضمّ الكاف «شيخ الكُتّان». كان يجلس في استراحة الشاي في الميرة، تلك الخيمة المسيّجة بأكياس خيش قديمة، يمسّد الفتق الذي أصاب سرّته، وأقعده كأن «أحشاءه انهارت»، حتى لفّ الفتق بوشاح مملوء بتبن حصانه. كان يقول إنّ العتالين أولادُ أمّهاتهم، يُنسَبون إليهنّ كعيسى بن مريم، ولا يخجلهم أنْ ينطقوا أسماءَهنّ:
-ليَ الشرف والفخر. فليُقَلْ عني ابن اليهودية!

يبني العتالون بالأكياس التي يحملونها منازل أوروبية ضخمة، قصوراً سطوحها مائلة، ولَبناتُها من ذهب القمح، يكسوها الخيش بدلاً من القرميد والغرانيت، ويغطّيها الغبار بدلاً من الثلج، خصوصاً حين يحمرّ الهواء بالعجاج، فتشحب الشمس كالزرّ القديم، وتزرقّ أنوار النيون في عواصف الخماسين، ازرقاقاً غريباً كقاتلات البعوض. رأيتُ، في تلك الساعات، كيف تخرج بخّاخات الربو من جيوب العجائز، الساعلين تحت خيم «قرموطي» لمجالس العزاء. لكنها منازل مصمتة من الداخل، لا تصلح للسكنى، اللهمّ إلا للعصافير والنمل وفئران الحقول والثعابين… هل تستطيعين أنْ تسكني منزلاً ليس له من حقيقة اسمه إلا الشكل الخارجي، وليس لك في داخله أي فراغ يخصّك؟ أنا أستطيع، حتى هنا في البرّية، تحت شجرة البندق الكبيرة هذه، لأنني عشتُ هكذا على الدوام- ضيفاً خائفاً، مسافراً خائفاً، لم يكن لي مكان في أيّ مكان آواني. كيف للحياة أن تُعاش، ما دمتُ أتوقّع ظهور من سيذكّرني في أيّ لحظة: «لست من هنا. عُد من حيث أتيت؟» كان المنزل حلماً تشرّدتُ في أرجائه. وحيداً، سأعود إليك وحدك.

امتعضتُ من شدّة المبالاة بأيّ شيء أقتنيه، وحراسته بالحرص. قلتِ:
-لا أطيق البخل. الحريصون على مقتنياتهم بخلاء وجبناء. أياديهم من إسمنت. الأسخياء الحقيقيون هم البدو.
فخشيتُ أنني المقصود بالبخل في تعليقك، قبل إعدادك زهورات الختمية، ساعة العصر، وبينها زهرةٌ كانت زنزانةً أنا سجّانها. كنتُ ألاعب الموت بنحلةٍ أحبسها طيّ البتلات، ثم أغلق فم الزهرة وأقطفها، لأسحرَ مسامعَك بطنين الجمال الذي أخنقه، فتُعتقينه بصفعةٍ على ظاهر يدي. الختمية تُذْهب الوحشة عني، وأينما رأيتُها أعادتني إليك، أو إليّ؛ تكشّر لاهيةً معي، مثل طفل يغسل أسنانه وفرشاته بيدي؛ تُحيي بأبواقها الأمكنةَ المهجورة، وكأنها تعزف في صمت لحنَ وداع سرياً لأرواح الذين غادروا؛ تصطفّ بذورها السوداء في أقراص كعمامات العثمانيين، بل كحلمات النهود، على تلك السيقان الوبِرة، الرفيعة. دهنتُ بطلَعها الأصفر خدّيك، انتزعتُ تويجاتها، شاقّاً أطرافها اللزجة، لألصقها كالأقراط الديريّة إلى أذنيك اللتين انسدّت ثقوبُ أقراطهما. كنتُ أستغرب جلَدك، وإصرارك على تعقيم عينك بقطراتٍ من الليمون. كنتُ أقشعرّ حين أنقّطها بين جفنيك، حتى تسيل داخل أنفك، وتكوي جيوبه، ثم تدورين بالثمرة تعصرينها فوق كأسي وكأسك، فيتورّد شراب الختمية الشفاف، قطرة ليمون بعد قطرة:
-هيرو! هذه زهورات مام جلال، تتلوّن مثله!
وبما تبقّى من اللبّ الحامض تفركين يديك وتشمّينهما:
-أزكى من فوح الكهرمان في مسبحتي عند فركها. شمّ!
ثم تمسحين بماء الليمون شعري ووجهك.

أخذتُ عن العتّال صورو مداواةَ سماط فخذيّ بالتراب، الضارب إلى الحمرة، الأشبه بالحناء أو الزعتر. لكنه نادرٌ هنا. استعضتُ عنه بالطحالب والأشنيّات، وإذْ أكشطها عن وجوه الصخور تتراءى لي البقع النحاسية في ابتسامة سالار، الخجول المتمتم، يفسّر صدأ أسنانه للسائلين:
-السبب؟ عوز الفلور في ماء القرية…
مكرّراً تفسير طبيب الأسنان في المستوصف، كما يكرّر بالخجل نفسه أمام الموظّفين البدو، أو أمام المعلّمين والمعلّمات الآتين من الساحل وحمص، وهم يطلبون منه دائماً أنْ يرفع صوته، ويردّد لهم معنى اسمه بالعربية: «القائد». أفتّتُ الأشنيات اليابسة بأصابعي، حتى تصير في كفّي كالدقّة الممزوجة بالكمّون والسمّاق، فأودّ لو ألعقها، ثم أفرك بالمسحوق احمرارَ جلدي الذي يقعدني أحياناً عن المشي، أنا كاره الجلوس. صدأ حارقٌ بين فخذيّ، أتخيّلني أكتب فوق هذا الاحمرار، كما كنتُ أخطّ نوع الحنطة على أكياس الحبوب، متنشّقاً رائحة الخيش المدهون بزيت القنّب الهنديّ، ومتلذّذاً بالكتابة فوقه، وقلم «الشنيار» في يدي. كنتُ أتجنّب هذا التعبير الأخير، المخجل «قلم الشنيار». أفتقد الكتابة بإصبع طباشير على السطوح الصدئة. متعة لن تعود. كنتُ أختلس كتابة الحرف الأول من اسمي بإصبعي، على أيّ سطح طريّ- سطل لبن فيه مذاقُ شعر الماعز المحروق، أو طين لم يجفّ على الجدران، أو صبّة إسمنت في آخر تمليسها… أو كنت أحفر الحرف بمفتاح على كلّ ما يصدأ، من بقع الطلاء المتقشر في باب بيتنا، وبوابة كراج الجرّار المصبوغة بصباغ يسمّونه «أحمر التأسيس»، إلى باب قنّ الدجاج ومؤخّرات الحصّادات، وحتّى المزاريب وخزانات المازوت.

كتبتُ الكثير على الوجوه الخلفية للأوراق المطبوعة، خاشياً من يتّهمني بالتقتير. لملمتُ الورق المقوّى من أكياس القمصان الجديدة، بطاقات الأعراس المرسلة إلى «العائلة المحترمة»، المغلّفات، أوراق انتخابات البلدية التي رشّح فيها أبي نفسه عن «الحزب» وخسر. كان هناك خطأ في الطباعة استفزّه كثيراً، وغيّر اسمه من «حامد» إلى «حمد»:
-كيف يتحدثون عن بناء الوطن، وهم يرتكبون هذه الأخطاء التافهة!
لملمتُ الكثير من أوراق تُرمى عادة. كتبتُ فيها مسوَّدات رسائل طويلة إلى الممثّلات. انتظرتُ ردودهنّ أحياناً، رغم أني لم أرسلها. تبتُ «التوبة النصوح» حين أرسلتُ إحداها، واحدة فقط لا غير. ما تبقّى كله رسائل إلى نفسي. كلمات تلك الرسالة اليتيمة لم تبارح رأسي ساعاتٍ وأياماً؛ راحت تتردّد وترتسم أشباحاً تتلاسن داخل جسدي، ضدّي ومعي، فتصحّحني وتتوعّدني، أو تمتدحني وتشدّ على يدي، مثل وجه واحد ضخم، ذي نظرتين في آنٍ معاً: إحداهما تؤنّبني، والأخرى تُشيد بي. لم أستطع الاهتداء إلى الكلمة الفَصْل، أو الكلمة الأخيرة. توحّش ندمي، حتى تمنيتُ حريقاً في مؤسسات البرق والهاتف كلّها، لكيلا تصل تلك الرسالة أبداً. كنتُ قد خصصت لها، في ذلك الصيف البعيد، أياماً بأكملها. تُهتُ بين مسوّداتها لفرط التنقيح. لفرط ما راجعتُها أوشكتُ أحفظها عن ظهر قلب. خيّطت المغلّف بيدي. طرّزت أطرافه كفساتين النوروز بخيطان قزحية الألوان، بدلاً من تلك المعينات المتناوبة بالأزرق والأحمر على حافات المغلّفات. ولما شرعتُ بالكتابة بدأت الدوامات تتقاذف عقلي، من متعة اللحظة، وانتشائي بنفسي، إلى اشمئزازي مما كتبت، حتى تشوّش كلّ شيء، فلم يعُدْ هناك حدّ، ولا منطق، ولا معنى، ولا بداية، ولا نهاية. كان عليّ- أنا العاجز عن تحديد الخيارات، بعدما باتت كلّ كلمة لغماً من المعاني، وقد تُفسَّر بألف طريقة- كان عليّ أن أدرك إنّ الحسم الوحيد هو تمزيق الرسالة أو إحراقها، نسيانها إلى الأبد. فليُرِحني النسيان، فليرْخِني النسيان. هيهات. ربما ضغطت رأسَ القلم زيادة عن اللزوم، فانطبعت أشباح كلمات محذوفة على ورقة المبيّضة تحتها، واصطيادها سهل عند إمالتها في النور. يستفزني السهو، لأني لم أتعلّم كيف أغفر لنفسي. كأنّ كلّ زلّةٍ وصمةٌ في أرشيف لا أدري مَن يكدّس ملفاته ضدّي. لا أدري متى سيشهّر الوضعاء بي. أردتُ رسالتي فوق كلّ عيب، لا يشوبها أيّ خطأ مهما ضؤل، فأتفه الهفوات كأعند الشوائب تلتصق بالذاكرة، لا تبارحها حتى لو غُفِرت، حتى لو تلطّف بنا مرور الزمن، وزيّن لنا أخطاءَ حاضرنا لتمتدّ البسمات في المستقبل. فمن ذا الذي سيقتصّ مني إذا أخطأتُ في حرف، أو حركة أو فاصلة، أو شطبت كلمة؟ كم تمريناً أعددتُ لكيلا تحتوي رسالتي خطأ واحداً، ولا حتى حرفاً واحداً مشطوباً، يستحيل استدراكه بعد الإرسال؟ عينُ مَن قرأت تلك الكلمات معي؟ أيّ عين ستقرأها في غيابي فتتشفّى بي، وتهزأ بتكلّفي، وتنعتني بالمتذاكي؟ فيمَ التفنّن في جمال الخطّ، ولماذا تباهيتُ بالتأني؟ بغتةً ناجيتُني:
-آه يا غروري، ما أشدّ بؤسك!
ذاك مآل عذابي: لن تسارع الممثلة متلهّفة لتقبِّل رسالتي، ثم تفتحها بأصابع مرتجفة وقلب مرتجف، بل سترميها بضجرٍ عاديّ إلى فرّامة الورق، دون فتحها، فتنطحن كلماتي بين تلك الأسنان الفولاذية كشِراك الثعالب، وتنتهي إلى القمامة مع رسائل غيري، خفيفة كالبوشار أو نثار الفلين. تخيّلت، بعد كل هذا العناء، ورودَ اسمي بالخطأ في الردود السريعة من بريد القراء، أو بين طلّاب أغنية لعمرو دياب على «ما يطلبه الجمهور».
عرفتُ بيوتاً لم يكن فيها غير قلم واحد بجانب الهاتف. الناس يجهلون كيف يكتبون. ربما يخافون الكتابة كالشعوذات، أو كالشبهات والممنوعات. إذا ما اضطروا، وحاولوا أنْ يكتبوا شيئاً، أتاهم الإلهام كلاماً جاهزاً، يملأ صدورهم بالزهو والرضا فلا يفهمون برودَ الآخرين. لا يدركون كيف يرى الآخرون الوضوحَ الشديد غموضاً. قد يتداركون فشلهم، ويشقّون محاولاتهم نتفاً، بل حتى يحرقونها ليدفنوا في الرماد خزيَ أخطائهم وركاكتهم. ضماناً للردّ، كنتُ قد فكرتُ بمراسلةِ نجمة من «الطبقة الكادحة»، صعدتْ فجأة سلّم النجوم. كنتُ واثقاً من أنها ستميّز سماكة خطّ قلم «الريم»، ستميّزه عن رشاقة الفرنساوي الأزرق، ذي الرأس الناعم، والخط الرفيع كالحاجب المزجّج، مغتبطاً بأن أتخيّل بياض كمّها يتلطّخ بمشحة حبر نفثها قلم «الريم»، في نقطةٍ ما آخر سطرٍ ما.

كتبتُ بالحبر الناشف، تحسّباً لأيّ بلل محتمل، من قبيل كوب شاي يندلق على أدراج المكاتب في البريد، أو وابل مطر صيفي يبلّل جُعَب السعاة، المعلقةَ خلف درّاجاتهم كخُرْج حمار. تردّدتُ أمام النعوت، مبغضاً إسرافي في التهذيب، مترنّحاً على الشعرة الممدودة بين التذلُّل والتكبُّر، بين الصدق والتنميق. احترتُ هل أبدأ معرّفاً بنفسي، ومَنِ الأولى بتقديم الاسم في المخاطبة أنا أم هي، ثم متى ستصل الرسالة، وفي أيّ وقت سوف تُقرأ، هذا إذا وصلت وإذا قُرئت، متذبذباً بين «صباح الخير» و«مساء النور»، أو «تحية عطرة وبعد»، أو «الأخت الفاضلة»، أو «الآنسة الموقّرة»، أو «سيدتي الكريمة» في البداية، فأخاف جفافَ تحيّتي، كما يقلقني جفافُ الردود، واحتمالات تأخّرها، وشدّة ترقّبها على نكرة مثلي لا يُبالى بالردّ عليه، تستفزّ غيره ميوعةُ كلماته، أو ربما وقاحتها، إذ لا صبرَ لواحد مثلي ما فاضَ على قحط سنواته إلا الانتظار. كانت خشيتي أنّ الضعافَ والمهزوزين وحدهم يكتبون أجمل الرسائل. كنتُ أهزّ رأسي بيأس المتفائلين، الظانّين أن مخاوف السخرية شائعة، لا تداويها إلا الشيخوخة، ثم أحذف «عزيزتي»، لأنها تطاول أو مجاملة، أو حتى شتيمة إذا كانت الممثلة من جبل العرب. الأكيد أنّ الفنانات يتلقّين دوماً رسائل نابية من المعجبين. ثقبتُ ياء الملكية برأس القلم، وشطبتُ «أمّا بعد»، لأني لستُ الرسول مكاتباً المقوقس عظيم القبط، وصولاً إلى «مودتي» في الختام، أو «محبتي»، أو «تفضّلوا بقبول فائق الاحترام»، أو «تفضّلن بقبول فائق الاحترام»، أو جلافة «وشكراً» الناشفة كالخبز اليابس، محاذراً أنْ تلتصق بي «أطيب الأمنيات» وتصير لقبي، إذا فُتِح المغلف وقُرئ ما فيه، فأنادَى به في الشوارع؛ ما بين البدء والختام سهامٌ بالأحمر، تشطيبات وإشارات ضرب مدوّخة، وأنا جاهل إلى متى سأحتار ماذا سأختار، وكيف سأختتم، وهل يحقّ لي إمضاء الرسالة. أين سأضع المكان والتاريخ، يساراً أم يميناً؟ في أعلى الصفحة، أم أسفلها؟ وهكذا إلى أنْ رفعتُ رأسي عن الأوراق، وقد زاغت عيناي، وغشت الظلالُ ما حولي، فرأيتني جالساً إلى جحش الكوي أكتب، أمامي النافذة الواسعة المغطاة بالمنخل. باغتتني كلماتي، تروقني كأن مَن كتبها سواي، فكدتُ أحضن الجحش، ضاحكاً كلاعب جمباز تزحلق في قفزته على الحصان الخشبي. قرب يدي بخّاخ المكواة، مثل مسدّس مائي ملقَّم بمبيد سائل من أجل ورودك المريضة التي قضم المنّ أوراقها الخضراء، وثقّبها كالغربال. فكّرتُ مراراً بتربية «أسد المنّ» من أجلها.

أحياناً أخرى، كنتُ أجلس إلى آلة الخياطة التي لا تعرفين كيف تستخدمينها. كانت تسدّ بابَ الصالون الشماليَّ، المغطّى بالنايلون في الشتاء، ومن تحته يتسرّب هواء كالشفرة لاسع البرودة. إذا طُويت الآلة في صندوقها الخشبي صارت طاولتي، بسطحها البني، المزيّن بفراشة ذهبية من الصين، كنتُ أخيط رسالتي بين جناحيها، منكبّاً على كلماتي خلسة، ساعةَ قيلولتكم، ونومكم يطلق عباراتي في رحاب الكون. فإذا دُوهمتُ سارعتُ إلى مضغ الورقة كالجدي، أو رميها في خزانة الحائط، المتوارية وراء اللحف والمخدات المصفوفة كالجدار، لاهياً بالصعود ومعانقاً قمته، للاستلقاء هناك. كنتُ أحياناً أختبئ في تلك الخزانة، وراء ذاك الجدار الوثير، فأعثر هناك على كرتي المنسية، الرقيقة المنفوخة بالفم، المقلّمة بخطوط عريضة لقوس قزح كحزوز البطيخ. كنتُ أعدّ بها على ركبتي وقدميّ حتى المئتين، وأنا أجوب الغرف وحدي. كنتُ أجلس داخل تلك الخزانة الضيقة العالية، الظلّ الرحيم يكتنفني، كرتي في حضني، ذابلةٌ ذبولَ البالونات المنسية في زينة رأس السنة بعد أيام من انتهاء السهرة، فيتناهى إليّ، عبر الجدار الذي يرقّ في خزانات الطين، غناءُ جارنا حارس الحاووز. كان صوته يلعلع في الحمّام:
-Kîme Ez؟ Kîme Ez؟
فأجيبه زاعقاً:
-أنا العشب المرّ في باحة البيت.
وأتحدّاه من هناك، والجدار بيننا، ليردّد معي نشيدنا الوطني الذي لا وطن له:
-تقدّموا… تقدّموا! الكرد لا يموتون، الكرد ينبتون…
فيفحمني تعليقك:
-صحيح، صحيح. الكرد ينبتون، ويخضرّون، ويزرقّون، ويأتي الماعز ويأكلهم عن جنبات الطريق.

هناك أناسٌ، في كل أصقاع الأرض، يخشون أنْ تضيع رسالتهم المنتظرة، المسجّلة باسمهم، فيما هم سُدى ينهرون اهتزاز سيقانهم، في وحشتهم وأرقهم، متحرّقين أملاً لتقبض أصابعهم على الورقة المشتهاة كالطير البرّي، ثم تختفي المنتظَرة بانقلاب سيارة البريد، أو تمزّق كيس الرسائل، وطيران أوراقها مع أكياس القمامة داخل زوبعة، أو بتسليم الرسالة لشخص آخر في سهوةٍ من ساعي البريد، هذا الأسعد من سعاد حسني على درّاجة هوائية، أو تُرمى مع ما تطفح به صناديق الناس، ولا يُنْتبه إليها بين دعايات البيتزا، والمكاتب العقارية، والمتاجر العملاقة، وبطاقات المشعوذين، والأطباء الشعبيين، وورشات الصحية… أحياناً، ثمن الهفوة حياة بأكملها. هفوة واحدة تكفي ليكتمل نحسُ البعض بفقدان أهمّ رسالة في حياتهم، كانت ستقلب مجرى أيامهم بالكامل، وتحقن رؤوسهم بوهم البدء من جديد، فيتفّهون أنفسهم على استهتارهم، ويشتمون أنفسهم بلا هوادة ولا شفقة، في السرّ والعلانية، ليلاً نهاراً. أنا واحدٌ من هؤلاء. الذنب ذنبي، ولن أنال أيّ صفح من أحد. في الصمت الناريّ لوحدتي، استعددتُ للملاحقات، لأن رسالتي الضائعة ظلّتْ عالقة على الطريق كالمخطوفة بأيدي مجهولين، فلم تعُدْ إليّ ولم تصلْ إلى مقصدها. انتهتْ مهلة الردّ وفق بنود قوانين لن أعرفها أبداً. انتهت المهلةُ الممنوحة للغرباء، المكشوفين أمثالي، للبقاء على هذه الأرض، حتى أتى مَن أتى ليطردني إلى هذه الجبال، إلى عراء النسيان، إلى عزاء النسيان.

اختزلتُ رسائلي كثيراً. أعددتُ لها مسوّدات نقّحتها، ونمّقتُها مائة مرة، حتى قضيتُ على آخر ذرّة صدق فيها وكرهتُها، ثم أعدتُ كتابتها، حريصاً ألا تميل سطوري في النسخة الأخيرة، كأنّها خيوطُ مطر أزاحها قلقُ أنفاسي. لهذا سطّرتُ بياض الورقة بالمسطرة وبقلم رصاص، ثم محوتُ السطور، على أقلّ من مهلي لكيلا تجعّد الممحاةُ الورقة. المحو أخيراً، بعد الانتهاء من التدوين بمزيج من الخطّ الفارسي والخطّ الفنّي الحديث، لأن الرقعة والنسخ مبتذَلان. أخيراً، تجرأت على إرسال الرسالة اليتيمة إلى إحداهنّ:
دمشق
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
تصل ليد الفنانة مرح جبر
مع الشكر لساعي البريد
حرّكتُها بقوّة كمروحة الشواء، لأذبّ عنها بقايا روائحي، ثم حسمتُ أمري وأرسلتها. وبعد بضع دقائق، انتبهتُ إلى تلوّثها بطيش اللحظة الأخيرة. السبب حماستي اللعينة، وابتهاجي بأنني انتهيتُ فعلاً. كنتُ قد كتبت العنوان بخطّ عريض أسود، وكأنّ ساعي البريد مكفوف. لم أكتب عنواني، لأن تحديده يحيّرني، ولا أثق بأي بديل كالكوّاء أو السمّان، واسم شارعنا «سليمان الحلبي»، المكتوب بحروف بيضاء على صفيحة زرقاء كاللافتات في باريس، اختفى عن الناصية بعد تطيين جارنا جدرانَ بيته الخريفَ الفائت. لو رأت الممثلة اسمي الكردي، أو اسم بلدتي، على المغلف لرمته من باب الحيطة، أو باب الملل. ولهذا لم أوقّع كلماتي باسمي، كما أنّي لا أملك صندوقاً للرسائل لأتفقّده بنار الشوق صباح مساء، واقفاً بمفتاحي أمام حائط الصناديق، الموزّعة في مدخل البريد كتنكات فارغة في أبراج الحمام. آه، لو كنتُ قد كتبتُ العنوان، فلربما أخطأ الساعي، وردّ رسالتي إليّ، لأقرأها بعد أسابيع، وأحرقها فور استلامها، شاكراً ربي لأنها لم تصلْ أبداً. ظللتُ مسكوناً باللطخات السوداء لقلم التخطيط فوق كلمات رسالتي، متفشية من الوجه الخلفي للمغلف الذي صمّغته بلساني، وأغلقته قبل أن أكتب العنوان، رغم تأكّدي من صحّته مراراً وقلبي يخفق، متوجساً من أنّ تدقيقي المغالى فيه سيوقعني في الخطأ لا محالة، وهذا ما كان. فليكن، قلتُ لنفسي. فليكن خطئي كالخطوة الأولى تشقّ بالشؤم نصاعةَ ثلجٍ ما داسه أحد، مثل ميت وُوري قبره، وعلى كفنه لطخةٌ بنفسجية من أختام شهادة الدفن.

لا أقول هذا لأن كلماتي مصيرها النفايات أو النسيان، فهذا محتَّم، لكني كنت أخاف الورق الأبيض. كانت يدي تبرد حين تطول الملامسات بيننا. الورق الأبيض بشعٌ ومُعْمٍ كالنيون. ضجيجه، عند النفض والطيّ، كطقطقة التنك. كنتُ إذا جرحتْ حافتُه إصبعي مصصتُ دمي خلسة، لأنك تنهرينني عن هذا التصرّف المشؤوم:
-توقّفْ! لا تكُنْ عدوَّ نفسك!
القتل هيّن دائماً. يستطيع المجرمون بحافة ورقة مشدودة أنْ يمزّقوا أوداج النائمين، في حركة خاطفة كنصل الخنجر.
أضحك الآن وأنا وحدي، متذكّراً استلقائي في حضنك، على سريرنا الصيفي الأخضر. كنتُ خائفاً قليلاً، أتوهّم العقارب غاضبة، تتزحلق على علب الدهان الفارغة التي وضعنا القوائم فيها لنمنع صعودها إلى فراشنا. كنتِ تفكّين الـ«شوحي»، حزامَ خصرك، الملوّن كشجر الشوح المزيّن بالنذور قرب المزارات، ثم تمدّينه بين سرّتك وسرّتي كشريط هاتف ممدود بين علبتي كبريت فارغتين، لينتقل صوتُ روحي إلى كبدك، فتدوّي قرقرات جوعي في التواءات أمعائك، قبل أنْ تدغدغي بطني بنعومة الكرات القماشية المنفوشة التي ينتهي بها طرفُ حزامك. كنتُ المستقبل العائم في ليل رحمك تسعة شهور. أعلم أنّ بطنك يوجعك إذا تألمتُ وأنا بعيد.
كنتُ أستلقي في حضنك، تحت شبكة الناموسية، ترقّعينها من الداخل بالخيط الأبيض ذاته الذي تخيطين به اللحف، وكنتُ أنا من يبلّه، ويمرّره لك في عين الإبرة، وأحياناً كنتُ أخيط بما تبقّى منه اسمَ صدّام حسين في الجلد السميك لباطن قدمي لأدوسَه جيداً، أو أخيّط للعجوز عبوكِه صندلها البلاستيك المشقوق من الخلف. كان اللحاف، العاري من غطائه، مقطَّعاً إلى مضلَّعات مثل قطعة بسكويت ضخمة، أو مثل قطعة من رغيف خبز عملاق طبع عمّال الأفران في عجينه بصماتِ أصابعهم، وهم يرقصون مستمعين إلى أغنيات لايِه رمّو وصلاح رسول، ويشربون الشاي الحارق ليبرّدهم أمام وهج النار. ألهذا يُقال إن المسرنم إذا جاع أكلَ لحافه، ومَنْ يحنّ يمشِ في نومه؟

كنتِ تنكشين بالإبرة أذنك، فأسمع الفولاذ يحتكّ بالجلد والعظم: «خْشت، خْشت…» وأخشى أن يتمزّق غشاء طبلك فيما أنت ساهية، تمرّرين طرف ذؤابتك بين شفتيك، تنزمّ عينك ويرفّ جفنها قليلاً، كأنك تتذكّرين شيئاً لن تفشيه أبداً، لأنك تنسينه على الفور، مفلتاً منك دائماً حين تُسْألين:
-بمَ شردتِ؟
لولا ذؤابتك لما سمعتُ الريحَ، الآن، بين هذه الأوراق الخضراء، الغامقة. لولا ذؤابتك لما علّمني رِفاقي، هنا، كيف يستطيع العميان تمييز أنواع الأشجار من أصوات حفيفها. لست بحاجة إلى إغماض عيني لأتعلم فروق الحفيف في هذه الجبال. أعلمُ أنّ الموسيقى تُرى بعينين مفتوحتين. مثلاً، البندق هي الشجرة الأصل في بستان الحقيقة لأنها شجرة الكذب- خشخشةُ أوراقها هي نهنهة الباكيات التي بحّت أصواتهنّ، حزناً على فراق أحبّتهنّ. خطواتُ هذه الشجرة وئيدة، بندقة تلو أخرى، عبر آلاف السنين، انتقلت من جنوب الأناضول إلى أقصى شمال الأرض. كانت ثمارها تتفتّق بغتة، فتتطاير حبّاتها في انفجارات صغيرة مسموعة، مثل الشجيرة التي كنتِ تسمّينها «كردستان» في أرض الدار، ذات الزهور الشبيهة بالشوارب. كانت قرون ثمارها تتفجّر وتجفلك. البندق ثمرة البطران الذي يرى بظراً في الثمرة الصغيرة، المحفوفة بالأوراق، الواهم أنّه يعيش في الجنّة، غافلاً عن طرده الوشيك. إذا ركلتُ حبّاته كالكرات، هنا، فلا أحد ينهرني لأنني أركل النعمة، أركل بهجة رأس السنة، أمام بساط الاحتفال الصغير، الممدود أمامنا وحدنا أنا وأنت، حين كنتُ أسبقك إلى القول إزاء الحبّات الفارغة:
-العقل الخفيف عبء ثقيل.
فأرى في حبة الجوز بين يديّ أجملَ أحجية، نصفَي دماغ كفقيهين في جدالٍ لا نستطيع سماعه، جالسين داخل قصر. كنتُ أقاوم سطوة النوم. شفتاي قد ملّحتهما بذور البطيخ التي كنت تجفّفينها وتقلينها بالرمل، وأنا، ناعساً، أتابع لك سحبَ اليانصيب في سهرة التلفزيون. كان ضجراً حنوناً، أكوّم فيه على ركبتي لبابَ البذور، واحدةً بعد أخرى، لألتهمها دفعةً واحدة، فتقولين:
-كفاك تكويماً مثل الخلد الأعمى! تابعِ السحب!
كنت تأملين خيراً إذا تعثّر دولاب وتوقّف، فلا يظهر أيّ رقم في بياض عينه. كنا نصلّي ليد الطفل الذي يعود من الكواليس لتدويره. كان لفظ «السحْب» يُحشرِج صوتي، أكثر من جبنة كيري، أو دودة القزّ. قبل «محطات رياضية»، برنامج عدنان بوظو، الأسمر، خلافاً لكنيته الكردية، كنا نجلس وحدنا، في ساعات المساء الثقيلة أيام الثلاثاء، أمام تلفزيون سيرونيكس بالأبيض والأسود، بطيء الإقلاع، مثلوم المفاتيح، وأنا أطابق أرقام بطاقتك، أو بالأحرى أنصاف بطاقاتك، مع دواليب الحظّ. بفضلها تعلّمتِ الأعداد. لا أزال أعاني عند تدقيق أيّ رقم أو نقله، لا أجد بدّاً من مراجعته مراراً للتأكّد من الصواب. كنتِ تجلسينني على ركبتيك، فأقرئك راحتيَّ، وتقولين:
-هذه الخطوط ليست سككاً شقّها القدر. راحتاك مرآتان. هذان الرقمان فيهما 18 و81، مجموعهما أسماء الله الحسنى، وطرحهما عمر الرسول.
ثم أزيح صحن الموالح، وأنهض لأنزع الشاشة الواقية الزرقاء، فتنجذب أشعار ساعدي إلى شاشة التلفزيون كالمغناطيس، وتفرقع كأنني اعتصرتُ قشرة برتقال فوق شمعة. لكنّ الشاشة المطفأة لا تبرحها أطياف المذيعة، والأطفال الصامتين الذين يديرون «عجلات القدر»، فنراهم يتحرّكون كأن العرض لا يزال مستمرّاً، رغم أنك قد قرّرتِ إنهاءه، وأنت تلعنين حظّك لأنك مرة أخرى لم تربحي شيئاً، سامعةً رئيس لجنة المراقبين المتوارين، يعلن على الهواء أنّ البطاقة الفائزة مُباعة في جبلة، أو القرداحة:
-اجلبْ جريدة «تشرين» مساء غد، وتأكّد مرة أخرى. ربما سهوتَ عن بعض الأرقام وأنت نعسان. كانت الحكّة هذا الصباح في يدي اليسرى. لم نقبضْ شيئاً. خاب ظني. «يا دواليب الحظّ دُوري»! خسارتي سببها صوتُ صالة نصري!
كنتِ تقولين «آخ، آخ صالة!» وأنتِ تنهضين لتضعي طرف فستانك في فمك، صانعة كالكنغر جيباً مليئاً بقشور الثمار والبذور، القشور التي تفوح حين تيبّسها الشمس، ثم أسمع خشخشة القواقع الخفيفة للمكسّرات، في صقيع الباحة المعتمة، تتساقط من حضنك في فم التنّور. غداً، مرة أخرى، سيكون لخبزنا طعم الرماد.
لم أكن ممّن يسمون الباذنجان بندورة سوداء، ولا بيض الجان أو بيضة الحمار، لكنّي لا أزال أستصعب التمييز الفوري بين الخوخ والدرّاق، وبين الكمثرى والأجاص، وبين البلوط والكستناء. يربكني التمييز بينها، كقواعد العدد والمعدود في التذكير والتأنيث. لا بد لي أن أتخيّل الثمرتين، وأقارن شكليهما أولاً، ربما لأنني تعلمت أسماءها بالمقلوب، وتأخرتُ كثيراً عن تصويبها. حين ألملم البندق، أو أقطفه (ربما حين أقطف أي ثمرة، عن أي غصن، في أي مكان)، أتوقّع حارساً ما يظهر على هذه السفوح التي لا أسيجة فيها، كأنني قد تسللتُ إلى حديقة في منزل مهجور لأسرق الفاكهة، فيصيح: «لصّ! لصّ!»، فأكاد أقول «قربانكِ أنا يا قدمي، اركضي!» وأبدأ الجري. لسرقة البساتين أصولها، فالشريط الممزّق المربوط إلى ثمرة البذار علامة، معناها أنّ تلك الحبة الضخمة لا يجوز المساس بها. الانتهاك لعنة محققة، فمَن يعضّ ثمرةً مسروقة تتبخّر ذكرياته كلّها في تلك اللحظة. أحدّق الآن بيدي اليسرى. كنتِ تمسكينها وتفردين أصابعها، واحدة بعد الأخرى:
تقول البنصر: «أخواتي- فلنذهب إلى السرقة!»
تجيب الخنصر: «هيّا!»
تؤازرها الوسطى: «هيّا، هيّا!»
تعلو السبّابة: «وأنا الشاهدة!»
تتحسّر الإبهام: «وأنا العجوز قصيرة لا أطال ما تطالون!»

قلّما مصصتُ إبهامي، وإذا شردتُ وفعلتُ، انتزعتهِ من فمي:
-يا صوفي بيت الشيخ! جدُّنا إبراهيم بطل القرآن. كان رضيعاً لمّا تركته أمه، وحيداً في مغارة أخفاها الله بصخرة. ما أدركتْ أنّ مهد ابنها ثلمٌ في ناب ثعبان. وحين عادت وجدته قد شبّ، ولكنه لا يزال يمصّ أصابعه. أطعمه الله، فأنبع له الماء والسمن من راحتيه، جعل له في إبهام يمناه عسلاً، وفي إبهام يسراه لبناً، أو ربما العكس؟ نسيت. انظرْ.
ورفعتِ إبهامي أمامي. بحلقتُ حتى احولّت عيناي، وارتجفتْ يدي كأني سأبصم بالدم على حائطِ مزار أبيض. كنت، إذا بصمتُ، أخشى ظهور اسم مَن أحبّ في تعاريج بصمتي، خائفاً من افتضاح حبي قبل عثوري عليه، بل حتى قبل أن أعرفه، لأن الله أخفى في شعابِ البصمات اسمَ المحبوب الحقيقي لكلّ إنسان، ولا أحد يعلم متى يتجلّى.
أريتني في ظفر إبهامي شمساً بيضاء صغيرة، تشرق من عظامي ولا يكتمل شروقها، لم تلبث أنْ تحولتْ إلى تلة بعيدة غطاها الثلج. أنا ابن التلال، منها انحدرتُ، وإليها سأرفَع. في عينيّ، كلُّ تلة معشوشبة شامةٌ نافرة مُشعرة، كلٌّ منهما تذكّرني بالأخرى. الجبال هي الجمال الخطر الذي لا يُنال. إنها تذهلني وتحبطني. لم آلفها. لن آلفها مهما جُبتها وتسلّقتها. روحي تمشّط أشجارها، بقاعها القرعاء كالثعلبة في رأسي التي كنتِ تفركينها بحبة ثوم، كرأس من غفا وعلكة الغزلان في فمه، فالتصقت بشعره، حتى أتت الريح القارسة وقصّتها بشفرتها. خلف إصبعي الآن، يتهادى ما تبقّى من غمام الصبح، في الفرجة بين جبلين مشجّرين بالكستناء والشوح، مدغدغاً بفرائه أشفارَ الأرض. وادٍ أزرقُ الهواء، نديٌّ كلّ ما فيه، مقوَّسٌ كفلك نوح في هبوطه من قمة جودي، كأنّ حمامة زرقاء فرّت من أغنية عرس، شقّت بصدرها هذا الفراغ الحنون حين حطّت على التراب.

أكاد أسمع حمامة تهدل. كأنّ هناك انسداداً طفيفاً في أذني. أظنّ أنني عشت حياتي كلها مسدود الأذنين. ربما كلّ ما سمعته لم أسمعه جيداً، وحلّ مكانه صوتٌ آخر داخل رأسي. كنتُ وحدي، مستلقياً على جانبي وسط غرفة الجلوس، بعدما رطّبتُ الأرضية الترابية بماء قليل من إبريق الوضوء. كانت أصابع يدي اليسرى تتراقص، عازفةً على منقار الإبريق، لترشّ الماء كالمرذّات على التراب. كنتُ قد ابتعدتُ عن السخونة المنبعثة من بساط اللبّاد الطويل. تركتُ مروحة توشيبا الصغيرة تدور تحت خريطة العالم، الملصقة بجانب الباب، تبريداً لهواء الغرفة، وضعتُ أمام شفراتِ المروحة خمارك الكتّان القديم بعد تبليله. تكهربتُ بهذا البلل، أكثر من مرة، لكنّ الموت أفلت قبضته عني (رقصة التكهرب هذه هي ما أراه حين أقرأ «الرعشة»). مسنداً رأسي إلى يدي، كنتُ أحدّق بالأنابيب التي تخفي أسلاك التمديدات الكهربائية، وأنا أفكّر بحيلة ناجعة لإخفائها في تراب الجدار. وددتُ التخلّص من استفزازها الدائم لعينيّ، فتتحوّل أمامي إلى ناياتٍ طويلة من البلاستيك، شنيعة الأصوات، فيما أذني اليمنى كقمع تعبئة المازوت مفتوحةٌ أسفل خنافس الكالوسما. كنّا ندعوها «حشرات الخيار». كانت تتزاحم على النيون، المثبّت إلى عارضة السقف، فأخشى أنْ تحطّمه حين تضربه بدروعها. كانت في تلك الآونة قد غزتِ البيوت، فتتجمّع تحت مصابيح الشوارع، مثل بساط أسود برّاق سرعان ما يعاود التئامه حين تمزّقه دراجة عابرة، راكبها يرفع قدميه عالياً كأنه يخوض بركة موحلة. لحظتئذ، تهبّ الخنافس وتفوح من غمامتها رائحة حادّة كريهة، أنتن من هبوب رائحة المجاري. لحسن حظّنا لم تكن تزعق، ولا تهاجم الأطفال الملثّمين حين يدوسونها. استفقتُ من شرودي حين سقطتْ واحدة منها في أذني. خشيتُ الصمم على الفور. خشيتُ وصولها إلى مخّي، كالبعوضة في قصة لقمان الحكيم، وانحباسها هناك، بكلّ طنينها، في تلافيفي، أو خروجها من أنفي. حين هُرعتُ إليكِ، وأنتِ تقطّعين الجبنة البيضاء والبندورة لعشائنا، قلتِ:
-شيرو، يا أسد الوهاد الخالية، كفّ عن هزّ رأسك. ستصاب بارتجاج دماغ!
ثم أمرتِني:
-بتهوڤن، استعدّ! سأشدّ أذنك الموسيقية. واحد، اثنان، ثلاثة- سنفونيّة!
وشددتِها كما لم تشدّيها قطّ في حياتي. كان صيوانها طرياً، فأطويه كلّه كالبرعم في نفق أذني، وأسكتُ به الأطفال المتذمّرين الأصغر مني. لا أزال قادراً على تحريكه مليمترين أو ثلاثة. لم تضحكني، في تلك الحادثة، الميم التي تقلبينها نوناً في «سمفونية». كان ضحكي يضحكك، فآتيك عادة بمثال آخر عن عائلة «مين». جميع أفرادها نِحاف قِصار، رؤوسهم نحاسية كعيدان الكبريت، يؤنّثون الرجال حين يقلبون الميم نوناً في أواخر الكلمات، ثم أقلّد لكِ مِن بينهم «المكّوك» الذي يرفع سبابته عادة، جازماً بأنّ أم كلثوم ما كانت لتسلطن هكذا لولا شمّ الكيف في عقدة منديلها، لأن مواجهة الجمهور صعبة، ثم يمرّ بسبابته على شاربه المحفوف كالخيط. كان يقول:
-الكمان لله وحده. وجباتنا سريعة وصامتة كواجب عزاء الغرباء. الغناء ضرورة. اَسمِعونا شيئاً! فيروس أطيب على الفطور، عڤد الوهاب على الغداء، أنْ كلسون على العشاء، عڤد الدائن للتراويح وقِيان الليل.
وحين يلقي التحية: «السلان عليكن»، ترتفع قدمه لا إرادياً مع يده، مثل غمزة عين فاشلة ترتفع معها زاوية الفم.
سكبتِ زيت زيتون في أذني اليمنى التي لا أعلم مَن كبّر فيها حين ولدتُ، ثم حللتِ خمارَك، ومددتِ داخل أذني شعرةً من إحدى ذؤابتيك الرقيقتين، بالخفّة التي كنتِ تنزلين بها الدلو إلى البئر. اعتصمت الخنفساء السوداء بحبلك الأسود، وما لبثتْ أن انزلقتْ، وسقطت في الحفرة من جديد. تخيّلتُ أنني قد سمعتها تهوي إلى قعر أذني، وترتطم بغشاء الطبل. لكم حاولتُ أن أستعيد إيقاع أقدامها على ذاك الغشاء الرقيق، وهي تغرق وتحتضر داخل رأسي. حلمتُ بأنّ احتضارها سيلهمني لحناً يدفع سامعيه إلى سدّ آذانهم والصياح كالمجانين. انتهى حلمي عند رداءة الريشة التي كنت أعزف بها على الجُورة، حين لا أستخدم أصابعي وحدها. أسلوب «الخرفاني» للمعلّمين. مرّنت أصابعي أيضاً على آلات أتخيلها، ولا أوتارَ لها. كانت ريشتي أشبه بظفرٍ مقصوص من أطواق بلاستيك، يستخرجها الأولاد من ياقات القمصان الجديدة، ثم يحكّون بها أسلاكاً يثبّتونها إلى علبة دهان فارغة، أو علبة حلاوة فارغة، تحمل من الداخل شعار شركة «سادكوب» للمحروقات. كانوا يستهلّون المران بأسهل الأغاني عزفاًBûkê delalê : «عروستنا الغالية، قُومي تجهّزي…»، أو «طنبور قلبي تقطّعت أوتاره». يعزفون حتى تدمى أصابعهم، وتتبقّع أحضانهم بالعرق، متنّهدين يكرعون الماء من إبريق فولاذي في قلبه قالبُ ثلج. أحياناً، كنتُ أرى أولئك الأولاد وحدهم، أيديهم تتحرّك في الهواء، ورؤوسهم تهتزّ كأنهم يتمرّنون على آلاتٍ لا أراها، ثم يطرّون حناجرهم بسكّر النبات، ويصدحون. كانت دوزنة تلك المعادن الصدئة مستحيلة. الصوت فظيع، كصرير مسمار على الزجاج.
أبقيتُ رأسي مائلاً نحو كتفي الأيمن، حتى فاض زيت الزيتون كالنبع. كان أول إناء طالته يدك في المطبخ طاسة ستانلس، كنتِ تناولينني فيها الميِّر، أو الخيارَ باللبن. كنتُ أنفر من الثوم المدقوق فلا تضيفينه، ولا أبالي إذا تفل الشيطان على أيّ شيء أبيض يرغب فيه ولا يناله. كل شيء مفتوح عرضةٌ لبصقة منه، إلا القرآن. أخفضتِ ذقني. أحنيتِ رأسي، وأملتِه. رأيتُ يديك، اللامعتين كأنهما مطليّتان بالفازلين، أو مغلَّفتان بالنايلون، تتشوّهان في لمعان الطاسة. رأيتُ، بطرف عيني، كيف تنقّط الدمُ القاني، وزيت الزيتون، والصملاخ، وذرات تبن، حتى طفتْ أخيراً الخنفساء الغريقة. اختلجتْ، في بضع حركات أخيرة، وهمدتْ إلى الأبد. نعم، إلى الأبد. نعم إلى الأبد. نعم إلى الأبد. نعم إلى الأبد.
نفختِ في أذني الجريحة، ثم أدرتِ مسجلة سانيو، رصاصية صغيرة في النافذة الجنوبية الواسعة، الأعمق من أعمق خزانة. أسمعتِني موّال «ضاقت بي الدنيا كإطار منخل». سمعته، وإحساسٌ بالغمّ يقبض صدري، كأنّ المواويل كلها مجلبة للنحس، فيما الناموسية البيضاء تتماوج في الخارج، شبكتها تغربل التراب فوق فرُشنا، وتلتقط صفرة البابونج وخضرة النعناع (حين تطيّرهما الريح عن البسط، بزواياها المثبتة بالأحجار، والمنشورة على الأسطحة).
طفل نائم تحت الناموسية، هذه هي جنّتك. بعدما نوّمني بكائي، وأنا مرصّع بلسعات البعوض، ربطتِ يديّ كالسجين إلى عمود السرير. كنتُ أحكّ جلدي حتى ينزف. فكّرتِ بمذاق دمك في فم بعوضة، وأنت تمسحين بُثُوري بالثلج:
-غربلَتْك وعافَتني. بشرتك كورق السجائر. دمك ألذّ. دمي مُرّ. مرارة السنين تفوح من المسامّ.

كنتُ، أحياناً، أستيقظ بفمٍ موحل. وسادة الريش ملطّخة بلعابي، لأنني نمتُ بشفتين منفرجتين، وقد دسستِ لي بينهما ساقَ زهرة صغيرة. كنا أسماكاً في شبكة النوم. كان النوم والموت بائعين جوّالين، نشتري منهما التراب بالدين، بضع حبات من التراب تكفي الأطفال ليحكّوا عيونهم بظهور أيديهم، ورفوشٌ منه يُهيلها المشيّعون ليشبع ابن آدم أخيراً، حين يطعمون الأرض لقمةَ جسده الصغيرة.
أكلنا دائماً من جسد التي ستأكلنا. حككتِ شبكة النوم، بأظافرك التي قصصتُها لك بمقصّ الأزهار، وقلتِ:
-أظفاري مطمورة في اللحم. بطيئة النموّ كأظافر الموتى.
كنتِ تقضمينها أحياناً. لا حسد في قضمك إياها، ولا غلّ. بالبقية الشئزة من ظفر سبابتك حككتِ الناموسية فوقي. سمعتُ فرقعاتٍ ناعمة كرشّ شمعة برذاذ زيت أحبُّ عبقه، كنتُ أعتصره من قشرة برتقال عند انقطاع الكهرباء. مستلقياً، لمحتُ ظفرك يحتكّ بالتُّوْل، خالقاً شراراتٍ خضراء مزرقّة، على خلفية كحلية من مخمل السماء، وفمك يخدّرني بهدوئه:
-لا تتحرّك. السماء كالمرآة. سأصنع لك بروقاً أخرى. انتظرْ. ستلمس قطرةُ المطر الأولى رأس أنفك.
بلّلتِ سبابتك بطرف لسانك، ولمستِ أرنبة أنفي، فأغمضتُ عيني.
(…)