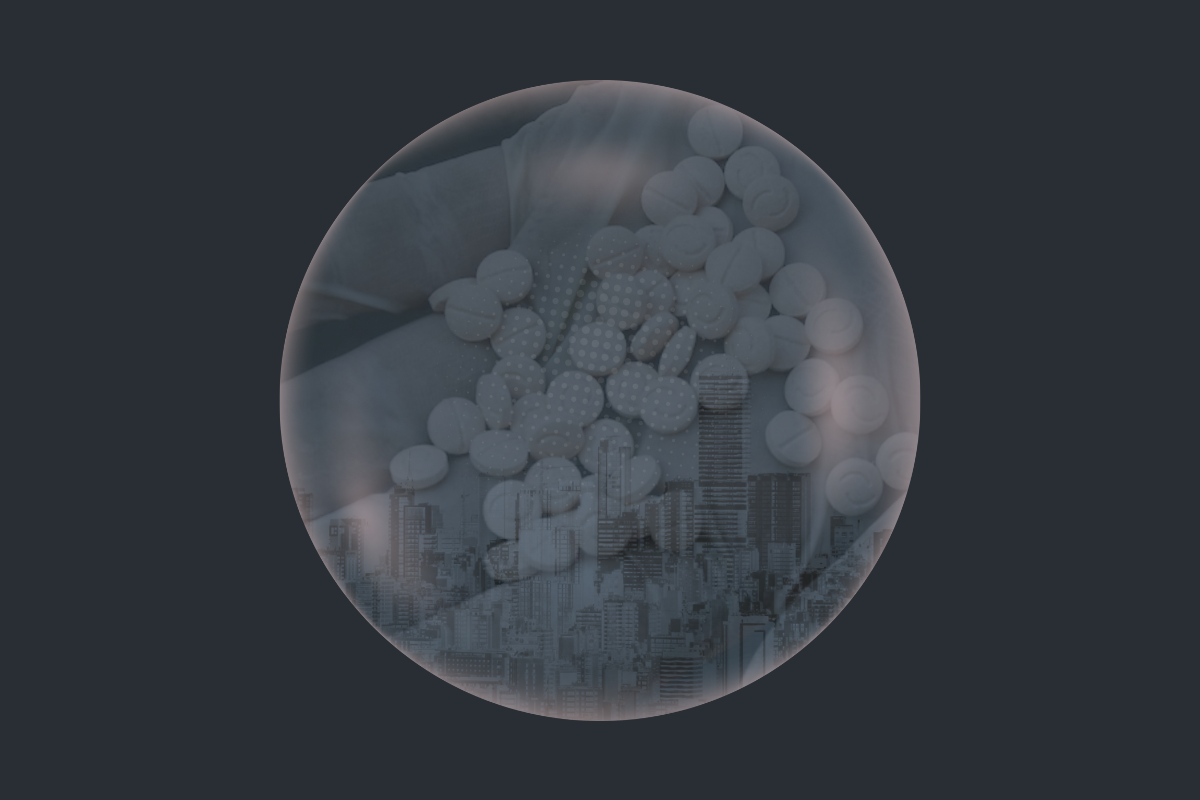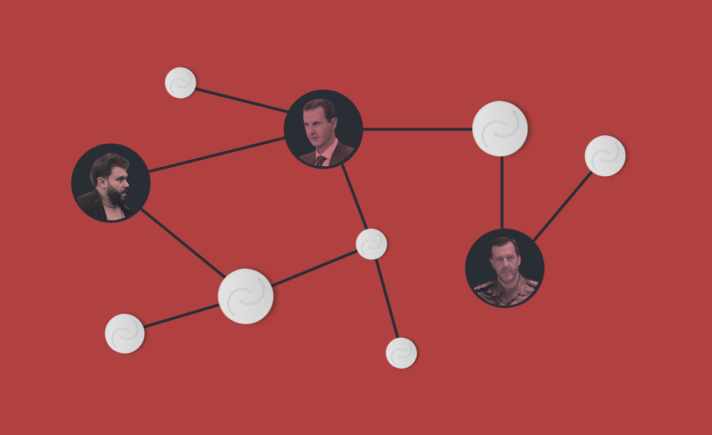بين مرفأ بيروت ومرفأ اللاذقية نشأ اقتصادٌ موازٍ يُنتِجُ للدولتين، أو على الأقل للنظام السوري وحزب الله اللبناني، أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً. اقتصادٌ كاملٌ قائمٌ على الممنوعات من المواد الأولية الطبية والمخدرات والسلاح والنفط، استيراداً وتصديراً وتهريباً، وهو الذي أجّلَ إلى حين وصول الاقتصاد في البلدين، أو للدقة اقتصاد أركان منظومة النظام السوري وحزب الله، إلى قعر الإفلاس الكامل.
نجحَ النظام السوري إلى غاية اللحظة في دمج صناعة وترويج وتهريب المخدرات، وخاصة الكبتاغون، في اقتصاده. هذا الاقتصاد الذي قام لعقود طويلة على مزيج من المساعدات العربية والإنتاج المحلي ذي النوعية المنخفضة، وعلى ريع أصول وثروات باطنية، إضافةً طبعاً إلى نهبٍ منظَّم لثروات محلية ولبنانية.
في الخلفية التاريخية
لطالما حَلَّ النظام السوري مشكلاته المالية على حساب فئات وطبقات ومجتمعات سورية أو لبنانية، وذلك من خلال أبوابٍ لعلّ أبرزها الهيمنة والتواجد في لبنان قبل العام 2005، وخلَقَ نظاماً متكاملاً من الرشى مستفيداً من الفساد ليوسِّعَ دائرة المؤيدين والمناصرين له، سواءً عبر تسهيلات غير مُستحقَّة لصناعيين، أو بالتغاضي عن عمليات تهريب كثيفة تقوم بها جهات نافذة أو حتى هامشية في السلّم التراتبي للنظام.
اليوم، ومنذ حوالي عقد من الزمن، استنفذت عدة عوامل إمكانية الاستمرار في هذا النظام الاقتصادي الهجين القائم على ثلاثة ركائز: مصادر شرعية، وأخرى رمادية، والاقتصاد الأسود أو المخالف كلياً للقوانين.
ومنذ عقد، ومع بدء دخول الحرس الثوري وتالياً حزب الله إلى ساحة الصراع السوري، كان لا بدَّ من إيجاد مصادر تمويل إضافية، خاصة أن الطرفين المذكورين يُعانيان من عقوبات دولية، وحربٍ على مصادر تمويلهما لم تنفع معها كثيراً مرحلة الغزل التي عاشها النظام الإيراني مع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما.
المخدرات، بعد تهريب السلع والبضائع، كانت الحلَّ الأفضل للقوى الثلاث المذكورة: الحرس الثوري الإيراني، حزب الله، والنظام السوري نفسه.
أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن اقتصاد الحرب وتجارة السلاح والمخدرات، أن الأمر يجري في نطاق شديدِ السرية وضيّقِ الفائدة، حيث يُثري فئة صغيرة من خلال تصنيع المخدرات وتهريبها. لكن ما نشهده في الواقع السوري اليوم هو العكس تماماً، إذ نجح النظام السوري وحزب الله اللبناني في تحويل صناعة المخدرات إلى جزء أساسي من آلية اقتصادية ضخمة، بحيث تم دمجها كلياً بالاقتصاد السوري وجزئياً بالاقتصاد اللبناني، وأصبحت دراسة موضوع المخدرات والأموال الناتجة عنها تتجاوز بكثير قدرات أجهزة الأمن الغربية، التي لا تزال تحاول الحصول على معلومات ميدانية وتقنية عن عمليات الإنتاج والتهريب.
أصبح الأمر بحاجة إلى أبحاث أكاديمية أكثر جدية من بضعة دراسات ممولة بعشرات الآلاف من الدولارات، ولكن بانتظار أن يتم البحث بالعمق الأكاديمي اللازم، يمكن كتابة مُلخَّص حول تَحوُّل صناعة وتجارة المخدرات في سوريا إلى جزء من الاقتصاد، وذلك بالاستناد إى ما توفِّره الأبحاث والتحقيقات المتاحة من معلومات بالإضافة إلى معلومات أخرى من مصادر خاصة.
فرضت الحرب في سوريا حاجة جديدة من التمويل متعدد الأشكال، وبدأ حزب الله باستخدام مرفأ بيروت لغير الأسباب الأساسية. ليس فقط لاستيراد المواد والتهرُّب من الضرائب وجني فرق الأرباح من السوق اللبنانية وتهريب بعض أنواع السلع إلى سوريا، بل أيضاً لاستيراد المكونات الأساسية لصناعة متفجرات البراميل، التي اشتدَّت الحاجة إليها مع تطوُّر الصراع في سوريا واستهلاك قوات النظام السوري لمخزون المتفجرات التقليدية، فجاءت نترات الأمونيوم لتحلَّ مكان المتفجرات الحربية، وفي النهاية أدَّت إلى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020.
وزارات وشركات
بحلول العام 2008 كان حزب الله يحكم سيطرته على أغلب مرافق الدولة، بعد أن هزم باقي الطوائف اللبنانية وبدأ ينهش مكانها في جسم الحُكم وماكينة السلطة. يومها راحت شركاته الخاصة تتضخم، وراح تهريب السلع والبضائع إلى السوق اللبنانية المعروفة بانفتاحها على الاستهلاك يتخّذ شكلاً منظماً؛ مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعشرات من الشركات الكبيرة أو التي في طور التعملق، استباحت مرافئ الدولة الرئيسية: مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت البحري، إضافة إلى مرافئ أخرى كطرابلس حين تدعو الحاجة.
عملت هذه الشركات في أغلب القطاعات، وخاصة الطبية والمالية والإلكترونية والإنشائية والحديد والصلب والكيماويات، وحَمتها شخصيات نافذة في الحزب ومتمكنة اقتصادياً، شكلت معاً ما يشبه اقتصاداً موازياً بكافة قطاعاته، واستفادت من وصول حزب الله إلى مقاعد الحكومات في مرحلة ما بعد الانسحاب السوري عام 2005.
الرَساميل المُستثمَرة في هذه القطاعات لم تكن كلها من حزب الله، بل استفاد الحزب من شبكات الأثرياء الجدد، مِن الذين جمعوا أموالهم من أفريقيا أو الولايات المتحدة واستثمروا في شركات مالية مشبوهة في لبنان. ضخَّ هؤلاء مبالغ مالية كبيرة في أسواق الاستيراد التابعة لحزب الله مقابل فوائد شهرية تتجاوز ما يمكن أن يقدِّمه القطاع المصرفي، يُضاف إلى ذلك تَحوُّلُ جمعية القرض الحسن إلى مصرف كامل المواصفات وجاذب للاستثمارات المالية والاحتياطي من الذهب والعملة الصعبة.
مع بداية التحول إلى استيراد المواد الأولية لصناعة الكبتاغون، كانت البنية التحتية الرئيسية جاهزة بالفعل، حيث كانت شبكة شركات المنتفعين من السيطرة الإدارية لحزب الله قادرة أن تنفّذَ كل عملية استيراد وتصدير للكبتاغون، بالإضافة إلى الخبرات العالية التي كانت تتوفر لدى الكثير من العائلات التي عاشت طويلاً على صناعة وتجارة المخدرات في بعض أجزاء لبنان، وراكمت حِرَفيتها على مدى عقود طويلة.
عددٌ كبيرٌ نسبياً من شركات الصناعات الدوائية، أو شركات استيراد الأدوية وتوزيعها، أو شركات الصناعات الكيميائية التي يوفر لها حزب الله الحماية والتسهيلات، تقوم باستيراد المواد الخام لصناعة الكبتاغون، إضافة إلى الأجهزة الصناعية من مكنات كبس الأدوية أو الشوكولا، بحسب قدرة معامل الإنتاج على دفع التكلفة، وصولاً إلى مَعدَّات إمداد المصانع الطبية بالكهرباء وقطع التبديل وغيرها، وبالوقود الضروري لتشغيل تلك المعدات.
كما كلُّ أجزاء صناعة الكبتاغون، يعتمد هذا الجزء على عمليات تجارية بحتة، فمن يستورد القطع الصناعية يُعيد بيعها الى المصانع الصغيرة أو الكبيرة التي تصنع الحبوب المخدرة، وكذلك مستوردو المواد الأولية الذين يعيدون بيعها إلى المصنِّعين، حيث تنتشر في لبنان عشرات المصانع الصغيرة التي تُنتج حبوب الكبتاغون. يساهم حزب الله عبر ما يسمى «معامل حزب الله» في توفير الخبرة والخبراء والتجهيزات الضرورية لهذه المصانع، سواء على الجانب اللبناني أو السوري من الحدود، عدا عن عدد من المصانع الكبيرة التي يشرف عليها حزب الله وتُسهِّلُ أعمالها الوحدة 4400 التي تُنسِّقُ مباشرة مع فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
يحرص الحزب على الجودة العالية للحبوب التي تُصدَّر من لبنان إلى سوريا قبل شحنها إلى الخارج، كما يحرص على تمويه الشحنات الصادرة من مرفأ بيروت أو المطار أو مرفأ اللاذقية، مُقدِّماً الاستشارات الهندسية والأفكار اللازمة لعمليات التمويه.
تُشكِّلُ مجموعة الخدمات هذه أيضاً مصدرَ دخل إضافي، ولكن مصدر الدخل الرئيسي يبقى حصص الحزب في المواد المستوردة والشركات العاملة والمصانع الصغيرة في لبنان، ومن تلك التي يملكها مباشرة، إضافة إلى فائض الأرباح التي يحققها من عمليات بيع المواد الأولية والصناعية والخبرات للجانب السوري عبر وسطاء من تجار المخدرات المحليين أو مباشرة في حالات معينة.
آلاف الأطنان من المواد الاولية التي تدخل إلى لبنان سنوياً تخلق حركة فعلية في مرافئ الدولة: سفنٌ وعمليات تنزيل البضائع، رِشىً وتخليصٌ جمركي، شاحنات تدخل وتخرج من المرافئ، مراكزُ تخزين، مصانع صغيرة وعائلات مستفيدة، صراعات داخلية وتجاذب للأرباح، وعداء مهنة. ثم بعد ذلك عبورٌ إلى الأراضي السورية، والمزيد من الرِشى. وفي الأراضي السورية تتوزع الكعكة على أطراف أكثر، وتُرضي شرائح أوسع.
في سوريا
حين وصول مواد تصنيع الكبتاغون والمهندسين والخبراء الكيميائيين والمعدات التقنية من لبنان إلى سوريا، فإنه من الضروري التمييز بين مجموعتين: الأولى هي تلك الخاضعة لنفوذ حزب الله اللبناني (مع مشاركة حزب الله السوري)، مثل مصانع الكبتاغون في أغلب مناطق القلمون، التي تتمتع باستقلالية عن الفرقة الرابعة وإن كان ثمة آلية للتنسيق بين الفريقين؛ والمجموعة الثانية التي تبيع أو تؤجِّر خدماتها للجانب السوري من كبار المُصنِّعين والمتاجرين والمهربين الخاضعين مباشرة للفرقة الرابعة، مع مراعاة حصص الحرس الثوري الإيراني.
يعاد شراء المواد على الأراضي السوري من المصدر اللبناني، والمصانع الرئيسية العاملة تحت إشراف ضباط الفرقة الرابعة تتعامل مباشرة مع وحدات حزب الله المتخصصة، فتشتري وتبيع منها عبر مناطق الطفيل، والأخرى الأقل أهمية تتجه إلى التعامل مع وسطاء يختارهم حزب الله.
تدرُّ هذه العمليات، من بيع المواد والخدمات، مئات الملايين من الدولارات على حزب الله اللبناني، وتذهب تقديرات بعض الميدانيين إلى القول إنها تتجاوز سقف المليار دولار سنوياً، تتوزع بين كبار العاملين في القطاع وبين حصص أخرى لمصلحة مالية الحزب، وأرباح المستثمرين الذين على الأرجح وضعوا أموالهم في خدمة شركات مالية غير شرعية في لبنان دون أن يعلموا في ماذا تُستثمر هذه الأموال.
وعلى الجانب السوري تنتشر مئات المصانع ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، خاصة في مناطق اللاذقية والحدود العراقية والأردنية، ومؤخراً بدأت تتوارد معلومات عن تكثيف العمل في مصانع كبتاغون قريبة من الحدود مع تركيا.
عدا عن مناطق القلمون التي يحتكرها حزب الله، تنتشر المصانع قرب الحدود الدولية لتسهيل حركتها باتجاه أسواقها النهائية، سواءً باتجاه العراق وتالياً منه نحو دول الخليج أو السوق العراقية، أو نحو الأردن ومنه نحو الخليج، أو نحو مرفأ اللاذقية ثم إلى الدول الأوروبية، أو نحو تركيا مؤخراً لمزاحمة منتوجات جزء من المعارضة السورية والدولة الإسلامية (داعش).
يستورد كبار التجار والصناعيين المواد الأولية، ثم يُعيدون بيع بعضها إلى مصانع أخرى مملوكة لأشخاص أو جهات أخرى، دائماً تحت أعين ورقابة ماهر الأسد والفرقة الرابعة. ثم يُعيد هؤلاء بيعها إلى مهربين محترفين، أو يتولى بعض المستوردين تصنيع المواد الاولية مباشرةً، وأيضاً توضيبها للتهريب، مع الاستفادة من خدمات وخبرات حزب الله في التغليف والتمويه، ومن غطاء الفرقة الرابعة في الحماية والحصول على المعلومات بشأن شدة المراقبة على الحدود البرية.
ولا ننسى أن ثمّة لاعبين أصغر حجماً هنا، مثل جمعية البستان التي أصبحت تحت حماية أسماء الأسد، إذ تُشارك الجمعية أيضاً في عمليات تصنيع وتوزيع الكبتاغون، خاصة في السوق الداخلي السوري.
مخدرات مقابل السلاح
التجارة مع الجانب الروسي تتولّاها فرقٌ مختلفة، أحياناً تحصل مباشرة بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني والجانب الروسي، إذ تتمّ مُبادلة كبتاغون مُصنَّع وجاهز للاستخدام مقابل معلومات أو أسلحة وذخائر، أو يقوم ضباط من الفرقة الرابعة مكلّفون بالعلاقة مع الجانب الروسي بمبادلات مشابهة أيضاً مع الضباط الروس.
هذه العمليات تخضع دائماً للمنطق والحساب التجاري، فالأمر ليس مجرد عصابة صغيرة تتولى بيع وتصنيع المواد المخدرة. الانتشار الكبير لشبكات الاستيراد والتصنيع والتغليف والتهريب، والعدد الكبير من ضباط الفرقة الرابعة وجنودها المشاركين، وتوزيع أجزاء من الأرباح على المشاركين وعُمالهم، وعلى صناعيين تقليديين هم جزءٌ من عمليات التمويه والتوضيب والتهريب، وشركات شحن، إضافة إلى أصحاب أعمال تمتد شبكاتهم المالية إلى خارج البلاد بُغية تسهيل عمليات غسيل الأموال ونقلها إلى داخل سوريا. كل ذلك أدى إلى تشابك أموال المخدرات بالناتج المالي لعائلات سورية، تعلم أو لا تعلم بأنّها، شريكة في صناعة ممنوعة.
التجارة البينية داخل سوريا بمفردها تخلق حالة من تدفق الأموال، وبات الاستغناء عنها يعني تدمير الموارد المالية للفرقة الرابعة، وتهميش الأطراف مجدداً، وإلغاء عشرات الآلاف من فرص العمل الموجودة ولو جزئياً بفضل تجارة الممنوعات، وإن كان ذلك على النمط السوري التقليدي الذي تعيش فيه قلّة من الخاصة في البحبوحة، بينما ترزح أكثرية السكان العُظمى تحت معدلات الفقر العالمية. إلا أنّ اعتماد النظام على المخدرات في نموذجه الاقتصادي، وتصاعد هذا الاعتماد في الأعوام الخمسة الأخيرة، بات يشكل مصدراً لربح تُقدِّره تقارير دولية بالعشرة مليارات دولار سنوياً (من أصل حجم كلي للكبتاغون السوري يُقدَّر بـ57 مليار دولار بحسب تقرير للحكومة البريطانية)، وهي تتوزع بشكل غير متساو على أركان اقتصاد الكبتاغون، من عُمَّال النقل والتحميل إلى كبار ضباط الفرقة الرابعة وشخصيات متنفذة من عائلة الأسد.
استثمارات صغرى
الأخطر هو التشابك العميق لاقتصاد الدولة السورية بالكبتاغون، فمع الأزمة الاقتصادية التي تعصف حالياً بسوريا، والتي لا تتوقف عند حدود تضخم وارتفاع أسعار العملة الصعبة مقابل الليرة، بات من الأيسر والأكثر ربحيةً لكبار الصناعيين والتجار الاستثمار في قطاعات غير شرعية؛ من توظيف الأموال في التلاعب بسعر الصرف (وهو أمر قد يجلب عواقب وخيمة في حال أراد النظام ضبط سعر الصرف)، إلى الاستثمارات المَرضي عنها لا بل المطلوبة، كالاستثمار في الكبتاغون أو على الأقل تبييض الأموال الناتجة عن تصديره ما بين الدول الخليجية والغرب من جهة، والمُصدِّرين السوريين من الفرقة الرابعة إلى صغار المهربين.
تكاد الفوائد المالية المُغرية تطيح بالصناعات المحلية الضعيفة أصلاً وذات الجودة المتدنية، والتي بات من الصعب أن تُنافِس في الأسواق الخارجية لتُعيد ضخ العملات الصعبة في اقتصاد يخضع للعقوبات، فيما عمليات نقل العملات الصعبة بين لبنان وسوريا (بالاتجاهين وبحسب الحاجة) لا تكفي لتعويم اقتصادَين (لبنان وسوريا) يغرقان في أزمات وعقوبات شاملة أو جزئية. هكذا صار تدخل أصحاب الأموال السوريين الذين لديهم أعمال في الخارج مطلوباً، وهو يُدِّرُ الثروات ويُبقي الصناعات في حالة عمل طالما أنها تشكل غطاءً وواجهة لعمليات غسيل الأموال. هنا أيضاً يبني كلٌّ من النظام السوري وحزب الله اللبناني على خبرات طويلة في هذا المجال، وخاصة الجانب اللبناني الذي يُعاني من مراقبة دولية على تحويل الأموال القذرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
إلا أن الاستثمار في الكبتاغون لم يعد يقتصر على رؤوس الأموال الكبيرة، إذ بدأت تتردد معلومات من أكثر من منطقة سورية عن وجود مكاتب للاستثمار المالي تقدم فوائد عالية على الأموال مقابل تجميدها في المكتب لفترة مُحدَّدة. تُعَدُّ هذه الفوائد خيالية بالمقاييس المصرفية، وهي أكثر من كافية لجذب المبالغ الصغيرة والمتوسطة من الادخارات الشخصية للمواطنين السوريين، الذين يعانون من الأزمة المالية الأكبر في تاريخ بلدهم. وتذهب هذه الاستثمارات الصغيرة نسبياً إلى صغار الصناعيين والمهربين للكبتاغون، ما يؤمن لهم حصة أكبر في سوق الاتجار بالممنوعات.
لا داعيَ لشرح مدى خطورة تشبيك اقتصاد الكبتاغون بالمال العام والخاص بهذه الطريقة، وجعل الاستثمار في هذه التجارة أقصر الطرق لتحقيق أفضل الأرباح، وتكفي الإشارة إلى أن سقوط هذه الصناعة يعني انهياراً نقدياً وليس اقتصادياً فقط، وهو انهيار سيطال شرائح واسعة جداً من السكان، حتى ممن لم يقتربوا من أموال المخدرات وصناعتها.
إلا أنّ المشكلة الحقيقية في مكان آخر، فاستمرار هذه التجارة يعني بقاء اقتصاد فقاعة يَحمي مشكلة سياسية أكبر من سوريا ولبنان، وإذا تجاهلنا مشكلة إيران في المنطقة ومَسعاها المحموم للتحول الإمبراطوري والسيطرة على مستعمرات أصبحت معلومة، فإن العلاج التقني الغربي لمشكلة الكبتاغون سيكون دائماً عاجزاً عن الاستجابة للمشكلة السياسية التي وَلَّدَت هذه الصناعة أساساً وطَوَّرَتها، ولن تكفي مجموعة عقوبات دولية أو أميركية، ولا ما بات يُعرَف بقانون الكبتاغون الأول والثاني الذي بدأ العمل على إصداره مؤخراً، لوقف هذه المشكلة أو حتى الحد منها بشكل فعَّال.
مراكز الأبحاث في حزب الله تسبق العقوبات عادةً بخطوة أو أكثر، وهي تنجح حتى الآن في الالتفاف عليها. وستبقى المشكلة الرئيسية هي نظام سياسي واقتصادي أفلسَ في سوريا وقاتَل بكل الوسائل حتى لا يموت أو يُدفَن حياً، وهو في عجزه عن الاستمرار بين الدول الحديثة يُحاول البقاء على قيد النزاع مع الموت باستخدام وقود جهنمي، مرةً يكون اسمه اللاجئون السوريون، ومرةً مساعداتٌ للمنكوبين، وفي السنوات الأخيرة بات اسمه الكبتاغون، الذي لا ينفع معه حلٌّ جُمركي بارد ولا حلٌّ مخابراتي يقتصر على المُعطى الأمني دون السياسي.