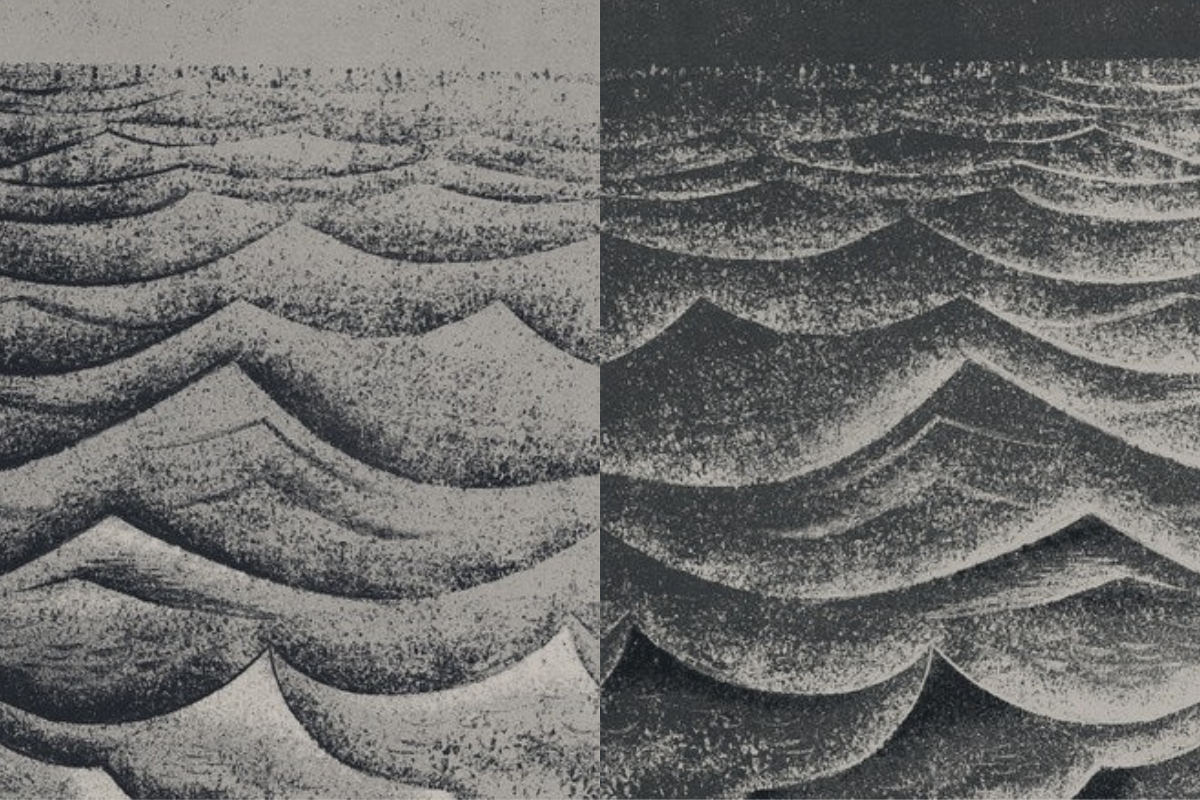تهبُّ الريحُ بقوة تارة، وبهدوء تارة أخرى، على التبّة العالية التي تطلُّ على شاطئ بحر مدينة الزهراء غرب قطّاع غزة. تُذكّره رياح أكتوبر(تشرين الأوّل) بأيام الطفولة، عندما كان يقفُ أمام البحر مُرتعدًا من أمواجه الهائجة وتيّاراته الشديدة في هذا الوقت من كل عام. لم يكن الخوف من البحر شيئًا مألوفًا بالنسبة إلى سكان مخيم الشاطئ للاجئين، الذي شُيِّد قُبالة الشاطئ غرب قطّاع غزة سنة 1948 بعد النكبة الفلسطينية، والذي يُعدّ ثالث أكبر مخيّمٍ للاجئين في القطاع وأكثرها اكتظاظًا بالسكان. يقول إن الطفل في مخيم الشاطئ يولد سبّاحًا، إذ ليس أمامه سوى الشاطئ، مساحة التنزه الوحيدة للكبار والصغار، فكل دهليز أو شارع من شوارع مخيّم الشاطئ يقودُ في النهاية إلى البحر.
ورق وثعابين
على بعد أكثر من 16 كيلومترًا من مكان نشأته وولادته سنة 1951، مرّن حامد أبو نحل (72 عامًا) عضلاته، وصافح البحر. يُعطي أبو نحل مفهومًا آخر للسباحة، وهو المصافحة. يقول حين يستعدّ للسباحة: «بدي أسلّم عالبحر» (أصافح البحر). منذ طفولته، كان يكره الخريف لأنّه يُنذر بانتهاء موسم الصيف، إذ لن يتسنّى له بعدها النوم في عراء الشاطئ ومراقبة المدى الفضي الفاصل بين السماء والبحر، والذّي يستحيل شيئًا فشيئًا إلى سواد حالك في ساعات الليل الأخيرة. يتنفّس الملح الخفيف الذي يحمله الهواء القادم من جهة البحر، ويمشي بين الأزقة الضيقة، متجاوزًا البيوت الإسمنتية، صوب الشاطئ. آنذاك، لم يكن العابر في شوارع مخيم الشاطئ بحاجة إلى دليل ليقوده إلى الشاطئ، إذ بين كل زقاق وآخر، كان يمكنه ببساطة، أن يلمح زرقة البحر، كطاقة وحيدة مفتوحة لسكان المخيم، منها يعبر الهواء، وإليها يلجأ المثقلون بضيق اللجوء.
ليس من السهل أن يتحدث أبو «السِباع»، وهو اللقب الذي يعرفه به الناس ويشعر بارتياح عندما أناديه به، عن علاقته مع البحر، فالأمر يُشبه تمامًا الحديث عن أدق تفاصيل حياته الشخصية وعن حميميّته. لا يُحبّ أبو السباع لحظات البوح ولا يفتح قلبه بسهولة.
لم يكن قرار أبو السباع أن يُمدِّد جسده على رمال البحر كل يوم وأن يغطّ في نومه الهادئ على الشاطئ نابعًا من معيشة مُترفة، بل كان هروبًا من منزلهم الضيّق والمتهالك في المخيم، إذ كان يعيش مع عائلته ككل اللاجئين في المخيم، في بيت لا تتجاوز مساحته بضعة أمتار منحته لهم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بدلًا من الخيمة: «كنا أكثر من 10 أفراد في البيت. أنا كنت أهرب، وكانوا يعرفوا دائمًا لما يفتقدوا حامد، يروحوله عالشط».
بين عامي 1951 و1952، حوّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «أونروا» الخيام في مخيَّم الشاطئ، الذي يُشكّل اللاّجئون المهجّرون من مدن الساحل الفلسطيني وجنوب ووسط فلسطين نسيج سكّانه، إلى بيوت طينية، وأنشأت مراحيضًا عامة لقضاء الحاجة. قيل إن شتاءً عاصفًا مرّ على قطّاع غزة، واقتُلعت الخيام إثر الريح القوية والأمطار الغزيرة، ما دفع وكالة الغوث لإنشاء هذه البيوت. وُزّعت الغرف على اللاجئين-ات حسب عدد أفراد العائلة. بالكاد كانت الغرف مناسبة للنوم، لذلك كان اللاّجئون يقضون معظم يومهم في الشارع، هربًا من ضيق البيوت، كما يقول أبو السباع.

بعد نحو 75 عامًا على إنشاء المخيم، لم يتغيّر شيء في حال اللاّجئين-ات، ما زالوا يعيشون ظروفًا قاسية، لكن الشعور بالضّيق والاختناق تضاعفَ بسبب الأبنية المتهالكة والعشوائيّة، إذ لا يجدون أمام زيادة أعدادهم سوى استغلال كل حيّز ممكن بُغية التوسع، سواء بالصعود في بيوتهم إلى أعلى أو التمدد بضعة أمتار أفقيًا. أصبحت الطاقة الزرقاء بين الأزقة التي كانت تُرشد العابرين والأطفال إلى البحر جدرانًا إسمنتية، تحجب البحر عنهم. كانوا يعتقدون بأنّ هذه البيوت الرماديّة الموحشة ستحتضنهم لفترة مؤقّتة يعودون بعدها إلى أراضيهم التي هُجِّروا منها عنوة، لكنّها تحوّلت إلى قدر محتوم، لا يمتلكون خيار البقاء فيها أو مغادرتها.
قضى أبو السباع أشهر الصيف في لعب «الكوتشينة» مع البحر، كما يُسمي طريقته في الإنقاذ البحري: «برتّب الناس والغرقى عالشط زي ورق الكوتشينة…». يحاول أبو السباع أن يتفادى نظرات الغريق ويغطِس على مقربة منه، ثم يخرج من خلفه، يلوي ذراع الغريق بيد، ويدفعه بهدوء بقدمه إلى سطح الماء، ثم يُطمئنُه بحزم: «لا تخاف، رد عليّ، رح تخرج سليم». يجذِّف وصولًا إلى أقرب نقطة في الشاطئ، ويمدّد الغريق على الرمال في وضعية تُذكّره شخصيًا بلعبة الكوتشينة (الورق).
«ما في لعب، إن أخطأت، يا إنت بتموت يا الغريق»، يقول وهو ينظر إلى الشاطئ بريبة أقل، فقد أدّى واجبه الوطني، كما يُسمي تطوعه في الإنقاذ البحري، ولم يعد هناك ما يستدعي التأهب. يغمس رأسه في البحر ويرقص. يُحبّ أبو السباع أن يشبّه السباحة أيضًا برقصة الباليه، فكلاهما يحتاج فهمًا وإيمانًا عميقًا بالمسألة، ورشاقة فائقة، كما يقول.
ذاكرة الموج
يَخرُج من البحر ويقف مُحدقًا في الشاطئ. يُذكّره صوت الموج بكل مرحلة في حياته. في طفولته، كان يسمع صوت الموج من بيته في المخيّم، وكان يعتبره نداءً من البحر له: «فمن الذي سينادي على اللاجئ غير أرضه ومائه؟».
أَقفُ مُصغيًا إلى الموج إلى جوار أبو السباع، الذي تختلف ملامحه مع كل موجة. بدا لي أن الموجة التي تخبط في الرمل يرتدُّ صداها في ذاكرة أبو السباع الذي قضّى أكثر من خمسين عامًا وهو يعمل كمنقذ بحريّ. قد يسمع موجة ويشعر بحنين إلى طفولته في المخيّم، أو يقشعرّ بدنه لأنها تُذكّره بصرخة غريق، وقد يسمع موجة ويبتسم لأنها تُذكّره بإنقاذ أحد وهو أكثر شيء يحبه.
كانت طفولة اللاجئين-ات في المخيّم قاسية. تُعيد الأمّهات خياطة أكياس الدقيق التي كانت تُسلّمها منظّمة الأونروا للاجئين بعد أن تفرغ، ليرتديها أطفالهنَّ بدلًا من السراويل غير المتوفرة. كان اللاجئون يسمونها قديمًا «بدلة (بزة) اللاجئ» التي وهبتهم إياها إسرائيل: «كنا نرتدي هذه السراويل، ونرتدي معها الحقد تجاه الاحتلال، ثم أمشي حافيًا نحو البحر، وأقضي معظم يومي هناك».
انقضى فصل الاصطياف بعد بدء العام الدراسي في قطّاع غزة. يكاد يكون الشاطئ فارغًا لولا وجود أبو السباع وبعض المصطافين الكبار الأوفياء للبحر في كلّ المواسم والفصول. يُخبرني أبو السباع بأنّ الخوف هو عدوّ البحر وهو السبب الرئيسيّ في غرق الكثيرين، لذلك يُسقِطُ دائمًا وصيَّته في أذن من يصادفه: «تعامل مع البحر كصديق، ولن تغرق أبدًا».
يستذكر واحدة من أهم عمليات الإنقاذ التي نفذها في أحد أيام الصيف في السبعينيات، حين انقلب مركب سياحي قرب ميناء مدينة غزة يحمل على متنه 15 فردًا. كان شارد الذهن لحظتها، لولا الصيحات التي اخترقت شروده: «أبو السباع… أبو السباع، إلحقّ! الناس بتغرق!». خلع أبو السباع سترته، وهبط على غير هدى إلى البحر. يقول إن المنقذ الذي لا يخلع سترته حين يهبط إلى البحر ليس منقذًا حقيقيًّا، لأن الغرقى يبحثون عن أي شيء ليتمسكوا به، وفي هذه الحال، تصير السباحة بالسترة في مهمة الإنقاذ أشبه بالسباحة مع خطاف صنارة صيد، قد تلتقطه يد الغريق ويدخل المنقذ في مهمة إنقاذ نفسه بدلًا من إنقاذ الناس.
حدّق لثانية في سطح البحر ليفهم حركة الثعابين قبل أن يغطس. يُشبّه أبو السباع التيارات البحرية بالثعابين لأنها تتحرك مثلها، ولهذا يراقبها سريعًا ليفهم إلى أي جهة عليه أن يسبح بالغرقى. أحسّ بشيء من الخوف وهو ينظر إلى الأجساد التي تتحرّك بعنف في المياه. غطس على مقربة من الغرقى وعرف حين اقترب منهم أنّ هناك من بإمكانه الصمود قليلًا بينهم، فاتجه إلى الذين تختلط أنفاسهم بالماء.
قد تبدو مهمة إنقاذ غريق واحد يسيرة، لكن العمليّة تُصبح تعجيزيّة عندما يُوضع المنقذ تحت ضغط إنقاذ عدد كبير من الأشخاص كما يقول. كان يقترب بخفة من الغريق وبسرعة كأنه يلضم إبرة. يقبض على ذراع الغريق بهدوء، يجذف قليلًا نحو الآخر ويلتقط ذراعه، ثم يدفع، بقدميه فقط، ثلاثة أجساد مسافة تزيد عن عشرة أمتار، ويوقفهم على أقدامهم حين يصل إلى نطاق الشاطئ، ثم يعود بكامل سرعته لينقذ غيرهم. تكرّر ذلك لنحو تسع مرات، حتى أحسّ بعضلاته تتيبّس كالخشب، عندها مدّد جسده على الشاطئ، تنفس وهمس: «ما أشدَّ تعلُّق الناس بالحياة!». أعانه في هذه الحادثة أن المركب انقلب على مقربة من الشاطئ، ولم تكن المسافة التي يجب أن يقطعها من موقع المركب الغريق إلى الشاطئ سوى مسافة قليلة. ما يزال أبو السباع يتذكَّر الحادثة كإنجاز يفتخر به، وكحادثة وضعت حياته على المحك، إذ كان يمكن أن يغرق في أي لحظة من شدة التعب.
مكّنته خبرته في معرفة حركة التيارات، بعد نحو 33 عامًا من هذه الحادثة، من استخراج جثة طفل من عائلة أبو كميل بعد ثلاثة أيام من غرقه قبالة شاطئ مدينة الزهراء غرب قطاع غزة. كان لا يزال أبو السباع حديثَ السكن في منطقة الزهراء بعد أن انتقل من مخيّم الشاطئ، لكن سمعته كانت قد سبقته. كان الطفل الغريق يعود لعائلة تسكن منطقة المغراقة شرق قطّاع غزة. جاء الطفل ليسبح، لكنه لم يعد، هذا هو التضارب الذي يؤلم أبو السباع في مسألة الغرق: «جاء ليلعب، لكنه مات، لماذا؟». سمع أبو السباع طقطقة مجنونة على بابه، وحين فتح وجد عائلة الطفل الغريق. يقول إن عيون الأب والمرافقين كانت تستنجد، وأبو السباع لا يخيِّب من يستنجده. بعجلٍ مشى أبو السباع مع العائلة إلى المنطقة التي سبح فيها الطفل. وزّع نظراته على طول الشاطئ، ثم سأل: «وين كان يسبح الولد؟»، فأشار أحدهم إلى المنطقة. خلع أبو السباع سترته، وغطس في البحر. بعد دقائق عاد وهو يحمل جثة الطفل التي وجدها عالقة في غرفة مفتوحة لمضخة مياه.
أعاد البحر وعمليات الإنقاذ وحالات الوفاة التي كان شاهدًا عليها، صياغة علاقة أبو السباع مع الموت. فلكل منقذ حكاية وتأويل للعلاقة مع الموت. لا يُبارز أبو السباع الموت ولا يعتبر نفسه بطلًا خارقًا، بل يحتال عليه لأنّ فرص الهلاك أكبر من فرص النجاة في عمليّة الإنقاذ. الموت يشبه طفلًا صغيرًا، كما يقول، ويجب أن تحتال عليه كي تُخلّص نفسك من غضبته: «لا نتعامل مع الموت بمنطق يا أنا يا إنت، هذه معادلة خاسرة مع الموت». تمدّد على الشاطئ، كما كان يفعل بعد كل عملية إنقاذ شاقة. يقول وهو يحدِّق في السماء، إن الخروج من حالة غرق تشبه تمامًا الخروج من البحر بعد شوط طويل من السباحة، تُصفّي الحادثة قلبك وذهنك وتصير إنسانًا أفضل ولو لدقائق.

أرض القمامة والأسلاك الشائكة
يُصغي إلى الموج ثم يأخذ نفسًا ويتذكر يوم قادته سُِمعته، كأحد أكثر المنقذين احترافية في قطّاع غزة في فترة السبعينيات، إلى العمل منقذًا في نادي الموظفين الدولي التابع للأمم المتحدة. يُعرَف النادي الذي تأسَّسَ سنة 1950 على شاطئ بحر غزة بـ«البيتش كلاب»، وكان مخصصًا للموظفين الدوليين والبعثات الأممية.
كان النادي محطة رئيسية لكل الموظفين الدوليين والأجانب الذين يزورون غزة، إلى أن بدأت ملامح الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس تتبدّى على الحالة الأمنية في قطّاع غزة. طالت هذه التحولات النادي الذي أصبح أثرًا بعد عين. في فجر الأول من يناير(كانون الثاني) 2006، ترجّل مسلحان ملثمان من سيارة، محملان بعبوتين ناسفتين، واقتحما النادي بعد أن قيّدا الحارس. زرع المسلحان العبوتين في الملهى وبار النادي. فُجّرت العبوات عن بعد، ولحق إثر ذلك دمارٌ كبير بالمكان. لم تقع أي إصابات لأن الأجانب والموظفين الدوليين كانوا قد غادروا قطّاع غزة خشية الاختطاف في ظل الحالة الأمنية غير المستقرة. بعد الحادثة، نُهبت أغراض النادي وتحوّل مع الوقت إلى مكان مهجور. لم تُعرف إلى اليوم الجهة التي استهدفت النادي، لكن عمليّة التفجير تزامنت مع اختطاف مواطن أجنبيّ يُدعى أليساندرو بيرو (26 سنة) من قبل ثلاثة مسلحين ينتمون إلى «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة فتح، بعد عملية إطلاق نار. كان بيرو ضمن وفدٍ من البرلمان الأوروبي مكون من 18 عضوًا، زار مكتب الحملة الانتخابية لقائمة الطريق الثالث التي يترأسها وزير المالية الأسبق في السلطة الفلسطينية، سلام فياض. مساء اليوم نفسه، تمكّنت قوة تابعة للأمن الوقائي الفلسطيني آنذاك، من تحرير الرهينة بيرو من مكان اختطافه في منطقة المواصي جنوب قطّاع غزة، دون أن يتعرض أحد للأذى.
خلال عامي 2005 و2006، نشطت الخلايا المسلّحة التابعة لحركتي حماس وفتح وبعض الفصائل الفلسطينية في قطّاع غزة، وشهد القطّاع سلسلة تفجيرات وعمليات اختطاف ضد ناشطين وموظفين دوليين وشخصيات أجنبية وشخصيات مختلفة من الفصائل الفلسطينية، بفعل حالة التجاذبات التي سبقت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى والأخيرة التي أُقيمت عام 2006، بُغية تعطيلها أيضًا.
دُمِّرً النادي لاحقًا بعد أن هُجِر وسُحِبت الوفود الأجنبية من القطاعبلاد. كان للنادي رمزية استعمارية في المخيال الجمعيّ الغزّاويّ. يزفِرُ أبو السباع بصوت مسموع، يُعدّل جلسته على الشاطئ ويقول: «تخيّل، تطلع من بيتك الضيّق في المخيم، وتروح تخدم في مكان ما بيشبه مكان معيشتك؟ شيء خيالي كأنه في الأفلام وما بشبه معنى الحياة تحت الاحتلال. على بعد أمتار، كان الاحتلال يَقتل ويدمِّر، بينما هنا، تستجمُّ الوفود الغربية وتراقب المذبحة».
بملامح باردة يطرح أبو السباع السؤال الذي كان يشغل باله حين كان يرى فارق الحياة بين معيشته في المخيّم وعمله في نادي الأمم المتحدة: «كيف يمكن أن يجتمع الجحيم والنعيم في نفس المكان؟»، ودون أن ينتظر إجابة، كان يُضاعف رصيد الحقد في قلبه تجاه الاحتلال.
في فبراير (شباط) عام 1993، سافر المصور والمؤرخ الشفوي الكندي لاري تاول «larry towell» إلى قطّاع غزة لتغطية أحداث الانتفاضة الأولى التي تشظّت شرارتها عام 1987 من مخيّم جباليا للاجئين في غزة وامتدت إلى باقي الأراضي الفلسطينية، بعد أن صدمت شاحنة عسكرية إسرائيلية حافلة تُقلّ عمّالًا فلسطينيين، وقُتِل إثر ذلك أربعة فلسطينيين وجُرِح عدد آخر من مخيّم جباليا.
هرب تاول من «أرض القمامة والأسلاك الشائكة»، كما يصف قطّاع غزة الذي يزوره للمرة الأولى في مقدمة كتابه المصوَّر «No Man’s Land» أو «أرض لا أحد»، إلى نادي الأمم المتحدة: «المكان الوحيد في غزة حيث يمكنك شراء بيرة يقدِّمها عمال إيرلنديون أجانب». كان تاول من القلّة التي تمتلك رفاهية الهروب من الواقع في غزة كما يقول، فالنادي محرّم على السكان المحليين.
تنقّل تاور من مخيم إلى آخر، وهو يغطي المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال، مجرِّبًا من على السطح، بؤس معيشة أهل المخيمات ومعاناتهم في الضيق والاكتظاظ الرهيب في عدد السكان، والمجاري التي «تنزف مثل العروق المفتوحة». من هناك أيضًا كان أبو السباع يتنقّل بين مهامه: في النهار يؤدي مهامه في الإنقاذ، وفي الليل يتحرك لعقد تسوية مع شحنات النقمة والغضب المتراكمة في صدره.
مهام الليل
يمتلك أبو السباع جسدًا صلبًا مازال يحتفظ بحيويته وهو في عمر السبعين، وذكاءًا حادًا، وحسًا أمنيًا عاليًا، وهو ما أهّله لأن ينخرط بسهولة في قيادة خلايا العمل الفدائي الناشئة في قطّاع غزة منتصف السبعينيات. شبَّ أبو السباع في زمنٍ كانت فيه المخيمات محرّك الثورة الفلسطينية الوليدة، لينسل سريعًا في صفوف الثورة، فدائيًا وفاعلًا في سياقاتها الاجتماعية. لم يكن الأمر خيارًا، بل ضرورة، كما يقول. يرسم على الشاطئ مربعًا صغيرًا، ويقول: «هاد بيتي في المخيم بعد ما تهجرنا بسبب إسرائيل». وحول المربع الذي رسمه، يرسم دائرة واسعة وفي قلبها بيته، قائلا: «هذه هي أرض عائلتي في قريتنا الأصلية قرية بربرة التي هجرنا منها، وبدك إياني ما أحقد وأقاتل؟». دفعت ظروف مخيمات اللاجئين، التي عانت من الفقر والاكتظاظ وانعدام الأمل، اللاجئين-ات إلى الانخراط بكثافة في مواجهة الاحتلال أكثر من المناطق الأخرى.
كان أبو السباع مسؤولًا عن خلايا فدائية وسط وغرب قطّاع غزة. يُقضي نهاره على شاطئ القطّاع، وفي الليل تدوي يده قرب الدوريات الإسرائيلية وسجن السرايا المركزي الذي تأسس سنة 1921، في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين. كان السجن مخصصًا للخلايا الفلسطينية الفدائية، ثمّ استخدمته الإدارة المصرية كمجمّع للدوائر الحكومية، وأبقت على جزء منه كسجن، إلى أن سيطرت إسرائيل على قطّاع غزة سنة 1967، وحولته إلى سجن مركزيّ. بعد اتفاق أوسلو (السلام) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، تحول السجن إلى مجمّع حكومي، ثم بعد سيطرة حركة حماس على قطّاع غزة، قصفته إسرائيل في حرب 2008 ودمرته.
عندما يزور أبو السباع منطقة «السرايا»، يتذكّر الأنباء المُوجعة التي كانت تصل مجموعته عن عمليات تعذيب بحق المقاومين والفدائيين الفلسطينيين في سجن السرايا المركزي. بالرسائل الشفهية كانت المجموعات الفدائية تُرسل المعلومات والأوامر لبعضها البعض، وبرقية التعذيب هذه كانت تعني أن على عتمة الليل أن تضيء. يتحرّك أبو السباع مع مجموعته، رغم سيطرة الاحتلال الكاملة على قطّاع غزة، يحمل قنبلة بيد، ومسدساً باليد الأخرى، لفعل ما يمكن أن يوقف التعذيب كإرباك محيط السجن بالقنابل اليدوية أو محاولة استهدافه بالرصاص. بالنسبة له، فإن سجن السرايا الذي تحوَّلَ الآن إلى مساحة خضراء للتنزه وسط قطاع غزة، دليلٌ على الممكن في مواجهة الاحتلال، فبعد أن كان المكان سجًنًا، ها هو مساحة خضراء معشّبة، يلجأ إليها الناس للسمر والترويح عن أنفسهم.
انتقام
ظلّ أبو السباع يتنقَّل بين عمله في الإنقاذ في النهار، وعمله الفدائي في الليل، لمدّة تزيد عن 14 عامًا، إلى أن كُشف أمره وطاردته القوات الإسرائيلية في منتصف الثمانينيات. في ليلة معتمة، وصل إليه الخبر: قُبض على مجموعة فدائية من المجموعات المسؤول عنها. تمكّنت القوات الإسرائيلية بعد تعذيب أفراد المجموعة من انتزاع معلومات عن المسؤول أبو السباع. في الليلة ذاتها، ودّعَ عائلته كأنه يراهم للمرة الأخيرة، وخرج من مخيم الشاطئ باحًثا عن طريقة للهروب. كان يمشي محترسًا على طول الساحل لا يأمن إلا جهة البحر. وما أن وصل إلى منطقة «الشيخ عجلين» غرب قطّاع غزة، شعر بنداءات البحر له، ورمى نفسه بيأس في بحر المنطقة، وسبح وصولًا إلى مدينة رفح المصرية جنوب القطّاع. يقول إنه لم يكن يأمل أن ينجو، لكنه همس لنفسه: إن كان الموت، فليكن موتًا في البحر، فأنا منه وإليه. تُشبه السباحة المشي، كما يقول، كل ما يتطلّبه الأمر أن تتقن التنفس الجيد خلال السباحة ولن تتعب أبدًا، تمامًا كالمشي.
بعد هروبه بفترة وجيزة، داهمت القوات الإسرائيلية بيته في مخيم الشاطئ في أحد أيام عام 1987، لكنها لم تجد أمامها سوى عائلته، وولده البكر رامي (15 عامًا)، فعاقبته باغتياله في بيته. كان بإمكاني رؤية تدفق تلك الذكرى على ملامح أبو السباع، حيث عقد حاجبيه، ورفع رأسه وتنفّس بهدوء كأنه يحاول استيعاب الخبر مثل أوّل مرّة: «كنت خارج قطاع غزة، تقطع قلبي لمّا سمعت الخبر، كان مثل الوردة، فعاهدت نفسي أن أنتقم له».
تُذكّرني لفظة الانتقام التي سقطت من فم أبو السباع بعد أن كوّر قبضته بغضب، بالطفل محمد بَكر من مخيّم الشاطئ، حين حاوطته كاميرات المراسلين بعد أن نجى من مجزرة إسرائيلية أودت بحياة أولاد عمه الأربعة خلال لعبهم على الشاطئ عصر يوم الأربعاء 16 تموز (يوليو) من عام 2014. وزّعَ محمد الذي كان في العاشرة من عمره تقريبًا، كما أولاد عمه الذين قُتلوا، نظراته على الوجوه التي تُحدّق به وصاح متعهدًا: «لمّا أكبر… بدي أضرب تل أبيب». إذن، هكذا تُصنَعُ الثارات الشخصية مع الاحتلال كما يقول أبو السباع. وُضع محمد بكر وأولاد عمه الأطفال وعائلاتهم في بيوت متهالكة في مخيّم الشاطئ. اضطروا على غير عادتهم أن يحبسوا أنفسهم في البيوت أول أيام حرب عام 2014، خشية القصف، لكن من الصعب أن يُحتمل البقاء طوال اليوم في بيوت مخيم الشاطئ خصوصًا في الصيف، إذ يحوِّل السقف الحديدي البيت إلى فرن. تحرك الطفل إسماعيل بكر من بيته إلى بيت عمه، نادى على محمد:
– يلا عالشط!
– شو بدنا نعمل عالشط؟
– «بندبر حالنا، بنلاقي أي حاجة عالبحر نلعب فيها».
هكذا ختم إسماعيل الحوار بعد أن سحب محمد من يده. لملم محمد وإسماعيل أولاد عمهم، ونزلوا إلى الشاطئ.
كان إسماعيل أول طفل يُقتل بعد أن استهدفتهم البوارج الحربية الإسرائيلية بأربعة صواريخ. لم يحالفه الحظ كأبو السباع، ولم يكن الشاطئ مساحة آمنة ومهربًا له من ضيقته. ينسى أهالي غزة المحاصرة منذ أكثر من 17 عامًا، أو يتناسون طمعًا في حيزٍ آمن، أن الاحتلال يُحيل وقتما يشاء الشاطئ بوصفه ملاذهم الوحيد إلى مذبح لهم.
اعتاد محمد أن يقف أمامى الشاطئ الذي صار شواهد قبور لأبناء أعمامه وأصدقاء طفولته، وأن يحمل حجرًا ويقذفه في الاتجاه الذي جاءت منه القذائف ويتمنى لو كان الحجر صاروخًا، ليرد الأذى بمثله. هذا ما حاول أبو السباع أن يفعله طيلة حياته.
سلّم أبو السباع نفسه إلى أول نقطة مصرية، وبدوره سلّمه الجانب المصري إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لتبدأ من بعدها رحلته مع القوات التابعة لمنظمة التحرير في الخارج. بعد نحو 38 عامًا، ما يزال أبو السباع يحمل امتنانًا كبيرًا لمصر، وبأسىً يُلخِّص التبدل في التعامل العربي مع الفدائيين الفلسطينيين، وتحوُّل السلوك العربي من احتضان للفدائيين إلى طردهم وملاحقتهم.
مازال أبو السباع يحفظ عن ظهر قلب أغنية «يمي يمي يمي» التي صدرت سنة 1988 بعد عام من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى. كتب الأغنية الشاعر الليبي علي الكيلاني، وغنّتها سوسن الحمامي وأمل عرفة وجوليا بطرس، وكان أبو السباع يردّدها في معسكرات التدريب في ليبيا، وهي أول محطة له بعد أن التحق بقوات منظمة التحرير في الخارج، يأخذ نفسًا، كأنه يسحب شيئًا من ذاكرته البعيدة، ويغني:
يمي يمي يمي
حيين دفنوا خوتنا… ولمين بنشكي؟
هدوا علينا بيوتنا … ولمين بنحكي؟
قطعوا علينا قوتنا… ولمين بنشكي؟
يقاطع نفسه، ويقول بصوته الحازم: لمين نشكي ولا نحكي؟ إيدك إلي بتجيب حقك، لازم نقاتل!
غادر مطلع التسعينيات إلى الأردن، المكان الذي سبقه اسمه إليه. يقول جاره جهاد أبو عتيلة إنه سمع باسم أبو السباع، أحد مسؤولي المنطقة الغربية في قوات الثورة الفلسطينية في قطّاع غزة، قبل أن يُرافقه ضمن قوات منظمة التحرير في الأردن، وكان آخر ما يتوقعه أن ينتهي به المطاف جارًا وصديقًا لأبو السباع بعد كل ما مروا به معًا. يغادر أبو السباع لاحقًا إلى سوريا ثم لبنان، هناك عُرِف بين زملائه في صيدا بـ«الحوت الأزرق»، كما يقول باسم دهشة، صديقُهُ الذي يسكن الضفة الغربية وكان يُرافقه في لبنان.
في صيدا، شمّ أبو السباع هواء البحر المتوسط الذي يربطه بأهله في غزة بعد غياب طويل، وخلافًا لرفاقه، كانت أذن أبو السباع تبحث عمّا تتوق لسماعه، حيث كان يسمع صوت الموج يدوي في أذنه بدلاً من صوت الرصاص، ويحمل ذلك ما يحمله من حنين إلى موج بحر مخيم الشاطئ. حتى في منفاه كان البحر يلاحقه، إلى أن سمع موجة وهوى على إثرها في قلب العتمة. كانت تلك الموجة طلقة أصابته في اشتباك مع القوات الإسرائيلية. تشبه العتمة التي هوى فيها بعد إصابته، عتمة البحر التي ألفها كثيرًا، كما يقول. اعتقد أبو السباع المنقذ، أنه لن ينجو، لكنه نجا بعد أن فقد كلية وجزءًا من أمعائه.
ولادة
عام 1994 عاد «أبو السباع» إلى قطّاع غزة مع قوات منظمة التحرير في الخارج، بعد اتفاق «أوسلو»، وصار ضمن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. تألّم أبو السباع لأن هناك اتفاقًا وقع مع الاحتلال، لكنه كان مشتاقًا لأولاده وأهله. بعد العودة أنجب 6 أبناء، ليزيد بعدها عدد أفراد عائلته إلى 16، عشرُ بنات، وستّة أولاد من بينهم رامي الذي سمّاه تيُّمنًا باسم ابنه الذي اغتالته القوات الإسرائيلية.

صار عمر رامي الآن 28 عامًا، لكن والده كلّما ينظر إليه يجده رامي الفتى ابن الـ15 عامًا الذي أعدمته إسرائيل. يقول رامي إنه يشعر أحيانًا أن وجوده يتلخّص في رغبة والده بأن يُعيد ابنه رامي الشهيد إلى الحياة. جسد رامي صلبٌ كجسد والده. يقف إلى جواره بهيئة منضبطة كأنه عسكري. عندما تنظُرُ إلى رامي تجد شخصية أبو السباع الصلبة فيه. يعتبر أبو السّباع الذي تأثّر كثيرًا بشخصيّة والده بأنّه لا يُربّي أبناءً عاديّين بل مقاتلين وفدائيين. يقول مفتخرًا إن والده ربّى سبعة أولاد وأربع بنات تربية وطنية، وكلهم فدائيّون.
لم يَدُم الحال طويلًا، فالرجل الذي تقلّد رتبة لواء في السلطة الفلسطينية، سيخسر معنى هذا اللقب في وقت قصير. ففي عام 2007، ومع سيطرة حركة حماس على قطّاع غزة بعد الانتخابات التشريعية، اعتقلت القوات التابعة لحركة حماس «أبو السباع»، وذلك خلال هجومها على المقرّات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. يحكي أبو السباع بملامح متحسِّرة كيف عُذّب على يد مسلحي حركة حماس، وعن الاشتباكات الدامية التي وقعت إبان أحداث الانقسام بين حركتي حماس وفتح. تُذكِّرُني نبرة أبو السباع المتألمة باليوم الذي احتميت فيه بعربة حصان جارنا. كان يومًا من أيام عام 2007، هادئًا بالنسبة لطفل في العاشرة من عمره، يتحضّر لصخب كرة القدم في شارع السكة، لكنه وجد نفسه أمام صخبٍ كاد يودي بحياته، إذ اخترقت شاحنتان عسكريتان تابعتين لمسلحين من حركة حماس وحركة فتح الشارع، تُطارد الأولى الثانية بالذخيرة الحية. أمام دوي الرصاص، لم أجد ملجًأ سوى عربة الحصان القريبة. ركضتُ واختبأتُ تحتها، إلى أن صرنا خارج مدى الرصاص العشوائي، لعب لصالحي الحظ ونجوت.
فكّكت حركة حماس البُنية الأمنية للسلطة الفلسطينية في غزة، وأنشأت أجهزتها الخاصة، فيما استنكف غالبية موظفي السلطة عن أعمالهم بقرار من السلطة، وهو القرار الذي بدّل حال أبو السباع. يُحرّك يديه بلا مبالاة تعكس ألمًا شديدًا، ويقول: «عسكري عنده واجب وطني، يقعد في البيت؟».
تركت تلك الفترة في نفس أبو السباع ندوبًا شديدًة كما يحدث عندما يُعذَّب فلسطيني على يد فلسطيني. «كانت تجربة قاسية»، يقول ثم يستدرك ليعزي نفسه بالمثل القديم: «إلي ما يعرف الصقر بيشويه». ويُحيل ما حدث، بنوع من التسامح الذي تُظهره ملامحه، إلى جهل القوات التابعة لحركة حماس بتاريخه الفدائي. طبعت هذه التجربة شخصية أبو السباع بمزيد من الارتياب، وبشيءٍ من العدوانية تأثّرت بها دائرته القريبة، فلم يتوقع أن تكون هذه الحال مكافأة مشواره الطويل الذي خاضه بقلب مُخلص لوطنه.
يغفر أبو السباع ما تعرّض له من ظلم من أبناء جلدته، لأنه «في النهاية كلنا فلسطينية» ولأنه يحمل في قلبه همًا أكبر، وهو ما وصلت إليه حال الفلسطينيين-ات الآن من ضعف وترهُّل. «جوّعوا الناس ووصلوهم لمرحلة إنه يكون العمل في إسرائيل أكبر همهم؟! هذا مشروع وطني؟» يقول متعجبًا.
ينظر أبو السباع إلى العمال الفلسطينيين الذين يقبلون العمل داخل إسرائيل بارتياب شديد. وللحق، فإن كلمة إسرائيل لوحدها تثير حنق أبو السباع. سُمح مؤخرًا لعمال فلسطينيين من قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار التي رعتها مصر بين حركة حماس في القطّاع وإسرائيل. يعود أبو السباع في حديثه إلى عام 1973، عام النكبة الثانية كما يقول، بعد أن وُقِّع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، فمن بعده لم ير الفلسطيني-ـة خيرًا، وبات العمل في إسرائيل شيئًا عاديًا. قبل ذلك، كان التعامل مع كل من يتوجّه إلى العمل داخل إسرائيل يسيرُ في اتّجاهين لا ثالث لهما، إمّا الاعتقال أو الاغتيال، عدا عن الشعور بالعار الذي يلاحق عائلة العامل. لكن كل ذلك تَغيَّر، يقول أبو السباع بفم مهموم، إن الأمر بات شيئًا عاديًا، حتى وصل الحال إلى اعتباره إنجازًا الآن، وهو الخطيئة الوطنية التي لا تغتفر.
كان لأبو السباع مقاربته الخاصة في التعامل مع العملاء أو من يثبُت تورطهم بالتخابر مع الاحتلال في السبعينيات والثمانينيات، فبدل التصفية كان يقترح على المجموعات الفدائيّة أن يوضع العميل وزوجته في بيت، ويُمنع من الخروج إلى أن ينجب عددًا من الأبناء. يعتبر أبو السباع الإنجاب فعل مقاومة في تلك الفترة لمواجهة الإبادة الإسرائيليّة للنسل الفلسطينيّ…
في الأعوام الأولى من اللجوء، كان اللاجئون حريصين على زيادة أعداد أفراد العائلة، لأن حلم العودة لم يتبدّد بعد، فكما كان خروجهم من أراضيهم محض صدفة يصعب تصديقها، فإن العودة أمانة وعُهدة يجب أن تنتقل من جيل إلى آخر، كما يقول. يحكي أبو السباع عن الإنجاب بنبرة مرتابة كأنه يحاول التحذير من خطر داهم، مُشيرًا لأحاديث حاخامات إسرائيليين كانوا يحذّرون من سلوك العائلات الفلسطينية والعربية في الإنجاب. عُرف بين هؤلاء، الحاخام الإسرائيلي من أصل أميركي مائير كاهانا الذي أسس حزب «كاخ» المتطرف. كانت رؤية حزب كاهانا تتمثل بالطرد والعنف كحل لنفي الوجود الفلسطيني في «أرض إسرائيل». ولكاهنا تصريحه المعروف الذي يقول فيه: «إن العرب يهددونا بالرضَّع والقنابل».
حتى يومنا هذا، لا يزال النقاش الفلسطيني-الفلسطيني بشأن التعامل مع المتخابرين مع الاحتلال متضاربًا كما مسألة العمل داخل إسرائيل. يقول أبو السباع، إن العمل في إسرائيل لا يمكن قبوله، لأن إسرائيل لا تقدِّم شيئا عن حسن نية: «قبول العمل داخل إسرائيل يعني أن ينسلخ الشخص عن همِّه الوطني، وبصير جزء من الاحتلال»، فإسرائيل التي تمنع الفلسطينيين من امتلاك بنية اقتصادية منفصلة ومستقلة، هدفها أن تمسك بقوت يوم الفلسطينيين، وأن يصير وجود الفلسطيني مرتبطًا بوجود الإسرائيلي. يمكن أن تجادل أبو السباع في أي مسألة، إلا الاحتلال، فالأمر لا يحتمل أي جدال بالنسبة له. يسند ظهره إلى الحائط على عتبة بيته، ويقول إن الحالة الحزبية التي تغرق الفلسطينيين الآن أنشأت جماعات مفككة وانتماءات أقصر من أن تصل إلى فلسطين. يقول: «ما الأفضل؟ أن نكون يدًا واحدة، أم ألف يد وتَوجُّه؟».
يُغلّف أبو السباع قلبه الطيب بجلد قاسٍ، هكذا، يصعب على أيّ أحد أن يكتشف طيبة قلبه وأن يتعامل معها كضعف كما يقول، لكن احتراسه الشديد، لم يمنع الناس من معرفة سرّه، لذلك يستنجدون به في كثير من الأوقات. يتذكر يوم لجأت إليه امرأة عنّفها زوجها وفتح لها أبواب بيته. يحكي عن الموقف بنبرة هادئة وملامح مرتاحة تعكس فخره بسمعة الشهامة التي تسبقه في كل مرة. يقول جاره يوسف أبو السعيد إن عمل أبو السباع في الإنقاذ لعقود طويلة حوّله إلى مصدر أمان له وللمكان الذي يسكنه: «في البر أو البحر، طالما أنت إلى جانب أبو السباع فأنت بأمان».
تتبدّى إنسانية أبو السباع المفرطة في حالات لا يمكن توقعها أيضًا، كما يقول أبو السعيد. في الشتاء الأخير، سمع أبو السعيد صوت أبو السباع من أمام بيته وهو يصيح موبخًا رجلًا لأنه ترك حماره محاصرًا تحت غزارة الأمطار وهرب ليحتمي تحت مظلة قريبة: «إنت بتحسش! مش إنسان! هذا الحيوان بحس مثلك مثله». مشى بسرعة وقبض على أرجل الحمار وحمله وأنزله تحت المظلة ليحميه من المطر.
يمكن ملاحظة انعكاس التجربة القاسية والطويلة التي عاشها أبو السباع في العمل الفدائي والتنقل مع قوات منظمة التحرير الفلسطينية على ملامحه حين يلمح غريبًا، أو يحاول أحد ما محادثته للمرة الأولى، إذ تركت تجربته الطويلة ندوبًا أمنية في ذاكرته، وبات يظهر على شخصيته الارتياب الذي يتبدّى في معاملته حتى مع دوائره المقرّبة وعائلته. يقول ابنه رامي إن والده لم يمر بشيء قليل أو بسيط، مسيرته طبعت في شخصيته أشياءً لا يمكن تغييرها، وأثرت حتى على أولاده: «من الصعب أن يستأمن شخصًا ما بسرعة، أو أن يصدق بسهولة كل شيء».

يفتخر أبو السباع كثيرًا بسيرته، وبما قدمه لوطنه كما يقول. يأخذ نفسًا عميقًا، ويقول بصوت ثابت: «لو مدَّ الله في عمري أكثر، أو طلب مني أن أُعيد تجربتي لن أتردد، والآن متمسّكٌ بواجبي الوطني الأخير وهو الإنقاذ البحري، ولن أتخلى عنه». يبتسم بملامح صادقة ويقول إنه يود لو يكتب عن حياته كتابًا ويعنونه: «أبو السباع.. مُنقذ بحري نهارًا، فدائي ليلًا».