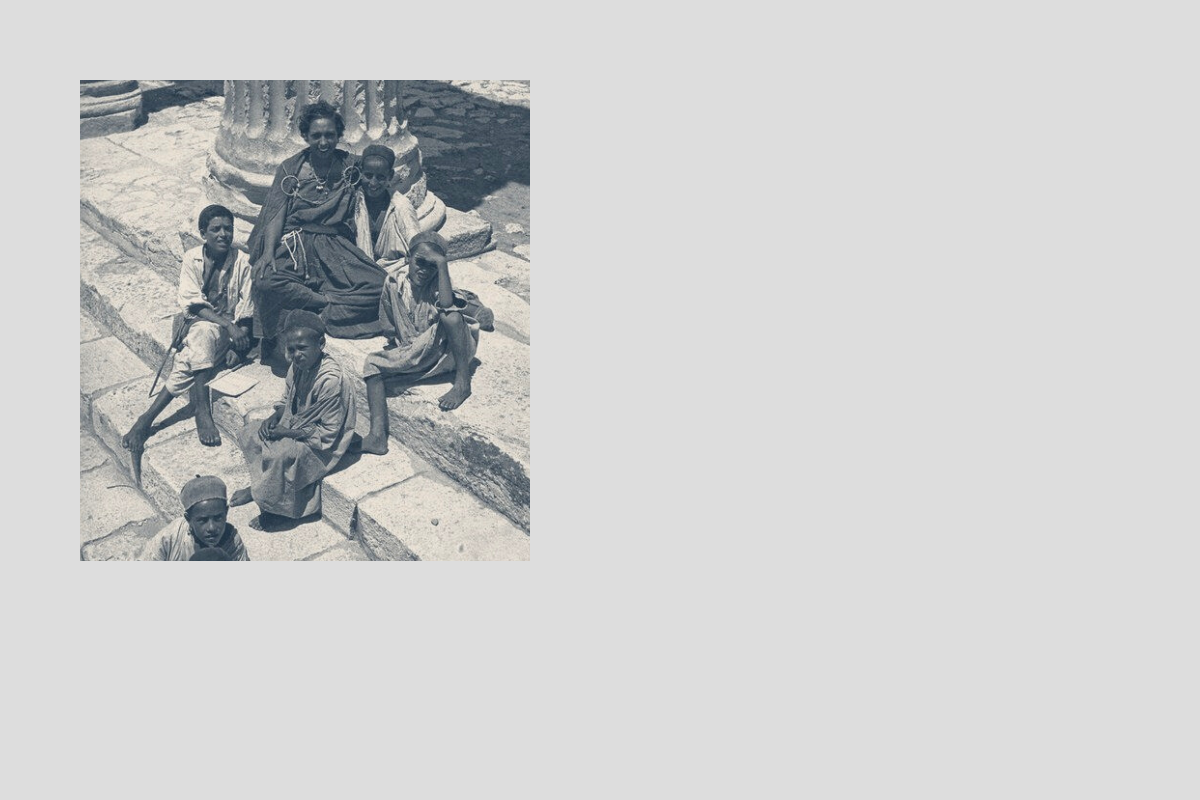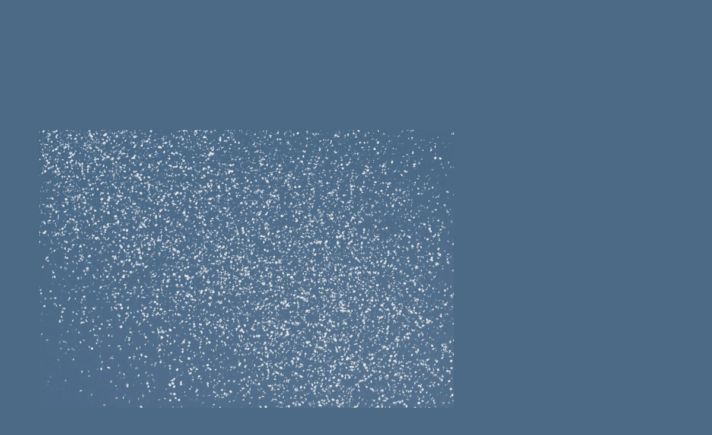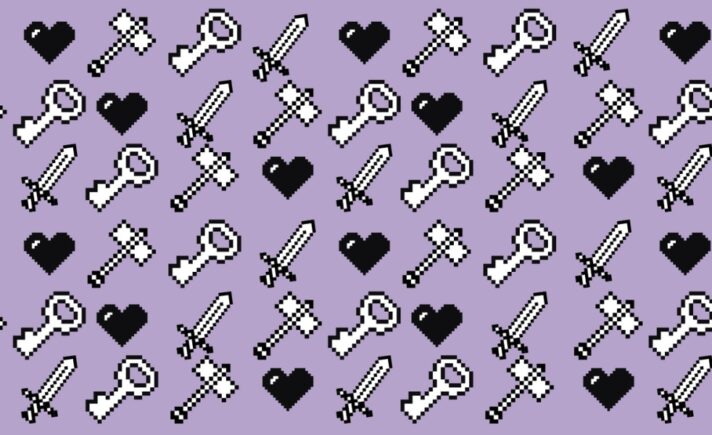على أعمدة جريدة الزمان بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1931، كتب مدير الجريدة، محمد بنيس، خبراً قصيراً حول قدوم جوزفين بيكر إلى تونس العاصمة: «حادثان كبيران في هذا الأسبوع: الأول: تسمية م. طيوكور كاهية رئيساً أول لبلدية العاصمة، والثاني: قدوم جوزفين بيكر لجوقة البالماريوم. لا شكَّ أن عموم الإفرنج واليهود اهتموا بالثاني أكثر من الأول. ولكننا نحن – وقد لا نَعجَبُ لرؤية الزنوج مع كل احترامنا لكوكب الطاحون الأحمر – فقد كان اهتمامنا بالأول أوفر، لكننا نسينا السيدة جوزفين بيكر. فنحن نرّحبُ بها ترحيب القادم، ولسنا في احتياج إلى الإعلان عنها، فجدران المدينة وأحاديث القهاوي والمجتمعات قد كفّتنا المؤنة، وفوق ذلك فلم تعد توجد المقاعد اللازمة في مسرح البالماريوم. فيا هؤلاء، بدّلوا ألوان جلودكم إذا شئتم الشهرة والإقبال». يكشفُ الخبر، رغم نبرة صاحبه العنصرية، عن عَظَمة أثر قدوم جوزفين بيكر إلى تونس في ذلك الوقت. فقدت الساحة الفنية الكثير بِموت الديفا حبيبة مسيكة سنة 1930، ولم تَقدِر بقيّةُ الفنانات، يهوديات أو مسلمات، على ملء ذلك الفراغ. من جهتها، كسبت جوزفين الكثير بهجرتها من أميركا إلى فرنسا منتصف العشرينيات هروباً من العنصرية ضد أصحاب وصاحبات البشرة السوداء، وحازت اهتماماً عالمياً في الغناء والاستعراض والسينما.
أحدثت تلك الزيارات المبكرة لجوزفين صدىً في الصحافة الإخبارية والهزلية التي عاشت طفرةً خلال فترة ما بين الحربين. ساهم محمود بيرم التونسي في تفجير مشهد الصحافة الهزلية خلال الثلاثينيات عبر جريدته الشباب، وألهم الكتّاب الصاعدين من حوله لإنشاء مشاريع مماثلة جعلت من الواقع اليومي مادّة للسخرية والهزل والأدب أيضاً. نشر بيرم في جريدته الشباب سلسلةً كاريكاتورية بعنوان الموزيكهول الأهلي، تهكّم فيها على فنانات وراقصات تلك الفترة وتأثرهنّ المبالغ بِجوزفين بيكر؛ مثل شافية رشدي وفتحية خيري وفضيلة ختيمي. لم يكن تحامُلُ بيرم على جوزفين بيكر بقدر ما كان مُوجَّهاً بالأساس إلى نجمات الغناء المحلي وتخليهنّ عن تونسيّتهن لصالح مظاهر مستوردة سببها الهوس بِجوزفين. امتد الاحتفاء بأثر جوزفين إلى الأدب. تحدّثت محرزية بورناز في كتابها محرزية بورناز تتذكر: تونس 1930 عن أغنية J’ai deux amours التي انتشرت على نطاق واسع لجوزفين بيكر (صفحة 23)، وكذلك هيوجات سنيا باردو في كتابها ما بين صقلية وتونس عندما أشارت إلى نفس الأغنية منبعثةً من الفونوغراف أثناء حفل زفافٍ لإحدى العائلات في بنزرت سنة 1934.
خلف ردود الفعل المتباينة، التي تراوحت بين الاحتفاء والتندّر والتهجُّم، ترك طيف جوزفين بيكر أثراً ملتبساً في الغناء التونسي من خلال أغنية محلاك يا النقريتاالنقريتا؛ كلمة إسبانية تشير إلى المرأة ذات البشرة السوداء. التي كُتبت افتتاناً بها في إحدى زياراتها. نُسب نص الأغنية إلى محمد العريبي، أحد رواد حركة تحت السور، ولحّنها محمد التريكي الذي عاصر نشأة الرشيدية وترأس تختها وكان أول من دوّنَ التراث الموسيقي من نوبات المالوف والموشحات الأندلسية. شكّلت النقريتا حلقةً ضائعة في تاريخ الموسيقى التونسية، إذ لم تُسجّل على أسطوانة حسب تأكيد منير الهنتاتي الذي أشرف على الأرشيف السمعي لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، النجمة الزهراء، لكن غنّتها فتحية خيري وفقَ فاخر الرويسي في كتابه عن الفنانة، وسانده في ذلك عبد الستار عمامو الذي ذكر في مقابلةٍ له مع الراحل محمد التريكي ملحن الأغنية بأن كل من لويزة التونسية وفتحية خيري أدّتا الأغنية. اشتهرت الأغنية في وقت لاحق مع شكري بوزيان الذي استعادها بشكل متأخر بداية التسعينيات بعد استشارة محمد التريكي، واكتسح بها محطات الراديو التي أدمنت على بثّها خلال الفقرات الصباحية لِطابعها الراقص الجذاب وخفتها الإيقاعية واللحنية.
تَغنّى العريبي، الذي نُسب إليه نص الأغنية، بالجمال الأفريقي لِجوزفين بيكر ورقصاتها المثيرة: «عزفك عالرومبا ورقصك عالسمبا»، في فترةٍ شهدت تزايد الولع بالجاز والرقصات المستوحاة من أفريقياإثر الحرب العالمية الأولى أصبح الولع بالجاز والاهتمام بالرقصات المستوحاة من أحفاد العبيد الذين جُلِبوا إلى أميركا الشمالية يعكسُ بوضوح طموح الثلاثينيات. سلوى بن حفيظ. الرقص في الثقافة الإسلامية، جذوره أبعاده وتمثلاته، ص 462. التي اكتشفها الجمهور مع جوزفين في تونس عبر عروض الميوزيك هول. تتفقُ المراجع الوحيدة التي ذكرت قصة الأغنية في الإشارة إلى 1934 كتاريخٍ لكتابتها من طرف العريبي، أهمها شهادة محمد التريكي نفسه في حوار معه نُشر في مجلة الحياة الثقافيةأعد الحبيب جغام الحوار مع محمد التريكي سنة 1994، ولم ينشر إلا في العدد 181 من مجلة الحياة الثقافية خلال عددٍ خاص بالموسيقى التونسية، آذار (مارس) 2007.، وكتاب محمد التريكي لِمحمد بوذينةص 34.، غير أن فاخر الرويسي تفرّدَ عن الجميع في كتابه عن فتحية خيريفاخر الرويسي. فتحية خيري فن وشجن، ص 76. وأشار إلى أن الأغنية كُتبت ولُحّنت سنة 1935 أثناء زيارة جوزفين بيكر لتصوير فيلم برينسيس تام تام وإقامتها لِحفلٍ في البالماريوم.
بالتدقيق في الجرائد الصادرة سنة 1934، نكادُ لا نعثرُ على أثرٍ لزيارة محتملة لِجوزفين بيكر على امتداد السنة، وهو ما يجعل الشهادات التي كان مصدرها محمد التريكي، الذي زامنَ بين زيارةٍ مفترضة لبيكر إلى تونس وكتابة الأغنية، محل شكٍّ كبير. كما أنه من الثابت أن الأغنية لم تُكتب أثناء زيارة بيكر خلال سنة 1935 لتصوير فيلم الأميرة تام تام، نظراً لقصر المدة التي أقامتها في تونس لصالح الفيلم الذي لعبت فيه دور فتاة تونسية اسمها عوينة وكسبت احتفاء النقاد الذين شبهوها بِـ سندريلا عربية سوداء. لا يبدو اختيار الاسم اعتباطياً، أي عوينة، لكنه يحيل إلى أكزتكة الجسد الأسود، فالعوينة في العامية التونسية هي البرقوق الأسود، ولها حضور في الأمثال الشعبية: «العوينة الكحلاء ما تحبّش المكس». وصلت في الأول من تموز (يوليو) وغادرت البلاد في السادس من نفس الشهر، كما قضَت كل تلك الفترة في التصوير، ولم تؤدِّ عروضًا في المسارح والكازينوهات. جاء ذكر هذه الزيارة في مجلة شمال أفريقيا المصورة بتاريخ 10 آب (أغسطس) 1935، حيث أشار كاتب المقال المتعلق بزيارة بيكر إلى الشغل الكثيف للمخرج وأجواء العمل المرهقة والتنقل المتعب بين البلفيدير وقمرت ودقة. لو سلّمنا بأن محمد التريكي لحّن الأغنية سنة 1934، يحيلنا ذلك إلى أن العريبي قد كتبها وقتها أو خلال فترة سابقة، ونعني بذلك حوالي سنة 1931 في أولى زيارات بيكر إلى تونس، حيث نشرت جريدة صدى الجزائر بتاريخ 32 تشرين الثاني (نوفمبر) 1931 مقالاً بعنوان تونس تترقب جوزفين بيكر، أشار كاتبه إلى قدوم جوزفين بيكر بصحبة فرقة جاز مكونة من 16 عازفًا لإقامة أربع حفلات في قاعة البالماريوم وسط العاصمة. تحدثت الصحيفة الفرنسية باري ميدي بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1931 عن أصداء تلك الزيارة إلى تونس، وأشارت إلى أن أحمد باي الثاني منح جوزفين بيكر نيشان الافتخار؛ من أعلى الأوسمة في المملكة التونسية وقتها، مع مرافقيها، بعد أن أحيَت حفلاً خيرياً لصالح المستشفيات التونسية. خلافاً لاحتفاء الجرائد الاستعمارية بقدوم بيكير، شنّت بعض الجرائد المحلية هجوماً لاذعاً مثل مقال محمد بنيس، مدير جريدة الزمان. يمكننا استثناء ذلك التاريخ بسهولة، لأن العريبي وقتها لم يحترف الشعر الغنائي بعد، وكان طالباً زيتونياً محافظاً شديد الورع حسب معاصريه، ولم ينضم بعد إلى جماعة تحت السور.
لا يمكننا الحسم في تاريخ كتابة الأغنية دون المرور بحياة العريبي وفصولها المتقلبة التي جعلت منه كاتباً وشاعراً ساهم في صناعة أدب الأغنية التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ارتبطت الأغنية، رغم التباس تاريخها، بنزق حياة العريبي وتطرُّفه الإبداعي. ظلّت حياته مهمشة مقارنةً ببقية أعلام تحت السور مثل علي الدوعاجي الذي نال الألق الأكبر، وغيّبه الموت بشكلٍ مبكر.
محمد العريبي: من ورع الجامع الأعظم إلى عبث تحت السور
«عرفتُه سنة 1933 ولداً شاباًيُذكر أن العريبي ولد سنة 1915 حسب ما ورد في بطاقته الصحفية، فيما يشير بعض المقربين منه إلى تواريخ أخرى متضاربة ولكنها قريبة جداً من نفس السنة. قد بدأت لحيته تنبت ولم يقطع منها شيئاً ولا هذّبها في يوم من الأيام. كان محافظاً مغلقاً إلى درجة الرجعية، ومع ذلك يلتهم ما يلقى، أي الكتب والمجلات، ولا يرجع لك في الغد على نفس البساطة التي رأيتَها منه البارحة»؛ هكذا تكلم زين العابدين السنوي عن محمد العريبي في مجلة الندوة في آذار (مارس) 1953. لم يزل العريبي طالباً زيتونياً محافظاً شديد الورع خلال فترة تعرّف السنوسي عليه أوائل الثلاثينيات، قبل انقطاعه عن دروس الجامع الأعظم في نفس السنة [بحسب الموسوعة التونسية] وانضمامه إلى جماعة تحت السور التي غيّرت من وجه الحياة الثقافية في تونس زمن الثلاثينات الوعرة.
توسطت الثلاثينيات مرحلة عسيرة مرت فيها البلاد بين بداية القرن العشرين واندلاع الحرب العالمية الثانية. كان كل شيء في تونس يتحرّك ويتفكّك في ذلك الوقت، ويضعُ المجتمع بكل فئاته في قلب الأحداث والتحولاتكلثوم جميّل، من وجوه تونس الحديثة: شيخ الفنانين، عبد العزيز جميّل. ص 85. خلافاً للعشرينيات التي اقتصرت بالكاد على حبيبة مسيكة وفضيلة ختيمي، مثّلث الثلاثينيات بأوجهها المتعددة والمتناقضة فترة فتيّة في تاريخ تونس الأدبي والفني. تزامنت مع مرحلة حالكة سياسياً واجتماعياً تعاظم أثرها مع تداعيات أزمة الثلاثينيات، بعد انهيار بورصة وول ستريت وتفاقم حركات النزوح وتصاعد وتيرة القمع من طرف الاستعمار آنذاك. ظهرت في الأثناء بوادر حركة إصلاحية مستنيرة من قلب الأزمة، كان لها تعبيراتها النقابية والتحررية التي ارتبطت بشكل خاص بحقوق المرأة، كما احتدم الحراك السياسي برمته مع دخول جيل جديد من الناشطين. تغيّر المشهد الموسيقي مع الدور الذي لعبه البارون ديرلانجي ومؤتمر القاهرة الأول، بالإضافة إلى تأسيس الرشيدية والإذاعة في وقتٍ لاحق، وظهور موجة شعراءٍ غنائيين تزامنت مع طفرة الصحافة الهزلية والأدبية في تونس التي دفعت إنتاجاتِهم ونشرَتها على نحوٍ واسع. ارتبطت الحركة الأدبية والفنية بشكلٍ واضح بالصحافة المكتوبة وقتها، فيما كان أثر كتاب الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ومحاضرة أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، كبيراً على المشهد الثقافي آنذاك، إذ أشعلا النقاش حول مواضيع ظلّت محظورةً مثل تحرّر المرأة وقضية الجماليات الشعرية العربية. تعدّدت المحاضرات واللقاءات التي أمّنتها الفضاءات الثقافية في العاصمة، ومثّلت الحفلات التأبينية للشعراء والكتاب الأجانب علامةً لانفتاح المثقفين الصاعدين على محيطهم الخارجي وتوْقهم للتغيير.
لم يزل العريبي طالباً زيتونياً آنذاك، يُشارك في تلك الندوات التي جمعت تيارات المحافظة والتجديد، حيث بلغ «الانشقاق الفكري بين القدامى والمجددين أشدّه، وانتعش العمل السياسي من جديد وانتقلت الزعامة السياسية والفكرية من أيدي المثقفين التقليديين إلى أيدي المثقفين الجدد»محمد الجلاصي. محمد العريبي، ص 9. بدأت بوادر التمرُّد في نفس العريبي في تشرين الأول (أكتوبر) 1932 عندما حضر حفلاً تأبينياً للشاعر حافظ إبراهيم في الخلدونية، إحدى الجمعيات النشيطة وقتها بجانب قدماء الصادقية. مثّلَ الحفلُ نقطة التحول في اتجاهه الفكري، ودفعه فيما بعد إلى إنهاء دراسته بجامع الزيتونة. تغيّبَ رئيس الخلدونية عبد الرحمان الكعاك وعوّضه أحد شيوخ الزيتونة لرئاسة الحفل الأدبي. اعتلى أحد الحاضرين المنصة لإلقاء قصيدةٍ أرسلها الشاعر الجزائري مفدي زكرياء خصيصاً للتأبين يقول فيها: «كذب الناس أنت لست بميّت / إنما أنت خالد الذكر حيّ». ثارت ثائرة الشيخ الزيتوني الذي ترأس الحفل وأعلن أمام الجميع بأن ما كتبه زكرياء ضربٌ من الكفر والزندقة، فأيّده أمثاله من المحافظين الموجودين هناكالعالم الأدبي، 19 كانون الأول (ديسمبر) 1932.. سادت الفوضى القاعة وانتفض الهادي العبيدي، أحد الشباب الزيتونيين المتحررين، تصادم مع الشيخ ثم غادر القاعة ساخطاً معلناً ثورته على الرجعية. أثّرَ ذلك المشهد كثيراً على العريبي الذي راقب ما حدث في صمتٍ وذهب إثرها في تقفي أثر العبيديمحمد الجلاصي، محمد العريبي، ص 12.. أحدثت وقائعُ المحاضرة شرخاً كبيراً فتح العريبي على عالم جديد وأدخله رحى الثلاثينيات المستعرّة التي هزّت تونس.
تزامنت تلك الحادثة مع موت والد العريبي. اضطُر الولدُ إلى احتراف التجارة في سنٍ صغير ثم التحق للعمل بالمصرف الإسلامي سنتي 1934 و1935. تمكّنَ من توسيع شبكة علاقاته واتصالاته، وتعرّف إلى زين العابدين السنوسي في دار العرب التي أصدرت العالم الأدبي؛ أهم مجلةٍ أدبية في ذلك الوقت، وسمع به الدوعاجي أخيراً. ساهمت تلك الاضطرابات التي عاشها العريبي في انتقاله من مرحلة تديّنٍ ووَرَع إلى مرحلة بوهيميةٍ وجموح، ما يفسّر حماسته لجماعة تحت السور التي كانت عنواناً للهامشية والعربدة. تأسست الجماعة بعد انشقاق روادها الأوائل عن مجلس الشاعر العربي الكبادي في مقهى الدربوز قبالة باب منارة؛ الذي يعدّ أول مقهى أدبي وقتها. يعوز الدوعاجي أسباب الانفصال إلى تهرّم ذائقة مجلس الكبادي واختلافهم حول الأغاني التونسية وركود الحركة الشعرية الغنائية: «لا أودُّ أن يذهبَ بالك إلى معتزلة الكوفة من أصحاب الحسن البصري وإنما معتزلتنا هؤلاء اعتزلوا مقهى باب منارة وجماعة شعراء الفصحى ونزلوا إلى مقهى تحت السور، وسبب ذلك نادرة سأرويها لكن في إيجاز. كنا في المقهي في باب منارة، وفي المقهى فونوغراف يردِّدُ على مسامعنا طوال اليوم أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم، وهم وإن كانوا يحذقون فنهم كل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى (ايزالكه سمش عليك) و(بردقاني حلو ومسكي أحلى من شرب الوسكي) وسماجات أخرى يترواح عيارها بين 9 و14 قيراطاً، وليس لهم من ذنب في ذلك ما دام الزجّالون لا يعدونهم بأحسن مما لديهم» كما ورد في مقالة لعلي الدوعاجي، في جريدة الأسبوع بتاريخ 16 حزيران (يونيو) 1946. جمع مجلس الكبّادي بين المحافظين والمجددين في مقهى الدربوز، ومنهم الدوعاجي الذي كان من رواده قبل أن يُعلن العصيان والانسلاخ. تحوّل الدوعاجي مع جماعته باتجاه مقهى شعبي في باب سويقة للاقتراب من الفنانين والملحنين والمغنين. عُرف المكان بأسماء عدّة منها مقهى سيدانة وتحت السور وسيدي علي نسبةً إلى صاحبها، وشكّل مركز اجتماع شرائح اجتماعية مختلفة تجمعُ العاطل والعامل والأديب والشاعر والرسام والفنان والموسيقيّ. تلبّسَ المقهى بخصوصية فريدة جعلت منه وجهةً لعقد الصفقات الفنية والمعاملات المهنية والمالية. يستعرض الرواد من الفنانين والشعراء خلال جلساتهم المسائية إنتاجهم الإبداعي، الذي تميّز بطابع خاص حرصت جماعة الدوعاجي على تنميته وتكييفه للرؤية الهامشية التي وسمت سلوكهم وإبداعهمابتسام الوسلاتي، الهامشية في الأدب التونسي، ص 53.، وصنعت الجماعة من انخراطها الطوعي في الهامشية والتصاقها بالمقهورين لغةً تعبيرية فنية قريبة من الشعب. شكّلَ ذلك إحدى أهم ظواهر التجديد في الأدب التونسي آنذاكمحمد الجلاصي، محمد العريبي، ص 17..
نال العريبي عضوية مجلس تحت السور من خلال قصيدة الملال التي تم ترشيحها بغالبية أربعة أصواتٍ ضد إثنين، ليصبح أصغر جماعة تحت السور سنّاًعلي الدوعاجي. من صميم الحياة تحت السور، الأسبوع 30 حزيران (يونيو) 1946.. كتب العريبي قصيدة الملال سنة 1934 التي يقول في مطلعها: «مللت العقل والدنيا / فهات الكاس واسقينا». لم تُنشر إلا سنة 1935 في العدد التاسع من مجلة العالم الأدبي. قامت حوله ضجة كادت تُلحقه بالطاهر الحداد وأبي القاسم الشابي، لكنه لم يأبه. «كان إذا كاشحوه ضحك لهم وجازف في مبالغات لا تبقي الحيث للفكر أو للدعوة بل توجه للنكتة الأدبية والزراية الكاملة بالحياة وإلى الاستهتار» وفقاً لما كتبه زين العابدين السنوسي في مجلة الندوة، في آذار (مارس) 1935. تحمّست جماعة تحت السور للعريبي ووجدوا فيه البودليري المتوثّب والبوهيمي الجامح. احتفى به الدوعاجي وكتب عنه في جريدته السرور: «بوهيمي طويل القامة، قصير النظر، كثير الذكاء، كثير النشاط، سبيرتيال، تعريب عامّي لكلمة روحاني بالفرنسي، وهو مع ذلك كثير الغرور، كثير الخبث والشذوذ، والأمثلة لذكائه وغروره كثيرة. جرّب نظم الشعر فنجح نجاحاً باهراً، فحاول كتابة القصة وهو لذلك يعدّ نفسه أول قصّاص في الشرق، ويزاحم الأخطل الصغير في السعي إلى إمارة الشعر». بحسب ما ورد في مقالة لعلي الدوعاجي في جريدة السرور، بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 1936.
التاريخ المُلتَبِس لأغنية النقريتا
تُزامِنُ أغلب المراجع بين انضمام العريبي إلى جماعة تحت السور وكتابته لأغنية النقريتا في نفس سنة 1934، منها الشهادات حول محمد التريكي وكتابات بعض مؤرخي الموسيقى، وحتى الجرد الرسمي لرصيد محمد العريبي في النشر. شهدت تلك السنة أيضاً دخول العريبي مجال الصحافة مع أول قصيدةٍ منشورة له بعنوان موت قلب بتاريخ 13 كانون الثاني (يناير) 1934 في مجلة العالم الأدبي لزين العابدين السنوسي. لكن ليس هنالك أي أثر في الصحافة المكتوبة وقتها عن قدوم جوزفين بيكر في السنة نفسها، كما لا يوجد أي أثر لنص النقريتا الذي كتبه محمد العريبي في كل ما نشرته له الصحف وقتها، من الزهرة إلى السردوك والعالم الأدبي والزمان والمسرح والأسبوع والمباحث وصبرة. سبق لِرضا الكشو الإشارة إلى ذلك في بحثه المرجعي الفريد عن محمد العريبي في إحدى أعداد مجلة إيبلا الصادرة سنة 1978، إذ خصّ النقريتا بفقرة كاملة تحدث فيها عن النصوص المنسوبة إلى العريبي والتي لم تنشر، ومثله فعل محمد الجلاصي في كتابه عن محمد العريبي: «للعريبي قصائد نظمها باللغة العامية، وقد يبلغ عددها خمس عشر قطعة كما أشار إلى ذلك البعض من أصدقائه ممن ساهموا في إقامة الحفل التذكاري للعريبي في جانفي 1969، وقد حاولنا الحصول عليها فاتصلنا بدار الإذاعة التونسية فلم يتيسر لنا العثور عليها باعتبار أن التسجيلات المحفوظة بالإذاعة تبتدئ بسنة 1959 وذلك حسب جواب مصلحة البرامج الثقافية. وقد علمنا أن هذه الأزجال توجد كاملة في حوزة السيد الحبيب شيبوب الموظف بإدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية القومية ونرجو أن يريها النور في يوم من الأيام»محمد الجلاصي، محمد العريبي، ص96. شهادة الكفاءة في البحث العلمي، إشراف رياض المرزوقي. 1972..
لو سلّمنا بتلك السنة كتاريخٍ لكتابة نص الأغنية، فمن المرجح القول إن العريبي، الذي أصبح من جماعة تحت السور وقتها واعتزل تديُّنه ودروسه بجامع الزيتونة، قد شارك أصحابه الجُدد نصّه حول جوزفين بيكر، النقريتا، ليصل إلى الموسيقي محمد التريكي الذي لحّنه على الفور وقدّمه لفتحية خيري دون نشره في الجرائد. جرت العادة وقتها أن تنتقل أغلب الأغاني مباشرةً من الشاعر إلى الملحن قبل نشرها حتى لا يختطفها ملحنون آخرون عطشى للنصوص الجديدة، خاصة مع تطور العلاقة الثلاثية بين المغني والشاعر والملحن؛ أساس الشكل الجنيني للأغنية التونسية التي كان لِحبيبة مسيكة الدور الفاعل في بنائها. يعترضنا إشكالٌ أول في ترجيح فرضية التواصل المباشر بين العريبي والتريكي بخصوص نص النقريتا، فالعلاقة المتطورة بين الشاعر والمُلحِّن لا تتولّد إلا بعد تجاربٍ عديدة وإثر ظهور نضجٍ واضح لدى كليهما، والحال أن سنة 1934 التي تشير المراجع إلى أنها موافقة لكتابة العريبي لنص الأغنية، مثّلت بداية العريبي في مجال الصحافة واحتكاكه بمجالس الأدباء والفنانين والموسيقيين، وهو ما يجعل هذا التاريخ قابلا للدحض بقوة.
على صعيد آخر، يمكننا الاستدلال بحادثةٍ منسية قد تكشف لنا عن الغموض الذي يلفُّ نص النقريتا. كانت لدى العريبي عادة غريبة تمثلت في إتلاف بعض آثاره نتيجة نوبات الغضب. يذكر زين العابدين السنوسي في مجلة الندوةمجلة الندوة. العدد 3، آذار (مارس) 1953. أن العريبي ألّفَ رواية نحب نعرّس وهو في السجن، إلا أنه غضب غضباً شديداً من الحبيب شيخ روحه صاحب جريدة الصباح فرمى بها في تنّور الفطائر وأحرقها مغايضةً له. يمكننا التعلّل بأن التطرف الإبداعي للعريبي قد دفعه إلى إتلاف نصوصٍ أخرى غير روايته، مما يفتح باب الفرضيات حول أن يكون لِنص النقريتا مصيرٌ مماثل. لطالما زهدَ جماعة تحت السور بنصوصهم وتغاضوا في كثيرٍ من الأحيان عن حقوق الملكية. اكتشف العريبي، في لقائه مع جلال الدين النقاش وكرباكة لمقاله شعراء الأغاني يتحدثون، خلافهما حول ملكية نص أغنية. كما أن هنالك آثاراً ضائعة لجماعة تحت السور، فالثابت أن الدوعاجي كتب روايةً يتيمة بعنوان شارع الأقدام المخضبة، وجاهد لنشرها غير أنه اصطدم بإجحافاتٍ عديدة. أتت الحرب العالمية الثانية ولم يتبقى من مخطوط الرواية غير صفحتها الأولى التي نشرها عز الدين المدني في كتابه علي الدوعاجي بعد أن حصل عليها من نجيب شقشوق، وهو قريب علي الدوعاجي من الأم، ضمن سلةٍ قماشية فيها خليط من الأوراق التي تركها الدوعاجي. يورد العريبي نفسه عن الدوعاجي أنه كان يمزق جلّ ما يكتبه: «والشيء الذي أعرفه عن الدوعاجي أنه ينظم كل يوم ويمزق ما ينظمه. الدوعاجي ينظم لنفسه، وأحسن قطع الدوعاجي لم يعطها للغناء لأنه يغار عليها»محمد العريبي. شعراء الأغاني يتحدثون، جريدة الزمان، العدد 482 الصادر في 20 كانون الثاني (يناير) 1940..
كتب العريبي معظم الوقت تحت أسماء مستعارة اختارها للتندر، أهمها ابن تومرت – نسبة إلى الداعية الفاطمي ببلاد المغرب الذي ينحدر من نفس مدينة العريبي في الجزائر – والراوي وولد الشيخ، لكنه اختار في أحد أعداد جريدة الزمان – الصادر بتاريخ 8 آذار (مارس) 1941 – اسماً غريباً، الشاذلي الشواشي، لنَسبِ نص أغنية هذي غناية جديدة التي لحنها وغناها الهادي الجويني. لم نعثر على اسم الشواشي لاحقاً في أي نصٍ غنائي أو مقتطف حديثٍ عن تحت السور. يبدو الأمر واضحاً في نص المقال القصير الذي كتبه العريبي نفسه، إذ ذكر أن الشواشي شاعر جديد وغير معروف، واكتشف «بعد بحثٍ أنه من روّاد تحت السور، والحال أن العريبي يعرف حق المعرفة من هم جُلّاس تحت السور وشعرائه، كما أنه من غير المنطقي أن يكتب شاعرٌ نصاً لإحدى أهم الأغاني وقتها دون أن يُعرف أو أن يتخاطف بقية الفنانين نصوصه».
أيّ كان تاريخ كتابة الأغنية وظروفها، أرّخت النقريتا لأثر مرور جوزفين بيكر وكشفت عن أسلوبٍ ظريف وغير مسبوق للعريبي في كتابة الأزجال والأغاني. تكشف النقريتا عن انجذاب العريبي إلى الثقافات الإفريقية الذي ظهر أيضاً من خلال أهم قصصه على الإطلاق، الرماد، التي نُشرت في جريدة المباحث – العدد 10 كانون الثاني (جانفي) 1945 – التي كتبها أثناء سفره إلى الكونغو برازافيل عندما اشتغلَ هناك لفترة، وأصبحت عنواناً لمجموعته القصصية الوحيدة التي صدرت بعد موته. يبدو ذلك الشغف سمةً مميزة لجماعة تحت السور الذين انجذبوا إلى كل ما هو غريب وغير مألوف، ومثّلَ إحدى مظاهر التجديد في الشعر الغنائي آنذاك. فمثلما كان للعريبي النقريتا خاصته التي ألهمته، استلهم الدوعاجي شخصية قلاديمة التي ابتكرها في كتاباته، وهو رجلٌ أسود يتوسط جمعاً من العمال لكنه لا يشاركهم بالعمل بل يغني لهم: «ليس غناؤه هذا بعبث بل هو عمل شريف كعملهم». يذكر أيضاً أن علي الرياحي تغنى بالجمال الأسود في حبيبتي زنجية واستحضر فيها تأثيرات إيقاعية إفريقية.
كانت نهاية العريبي مماثلةً لنمط حياته البوهيمي الساخر، إذ اعتُبِرَ في عداد المنتحرين: «وقد أمضى يوم 24 ديسمبر 1946 في حبور وقضى ليلةً بديعة كما ذكرت عنه صديقته فالنتين التي فارقته في آخر لحظة، ليتم بقية الليلة نائماً. فإذا به يصبح يوم 25 ميتاً مختنقاً بغاز الاستصباح، فقُيّدَ في عِداد المنتحرين ودُفنَ في نفس اليوم بمقبرة بوبيني الإسلامية»زين العابدين السنوسي. ضحايا النبوغ المبكر، محمد العريبي. الندوة، السنة 1، العدد 3، آذار (مارس) 1953.. ضاعت أغلب آثار العريبي، غير مقالاته الصحفية، مثل العديد من رواد تحت السور الذين غيّروا من وجه الموسيقى والأدب منذ الثلاثينات وتشبَّعَ إرثُهم بِحمولة تاريخية قارب أثر البيت جينيرايشون أو «الجيل الضائع»عبارة أطلقتها الكاتبة جرترولد شتاين عن تشكيلة واسعة من الكتاب والمبدعين والفنانين الأميركيين الذين استقروا في باريس إثر الحرب العالمية الأولى. في أميركا الذي انتمت إليه جوزفين بيكر.
بقدر ما كان العريبي بطلاً ملعوناً لِجماعة تحت السور، وبقدر ما تركت زيارات جوزفين بيكر صدىً في مجالات شتى في تونس، شكّلت النقريتا حالةً فريدة وعنواناً ملائما للثلاثينات، إذ جَمعَتْ بين سرديات الاحتفاء والتغييب. تكشف الملابسات المحيطة بتاريخ كتابة النقريتا عن حلقةٍ مفقودة وملتبسة من تاريخ الموسيقى التونسية، شَقّتها تغيرات سياسية كبرى زمن الاستعمار ومعارك فكرية امتدَّ أثرها إلى اليوم. تُعبّر النقريتا – بكل حمولة الالتباس التي رافقتها – عن واقع الثلاثينيات الموسيقي الذي أَسعرته معارك الهوية والشغف بِالغرائبي وتجديد أنماط الشعر الغنائي ومواضيعه، ومثَّلَ الحقبة الزمنية الأهم في فصول التعميد الأولى للأغنية التونسية والمشروع الموسيقي الوليد الذي شهدت شوارع تونس مخاضه الأهم؛ ليس بعيداً عن خَسّة الحلفاوين وباب سويقة، سرّة البلاد.