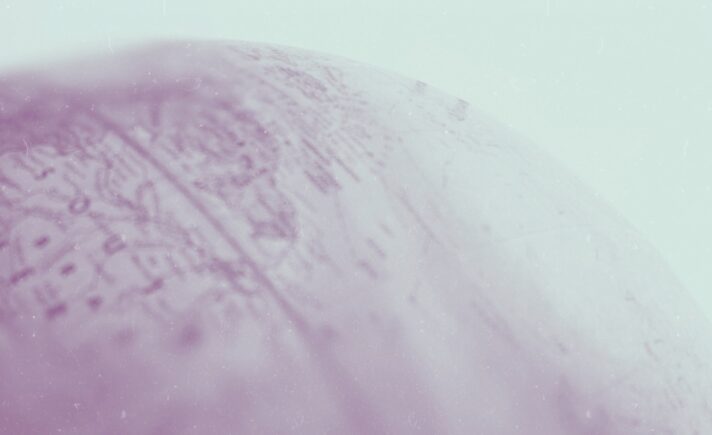الساعة السابعة والنصف صباح يوم العشرين من آذار (مارس) 2003، كنتُ قد استيقظتُ قبلها بقليلٍ. مثلَ ملايين السوريّين، يومها، هرعتُ إلى التلفزيون لكي أتابع تغطية قناة الجزيرة لمجريات الأحداث، إذ كانت نُذُر الحرب على العراق قد بَلَغَت أوجَها قبل ذلك بأيّامٍ، وكانت المسألة مسألة وقتٍ فحسب. تتابعتْ أمامي التقاريرُ على الشاشة، وعلمتُ كيف ابتدأ قبل ذلك بساعتين، وبالتحديد في الساعة الخامسة والنصف فجراً، دويّ القنابل فوق سماء بغداد: لقد ابتدأ الغزو.
ولم يكن قد مرّ على بِدئه سوى ثلاثة أسابيعٍ، حتى تتالت ملامح واضحةٌ لهزيمةٍ مدوّيةٍ لنظام صدّام حسين الذي كان قبل ذلك يبدو وكأنّه لا يسقط. كما امتلأت هذه الأسابيع الثلاثة بالتصريحات الناريّة التي طفحت منها المبالغات الطنّانة لوزير الإعلام العراقيّ يومها، محمّد سعيد الصحّاف، الذي اشتُهر بتعابير «العلوج» و«الطراطير» أو تصريحاتٍ من نمط «إنّهم ينتحرون على أسوار بغداد!» وسواها من المبالغات المضحِكة-المُبكية. أَزِفَت اللحظة-الفصل، لحظة السقوط الرمزيّ والفعليّ للنظام: كانت تلك لحظة إسقاط تمثال صدّام حسين، الذي كان يرمقُ العراقيين بكِبَرٍ واستعلاءٍ من منتصف ميدان الفردوس، بعد ظهر يوم الأربعاء التاسع من نيسان (أبريل) 2003. أسقطته دبّابة أميركيّة بعد أن ربطت رقبته بالجنازير وجرّته إلى الأرض؛ لتدوسه نعال العراقيّين المتجمهرين حولها بغضبٍ وحقدٍ وانتقامٍ من رمزٍ يمثّل ذلك الفرد الذي أطبق حكمه الاستبداديّ الدمويّ على رقابهم، وعلى حاضرهم ومستقبلهم، أربعاً وعشرين سنة. ومع تتابُع هذه المشاهد على الشاشة سرَت رعشة رُعبٍ خفيّةٍ، لكنّها كانت ملموسةً بصورةٍ جليّةٍ، في داخلي. لكنّني شعرت بها في شوارع دمشق، وشوارع باقي مدن وقرى سوريا، وفي أفئدة وأرواح وخواطر الجميع، من ساكن قصر «الربوة» وأركان نظامه إلى أبسط فردٍ في سوريا.
وكان ردُّ الفعل المباشر والعفويّ تماماً لدى غالبيّة السوريّين، بمَن فيهم أطُر المعارضة داخل البلاد وخارجها ساعتها، هو الانكفاء والالتفاف حول مقولات النظام الرسميّة من باب الخوف على المصير والخشية على البلد من مصيرٍ يشبه مصير العراق، الذي كان بدأ يتكشّف أمام الجميع: مصير تَفتُّت المجتمع وتذرّره إلى فئات و«مكوّنات» منقسمة ومتطاحنة ومتصارعة حتى إحراق البلاد والعباد. كانت مقولات النظام، في العموم، تدور في فلك اللغة الشعبويّة البعثيّة الصدئة إيّاها؛ شعارات الصمود والتصدّي والمصير العربيّ المشترك والدفاع عن العرب والعروبة، وما لفّ لفيفها. لكنّ أهمّ المقولات وأكثرها إقناعاً وتوافقاً، كان الدفع بعدم شرعيّة الغزو الأميركيّ للعراق لأنّ فيه «انتهاكاً لسيادة» الدولة العراقيّة.
ولكن، ما الذي تعنيه «السيادة»؟
يأتي المفهوم المعاصر للسيادة من تعبير Sovereignty باللغة الإنكليزيّة، الذي يجد أصوله في الحقّ الممنوح للملك (Sovereign) بالسلطة التامّة على محكوميه في إطار مُلكه. ويعني تعبير السيادة، فيما يخصّ الدول «قدرة الدولة على سنّ القوانين والسيطرة على الموارد دونما إكراهٍ من قبل الدول الأخرى». وقد تطوّرَ هذ المفهوم تاريخياً مع تَطوُّر مفهوم الدولة الوطنيّة في أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشر، مع صلح ويستفاليا بين الممالك والدول الأوروبيّة المتناحرة عام 1648، والذي أرسى للمرّة الأولى مفهوم سيادة الدول بصورةٍ مكتوبةٍ ومُقنّنة. وتباينت النظرة إلى مفهوم السيادة لدى فقهاء القانون الدوليّ، ما بين مفهومَيْن رئيسَيْن؛ أوّلهما هو مفهوم السيادة المُطلَقة الذي يرى في السيادة معياراً وحقّاً مُطلَقاً للدولة، غير قابلٍ للتصرّف وأحاديَّ الاتّجاه: أي أنّ الدولة تمتلكه تجاه مواطنيها، وليس العكس. وبهذا المفهوم، تستطيع الدولة بالمُطلَق سنّ القوانين وتطبيقها بالطريقة التي ترتئيها دون عاصمٍ من قوانين أخرى، أو أعرافٍ أو سوابق قانونيّةٍ أو دستوريّة. وثانيهما هو مفهوم السيادة القانونيّة والواقعيّة، المبنيّ على ضرورة وجود الاعتراف بمؤسّساتٍ قانونيّةٍ تقوم بإنفاذ السيادة ضمن أُطُرٍ محددّةٍ ومحدودة، وعلى ضرورة وجود قدرة فعليّة على أرض الواقع لفعل ذلك (أجهزةٍ بيروقراطيّة وأمنيّة تستقي شرعيّتها وشرعيّة عملها من القانون). وقد تَبنّى ميثاق الأمم المتّحدة (وتحديداً، المادة الثانية، الفقرة السابعة) مبدأ السيادة المطلَقة للدول، من حيث عدم جواز التدخّل، إضافةً إلى «عدم امتلاك الأمم المتحدة أيّ سلطةٍ للتدخّل في الشؤون التي تقع ضمن الولاية القضائيّة المحلّية لأيّ دولة».
على أنّ مفهوم السيادة تعرّض إلى تطوّر لافِت بدأً من سبعينيات القرن الفائت في الجامعات ومجتمعات الفقه القانوني، ثم وَجدَ طريقه إلى منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، فقد ظهرَ توجُّهٌ فقهيٌّ قانونيّ يرى أنّ السيادة مشروطةٌ بسلوك الدول تجاه مواطنيها. وبات هذا السلوك كذلك، بالتالي، قضيّةً محطَّ اهتمامٍ وتدقيقٍ دوليّيْن، يتجسّد عبر المؤسّسات الدولية. أي أنه جرى التحوّل من مبدأ «السيادة كحقٍّ للدولة» إلى «فكرة السيادة كمسؤوليّة». وكان التعبير الأكثر وضوحاً عن هذا التغيير هو اعتماد مبدأ «مسؤوليّة الحماية» من قبل الأمم المتّحدة في القمّة العالميّة عام 2005. وينبني هذا المبدأ على افتراض مسؤوليّة كل دولة في حماية المدنيين كجزءٍ أساسيٍّ من سيادتها القانونيّة، ما يسمح، بالتالي، للمجتمع الدولي بخرق سيادة أي دولة تفشل في تقديم الحماية لمحكوميها (عن عجزٍ أو بصورةٍ عمديّة)، أو تقوم بارتكاب الجرائم عامدةً بحقّهم. ففي البيان الختاميّ للقمّة العالميّة نصّت الفقرة 139 على ضرورة «تَحمُّل المجتمع الدولي […] مسؤوليّة اتّخاذ إجراءات جماعيّةٍ، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة [أي عسكرية، إذا استدعى الأمر]، من خلال مجلس الأمن ووفقاً للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع». وحدّدت هذه الفقرة أنّه يُصبح التزاماً على هذه الدول التدخّل في حالات «الإبادة الجماعيّة»، وجرائم الحرب، والتطهير العرقيّ، والجرائم ضد الإنسانيّة.
«السيادة» بالنكهة الأسديّة: شرعنةٌ للاستبداد!
في المنطقة العربية، ومع نشوء الدول الوطنية على النمط الغربي مع بداية القرن العشرين، اختارت النظم السياسية فيها، خصوصاً مع عهود الاستقلال الوطنيّ عن الاستعمار، مفهومَ السيادة المُطلَقة للدفاع عن استقلالها ومنع التدخُّل الأجنبي في شؤونها. وقد ترافقَ ذلك مع صعود نجم حركات الاستقلال في العالم الثالث، وانتشار الفكر القومي العربي. ولطالما استعادت الأنظمة العربية، وبالتحديد تلك العسكريتاريّة منها ذات الإيديولوجيا القومية الشعبويّة، مفهومَ السيادة المُطلَقة بصورة جامدة وضيّقة، وخصوصاً تلك المنتمية إلى التيار البعثيّ في كلٍ من العراق وسوريا. مفهومَ السيادة المُطلَقة بصورة جامدة وضيّقة.
لطالما حَمَل التدخُّل الأجنبي ذاكرةً بالغة السوء في خاطر الشعوب العربيّة في المنطقة. إذ كان على الدوام يبدأ بوعودٍ بإنقاذ المنطقة وشعوبها من خطرٍ أو أزمةٍ ما، لكنّه سرعان ما يبدأ يتكشّفُ بصفةٍ لا تعدو «غزواً» هو الآخر، غزواً ينتهي إلى أبشع ممّا وعد بتخليص الناس منه. وكان، بالتالي، من السهل استثارة مخاوف الجماهير من أيّ تدخّل خارجيٍّ، وتحديداً من طرف الغرب، خصوصاً مع بدايات عهد الاستقلال والخروج من الاستعمار الغربي المباشر للمنطقة.
فلم يأتِ الوجود الغربي في الشرق، ما بعد انتهاء الاستعمار، إلا بـ حلف بغداد والعدوان الثلاثيّ على مصر، ونزول المارينز على الشواطئ اللبنانيّة، على سبيل المثال. وقد دأبت مصرُ جمال عبد الناصر، عبر ذراعها الإعلاميّة إذاعة صوت العرب، على ترسيخ صورة أيّ تدخّلٍ أجنبيٍّ، حقيقيّاً كان أم مُفتَرضاً، باعتباره تهديداً خطيراً ومُخيفاً. وكان البعث السوريّ الذي أمسك بالسلطة في الثامن من آذار ( مارس) 1963، في محاولته منافسة عبد الناصر على حمل لواء القومية العربية وتثبيت شرعيّة وجوده في السلطة، يسعى على الدوام إلى اعتماد لغة خطابٍ أكثر تشدّداً فيما يخصّ مسألة الشكّ بالخارج وتدخّلاته. وكانت، بالتالي، الإشارة الدائمة إلى «مؤامرات» تُحاك في محاولةٍ لانتقاص «السيادة» ومُغالبة المشروع القومي العربي (الذي يدّعي البعث أنّه هو، ولا سواه، الرائد والقائد فيه)، لازمةً دخلت في الوعي العامّ للسوريين وباتت من مفردات التفكير والوعي الجماعي بصورةٍ شبه عفوية ولا تُساءَل بأيّة صورةٍ جدّية.
لحظة استيلاء حافظ الأسد على زمام السلطة في سوريا في العام 1970، وَجَد بين يدَيْه مجموعة أدواتٍ سلطويّةٍ، إحدى أهمّها ذلك الخطاب البعثيّ الشوفينيّ الشعبويّ الجاهز لتضييق الفضاء العامّ السياسي والإعلامي بحسب مصالح نظامه ومعطياتها في أيّة لحظة. ففي ظلّ السلطة الاستبدادية التي أرساها، أصبح ما تُروِّجُ له وسائل إعلام النظام، المُمسكة بصورةٍ حصريّةٍ بالخطاب العامّ ورسم وعي الناس وتحديد مجال النقاش السياسي وتضييق، هو فحسب المجال «الشرعيَّ» سياسياً. بات أيُّ اتّصالٍ بالخارج بأيّة صورةٍ رديفاً للخيانة، والخيانة واجبة العقاب وتمحو عن صاحبها أيّة حقوقٍ أو حمايةٍ قانونيّةٍ أو سياسيّةٍ، أو مجتمعيّةٍ حتى. كل هذه الممارسات بُنيَت على نسخة متشدّدة من مفهوم «السيادة المُطلَقة» كما ذُكِر سابقاً، نسخة تجعل هذا المفهوم مرتبطاً بشخص رأس النظام والحقّ اللامحدود الذي منحه لنفسه في ثواب أو عقاب أيّ خروجٍ عنه. عنَى ذلك تناقضاً وقع فيه السوريّون من كل الأطياف، حلفاء النظام (على قلّة عددهم، في أحسن الأوقات) أو خصومه: سُحِبت منهم «السيادة» على أبسط شؤونهم، ثمّ استُخدِمَت عصاً غليظةً لضربهم على رؤوسهم حين يشاء النظام حرمانهم من أيّ غطاءٍ تجاه ممارساته القمعيّة المُغرِقة في العنف قبالتهم.
مسألة التدخُّل والسيادة لدى المعارضة: من غزو العراق إلى الثورة السوريّة
حينما ابتدأت نُذُر الغزو الأميركيّ للعراق تتّضح أكثر فأكثر، كانت غالبيّة مواقف المعارَضة السوريّة منه تكاد تتماهى بصورةٍ شبه تامّةٍ مع موقف النظام الأسديّ، مشكّكةٍ في أهدافه ودعاويه ومستحضرةً مسألة «السيادة» كمُبرّرٍ لرفضه. فمثلاً، كتب برهان غليون بعد سقوط النظام في بغداد كيف «أنّه من الصعب على الشعب الذي عانى الأمرّيْن من النظام الديكتاتوريّ العراقيّ أن يتخلّى ببساطةٍ عن سيادته لسلطةٍ أجنبيّةٍ، حتى لو كانت هذه السلطة هي الأداة التي حصلت بها إطاحة النظام العراقيّ». كما وصف في كتابه عطب الذات، المخصّص للتمعّن في مآلات الثورة السوريّة في سنتَيْها الأوليَيْن، كيف كان الترحيب بالتدخّل الأجنبيّ أو التفكير في طلبه هو «ما يُعادِل الكُفرَ في نظر اليسار الماركسيّ والقوميّ الذي كان يسيطر على الساحة السياسيّة». من جهةٍ أخرى، فقد مالَ علي صدر الدين البيانوني، المراقب العامّ الأسبق للإخوان المسلمين في سوريا، إلى التلميح لا التصريح في موقفه من الغزو الأميركي. فعِوضاً عن إدانةٍ صريحة للغزو الأميركي، فضّلَ اعتباره جرس تنبيه للنظام في سوريا حتى يُغيّر طريقة تعاطيه ويقوم «بالإسراع في الإصلاح السياسيّ وعدم إعطاء القوى الأجنبيّة فرصةً للتدخّل في الشأن السوريّ»، لكنّه، وبطريقة الإخوان المعتادة، سرعان ما استشفّ اتّجاه مهبّ الرياح السياسيّة، فقام بعكس الاتّجاه؛ تبنّى موقفاً متطابقاً مع موقف النظام السوريّ تجاه أي نداء داعٍ للتدخّل الدولي في سوريا، بقوله «نحن لا نقبل الاستقواء على الوطن مهما كان».
أمّا ميشيل كيلو، في مقالٍ كتبه على مشارف الغزو في شباط (فبراير)، فقد مال إلى رؤية التدخّل الأميركي في صورةٍ سلبيّة، لكن دون الإدانة الصريحة. فبعد التنبيه من أنّ غزو العراق يؤذِن بفتح صفحةٍ مأساويّةٍ من التاريخ العربيّ، لن تنطوي بسهولةٍ، أردَفَ مُحذِّراً: «أنّنا نحن أيضاً، في سوريّة، مُستهدَفون، وفي حالٍ يُرثى لها». على أنّ المعارِض الوحيد تقريباً الذي خرج عن سرب إدانة الغزو بصورةٍ مُطلَقةٍ (ولكن دون رؤية أيّ جانبٍ إيجابيٍّ فيه) كان رياض الترك، أمين عام الحزب الشيوعيّ السوريّ-المكتب السياسيّ. لم يعارِض الترك الغزو الأميركي للعراق، بل وصرّحَ بأنه رأى فيه احتمالاتٍ لنهوضٍ مقبلٍ، إذ إنّ إسقاط نظام صدّام حسين أسهم في «رفع العراق من تحت الصفر [وإيصاله] إلى نقطة الصفر». وقد فتح عليه هذا التصريح بالذات أبواب إداناتٍ وشجبٍ كثيرة، ومن شتّى الاتّجاهات، في وقتها.
ولكن ذلك كان في العام 2003، فمع حلول العام 2012، وبعد التداعيات المتتالية لازدياد عنف «الحلّ الأمنيّ» الذي اختار النظامُ أن يتّبعه في مواجهة ثورة السوريين عليه، ظهر تغيّرٌ ملفتٌ على الموقف من موضوع التدخُّل الخارجي؛ وبالتالي، في كيفيّة نظر كثيرٍ من السوريين، بمَن فيهم قيادات في المعارَضة، إلى مفهوم السيادة. فلم يَعُد البيانوني، على سبيل المثال، يرى أيّ غضاضةٍ في الدعوة إلى الحماية الدوليّة، بل وحتى في مطالبة المجتمع الدولي «بأن يتحمّل مسؤوليته في حماية المدنيين» تجاه «حرب الإبادة» التي يتعرّضُ لها السوريّون. وأمّا برهان غليون، فقد انتقل بسرعةٍ لافتةٍ من حذره البالغ من التدخّل الأجنبي إلى المُطالَبة، بعد مرور تسعة شهورٍ على بداية الثورة وبوضوحٍ لا لبس فيه، بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن وطلب «تدخّلٍ دوليٍّ عاجلٍ لوقف القمع الوحشي والإجرامي بحقّ الشعب السوريّ». كذلك الأمر، كان موقف رياض الترك إيجابيّاً تجاه تدخّلٍ دوليٍّ في سوريا، مع بدايات الثورة، على أنّ موقفه هذا تَغيَّرَ في مراجعةٍ مع الذات، بعد ذلك بسنوات. هذا الموقف لم يكن واحداً لدى كافّة قيادات المعارَضة، ففيها مَن وقف متوجسّاً من مسألة التدخّل الدولي، مثَل ميشيل كيلو الذي قال مبكّراً، في أول أشهر الثورة، إنّه «ضد أيّ تدخل عسكري أجنبي في سوريا». كما كان جزءٌ ليس باليسير من قيادات «معارَضة الداخل»، أي من الذين كان النظام يتساهل بعض الشيء مع نشاطهم السياسي المحدود للغاية، كمثَل لؤي حسين رئيس ما سُمّي «تيّار بناء الدولة»، حيث صرّح الأخير عن إيمانه بإمكانيّة، بل وضرورة، مقارَعة «السلطة المستبدّة» ورفض التدخّل الأجنبي في اللحظة نفسها.
على أنّ الجهة الأكثر تشدّداً في هذا الصدد كانت «هيئة التنسيق»، التي اعتُبِرَت الجهة الأبرز بين جهات وشخصيّات «مُعارَضة الداخل». فقد انطلق عملها ببرنامجٍ تضمّنَ لااءتٍ ثلاثة، وُضِعَت كشرطٍ منها لأيّ حراكٍ ضدّ النظام الأسديّ، ألا وهي: «لا للتدخُّل العسكري الأجنبي، لا للتجييش الطائفيّ والمذهبيّ، ولا للعنف وعسكرة الثورة». قد يبدو من المُستغرَب، بل ومن المُستهجَن حتى، قيام جهةٍ معارِضةٍ بفرض شروطٍ على حراكٍ شعبيٍّ، بدلاً من فعل ذلك تجاه النظام السياسيّ. لكنّ تقديري هو أنّ هذه الهيئات والشخصيّات، التي كانت تعمل تحت ظلّ هيمنة النظام على الفضاء العامّ، وخصوصاً في الجوّ الأمنيّ الرهيب الذي ازدادت سطوته مع صعود الثورة، كانت تتصرّف من وحي «سدّ الثغرات» قبالة النظام وحملاته الإعلاميّة التخوينيّة التي تهدف إلى تشويه سمعة كلّ مَن لا يروق له، وإخراجهم من اللعبة السياسيّة بالكامل. فالنظام هو الذي يفرض شروط ما هو مقبولٌ قوله وفعله، ما هو «وطنيّ» وما هو «خيانة». ومن ضمنه تقديس «السيادة» وتحريم المساس بها، وبحسب ما يرسمه النظام من مُحدِّداتٍ، لا بحسب أيّ إجماعٍ وطنيٍّ فعليّ.
على أنّ هذه المواقف بمُجملها لم تكن بالضرورة تعكس تَوجُّه القوى الثوريّة الفاعلة على الأرض، أو واقع مطالبها واحتياجاتها. فهذه القوى هي التي كانت تقف عزلاء من أيّ وسائل حماية قانونية أو سياسية أو أمنية أمام النظام، وهي التي كانت «تأكل العصيّ» ولا تَعدُّها فحسب. وحينما تمّ توقيع اتّفاق القاهرة للمعارَضة السوريّة مع مطلع العام 2012، خرجَ بصيغة توفيقيّة هدفت إلى تجميع قوى المُعارَضة السياسية وتوحيد جهودها، بين «خارج» و«داخل». لكنّ هذا أثار حفيظة «الهيئة العامّة للثورة السوريّة»، التي قرّعت المجتمعين في القاهرة، وبالخصوص «المجلس الوطنيّ»، على هذه الصيغة مُنبّهةً بأنه «لو وصلت الأمور الى حدٍّ سيءٍّ جداً من المذابح اليوميّة مع تخاذل المجتمع الدوليّ عن إقامة القانون الدوليّ، فانّ الشعب السوريّ متمثّلاً بثوّاره هو من يقرّر ضرورة تدخّلٍ فرديٍّ من إحدى الدول العربيّة أو غيرها لحماية الشعب السوريّ».
السيادة والتدخُّل الأجنبي: ما بين «درس» العراق و«فرصة» ليبيا؟
إذاً، فقد تضافرَ تاريخٌ من ذاكرة سيّئة مع تجارب التدخّلات الأجنبية، وانتشار مفهومٍ ضيّقٍ لـ«السيادة» رافقَ عهود الاستقلال وحركات التحرُّر الوطنية وانتشار الفكر القومي العربي، واستيلاء السلطة في سوريا على هذا المفهوم واستخدامه سلاحاً لتثبيت هيمنتها على المحكومين وشرعنة استبدادها؛ تضافرت هذه الظروف جميعها على رسم صورة الوعي العامّ لدى السوريّين فيما يتعلّق بمفهوم «السيادة». ثمّ جاء غزو العراق في العام 2003، وما رافقه من مشاهد تَفسُّخ المجتمع العراقيّ وانهيار روابطه المدنيّة وانحلالها إلى مجموعةٍ من الارتباطات الما-قبل وطنيّة، عشائريّة ومناطقيّة، والأكثر خطراً: طائفيّة. كانت الصورة مُخيفةً ومرعبة، خصوصاً للمجتمع السوري الذي كان يعي دقّة الوضع الطائفيّ والعشائريّ والمناطقيّ في سوريا، وسهولة انحدار الأمور إلى منزلقات عنيفة ومُدمّرة؛ بالإضافة إلى إدراك السوريين لمدى دمويّة النظام ووحشيّته.
ليس من سوريّ واحد لم يشهد بأمّ العين أخبار دوّامات القتل والتدمير في العراق، أو لم يتعاطَ أو يمرّ باللاجئين العراقيين الذين بلغ عددهم في سوريا ما بين 800 ألفٍ ومليونٍ وستمائة ألفٍ، بحسب التقديرات. ارتبطت كلّ هذه النتائج بفكرةٍ عمّت بين السوريّين، مفادُها بأنّ كلّ ما حصل في العراق وللعراقيّين كان سببه التدخّل الأجنبيّ الذي حرَّكَ كل العفاريت الهاجعة، بالكاد، قبل حضوره. فزاد ذلك من مخاوف السوريّين وحرّكَ فيهم هواجس الحذر من دفع الأمور إلى مرحلةٍ يمكن أن تدخل فيها البلاد في قبضة التدخُّل الأجنبي ومآلاته. وما النقاشات التي طفَت على سطح الحياة العامّة في سوريا، مع بداية الثورة، ما بين تأييدٍ للتدخّل العسكري للإطاحة بنظام بشّار الأسد على غرار الإطاحة بنظام صدّام حسين؛ وما بين رفضه كما رأينا أعلاه؛ إلّا تجلّيات للأثر العميق الذي تركته التجربة العراقيّة على الوعي العامّ للسوريين.
لكنّ «درساً» آخَر كان قد أسهم في تغيير شدّة هذا الرفض: التدخّل الدوليّ في ليبيا، بعد أن دعت جامعة الدول العربية إلى إقامة منطقة حظر جوّي فوق البلاد، الذي شكّلَ واحداً من أبرز تجلّيات مبدأ «مسؤوليّة الحماية» والمتجسّد في قرار مجلس الأمن رقم 1973 ضدّ نظام معمّر القذّافي. فقد بدا في لحظتها وكأنّه يُظهِر إرادةً دوليّةً جديدةً، مبنيّة على إعانة الشعوب في إزالة أنظمة الاستبداد التي تمارس العنف ضدّها، دون الدخول في غزوٍ أو تواجدٍ عسكريٍّ مديدٍ وما ينتج عنه من سلبيّاتٍ ظهرت بفجاجةٍ في المثال العراقيّ. بدا من الممكن، إذاً، وجود مسوّغاتٍ لطلب التدخّل الدوليّ بوصفه تصرّفاً حِمائيّاً. وسرعان ما منح العنف المفرِط الذي ولجَ فيه النظام قبالة تظاهرات السوريّين السلميّة، وتصعيده التدريجيّ باتّجاه خوض حربٍ شاملةٍ على المجتمع السوريّ، دافعاً أكثر قوّةً نحو تبنّي مَطلب التدخُّل الدولي لحماية المدنيين في سوريا، وتجسّد ذلك في تسمية مظاهرات «جمعة الحماية الدوليّة» في التاسع من أيلول (سبتمبر) 2011. على أنّ تَصاعُد دمويّة تعاطي النظام وإيغاله في التوحّش مع تنامي الثورة السوريّة ضدّه، كان كفيلاً برفع كافة التحفّظات السابقة عن طلب المعونة والتدخّل الأجنبي والدولي للحماية من بطش النظام غير المسبوق: فمع فتح النظام باب الجريمة الكبرى باستخدام السلاح الكيماويّ في الغوطة في صيف العام 2013، تزايدت مطالبات الثوّار السوريين بتدخّلٍ دوليٍّ يردع نظام الأسد على أقلّ تقديرٍ، أو يقتلعه، على أقصى تقدير عقاباً على هذا التجاسر. على أنّ التناقض في المواقف في المستوى السياسيّ للمُعارَضة بين الداخل والخارج بقي سيّد الموقف: ففي حين اكتفت «هيئة التنسيق» بطلب إرسال مراقبين دوليّين لكي «يتمّ تحديد هويّة المسؤول» عن هذا الهجوم، طالَبَ «الائتلاف الوطنيّ» المجتمع الدوليّ بـ«عقد جلسةٍ لمجلس الأمن لتحمّل مسؤوليّاته».
واليوم، في الذكرى العشرين لغزو العراق، لا نزال نجد أنفسنا كسوريّين عالقين. لانزال عالقين ما بين مفهوم السيادة المُطلَقة لدولٍ لا تجد تعبيراً لها إلّا في استفراد النُظم القمعيّة بالدَوْس على مصائر شعوبها؛ و«التدخّل» الأجنبيّ الذي لا يُقيم وزناً لإرادات هذه الشعوب، بل ويودي بها إلى مصائر أسوأ مما كانت فيه قبل وقوعه: تَفتّتٌ وتشرذمٌ في بُنى المجتمعات، عنفٌ مُنفلت العِقال، واقتلاعٌ من المكان بالنزوح واللجوء في المحيط القريب أو البعيد.