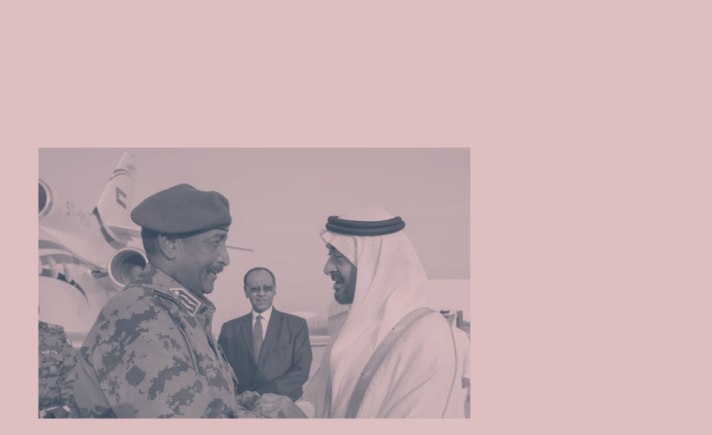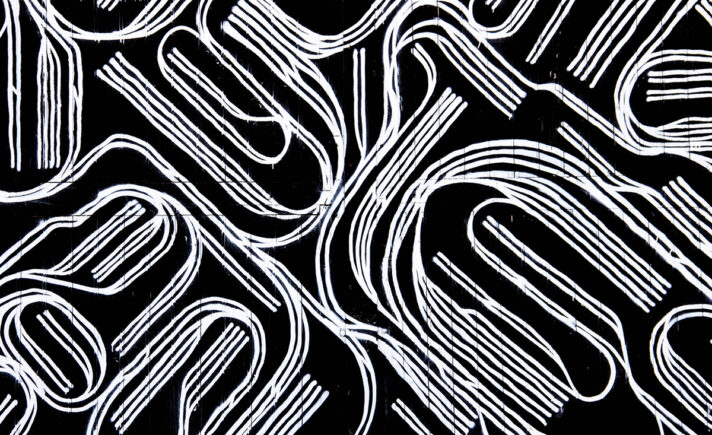تَشهدُ المنطقة العربية كثيراً من مظاهر العنف، خصوصاً في العقد الماضي. كذلك تشهدُ دولٌ ديمقراطية فصولاً من العنف على نحو ما نرى في شوارع فرنسا مثلاً من وقت إلى آخر. تترابط مظاهر العنف في العالم وتتشابك إلى حدّ التماهي، تختلف في أشكالها وآثارها، على أنها في نهاية المطاف تستهدف جهة وحيدة؛ الإنسان، ككائن يعيش في مجتمع ظنَّ يوماً أنه سيكون أفضل من حالة الطبيعة السابقة، وأنَّ حالة العنف المُنفلت سوف تصلُ إلى نهايتها بمجرد تأسيس الدولة بشكلها الحديث. ليس هذا حالنا اليوم، حتى في الدول الديمقراطية.
سأحاولُ في هذا المقال إبراز بعض مظاهر العنف في الدول الديمقراطية من خلال الحالة الفرنسية، مُفترِضاً أن مؤسسة الدولة القادرة على حفظ الحقوق والحريات، في سعيها الدائم للحفاظ على الأمن وتطبيق القانون، تُمارسُ عنفاً يكلِّف الناس حيواتهم. هذا العنف يولّد ردَّ فعل مقابل، عنيف وقاتل أيضاً، من جهة الخاضعين لسلطة الدولة، إلا أن الأخيرة تبقى صاحبة اليد العليا في ممارسة العنف، وتتخِّذُ مُمارستَه اليوم كجزء من شرعية وجودها.
حفظ الكرامة الإنسانية؛ الدولة كمؤسسة
في عام 1977، شغلَتْ قضية باتريك هنري الرأي العام الفرنسي على نحو واسع. هنري هو قاتلٌ لطفل بعمر السبع سنوات، أُلقيَ القبض عليه وخضع للمحاكمة من قبل لجنة قضاة مؤلفة من اثني عشر قاضياً، طالب الشارع الفرنسي حينها بتطبيق عقوبة الإعدام ضد المجرم، حتى أن ميشيل بونياتوفسكي، وزير الداخلية في ذلك الوقت، صرّحَ أنه لو كان ضمن لجنة القضاة فإنه سوف يُقرُّ عقوبة الإعدام. جاء قرار المحكمة صادماً، إذا حَكَمَ القضاة على باتريك هنري بالسجن المؤبد، وذلك بفضل محامٍ شاب استطاع إقناع القُضاة الاثني عشر باختيار السجن المؤبد على الإعدام. بعد أربع سنوات على هذه القضية، وفي 9 تشرين الأول (أكتوبر) 1981، ألغت فرنسا بشكل نهائي عقوبة الإعدام، بفضل مشروع قرار قدّمه وزير العدل في تلك الفترة روبرت بادنتير، المحامي الشاب في قضية باتريك هنري نفسه.
في نص بديع لألبير كامو؛ تفكير حول المقصلة المنشور عام 1957، يُناقش الكاتب سبب رفضه لعقوبة الإعدام في فرنسا، على اعتبار أن تطبيق المقصلة على المجرمين في الساحات العامة لم يُسجِّل انخفاضاً في عدد مرتكبي الجرائم، ناهيك عن انتقال مكان التنفيذ إلى أقبية السجون؛ ما يُشير إلى فظاعة حكم التنفيذ من جهة، وفقدان عقوبة الإعدام جدواها الاجتماعية في ردع المجرمين المستقبليين من جهة أخرى. على المستوى الإنساني، فإن قتل القاتل لا يُضيف للمجتمع سوى ضحية أخرى، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار بشاعة بعض الجرائم ومدى وحشية مرتكبيها، يرى كامو أن السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة يُعَدُّ بديلاً مناسباً للإعدام. تُعتبر عقوبة الإعدام بمثابة طريق باتجاه واحد، إذ لا يمكن العودة عنها في حال ثبتت براءة المُدان بعد تنفيذ الحكم. لهذا يقول كامو في سياق حديثه عن السجن المؤبد: «لأولئك الذين يرَون أن هذه العقوبة أشدُّ من عقوبة الإعدام…. سنذكرهم أيضاً أن الأشغال الشاقة تترك للمحكوم إمكانية اختيار الموت، في حين أن المقصلة لا تفتح أي طريق للعودة»، ويُضيف لأصحاب الرأي الآخر: «لأولئك الذين يرَون، على العكس، أن الأشغال الشاقة هي عقوبة أخف، سنردُّ أولاً أنهم يفتقدون للخيال، ومن ثَمَّ أنَّ تقييد الحرية تبدو لهم كعقوبة خفيفة فقط لكون المجتمع المعاصر علّمنا ازدراء الحرية».Alber Camus, Réflexion sur la guillotine, folioplus philosophie, avec dossier et notes réalisés par Marc-Henri Arfeux.2008. P.20-P.59-60. (للكِتاب ترجمة عربية لجورج طرابيشي تحت عنوان المقصلة، صدرت طبعتها الأولى عن دار المدى في 2017). فكرة السجن في حدِّ ذاتها رهيبة جداً، تقييد حرية الإنسان، في مساحة ضيقة أو واسعة في داخل غرفة أو في مجتمع بأكمله، لا فرق، فهي تبقى فكرة مرعبة في حدِّ ذاتها. لكن سنركز هنا على عقوبة الإعدام لأن تقرير موت إنسان من قبل فرد (قاتل) أو مؤسسة (دولة) هي جريمة بحق الإنسانية، إذ ليس لأي إنسان على وجه الأرض الحق في تقرير إنهاء حياة شخص آخر تحت أي مسمى قانوني أو عرفي (لجرائم الشرف تاريخ حافل حول تشريع القتل بسلطة رجال العائلة). في فرنسا، يُعَدُّ إلغاء عقوبة الإعدام مثالاً على دور مؤسسات الدولة التشريعية في السعي لحماية الكرامة الإنسانية، على اعتبار أن أكثر من نصف الفرنسيين في ذلك الوقت كانوا ضد إلغاء عقوبة الإعدام، لكن مجلس النواب الفرنسي استطاع تمرير القرار دون أن يواجه اعتراضات شعبية. يَعتبر المجلس الأوروبي اليوم أن عقوبة الإعدام انتهاكٌ صارخ لحقوق الإنسان.

لكن السؤال الأهم هنا، هل يقتصرُ إلغاء حُكم الإعدام على الكفِّ عن استخدام المِقصلة، أم يمتد ليشمل كل ما تتخذه الدولة من قرارات أو ما تُحجِم عن اتخاذه، والذي قد يودي بشكل أو بآخر بحياة الإنسان؟ من خلال المثال الفرنسي أيضاً، سأحاولُ تسليط الضوء على موضوعين اثنين لمُساءلة عنف الدول الديمقراطية.
الحرمان من الحقوق؛ عنف إداري؟
بعد تجاوز المسار الإداري «البيروقراطي» لطالب اللجوء في فرنسا، نصلُ إلى لحظة دراسة الملف، والمسؤول الرئيسي هنا هو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA). تَعتمدُ دراسةُ الملف أولاً على تبيان مدى تَوافُق قصة طالب اللجوء مع بنود اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، وفي حال لم تنطبق شروطها على قصة مقدم الطلب، تنتقل دراسة الملف إلى الحماية الفرعية التي تخضع لقوانين الدولة المُستقبِلة مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية جنيف أيضاً. في الحالة الثانية أو في حالة رفض الملف، لطالبِ اللجوء الحقُّ في الاعتراض على قرار المكتب الفرنسي (OFPRA) أمام المحكمة الوطنية لقانون اللجوء (CNDA).
على أن لاتفاقية جنيف لحماية اللاجئين بعض الاستثناءات التي تستبعد فيها حماية طالبي اللجوء، إذ تُشير إلى أن «أحكام هذه الاتفاقية لا يتم تطبيقها على الأفراد التي يكون لدينا أسباب محقة للاعتقاد: 1ـ أنهم ارتكبوا جريمة ضد السلام، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المُستخدم لهذه الجرائم في الاتفاقيات الدولية؛ 2ـ أنهم ارتكبوا جريمة جسيمة خارج الدولة المُستقبِلة قبل منحهم حقَّ اللجوء؛ 3ـ ارتكابهم أفعالاً تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة».الاتفاقية المتعلقة بشؤون اللاجئين.
على اعتبار أن اتفاقية جنيف المتعلّقة بشؤون اللاجئين تعود لعام 1951، أي قبل سنوات من إلغاء حُكم الإعدام في أغلب الدول الأوروبية، فهي تُغفل مصير المستبعدين من الحماية في حال تَعرُّض حياتهم للخطر إثر عودتهم إلى بلدهم الأصل؛ فما مصير من تتوفّر فيهم إحدى الشروط الثلاث الأخيرة ولكنهم مُهدَّدون بالموت إذا ما تم إرسالهم للبلد الذي هربوا منه؟
في هذه الحالة تتم دراسة الملف بشكل طبيعي، بمعنى يُمنح حق اللجوء أو الحماية الفرعية (في حالة تحقيقه لشروط الحماية)، ولكنه يُستبعَد من التمتع بهذه الحق بسبب الاعتقاد بارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة أعلاه، أي أنه يحق له البقاء على أرض الدولة المستقبلة دون التمتع بأية حقوق مدنية (الحق في العمل، الحق في التنقل، الحق في التأمين الصحي…). حرفياً يُسمح للشخص بالبقاء، لكن على هامش المجتمع بشكل تام. يجب التنويه هنا إلى أن (OFPRA) هي جهاز إداري يتبعُ لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنّ محكمة اللجوء (CNDA) هي محكمة إدارية أيضاً تَتبعُ لمجلس الدولة لشؤون القضاء الإداري، بمعنى أنَّ الجهازين المعنيين بدراسة ملف اللجوء لا يملكان صلاحيات لتجريم طالب اللجوء في حال اشتباههم بارتكابه إحدى الجرائم، لكن يحقُّ لهما استبعاده من حق اللجوء. إن هذه الحالة لا تَحرمُ الفرد من حق السعي إلى الحصول على إقامة من محافظة المدينة لأسباب أخرى، بحسب شروط قانون دخول واستقرار الأجانب وقانون اللجوء (CESEDA)، كالزواج من مواطن أو العمل أو لأسباب صحية على سبيل المثال، لكن يحق لإدارة المحافظة رفض طلبه للإقامة بالاستناد إلى قرار محكمة اللجوء باستبعاده، أي بسبب «الاعتقاد» بارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة في اتفاقية جنيف. عندما تُستَنفذ الفرص القانونية، سيَستمرُ الشخص بالعيش في حالة من محاولة البقاء على قيد الحياة. في هذا الوضع، يموت الشخص اجتماعياً ومعنوياً. يجد نفسه في الشارع، أو تحت الجسور، في الأقبية، على مداخل الأبنية. بتعبير آخر،Christiane GENET-BENSAÏD, « les sans-papiers », dans Victimes du présent, victimes du passé, vers la sociologie des victimes, L’Harmattan, 2004, P.83-84. يصبح الفرد في حالة تشرُد، لا يملك سوى السوق السوداء للحصول على عمل، ولا يستطيع استئجار غرفة أو التنقل بين الدول الأوروبية أو الحصول على خدمات صحية لعدم امتلاكه أوراق إقامة. يعيش على هامش المجتمع حرفياً، وهذا التهميش يمحو هوية الفرد، يجعله غير مرئي تماماً. عَرّفَ المرصد الوطني الفرنسي للفقر والاستبعاد الاجتماعي في العام 2016 اللامرئية الاجتماعية بأنها: «مجموعة الإجراءات التي يتدخل بها فاعلون متعددون، والتي من خلالها يمكن أن يؤثر إنكار الاعتراف بالوجود الاجتماعي للأشخاص، على مختلف المستويات، إلى تعميق وإطالة وتطوير أوضاع الفقر والاستبعاد».Élise Plessis, (Du déni de reconnaissance à l’invisibilité sociale : faire œuvre dans l’exil), dans Exil et violence politique, les paradoxes de l’oubli, Centre Primo Levi, érès éditions, 2019, P.125.
في جلسة لمحكمة اللجوء الفرنسية، تسألُ القاضية ضابطاً سورياً منشقّاً كيف يُمضي أيامه، وإذا ما كان يشعر بمسؤولية حيال مئات المدنيين الذين قُتلوا بطائرات ثكنته العسكرية، وإذا كان مُرتاح الضمير بصورة عامة؟ أجاب الضابط أن يديه نظيفتان تماماً، وبأنه لا يشعر بأي مسؤولية حيال الجرائم التي ارتُكبت. الضابط ذاته كان يخدم في مطار عسكري في الشمال السوري، كانت مهمته التأكد من جاهزية الطائرات التامة للإقلاع محمّلة بالقذائف، بشكل أكثر دقة، كان مسؤولاً عن كهربائية الطائرات العسكرية. المطار المذكور مسؤولٌ عن قصف مدينة حلب وقتل مئات المدنيين بين نهاية عام 2012 وبداية عام 2013. كان الضابط يُركّز على صعوبة الانشقاق في تلك الفترة، وأنه كان يخشى على عائلته من خطر انشقاقه، تجرأت القاضية وسألته: «إذا كنت تعلم بأن هذه الطائرات ذاهبةٌ لقصف المدنيين، ألم تفكر بالتضحية بنفسك ورفض الخضوع للأوامر على اعتبارك فرداً واحداً في مقابل مئات قُتِلوا بقذائف الطائرات؟». أعاد الضابط روايته ذاتها، أنه كان يخشى على زوجته وأطفاله من تبعات انشقاقه، لكن كيف لقاضية في محكمة لجوء أن تسأل شخصاً يطلب الحماية من الموت عن سبب عدم تضحيته بنفسه؟
يعيش هذا الضابط اليوم حالة اللامرئية الاجتماعية التي تحدثنا عنها أعلاه، إذا تم استبعاده من حق اللجوء مع السماح له بالبقاء على أراضي الدولة. هناك آلاف الحالات المماثلة لأشخاص يعيشون على هامش المجتمع الفرنسي، دون حقوق، دون عمل، ودون ضمان صحي. اختَرتُ الحالة الأكثر تحدياً «لديمقراطيتنا» الداخلية، عندما نسأل أنفسنا عن مدى قُدرتنا على الدفاع عن حقوق الآخرين حتى ولو كانوا جلّادينا أنفسهم، فهل علينا حقاً أن نكون جلّادين في محاسبة الجلّاد؟ وإذا كان طريقُ العدالة معبَّداً بالجلّادين، كيف نحمي أنفسنا ونحمي الضحايا من التحوُّل إلى جلّادي المستقبل. هنا، يُطرح سؤال العنف كوسيلة لتحقيق غايات أصيلة لمستخدميه، نتيجة ما يكونون قد عايشوه من رعب وخوف على مر السنوات. على أن من يَستخدم هذا العنف هنا هو دولة يُسجِّلُ إلغاء حكم الإعدام فيها قرابة النصف قرن. في مقالها (من إنكار الاعتراف إلى اللامرئية الاجتماعية: أن توجد في المنفى) تُشير إيليس بليسي، وهي مساعدة اجتماعية في مركز بريمو ليفي في باريس، في سياق حديثها عن إجراءات اللجوء في فرنسا، والتي تُشبّهها بإجراءات عدم الاعتراف (non-reconnaissance)، إلى أن: «الاعتراف بالفرد من عدمه لا يتم إلا من خلال شرعية إدارية ممنوحة أو لا… فالتواجدُ كإنسان سيتوقف على حقيقة القبول… إجراءات الاعتراف تُظهر الكائن الإنساني، تجعله مرئياً، هو وحياته الاجتماعية كذلك».Ibid. P.124. في دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن اليوم، هناك مئاتُ الأشخاص من دون أوراق، من دون اعتراف اجتماعي بوجودهم، مُهمَّشون على كافة الصعد، يحاولون البقاء على قيد الحياة، لكن كثيراً ما تفشل محاولاتهم.
أحداث سان سولين والمادة 49.3 من الدستور؛ عنف ديمقراطي؟
عَرَضَت الحكومة الفرنسية في كانون الثاني (يناير) الماضي مشروعاً لمُستقبل نظام التقاعد الفرنسي، والذي من خلاله سيتُم رفع سن التقاعد في فرنسا بشكل تدريجي من 62 سنة إلى 64 سنة. يعني هذا أنه في الأول من أيلول (سبتمبر) لسنة 2023 سيتم زيادة 3 أشهر لكل سنة ميلادية، ليصل في سنة 2027 (نهاية الولاية الرئاسية في فرنسا) إلى 63 سنة وثلاثة أشهر، وبعد ثلاث سنوات في عام 2030 يصل القانون إلى مبتغاه، أي 64 سنة.من أجل مستقبل نظامنا التقاعدي، وزارة العمل الفرنسية، أخر زيارة للموقع 30/03/2023. في تفاصيل مشروع القرار وبالمقارنة مع الدول المجاورة لفرنسا، يبدو المشروع كخطوة بديهية من قبل الحكومة الفرنسية، على اعتبار أن سنَّ التقاعد في ألمانيا هو 67 عاماً، وفي بلجيكا سيصل سن التقاعد فيها الى 66 عاماً سنة 2025 بعد مشروع القرار المقترح في 2014. هكذا يبدو الأمر لمراقب خارجي، يرى أنه يصعب إرضاء الفرنسيين، لكن الواقع عكس ذلك تماماً، فإذا كان تعديل قانون التقاعد محقاٍ في حالة اجتماعية مستقرة، فإن مشروع القانون الجديد يأتي كمكمل لسياسة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الحالي منذ العام 2017، والتي تركز على محاباة الأغنياء أكثر من دعم الفئات الأقل ضعفاً. بالإضافة إلى أنّ القانون يأتي في ظل أزمة اقتصادية عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا، التي تسببت بارتفاع الأسعار، فمعدل التضخم في فرنسا وصل إلى 5.2 بالمئة في سنة 2022، مقابل 2.1 بالمئة سنة 2011.بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا.
بعد طرح الحكومة لمشروع القرار، دعت كافة النقابات في فرنسا إلى الإضراب العام والنزول للشوارع في رد على قرار الحكومة لتعديل نظام التقاعد. في أول يوم للإضراب، الذي كان في 19 كانون الثاني (يناير)، وصل عدد المتظاهرين في عموم فرنسا إلى 2 مليون شخص منهم 400 ألف في باريس فقط بحسب ما صرّحت به النقابات، على أن وزير الداخلية تحدث عن مليون واثني عشر ألفاً من المتظاهرين في كافة المدن الفرنسية، منهم ثمانون ألفاً في باريس. تتفاوت أعداد المضربين عن العمل بين القطاع العام والخاص، على أن نسبة الإضراب في شركة الكهرباء على سبيل المثال وصلت إلى 44.5 بالمئة، وفي المؤسسة العامة للسكك الحديدية الفرنسية وصلت حتى 46 بالمئة. استمرت الإضرابات في مختلف القطاعات، حتى أن الاحتجاجات تراوحت بين حركات طلابية تبدأ من تعطيل استمرارية الدوام الجامعي في مباني الكليات، إلى النزول إلى الشوارع لمختلف الفئات الاجتماعية، دفاعاً عن مستقبل بات مهدداً في ظل سياسة الحكومة الحالية. يجب التنويه إلى أن الحكومة الحالية برئاسة إليزابيث بورن لا تملك أغلبية برلمانية، أي أنها غير قادرة على تمرير مشاريع قوانين في مجلس النواب إلا في حالتين اثنتين: الأولى هي إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى بهدف تمرير مشاريع القوانين الجديدة، وهذا ما لا تستطيع الحكومة الحصول عليه بسهولة كونها مكروهة من قبل اليمين واليسار على حد سواء؛ الحالة الثانية هي اللجوء إلى المادة الدستورية رقم 49.3، وهي مادة تمنح الحكومة القدرة على «التمرير بالقوة» لمشاريع القوانين دون إخضاعها لتصويت مجلس النواب. الهدف الأساسي لهذه المادة عدم تعطيل أعمال الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالموازنة السنوية التي تحتاج موافقة مجلس النواب. {بعد المراجعة الدستورية لعام 2008، فإن استخدام المادة 49.3 حُدِّدَ بنص قانوني واحد لكل جلسة برلمانية، باستثناء مشاريع القوانين المالية، وتمويل الضمان الاجتماعي، والتي تستطيع الحكومة اللجوء فيها إلى المادة ذاتها دون قيود}.بحسب اللوموند، آخر زيارة للموقع 07/04/2023. تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة الحالية لجأت إلى هذه المادة إحدى عشر مرة منذ توليها زمام الأمور في السادس عشر من أيار (مايو) 2022، وبهذا تُعَدُّ حكومة إليزابيث بورن ثاني أكثر حكومة فرنسية بعد حكومة ميشيل روكار بين عامي (1988ـ1991) تلجأ إلى المادة 49.3 منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958.
مع بداية الإضرابات، شهدت العديد من المظاهرات مواجهات عنيفة مع رجال الشرطة، ما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين. خلال هذه المظاهرات المتعلقة بقانون التقاعد، تظهر أزمة أخرى تؤجِّج الاحتجاجات في فرنسا، وهي قضية سان ـ سولين، البلدية الريفية في وسط غربي فرنسا والتابعة لمحافظة دو سيرف، التي وقعت أحداثها على إثر قيام الدولة ببناء ما يشبه البحيرة الصناعية (تستوعب من المياه ما يعادل 260 حوض سباحة أولمبي)، الغرض منها ضخ المياه الجوفية في البحيرة وتخزينها في الهواء الطلق بهدف مواجهة موجات الجفاف في الصيف. في الخامس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي، خرجت مظاهرة في المدينة دعا إليها ناشطون وجمعيات لحماية البيئة رفضاً لما أسموه (خصخصة المياه) التي هي ملكٌ للجميع، بالإضافة إلى أن مشروع البحيرة الصناعية أو الحوض الضخم يمثل خطراً على البيئة. قبل وصول المظاهرة إلى مكان المشروع بدأت الشرطة الفرنسية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وقنابل تفريق المظاهرات لمنع وصول المتظاهرين إلى حوض المياه، تحت ذريعة أنَّ المظاهرة غير مُصرَّح لها. مع تصاعد عنف الشرطة لجأ بعض المتظاهرين إلى إعادة رمي القنابل المسيلة للدموع تجاه سيارات الشرطة، بالإضافة لاستخدام كوكتيل المولوتوف. نتج عن هذه المواجهات إصابة قرابة 200 متظاهر بينهم متظاهر يدعى سيرج بين الحياة والموت إلى لحظة كتابة هذه المقالة، إثر إصابته بقنبلة في الرأس. يُذكَر أن الشرطة الفرنسية لحظة إصابة سيرج منعت وصول الإسعاف إلى مكان الحادثة، بذريعة عدم أمان الموقع. كما تجدر الإشارة إلى أن إصابة سيرج تبِعتها خروج بعض المقالات الصحفية التي تشير إلى أن المصاب يملك «فيش» جنائي، وأنه معروف من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية، في محاولة لشيطنة المتظاهرين ممّا ينزع شرعيتهم ويحولهم إلى مجموعة من المخربين (الزعران)، حيث يغدو استخدام «العنف» ضدهم ضرورة «شرعية». شغلت قضية سيرج الإعلام الفرنسي، حتى أن جريدة اللوموند أجرت تحقيقاً مصوراً حول إصابته. أصبح العنف المُستخدَم خلال مظاهرة سان ـ سولين موضوع المظاهرات في الأيام اللاحقة، لتغدوا مسألة قانون التقاعد إحدى أسباب التظاهرات وليس السبب الرئيس.

في مثال آخر على التعسف في استخدام العنف، يحق للشرطة الفرنسية إيقافُ أي شخص لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد إلى 48 ساعة عند الاشتباه به، وقد بدأت الشرطة الفرنسية منذ اندلاع الاحتجاجات بإيقاف الناس بشكل عشوائي على ما أثبتته شهادات الكثير من الموقوفين، والتي توضح ليس أن التظاهر أصبح تهمة بحد ذاته، بل حتى المرور من شارع بالقرب من مكان المظاهرة يعد تهمة قد تحرم العائدين إلى منازلهم من المبيت بين أهاليهم بسلام. تُعدُّ قصة كميل، وهي طالبة وبائعة كتب في باريس تم إيقافها من قبل الشرطة الفرنسية في 23 آذار الماضي، مثالاً من مئات الأمثلة والشهادات للأشخاص التي تم إيقافهم خلال الفترة الماضية، إذ أدى رفضها منح بصماتها ومسحة الـ DNA إضافة إلى رفضها أن يتم تفتيش هاتفها (على اعتباره جزءاً من حياتها الخاصة) إلى إطالة مدة احتجازها من 24 الى 48 ساعة، إضافة لنقلها إلى سجن مؤقت بهدف تحويلها إلى محكمة حيث وجِّهَتْ لها اتهامات من قبيل التظاهر بوجه مغطى، والتخريب والقيام بأعمال عنيفة. أكدت العديد من الشهادات الأخرى لموقوفين أنه، في حال قبول كافة مطالب الشرطة، يستطيع الموقوف الخروج بعد مضي 24 ساعة، على أنه خلال التحقيق تُمارس الشرطة العنف النفسي في الضغط على الموقوفين لدفعهم إلى الإدلاء بمعلومات تحت التهديد بتحويلهم إلى المحكمة. يُعدّ «العنف المعنوي»، على ما أسماه ديدييه فاسان في إحدى مداخلاته عن عنف الشرطة،ديدييه فاسان: طبيب وباحث في الأنثروبولوجيا، من محاضرة حول عنف الشرطة في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية في باريس، 11/04/2023. أحد الوسائل المتبعة من قبل الشرطة الفرنسية، والذي يشمل على أشكال الإهانات والتحقيق تحت الضغط، والاقتصار على وجبة طعام واحدة خلال الاحتجاز، وكافة الممارسات الأخرى التي تهدف إلى إضعاف الآخر نفسياً وجسدياً. يذكر فاسان في المناسبة ذاتها أن «العنف المعنوي» لم يدخل يوماً ضمن القوانين والتشريعات، ولم يحدث أن جُرِّمَ استخدامه.
إذا أخذنا العنف بمعناه المطلق، أي «كافة الممارسات التي تهدف إلى إهانة الكرامة الإنسانية والتي تودي بشكل أو بآخر بحيوات الناس»، يغدو احتكار العنف من قبل الدولة وسيلة لتفادي الدخول في حالة (حرب الجميع ضد الجميع) من جهة، وبهدف حفظ الكرامة الإنسانية لرعاياها بحمايتهم من التعرُّض للعنف من جهة أخرى. لكن مع مرور الزمن، غدا احتكار الدولة للعنف شرعيةً في ذاته، ليصبح حقاً وليس احتكاراً، أي أن «العنف الشرعي» تَحوَّلَ إلى شرعية عنيفة، وهو ما دفع بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا إلى رفض استخدام مصطلح (عنف الشرطة) على اعتبار أنه «يساوي بين من يستخدمون العنف وهم لا يملكون سلطة شرعية لاستخدامه وبين من يملكون العنف الشرعي للدولة». هنا يُطرح عددٌ من الأسئلة: من يردع الدولة في حالة تخطيها حدود الاستخدام الشرعي، من يقدرُ على محاسبة رجل شرطة يمارس العنف تحت مسمى «تنفيذ الأوامر الموجهة إليه»، من يروّض الغول البيروقراطيراجع مقال الغيلان الثلاثة وأزمة الثقافة العربية: مقالة غير عقلانية، ياسين الحاج صالح، الحوار المتمدن. الذي غدت تُمثله الدولة المعاصرة؟
إن هذه الأسئلة نابعةٌ من عدم فاعلية الجواب الذي يقول إن جهاز القضاء المستقل اليوم قادرٌ على إجراء هذه المحاسبات، فالعديد من الأمثلة التي يمكن استخراجها من السياق الفرنسي تُظهر عكس ذلك تماماً، فما حدث في إحدى جلسات المحكمة في قضية رفعها أحد المتظاهرين، وهو باحثٌ في علم الاجتماع، ضد رجل شرطة، يُمثِّلُ مدى قصور الجهاز البيروقراطي اليوم على تحقيق العدالة. بعد سنوات من التحقيق وجلسات المحكمة بين عامي 2007 و2018، أقرّ الشرطي بأنه حَيّدَ «neutralisé» الهدف (المتظاهر) تنفيذاً للأوامر. أولاً، وبحسب الباحث نفسه، فالعقلية العسكرية للشرطة تتعامل مع المتظاهرين كأهداف يجب إسقاطها خلال تدخل الشرطة، ليضيف بأن قرار القاضي، ولربما كان أقسى من الإصابة نفسها خلال المظاهرة، أتى على الشكل التالي: «أن الشرطي حقاً استهدف المتظاهر، إلا أنه طالما أطاع أمراً موجهاً إليه، فهو لم يخرق القانون، لأنه أطاع امراً لا يبدو غير شرعي».فيلم وثائقي بعنوان: تحت مسمى حفظ النظام. خلال مظاهرات السترات الصفراء، بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وآذار (مارس) 2020، وعن طريق استخدام أدوات القمع، سُجِّلَت وفاة شخصين، و327 إصابة في الرأس من ضمنهم 27 شخصاً فقدوا إحدى عيونهم، و78 إصابة باليد بينهم خمسة حالات بتر، يضاف إليها 135 إصابة في الساق.فيلم وثائقي بعنوان: الشرط والمواطنين، علاقة متوترة.
بالحديث عن العنف الشرعي للدولة، يجب الأخذ في الاعتبار أن قُدرة الدولة الحديثة على توظيف التكنولوجيا (مراقبة المظاهرات بالطائرات الموجهة)، وأدوات القمع (قنابل تفريق التجمعات، قنابل غازية خانقة، رصاص مطاطي، إلخ)، بهدف حماية قراراتها بذريعة الحفاظ على الأمن، تضع فكرة العقد الاجتماعي تحت المجهر. فالتسليمُ باحتكار العنف لا يضع في الحسبان تطوير ممارساته، لتغدو الدولة مع الوقت ذات قوة تدميرية أكثر من كونها احتكارية. في هذا السياق، ليس هدفي رفض فكرة الاحتكار بذاتها، على العكس، فاحتكار العنف ضرورة لحماية المجتمع من فوضى التسلّح، وإنما الهدف هو إعادة النظر لتطوير آليات عدالة إضافية تُحاكي التطور التكنولوجي لأدوات القمع، حتى لا نفقد السيطرة على عنف منحه المجتمع ضمنياً لجهاز الدولة.
خاتمة
هنا دعوة للتفكير حول عنف الدول الديمقراطية كجزء لا ينفصل عن عنف الدكتاتوريات، إذ أن الاثنين من جذر مؤسساتي نظري واحد (دولة تحتكر استخدام العنف)، فإذا كان عنف الدكتاتوريات يحتاج لفهم آلية عمله كونه حاضرٌ دوماً، فإن العنف في البيئات الديمقراطية يتطلب التنقيب وتسليط الضوء بشكل مستمر على ثغرات منظومة بيروقراطية، يودي استخدامها للعنف، سواءً بتسريع العملية البيروقراطية تحت مسمى (الإنتاجية) أو في سعيها الدائم «للحفاظ على الأمن»، برقاب مواطنيها إلى حد المقصلة.
علاوة على ذلك، فإن العنف في الأوساط الديمقراطية يهدد آمال من يعيشون في ظل الديكتاتوريات، ويحبط طموحات التغيير لديهم، إذ يَظهرُ كما لو أنه جزء من تركيبة المجتمعات بغض النظر عن شكل نظام الحكم القائم. في عالمنا اليوم هناك حاجة ملحة إلى إعادة التفكير في العقد الاجتماعي بحد ذاته، في مدى صلاح احتكار الدولة للعنف لمستقبل الشعوب، وفي ما إذا كان منظرو العقد الاجتماعي ذاتهم قد تخيلوا يوماً تَحوُّلَ الدولة إلى غول بيروقراطي لا تصلح قوانينه لضبط عنفه المنفلت. كذلك يجب التركيز في كافة مؤسسات الدولة على حفظ الكرامة الإنسانية كغاية أساسية، إلغاء عقوبة الإعدام بشكل مطلق، بمعنى عدم أحقية أي إنسان أو مؤسسة في إنهاء حياة إنسان تحت أي مسمىً كان، حتى بذريعة إحقاق العدالة، فالعدالة التي تحتاج إلى موت الآخر لإحقاقها هي جريمة تحاول شرعنة نفسها.
في الوقت ذاته يجب التأكيد على أن الديمقراطية هي منظومة تفكير مُستدام، إذ لا نظام ديمقراطي دون نقد ممارسات تهدد حيوات من يعيشون في ظله، وأَفترضُ هنا أننا في لحظة تحويلنا للديمقراطية إلى نظام جامد (باعتبارها خيراً مطلقاً). نخسر الحاضر ونهدد مستقبل من يطمحون للتغيير ويسعون إليه. في الختام، إذا تمثّلَ من يمنح الحياة برحم أم ومن يمنعها بمجرم أو حاكم جائر، فإن من يجمع بين يديه المنح والمنع في آن معاً هو حُكماً بعضٌ من إله.