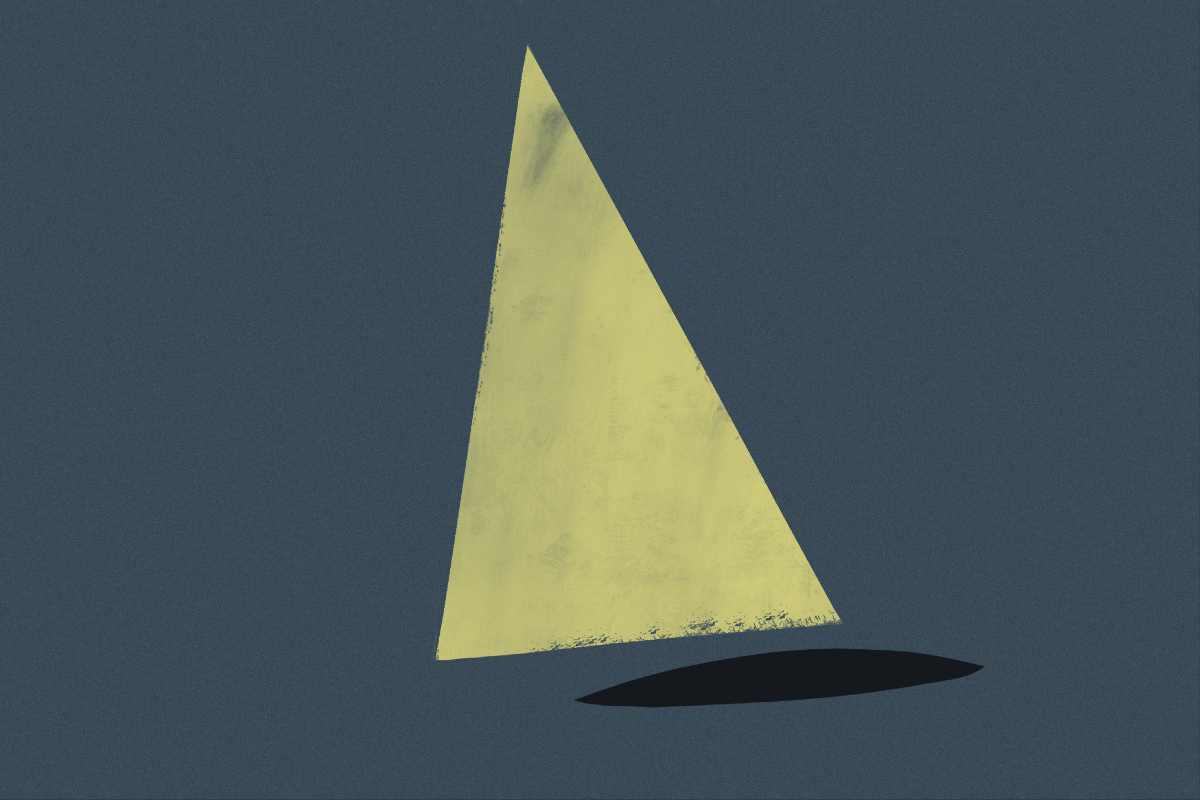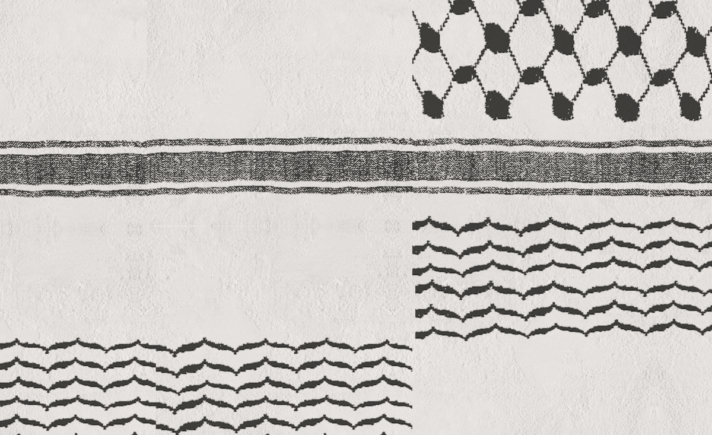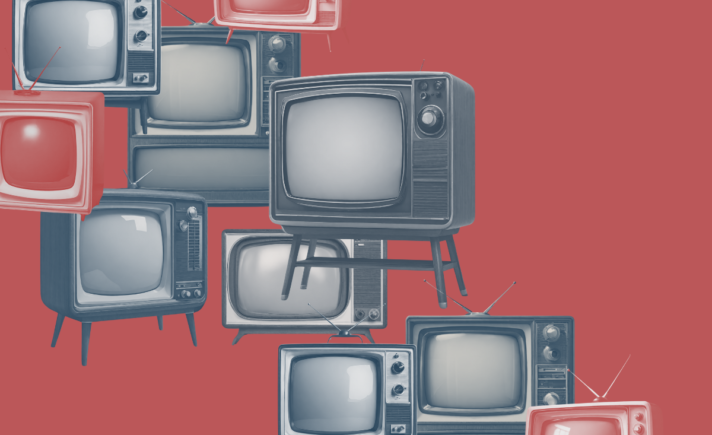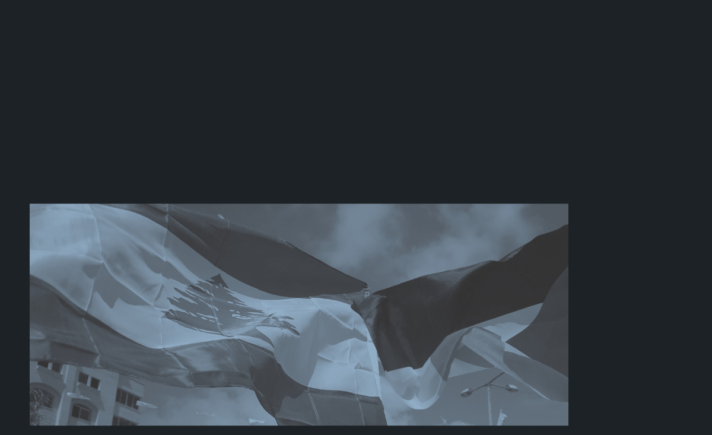«أنا وصلت بخير يا أم بسام».
قد تبدو رسالة واتساب هذه وكأنها من تلك التي يكتبها المسافرون على عجل في قاعات المطارات بعد رحلة طويلة، أو بعد أن يتجاوز الإنسان مكانه ليصل إلى احتمالات جديدة، تُلزمه بشيء من مسؤولية طمأنة زوجته عن سلامته.
محمد أبو بسام، 56 سنة، ابن درعا الذي يسكن في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، وصلَ إلى ورشة البلاط في شارع الحمرا. يبدو هذا الخبر عادياً ومن المريب التعامل معه بأهمية في حياة منطقية وعادية، ولكنه مفصليٌ في حياة أم بسام منذ بداية عمليات اعتقال اللاجئين السوريين في لبنان وترحيلهم قسراً إلى سوريا. المسافة بين مخيم شاتيلا والحمرا لا تتجاوز ستة كيلومترات، يمكن قطعُها خلال أقلِّ من عشر دقائق بالسيارة، ونحوِ أربعين دقيقة سيراً على الأقدام، وعُمْرٍ كاملٍ بالنسبة للسوريين الذين لم يستكملوا أوراقهم التي تُمكِّنهم من عبور النقاط الأمنية.
الساعة الثامنة صباحاً، شوارعُ بيروت شبه خالية، يتوافد العمال والموظفون والطلاب تدريجياً إلى نقطة جسر الكولا، يحاولون الحصول على أفضل المقاعد في حافلات صغيرة، يتطلب حجمها أن تحشر ظهرك في زوايا ضيقة لتتسع لجميع الركاب. تصل هذه الحافلات إلى صيدا وطرابلس بأسعار مناسبة، ولكن تلك النقطة مهمة أيضاً بالنسبة للاجئين السوريين بسبب مرور باصات أكبر حجماً فيها تربط بعض أحياء بيروت ببعضها، ولأنها تشكل عقدة مُتداخلة لنقاط عدة بين الضيع والمناطق، يتطلب الوصول إليها بسيارات الأجرة الخاصة مبالغَ كبيرة.
مع بداية موجة الترحيل التعسفية للاجئين السوريين، بدأت قوات الأمن اللبنانية الاعتمادَ على مثل هذه النقاط الحيوية في المدينة لمُحاصرة السوريين. و«محاصرة» هي الكلمة الأكثر دقة، لأن ذاكرتنا الجماعية السورية تحملُ تَصوُّراً عن فكرة الحاجز الأمني، الذي يدقق في الأوراق الرسمية ويسمح بالعبور المؤقت نحو حاجز آخر أكثر تهديداً، ولكن ما يحدث فعلاً هو انتشار مفاجئ للسيارات الأمنية في نقاط تجمع السوريين، ومحاولة القبض على كل شخص يبدو سورياً دون أي تدقيق حقيقي في الأوراق الثبوتية، ليتم جمعهم في سيارات الشحن ونقلهم إلى الحدود السورية.
ولكن، حقاً، كيف يبدو الإنسان سورياً؟!
يستيقظ محمد أبو بسام كل يوم في الساعة السابعة صباحاً، يبحث عن تحديثات مقتضبة كتبها اللاجئون السوريون في مجموعاتهم على فيسبوك حول تَطوُّر أحداث الترحيل، يشاركها على عجل في مجموعة واتساب صغيرة أنشأها مع أصدقائه في العمل. علاقة الأمرين هنا طردية، بحيث أنه كلما حاولت السلطة تضييق المساحات العامة على اللاجئين السوريين، كلما اتّسعت مساحات حضورهم في الفضاء الافتراضي.
يحاول محمد أبو بسام فهم واقع المدينة في كل صباح، آخر أخبار ترحيل اللاجئين السوريين، والقرارات التي تشملهم، والحِيَل التي يمكن أن يتّبعها ليصلَ إلى عمله.
«أنا ما كنت دير بالي هالقد، لحتى شفت بعيني. كنت نازل باتجاه الكولا لحتى آخُد باص أوصل على شغلي، شفت من بعيد تَجمُّع ناس، وفي عالم عم تركض، وبدلات مموهة عم تمسك السوريين وتاخدهم بسيارات».
المرة الواحدة هنا كافيةٌ لأي سوري في لبنان كي يرى العالم كله عبارة عن سيارة نقل عسكرية عليه الهرب منها قبل أن تحمله نحو مصيره المجهول، ورغم أن عمليات الترحيل غير مكثفة في وسط بيروت، فإنها تحدث فجأة وليست ثابتة. تُغلَق الطرقات وتبدأ عمليات المطاردة، لتنتشر همسات مريبة بين المشاة المُسرعين «عم يلقطوا سوريين».
بدأ الخوف من الساحات المفتوحة، ونقاط التجمُّع، يشكل تحدياً بالنسبة للاجئين السوريين، خاصة أولئك الذين يتطلب عملهم التنقُّلَ لمسافات طويلة، أو الجلوس في الساحات العامة بانتظار توليهم مهامَ يومية شاقة، مثل نقل الأثاث على أدراج مبانٍ مُعتمة وشاهقة، أو تنفيذ تصليحات معقدة ومكلفة مقابل مبالغ زهيدة جداً.
يضع محمد أبو بسام في جيبه ورقة مئة دولار قبل ذهابه إلى العمل، لا يضعها في محفظته الجلدية ضمن مصروفة اليومي، مع أن الذي في المحفظة لا يتجاوز الثلاثين دولاراً في أحسن الأحوال، ذلك أن على المئة دولار أن تكون سهلة الإشهار، أن تظهر فجأة كورقة من القَدَر يمكنها أن تُعيده إلى منزله في حال القبض عليه، لأن الإشاعة التي انتشرت حول شاب سوري دفع مئة دولار لعُنصر الأمن الذي قبض عليه ليُنزله من سيارة الترحيل، هي آخرُ أملٍ يمكن أن يصدقه كل سوري سوف يتعرض للترحيل. صدَّقَ أبو بسام الإشاعة، ليس لأنها حقيقية، بل لأنه يريد تصديقها، لأنها تعيطه أملاً أخيراً أنه حتى لو قبض عليه، ما زالت لديه فرصة أخيرة للعودة إلى البيت.
دفعتني حيلة المئة دولار هذه للتفكير: ما الذي يدفع أي لاجئ سوري في لبنان للتنازل بهذه السهولة عن ورقة نقدية قد تساوي راتباً شهرياً؟ يتبادل أفراد العائلة الواحدة المئة دولار ذاتها، يُسلِّمونها لبعضهم بعضاً كحبل نجاة مؤقت لا يضمن الوصول. ولكن مع ذلك، هناك شيء غير الخوف يدفعهم إلى هذه المحاولة، إنها خيبة الأمل من كل الجهات التي يجب أن تضمن حمايتهم، خاصة أن اللاجئ السوري يدرك عميقاً أن العالم بكل ما فيه من منظمات ومؤسسات وغرف أخبار وطوارئ لا يمكنه أن يحميه من الذهاب إلى الموت.
الساعة الثامنة. يتذكر أبو بسام جُملة زوجته الدائمة: «لا تنسى المية يا أبو بسام». يُغلق باب منزله في مخيم شاتيلا، يتحسُّسُ هاتفه، مفاتيحه، ومحفظته، والمائة، وهو يعلم تماماً أن العودة إلى المنزل سالماً وتَجنُّبَ التوقيف من قبل أي حاجز أمني اليوم، أمورٌ لا تعني أنه سيكون بخير.
«أنا مو خايف أرجع على سوريا، أنا خايف من النظام بسوريا، في حدا بِخاف يرجع على بلده!! أكيد لاء، سوريا ما بتخوف، يلي بخوف هو شو ممكن يصير فيك إذا حبيت سوريا وما رضيت تأيّد النظام فيها. ما بعرف ليه العالم متخيل انو مبسوطين هون، شوف بيوتنا وحياتنا. سمعت الكلمات اللي بنسمعها بالشارع؟!! هذا البلد مو ألنا، عطونا ببلدنا أمان، بس الأمان، ونحن منرجع».
تكريس الهشاشة واختراق الحقوق
حاولَ الإعلامُ اللبناني التمهيد لعمليات الترحيل العشوائية بتكريس صور نمطية حول اللاجئين السوريين. استخدمَ معلومات مضللة وأرقاماً مغلوطة حول أعدادهم والمساعدات التي يتلقونها من الأمم المتحدة، لم يكن سؤال الإعلام جدياً حول أوضاع اللاجئين، بل اعتمد بشكل أساسي على تعميق الهشاشة التجييش الطائفي كأدوات يمكن أن تهدد اللاجئ السوري. على الرغم من أن سؤال اللجوء السوري في لبنان معقدٌ ومستمرٌ منذ 12 عاماً، ولكن الإعلام عمل على تبسيطه من خلال بروباغندا عنصرية، اعتمدت بشكل أساسي على اختراق حقوق اللاجئين اليومية في التنقل والسكن والتواجد في الحيّز العام. تقوم السلطات اللبنانية منذ الشهر الماضي بمداهمة منازل السوريين في بيروت، واعتماد الاعتقالات العشوائية ضمن مناطق تَجمُّع اللاجئين وتضييق مساحات الأمان، ما دفعَ بعض اللاجئين إلى موجات نزوح نحو مناطق أكثر أمناً، لأن مهام السلطة بتهديد مصالح السوريين ومداهمة منازلهم، رافقها تآمرُ بعض سُكّان الأحياء كمخبرين يرشدون العناصر نحو منازل السوريين وأماكن عملهم.
سَجَّلَت العديد من المناطق في بيروت المشهد ذاته، سيارات عسكرية، عناصر يتراكضون لمداهمة بيوت السوريين، فيديوهات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيها أطفال ونساء ورجال بين بدلات المارنز، يحاولون التملّصَ من الركوب الأخير في السيارة المخصصة لترحيلهم نحو سوريا. العشوائية التي تفرضها السلطة على اللاجئين السوريين لم تُقلِّص دوائر الأمان فقط، بل فرضت عليهم محاولات هجرة غير آمنة، وفوضى في الأوراق الثبوتية، بسبب تَنصُّل دوائر الأمن من دورها الرسمي، وتحويلها إلى مراكز تضغط على اللاجئين السوريين وتُصادر أوراقهم لدفعهم بالقوة للتوقيع على تعهدات عودة طوعية غير قانونية إلى سوريا، مثلما حدث في بلدية منطقة الدكوانة في بيروت.
السؤال ذاته، ولكن الإجابات هي التي تطفو ثم تختفي في عتمة الاحتمالات: «إلى أين؟!».
تفتح وسام، 40 سنة، باباً كان أبيضَ قبل أن يتآكل ببقع نحاسية بنية. تطلبُ مني الدخول وهي تجمع أطباقاً مرمية هنا وهناك ووسائد مختلفة الألوان، جلستُ على فراش للنوم قرب رُخام مجلى مُوشَّح بالسواد، تنبعث منه رائحة خضراء لأوراق نعنع تختلط برائحة نوم خفيفة تفوح من الفراش. ردَّت على سؤالي بهمس ثابت لم يهتز أبداً: «لوين!! على البحر، ما إحنا هربنا من برج حمود على مخيم شاتيلا، طيب بعد شاتيلا لوين؟! أكيد برا لبنان، يلي بشوف كيف الجيش عم يقتحم البيوت وكيف العالم عم تتهجم على السوريين، أكيد ما رح يشوف غير البحر».
حي برج حمود أحد ضواحي بيروت الكبرى، يتبعُ لقضاء المتن في محافظة جبل لبنان، وهو من أول الأحياء في بيروت التي شهدت مداهمات متكررة للسلطة اللبنانية لبيوت السوريين، رافقها عنصرية مباشرة، وممارسات انتقامية تنتهك حقوقهم اليومية، وتآمرٌ قَادتْهُ مجموعاتٌ لإرشاد قوى الأمن إلى أماكن تواجد السوريين.
ما إن تركتُ نهر بيروت، ودخلتُ شارع أرمينيا، بدأت أسلاك كهربائية تمتد أمامي إلى مالا نهاية بين أبنية مترامية بعشوائية، وكلما توغلتُ أكثر بين الأسمنت، رافقني خَدَرٌ خفيفٌ ورغبةٌ مُلحَّة بالهرب. «أرمينيا الصغيرة» كما يُطلَق على برج حمود، بناها الأرمن بعد لجوئهم إلى لبنان عام 1915 نتيجة الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في أراضي الدولة العثمانية. مع السنوات بنت منطقة برج حمود اقتصادها الخاص وحركتها التجارية الغنية بالتنوع، كما أن تَداخُلها مع مناطق أخرى، بين الدكوانة وسنّ الفيل حتى منطقة الدورة، جعلها مقصداً للعمال واللاجئين والمهجرين من مختلف الجنسيات، ومن بينهم «الغرباء» كما يوصَفُ اللاجئون السوريون اليوم في المنطقة، حيث «الغريب» تحولت تدريجياً من صفة إلى تُهمة يخضع من «ارتكبها» لتهديدات مستمرة بالترحيل. نزحَ فعلاً عشرات اللاجئين من المنطقة، بينما يعيش الباقون في ظلّ اختراق كامل للحقوق.
تحت عنوان «إخلاء اللاجئات\ين السوريين: خرقٌ للحق في المدينة والسكن والتنقل واختيار مكان العيش»، نشرَ استديو أشغال عامة بيانه الأخير حول عمليات الترحيل التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون، مؤكداً على عدم قانونية إجراءات السلطة اللبنانية بحق اللاجئين، ومدى خطورة الإجراءات المتلاحقة على حياتهم، وما يتعرضون له من من ممارسات اجتماعية سامّة نتيجة للحملة العنصرية التي تشنها قوى الأمن بتغطية من الإعلام اللبناني، الذي حرص على تجييش الرأي العام ضد السوريين، مُوثِّقة في بيانها انتهاكات لحقوق العمل والوصول للمساحات العامة والتنقل، وخروقات لحقوق السكن والتنقُّل التي نتج عنها هشاشة سكانية حادة.
بحسب آخر تحديث لبوابة البيانات التشغيلية ODP، يعيش %22.2 (ما يُقدَّر بنحو بنحو 178650 شخصاً) من اللاجئين السوريين في بيروت. يبقى الرقم تقريبياً، وغير دقيق، خاصة أنه يعتمد بشكل رئيسي على أعداد السوريين المُسجَّلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولكنه يوضح كيف أن أعداد اللاجئين في بيروت أقلّ بالمقارنة مع منطقة البقاع والشمال. تَوزُّعُ اللاجئين السوريين ضمن مدينة بيروت غير واضح، ولكن الترحيل أعاد طرح سؤال المساحات الآمنة بالنسبة لهم، وسؤال قدرتهم على الاستمرار في مناطق عمل وعيش تعتمد ممارسات اجتماعية سامّة. حاولت بعض العائلات السورية أن تتنقّلَ بين المناطق لتفادي الترحيل والتعديات العنصرية، خاصة بعد محاولات الإحصاء للسوريين التي تعتمدها أغلب بلديات بيروت، والتي تُهدِّدُ بغرامات مالية وعقوبات في حال عدم مراجعة البلديات أو ملئ استمارات تطلب معلومات تفصيلية عن حياتهم، ذلك في وقت يعتاشُ أغلبهم كعمال بالمياومة، ما يعني أن تقييد حركتهم وتضييق مساحاتهم العامة عوائق رئيسية أمام تأمين قوتهم اليومي.
تُقلِّبُ وسام بصلاً في مقلاة صغيرة، تسحب الشرائح إلى الوسط ثم تنفضها بخفّة نحو الأطراف، رائحة العدس والبصل تشكل سحابة لا تجد مكاناً لتخرج منه، لتختفي بهدوء في سقف الغرفة. تسرق نظرات خاطفة نحوي وتقول بصوتها الثابت: «جمعنا شوية مصاري أخدنا فيهم هي الغرفة بالمخيم. مو سهل تلاقي غرفة بالمخيم، المخيم ما فيه مساحة أبداً، بس هون أقل شي جوزي بيطلع على الشغل وهو متأكد أنو ما رح يرجع وما يلاقينا». يعمل زوج وسام كعامل مياومة بوقوفه المستمر عند نفق البربير، وهي نقطة تَجمُّع للعمال السوريين. يضعهم وقوفهم في مجموعات دائماً تحت تهديد مباشر بالترحيل، خاصة أن أغلب العمال السوريين غير مُسجَّلين في سجلات الأمن العام، ومع ذلك يحرص زوج وسام على الوقوف هناك، وتنفيذ مهام مرهقة مثل حمل الأثاث المنزلي على إدراج أبنية عالية، أو تصليحات شبه مستحيلة بأجر زهيد، ما قد يجعل يوميته في أفضل أيام العمل 10$.
يفرض خطر الترحيل على خالد، زوج وسام، غيابات متكررة، يحاول تعويضها بعمله في قاعات المناسبات والأفراح، ترتيب الطاولات وتكديس الكراسي أو توزيعها، العمل الذي يفرض عليه التأخُّرَ لساعات طويلة عن المنزل، بانتظار انتهاء الأعراس، لترتيب القاعات وتنظيفها بعد رقص الآخرين. يؤمّن هذا العمل لخالد دخلاً في أوقات انتشار أخبار حول مداهمات من قبل الجيش في منطقة نفق البربير.
أطفأت وسام الغاز ونزلت عن كرسي بلاستيكي صغير خصصته لغاز كهل بعين واحدة، لتقول بصوتها المرتجف مثل باب ثقيل يصطك بفعل ريح مفاجئة: «نحن عم نفكر نطلع بالبحر، من قبل الترحيل. عندي ولدين وجوزي، والنظام ما تركلنا شي بسوريا نرجعله، البيوت صارت تلال حجار، وأهلي وأهل جوزي، يلي استشهد ويلي سافر ويلي مو مبين. ما في شي نرجعله ولا مكان نروح عليه، ومع هيك بفكرونا مبسوطين بلبنان، أو مرتاحين».
دولة الارتجال السياسي وما يشبه الحلول
مثل جميع الأزمات التي تواجه السلطة اللبنانية والحكومات المتعاقبة، حاولت الدولة اللبنانية أن تواجه ملف وجود اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال الشعبوية والارتجال السياسي، فمنذ 12 عاماً فشلت الحكومات اللبنانية في طرح أسئلة جدية حول هذا الملفّ وفشلت في تنظيمه. وفي دولة فقيرة بالداتا والمعلومات، اعتبرت السلطة اللبنانية اليوم أن الحل يكمن في الترحيل العشوائي، بعد غياب كامل وطويل لأي تنظيم واضح لأوضاع السوريين، وغياب كامل لأي محاولة للإنصات لهم، في ظل انقسام سياسي يشكّل استمراراً للسياسة اللبنانية القائمة على الطائفية المباشرة في بناء المواقف واتّخاذ الإجراءات.
حتى الآن تعتمد الدبلوماسية السياسية اللبنانية نظريةَ المؤامرة، التي ترى أن هناك مؤامرة على لبنان، هدفها تغيير ديموغرافي عميق في التوزيع الطائفي، لذلك تغيب في السياسة الخارجية اللبنانية أي محاولات لطرح حلول ممكنة إلّا بالتعاون مع النظام السوري، الذي تفتح قنوات اتصال مستمرة معه في محاولة لردم ملف اللجوء من خلال تسليم اللاجئين لمن كان سبباً في هروبهم. مع ذلك، ما زالت الخارجية اللبنانية تعتمد خطاب التسوّل لاستمرار الحصول على الدعم المالي، وخطاب التهرُّب الدائم من المسؤولية.
إطلاقُ «الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري»، وضغوطُ وزارة الداخلية المستمرة على مفوضية اللاجئين لتسليمها معلومات شخصية وتفصيلية عن اللاجئين، هي أدلّة جديدة على فشل السلطة اللبنانية في إدارة ملف مُهمّ وحسّاس، مثلما فشلت في السنوات الثلاثين الماضية في إدارة أغلب الملفات التي تهدد مجتمعها واقتصادها ودورها السياسي الداخلي والخارجي، واعتمدت أسلوبها الواضح والسريع من خلال ترهيب اللاجئين ومحاولة مَحوهم بسيارات عسكرية تنقلهم إلى الحدود، في انفصال تام عن الواقع، وقراءة سريعة وخاطئة لمدى خطورة ما تُمثله الفوضى الحكومية والسياسية في إدارة ملفّ يذهب ضحيته اليوم عشرات الأبرياء من اللاجئين.