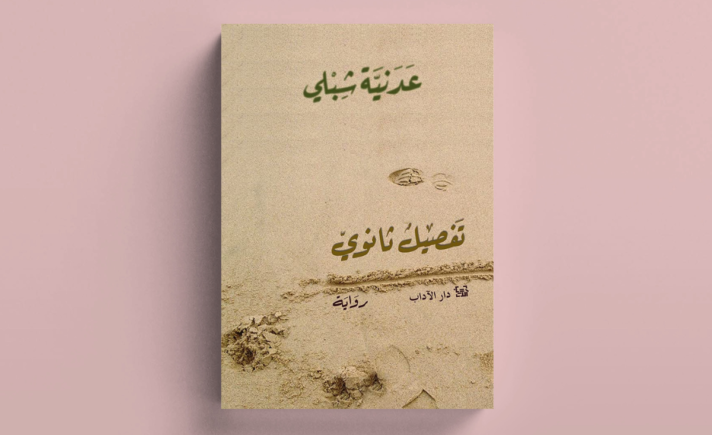عشرون عاماً رَاكمَتْ حدثاً فوق آخر، حرباً فوق أُخرى، وثورةً والكثير من الأحداث الدموية الأخرى. كم يا تُرى نستطيع أن نتذكّر ما عشناه دون أن يختلط بما تعلّمناه بعدها وبما علّمونا أن نتذكّره؟ أن تكون صورة سقوط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس هي الصورة الرسمية للغزو الأميركي للعراق عام 2003، لتبدو للبعض بعد زمن كثورة مُهداة، وما الحربُ سوى ظلٍّ لها. سقط الديكتاتور ورأى العالمُ العراقَ الذي كان مُغيَّباً، والعراقُ بدوره رأى ذلك العالم، ورأى نفسه بطل الشاشات بعدما استطعنا إدخال أجهزة الستلايت أخيراً بعد أن كانت ممنوعة.
بالنسبة لآخرين، مهما عُرِضت صورة إسقاط التمثال، كانت ذكرى الحرب متمثّلة بانفجار سيارة مفخخة، أو مقتل جار أو قريب. بالنسبة لي، كان مقتلُ الابنة الأصغر لجارة جدتي بشظية من صاروخ أميركي في رأسها هو ذكرى الحرب. كانت ورود تقفُ دائماً في حديقة رصيف بيتها وكأنها سجينة هذه الحديقة، عندما بدأت تشبُّ وتصير صبية راحت الأقاويل تشيعُ عنها أنها تبحث عن عريس بهذه الطريقة، لكنها كانت في حديقة الرصيف هذه مذ كانت طفلة بصدرية المدرسة نفسها والقميص الأبيض. تهامستْ عائلتي بخبر مقتلها كي لا نسمعَ ونُصدَم، لكننا سمعنا، فموت شابة لا تتجاوز السابعة عشرة لا يمكن أن يُخفى وإن مات مئاتٌ غيرها، لا يمكن أن يختفي خبرها وسط كل تلك الأخبار.
منذ مقتل ورود لم أعد أرى الشارع، ولا الأخبار حتى. اشترَتْ عائلتي مُولِّدةً للكهرباء كي نستطيع مشاهدة البرامج المختلفة، ولننسَ ما يحدث حولنا ولا نطالبَ بالخروج كي لا نسقط بشظية مثل كثير من الأطفال غيرنا.
قبل بداية القصف، هربت عائلتي من بغداد إلى مدينة الفلوجة لأن الغزو كان حتميّاً. لا أذكر كم قضينا من الوقت هناك، والصورةُ الوحيدة في رأسي عن تلك الأيام في الفلوجة هي مشاهدة التلفزيون مع الجميع ورؤية بغداد تحترق. قالت جدتي لأمي: «يكولون بغداد تروح غريق لو حريق، وهاي راحت». لم نبقَ هناك كثيراً، أرادت عائلتي العودة إلى بغداد. خلال أيام تم استبدال النوافذ المُحطَّمة جرّاء أصوات القصف. سلّة قمامة مليئة بالزجاج المُحطّم، حصلتُ على ندبة في يدي منها. نزفتُ كثيراً وظننتُ أنني سأموت مثل الأفلام التي بدأتُ أشاهدها أخيراً؛ ينتحرون بجرح معصمهم. خفتُ وبكيت، لكن في مكان ما في أعماقي ظننتُ أن هذا طبيعي وأننا سنموت جميعاً في كل الأحوال بشظايا صواريخ أو زجاج محطّم أو ربما رصاصة. لم أَمُت، كان الجرحُ بسيطاً، وضحكت عائلتي من الدراما التي أدخلتُ نفسي فيها. أغلقوا عليّ وعلى أخي أكثر وأكثر، وحُرمت من الذهاب إلى المدرسة ومن رؤية ابنة عمتي. كان البيتُ مليئاً بقناني مياه وأطعمة مُعلَّبة خزّنتها عائلتي تَحسُّباً لمجاعة ما. أطلقنا أنا وأخي أسماءَ على قناني المياه ورحنا نلعب بها، لا أذكر كم من الوقت قضينا في تلك الغرفة، نختلق عوالمَ مختلفة وأسماءَ نَتعلَّمُها من قنوات التلفزيون الجديدة المختلفة. كنا الأطفال المحظوظين، كان غيرنا يموتون أو يَفقدون أطرافهم أو ذويهم في الانفجارات.
بعد فترة قليلة انقلبَ الوضع، وجاء النازحون من الفلوجة إلى بيتنا ليشاهدوا مدينتهم تحترق في شاشات التلفزيون. كانت بغداد قد سقطت وانتهى الأمر، لكن الفلوجة كانت تقاوم وكانت عائلتي فخورة بذلك. استمعَ رجالُ ونساءُ العائلة المجتمعون في بيتنا لشريط كاسيت انتشرَ في ذلك الوقت لأغنية سوريّة بعنوان «عفية أهل الفلوجة»، تُحيي المقاومة الكبيرة ضد الجيش الأميركي في الفلوجة، وتَشي في الوقت نفسه بدخول كثير من الشبان السوريين للقتال في العراق ضد المحتل الأميركي: «للرمادي تعنّينا وطول الدرب ما همنا… ترا سقوطك بغداد مثل الفجعة بأهلنا». كانت تلك الفترة الوحيدة التي لم تستطع فيها عائلتي حمايتي من سماع أي حديث سياسي أو طائفي، فغُرفتي المليئة بالألعاب المخصصة لصناعة طفل يعيش ملتصقاً بالحائط، صارت غرفة تضُم ستة أو سبعة أفراد آخرين نزحوا لأن الفلوجة تُقصَف بلا هوادة. في ذلك الوقت عرفتُ أن تأييد المقاومة في بيتنا لم يكن شأن العراق كله، فعندما قُتل جارنا برصاصة أميركية بقيت العائلة تتحدث لأسبوع عن فرحه بدخول الجيش الأميركي الذي خلّصَ العراق من صدام حسين، وعن أنه لم يَحسب حساب أنَّ نهايته ستكون على يد هذا الجيش الذي رحَّبَ به. سمعتُ عن الذين قَبَّلوا الجنود واحتفلوا بقدومهم، فيما صورُ سجن أبو غريب تتسرب من شاشة التلفزيون. كانوا عراقيين مثلنا وكُنّا عراقيين مثلهم، لكن عراقيتنا مختلفة. كان الكبار يعرفون ذلك، ونحن الذين وُلِدنا على صمتهم كان علينا أن نُصدَم بكل ذلك دفعة واحدة، لكننا تشاركنا مشاعر الألم نفسها لاحقاً، وبعضَ النشوة أيضاً. أنا وأخي حظينا بنصيبنا من نشوة سقوط صدام بدورنا، بعدما سمعنا والدي يُسميه «الكلب ابن الكلب».
أطفالٌ مزّقوا صورة «بابا صدام» من كتبهم المدرسية، الصورة المقدسة الوحيدة التي لم يجرؤ طفلٌ على الرسم فوقها، وإن فعل سارعَ أهله للحصول على نسخة أخرى من الكتاب المدرسي رغم صعوبة الحصول على كتب مدرسية، إذ كُنَّا في فترة الحصار نرثُ كتبَ الطلاب السابقين ويتوجّبُ علينا إعادة كُتبنا في نهاية العام الدراسي ليحصلَ عليها غَيرُنا. لا يجب أن تهترئ صورة القائد، وإن حصلتَ على كتابك مهترئاً مع صورته فسيعيش أهلك في رعب آملين عدم انتباه أحد، إلّا إذا استطاعوا تأمين كتابٍ آخر. مَزّقنا الصور، رسمنا فوقها، وأكثر من ذلك قام أخي الصغير الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره بالتبوُّل على صورة لصدام حسين مَزَّقها من إحدى كتبه المدرسية. ضحكَ والداي، ولم يخافا هذه المرة. قمنا بتمزيق المزيد، فقد كانت صورته على كافة الكتب وليس فقط كتاب التربية الوطنية. كانت هذه الذكرى الوحيدة الممتعة، والتي تشاركناها دون وعي مع من أسقطوا تماثيل صدام وصُورَه في الشوارع. قبل ذلك وبعده، كان الخوف وتَسرُّبُ المعلومات عن «الآخرين» إلى أدمغتنا الصغيرة. عدا ذلك، كان صوت المروحيات والمولّدات الكهربائية جُزءاً من حياتنا اليومية، حتى نحن الناجين الذين لم يدخل جَسدَنا سوى شظايا الزجاج. لم تستمر نشوة العبَث بصور القائد لأكثر من يوم، بعدها عاد كل شيء مُخيفاً كما كان.
لم يتوقف الخوف، كان علينا أن نهرب. أتذكرُ مطار بغداد الدولي بضبابية، كان لا يخلو بدوره من علامات الحرب لتكون صورته هي الصورة الأخيرة للعراق في ذهني. صادر أمن المطار قلادة أمي الذهبية، ووقفنا في طوابير طويلة يملؤها أناسٌ يرتدون ملابسَ مختلفة. أصحاب الملابس الرثّة هم من أثاروا انتباهي، فبرغم الفقر البادي عليهم، كان عليهم صعودُ الطائرة حتى لو كان الثمن كل ما يملكون من مال. لا أتذكرُ تماماً متى واجهنا الكلاب البوليسية من نوع جيرمان شيبرد التي كانت تقف قرب المطار في الخارج، تشمشم بحثاً عن رائحة سلاح رُبّما. إن أردتُ أن أضع ترتيباً منطقياً للأحداث، فإن الكلاب كانت عند مدخل المطار قبل دخولنا، لكن في رأسي، كانت هي الصورةَ الأخيرة. ربما لأن هذه كانت مواجهتي الأخيرة مع الرعب في ذلك الوقت.
منذ عدّة سنوات سألتني فتاة سوريّة عن سبب قدومي إلى سوريا. قلتُ لها إني جئت مثل كل العراقيين هرباً من الحرب، لتسألني باستغراب: أيّة حرب؟ كان قد مضى على الغزو الأميركي للعراق سنوات أطول من عمر وعيها. أخبرتها باقتضاب أن الولايات المتحدة الأميركية غَزَتْ العراق عام 2003 وكانت الحرب مرعبة، كان علينا أن نخرج من هناك. قالت: إلى سوريا؟ وضَحِكَتْ. ضحكتُ معها، وتراجعتُ عن فكرة إخبارها بقصتين صغيرتين حفظتُهُما لأرويهما للسوريين الذين يرَونَني كناجية. حفظتُ القصّتين في ذاكرتي لأني لا أذكر تفاصيلَ مروِّعة أخرى، ولم أشهد الكثير من الفظائع التي يتخيَّل مَن شاهد الأخبار أن العراقيين شهدوها على حدّ سواء. لكن كان عليَّ أن أروي ما عشته وإن كان ضئيلاً، ربما لرغبة في إخبارهم أنّي أنا أيضاً أستحقُّ اللجوء وإن جئتُ مع عائلتي بأكملها بأطراف أجسادنا كاملة، وبأن ما حدثَ كان فظيعاً حقاً وإن كنتُ أبتسمُ الآن. كان ذلك قبل الثورة السورية، عندما كان الحديث عن الحرب مُعقَّداً لمن لم يشهدها، وكان السبب الآخر لرغبتي في رواية هاتين القصتين هو تراجع صورة الجندي الأميركي في الأخبار مقابل الميليشيات والسيارات المفخخة التي لا يعرف أحد من وضعها؛ تنظيم القاعدة أو جيش المهدي أو غيرهم، المهم هو أن العراقيين كانوا متورطين في حرب ضد بعضهم، وقد أردتُ أن يكون الجيش الأميركي هو المُذنِبُ الوحيد في قصصي. أما الفتاة التي سألتني، فأردتُ أن أُجنبها ثقل حكايات حرب قديمة، وهي النازحة من الغوطة في عمر صغير.
القصة الأولى كانت عندما عُدتُ إلى المدرسة. مرَّتْ دباباتٌ للجيش الأمريكي قرب مدرستنا، وقُمنا، اقتداءً بأطفال الحجارة، برمي الحصى عليهم. خرجتْ المديرة تصرخ علينا وتبكي، وقالت إنهم هَدَّدوها بإسقاط المدرسة فوق رؤوسنا. القصة الثانية كانت عن رؤيتي للجيش الأميركي داخل بيتي كما حدثَ مع أغلبنا. كانوا يُمّشطون المنطقة بحثاً عن أشخاص متورطين مع الإرهاب. ضربوا الباب الحديدي بأحذيتهم العسكرية حتى تحطَّمَ القفل. ظننا أنه كان قَصفاً فقط، كنا نائمين ولم نستطع إدراك الصوت جيداً. وجدناهم داخل بيتنا ينبِشون كل شيء، يبحثون في ألبومات الصور ويسرقون النقود من دُرج أبي. سألني أحدهم إن كنت أعرف المدعو أبو علي، لا أذكر إجابتي. ثم أرَوني صورة بعدها، وأجبتُ بالنفي. يحلو لي أن أتذكر أنّي قلتُ لهم ساخرة: «نصّ العراق اسمه أبو علي». لم تكن طفلةٌ لتجرؤ على قول ذلك في وجه مترجم الجيش الأميركي وإن كان عراقياً، ربما سرقتُ هذه الجملة من شخص ما ووضعتها في ذاكرتي لتبدو القصة أفضل. أخذوا أبي للتحقيق، خرجَتْ أمي تصرخ. عاد والدي بعد ساعات، كُنّا من القلّة المحظوظين.
عرفَ والدي أن الحظ لا يمكن أن يستمر طويلاً. إن نجوتَ من الجيش الأميركي لن تنجو من الميليشيات وعصابات الخطف والقتل التي انتشرت بسرعة. كانت أمي حاملاً، ولا يمكن للطفل أن يولد في بلد يُخطف فيه الأطفال وتُلقى جثثهم أمام بيوت ذويهم، كما لا يمكن أن يولد في بلد يُقتل فيه المرء بسبب اسمه. لم يَعُد للوطنية مكانٌ بعد عامين من الغزو. كان علينا أن نهرب حتى تهدأ الأوضاع، ومثل أغلب من هاجروا اخترنا سوريا القريبة، التي فتحت أبوابها لنا.
عندما وصلنا، كان الكثير من العراقيين قد سبقونا بالفعل إلى هذه البلاد التي لم نعرفها من التلفزيون كما نعرف مصر مثلاً، وبسرعة بنوا تَجمُّعاتهم الخاصة في مناطق عدّة، في قدسيّا وجرمانا على الأخص لتوفُّر الشقق أكثر. في قدسيّا وجرمانا كان هناك عراقٌ صغير. افتُتِحَت مطاعم السمك المسكوف ومخابز التنور والصمّون الحجري العراقي والشاورما العراقية المعروفة باسم «الكص». أرادت عائلتي البقاء لسنة أو سنتين فقط، لكن هؤلاء الذين أسموا بلدة قدسيّا بساحة الفلوجة كانوا يعلمون أن الأمور لن تهدأ بهذه السهولة، وكان عليهم بناء مساحتهم. بحلول عام 2007 ضمّت سوريا أكثر من مليون لاجئ عراقي من مختلف أطياف العراق وطبقاته، على العكس من الأردن التي ضمّت غالباً الطبقات الثرية. امتلأ سوق الحميدية في دمشق بأعلام العراق وقبّعات علم العراق، وقلائد للخريطة وغيرها من أمور تُباع لأولئك الوافدين الجُدد الذين يشعرون بحنينٍ دائم لوطنهم. أما سوق العقارات، فكان المُتأثِّر الأكبر بقدوم العراقيين، والمُؤثِّر الأكبر كذلك بجيرانهم أصاحب الأرض.
بدأ أصحاب البيوت برفع أسعار الإيجارات لأن العراقيين يدفعون أكثر. أدى هذا إلى مشكلة سكنية لدى السوريين، وبسرعة بدأت تنهار العلاقة بين الشعبين. اللاجئ الذي يستدعي التعاطف بات عبئاً ثقيلاً، وبدأت المشاكل تحدث لنرى نحن الجيل الأصغر آثارها في شجارات المدرسة، ومن تعامُلِ بعض المُعلِّمين والمُعلِّمات الغاضب. العراقيون الذين لم يملكوا المال أثاروا أزمة أخرى بدورهم. راحت سمعة مدينة جرمانا تسوء أكثر مع افتتاح الكثير من الملاهي الليلية العراقية، وليس في جرمانا وحدها، فملهى الروابي على طريق الهامة كان واحداً من أشهر الملاهي العراقية في دمشق وريفها. الكثير من الفتيات العراقيات من اللاجئات اللواتي فقدنَ كل شيء دخلن العمل الجنسي، الذي كان سهلاً في سوريا بشكل كبير وعَلَني.
اختارت عائلتي السكن في منطقة لا يتجمّع فيها العراقيون للابتعاد عن أي مشاكل مع أصحاب الأرض. جرمانا وقدسيّا وصحنايا لم يكونوا ضمن الخيارات، لأن المشاكل بين العراقيين والسوريين فيها كثيرة. علّمتني والدتي أن أصمتَ في المدرسة إذا أزعجني أحد لأنني لست ابنة البلد، ورَدَّدت جملة: «يا غريب كن أديب»، كما حرص والداي على إعطائنا تعليمات مُعينة لنتجنَّبَ أي احتقان مع أي سوري. مثلاً؛ إن سألنا أحدٌ إن كنّا نحب صدام أو نكرهه، علينا أن نقول بأننا نحبه، فهذا الجواب يعجبهم، فهو سؤال غير مباشر عن الطائفة التي لم يكن يخجل البعض من السؤال عنها بشكل مباشر. في دمشق كانت الطائفة السنّية مقبولة أكثر، لذا كان علينا أن نُحبّ صدام. في الوقت نفسه كان السوريون هم الشعب الأكثر تقبُّلاً للوجود العراقي مقارنةً بدول الجوار الأخرى. مع هذه الشروط الطائفية غير المعلنة، اختار عددٌ لا بأس به التكتُّل السكني مع طوائفهم. الشكل الأوضح كان في منطقة السيدة زينب، حيث امتلك الشيعة العراقيون مساحة لممارسة شعائرهم مع وجود الحسينيات هناك، أما السنّة فقد اختاروا منطقة قدسيا والهامة في ريف دمشق، التي تقطنها أغلبية سنّية سوريّة.
لم يكن هذا الفصل حاداً، إذ يمكن إيجاد التنوع الطائفي بسهولة في كل المناطق التي اختار العراقيون السكن فيها، وإن طغت أغلبية طائفية على بعضها. بهذا الشكل رسمنا حدوداً أخلاقية سِلميّة في دمشق، ولم نشأ نقلَ ما يحدث في العراق من حروب طائفية إلى البلاد التي هربنا إليها. وإن حدثت بعض الشجارات بين عراقيين، لم تكن سوى حالات فردية لم تتطور إلى مشاكل كبرى، خصوصاً وأن الأمن السوري كان قوياً بما يكفي للتعامل مع أي عنف يخرج عن السيطرة بشكل سيؤذي جميع المتورطين حتى وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم. من خلال تجاربهم في العراق، عرفَ العراقيون أن لا خيرَ يأتي من التورط مع أمن حزب البعث. كذلك، كانت سوريا تُوفّر للمقيم العراقي ما يريده، فالشعائر الحسينية موجودة، وأبناء حزب الدعوة الإسلامي موجودون، وفي الوقت نفسه يوجد مكتب لحزب البعث العراقي في منطقة العفيف، لكن المساحة السياسية كانت تحت أعين النظام السوري ومِن صُنعه، لذا لا يمكن لأحدٍ تَجاوُزُ ما يُسمَح له. اكتفى العراقيون غالباً بحياة سِلمية ركيزتُها المطاعم العراقية التي تجمعهم جميعاً. قوبلَ هذا القبول، بتشعباته وتناقضاته، بامتنانٍ لم ينسَهُ كثير من العراقيين حتى اليوم بعد العودة إلى العراق، سواء كان الامتنان للشعب السوري، أو للنظام الذي يحظى بتأييد في العراق حتى الآن.
مرَّتْ الأعوام ولم يتحوّل العراق إلى مكانٍ صالح للعيش بعد. كان العراقيون ينتظرون أمام الأخبار، لكن مفخخة وراء أخرى تنفجر في التجمعات والأعياد، والميليشيات تتعدد وتكبر، والجيش الأميركي ما زال موجوداً. الجيل الذي كان طفلاً عند بداية الغزو، كبرَ في بلدان اللجوء منتظراً العودة أو الرحيل إلى أميركا أو أوروبا، فمكانٌ مثل سوريا وإن امتلأ بالعراقيين ما هو إلا محطة. لا يمكن الحصول على الجنسية السورية، ولا يمكن الدراسة في الجامعات السورية دون دفع مبالغ كبيرة كأقساط للطلبة العرب والأجانب، إذ تبدأ أقساط الدراسة الجامعية للعام الواحد من 2000 دولار وحتى 5000 دولار بحسب الفرع الجامعي، إلا لمن حصل على منحة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (تُعطَى لفرد واحد من العائلة)، أو مقعد قيادة قطرية يُسمَح للطالب الحاصل عليه بالدراسة مجاناً أو برسوم قليلة في الجامعات السورية. للوصول إلى مقعد القيادة القطرية في الجامعة، يحتاج الطالب العراقي إلى تقديم طلب من مكتب حزب البعث العراقي في دمشق ليُرشِّحَ نفسه، ويُعّدُ بعدها حزبياً. أما منحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد كانت مُخصصة لمن سُجِّلوا كلاجئين. لم تكن هذه الفُرَص كافية، لذا كان على العراقيين العودة إلى الوطن للحصول على تعليم جامعي.
مع نصائح والديّ عشنا على الحياد، لم نتعرّض للكثير من العنصرية مثل غيرنا، لأننا اخترنا وسطاً لم يتأثر بارتفاع أسعار العقارات، ولأننا كنا بعيدين كل البعد عن جرمانا ونتبرأ في كل مناسبة مما يحدث فيها لِنحظَى بالقبول. حصلتُ أيضاً على صديقة عراقية، شاركتني CD ألبوم حسام الرسّام الذي أطلقه في 2007، أحد أكثر الأعوام دموية في العراق، والذي كان بعنوان «كان خادم». بِيعَ هذا الألبوم بشكل جنوني في سوريا وغيرها من دول اللجوء، لاحتوائه على أغنيتين حزينتين تنعيان العراق: عندي وطن ومو قالوا. أغنية كان خادم كانت عن الوضع في العراق أيضاً بشكلٍ غير مباشر، فالحرب والسرقات والخسائر صنعت طبقات جديدة، وهذا أيضاً كان شأناً يُحزن الكثير من المغتربين الذين خافوا العودة إلى العراق الذي لم يعودوا يعرفونه، وقرروا بناء حياة جديدة خارجه دون فكرة عودة.
2011 كان عاماً فاصلاً بالنسبة للسوريين، ومثلهم العراقيون في سوريا. الثورة السورية كانت الفصل، عندما بدأ السوريون يتحدثون في السياسة كان على العراقيين البقاء في صمتهم، خصوصاً وأنهم ممتنون لبشار الأسد الذي فتح أبوابه، ولم يُزعجه أن نتسبّب بارتفاع أسعار الإيجارات أو بـ«انتشار الدعارة». عائلتي كانت مُمّتنة مثل غيرها. ورغم الوجود الكبير للعراقيين في سوريا، كان هذا الوجود هشّاً ولا تكفيه المطاعم العراقية. الإبعادُ السياسي عن سوريا للمقيمين فيها لم يكن يحتاج أي جهد من الحكومة السورية، فالعراقيون يعرفون هذا النوع من الأنظمة جيداً، وسيَبتعدون عن السياسة بأنفسهم، وبالمقابل لديهم أحداث العراق بأكملها للخوض فيها، وانتخابات عراقية تجري في سوريا للمشاركة فيها، ولم يبدُ للكثير منا أننا نمتلك الحق أصلاً بالتدخل في شؤون دولة ليست وطننا، وإن قضينا عمراً فيها.
بالإضافة إلى الامتنان والخوف، خاف بعض العراقيين أن تتحوَّلَ سوريا إلى عراق آخر، ما زاد من تأييدهم للنظام على الأقل في عام الثورة الأول. بعدها عرفنا أن سوريا التي أحببناها لن تعود كما كانت مثلما حدث في العراق، لذا فإن خيار العودة كان الخيار الوحيد للكثيرين، فالأمان الذي طلبوه فُقِد، والطائرات الحربية التي هربوا منها تَحوم فوقهم مجدداً، والقناصون يتمركزون فوق الأسطح مجدداً. في الوقت نفسه كانت الأمور أهدأ في العراق، وكان علينا أن نعود إلى عائلاتنا وبيوتنا.
عادت عائلة صديقتي قبلنا، ودخلتُ أنا الجامعة في دمشق. في الجامعة نسيتُ عراقيتي قليلاً، أو تناسيتها لأستطيع الاندماج في سوريا. كانت عائلتي تُخطط للعودة، وأتشبّثُ أنا بسوريا بأسناني. لم أعد أجيب عن أي أسئلة متعلقة بصدّام أو الحرب، أردتُ أن أسمعهم. تخلّيتُ عن لهجتي العراقية، وأتقنتُ اللهجة الشامية. سمعتُهم وقررت أن يكون لي رأيي السياسي المشابه لرأيهم. كان عليَّ أن أسمع كثيراً لأتخلص من سطوة الامتنان للحكومة السورية التي رُبّينا عليها كعراقيين في سوريا، ومن سطوة ما تربّيت عليه في العراق حيث يحق للحاكم قتل معارضيه وسجنهم. تعلّمتُ أن هذا ليس طبيعياً، واخترتُ الجانب الذي أقف معه رغم أني لم أقم بأي فعل، لم أخرج في مظاهرة ولم أتحدَّثْ بصوتٍ عالٍ. لم أَكُن لوحدي، إذ ما زال حتى الآن شبّان عراقيون في المعتقلات السورية، خرجوا في مظاهرات أو تحدثوا عن رأيهم أمام مُخبِر، وبعضهم اختفى دون أن يعرف أحد ما فعلوا.
عبّرتُ لعائلتي بصراحة عن دعمي للثورة السورية فخافوا أكثر، وذَكَّروني بكم عليَّ الامتنان لهذه الدولة التي احتضنتنا كل هذه المدة.
حتى اليوم، لم أُفكر في سنوات عيشي في سوريا كجزء من عشرين عاماً على غزو العراق. مع الوقت كنت قد نسيت عمداً، لم أُرِد أن أكون ابنة الحربين. الفتاة التي لم تَعرِف بحرب العراق ذَكَّرتني بهويتي العراقية المُرتبطة بالحرب، لأحمِلَها جنباً إلى جنب مع انتمائي الذي اخترتُهُ لسوريا وكل مأساتها. أُفكر بذلك الموقف، ولا ألومها على عدم معرفتها بما حدث في العام 2003؛ إن كنتُ أنا أريد النسيان فلماذا أُطالبها بالمعرفة؟ تُنشَر الصور الرهيبة بمناسبة مرور عشرين عاماً لتنكأ الذاكرة، نجَونا من هذا ولم يَنجُ غيرُنا. نظنُّ أننا نجونا، لكننا نُهاجر مرة أخرى من بلدان بقينا فيها طويلاً. البعض منا عاد إلى بيته، وبعضنا اختار عودة مختلفة، إلى أربيل؛ ذهبنا إليها نحن والسوريون الذين عشنا معهم لأن بيوتنا ذهبت، أو لأن الحياة كما نعرفها في بغداد قد انتهت، ولا نريد أن نرى هذه النهاية بأعيننا كل يوم.