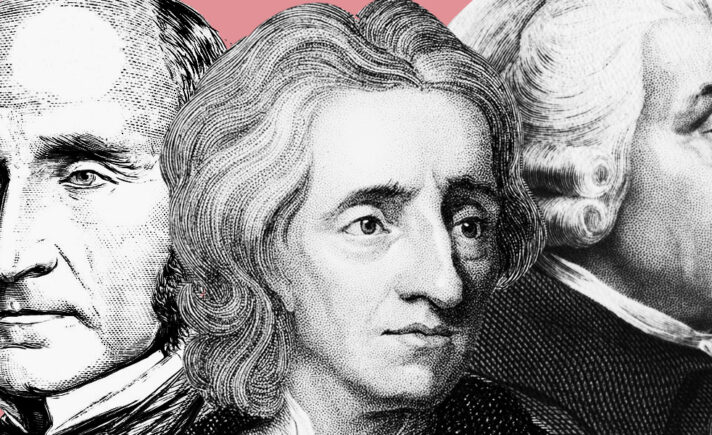لزمن طويل، ارتبط مصطلح التراث الثقافي بالأبنية القديمة؛ من دُوْر العبادة والقِلاع والأسوار التي تركَتها لنا شعوب وحضارات مختلفة. يُعرَّف هذا النوع من التراث بالتراث الثقافي المادي أو الملموس. لكن كيف كانت هذه الشعوب تعيش في مُدِنها؟ كيف كانت طبيعة حياتهم اليومية؟ طقوسهم الدينية؟ غالباً ما كنا نستنتج بعض الأجوبة عن طريق التاريخ الشفوي والتقاليد التي نقلتها الشعوب عبر الأجيال؛ كالطعام والعادات اليومية والفنون والمعارف واللغة والطقوس الشعبية والأعياد الموسمية، إضافة إلى الكتابة واللَهجات والتاريخ المُتناقَل عبر الأجيال؛ يُعرَّف هذا كله بالتراث اللامادي.
في العقود القليلة الماضية تزايدت أهمية هذا التراث، خاصةً في مواجهة موجات العولمة، باعتباره تراثاً هشّاً ومُعرّضاً للزوال في حال عدم وجود توثيقٍ كافٍ له. كما أنه يتعرّض للاندثار الآن لأسباب مختلفة، أبرزها موجات الهجرات القسرية للملايين من الناس من أوطانهم، وفقدانهم الروابط المُجتمعيّة التي حافظت على ديمومة ثقافتهم المشتركة.
في مدينتنا، حمص، ومع تدمير أكثر من نصف أحياء المدينة منذ عام 2011، وتهجير الكثير من أهاليها من بيوتهم، نعود لنسأل عن التراث اللامادي. ما هو تاريخ مدينة حمص؟ مَن كَتبه؟ ما هي المعارف المكتوبة عن هذه المدينة؟ وهل يُمكننا عن طريق هذه المعارف أن نُعيد تشكيل وصياغة تاريخ نحتاج له اليوم، في زمنٍ من الضياع الجغرافي ما زلنا نعيشه؟ هذه الأسئلة حول التراث اللامادي تُصبِح ضرورية اليوم لنعرف من نحن في حمص، ومن هي حمص.
لا ندّعي في هذا المقال أننا نكتب تاريخ المدينة، أو حتى أننا نقترب من ذلك، هي فقط شذرات من هذا التاريخ، وبعض التفاصيل عن تراثٍ لاماديّ كان إلى فترة قريبة حياً في عُرْف الناس، والآن لم يبقَ منه إلا بعض الذكريات التي تدور على ألسنتهم، ونعود نحن هنا إلى كتابته من منظور مختلف.
متاحف للسياح
عشرات الكتب كُتبَت وطُبعَت عن تاريخ المدينة وتُراثها، جميعها كانت في طبعاتٍ محدودة العدد، وغالباً ما كانت على نَفَقة كُتّابها، مبيعاتها محدودة ومعرفة الناس بها أيضاً كذلك.
لم يكن يهتمّ بتاريخ المدينة إلا قلّة من الناس، ولم يَعرِف الجميع هذه الكتب بالتأكيد، وما كان معروفاً من قِبَل مُعظم أهالي المدينة قبل 2011 كان يتم تناقله شِفاهاً، سواء عن التراث المادي أو اللامادي للمدينة، وللأخيرة حصةٌ أكبر في هذه المرويّات، دون التحقق منها إلا ما ندر، أو تدوينها والتثبُّت من صحتها أو مرجعيتها التاريخية، فلم يكن الوضع كما هو عليه الآن؛ مصادر مفتوحة وكتب إلكترونية وازدياد في عدد المُهتمين بتراث المدينة وفي تداول المعلومات فيما بينهم، وانكشاف أرشيفات مكتبات عالمية تحمل بعضاً من تراثنا.
سنة 2004، بالصدفة وقع بين يدي أحد كاتبَي هذا المقال كتاب صفحات من تاريخ حمص، لمؤلفه إيلي شهلا، يحمل بين أوراقه فُتاتاً من تاريخ المدينة وليس تأريخاً علمياً مُحكَماً لها.هذه التجربة الخاصة عن تراث حمص هي تجربة وائل ريحاني، ولذلك كُتبت المقاطع المتعلقة بها فقط بضمير المفرد. ما كان يلفت النظر في هذا الكتاب، أمام أشخاص لا يعرفون شيئاً عن تاريخ مدينتهم، هو الحديث عن جامع خالد بن الوليد وبنائه الجديد بداية القرن العشرين على أنقاض قديم لم نعرف شكله إلا مؤخراً من بعض الصور المُكتشفة في الأرشيف العثماني. هُدِم هذا الجامع القديم الذي بُنيَ قبل أكثر من سبعمائة سنة، وبُنيَ على شكله الذي نعرفه والذي دخلناه مراراً وتكراراً، لكن لم نكن نعرف، إلا من هذا الكتاب، عن وجود غرفة هي عبارة عن متحف صغير يحوي مقتنيات من المسجد بشكله القديم. سألت من هُم أكبر مني عنها، لم يكن أحد يعلم بوجودها، فذهابهم إلى الجامع يقتصر على الدخول من البوابة إلى الصحن الداخلي ثم حرم المسجد للصلاة.
بحثت كثيراً حتى عرفت أن القائم على المتحف، فيصل شيخاني، هو أحدُ مؤرخي المدينة والمعنيين بتاريخها، وله كتب مطبوعة حول ذلك، وأن هذه الغرفة تحتوي بعض ما بقي من آثار المسجد القديم: بضع لوحات حجرية ورخامية، والمنبر الخشبي القديم الذي أمر ببنائه نورالدين الزنكي. دخلتُ المسجد كمن وجد كنزاً لا أحد يعرف بوجوده قبل ذلك إلا قلة ربما، وقابلتُ عند بابه ذلك المؤرخ الذي رأيتُ صورته عبر أحد المواقع الإلكترونية، بعد أن بحثت عنه وعن كتبه. قابلني بنظارته السميكة مُتفحّصاً بعد أن رميت عليه السلام، «شو بدك عمو؟»، طلبتُ إذناً بأنني أريد أن أزور المتحف، فقال لي المؤرخ إن هذا المتحف للسياح.
بقِيَت جملة المؤرخ عالقة في الذهن فترة طويلة، عن معنى أن لا نعرف شيئاً عن تاريخنا، وكيف أن الجيل الذي سَبَقنا لم يكن يعرف الكثير أيضاً، سوى المرويات الشفاهية التي يختلط فيها الحقيقي بالمزيّف، بحثتُ طويلاً عن كُتِب المؤرخ حتى وجدتها، وعرفتُ أن هناك كتباً أخرى تروي تاريخ المدينة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على آثار وبيوت قديمة معظمها اندثر، إنما يتعدى الموضوع إلى الثقافة والفنون والأدب، وأن هنالك أدباء مهمين مرّوا عبر السنوات وتركوا بصمتهم؛ رفيق الفاخوري، عبد السلام عيون السود، عبد الباسط الصوفي، وغيرهم الكثير. حاولتُ الحصول على معظم الكتب التي تُعنى بهم، وكان العثور على ديوان شعري للشيخ أمين الجندي، والذي ترتبط به عدة مرويات شعبية دون معرفة أصلها، هو أصعب ما واجهني، فكان البحث شاقاً حتى وجدت نسخة في دمشق، صوّرتها ليكون عندي نسخة منها، واكتشفتُ ما كنتُ قد سمعته شفاهاً دون دليل. عرفتُ بعد قراءتها أن بعض القدود التي كانت تُغنى وتُنسب لمدينة حلب هي لهذا الشاعر، أمين الجندي، وأنه تمّ غناؤها في حمص سابقاً، وربما أبرزها هيمتني التي غناها ببراعة المرحوم صباح فخري.
يقول عن ذلك الكاتب السوري – الفلسطيني تيسير خلف في مقال جديد له عن القدود:
وكان الشيخ أمين الجندي الشخصية الشعرية الأهم في جميع أنحاء بلاد الشام في القرن الثامن عشر، بحسب الكاتب جرجي زيدان، وكان، كما يُقال، مالئ الدنيا وشاغل الناس، نظراً لامتلاكه أسلوبه الخاص في التأليف الشعري، وتمكّنه من ابتكار المعاني والصور الجديدة المُصاغة بأسلوب سلس، سهل، يشجِّع الملحنين على تحويل تلك القصائد والموشحات إلى ألحان أخاذة. وكان الشيخ أبو خليل القباني أبرز من لحن بعض قصائد الجندي، وحولها إلى موشحات خالدة ما تزال تتردد على الألسن حتى اليوم، ويظنها الكثيرون من التراث الأندلسي البعيد.
ويُعدُّ ديوان الجندي أقدم وثيقة مكتوبة تأتي على ذكر القدود باسمها المعروف، إذ خُصص قسم مهم من الديوان لهذه المنظومات، مع ذكر اسم الأصل اللحني لكل قدّ، ومقامه الموسيقي، وضبطه الإيقاعي، وهو بذلك وثيقة ثمينة للغاية أيضاً حول الأغاني الشعبية التي كانت تجري على ألسنة الناس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
أيضاً مما لفت نظرنا خلال بحثنا أن معظم هذه الكتب كانت مكتوبة من قبل الرجال. وأن معظمهم لم يكونوا من الأكاديميين، حاولوا تعبئة الفراغ الموجود وتدوين تاريخ المدينة حسب معارفهم وما يوجد بين أيديهم، لكن هذا الحال بدأ يتغير، ولو بشكل بطيء، بعد عام 2011، مع ظهور عدد من الكتابات من نساء حمص مثل كتاب مروة الصابوني وكتاب نداء الدندشي على سبيل المثال.
التراث اللامادي / الخمسانات
ربما يعرِف كلُّ السوريين الحلاوة الحمصية، ولو من شكلها، وبعضهم يعرِف أن هنالك عيداً لهذه الحلاوة، لكن من يعرف عن الأعياد القديمة التي تسبِق وتلي خميس الحلاوة هذا؟ والتي أسماها الباحث الفرنسي جان إيف جيون (Jean-Yves Gillon) بأعياد الربيع القديمة؟
يذكُر جيون في كتابهJean-Yves Gillon, Les Anciennes Fetes De Printtemps a Homs, Institut Francais de Damas, 1993 أن الأعياد أو الخماسانات، كونها حُكماً تكون يوم الخميس، هي سبعة، تأتي وراء بعضها، وتُختَم بخميس المشايخ. وهي مُقسّمة إلى قسمين، أربعة ما قبل الاعتدال الربيعي وثلاثة ما بعده.
وماعاش من هذه الخماسانات حتى فترة قريبة هي الأخمسة الثلاثة الأخيرة المُرتبطة بالربيع، كونها تأتي في فصله، والتي بالإمكان تتبُّع أخبارها؛ الأول هو خميس النبات والذي تلاشت احتفالاته في عام 1920 مع دخول الفرنسيين إلى سوريا واتخاذ القلعة ثكنة عسكرية، والثاني خميس الأموات أو ما يُعرف بين الناس بخميس الحلاوة، والثالث هو خميس المشايخ. بعض هذه الخمسانات لا يقتصر على حمص، بل يوجد في مناطق أخرى من بلاد الشام، مثل القصير والبقاع اللبناني ويبرود وقرى فلسطين، مع اختلافات في طريقة الاحتفال وزمنه بين منطقة وأخرى.
وما يهمنا هنا هو أول عيدين من المجموعة الثانية، لما لهما من طقوس مختلفة عن السائد، طقوس تُعنى بالنساء بالدرجة الأولى، في زمن تغيب فيه النساء عن مرويّاتنا التاريخية.
أولها خميس النبات الذي يسبق خميس الأموات/ الحلاوة المعروف بأسبوع، واسم هذا الخميس يأتي من أسطورة تقول إن هناك بئراً عميقة في قلعة حمص، وإن النساء، خصوصاً العازبات منهن، كنّ يلقينَ حجراً في هذا البئر في هذا اليوم المخصّص، فإذا ترك الحجر صوتاً خلال ارتداده في البئر راجعاً إلى أذن المُلقية، فهذا يعني أن مُلقية الحجر قد نَبَت حظها، وإذا كان العكس فإن حظ البنت سيكون سيئاً.
مراسم هذا الاحتفال كانت تبدأ قبل يومٍ من الخميس، من البيوت، عندما كانت النسوة ينقعنَ الزهور بالماء ليلة كاملة، حتى يغسلنَ به وجوههنَ في صباح يوم الخميس، ثم يبدأ المسير نحو القلعة محمَّلين «بالخس» لأكله هناك، والتجمُّع يكون قُبيل المغرب عند سفح القلعة، أحياناً لم يكن المكان يتسِّع، فكانت المقابر المجاورة للقلعة ملاذاً للنسوة، ملاذاً بين حياة جديدة «تفلق الصخر» للفتيات أمام موت يجلسنَ بقربه، في استدعاء للخصوبة التي يرمِز لها صوت طنين الحجر.

في هذا الربيع (6 نيسان هذه السنة)، يحتفل أهل حمص بعادةِ بقيَ جزءٌ منها حيّاً إلى الآن، هو خميس الأموات، أو ما يُعرف بين الناس بخميس الحلاوة، وفيه ينتشر الباعة مع أنواع الحلاوة الحمصية المختلفة في الأزقة والطرقات لبيعها قبل أيام من الموعد، من قبل المختصين بإنتاج هذا النوع من الحلويات وأيضاً من غير المختصين الذي يجدونه وقتاً مناسباً لزيادة دخلهم. بعد نهاية هذا الخميس الذي يتغيّر موعده سنوياً وفقاً لعيد الفصح حسب التقويم الشرقي، تُزال بسطات الحلاوة من الشارع لتبقى بعض المحال المختصّة في بيعها.
بعد قراءة لبعض المصادر، نرى أن ميزة هذا العيد أيضاً أنه ذو طابع نسائي محض، ففيه تخرج النسوة بعد ظُهر الخميس إلى المقابر، لتوزيع ما حملنَ معهن من أنواع الحلاوة على القرّاء أو الزوار الذين ينتشرون في هذا اليوم حول القبور، وخصوصاً الفقراء منهم. كما أن هذا العيد يرتبط بالموت بشكل مباشر، ويمكن التعاطي معه على أنه حالة تذَكُّر للأموات بطريقة أصبحت تدعو للفرح، بمعنى أن «الاحتفال بالحياة البشرية يؤدي في الوقت ذاته إلى استدعائها» حسب توصيف جيون. خفَّت عادة زيارة القبور منذ منتصف القرن الماضي وحتى بداية 2011، وأصبحت مُقتصرة على عائلات قليلة جداً تقوم بهذه المهمة بعد أن كانت المدينة بأكملها تقوم بهذا الطقس، حتى أصبحت الحلاوة التي تنتشر في الطرقات هي: «مظهره الوحيد، وعليها وحواليها تدور مباهجه وأحداثه» كما يقول الأديب والشاعر رضا صافي في مذكراته عنه.
إذن كان هذا العيد/ الطقس مختصاً بالنساء كما يقول جيون، النسوة يذهبن للمقابر مع الأطفال في هذا اليوم ليقُمنَ بتوزيع الحلاوة على روح الأموات، الأموات الذين ذهبوا مع الزمن، ولم يبقَ من هذا العيد سوى الحلاوة التي تُباع في الطرقات، ومعه العبارة الشعبية المعروفة التي تقول «الله يرحم الأموات شو كانوا يحبوا الحلاوات».
في زحمة الموت التي ألمّت بالمدينة منذ أكثر من عشرة سنوات، كان من المتوقع أن تندثر عادة انتشار بيع الحلاوة في الطرقات، لكن بقي هذا الطقس وحده يقاوم حتى الآن، رغم ما مرّ على المدينة من ويلات خلال السنوات الأخيرة. وأيضاً ربما يكون الموت الذي شهدته المدينة منذ،2011 وحُصدت فيه أرواحٌ غالبيتها من الرجال، جعلَ الطقس يعود إلى أصله باعتبار المدينة الآن مدينة نساء، فأصبح لهذا الخميس معنى مختلف، طقس لا يُمارس كما السابق، لكنه ما زال يُذكر بالتأكيد، ويحمله من بقي ومن يعيش في المنافي.

هل يمكن أن نكتب تاريخ حمص النسوي؟
ارتباط هذين العيدين بالنساء على نحو ملحوظ، جعلنا نُفكر ونبحث أكثر إذا ما كان بالإمكان الكتابة عن تاريخ مختلف قليلاً، لا يتطرق له التاريخ عادة، هو تاريخ النساء في حمص، أو تاريخ حمص النسوي.
أثناء بحثنا في الكتب التاريخية عن حمص وجدنا صورةً بالأبيض والأسود لمجموعة من نساء المدينة عام 1897، كانت تُدعى جمعية العفاف. تُظهر الصورة عشر نساء، خمسٌ منهن جالسات في الصف الأول وخمسٌ واقفات في الصف الثاني. وعندما نظرنا لكل واحدة منهن، لمحنا ملامح مدينتنا ووَددنا أن نُذكِّر أهلها بها. بالرغم من أن الصورة مظلمة مع لباس النسوة الغامق اللون، وخلفيتها معتمة، إلا أنها صورة تدعو للأمل والفخر بنساء حمص وأعمالهن الخيرية.

قليلةٌ هي المعلومات المكتوبة عن هذه الجمعية في صفحات هذه الكتب. لكن نعيم الزهراوي وغيره من المؤرخين كتبوا بأنها كانت أول جمعية نسائية في حمص. فقد تأسست جمعية العفاف بأيادي خريجات المدارس الأرثوذكسية. وكان للجمعية أعمال خيرية عديدة منها بناء مشفى الحميدية، وإتمام كُلفة إنشاء مدرسة البنات.
يسمح لنا تراث حمص اللامادي، كما نحاول أن نثبت في هذا المقال، كتابة نوع ثان ومختلف من التاريخ، ككتابة تاريخ نسوي يرتبط بنساء المدينة وتاريخهنّ فيها وحياتهنّ اليومية. لكن كيف نعرف هذا التاريخ في حال تغييبه وتهميشه؟ في قراءات حول التراث النسوي العربي، تكتب ابتهال محادين:
لعلّ من أشد الفداحات التي ترتكبها النُظُم التعليمية العربية تغييبها التام لتاريخ وتراث النساء، وللتاريخ والتراث من منظور النساء. فإلى جانب فشلها الذريع في تخريج أجيال قادرة على التفكير النقدي والسؤال والبحث، وتعمّدها، على ما يبدو، التجهيلَ ووأد المواهب، فهي تجتهد في إسكات الأصوات المختلفة أو الروايات المناوئة لما يسمى «المقرر».’
تتزايد اليوم الاهتمامات حول كتابة المدن من منظور نسوي. فمثلاً، في كتابها المدينة النسوية: المطالبة بالفضاء في عالم من صنع الرجال، تدعونا ليزلي كيرن للتفكير في مدن النساء. هذا التفكير يتزايد في حالات الحروب مع تهجير وتغييب واعتقال الرجال في المدن. وفي مدينتنا حمص كتبت يوماً منى رافع عن مدينة النساء التي أصبحتها حمص وتغييرات دور المرأة في المدينة:
هل تخيلتم معنى فقدان الرجال في وقت الحروب بالنسبة لنساء يُسمّينَ الرجل «رب البيت»؟ هل تخيلتم العبء الثقيل على كاهل امرأة تسمونها تصغيراً «الحريمة»، ثم إذا كانت قوية أسميتموها «أخت الرجال»، لأن العلاقة بينكم وبينها كانت دائماً علاقة التابع بالمتبوع. ثم تستهينون بها في مواقف الشدة لتصبح عبئاً عليكم في حال الخطر، بدل أن تكون في نظركم سنداً وظهراً وبديلاً عنكم في غيابكم الاضطراري، وهو ما يحصل غالباً بطبيعة الحال، إذ تقوم النساء بكل المهام في ظروف الحرب الصعبة، وهو الأمر الذي يعلمه كثيرون منكم رغم عدم الإقرار الصريح به.
يسمح لنا التراث أن نفهم تاريخنا إن أردنا ذلك، وأيضاً إمكانية ربطه بالحاضر. ففي هذا المقال مثلاً، نربط جمعية العفاف بالجمعيات التي تديرها النساء اليوم في حمص والحملات والاستجابات التي يقمنَ بها، خصوصاً فترة الزلزال الأخير، وندعو أهل حمص في المدينة وفي المهجر لكتابة تاريخ بأياد نساء المدينة، أو على الأقل عنهن، لرواية حياتهن في مدينة النساء، للاحتفاء بهنّ لكونهنّ ما بقي لنا في تلك البلاد، وما يفعلنه الآن يفوق قدرة أي إنسان في ظرف طبيعي، فكيف الآن؟ للأمهات الوحيدات بعد تهجير شبابها، للأخوات اللواتي بقين في مدينة الدمار، للمعلمات، العاملات، الأكاديميات، والوحيدات في زمن الحرب. لنساء حمص، لنكتب.
نعلم أيضاً أن التاريخ يمكن كتابته، ليس فقط في كتب التاريخ ولكن في فراغات المدينة: في الشوارع والساحات، في أسامي المدارس ودور العبادة. ففي حمص مثلاً، ما هي أسامي النساء التي تربِطُ النساء بالمدينة؟ نبحث في خريطة المدينة لنجد معظم أسامي الشوارع والساحات والمدارس تخلّد أسامي الرجال (مثل شوارع زكي الأرسوزي، نزار قباني، شكري القوتلي وكعب الأحبار) مع ندرة قليلة لذاكرة النساء في المدينة كمدرسة الخنساء، مدرسة حميدة الطاهر، مدرسة أم البنين، كنيسة أم الزنار التي تُحيل إلى زنار السيدة مريم الموجود في إحدى كنائسها القديمة، وساحة كرجية حداد؛ السيدة الحمصية المغتربة التي تبرّعت بالكثير للمدينة، ومنها بناء ساعة حمص الجديدة التي أصبحت معروفة للجميع.
إذن يساعدنا التراث الثقافي اللامادي على إعادة كتابة تاريخنا، ويتيح لنا القدرة على تسليط الضوء على طبقات من التاريخ المنسية، المهمشة، والمكتومة. في ظل سيطرة الحكومات والسياسيين على كتابة تاريخ اختياري لخدمة مصالحهم وإعادة صياغته وفق ذلك، يُمكِّننا التراث اللامادي من استرجاع أصوات منسية، وكتابة قصص تساعدنا بأن نحتفل بنسخ متعددة من التاريخ المُعرَّض للزوال، وخاصة في زمن نخسر فيه تراثنا المادي.