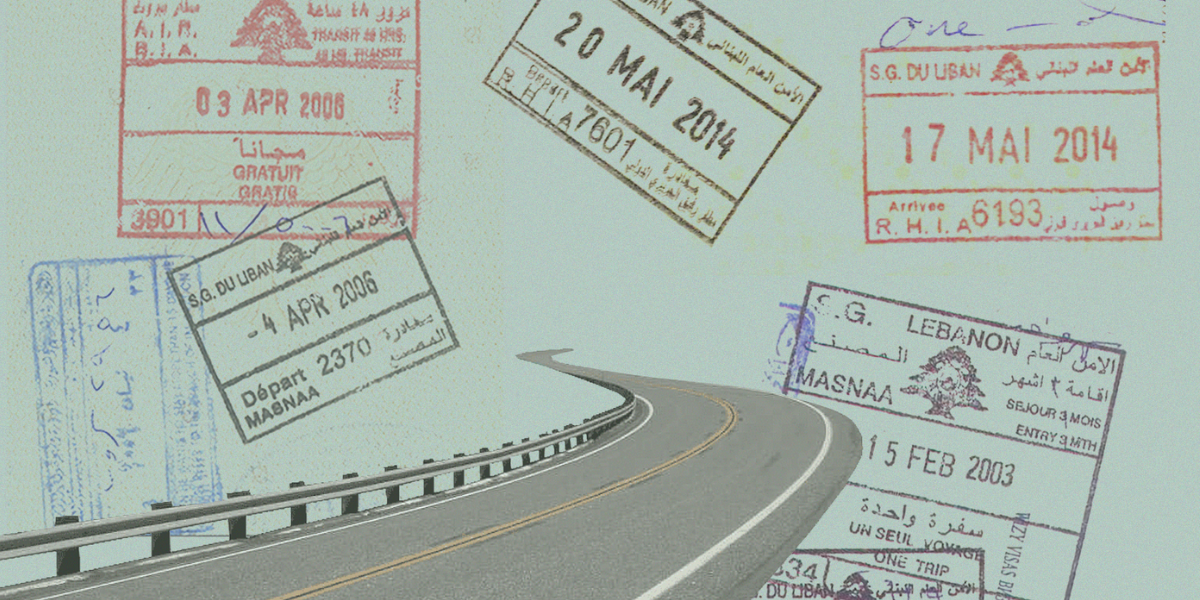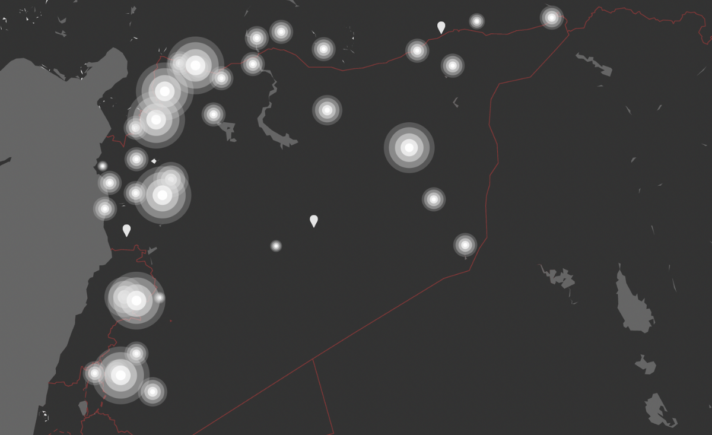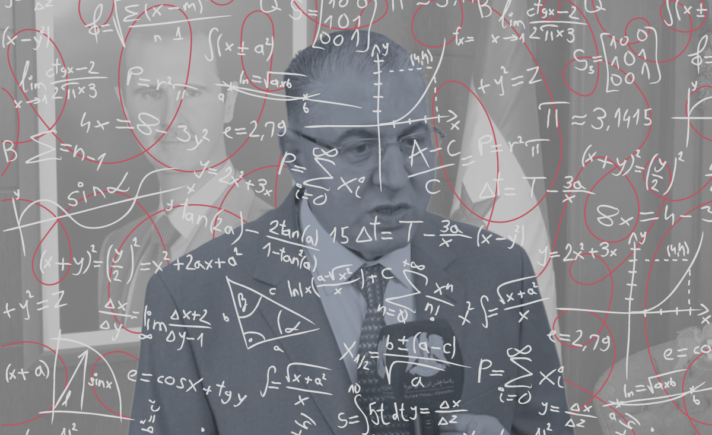دُعيتُ، مطلع فبراير(شباط) الماضي إلى مُلتقى شبكة «فبراير للإعلام المستقل» الخامس في بيروت، والذي أُقيم بين الـ 20 والـ 24 من الشهر ذاته. وكما هو مُقدَّر للسوريين أن يعيشوا المغامرات في أصغر تفاصيل حياتهم، بدأت مغامرة الرحلة إلى العاصمة الأقرب بيروت عندما قررتُ الذهاب بالطائرة، عوضاً عن البر، نظراً إلى تعقيدات الشروط وتقلُّباتها ومزاجية موظفي كلا الحدودين. بدأت بالبحث عن رحلة مناسبة، ولم أجد لدى السورية للطيران أو شركة أجنحة الشام رحلة مناسبة مع موعد الملتقى، الذي يبدأ يوم 20 شباط. أقربُ رحلة كانت يوم 22 شباط الساعة 11 ليلاً، ما يعني أنني لن أحضر سوى أقل من نصف أيام الملتقى.
بحثتُ عن رحلة مناسبة من دمشق إلى بيروت عبر خطوط طيران أخرى، وبالفعل، وجدتُ رحلة عبر خطوط فلاي بغداد، لكنها لم تكن مباشرة، بل كان هناك عبور «ترانزيت» في مطار بغداد. وأُتيح لي خياران للرحلة، الأولى بـ «ترانزيت» ساعة، والثانية 4 ساعات و35 دقيقة. لكن هنا برزت مشكلة أُخرى، أن الأولى لم تسمح سوى بحمل 5 كيلو فقط، وهو أمرٌ غير ممكن إطلاقاً لشخص ينوي الإقامة لمدة خمسة أيام في بلد آخر، لذا اخترنا الثانية، وقلت «أمري لله بقعد هالقعدة…». تجهّزتُ نفسياً، وجلبتُ معي ما سأقرأه خلال ساعات الانتظار تلك في مطار بغداد، ومن باب الثقة المُفرطة في الواقع، جلبتُ كتابين وليس كتاباً واحداً، كما من باب التنويع وتفادياً للملل.
وصلنا إلى المطار قبل موعد الرحلة، 19 شباط الساعة 1:00 ظهراً، بحوالي ساعتين ونصف، احتضنتُ زوجتي وقبّلتها وودّعتها وصديقي المُقرّب ودخلتُ منطقة التأكيد الـ(Checkin) في مطار دمشق، بينما هما عادا لاستكمال حيواتهما، مُطمئنَين عن سير العملية كل نصف ساعة تقريباً.
حان دوري، وأبرزت جواز سفري وتذكرتي وحجز الفندق في بيروت. استغربَ الموظف، وقال: «رايح على بيروت، شو آخدك على بغداد؟»، فقلتُ له إنني محكومٌ بالوقت ولم أجد رحلة مباشرة أنسب، فطلب مني الانتظار قليلاً، وراح يُراسلُ ويتحدّث إلى هذا وذاك على الواتساب، وأنا أنتظر، والمغادرون معي على الطائرة نفسها يتوافدون، يُرسلون أمتعتهم ويتوجّهون إليها. أصبحت الساعة حوالي 12:30، والأمل بدأ يتقلص دون الحصول على جوابٍ واضح، أو حتى غير واضح.
وصلَ الجواب أخيراً، واتَّضحَ أنه من غير الممكن لمطار دمشق السماح لي بركوب الطائرة المُتجهة إلى مطار بغداد، والسبب يعود إلى بروتوكول خاص بالأخير، وهو وجود منطقة واحدة فيه فقط للعابرين «ترانزيت» من خلاله، وإن كانت تلك المنطقة مشغولة من قبل خطوط طيران مُعينة فلا يمكن لأي خطوط أخرى إنزال الركاب فيها، ومضى ذلك الوقت ونحن نتحقّق من شركة الطيران التي كانت تشغل تلك المنطقة، واتضح أنها لم تكن فلاي بغداد.
الحلُّ الوحيدُ كان الحصولَ على تأشيرة لدخول العراق، والتي تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين، خلال مدة ربع ساعة قبل انطلاق الطائرة، وذلك رغم تَحقُّقي من عدم الحاجة لها إن كان هبوطي في بغداد مُجرّد «ترانزيت». كان هذا ما وصلنا إليه، واعتذر مني موظفو المطار بألبق العبارات.
عُدتُ أدراجي، وشاهدتُ وأنا عند بوابة المغادرين في مطار دمشق الرحلةَ التي كان من المفترض أن تقلّني تُقلع من فوقي. اتجهت إلى إحدى سيارات الركاب التي تقلّ العائدين من المطار، وبعد «الحمدلله عالسلامة أستاذ»، اخترتُ سيارة، دفعت له مسبقاً، وطلبت منه التوجه إلى عنوان منزلي. حينها لم أكن أريد سوى الاستلقاء، والنوم ربما.
صادفَ أنني أعرفُ السائق، أبو علي، الذي اختاره لي مسؤول التكاسي. والمعرفة في هذا السياق تقتصر على رحلة سابقة معه. ودار بيننا الحوار التالي:
- شو وضع الطلعة على بيروت بالبرّ؟
- مين اللّي بدو يطلع؟
- أنا.
- شو معنا غراض؟
- هالشنتة اللّي لحشناها ورا بالصندوق.
- إيمت؟
- هلأ إذا شغّال بدل ما نروح عالبيت منكمل ع بيروت.
- لا والله بعتذر منك أنا عسكري، بس رح حاكيلك أبو عهد، هاد زلمة مرتب وصرلو عالخط 15 سنة
اتصل بأبو عهد، وأخبره عني، فطلب منّا اللقاء في منطقة كفرسوسة، وأَطلعته على أوراقي المكوّنة من جواز سفر وإعفاء من الخدمة العسكرية – لعدم وجود أخوة ذكور – وحجز فندقي ودعوة من مؤسسة فبراير، فقال «محلولة»، وبدأ بإرسال تلك الأوراق إلى شبكة معارفه على واتساب، من باب التحقُّق من صلاحتيها لدخولي لبنان. قال لي مشكوراً: «واحد غيري بيقلّك طلاع وإذا ما مشي حالك بيدوّر وبيرجعك وبياخد أجرته، نحنا إن شالله ما مندقّ مارش لأتأكدلك إنك بتمرق عالحدود السورية واللبنانية».
شكرته، وجلستُ أُشاهد صور أوراقي تتراوح بين مجموعات السائقين وعناصر الأمنَين السوري واللبناني، ليصل الجواب الأول، تلك الأوراق لا تكفي، بينما قال الآخر تكفي، لكن دعوة فبراير تحتاج تصديقاً من الأمن العام اللبناني، الأمر الذي سيأخذ ما لا يقل عن يومين، لذا اعتبرناه خياراً غير متاح كذلك.
الأمل الأخير المُتبقي كان عند المدعو أبو صالح، صديق أبو عهد في الأمن العام السوري، الذي أشعل الأمل فيَّ بتسجيل صوتي قال فيه: «خلص لا تهكل هم، رح مشيلك ياه عالحدود السورية، بس خليني شوف مين يمشيله ياها عالحدود اللبنانية»، وبدأت رحلة انتظار جواب أبو صالح.
مرّت ساعة، ساعتان، ثلاث، ونحن في الشارع ننتظر أبو صالح، وبحسب الظاهر، فإن أبو عهد، رُبما، كان أدنى من أبو صالح في الهرم الوظيفي ضمن شبكة التهريب، فلم يجرؤ على الاتصال به والتحقق من الأمر، بل اقتصر الأمر على رسائل وتسجيلات صوتية كان رد أبو صالح عليها تارة «يلا عم شفلك»، وتارةً رسائل محوّلة من صديقه في الأمن العام اللبناني يقول فيها «رح خبرك شو وضعها».
حَلّت الخامسة عصراً تقريباً، وكلانا، أنا وأبو عهد، مُنهك، فاتفقنا أن أعود إلى المنزل، وأن يخبرني أبو عهد بجواب أبو صالح حين يصله، إن كان القبول نلتقي وننطلق نحو بيروت على الفور، وإن كان الرفض، فـ «العوض على الله». وبالفعل، عند الساعة السابعة تقريباً أرسل لي تسجيلاً صوتياً من أبو صالح يعتذر فيه عن عدم قدرته على فعل شيء، وأن الدعوة فعلاً ستتطلّب تصديقاً من الأمن العام اللبناني.
لكن أبو عهد لم يتركني وحيداً، وأرسل لي رقم هاتف «المدام راما» التي ستُقَدِّم لي عرضها البديل الذي لا أستطيع رفضه. اتصلتُ بالمدام راما، التي، بحسب أبو صالح، لها علاقات قوية مع الأمن العام اللبناني، والتي بدا من لهجتها أنها لبنانية، وأفادت بعرضها، الذي كان عبارة عن قطع تذكرة طائرة لي ستنطلق من مطار بيروت، وتأمين تجاوزي للحدود السورية تهريباً، ومن ثم دخول اللبنانية بشكلٍ رسمي من خلال تلك التذكرة، وعند العودة، ألتقي بفريقها للحصول على بطاقة تخولني من العودة إلى الأراضي السورية من خلال هويتي، بما أنه لن يكون على جواز سفري ما يثبت مغادرتي الأراضي السورية.
رفضتُ العرضَ مباشرةً، أولاً لأنه محفوفٌ بالمخاطر التي لم أكن مضطراً لاتخاذ خطوات باتّجهاها؛ فأوراقي وثبوتيّاتي جميعها سليمة وقانونية، وثانياً بسبب التكلفة المرتفعة لهذا الأمر، والتي بلغت حوالي 500 دولار أميركي.
مع تبدُّد الأمل، تبادرَ إلى ذهني المدعو «أبو باسل»، الذي تمكّنتُ من تجديد جواز سفري العام الماضي من خلاله في ذروة أيام التضييق التي ترافقت مع تفعيل المنصة الإلكترونية، والتي جعلت مجرد الحصول على موعد لاستخراج أو تجديد جواز سفر أمراً شبه مستحيل.
تواصلت مع أبو باسل، ولم يُخيّب توقعاتي صراحةً:
- مرحبا معلم، في سيارات ع بيروت اليوم؟
- في.
- حلو، بس مافي لا بطاقة نقابة ولا موافقة من الأمن العام.
- مو مشكلة.
- حلو، شو المطلوب؟
- ابعتلي صورة باسبورك وإذن السفر.
- أنا وحيد، معفى من الجيش فما بدي إذن سفر.
- طيب ابعتلي صورة باسبورك.
مضت حوالي الساعة بعد إرسال الصورة، لتأتيني رسالة من أبو باسل، بكرا الساعة 9 الصبح السيارة، واتفقنا على مكان للقاء. توجّهتُ إلى هناك صباحاً، والتقيتُ بأبو ياسين، السائق الذي سيقلّنا أنا واثنين إلى بيروت، وانطلقنا تقريباً عند العاشرة وأنا لا زلت لا أعلم كيف وماذا!
جلستُ في المقعد الأمامي، وضعت السماعات في أذني وشغّلتُ بعض الأغاني المفضلة، مُحاوِلاً الاستمتاع بطريق فيه الكثير من المناظر الطبيعية الجبلية الممزوجة ببقايا عاصفة ثلجية سابقة تُريح النظر والنفس، وبعد حوالي نصف ساعة، طلب منا أبو ياسين إرسال صور جوازات سفرنا إلى «أبو مرح»، شريك أبو باسل، وفعلنا ذلك فوراً.
لننتظر قليلاً، ويبدأ أبو مرح بإرسال المستندات، التي كشفت عن الخطة التي لم أتخيل يوماً أن أرى ما يشبهها ولا في أفضل روايات وأفلام الإثارة. المستندات التي استخرجها أبو مرح خلال تلك المدة القياسية كانت ما يلي:
- موعد لي في السفارة التركية في بيروت، يوم 21 فبراير (شباط) الساعة 8:30 صباحاً (هذا يُمكّنني من تجاوز الحدود السورية، لكن الحدود اللبنانية لا تقبل عبوري بموجبه).
- تأشيرة دخول إلى دبي مع تذكرة طيران يوم 20 فبراير(شباط) الساعة 10 مساءً، مرفقةً بصورة لإقامة أخي المُختلق (كوني وحيد لوالديّ)، المدعو «علي» المقيم هناك، والذي بفضله سأتمكن من عبور الحدود اللبنانية.
طبعنا تلك الوثائق في مكتبة قبل الحدود السورية بحوالي 3 كيلومتر، وانطلقنا، وصلنا إلى الحدود السورية لتصديق موعد السفارة التركية الذي ينتظرني وخَتم الجواز. دخلت إلى مكتب الرائد الذي يجب أن يوقع على تلك الأوراق قبل التوجه إلى الحاسوب لاستكمال العملية وإدخال تفاصيلها في قاعدة البيانات، لأنصدمَ بسؤاله غير المتوقع: «من لك في تركيا؟»، قلتُ له مرتبكاً، صديق، فطلب مني أن أغادر وأُحضر صورةً لإقامته. اعتراني بعض التوتر وخرجت إلى أبو ياسين أروي له ما حدث، فقال لي عُد إلى الداخل، وتوجَّه نحو الملازم أول الموجود في قاعة الكمبيوترات ليوقّع لك، هو وحده. عدت، وبحثت عن النجمتين على كتفه ووجدته.
دون أن أقول له شيئاً، سألني هل أنت فراس؟ أنا متفاجئاً «نعم!» واختلست نظرة على الهاتف الذي كان مفتوحاً بيده على محادثة واتساب، لأجد صورة جواز سفري! وقّعَ لي على الأوراق، وانطلقتُ نحو «موظف الحاسوب» لاستكمال العملية، التي سارت بكل سلاسة، وتم عبور الحدود السورية بنجاح، وبشكلٍ رسمي.
توقفنا في المنطقة الحرة بين الحدودين، مَزَّقنا موعد السفارة التركية المزعوم الذي انتهت مهمته، وبدأت مهمة زيارتي إلى أخي الجديد المخلوق منذ دقائق في دبي. جهزتُ تلك الأوراق، وجلسنا ننتظر جواباً من أبو مرح، الذي لديه قناة اتصال مباشرة مع الحدود اللبنانية عرف بموجبها بوجود لجنة مراقبة هناك، قد تدقق أكثر من اللازم في بيانات المسافرين، فقضينا حوالي الساعتين ننتظر مغادرتها، إلى أن جاءنا خبر إمكانية الانطلاق.
أحد المسافرين الذي كانوا معي في الرحلة يريد لسببٍ ما مغادرة الأراضي السورية بشكلٍ رسمي، لكن دخول الأراضي اللبنانية تهريباً، وهو الخيار الذي تتيحه باقات أبو باسل بالطبع (إلى جانب خيار عبور كلا الحدودين تهريباً)، فعندما وصلنا إلى الحدود اللبنانية تَرجَّلنا أنا وأحد الركاب لختم جوازات سفرنا بشكلٍ رسمي، بينما طُلب من الآخر – الهارب – التوجه إلى الاستراحة والانتظار هناك، وأُعلِمَ أنه إذا سُئل عن سبب وجوده فيجب أن يقول إنه لم يستطع دخول الأراضي اللبنانية، وها هو ينتظر أحد أقربائه من لبنان ليرسل له الـ 100 دولار الواجب تصريفها على الحدود السورية عند العودة.
المعاملة جرت بشكلٍ أكثر سلاسة على الحدود اللبنانية، سألني الموظف عن سبب الدخول، فأخبرته بزيارتي لأخي وأبرزت له التأشيرة والتذكرة، بالإضافة بالطبع إلى صورة إقامته، فتم ختم الجواز هنا أيضاً، وتم عبور الحدود اللبنانية، بشكلٍ رسمي أيضاً، بنجاح.
عندما عدنا إلى السيارة وانطلقنا، علمت من أبو ياسين عن آلية إدخال الآخر تهريباً، حيث تُرسَل سيارة تتبع لذات الشبكة، من داخل لبنان، لتقف عند الحدود اللبنانية، فتُقلّ ذاك الذي ينتظرها في الاستراحة، وتلتفّ وتتخذ الطريق العائد، وتعاود الدخول إلى لبنان.
بعدما قطعنا حوالي الـ 50 كيلومتر، انتهت مهمة أبو ياسين، لكننا انتظرنا – الهارب – ليلتحق بنا، وبدأت مهمة أبو أمين، الذي أقلّنا من هناك، إلى داخل بيروت.
بذلك، انتهت رحلة تحوّلت من مللٍ وانتظار كان سيستمر لأكثر من 5 ساعات في مطار بغداد، إلى مغامرة كان جميع المقرّبين مني قلقين حيالها، يُغرقونني برسائل اطمئنانهم، بينما أنا كنت غارقاً في متعة أني لم أشهد هكذا حبكة فقط، بل كنت جزءاً منها، عالقاً في دوامة بين احتقار الفساد وما وصل إليه، والانبهار من كم التخطيط والعقول التي تقف وراء ذلك، مُُتسائِلاً عمّا كان ممكناً لو سُخِّرت تلك العقول للعمل فوق الطاولة.