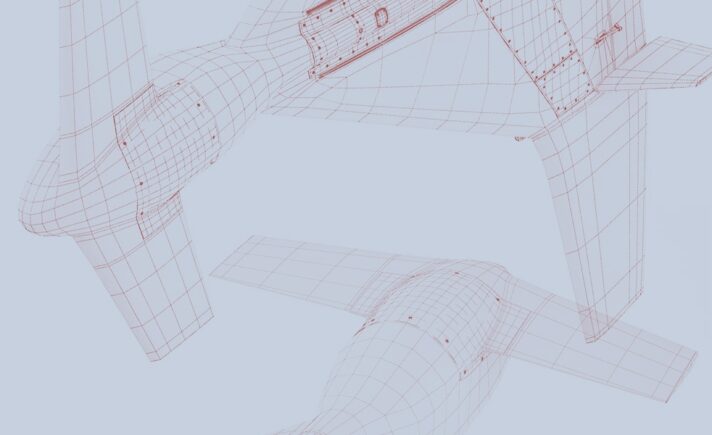في الخامس عشر من أيار الجاري حلّت الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس دولة إسرائيل، تلك اللحظة التي فتحت الباب على نكبة الشعب الفلسطيني المُستمرّة ومآلاتها، وعلى كثيرٍ من الارتكاسات والانعكاسات في الوضع العربيّ والإقليميّ، والتي لا تزال تتفاعل حتى اليوم. وفي هذه اللحظة، وبعيداً عن الاكتفاء بالغرق في أدبيّاتٍ تَنوس بين المكابرة المُغرقة في الإنكار والتفجّع المنكوب ورِثاء الذات، أجدُ أنه علينا طرح السؤال: أين، يا تُرى، تقف إسرائيل اليوم؟ ما مصير ما اصطُلح يوماً، في عزّ أيّام القوميّة العربيّة في الخمسينيات والستّينيات، على تسميته بذلك «الكيان المصطنع المزروع في الأرض العربيّة»؟ وكيف يمكننا التعامل مع إسرائيل والتحدّيات التي تفرضها ويفرضها وجودها المستمرّ علينا؟
هذه المقالة محضُ مُحاولةٍ لرؤية حقيقة إسرائيل اليوم، كما تبدو لنفسها ولنا، ومحاولة للنظر بدقةٍ إلى تاريخ نشأة فكرة الدولة ثم تجسيدها، والعامل غير العسكريّ لقوّتها (الاقتصاد)، ونقطة ضعفها البنيويّة الأساسيّة (التفرقة والعنصريّة الممنهجة)؛ لعلّ ذلك يُعطينا إمكانيّة رسم تصوّراتٍ عن احتمالات المستقبل القادم وكيفيّة إدارة الصراع معها بطريقةٍ أكثر رشداً ونجاعةً من الوضع القائم حاليّاً.
«ما بُنيَ على خطيئة…»؛ تاريخٌ مضطّرب لحلمٍ «مستحيل»!
لم يمرّ سوى أقلّ من 51 عاماً بين لحظة المؤتمر الصهيونيّ الأوّل في «بازل» في سويسرا في التاسع والعشرين من آب (أغسطس) 1897، ولحظة إعلان ديفيد بن غوريون إنشاء دولة إسرائيل من القاعة الرئيسيّة في مبنى بلديّة «تل أبيب» يوم الخامس عشر من أيّار (مايو) 1948. نصفٌ قرنٍ بالكاد، ما بين فكرةٍ كانت تبدو مجنونةً وغير قابلةٍ للتحقّق حتى لأشدّ المؤمنين بها، وما بين لحظة تَجسُّدِها على الأرض وفي الواقع. قد يبدو للوهلة الأولى أنّ مجرّد التذكير بحقيقة أن الحلم بإنشاء «وطنٍ قوميٍّ لليهود» في فلسطين لم يكن مصدر توافقٍ حتى بين الصهاينة أنفسهم اليوم، ما هو إلا ضربٌ من تعزية النفس؛ لكنّ هذه الحقيقة المهمّة التي هُمِّشت عن التفكير اليوم، لعبت، وبقيت تلعب، دوراً في قلب المشروع الصهيونيّ نفسه حتى يومنا هذا، وتجدر الإشارة إليها لهذه الأسباب.
فمنذ البداية، وبعد إصداره كتابه «الدولة اليهوديّة»، اعترضت أغلبيّةٌ كبرى من قادة المجتمع اليهوديّ في أوروبا الغربيّة على فكرة «هرتزل». كانت الإصلاحات النابوليونيّة قد بدأت تُعطي اليهود في أوروبا حقوقاً قانونيّةً ومدنيّةً متساويةً ومبنيّةً على مبدأ المواطَنة، بعد قرونٍ من التمييز ضدّهم. حتى شركاء «هرتزل» في اعتناق الفكرة الصهيونيّة أشاروا إلى «طيش» و«خطر» طروحاته. فقد اعترضت تنظيمات مثل Hovevei Zion «محبّو صهيون»، مثلاً، على مشروعه وأصدرت الكثير من البيانات والتصريحات الهازئة به وبها، كما يُعلِمنا موردخاي فريدمان. كذلك فعل «آحاد ها-آم» (أو «واحدٌ من الشعب»، الاسم المستعار للمنظّر الصهيونيّ «آشير غينزبيرغ») الذي كتب في العام 1891 مُحذِّراً من أنّ «دولةً من اليهود كهذه، ستكون سُمّاً قاتلاً لشعبنا وستطحن روحه في التراب». وحتى فيما بين أولئك الذين أسهموا فيما بعد بصورةٍ فاعلةٍ في وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ والتحقّق، لم يكن مشروع دولةٍ يهوديّةٍ في فلسطين مُقنعاً أو مُمكناً أو مُبرّراً حتى. فلم يكن «ناحوم غولدمان»، الصهيونيّ الملتزم ومؤسَس «المؤتمر اليهوديّ العالميّ» (المنظّمة الصهيونيّة العالميّة لاحقاً) في البدايات من أنصار فكرة «الوطن القوميّ» في فلسطين. وبقي رغم ريادته العمل الصهيونيّ لاحقاً من أشدّ منتقدي إسرائيل، وبالتحديد فيما يخصّ تعاملها العنصريّ والعنيف مع الفلسطينيّين العرب، إلى درجة أنّ «ياسر عرفات» حرص على التواصل والتنسيقٍ السياسيّ معه حتى في أحلك ظروف العمل الوطنيّ الفلسطينيّ، بما فيها حصار بيروت. وعند وفاة «غولدمان» في العام 1982، أبرق عرفات (من باخرته التي أقلّته إلى تونس بعد خروجه من الحصار، على الأغلب) تعزيةً إلى أرملته يخبرها فيها بأنّ «الفلسطينيّين ينعون وفاة ناحوم غولدمان [الذي] كان رجل دولةٍ يهوديٍّ ذا شخصيّةٍ فريدة».
رغم هذه البدايات المُضطربة، فقد تحوّل حلم كلٍ من تيودور هرتزل وماكس نورداو، وحفنةٍ ضئيلةٍ جداً من زملائهم من «الصهاينة الأوائل»، في تلك العقود الخمسة من مجرّد مشروعٍ خياليٍّ مستحيلٍ (ومختلَفٍ عليه بشدّةٍ، كما رأينا) إلى حقيقةٍ ناجزةٍ. فالحربان العالميّتان، وما بينهما التغيير السياسيّ في المنطقة على أيدي الانتدابات الأجنبيّة، فتحت الباب واسعاً أمام نخبةٍ صغيرةٍ من التنظيم الصهيونيّ للدفع قدُماً، وبنجاح، باتّجاه خلق دولةٍ يهوديّةٍ على أرض فلسطين. وما إن حلّت لحظة الخامس عشر من أيّار، حتى خرجت من أتون حديد ونار حرب 1948، بدايات لكيانٍ صهيونيٍّ يقوم على أنقاض الوجود الفلسطينيّ ومشروعه السياسيّ.
«… قد تحوّل إلى واقع: من ’كيانٍ‘ إلى ’دولةٍ‘ إلى ’قوّةٍ اقتصاديّةٍ عُظمى‘؟»
اتّسمت أولى سنوات وجود إسرائيل بمجموعةٍ من التحدّيات، التي واجهتها النخبة الصهيونيّة الحاكمة بمزيجٍ من البراغماتيّة والبرعة الديبلوماسيّة على الصعيد الدوليّ، ومحاولة مدّ الجسور ونسج التحالفات مع البلدان غير العربيّة في المحيط الإقليميّ (إيران وتركيا)، وممارسة مزيجٍ من التضليل والتفاوض بالدبلوماسيّة حيناً وبالقوّة العسكريّة المفرِطة في غالب الأحيان مع الدول العربيّة المحيطة، وبممارسة العنف الإقصائيّ والهيمنة والإذلال تجاه العرب في فلسطين بصورةٍ شبه دائمةٍ، في نفس اللحظة. ترافقَ ذلك بتوسعة مؤسّسات الـ Yishuv (المَهجر) السابقة وتحويلها إلى مؤسّسات الدولة الناشئة، كما وبإنشاء مؤسّساتٍ جديدةٍ على كافّة الصعُد، سياسيّاً وعسكريّاً وبيروقراطيّاً واقتصاديّاً. كل هذا، مع محاولة استيعاب موجات هجرةٍ ضخمة بلغت 685 ألفاً في العامَيْن الأوّليْن بعد حرب 1948 بما ضاعفَ عدد السكّان من اليهود الذين كانوا متواجدين على الأرض في لحظة تأسيس الدولة. جاء كل من هؤلاء المهاجرين، خصوصاً أولئك القادمون من أوروبا، مع خبراتٍ ومهاراتٍ عاليةٍ سرعان ما تمّ توظيفها في بناء اقتصادٍ نما بوتائر متصاعدة؛ حيث حافظ النموّ الإجماليّ في الناتج القومي (GNP) على معدّلٍ وسطيٍّ بلغ 11 بالمئة في العام ما بين 1950-1965، وهو معدّلٌ عالٍ للغاية.
وكانت وراء هذه المعدّلات أسبابٌ وعوامل كثيرة، أبرزها خارجيّ: فقد تلقّت إسرائيل تدفّقاتٍ نقديّةٍ هائلةٍ من المؤسّسات والمجتمعات اليهوديّة في الغرب وخاصّةً في الولايات المتّحدة؛ إضافةً إلى معوناتٍ حكوميّةٍ أميركيّةٍ وأوروبيّةٍ، والتعويضات من ألمانيا الغربيّة التي بلغت 715 مليون دولار ما بين العام 1952-1966 (أو ما يربو على 8 مليارات دولار بدولارات العام ٢٠٢٣)؛ والعوائد السنويّة لحملات بيع سندات الخزانة المُسَمّاة Israel Bonds، التي كانت تُسهم بما لا يقلّ عن 35 بالمئة من قيمة الميزانيّة الاستثماريّة في منتصف الخمسينيّات. كل هذا، مضافاً إلى الاستيلاء بالقوّة على البُنى الاقتصاديّة القائمة في فلسطين الانتداب والتي، وإن لم تشكّل اقتصاداً ناجزاً، فقد أسهمت في منح لبِنةً أولى لبنائه. لكنّ الأكثر أهمّيةً، والذي لا بدّ لنا من الإقرار به، تَجسّدَ في الإدارة الأقرب إلى الرشد، برغم فسادٍ كانت ولا تزال قصصه تملأ الفضاء العامّ، لعمليّة تأسيس وتثبيت الدولة الناشئة في خضمّ مصاعب ضخمة. فما عدا اضطرار الكيان الناشئ لخوض معركة وجودٍ تستلزم ضخّ المال والقوى العاملة في أغراض الحرب والقتال مع الجوار، وتكلفة وتعقيد الحكم العسكريّ للمدن والمناطق العربيّة المتبقّية تحت سيطرة إسرائيل بعد حرب 1948، وما استتبعه كل ذلك من جهدٍ إداريٍّ واستخباريٍّ وعسكريّ؛ فقد شكّل استيعاب وتهيئة وخلق هويّةٍ متجانسةٍ في الحدود الدنيا لكل شتات المهاجرين القادمين من بلدانٍ وثقافاتٍ وتجارب متضاربةٍ، تحدّياً هائلاً. كانت المحصّلة نجاحاً اقتصاديّاً عزّ نظيره في المنطقة، ودون الاعتماد على موارد أوّليّةٍ، كالنفط مثلاً.
فما بين عامَيْ 1960-2021، بلغ متوسّط الناتج المحلّي الإجماليّ (GDP) الإسرائيليّ 114.36 مليار دولار؛ ووصل إلى أعلى مستوىً له على بقيمة 488.53 مليار دولارٍ في عام 2021، بينما كان أدنى مستوىً 2.51 مليار دولارٍ في عام 1962. وإسرائيل اليوم تحتلّ المرتبة الـ 48 من بين أكبر اقتصادات التصدير في العالم، والمرتبة الـ 20 في الترتيب الكلّي (والعاشرة في البحث العلميّ) من حيث الاقتصاد الأكثر تعقيداً وفقاً لمؤشر التعقيد الاقتصاديّ (ECI)، الذي يصنّف البلدان بناءً على مدى ترابط انتشار المعرفة والبحث العلميّ ونجاح القطاعات الاقتصاديّة. والاقتصاد الإسرائيليّ متنوّع بصورةٍ مثيرةٍ للانتباه: إذ يشكّل الماس أهمّ صادرات إسرائيل (بقيمة 10,7 مليار دولار) حيث أنّ قطاع تقطيع وتحضير الماس الخام متقدّم جداً. يليه الصناعات الدوائيّة (بقيمة 4,72 مليار دولار)، وصناعة الرقائق والدارات المتكاملة (بقيمة 2,19 مليار دولار)، وتكرير البترول (بقيمة 1,58 مليار دولار). وتقوم إسرائيل بالتصدير بصورةٍ رئيسةٍ إلى كلٍ من الولايات المتحدّة (بقيمة 18,2 مليار دولار) وتليها الصين (بقيمة 3,66 مليار دولار).
في العام الفائت 2022، وعلى أساس نصيب الفرد، نما الاقتصاد الإسرائيليّ، الذي بلغ ناتجُهُ المحليّ حوالي 500 مليار دولار، بنسبة 4.4 بالمئة بالمقارنة بمتوسّط النموّ في منظّمة التنمية والتعاون الاقتصاديّ (OECD) في الفترة نفسها، الذي لم يَزِِد على 2.6 بالمئة. وتمتلك إسرائيل اليوم ثاني أكبر عددٍ من الشركات الناشئة في العالم، بعد الولايات المتّحدة، إضافةً إلى ثالث أكبر عددٍ من الشركات المُدرَجة في بورصة «ناسداك» التقنيّة، بعد كلٍ من الولايات المتحدة والصين. وذلك من نتائج تفوّق قطاع التعليم العالي، خصوصاً التقنيّ منه، حيث أنّ كلاً من «معهد وايزمان للتقنيّة» وجامعة «تل أبيب» يحتلّان المرتبتَيْن الـ 134 والـ 175 عالميّاً في تصنيف الجامعات. وحرصت إسرائيل منذ نهاية تسعينيّات القرن الماضي على محاولة اجتذاب كُبريات شركات «وادي السيليكون» للاستثمار فيها. وبالفعل، فقد قامت العديد من الشركات الرائدة عالميّاً، مثل Intel وMicrosoft وApple، ببناء منشآت بحثٍ وتطويرٍ في إسرائيل، حتى تمّ اجتذاب أكثر من 400 شركةٍ متعدّدة-الجنسيّات في مجال التقنيّة العالية، من مثل IBM وGoogle وسواها للّحاق بها في افتتاح مراكز متقدّمة للبحث والتطوير.
البنية التحتيّة لـ«الدولة»: التفرقة والعنصريّة
على أنّ هذا البنيان الاقتصاديّ المَهيب حقّاً، بقي قائماً على أساسٍ سياسيٍّ لُبّه التفرقة والعنصريّة الممنهجة والمُمأسَسة. فمنذ البدء، جرى تخطيط الاقتصاد ورسم وتنفيذ الخطط وتوزيع منافعها على أساس تحقيق هيمنة جزءٍ من المجتمع على حساب الجميع، وبالتحديد على حساب الفلسطينيّين العرب. حيث كان تَعاملُ إسرائيل مع الفلسطينيّين العرب في البدايات قائماً على المنع والتضييق الفجّ للحقوق السياسيّة وحصر الحقوق المدنيّة، وبالتحديد خلال فترة الحكم العسكريّ المباشر (1950-1966). وجرى ذلك بناءً على منظورٍ يرى ضرورة التعامل معهم باعتبارهم وجوداً عدوّاً يوجب القسوة والشدّة معه بغية حصر «ضرره»، في أحسن الأحوال؛ ويصل حتى ضرورة «طردهم» من الدولة حتى، في «ترانسفيرٍ» عرقيٍّ إلى شرقيّ الأردن، في أسوئها. كانت لهذه السياسات نتائج مديدة الأثر على الفلسطينيّين العرب داخل إسرائيل. فرُغم مظاهر المشاركة السياسيّة في الانتخابات وتمثيلهم بأعضاءَ في «الكنيست»، وحتى برغم الدور المحوريّ الذي لعبه بعض الساسة العرب في تشكيل الحكومة الائتلافيّة بعد انتخابات حزيران 2021، بقيت القيمة الفعليّة لدورهم سياسيّاً بعيدةً عن تشكيل مشاركةٍ أو مساهمةٍ فعليّةٍ فاعلةٍ في السياسات العامّة وتوجّهات الدولة. ويأتي تمرير قانون «يهوديّة الدولة» عام 2018 كمثالٍ على التهميش الفعليّ للعرب وضآلة دورهم سياسيّاً. ففيما عدا التوكيد على حصريّة «حقّ تقرير المصير» لليهود، وعلى جعل الاستيطان «قيمةً قوميّةً عُليا… تبذل الدولة فيها كل إمكاناتها»؛ فقد جرى كذلك إنزال اللغة العربيّة من الموقع (الشكليّ!) الذي كانت قد مُنحت إيّاه في السابق، كلغةٍ رسميّةٍ ثانيةٍ، لتصبح مجرّد لغةٍ ذات «وضعٍ خاصّ»!.
ومن حيث المؤشّرات الفعليّة يُظهِر، مثلاً، تقرير مهمّ لـ د. نسرين حاج يحيى، د. محمد خلايلي، د. آريك رودنيتسكي، و بين فارجيون الكثير من الدلائل على عمق تأثير هذه السياسات التي يستمرّ بعضُها بصورةٍ فجّةٍ حتى اليوم. فبحسب إحصاء عام 2020، يبلغ عدد سكّان إسرائيل حوالي 9.3 مليون نسمة، منهم ما يقرب من 1.96مليون عربيٍّ (أو ما نسبته 21.1 بالمئة من إجمالي عدد السكّان). ويشمل هذا الرقم قرابة 362 ألف عربيٍّ مقيمٍ في القدس الشرقيّة ممّن يحملون صفة «الإقامة الدائمة» لا الجنسيّة الإسرائيليّة. وتُصنّف 95 بالمئة من التجمّعات العربيّة في أدنى سُلّم التجمّعات من حيث المؤشّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، حيث بلغت نسبة الأُسَر العربيّة الرازحة تحت خطّ الفقر 45.3 بالمئة (مقارنةً بـ 13.4 بالمئة فقط بين اليهود). وفي عام 2020، مثلاً، انخفضت معدّلات توظيف الرجال العرب بشكلٍ حادّ إلى 69.3 بالمئة. واحدٌ من العوامل الرئيسة وراء انخفاض معدّلات التوظيف هو انخفاض مستوى التعليم، إذ تبلغ نسبة المتعلّمين حتى الشهادة الثانويّة (أو أدنى) 77 بالمئة من السكّان بينما يحمل 15 بالمئة منهم فقط شهادةً جامعيّةً بدرجاتها (بالمقارنة بـ 33 بالمئة لدى اليهود). ويعمل العرب بصورةٍ رئيسيّةٍ في القطاعات الصناعيّة ذات الدخل المنخفض والمهن غير الماهرة، ويتقاضون، بالتالي، رواتب منخفضة. وليس السبب وراء هذه المؤشّرات، كما تجري الإشارة إليه في الكثير من الأدبيّات السياسيّة الإسرائيليّة، عائداً إلى «التخلّف» المستشري في ثقافة العرب؛ بل إلى سياساتٍ ممنهجةٍ ضيّقت ومنعت وحجبت الكثير من أوجه التنمية عقوداً عن المناطق والأحياء ذات الوجود العربيّ، ولأسبابٍ سياسيّةٍ وعقائديّةٍ صِرفة.
فبحسب المرويّة الإسرائيليّة نفسها، اتّخذت النخبة المُؤسّسِة للدولة قراراً بإنشاء ما أسماه عالِمُ الاجتماع الإسرائيليّ سامي سموحة بـ «الديمقراطيّة الإثنيّة»، والتي يُعرِّفها على أنّها «نظامٌ سياسيٌّ يجمع بين الهيمنة الإثنيّة المنظّمة لفئةٍ واحدةٍ (اليهود) ومنح الحقوق الديمقراطيّة والسياسيّة والمدنيّة للجميع»، أو بمعنىً آخر، ديمقراطيّةٌ لليهود بحقوقٍ مدنيّةٍ معقولةٍ (في أفضل الأحوال!) لغير اليهود والعرب. ولكن، ليس لكلّ اليهود، حتى: فلم تكن التفرقة والعنصريّة حكراً على تعامل الدولة وقطاعاتها المسيطِرة مع العرب فحسب؛ بل وعلى اليهود المشرقيّين أو «المزراحيم» كذلك. ويخبرنا المؤرّخ توم سيغيف في كتابه 1949: الإسرائيليّون الأوائل تفاصيلَ عن قيام السلطات الإسرائيليّة، مثلاً، برشّ اليهود الوافدين من البلدان العربيّة بالـ «د.د.ت» والمبيدات الحشريّة بهدف «تطهيرهِم!»، أضف إلى الخطف المنظّم على أيدي السلطات لأطفال اليهود اليمنيّين، بُغية منحهم لأهالٍ فقدوا أطفالهم أو كانوا عاجزين عن الإنجاب من بين اليهود «الأشكناز». مثالٌ بارزٌ آخر في الوعي الجَمعيّ اليهوديّ هو مظاهرات وادي الصليب (1959) في حيفا. حيث قام اليهود المغاربة بقيادة «دافيد بن حرّوش» بمظاهراتٍ واعتصاماتٍ ومواجهاتٍ عنيفةٍ مع الشرطة احتجاجاً على سوء معاملتهم والتفرقة ضدّهم في كل مناحي الحياة، بما فيها عدم تمكينهم من العمل في وظائف حكوميّة والتضييق عليهم في الإسكان لمصلحة اليهود «الأشكنازيّين». فقد تمّ إيواء الوافدين الجدد من بولندا، في ذلك العام، في مساكن بُنيت حديثاً كان اليهود المشرقيّين قد وُعِدوا بها سابقاً، لكنّهم حُرموا منها وتمّ إبقاؤهم حيث تمّ إيواؤهم منذ وصولهم إلى إسرائيل، في أحياءٍ شعبيّةٍ مفقرةٍ بالأساس كان قد تمّ «تنظيفها» من قاطنيها العرب إبّان حرب العام 1948.
نتحدّثُ إذاً، إذا أخذنا بالرواية الإسرائيليّة السائدة في الفضاء العامّ، عن «ديمقراطيّةٍ بطابقَيْن». لكنّ من الواضح تماماً مدى افتراق هذه الرواية عن واقع الحال، ومحاولتها تنزيه الذات وتقديم نفسها بصورةٍ تؤكّد الانتماء إلى منظومة الديمقراطيّات و«القيَم» الغربيّة. لكننا في الواقع ننظر إلى نظامٍ سياسيٍّ باتت الإشارة إليه على أنّه نظام فصلٍ عنصريٍّ بالمعنى الفعليٍّ (أو «آبارتهايد» كما تصفه منظّمة «آمنستي» مثلاً) وبالممارسة والتقنين، وإن لم يكن بالتسميات الصريحة، سائدةً ومنتشرةً في أوساطٍ دوليّةٍ كثيرة.
ما الذي يعنيه كل هذا لنا، نحن العرب، اليوم؟
من المهمّ للغاية لنا وعيُ مدى تَجمُّد المواقف العربيّة من إسرائيل عند واحدٍ من موقفَيْن بارزَيْن، لا يبدو أنّ لهما ثالثاً حتى اللحظة: فثمّة الرفض المكابر العنيد للإقرار بأيّ واقعٍ يتعلّق بإسرائيل نفسها. فمن اعتبارِ عدم لفظ اسم «إسرائيل» والاكتفاء بلفظة «الكيان الصهيونيّ» تشبّثاً بالحق ودفاعاً عن «القضيّة»؛ إلى اعتبارِ عدم الإقرارٍ بكونها «دولةً» قائمةً بمؤسّساتٍ باتت مستقرّةً وقادرةً على إدارة شؤونها مقاومةً تَسحب عنها «الشرعيّة»؛ إلى الإحالة إلى واقعٍ مُتخيّلٍ يصبح فيه من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء و«تفكيك» كل ما ترتّب عن إيجادها وقيامها. وأمّا الموقف الثاني، فهو الانسحاق التامّ أمام مقولة «إسرائيل العُظمى» وقوّتها الطاغية وعجز العرب أمامها، بما يمنح تبريراً للارتماء، بحجّة الواقعيّة السياسيّة، في أحضانها دون تفكّرٍ أو تبصّر، والرمي جانباً بأيّة اعتباراتٍ مطلوبةٍ لتسويةٍ سياسيّةٍ تصون الحقوق الأساسيّة المشروعة للفلسطينيّين والعرب. وكلا هذَيْن الموقفَيْن، اللذيْن يقدّم كلٌّ من أصحابهما نفسه على أنّه وحده الموقف الصائب، لم يتزحزح قيد أنملةٍ عن أحكامه المطلَقة التي لا تقبل النقاش أو الاختلاف أو التفكير في بدائل. فقد تمّ تحنيط المواقف من إسرائيل عند نقطةٍ ثابتةٍ قائمةٍ على التفكير الرغائبيّ، أَوغلت بعيداً في مقارباتٍ انتحاريّةٍ أو تُبرّر ارتكاب الجريمة باسم منطق «طريق القدس يمرّ في القلمون وزبداني وحمص»؛ أو عند مواقف تُبرّر رمي كلّ شيءٍ جانباً باتّجاه تطبيعٍ فجٍّ للعلاقات مع إسرائيل لا يقيم اعتباراً للفلسطينيّين، بل ويزايد على حسابهم حتى.
على أنّ أيّاً من هذَيْن الموقفَيْن ليس حتميّاً، ولا يتوجّب علينا الوقوف عنده. فالصحيح أنّ إسرائيل حقيقةٌ سياسيّةٌ واقعةٌ مستمرّةٌ حتى اللحظة، ودولةٌ قائمةٌ وذات علاقاتٍ متشعّبةٍ وبَيّنةٍ مع كثير من دول محيطها الإقليميّ والقوى الفاعلة في العالم، وقوّةٌ عسكريّةٌ واقتصاديّةٌ متينة. على أنّ الصحيح، كذلك، أنّ لإسرائيل نقاط ضعفٍ مهمّةٍ أيضاً. فهي اليوم تمرّ بأزمةٍ يمكن أن يُقال عنها أنّها «بنيويّة»، تسبّبت بها محاولة الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة التي تُعتَبر الأكثر يمينيّةً في تاريخ إسرائيل بمحاولة تمرير «إصلاحاتٍ قضائيّةٍ»، كتب عنها الكاتب الإسرائيليّ الأشهر، يوفال نواه هراري، بأنّها تشكّل «انقلاباً مناهضاً للديمقراطيّة». فقد اجتاحت المجتمع اليهوديّ في إسرائيل تظاهرات عملاقة أدّت إلى إيقاف خُطَط الحكومة، مؤقّتاً. لكنّ هذا تَرافقَ بخروج نحو 85 مليار شيكل (أو 23 مليار دولار) من رؤوس الأموال خلال شهرين من تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوريّة، وهي أخبارٌ غير مرحّبٍ بها لقطاع التقنيّة الفائقة، الذي تموّله أموال الاستثمارات الخارجيّة بنسبة 90 بالمئة. لكنّ الأهمّ والأكثر عمقاً، هو أنّها كشفت كذلك عُمق الأزمة في مشروع «الديمقراطيّة الإثنيّة» المدّعاة نفسه، تلك الديمقراطيّة التي كانت «على طابقَيْن» وباتت تهدّد بـأن تصير على «طوابق» أكثر، لكن بين اليهود أنفسهم. كما كشفت كم أنّ بنيان فكرة الدولة، التي كان مُختَلفاً عليها منذ البدايات، لم يجد طريقه إلى توافقٍ حقيقيٍّ في العمق بين اليهود، وهو ما يجد تجسيده الأبيَن والأكثر فجاجةً في التعامل مع العرب داخل إسرائيل. إذ لا يمكن ليّ عنق الحقائق، ولا المداورة حول تصريحات بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة، وبما يبدو مُعبِّراً عن موقفٍ مُتوافَق عليه لدى الغالبيّة من اليهود، بأنّ «إسرائيل ليست دولةً لجميع مواطنيها… بل هي دولة قوميّة للشعب اليهوديّ، وللشعب اليهوديّ، فقط». كما أنّ النظرة التي عبّر عنها أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) في وصفه أعضاء «الكنيست» العرب باعتبارهم «طابوراً خامساً»، تبدو تكثيفاً رمزيّاً لنظرةٍ تبدو عامّةً لدى كثيرٍ من النخب السياسيّة في إسرائيل إلى العرب عموماً.
من المؤكّد أن أيّاً من هذه الأزمات لن يعني، على الأغلب، تداعي إسرائيل أو انتهاءها قريباً. لكنّ من المؤكّد، كذلك، أنّها تفتح أبواباً للتفكير في أساليب ومقاربات مختلفة تهدف إلى تفكيك منطق «يهوديّة» الدولة، وإحالتها إلى دولةٍ لكلّ مواطنيها: فهذا هو المعاكس الممكن للمشروع الصهيونيّ. وهو ما يحتاج مصارحةً عربيّةً وفلسطينيّةً مع الذات ومعاودة النظر إلى إسرائيل كما هي في الحقيقة، دولةٌ بنقاط قوّة وضعفٍ، والتوقّفَ عن «أَسطرتها» وبناءَ مقاربةٍ منطقيّةٍ لإدارة الصراع معها؛ لعلّ الأعوام الخمسة وسبعون القادمة تكون مختلفةً عمّا كانت عليه حتى اللحظة.