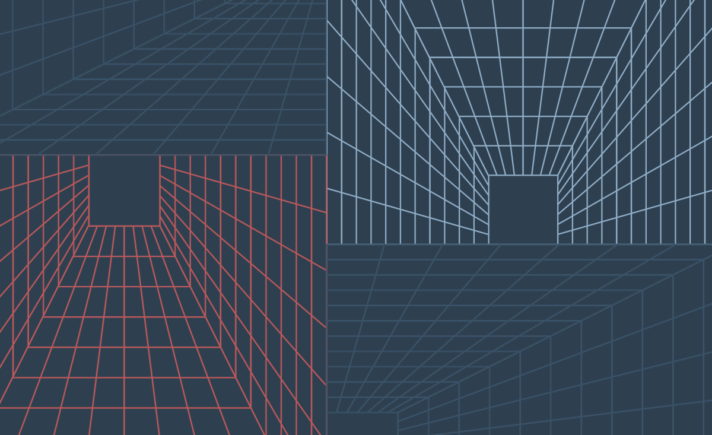تُحاول رواية الهَيْلَعي لعبد القادر الجاسم، الصادرة عن دار نرد، أن تحكي حكاية ثورة السوريين من زاوية مختلفة عن الزوايا التي اعتدنا قراءتها في الروايات التي تتناول أدب الحروب، وذلك من خلال الشخوص الروائية المُنبثقة من بيئة اجتماعية محددة يمكن أن نقول عنها إنَّها من أكثر البيئات الاجتماعية تنوعاً واختلافاً، إذ تبدأ أحداث الرواية ضمن قطعة عسكرية؛ والتي تُعَدُّ حيزاً مكانياً يجمع أفراداً ينتمون إلى ثقافات اجتماعية ودينية وقيَّمية مختلفة، وقد استطاعت السلطة الحاكمة من خلال سياستها القائمة على الاستلاب، أن تعيد بَنْيَنة البشر فيها وفق نظام قاسٍ لا تحكمه القوانين بقدر ما يتحكَّم فيه العُرْف، الذي يحاول تدجين البشر وزرع الخوف في نفوسهم باستخدام أساليب قمعيَّة ترسَّخت في ذاكرتهم منذ أحداث الثمانينيات، مما خلق في هذه البيئة المذكورة أجواءًَ تسودها الريبة والشكُّ، خصوصاً تجاه كل صوتٍ ذي رأي واضح بما يخص السياسة والدين.
وعلى الرغم من تحميل بطل القصَّة، عمر، إسقاطات الكاتب التي تُعبِّر عن الخلفية الذهنية لموقف الفئة المعارضة للنظام منذ بدء الثورة، تُقلِّبُ الروايةُ المسألة على وجوهها المتعددة فتُبرز بطلاً معارضاً للبطل الرئيس وهو سعد الدين الذي يمثِّل أيضاً فئة كبيرة من الشعب الذي انساق مع الموجة الصاعدة وانحسر بانحسارها، وقد اختار الكاتب اسم الرواية الهيلعي بوصفها عَتَبة نصية يمكن من خلالها استلهام المقاصد الدلالية للبُنيات التي يقوم عليها النص الروائي ضمن التحولات التي تترافق مع تصاعد الحدث.، يمكن أن توصفَ هذه التحولات التي تُلامس شخصية سعد الدين التي يمكن أن توصف بأنها شديدة السرعة نتيجة عدم تجذُّرها وتخلخل بناينها، فكان ذلك الوصف ينطبق على الوقت القياسي الذي استطاع فيه سعد الدين التحوُّل في الولاءات منسجماً مع الفرقة التي يرقص على إيقاعها، وقد قمنا في هذه المقالة بتقسيم تلك التحولات إلى ثلاث مراحل متتابعة لرصد التغيرات التي طرأت على تلك الشخصية غير المنتمية إلَّا لأناها:
1- بائع الدم والضَّمير:من قصيدة المُخبِر للشاعر العراقي بدر شاكر السياب
الحيّز المكاني الذي اختاره الكاتب فضاءً لروايته هو عبارة عن نموذج مصغَّر عن المجتمع السوري، هذا المجتمع الذي تربَّى أفراده على الخوف والشك في «دولة الرعب والمخابرات والجدران التي تُنصت»، مع سلطة سَعَت جاهدة لبثّ شبكتها الاستخباراتية وترسيخ مفهوم الذهنية القطيعية لدى الشعب. تبرز شخصية سعد الدين في هذه المرحلة بوصفها نموذجاً رائجاً للشخص الفَهْلوي الذي يستطيع اللعب على الحبال بدقة متناهية لتكون له حظوة ومكانة عند رؤسائه في الجيش، فكانت لوحة الرئيس التي رسمها على السبورة ونالت إعجاب قادته بدايةً موفقةً لمخططاته التي بدأت تتطوَّر متَّخذة شكلاً واحداً من حيث الأسلوب؛ التملُّق بإظهار تبعيته المُطْلقة للنظام وإبراز مخالفات الآخرين وتقصيرهم تجاه السلطة والإيقاع بهم لينتهوا ضحايا للتعذيب في أحد أفرع المخابرات.
استطاع سعد الدين الاستفادة من الأحداث السياسية المتصاعدة إثر قيام الثورة في سوريا عام 2011، خاصة مع شيوع الأجواء المثيرة للريبة والقلق التي تخلّلتها أخبارٌ عن انشقاقات واعتقالات عشوائية في الجيش، فلم يفوّت الفرصة لدعم مكانته مُنضماً إلى إحدى الوَقفات التضامنية في جامعة حلب مُنادياً بخلود الرئيس وأبديته، ومن ثمَّ مُلاحِقاً المنشقين بهدف تسليمهم وإطلاق النار عليهم وعلى المدنيين في موقعة حصار الزبداني.
2- يجري مع كلِّ ريح:مقولة لابن مسعود في معرض حديثه عن الإمّعة.
في هذه المرحلة تتلاحق تحولات شخصية سعد الدين من خلال الأقنعة المختلفة التي كانت تتبدل مع تبدُّل ولائه، فقد رَغِب في أن يكون أوَّل من يرفع علم الجيش فوق أبنية الزبداني لولا إصابته في تلك المعركة، وعند عودته لقضاء فترة النقاهة في بيته، تلقى أول ضربة بقتل والده برصاص رجال الأمن، وهو الرجل الذي قَضَى حياته مدافعاً عن الطبقة الكادحة في أروقة حزب البعث واجتماعاته، وتلاها مقتل أخيه بعد عدَّة أيام في الجامعة على يد الشبيحة وهو الشاب الذي ابتعد تماماً عن الأحداث السياسية، كانت هذه التجارب الجذرية سبباً في إعادة ترتيب أوراقه تمهيداً لمرحلة جديدة تمخَّضت عن هذين الحَدَثين.
بدأ سعد الدين بقراءة المشهد من جديد بعد ما شاهده من فبركة إعلامية للحدث في قناة سما عند إذاعة خبر مقتل أخيه والشبان الجامعيين على أنَّهم سقطوا بنيران العصابات المسلَّحة والمندسين، ولم يكن انشقاقه عن الجيش ووقوفه ضدَّ النظام إلا رغبةً بالانتقام من القاتل، إذ عاد نظام الثأر من جديد للشيوع بين الناس مُتناسين القضية الأساسية وواضعين الثأر غايةً نُصب أعينهم، وبذلك تحوَّلت القضية من مشكلة شعب بأكمله يُقتل ويُشرد بآلة الحرب الوحشية إلى مشكلات شخصية، وباتت مصلحة الفرد تفوق في أهميتها مصلحة الجماعة، وعندما بدأ سعد الدين يشعر أنَّ الكفة تميل لصالح المعارضة حسم أمره وتغيَّر موقفه، فانضمَّ إلى أحد فصائل الجيش الحر؛ وقف على حواجز التفتيش، وقاتل في صفوف فصائل المعارضة المتعددة حتى استقرَّ مقامه مع جبهة النصرة التي استشعر أنَّها الفئةُ الغالبة، كما وجد فيها ما يحقِّق طموحه في الظهور والتباهي مستغلاً الفوضى الحاصلة نتيجة سوء التنظيم وغياب القانون.
ظهر تنظيم داعش بعد ذلك، محاولاً بسط سلطته وإخضاع من يقطنون في مناطق سيطرته، بمحاولاتٍ قوبلت في بعض الأحيان باستسلامٍ يشبه حالة الاستسلام التي سادت أيام النظام قبلها، «أربعون عاماً من الضخِّ الإيديولوجي الأخرق كانت كفيلة بصناعة هياكل آدمية جوفاء يمكن استعمالها لأيِّ شيء كلما اقتضت الحاجة» بحسب ما يرد في الرواية، يستغل سعد الدين الموقف مجدداً وينضم لتنظيم الدولة مبايعاً لأمير المؤمنين؛ لأنَّه رأى أنَّ المستقبل لن يكون إلا لدولة الخلافة.
3- مَلَكَ النِّفاقُ طباعَه فَتَثَعْلَبَا:من قصيدة للشاعر ابن الرومي.
تكتمل الصورة الحقيقية للحرب بمشهد المخيمات، حيث الألم أكبر من الجرح، الناس هناك عبارة عن مجموعة من البشر الذين اختلطت ملامحهم بملامح الحزن إلى درجة التماهي، هرب معظمهم من الموت المجاني، هربوا من الظلم والاستبداد، وأضحت حياتهم حفنة من الذكريات التي غدت زيتاً يستمدون منه وقوداً لما تبقَّى من سراج عمرهم.، أمَّا الذين تجاوزوا المخيمات إلى تركيا وأوروبا فقد كانوا يعيشون تجربة الاغتراب المُرَّة، لقد امتلك السوري في شتاته الجديد ذاكرة «تقف غالباً في حدود يومه الأخير في سوريا» فكان بعضهم يجرِّم النظام وبعضهم يجرِّم الثورة، وبعضهم لم يكن يبالي إلَّا بما حقَّقه من مكاسب استحوذ عليها على أكتاف الأزمة، فكانوا تجاراً بالقضية حين سقطت قيمهم الأخلاقية وهذا ما حصل مع سعد الدين في تلك المرحلة.
تجاوز سعد الدين تجربته التي ما استطاع أن يخرج منها بنتيجة ثابتة، وتخلَّى عن كلِّ شيء عدا المال الذي تمكَّن من تحصيله.، في تركيا بدأ يعمل بالاإتجار بالبشر من خلال تهريبهم إلى أوروبا، بالإضافة إلى أنَّه أصبح مديراً لمدرسة «السُّراة» التي اشتقَّ اسمها من السمو الذي افترض أنَّه قد وصل إليه بذكائه وفطنته مستخدماً هذا العمل كواجهة حضارية لمسيرته الانتهازية.، وصحيحٌ أنَّ الرواية تتوقَّف هنا عند هذا التحوُّل، إلَّا أنَّها تفتح الباب واسعاً للتفكير بالمآلات التي يمكن أن يَصِل إليها مَن عايش حرباً وقَبَعَ تحت حكم أنظمة تهدم إنسانية الإنسان، وتختبره ضمن أصعب الظروف التي يمكن أن تمرَّ على بشر.
الرواية تحكي الكثير من الحقائق، وتعيد ذاكرة السوريين إلى بدايات الاستبداد وبدايات الخضوع، ملقيةً ببعض اللوم من خلال بعض وجهات النظر التي يقدِّمها الكاتب على لسان شخصياته على السوريين أنفسهم، ممن سكتوا على ظلم ليس عمره عمر الثورة، إنَّما يمتدُّ في الزمن إلى بداية حكم الطاغية الأب، الظلم الذي ترعرع وشبَّ في عهد ابنه، الهَيْلَعي الأول.