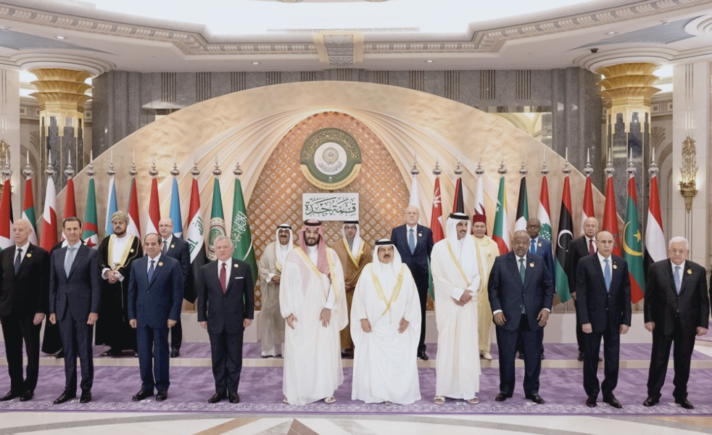لو كانت سوريا بلداً اعتيادياً لكان خبر اعتقال ومصادرة أموال عمرو سالم، وزير «التجارة الداخليّة وحماية المستهلِك» المُقال للتوّ، خبراً يستحقّ التوقّف عنده مطوّلاً. ومّما يجعل الخبر محاطاً بالشكوك أنَّ مصادره مبنيّة على سلسلةٍ من البوستات على السوشال ميديا، إذ لم يصدر أيّ قرارٍ رسميٍ بهذا «الاعتقال»، حتى أنّ سالم نفسه (على ذمّة الإعلام شبه-الرسميّ) لا يزال في منزله. ولكنه يبقى خبراً يثير التساؤلات، ذلك أنَّ قِدَم وجوده بالقرب من هرم السلطة في البلاد، وعلاقاته المتشعّبة و«بروفايله» دوليّاً وسوريّاً على مدى سنواتٍ متعدّدة، إضافةً لحقيقة كونه وزيراً، كانت كفيلةً بجعل خبر إقالته، ومن ثمّ الاتّهامات المُهينة التي نُسِبت إليه بصورةٍ علنيّةٍ فجّة، خبراً استثنائيّاً. لكنّ سوريا بحدّ ذاتها هي بلد-استثناء، لا ينطبق فيها أو على أيّ وجهٍ من وجوه الحياة أو السياسة فيها أيّ قدرٍ من «الاعتياديّة» ولو بأدنى درجاتها.
من الممكن الاستدلال من شخص عمرو سالم نفسه، كما ومن خبر إقالته ومصيره المباشر بعدها، على مثالَيْن عمليّين على حقيقة «سوريا الأسد» بنسختها البشّارية منذ العام 2000 حتى اليوم. فالرئيس-المصادفة الذي لم يكن يتصوّر أن يكون رئيساً يوماً، والذي يدخل عامه الثالث والعشرين في الحكم، حاول منذ اليوم الأول وبصورةٍ علنيّةٍ أن يتمايز عن الدكتاتور-الوالد؛ لذلك، اختار أن يحيط نفسه بشخصيّاتٍ حاول أن يعكس عن طريق سِيَرها الذاتيّة صورةً ذهنيّةً مختلفةً تمام الاختلاف عن مرحلة ورجالات أبيه. ففيما فضّلَ حافظ الأسد إحاطة نفسه بوزراء من البيروقراطيّين الحزبيّين البعثيّين من غير ذوي الاختصاص المهنيّ بناءً على عامل الطاعة والولاء حصراً، كما شرح الباحث حنا بطاطو في كتابه عن سوريا؛ فقد نَحَى بشار، في بداية حكمه على الأقلّ، منحىً مغايراً، مفضّلاً اجتذاب أشخاصٍ ذوي كفاءةٍ مهنيّةٍ عاليةٍ وخبراتٍ دوليّةٍ وسيَرٍ ذاتيّةٍ مميّزة. وعمرو سالم واحد من أولئك البيروقراطيّين النموذجيّين لمرحلة الأسد الابن.
فعمرو سالم البالغ من العمر 65 عاماً، خرّيج كلّية الهندسة الميكانيكيّة من جامعتَي حلب ودمشق، ثمّ درس هندسة المعلوماتيّة في سويسرا حيث نال شهادة الدكتوراه فيها (مع اختصاصٍ فرعيّ في مجال الإدارة). كانت بداياته في سوريا متواضعةً، حيث عمل في بداية تسعينيات القرن الماضي في مجال الحوسبة حديث العهد آنذاك في القطاع الخاصّ. وكان هذا مدخله إلى الاحتكاك مع «وليّ العهد» القادم، بشار الأسد: إذ سرعان ما دخل الدائرة القريبة التي صنعها الأخير من حوله؛ دائرة من «مستشارين» تكنوقراطيين يقومون تحت إمرته ببناء مشروع «التحديث الاستبداديّ» لنظام أبيه، أو ما اصطُلح على تسميته إعلاميّاً بمشروع «التطوير والتحديث». فكان واحداً من المساهمين في تأسيس «الجمعيّة السوريّة للمعلوماتيّة» في نفس الفترة التي كان يعمل فيها مع مؤسّسة «مايكروسوفت» بين العامَين 1998 و2005، وبقي خلالها على تواصلٍ مع «رئيسهِ»؛ حيث كان كذلك يقوم بدورٍ أشبه ما يكون بمثابة «مستشارٍ» غير رسميّ للشؤون التقنيّة وسواها، بحسب ما تستدعيه الحاجة. وكان قريباً من دائرة الأسد المدنيّة إلى درجة أنّه، وحال عودته إلى دمشق (بالاستدعاء، أغلب الظنّ)، سرعان ما عُيّن في حكومة العطري الثالثة (عام 2006) وزيراً للاتصالات والتقانة، واستمرّ في منصبه هذا عاماً ونيّف.
خرج عمرو سالم بـ«خُفّيْ حُنين» بعد هذه التجربة الوزاريّة القصيرة التي حامت حولها شبهات فسادٍ، إذ جرى اتّهامه بهدر المال العام والاختلاس، تهمٌ خرج منها «بريئاً» بعد عامٍ من خروجه من الوزارة. على أنّ ما رشَح في طاحونة الشائعات في دمشق وقتذاك قدّمَ السبب الأكثر إقناعاً، وبالتحديد ما أُشيع وقتها عن «عدم رضا» رامي مخلوف (الذي كان قطاع الاتّصالات ملحقاً بإمبراطوريّته الاقتصاديّة مترامية الأطراف والتي لم تكن تغرب عنها الشمس) عن عدم «تعاون» سالم فيما يخصّ مناقصات قطاع الاتّصالات بما فيه الكفاية، وعرقلته لبعضها «دون وجه حقّ». ويبدو أن تلك التجربة كانت بمثابة دورةٍ تدريبيّةٍ على أصول العمل في «دولة الأسد»: معرفة من أين، حقّاً، «تؤكَل الكتف»؛ معرفة معنى «السمع والطاعة» و«المشي الحيط-الحيط»، على ذمّة الحكمة الشعبيّة، وكيفيّة أدائهما على أحسن وجهٍ محتَمل، وإدراك ما تفتحه هذه الفرصة من أبوابٍ لجني المال وتكديس الثروة ومُراكمة السلطة المجتمعيّة والقوّة، في إطار ثقافةٍ عامّةٍ مطبوعةٍ بعبادة القوّة، تحت ظلّ نظامٍ عنفيّ كنظام الأسد. وبعد فترةٍ قضاها خارج دائرة الضوء الحكوميّة، ولكن في إطار التقافُز في الإعلام والعمل مع المنظّمات غير الحكوميّة الناشئة في قطاعات ريادة الأعمال وخلافها؛ منحته مرحلة ما بعد ثورة السوريين في العام 2011 وما نتج عنها في أجواء النظام، فرصةً لتلميع صورته أمام «رئيسه»، وطرح نفسه في سوق التوزير والمناصب الحكوميّة. وهو ما حصل عليه في النهاية، إذ تمّ تعيينه في حكومة حسين عرنوس الثانية في العام 2021 وزيراً للتجارة الداخليّة وحماية المستهلِك.
وهنا، بدأت تظهر «مواهبه» في التفتّق عن سياساتٍ لضبط ساعة حياة السوريين البائسة خصوصاً في مناطق نفوذ النظام بنتيجة الحرب وما أفرزته، عند «ساعة» النظام. فسلسلة الأزمات المعيشيّة التي عاناها السوريّون لم يكن بإمكان أيّ وزارةٍ، أيّاً يكُن وزيرها، تقديم حلولٍ لإيقافها أو التخفيف منها. لذلك لجأ عمرو سالم، بأسلوبٍ يستبطن حدّ التطابق مفاهيمَ الدولة الأسديّة وشكليّاتها، إلى سلسلةٍ من التصريحات والمواقف العلنيّة الكثيرة التي سجّلتها ذاكرة السوريين. تلك الشكليّات تتضمّن اللجوء إلى الكذب الصريح الذي يعتبر المتلقّين مجموعةً من الحمقى، أو يطالبهم بالتماهي مع مقولاتٍ لا تمتّ إلى الواقع بأيّة صلة، بهدف إغراق الفضاء العام برواياتٍ تؤكّد سلطة النظام وتصوّراته عن الواقع. من مثل هذه التصرّفات مواقفه إبّان أزمة المخابز في فيديو شهيرٍ تندّر عليه السوريّون على السوشال ميديا كثيراً؛ أو منها فيديو أحدث عمّا سُمّي «أزمة البصل»، بعد قيام وزارته بحصر أوقات وكمّيات البصل المتاحة لاستهلاك العائلات السوريّة عن طريق «البطاقة الذكيّة»، وسواها من المواقف والتصريحات. وبدأت علائم الأزمات المتتابعة تتراكم على صورة وزارته وصورته شخصياً، إلى درجة تصاعد المطالبات على الصفحات الموالية للنظام باستقالته، تلك الدعوات التي واجهها بتصريحٍ في مقابلةٍ تلفزيونيةٍ بتصميمه على عدم الاستقالة، لأنها «في ظلّ الظروف التي نمرّ فيها […] نوع من الخيانة»، مردِفاً أنّه «يُقال ولا يستقيل، ويقبل الإقالة وهو صاغر». على أنّ كل هذه المواقف والسياسات والتصريحات لم تشفع له لدى رأس النظام الذي لم يكتفِ بإقالته على ما يبدو، إذ انتشرت عبر السوشال ميديا الموالية كذلك صورة لوثيقةٍ قيل أنّها صادرة عن «مكتب الأمن الوطنيّ» من العام 2005، فيها اتّهامات لسالم بالعمالة لصالح كلٍ من الموساد والمخابرات المركزيّة وتحذّر من تعيينه في أيّ منصبٍ عامّ. وعلى الغالب، فهذه الاتّهامات قائمة على احتمال اشتراكه في تلك الحقبة، من ضمن قائمةٍ أخرى من الشخصيّات المقيمة في سوريا أو خارجها آنذاك، في اتّصالاتٍ مع الأميركيين والإسرائيليين فيما عُرِف بدبلوماسيّة «المسار الثاني» (Track-Two Diplomacy) التي قامت بين شخصيّاتٍ وجهاتٍ أكاديميّة ومن قطاع الأعمال برعايةٍ أميركيّةٍ ودعمٍ قطَريّ لتحريك مسار المفاوضات السلميّة المتعثّر مع إسرائيل. وفي حال صحَّ هذا التوقّع فهو لا يشير إلى معرفة النظام بكلّ هذه الاتّصالات وحسب، بل وإلى مدى ضعف الأجهزة الأمنيّة السوريّة في أداء ما يُفتَرض أنّه عملها (حماية الأمن الوطنيّ)، وإلى كمّ النذالة و«المكيافيلّية» المبتّذلة التي يتّصف بها رأس النظام في تعامله مع مرؤوسيه.
وفي كل الحالات، يتّضح هنا إذاً كم يمثّلُ نمط عمرو سالم كأحد بيروقراطيّي الدولة «الأسديّة»، والطريقة التي وُزّر بها ثمّ عُزِل، نموذجَ الدولة الأسديّة بنسختها «البشّارية». فمن الصحيح أنّ بشار حاول التمايز عن أبيه في الشكليّات وحسب: فالسيرة الذاتيّة لوزرائه، وبالتحديد التقنيّين منهم، تؤكّد على ضرورة امتلاكهم لمؤهّلاتٍ علميّةٍ (يُستحبّ أن تكون من جامعاتٍ غربيّة)، وعلى تماهيهم مع نمط الإدارويّة النيوليبراليّة من حيث المفاهيم ولغة الخطاب والممارسة. لكنّه، من جهةٍ أخرى، اتّبعَ بأمانةٍ شديدةٍ مسيرة أبيه من حيث انتقاء أفرادٍ «منخورين» بصورةٍ من الصور؛ إمّا مِمّن لديهم ماضٍ مشبوه أو يمتلكون ملفّاتٍ أمنيّةٍ أو أولئك الذين عليهم تهم فسادٍ من نوعٍ ما، بل وكلّما كانوا مكروهين أكثر، كلّما ارتفعت أسهمهم لديه. ولنا في رئيس وزرائه الأسبق عماد خميس مثَلٌ بارز: إذ كان محطّ الاستهزاء والسخرية لدى الجمهور السوريّ حينما كان وزيراً للكهرباء في وزارة وائل الحلَقي (2012-2016). فما كان من بشار الأسد إلا أن عيّنه رئيساً للوزراء حيث بقي في منصبه ما يقرب من السنوات الأربع! الجميع في سوريا يعرف محدوديّة سلطات الوزارات والوزراء، في دولةٍ تحكمها فعليّاً توازنات السلالة الحاكمة ومافياتها. لكن يبقى لمنصب الوزارة بعضٌ من «البرستيج»، إضافةً إلى سلطانٍ ماليٍّ واجتماعيّ. وفي الطريقة التي تمّ فيها توزير عمرو سالم في المرّتين بعد شبهاتٍ طالته، ثمّ في الأعذار التي وُضِعت لإخراجه من منصبه، أمثلةٌ على قيمة ودور الوزراء في الدولة الأسديّة: واجهاتٌ شكليّة، شمّاعاتٌ للمسؤوليّة وتمرير الصفقات والتنفيس عن غضب المجتمع، في بعض الأحيان. إذاً، في بلدٍ لا شيء فيه اعتياديّ بأيٍّ من المقاييس، سيبقى خبر إقالة وفضيحة عمرو سالم خبراً آخر من الأخبار الأقلّ من الاعتياديّة.