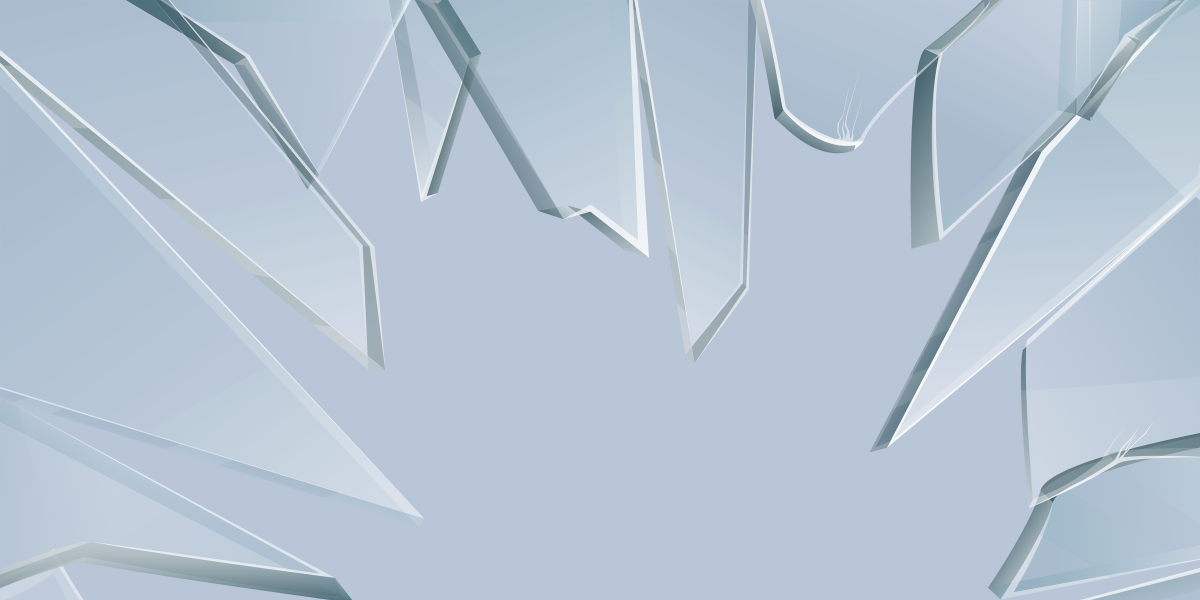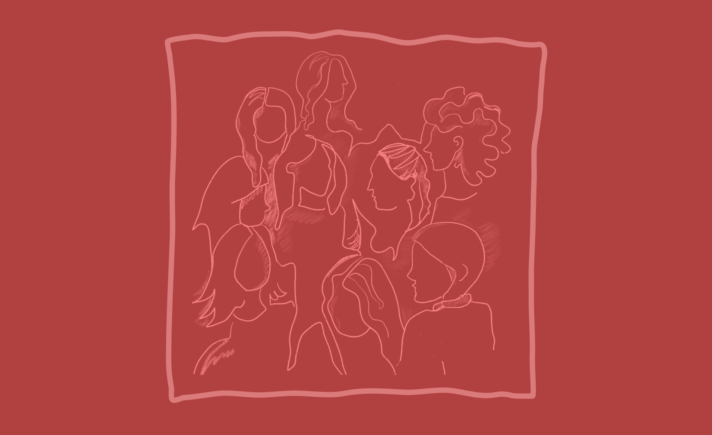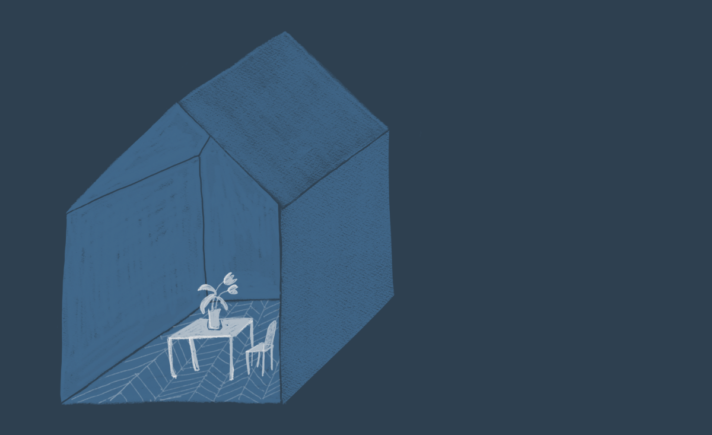«إن لم أُعرِّف نفسي بنفسي، فسأكون مُنغمسة في تخيّلات الآخرين عني، وسأُؤكْل حيّة»
أودري لورد
أَتوَّغل في الاغتراب والغضب. بدأ ذلك منذ العمر الذي فهمتُ فيه معنى التوقعات الجندرية تحت جناح البطريركية، أدركت ذلك منذ طفولتي. لكني حتى مدة ليست ببعيدة لم أكن قادرةً أن أُعرِّف نفسي، وكنت أرفض أي شكل من أشكال الانتماء. يُصعّب ذلك من عملي كفنانة في مجالٍ تحكمه سياسات الهوية، خاصةً كوني لم أملك الأدوات اللازمة للعمل على مواضيع تهمني دون الوقوع في فخ الضحية السلبية التي يحتاجها النظام المهيمن، والتي لا تستطيع التحدث إلا عن آلامها، في سوريا نسمي ذلك «تنفيسة». ولهذه الأسباب لم أستطع الاقتراب من مواضيع شخصية وأسئلة جيوسياسية تعنيني لسنوات.
عام 2017 كنت أتقدّم لمنحة موجّهة للفنانات-ين المهاجرات-ين المقيمات-ين في فيينا، وأنا على علم أن مشاريع كهذه لا تُحدِث تغييراً، بل تؤكد على وضعنا في مكان «الآخر» الضحية. بعد عامين من موجة المَعارض والمشاريع التي اهتمت بما سُميّ «بأزمة اللجوء»، لكنها لم تكن من موقع تحرري، بل سطحي، وفي بعض الأحيان عنصري، كتبتُ وقتها:
«لا أُعرّف نفسي على أنني مهاجرة، أو نسوية، أو كويرية، أو ديكولونيالية، أو ناشطة. على الرغم من أنني امرأة مهاجرة ناشطة سياسياً، قادمة من أماكن لها تاريخ طويل مع الاستعمار. ربما ما أطلقتْ عليه روزي بريدوتي اسم ’’الآخر المتحول‘ (The Metamorphic Other) هو أقرب هوية؛ الآخر الذي التي يطارد الرؤية المهيمنة. ما يهمني هو الاعتراف بالذاكرة المضادة، والتاريخ المضاد، التغّلب على التأريخ السائد من أجل تكوير الذاكرة والعمل مع هذا المستحيل في مجتمع نيوليبرالي».
بالنسبة للفيلسوفة والمنظّرة النسوية روزي بريدوتي، يحتاج المهيمن إلى الآخر المتحوّل من أجل تمثيله الذاتي. وبما أن الذات المُهيمِنة تحتاج إلى الآخر من أجل الوجود، يشكل الآخر المبني من قِبَلها في المقام الأول خطراً لأنه ضرورة. فيمكن أن يتسبب هذا الآخر في إلغائها لأنه لا يوجد إلا من خلال مرآتها. أعجبتني هذه الفكرة، وقرّرتُ التخلّص من المرآة كبداية في رحلة طويلة من إعادة التعلم، ومحاولة التعامل مع نظام تعليم مازال الرجل الأبيض يحكمه.
أعي الآن أهمية التموضع كفعل تحرري، لكني وقتها كنت منغمسةً في رفض تخيّلات الآخرين عني، وكان التعرّف على عمل بريدوتي مساعداً. ومع أنها تُعتبر نسوية تقاطعية، لم أجد نفسي في الحركة النسوية التقاطعية ولم أُعرّف عن نفسي كنسوية حتى تعرّفتُ على عمل النسويات ذوات البشرة السوداء والملونة كأودري لورد، وسارة أحمد، وبيل هوكس. وتعلّمتُ منهن أن هذا الرفض وحده غير كافٍ. لم يكن الطريق سهلاً، بل شائكاً ويتطلب الكثير من النبش والتفكيك والشك.
خلال فترة دراستي في سوريا، ربطت النسوية بالنسوية البيضاء. كنت أعرف القليل جداً عن النسوية التقاطعية، وأن النسوية يمكن وينبغي أن تشمل التقاطعات بين العرق والطبقة الاجتماعية. لا أعتقد أن ذلك كان بسبب تقصيرٍ أو عدم اهتمامٍ مني، بل لأن الفن والفكر النسوي ما يزال مهمشاً ومدفوناً، يتطلّب أدوات جديدة لا تقدمها لنا المدارس والجامعات على طبق من ذهب. من أهم ما تعلّمته في هذه الفترة هو مُساءلة المعرفة المُقدّمة على أنها حقيقة، وعن العلاقة الوثيقة بين إنتاج المعرفة والسلطة. إن ترعرعتَ تحت نظام الحزب الواحد، يمكنك إدراك ذلك بسهولة دون قراءة ميشيل فوكو!. كما تعلمتُ خارج الجامعة من خلال نقاشاتي مع زملائي، نقاشاتٌ كانت تنتقد المنهاج الدراسي من جهة عدم تضمينه لمواضيع تهمّنا، ولأنه لا يعلّمنا إلا عن تاريخ الفن الحديث في فترة محددة، تبدأ بصالون المرفوضات وتنتهي قبل «ما بعد الحداثة»، هذا التاريخ المكتوب من منظور المستعمِر، ولا تُذكر فيه أسماء الفنانات النساء حتى.
لا يكفي ذكر الأسماء المُغيّبة عن تاريخ الفن المهيمن، ولن تكفي إضافة الصفوف الاختيارية التي تُعنى بالفن النسوي والكويري إلى مناهج الجامعات. بل يجب علينا النظر في الممارسات التي لم يُنظر إليها كفنٍّ من الأساس، وذلك ليس من أجل إضافتها بشكل هامشي إلى هذا التاريخ، بل من أجل الاستفادة منها لصنع أدوات جديدة وبناء منزل جديد لا يوجد في العلاقة مع الرجل الفنان أو المفكر، ولا في غرفة صغيرة تحت جناحه. ومن أهم ما كُتب عن إمكانيات هذه الأدوات وضرورة النسوية التقاطعية نص: لا يمكن لأدوات السيد أن تهدم منزله (1979). كان هذا النص في الأصل خطاباً ألقته أودري لورد في مؤتمر نسوي سُميّ على اسم كتاب الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار. كان حضور النساء ذوات البشرة السوداء مهمشاً، إذ تمّت دعوتهن آخر لحظة إلى دائرة أكاديمية نسوية بيضاء لم تنظر إلى مشاكلهن كجزء رئيسي من قضاياها.
عن التشكيك في دور السلطة ومن يمسكها، «السيّد»، كتبت أودري لورد: «لأن أدوات السيّد لا يمكن أن تهدم منزله. فهذه الأدوات قد تسمح لنا بشكل مؤقت بأن نهزمه في لعبته، ولكن هذا لن يمكّننا مطلقاً من تحقيق تغيير أصيل. وهذه الحقيقة تمثل تهديداً فقط لهؤلاء النساء اللاتي لا يزلن يعرفن منزل السيّد على أنه المصدر الوحيد لدعمهن». بالنسبة إلى لورد، فإن التخلي عن أدوات السيد هو الطريق إلى الأمام. هو أن نرى كيف يكون الشخصي سياسياً، لنرى كيف تساعد الرؤى الشخصية، على إرساء أسس العمل السياسي الجماعي الذي يُحدث تغييراً.
«الشخصي هو سياسي» كان شعاراً مهماً جداً في الموجة الثانية، ولا يزال يطارد ذاكرتنا. عند إعادة التفكير فيه اليوم، في الأماكن التي لا يستطيع فيها التابع التحدث إلا إن تكلم عن آلامه – تؤكد ذلك إيف تاك -، نكتشف أننا لم نهدم منزل السيّد بعد. ولا يمكننا فعل ذلك إلا إذا أدركنا أن تعليم الثقافة المهيمنة والأبوية عنا لن يُحدِث تغييراً جذرياً. وفي منزلنا الجديد يجب أن نكون رواة القصص والباحثات-ين عن تاريخنا المضاد. عندما استطعتُ تعريف نفسي كنسوية ممارسة لها في الأكاديمية والمنزل والشارع، استطعتُ العودة إلى أساليب مختلفة من إنتاج المعرفة التي كانت حولي دائماً لكني أهملتها. واستطعت حينها أن أعمل انطلاقاً من الشخصي-السياسي. ونظرت في التاريخ النضالي لعائلتي الفلسطينية ضد الاستعمار. حدّثني جدي المهتم بالتاريخ -خاصة بما لم يؤَرخ- على مُساءلة ما تعلّمته في المدرسة على الدوام. وأخبرني أن هناك صورة أكبر دائماً، أن المخفي من التاريخ تُسجّله الحكايات.
استطاعت أودري لورد، المشهورة بعبارة «لن يحميك صمتك»، الكلام في الوقت الذي تعلّمتْ فيه الكتابة بعمر الأربع سنوات. كانت تُقدّر أهمية الشِعر منذ طفولتها، وتحفظ القصائد التي تستخدمها للتعبير عن مشاعرها. أتذكر كيف كان جدي يقول لي عشرات القصائد التي يحفظها عن ظهر قلب في منزلنا الصيفي، على الطرف الآخر من جبل الشيخ الذي يفصل بينه وبين فلسطين. وفي زيارتي الأخيرة له أخبرني بسره، عندما كنا نستذكر قصيدة لمحمود دوريش وسبقتُهُ في تذكر الكلمات: «في الشعر القديم أقوم باستبدال الكلمة التي نسيتها بما على وزنها، وبما يناسب المعنى. لا تنفع هذه الحيلة مع الشعر المعاصر». وأنا كنت خلال كل هذه السنوات أتعلم القصائد من منظوره الشخصي. أعجبتني هذه الخدعة، فالشعر يتغلّب على سلطوية اللغة، وهو أداةٌ للشعوب المستعمرة كالحكايات. وفي اعتراف جدي إدراكٌ لأهمية الشخصي، الذي تنكره إيديولوجيا المؤرخ أو السلطة وتتحكم به الأنظمة المستبدة البطريركية.
بعد تعرُّفي على الفكر النسوي وعلى منهجيات السكان الأصليين في الإنتاج المعرفي، اكتشفت أن معرفة الشعوب المستَعمَرة لا تقتصر على التاريخ الشفوي، بل هنالك طرقٌ لإنتاج علاقات بين الأشكال والمعنى والأرشفة بلغات لا تحكمها سلطة المستعمر. كان التطريز من حولي قبل أن أعرف أنه شكل من أشكال إنتاج المعرفة. فكانت جدتي ترتدي الثوب الفلسطيني المطرّز كفعل سياسي. وتُطرز خريطة فلسطين قبل الاستعمار كممارسة مقاومة، بينما كان جدي منخرطاً في العمل السياسي. فَتَح تعلّم هذه اللغة عالماً من الاحتمالات المعرفية خارج منزل السيد.
إن فَهِمْنا أن أدوات السيّد لا يمكن أن تهدم منزله، سنواجه أنواعاً مختلفة من المشكلات. الغضب والاغتراب الذي نشعر به عندما نعمل على القضايا المتعلقة بالعرق والطبقة والجندر، والذي كتبت عنه أودري لورد في نص استخدامات الغضب، قد لا يتحول إلى وقود ولكنه يحرقنا من الداخل إن لم نعرف كيف نستخدمه. خارج منزل السيّد نحن معزولات ومغتربات. ولكن هذا الاغتراب هو الطريق الوحيد نحو تحريرنا. يؤكد على ذلك بيان Xenofeminist: A Politics for Alienation الذي نُشر عام 2018: «جميعنا مغتربات-ين، لكن هل كنا غير ذلك من قبل؟ من خلال اغترابنا، وليس على الرغم منه، يمكننا تحرير أنفسنا من وحل الفورية. الحرية ليست مُعطى – ولا يمنحها أي شيء ’طبيعي‘ بالتأكيد. لا ينطوي بناء الحرية على اغتراب أقل بل أكثر؛ الاغتراب هو عمل بناء الحرية. لا ينبغي قبول أي شيء على أنه ثابت أو دائم أو ’معطى‘، لا الظروف المادية ولا الأشكال الاجتماعية.».
جميعنا مغتربات-ين تحت النظام البطريركي والرأسمالي، يتعامل المخرج السويدي روي أندرسون مع عبثية هذا الاغتراب في أفلامه على سبيل المثال. شخصياته مغتربة، وحيدة، وقد تحاول التغلب على الحزن والعبثية التي يُظهرها في حياتهم اليومية. في مشهد من فيلمه الرائع أنت، الحي يقرر الحلاق العربي الغاضب إفساد شعر زبونه، ويخرج من المحل في لحظة المقاومة، بعد أن قال له الرجل الأبيض إن العرب يكتبون بالمقلوب. يقوم بذلك بعد أن يحاول أن يشرح له: «إذا عبرت السيارة الشارع من اليمين، فهذا لا يعني أنها تسير للخلف». لغة الحلاق بالمقلوب ما دامت الطريقُ هي المهيمنة. وخارج هذا الطريق المؤدي لمنزل السيّد، نستطيع أن نتعلم عن استخدامات الاغتراب والغضب، وأن نتكلم عن أنفسنا بغيابه.