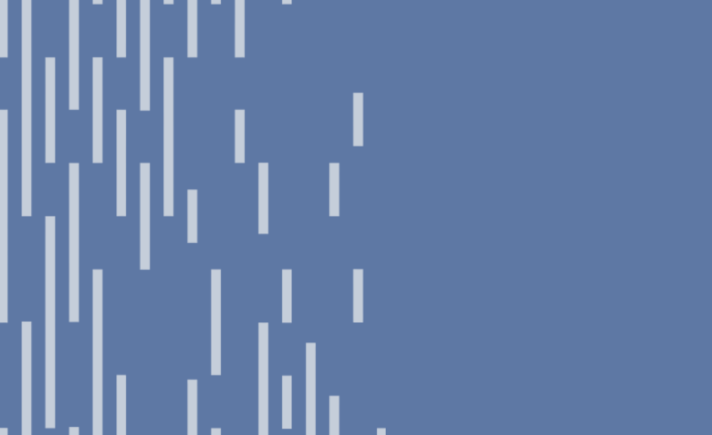«إيمان الجماهير» لا يشبه الإيمان الذي نحتاجه وقت الشدائد في شيء. إنه إيمان الكتل التي تذوب فيها جميع التفاصيل بحرارة صهرٍ تُذيب حتى الفولاذ، حتى تلك التي تعطي للكائن ملامحه، فيغدو الكل واحداً، ويتحولون إلى كتلةٍ مصمتةٍ صمّاء. هناك تعطيلٌ حقيقي، ليس فقط لمدارك أساسية ومحاكماتٍ عقلانية تُبنى عليها، عند «تابعٍ» ما، وهو من يفترض أن يكون حراً لا يملك أحدٌ سلطةً عليه طالما بقيَّ في الروح نَفَس؛ بل إن المشكلة تصبح أكثر غِلظة حتى في حضورها الثقيل الفارض نفسه بجبروت تلك الكتل نفسها، التي يُفترض أنها بشرية، والتي لا تلبث أن تتحول إلى ماكيناتٍ تدور بهديرٍ لا يرحم حول مركزٍ واحد… سواء أكان صنماً، زعيماً، فكرةً، أو حتى مبنىً حجريٍّ ما وسط الصحراء… فتصبح الحياة، بهذا الدوران الأبدي الكُتَلي الأصم، هباءً دون أي معنى.
ولكن هناك إيمانٌ آخر؛ إيمانٌ كنسمة، كما يمكن للإيمان أن يكون، إنْ وُجد كقيمةٍ جديرةٍ بالاحتفاء بها؛ إيمانٌ لا يعاني من رهاب التفاصيل الإلزامية لجموع المؤمنين الباكين، لدرجة فقدان الإدراك في حضرة إلهٍ ما. هي تفاصيل، إن وجدت، وهي ستوجد ما دمنا بشراً، فهي تعني صاحبها، يصوغها على هواه وبما يسعده؛ إيمانٌ حنونٌ ودافئ، الحديث عنه مليءٌ بالشوق والذكريات. إنه ذلك الإيمان الخاص بحنان أمّهاتنا وبأملهن الذي لا ينضب. أمّهاتنا، بأغطية رؤوسهن البيضاء، هنّ من أنجبن أنبياء آخر الزمان السوري: الخوذ البيضاء.
لا أظن أن حناناً، وإيماناً، يقلّ عن حنانهن وإيمانهن بعمقه وصدقه وبالتالي قدرته على خلق شيء جميل، حتى ولو من عدم. لا أظنّ أن عاطفةً كهذه يمكن أن يحتملها إنسانٌ ما، إن لم يكن وطّن نفسه ليكون نبياً، ولكن دون رسالةٍ تدعو إلى إله ليس إلّا وسيطاً يتحكم من خلاله برقاب العباد. «نبيّنا» هذا نبيٌّ فقط لتكريس تلك الفكرة التي لم تنفك أمهاتنا عن الإيمان بها حتى آخر قطرةٍ من أرواحهن: الخير لم، ولن، يزول من هذه الدنيا.
عندما تقع الأنقاض فوق رأسك الأعزل -وهل هناك «رأسٌ» غير أعزل؟- ولا أحد في العالم كله، ربما حتى جزءٌ من أولئك الذين كانوا قد نجوا بأرواحهم من تحت السقف نفسه الذي كان يؤويهم معك، معنيٌّ بك، سوى تلك الأيادي التي، على قلّتها، تحمل من الرحمة ما يكفي لبثّ نسمة هواء، أو شربة ماء، طال انتظارها وعزّ وجودها. عندما يحدث هذا، فإن أصحاب تلك الأيادي، هم فقط، من يُنجيك من مواجهة مصيرٍ أعمىً لا تعرف كيف حلّ بك، بكل ما يحمله من عدم، فيعيد إليك بعضاً من ذلك اليقين الذي يبقيك حياً ولو لبضع لحظاتٍ على أمل. ليس سوى أصحاب تلك الأيادي، كأيادي أمهاتنا، مَن يجعل لهذا الأمل معنىً فعليّ.
من أي يقينٍ قُدَّ هؤلاء الأنبياء، نساءً ورجال؟ أيُّ فرجة أملٍ مباغتة، كائناً ما كان حجمها، ألقتهم في سواد حياتنا لتنير ولو قليلاً؟ معيدةً إلينا بعض ذلك الإيمان النسمة، الذي لن نجد سواه، في كل الأحوال، منقذاً لأرواحنا من الغياب في حفرة موتٍ أُريدَ لنا جميعا أن نُدفن فيها فقط لنعود كما كنا، منسيين. حتى لا يتعكر صفو حياة بشرٍ آخرين يريدون أن يتابعوا حياتهم كالمعتاد بعيداً عن آلام غيرهم، حتى ولو كانوا يعيشون على بعد بضعة أمتارٍ فقط.
ليس هناك أقسى من الحجر، بالذات عندما تضعه يداك فوق جثمان عزيزٍ فارق الحياة. تدرك، وأنت الحي، أن في الأمر رسالة في غاية القسوة، لك، وليس لمن تضع الحجر فوق جثمانه وهو الميت ربما منذ أيام، أن لا رجوع… انتهى… هنا آخر الطريق، هنا الحجر. تحتاج إلى وقتٍ، ربما يستمر سنيناً، لتنسى. فكيف يكون الحال والحجر اللعين نفسه يهبط عنوةً فوق رؤوس مَن كانوا يتنفسون ويضحكون ويحلمون قبل لحظات؟ أولئك الأنبياء يقاومون ذروة القسوة تلك التي فُرضت علينا عنوةً، عبر حياةٍ كاملةٍ أو بغتة. إنهم يمدّون أيديهم، وأرواحهم، عبر هذا الحجر ليعيدون الميت إلى الحياة، ليُعيدونا نحن إلى الحياة.
لا أحد سواهم، وجثثنا الملقاة على قارعة الطريق أو تحت الأنقاض. وزِلزالنا قد مضى عليه ما يكفي من وقت، إثنا عشر عاماً متواصلة، لندرك هذه الحقيقة. فأن تقف وحدك وسط كل هذا الدمار المعمّم الذي سدَّ حتى الأفق نفسه، ولديك أملٌ بأن تُنقذ روحاً ما، فوالله إن هذا لجديرٌ بأن يعيد خلقنا من جديدٍ بعد موت.