منذ عقود لم تعد قليلة، وتعبيرا «أزمة الثقافة العربيّة»، و«أزمة المثقّفين العرب»، يلازمان النصّ العربي، السياسيّ منه والفكري السياسيّ.
ولئن تجمّعت لدينا أفكارٌ لم يعد يمكن الاستغناء عنها عند أيّ تناولٍ جدّيّ للظاهرة المذكورة، فما تسعى إليه هذه المداخلة هو التركيز على علاقةٍ نزعم أنّها إحدى العلاقات المؤسِّسة لتلك الأزمة، وعلى حقبةٍ هي التي لا تُفهم العلاقة تلك، في نموّها ومساراتها، إلّا بالرجوع إليها.
فليس بلا دلالة أن يعتبر المؤرّخ المغربيّ عبد الله العروي، في كتابه الإيديولوجيا العربيّة المعاصرة، أنّ الثلاثة الأشدّ تأثيراً في فكرنا السياسيّ، أو موديلاته البدئيّة، هم «رجلُ الدين» محمّد عبده و«السياسيّ الليبرالي» أحمد لطفي السيّد و«داعية التقنيّة» سلامة موسى، علماً بأنّه رأى الثلاثة تابعين لصيغٍ سابقةٍ من الحداثة الغربيّة. والثلاثة، مع فوارق طفيفة في حِسبة السنوات، أبناء تلك الحقبة إيّاها التي سمّاها الأكاديميّ الفلسطيني الأميركي هشام شرابي «السنوات التكوينيّة»، جاعلاً التسمية هذه عنواناً فرعيّاً لكتابه المثقّفون العرب والغرب.
والحال أنّ 1875-1914 هي بالضبط سنوات «الزمن الجميل» الأوروبي، حيث شهدت أوروبا تضافر النمو والازدهار والسلام وحركة الإبداع والاختراع، كما عَرفت في خارجها التوسّع والإمبرياليّة.
ويمكن، أقلّه ثقافياً، أن نمدّ بعض تيارات تلك الحقبة بضعة عقود، إذ استمرّت مفاعيلها، بتقطّعٍ وتعثّر، مع استقلال مصر غير الناجز في 1922 ثمّ العقود المَلكيّة والبرلمانيّة الثلاثة التي تلته، ليبدأ الانقطاع مع انقلاب يوليو 1952 الذي أعلن افتتاح الخاتمة البائسة.في صياغة الروائيّ والكاتب المصريّ عزّت القمحاوي: «بحلول منتصف القرن العشرين تحوّلت أنظمة الحكم في دول الثقل الصحافيّ والأدبيّ، مصر والعراق وسوريّا، إلى جمهوريّات عسكريّة المنشأ، وبدأت المسيرة المعاكسة باتّجاه نموذج دولة السلطة القويّة والمجتمع الضعيف. وفي إطار هذا المسعى سيطرت السلطة على الصحف، وأصبح الجدل السياسيّ محرّماً والجدل الأدبيّ مكروهاً، فخفتَ صوت المعارك الأدبية في كلّ دولة، حسب درجة السيطرة على المجال العامّ». عزت القمحاوي، ثقافة الانتظار لا تحب المعارك، في: جريدة الشرق الأوسط، 21/11/2022.
فما سمّاه بعض المؤرّخين «النزعة الإصلاحيّة»، وبعضهم الآخر «الحقبة الليبراليّة»، عاش في جوار التمدّد الأوروبيّ نحو «الشرق»، من هجوم الروس على تركيا (1877) إلى احتلال فرنسا تونس (1881)، ثمّ احتلال بريطانيا مصر (1882)، وصولاً إلى وقوع ليبيا والمغرب ومعظم «الممتلكات التركية» في أوروبا، إبان الحرب الأولى، في قبضة الأوروبيين. وكان الوجه الاحتلالي هذا ما أملى النظر إلى أوروبا «أكثر فأكثر بمعيار الإمبرياليّة، وأقلّ فأقل بمعيار التقديمات الثقافيّة». هكذا تَبلور حيالها، «في العقد أو العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر، موقفٌ سلبيٌّ ومُعادٍ».Hisham Sharabi, Arab intellectuals and the West: the formative years, 1875-1914, Johns Hopkins Press, 1970, p. 46.
وهذه عموماً باتت حقائق معروفة، بل معلومات مدرسيّة كُتب فيها الكثير بدءاً بعمل ألبرت حوراني الشهير عن العصر الليبرالي (الفكر العربي في عصر النهضة، كما عُرِّب). لكنْ إذا كانت الثقافة الحديثة، كالسياسة والاقتصاد الحديثين، من مواليد «الزمن الجميل» وامتداداته العالميّة المتضاربة، فمن الصعب، أقلّه نظريّاً، أن تتساوى الثقافة والسياسة والاقتصاد حيال البُعد الصراعي مع أوروبا، أو الغرب، أي مصدر «الزمن الجميل». ذاك أنّ الفارق بين الثقافة وكلٍّ من السياسة والاقتصاد قابل لأن يُختصَر بالتالي:
هناك بين السياسة الحديثة والغرب، بوصفه أصل تلك الحداثة، هامش صراعٍ عريض مداره السلطة ورمزه المباشر نيل الاستقلال، ما قد يتأدّى عنه عنفٌ وتدميرٌ ورغباتٌ استبداليّة مؤكدة. والشيء نفسه يُقال في علاقة الاقتصاد الحديث بالغرب، إذ هما قد يتنافسان في السوق الوطنيّة وفي الاستحواذ عليها، ما قد يدفع إلى إجراءات وقائية وحمائيّة أو أخرى عِقابيّة يفرضها المتروبول. غير أنّ هذا كلّه لا يصحّ في العلاقة بالثقافة وعموم البنية الثقافية الحديثة.
فمنذ أن بدأت المدرسة تحلّ محلّ الكُتّاب، والمسرح محلّ الحكواتي، والرقص الحديث محلّ رقص الدراويش…، وبكلمة، منذ شرَع المثقّف يحلّ محلّ الشيخ، نشأت علاقة أبوّة كاملة بين الغرب وثقافتنا في ظهورها الحديث. فإذا كان التناقض بين السياسة والاقتصاد الوطنيين وبين الغرب قابلاً يستند إلى أسباب ومقدّمات «مهنيّة»، فإنّ تناقضاً كهذا بين الثقافة الوطنيّة والغرب يرقى، وقبل أيّ اعتبار، إلى خيانةٍ لـ«المهنة» ذاتها وإعاقة لحسن اشتغالها. فكيف وأنّ المثقّفين، على عكس السياسيّين ورجال الاقتصاد، غير معنيّين بإرضاء مزاج عامّ، وهو ما تبلغ صحّتُه أعلى درجاتها في قطاع عريض منهم كأساتذة الجامعات و/أو العاملين في مراكز الأبحاث.
فقابليّة الثقافة إذاً لأن تقلّ عن السياسة والاقتصاد استغراقاً في الصراعات الدائرة والنظرة التناحريّة المنجرّة عنها، إنّما تستند إلى تلك الأبوّة الكاملة التي لا تتوفّر للدائرتين السياسيّة والاقتصاديّة. وتقديرٌ كهذا يعزّزه افتراضٌ تكثر البراهين عليه: فإذا كانت المساواة بين البشر، كما بين الأمم، مهمّةً لا يُمارى في صحّتها وأخلاقيّتها، كما لا يُمارى في حق الشعوب بنيل استقلالها والتمتع بثرواتها، فالمساواةُ بين الثقافات لا يصحّ فيها هذا الحكم تبعاً للقابليّات المتفاوتة لدى الثقافات لجهةِ تسهيلها الاندراج في الزمن الحديث، ناهيك عن تفاوتها في إنتاج الحداثة ذاتها.
الحرّيّة والحقبة الاستعماريّة
مع الإقرار بالضجر الذي قد يسبّبه السرد التِعداديّ الخام للقارىء، ممّا يمكن العثور على مادته في أدغال الإنترنت، لن تتردد هذه الأسطر في استعادة معطيات وأحداث كبرى في مَسارَي الحداثة والثقافة العربيّتين، لا سيّما المشرقيّتين. فكون هذا معروفاً ومتاحاً، لا يقلّل، بل يكثّر، تَظهير لوحة تلك الأبوّة الكاملة والمُحكَمَة.
ففي كنف الحقبة الاستعماريّة وما بقي من مفاعيلها إبان نظام الأعيان التقليديّين، أحرز المثقّفون الشرط الأوّل للعمل الثقافي، وهو الحرّيّة وما يصاحبها من نزعات نقديّة ونقاش عامّ.
وكان من تحصيل الحاصل انشغال المثقّف الحديث، الذي أنتجته الحقبة الكولونياليّة، بالمفاهيم والمعطيات التي تنتمي إلى الأفق التاريخيّ ذاته الذي تنتمي إليه الثقافة الحديثة، أي الحرّيّة أساساً، ومن ثمّ باقي المفاهيم والمعاني التي تكون الحرّيّة شرط إحضارها إلى النقاش العام، كالعدالة والمساواة والوطنيّة والدولة والإدارة والمدرسة وحقوق المرأة والتسامح الدينيّ وتحديث اللغة ونزع السحر عن العالم إلخ…
وهذا الانتساب إلى ذاك الأفق يصحّ، بهذه النسبة أو تلك، في عدد من المثقّفين المصريّين وعدد آخر من زملائهم اللبنانيّين والسوريّين والعراقيّين. فمنذ الربع الرابع من القرن التاسع عشر بدأت تظهر، بما لم يَخلُ من براءة المحاولات الأولى وتخبّطها، مفاهيم حقوق المرأة، كما عند وليّ الدين يكن، ومناوأَة الاستبداد، كما عند عبد الرحمن الكواكبي، فضلاً عن مفاهيم الوطنيّة والشعب، كما عند بطرس البستاني، وهي جميعاً موضوعات جعلت تتبوّأ مذّاك أدواراً ومواقع غير مسبوقة في الأدب العربيّ ثمّ في الفنون ولاحقاً السينما. كذلك عرَّفَ شبلي الشميّل بنظريّة داروين، وهي المهمّة التي انضم إليها اسماعيل مظهر مع نهاية الحرب العالميّة الأولى، وواكبها في العراق الشاعر (وابن المفتي) جميل صدقي الزهاوي.
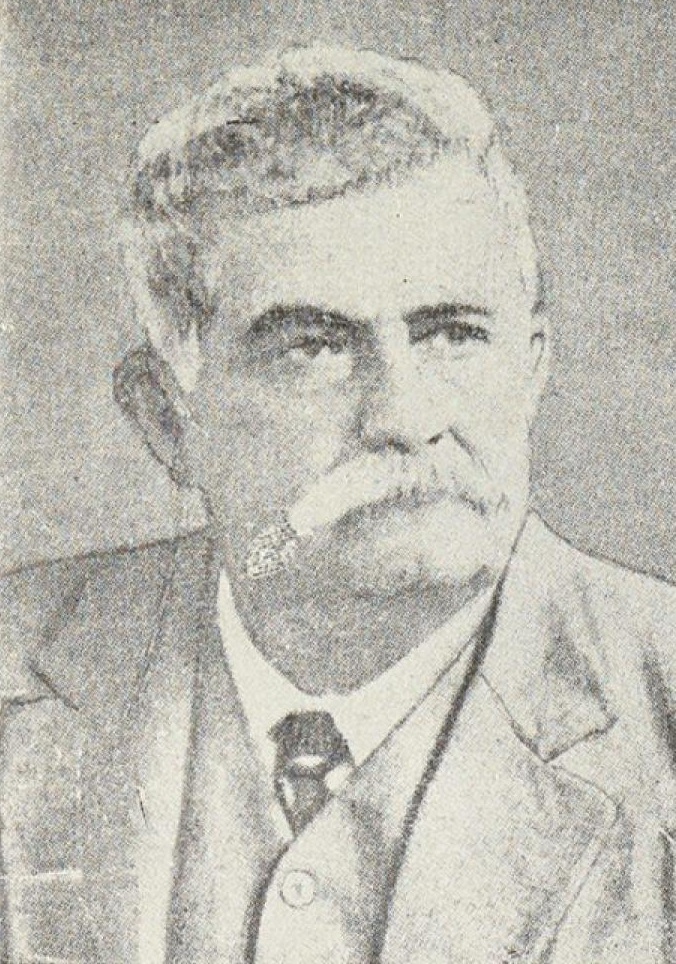
وفي 1902، اندلعت مناظرة الشيخ محمّد عبده وفرح أنطون حول الدين والحرّيّة والعلم والعَلمنة بعد نشر الثاني دراسته عن ابن رشد. وما لا يقلّ أهميّة عن الموضوع الحسّاس للسجال، تجرّؤ مسيحيّ لبنانيّ شابّ هاجر قبل خمس سنوات فقط إلى مصر، على مجادلة أحد أهمّ مراجع الدين في العالم الإسلاميّ، والذي سبق أن شغل، بين ما شغل، إفتاء الديار المصريّة. وإذا كان أنطون حينها في الثالثة والعشرين، فعبده كان في الثالثة والخمسين.
وفي 1913 طرح أحمد لطفي السيّد إحلال اللهجة المصريّة محلّ الفصحى، وتجرّأ على تبيان ما اعتبره قصوراً في العربيّة «لغة القرآن» عن مواكبة التحوّلات الحياتيّة والعلميّة. وقد تصدّى له مصطفى صادق الرافعي مُماهياً اللغة بالدين والحضارة.
وفي 1925 استطاع علي عبد الرازق، في الإسلام وأصول الحكم، أن يخترق، وهو رجل دين، المؤسّسة الدينيّة نفسها، نافياً وجود نظام الخلافة في الإسلام، وداعياً، بحسب بعض شارحيه، إلى فصل الدين عن الدولة. وقد أصاب حجر عبد الرازق عصفورَيّ السلطة والدين، إذ اعتُبر عمله تحدّياً موجّهاً للسلطات السياسيّة الطامحة إلى الاستحواذ على خلافة ألغاها أتاتورك. ولأنّ حاكم مصر الملك فؤاد كان أبرز الطامحين بتولّي الخلافة، تأدّى عن تحدّيه سحب شهادة العالِميّة منه.
وفي 1926، وفي إحدى أكبر مناظرات التاريخ العربيّ الحديث، كان كتاب طه حسين في الشعر الجاهليّ حيث رأى أنّ ذاك الشعر «منحول»، بما يثيره ذلك من اعتراض على الرواية السائدة والمقدّسة في قراءة التاريخ. وكان الرافعي أيضاً أحد الكثيرين الذين ردّوا عليه بكتاب سمّاه تحت راية القرآن.
وبدا من اللافت في حالتي عبد الرازق وحسين، اللّذين بكّرا نسبيّاً في إثارة المسائل الحسّاسة، أنّ المناخ العريض الذي اكتنف القضيّتين كان بلا قياس أشدّ صحّيّة وأقلّ تعصّباً وحقداً ممّا عهدناه لاحقاً. فالعقوبات التي نزلت بهما خلت من العنف، وكانت وظيفيّةً وعابرة، والأهمّ أنّها بدت قابلة للتراجع، إن لم يكن التكفير عنها: فعبد الرازق تولّى، في 1948-1949، وزارة الأوقاف، كما شغل عضويّة مجلسي النوّاب والشيوخ، فضلاً عن عضويّة مجمع اللغة العربيّة في القاهرة. أمّا طه حسين فنيطَت به عمادة كلّيّة الآداب في الجامعة المصريّة بعد سنوات قليلة على قضيّة كتابه، ثمّ وُزِّرَ في آخر حكومات حزب الوفد عام 1950، حيث سُلّم وزارة المعارف. ومن خلالها حقّق إنجازه الأكبر وهو مجّانيّة التعليم الذي هو «كالماء والهواء».
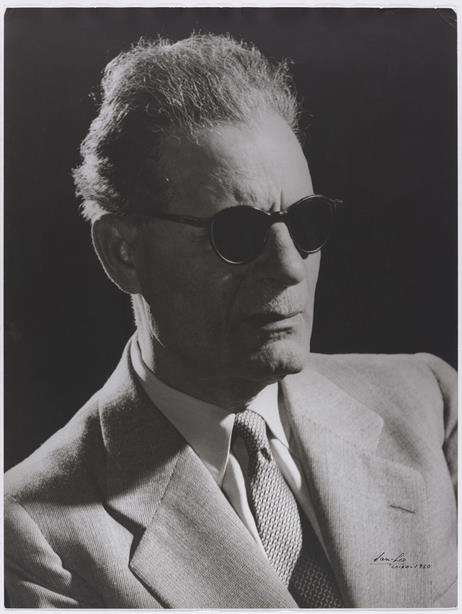
ثمّ في 1937 وضع اسماعيل أدهم رسالته لماذا أنا ملحد؟، رادّاً على محاضرة ألقاها أحمد زكي أبو شادي بعنوان عقيدة الألوهيّة، ومدافعاً عن التوفيق بين الدين وحقائق العلم. وبدوره ردّ محمّد فريد وجدي على أدهم بمقالته لماذا هو ملحد؟.
ولم يعد بلدٌ كالعراق بمنأى عن تلك المؤثّرات. ففي 1933 مثلاً أصدر الشاعر معروف الرصافي كتابه الشخصيّة المحمّديّة حيث قدّم، هو الآخر، محاولة في التأويل التاريخيّ تُجافي الرواية الدينيّة.
وكانت الحرّيّة الثقافيّة تلك وجهاً من وجوه الحرّيّة السياسيّة. ففي عام 1907 وحده نشأت خمسة أحزاب في مصر، أسّس معظمها مثقّفون وكتّاب وصحافيّون كأحمد لطفي السيّد (حزب الأمّة) ومصطفى كامل (الحزب الوطنيّ) وعلي يوسف (حزب الإصلاح). ولم يتأخّر العراق عن اللحاق بالركب فصدر، في 1922، «قانون الأحزاب والجمعيّات» ممهّداً لقيام أحزاب أربعة (الوطنيّ والنهضة والحرّ وحزب الأمّة)، وفي الثلاثينيّات ظهرت «جماعة الأهالي» قبل أن يتفرّع عنها «الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ» الذي أسّسه مثقّفون أبرزهم كامل الجادرجي ومحمّد حديد.
فإذا جاز الكلام عن تداخل بين السياسيّ والثقافيّ حينذاك، فالواضح أنّ الغلبة كانت للثقافيّ الذي يقود السياسيّ أكثر ممّا يُقاد به. وفي السياق هذا حاول المثقّفون نقل أفكار وإيديولوجيّات غربيّة كالليبراليّة والفابيّة، فضلاً عن الماركسيّة، إلى بلدان المشرق.
وكان ممّا أتاحته الحرّيّة أنّ الأيقونات الأدبيّة والشعريّة لم تعد بمنجاة من النقاش والنقد العامّين. فمنذ العشرينيّات هاجم جماعةُ «الديوان» (عبّاس العقّاد وعبد القادر المازني…) أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والمدرسة الشعريّة السائدة وطرائقها في الكتابة. وفي الثلاثينيّات نشأت جماعة «أبولو» التي ذهبت بعيداً في انشدادِها إلى الآداب الأوروبيّة، لا سيّما الرومنطيقيّة الإنكليزيّة، ودار معظم إنتاجها على الطبيعة ومعاناة الفرد.
قبلذاك، وفي موازاتهِ، كان لتطوّرين بارزين أثّرَا في أحوال اللغة والكتابة العربيّتين، وباشرا لوناً من القطع مع التناول المنفلوطيّ المتهالك: الأوّل، ترجمة الكتاب المقدّس التي لم تكن بعيدة من البيئة الإرساليّة ومن ثمّ الجامعة الأميركيّة (الإنجيليّة السوريّة آنذاك) في بيروت، وهو ما بدأ مع أحمد فارس الشدياق ووليم واتس في 1857، ثمّ بطرس البستاني وعالي سميث وكرنيليوس فاندايك في 1865. أمّا التطوّر الثاني فجسَّده ما بات يُعرف بالأدب المهجريّ، خصوصاً مع تأسيس «الرابطة القلميّة» (خليل جبران وأمين الريحاني…) في الولايات المتّحدة عام 1922.
والأمر لم يقتصر على الحرّيّات التي وفّرتها تلك الحقبة وأتاحت النقاش العامّ. فإلى ذلك أُنشئت حينذاك البنية التحتيّة للثقافة الحديثة. فإلى جانب الجامعتين الأميركيّة واليسوعيّة في بيروت، ومعهما جامعة الحكمة، أواخر القرن التاسع عشر، تأسّست جامعة القاهرة في 1908، وكلّيّة الحقوق في بغداد، ثمّ جامعة دمشق في 1923. هكذا، وعبر دور التعليم في الجامعة، وفي المدرسة، حضن الزمن الكولونياليّ حَراكاً وسّعَ النطاق الطبقيّ للتعليم والمتعلّمين. فالتحديث، ناهيك عن الحداثة، ممّا أقلع في النصف الأوّل من القرن العشرين، إنّما تطلّب مثقّفين يُنشئون المفاهيم ويَسبغون الشرعيّات كما يواكبون تعبئة المجتمع وتغيير أوجهٍ من حياته. وحتّى السياسة نفسها بدت بحاجة لمن يُعبّد طريقها في مجتمع تقليديّ ووسط مفاهيم تقليديّة، ما يفسّر تأسيس المثقّفين للأحزاب وتوزيرهم على نحو ملحوظ.
وقبل الحقبة التي نحن بصددها، لكنْ في ما قبل تاريخها، أُقيم المتحف المصريّ في القاهرة في وقت يرقى إلى 1835. ولم يكن هذا التعرّف المبكر إلى المتحف إلاّ من نتائج حملة نابليون واكتشاف حجر رشيد، وبالتالي انبعاث الاهتمام الفرنسيّ المبكر بالحضارة الفرعونيّة. كذلك لم يكن هذا النشاط وتوسّعه اللاحق بعيدين عن جهود علماء مصريّاتٍ فرنسيّين كأوغست مارييت ثمّ غاستون ماسبيرو. وفي 1926 أسّست غيرترود بِلّ، الموظّفة الكولونياليّة البريطانيّة التي كانت أيضاً كاتبة ورحّالة وعالمة آثار، المتحف العراقيّ في بغداد.
وُأنشئت دار الكتب المصريّة في 1870 استجابةً لاقتراح قدّمه علي مبارك للخديوي اسماعيل بحيث تحاكي الدارُ الموعودة المكتبةَ الوطنيّة في باريس.
وفي العراق، وأيضاً بمعونة بِلّ، أنشأت البريطانيّة مورييل جيسّي فوربس المكتبة والأرشيف العامّين عام 1920، وبعد عام أُنشئت المكتبة الوطنيّة اللبنانيّة. ومن أنشطة كهذه، تطوّرت أعمال التوثيق والحفظ والأرشفة التي جعلت ما بِتنا نسمّيه تراثاً؛ تراثاً.
وتولّى مهاجرون، أغلبيّتهم الساحقة من مسيحيّي لبنان، إطلاق حياة صحافيّة في مصر، فكانت جريدة الأهرام ومجلّة المقتطف في 1876 وجريدة المقطّم في 1888، قبل أن تظهر مجلّة روز اليوسف في 1925. وفي لبنان كانت قد نشأت صحف أبكر إنّما أقلّ شأناً، كـ مرآة الأحوال في 1855 وحديقة الأخبار في 1858 ونفير سوريّا في 1860. أمّا في العراق الذي تأخّر احتكاكه المباشر بالغرب، فلعب دورَ التحفيز الوالي مدحت باشا، الموصوف بالإصلاحيّة والتأثّر بالغرب، مؤسِّساً، عام 1869، صحيفة الزوراء التي عُدّت أولى الصحف العراقيّة. وظهرت صحف كثيرة من هذا القبيل لم يكن مدحت بعيداً منها. لكنّ الجرائد والمجلاّت الحديثة، في بغداد ثمّ في البصرة والموصل، شرعت تتكاثر بعد الاحتلال البريطانيّ عام 1920.
إلا أنّ حقول الثقافة الحديثة وأجناسها، وهذا تحصيل حاصل، لم تُعرف أيضاً قبل الحقبة التي نتناولها.
فالرواية العربيّة الأولى، أكانت زينب لمحمّد حسين هيكل أم حُسن العواقب لزينب فوّاز، ما كانت لترى النور لولا الرواية الأوروبيّة المسلّم بأنّها من أبرز وأهمّ منتجات الحداثة الأوروبيّة.
وسريعاً جدّاً في المحاكاة، أي بُعيد العرض الأوّل لفيلم صامت للأخوين لوميير، في باريس عام 1895، بدأت تقام عروض سينمائيّة تجاريّة متفرّقة في القاهرة والإسكندريّة. وفي 1923 أنشأ محمّد البيّومي، بعد زيارات لأوروبا، ستوديو عمّون، كما أخرج فيلماً يصوّر الاستقبال الشعبيّ لسعد زغلول بعد عودته من المنفى. وبمساعدة طلعت حرب، مؤسّس بنك مصر، أنشأ البيّومي استوديو مصر الشهير. وكان مارون النقّاش، العائد من إيطاليا، مَن حمل معه إلى بيروت الفنّ المسرحيّ، عارضاً فيها ترجمته لـ«بخيل» موليير عام 1848، ثمّ في 1871 فعل أبو خليل القبّاني الشيء نفسه في دمشق. وهو لئن ظلّت موضوعاته أكثر انشداداً إلى التراث الإسلاميّ، فهذا لم يَحُل دون اقتباسه عن كورناي.

وفي مصر اتّصل تحديث الموسيقى بسيّد درويش، الذي ربط تقاليد الغناء الشعبيّ بتراكيب حديثة وإيقاعات حيويّة بعيداً من الزخرفة والقوالب الشكليّة. ومن غير أن يُنقص ذلك من كونه «فنّان الشعب»، أدخل درويش في 1920 الغناء البوليفونيّ، حيث تتعدّد النغمات في لحظة واحدة، كما في أوبريت العشرة الطيّبة التي تمجّد الفلاّح المصريّ.
ولم تتطوّر المحاولة الدرويشيّة في معزل عن مناخ فنّيّ مصريّ افتتحه عزف فيردي أوبرا ريغوليتّووذلك على عكس الاعتقاد الشائع بأنّ فيردي لعب «عايدة»، وهو ما حصل فعلاً في القاهرة إنّما بعد سنتين. احتفالاً بافتتاح قناة السويس في 1869، أو إنشاء بيت الأوبرا عامذاك بأمر من الخديوي اسماعيل.
وفي الإسكندريّة، في 1904، بدأ تاريخ الفنّ التشكيليّ الحديث في مصر، وتالياً في العالم العربيّ، حين استقبلت بلديّة المدينة لوحات مُقتنٍ ألمانيّ وعرضتها. وبعد أربع سنوات أنشأ الأمير يوسف كمال أوّل مدرسة للفنون الجميلة كان مدرّسوها أوروبيّين وخرّجت، ممّن خرّجت، النحّات البارز محمود مختار.

واستمرّت الوجهة هذه في تجارب معظم الفنّانين اللاحقين الذين برزوا في القرن العشرين، كجواد سليم، العراقيّ الذي درس في باريس وروما ولندن، وجورج حنين، المصريّ الذي درس في روما وباريس، واللبنانيّين الثلاثة مصطفى فرّوخ وعمر الأنسي وقيصر الجميّل الذين درسوا هم أيضاً في باريس. وقد تتلمذ أكثر أبناء ذاك الجيل على خليل الصليبي، الذي تعرّف إلى الفنّ التشكيليّ في مدارس تبشيريّة وفي الجامعة الأميركيّة ببيروت قبل انتقاله إلى أدنبره وفيلادلفيا.
وأهمّ من هذه الوفادات والتأثّرات كان ما صنعته الأجناس الأدبيّة والفنّيّة الجديدة في نظرة الناظر العربيّ إلى الحياة والآخر والعلاقات الاجتماعيّة و/أو الإنسانيّة، وإلى ذاته نفسها، وفي ما أدخلته إليه من طرائق في الكلام والتعبير، ومن معرفة بعوالم واحتمالات كانت مجهولة تماماً.
فقد راح يتشكّل من هذا كلّه ما يمكن وصفه بـ«الثقافة» بالمعنى الأنثروبولوجيّ الأعرض الذي يتعدّى المثقّفين ويمتدّ اشتغاله من التعامل مع الزوجة والأبناء إلى صورة عن الحبّ والعلاقات العاطفيّة نقلتها إلينا السينما، وهذا فضلاً عن الصلة بالوقت، أو السكن في بيوت حديثة، أو التخطيط المدينيّ وإنشاء مجالس بلديّة منتخبة، أو تدريس الصغار في غرف مؤطّرة في المدرسة…
الكيفيّة الثقافيّة الخاصّة…
لا يلغي وصف العلاقة بين ثقافتنا الحديثة والغرب بالأبوّة الكاملة وجود تناقضات بينهما. والحداثة، في النهاية، تكفّ عن كونها حداثة إن عطّلت مفهوم الصراع أو استبعدته.
والراهن أنّ عدم اكتراث بعض المثقّفين من ذوي الهوى الغربيّ الفائض بذاك الصراع، وإسباغهم الطاعة والتقليد على الأبوّة كان ضارّاً، فآل إلى نتائج تبسيطيّة ساهمت في الهرب من تعقيدات مجتمعاتنا والحيلولة دون تطوير طرق ذاتيّة إلى التقدّم والحرّيّة. ينطبق ذلك على أعمال تركها لطفي السيّد وآخرون من مجايليه تترجّح بين الكتابة والترجمة، أو على مستقبل الثقافة في مصر الذي كتبه طه حسين بعد عامين على التفاؤل الذي أشاعتهُ معاهدة 1936 البريطانيّة المصريّة، وحينما كانت النزعات العلمويّة والجغرافيّة لا تزال راسخة الحضور في شقّ من الثقافة الغربيّة.
لكنْ يبقى أنّ التناقضات الصحّيّة بين المثقّفين الحديثين و«الغرب» لا تصدر، في مطلق الحالات، عن الحيّز المهنيّ، كما الحال مع السياسيّين والاقتصاديّين. فهي، في المقابل، تصدر عن أنّ الثقافة، في تأويل إنسانيّ وتقدّميّ لها، تحضّ على رفض الظلم والاستعمار والعنصريّة. وهي، أقلّه وفق هذا التأويل، تُملي التضامن مع شعب مقهور يخوض صراعاً ضدّها، سيّما حين تربط المثقّفين بهذا الشعب وشائج قرابةٍ من نوع أو آخر. وهذا فضلاً عن كون المثقّفين أنفسهم مواطنين، أي سياسيّين معنيّين كغيرهم بالشأن العامّ، وأكثر منهم تفكيراً في ذلك وإفصاحاً عنه.
وهذه الخصوصيّات مجتمعةً إنّما تنجب كيفيّة خاصّة بالثقافة في صراعها مع الغرب بوصفه استعماراً، وفي كلّ تدخّل آخر قد تمارسه في الشأن العامّ. فالثقافة تنطوي بالتالي على احتمال تثقيف الانحياز ضدّ الاستعمار أو تثقيف الخدمات التي تُسدَى لمصالح الشعوب ولرغباتها.
هكذا يحتلّ، ما بين البنوّة المهنيّة للغرب والارتباط القيميّ والسياسيّ والأهليّ (أو الوطنيّ)، موقعاً يكاد يتفرّد به، تُمارَس فيه تلك الكيفيّة التي تجلو تمايزه. أمّا تكريس موقع كهذا وتوسُّعه، فهو وحده ما يفتح الباب لوجود تاريخ ثقافيّ عصيّ على الذوبان في التاريخ السياسيّ.
وبشكلٍ ما عبّر مثقّف الحقبة التي نتناولها عن قدر معقول من الموازنة بين «طبيعتيه» هاتين. ففي العهدين الكولونياليّ و«الرجعيّ»، يصعب الكلام عن قطيعة في سِيَر المثقّفين الحداثيّين بين شطر تقليديّ من الثقافة وشطر حديث، أي أنّهم، والحال هذه، لم يكونوا «تغريبيّين» و«متغرّبين» و«مُهجّنين» على ما زعمت اتّهامات لاحقة، ولا هم طلّقوا الخلفيّة الثقافيّة التي صدروا عنها أو «هموم الشعب» وتطلّعاته.
نجد هذا ابتداءً بالجدّ الأعلى لتلك الحقبة، أي رفاعة رافع الطهطاوي، رجل الدين المتفرّع عن أسرة دينيّة، والذي أمَّ أفرادَ بعثة محمّد علي إلى فرنسا مطالع القرن التاسع عشر.
فأحمد لطفي السيّد مثلاً كان ممّن تتلمذوا على محمّد عبده كما لازم جمال الدين الأفغاني في اسطنبول، وبعده درس طه حسين وأحمد أمين في الأزهر، ثمّ انتقل أوّلهما إلى الجامعة المصريّة حيث كتب أطروحته عن أبي العلاء المعرّي، قبل ابتعاثه إلى فرنسا حيث كانت أطروحته عن ابن خلدون.
أمّا علي الوردي، في العراق، فكان عطّاراً في صغره، ولم يغيّر زيّه التقليديّ حتّى 1932، فيما درس جواد علي في كليّة أبي حنيفة في بغداد، وحفظ عبد العزيز الدوري القرآن قبل انتقاله من الريف إلى بغداد.

فإذا عدنا إلى كتاب رئيف خوري الفكر العربيّ الحديث: أثر الثورة الفرنسيّة في توجيهه السياسيّ والاجتماعيّ، وقعنا على معطيات ومعانٍ بعضها مدهش حقّاً. فقد كان أيّوب ثابت، أحد رؤساء جمهوريّة لبنان في عهد الانتداب الفرنسيّ، مَن ترجم «إعلان حقوق الإنسان» إلى العربيّة، عاونه في ذلك أوّل رؤساء تلك الجمهوريّة شارل دبّاس. وعلى نطاق عربيّ أعرض، وعلى جاري تقليدٍ ساد بين مثقّفي ذاك الزمن، اعتُبر «الفتح» النابوليونيّ لمصر في 1798 «أوّل مجاري الثورة الفرنسيّة إلى الشرق العربيّ»، إذ حمل «بذرةً، وإن تكن طفيفة، من تمرين الأمّة [المصريّة] على الإدارة الذاتيّة»، كما «هزّ (…) جوّ الجمود الذي كان مخيّماً على مصر»، وفي عداد ذلك تعريب القوانين الفرنسيّة الموضوعة في العهد النابليونيّ.
وبعد أن يتحدّث خوري، ككثيرين سواه، عن تأثّر الطهطاوي «أعمقَ التأثّر بما رآه في نظام فرنسا من نتائج ثورتها الكبرى»، يشير إلى الاستقبال الإيجابيّ للثورة الفرنسيّة عند الأفغاني وفرنسيس مرّاش الحلبي وأديب اسحق وعبد الله النديم وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي الشميّل وفرح أنطون ومصطفى كامل ووليّ الدين يكن وأمين الريحاني وجبران خليل جبران وروحي الخالدي وجرجي زيدان وطه حسين ومحمّد حسين هيكل وعبد الرحمن الرافعي ومحمّد كرد علي وسلامة موسى…، وهم عموماً، إن لم يكن إجماعيّاً، مناهضون للاستعمار، دون أن يمنعهم هذا من الإعجاب بأفكار فكّرتها دول الاستعمار أو بأفعال فعلتها. لا بل نلاحظ ما قد يكون فصلاً تامّاً بين الموقف من الثورة الفرنسيّة (حيث الإشارات إلى الاحتلالات وما يتّصل بها قليلة جدّاً) وبين الاستعمار الذي لم تخفّف إدانتُه مباركة الثورة. أمّا الكثير من المآخذ التي أخذها مثقّفون، كميّ زيادة أو فيليكس فارس، على تلك الثورة فاتّصلت بالقضايا التي أثارتها، كتساؤلهم حول إمكان تحقيق المساواة، أو نبعت من تأثّراتهم النيتشويّة، بمعنى أنّ جزءاً كبيراً من النقاش مع التحوّل الفرنسيّ الكبير كان داخليّاً محضاً، من داخل تجربته ومسائلها، ما لا صلة له من قريب أو بعيد بمسائل الاحتلال والاستعمار.رئيف خوري، الفكر العربيّ الحديث: أثر الثورة الفرنسيّة في توجيهه السياسيّ والاجتماعيّ، مؤسّسة هنداوي، 2017 (صدر أصلاً في 1943)، خصوصاً الصفحات 13 و65 و66-67 و74 و89-97 و128-131.
وحين يحتفل محمّد البيّومي في فيلمه المبكر بوطنيّة سعد زغلول، أو يمجّد سيّد درويش في موسيقاه حياة الفلاّح المصريّ، أو يستخدم طه حسين ثقافته الغربيّة لتوسيع تعليم المصريّين وجعله مجّانيّاً، فهذا ما يجعل تهمة التغريب والتفرنُج هواءً ساخناً لا أكثر.
فالمثقّف العربيّ، في الحقبة التي نحن بصددها، أحرز إذاً بعض مفاتيح الكيفيّة الخاصّة بالتدخّل الثقافيّ في السياسة والصراع السياسيّ. وهو فعل ذلك بقدر لا يَخفى من البساطة والأوّليّة، بل البراءة التي تتاخم السذاجة أحياناً، لكنْ يبقى من الجائز أن نفترض أنّه لو أُتيح تطوير تلك الكيفيّة التركيبيّة لاستطاع حاملوها الإسهام في تصويب المواجهة السياسيّة مع الاستعمار أو الغرب.
وفكرة الموقع الوسيط للمثقّف (وهي في حالتنا وساطة بين القيم الثقافيّة و«المهنيّة» الغربيّة والقيم والاعتبارات النضاليّة) سبق أن استوقفت، وإن في سياقات مغايرة، سوسيولوجيّين ربّما كان أهمّهم الهنغاريّ البريطانيّ كارل مانهايم.
فعنده يتمتّع المثقّفون بموقع استثنائيّ وبـ«خصوصيّة في النظام الاجتماعيّ» إذ هم وحدهم، بفعل التعليم والمعرفة، يستطيعون رؤية المجتمع بكلّيّته والتوصّل إلى تركيب «ديناميّ» ضروريّ بين إيديولوجيّاته الفاعلة. فالمثقّف، لأنّه لا يشارك في العمليّة الإنتاجيّة، فإنّه «لا طبقيٌّ نسبيّاً»، وبالتالي قادر على تمثّل منظورات طبقيّة عدّة، ما يجعله الأقدر على بلوغ «حقائق كونيّة».
لقد توقّف مانهايم عند دور التعليم الذي يقلّص فوارق أخرى، طبقيّة وغير طبقيّة، بين المثقّفين. وهذا دون أن يلغي، بطبيعة الحال، الفوارق وتعدّد آراء المثقّفين إيّاهم واختلافاتهم، يخلق «وسطاً متجانساً تستطيع الأطراف المتنازعة أن تقيس قوّتها من داخله». فالتخلّص من أَسْر النظرة الواحدة، والفرصة المتاحة للاطّلاع على عالم «يحتوي كلّ وجهات النظر المتناقضة» إنّما يوفّران للمثقّف «مساحة أعرض للخيار». وهكذا فالمثقّفون، بوصفهم الأقدر على ممارسة «الطيران الحرّ» فوق الانحيازات، هم أكثر الفئات الاجتماعيّة إقبالاً على الانحياز إلى من قد يختلفون عنهم طبقيّاً ومصلحيّاً، وهم إذا اندرجوا في العمل السياسيّ والحزبيّ أضافوا إليه «اكتشاف الموقع الذي يغدو ممكناً معه نشوء منظور كامل».KARL MANNHEIM, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, 1954, pp. 138-144.
في انتظار لينين
لم يكن المثقّفون العرب في الحقبة التي تناولناها على رداءة زملائهم اللاحقين. لقد كانوا أشدّ إنصافاً وتركيباً في نظرهم إلى أنفسهم وإلى العالم، وكانوا، بتأسيسهم الأحزاب والمؤسّسات وتوزيرهم في الحكومات، أفعلَ بلا قياس وأشدّ تأثيراً.
على أنّ الوجهة التي غلبت ما بين نشأة الإخوان المسلمين (1928) وانقلاب جمال عبد الناصر (1952)، وكانت هزيمة فلسطين (1948) قد حلّت بينهما، إنّما أَنهضت قراءةً أخرى للتاريخ، ولوظيفة المثقّفين تالياً، استُبعدت بنتيجتها الكيفيّة المركّبة، ليحلّ محلّها التحاقٌ شبه كلّيّ بالسرديّات السياسيّة والشعبويّة وميلٌ إلى عسكرة الثقافة أوقعَ المثقّفين في حبائل رواية الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة، حتّى بات جائزاً الكلامُ عن انتحار ذاتيّ للمثقّف والثقافيّ على مذبح السياسة والسياسيّ.
وأغلب الظنّ أنّ الممانعة الأهليّة والدينيّة القديمة للحداثة وجدت في الفكر الغربيّ المناهض للغرب، والذي أعلن موته على نحو أو آخر، ما يغذّي رفضها اشتغالَ الكيفيّة المركّبة. فقد استُخدم لهذا الغرض كلٌّ من شبنغلر ونيتشه وهايدغر، على اختلافهم واختلاف القراءات العربيّة لهم، فاعتُبروا المبرّر الثقافيّ، إن لم يكن الروحيّ، لتطليق «الثقافة الغربيّة» والذوبان في السياسات «الوطنيّة». وهذا ما عزّز استعدادات قائمة لدى مثقّفينا لافتراض أنّ الكثير من الجوهريّ والماهويّ إنّما يقيم وراء الواقع الظاهر الموسوم بتفوّقٍ للغرب لا يعدو كونه ظاهراً عابراً.
لقد ترك نيتشه وهايدغر، ثمّ سارتر، بعض التأثير في الخمسينيّات والستينيّات، ولم ينفصل ذلك، سيّما في البيئات القوميّة، عن السعي وراء صيغ فكريّة تتمايز عن الشيوعيّة، فضلاً عن إبداء رفضها للغرب. لكنّ هذا التأثير تراجع مع مصالحة الشيوعيّة السوفياتيّة والناصريّة، قبل أن تباشر الحركة القوميّة العربيّة ذبولها الإيديولوجيّ.
ولربّما غدت اللينينيّة، من بين أشكال ذاك الفكر الغربيّ المناهض للغرب، أكثرها تسهيلاً للمشكلة الفكريّة وتحايُلاً على تعقيدها: فاللينينيّة ليست فحسب مادّة ثقافيّة، بل أيضاً دعوة طليعيّة لتغيير يجبّ ما قبله، دعوةٌ حوّلتها ثورة 1917 الروسيّة إلى واقع فاعل على نطاق عالميّ،قد لا يكون عديم الدلالة على بعض خيارات المثقّفين أنّ «الحزب الاشتراكيّ المصريّ»، الديمقراطيّ التوجّه، الذي أسّسه سلامة موسى ومثقّفون آخرون في 1921 تحوّل، بعد عامين فحسب، إلى «الحزب الشيوعيّ المصريّ». ثمّ كرّسها وجود الاتّحاد السوفياتيّ، خصوصاً بعد قيام «المعسكر الاشتراكيّ» ونشوب الحرب الباردة.
وعلى اختلاف تأويلاتها انطوت الماركسيّة اللينينيّة على بذور نزعةٍ تستصغر الجهد الثقافيّ حتّى في لحظات الإقرار بأهميّته والدعوة إلى ممارسته والاحتفاء برموزه.هذا لا يلغي حالة كثيرين ممّن انتسبوا إلى الماركسيّة وانجذبوا إلى إغراءٍ ثقافيّ ما ميّزهم عن المثقّف القوميّ، وطبعاً عن المثقّف الدينيّ. فهنا تراءى أنّ ثمّة فضاء للعمل الثقافيّ الحرّ نسبيّاً، وهامش تعارض واسعاً مع المعطى السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ الموروث والتقليديّ، وصلة مفتوحة بتيّارات الثقافة العالميّة أو بعضها ‘التقدّميّ’ على الأقلّ. لكنْ هنا تحديداً تتبدّى حالات من التوتّر بين السياسيّ الذي انشدّوا إليه والثقافيّ الذي آثروا أن لا يطلّقوه بالكامل. وقد تضاعف هذا التوتّر خصوصاً بعد الانقلاب العسكريّ وتوطّد سلطته ثم مع صعود الإسلام السياسيّ. فالتمزّق بين السياسيّ والثقافيّ بقي أوضح ما يكون في حالة مبدعين «تقدّميّين» عرب انضمّوا إلى التحرّر الوطنيّ بشروط قواه السياسيّة، وما لبثوا أن أحسّوا بالكلفة التي ينبغي دفعها. معظم هؤلاء تغيّروا وطوّعوا الثقافيّ تطويعاً كاملاً للسياسيّ، خصوصاً مع تعاظم ذاك الالتحام (غالباً نزولاً عند رغبة موسكو) بين الأحزاب الشيوعيّة والمعطى الموروث والتقليديّ ونظامه القوميّ أو الدينيّ. أمّا الذين رفضوا الانتحار كمثقّفين فتعرّضوا ويتعرّضون لنقد مَن هم أكثر انخراطاً في السياسات النضاليّة. من هذا القبيل، كتب أحدهم في جريدة الأخبار اللبنانيّة عن «مخانيث اليسار»، أي عمّن «يقع في منزلة بين المنزلتين»، فلا يُعدّ في الذكور ولا في الإناث، بل في برزخ ما بين الجنسين». ذاك أنّ هؤلاء لم يقطعوا كلّيّاً مع «اليسار الأوروبيّ» ومع «خطاب المحافظة على البيئة» و«الدولة المدنيّة» و«العلمنة الشاملة» إلخ… رضا الشيخ خليل، «مخانيث اليسار»، في: جريدة الأخبار، 28 تمّوز 2022.
فالوعد الطوباويّ الأخير إنّما هو إنهاء التمايُز بين اليدويّ والذهنيّ الذي لم ينجم إلاّ عن تقسيم عمل طبقيّ مديد. أمّا افتراض أنّ أصحاب العمل الذهنيّ يحظون بمواقع مميّزة في المجتمع تبعاً لعملهم هذا، فمّما ينبغي أن يزول بما فيه تعاليهم المفترض على أصحاب العمل اليدويّ. فهم وتعليمهم نِتاج فائض القيمة الاجتماعيّ، أي النهب المعمّم والمتراكم، وما الهدف من التعليم الذي يجعلهم متعلّمين، ومن ثمّ مثقّفين، سوى إعادة إنتاجهم ككوادر تدير عمليّة النهب، فضلاً عن توسّلهم لإعادة إنتاج الأفكار والقيم التي يلدها النهب ويستدعيها. ولأنّ المثقّفين لا يحتلّون موقعاً ناجزاً من الإنتاج فهذا مصدر للحذر منهم والحيرة حيالهم، وبالتالي الرغبة في تطويعهم، اجتماعيّاً وسياسيّاً، بوصفهم «آخرين». ولسوف نرى لاحقاً كيف أنّ مبدأ «الثورة الثقافيّة» الذي افتتحت الصين الماويّة العمل به، في الستينيّات، كان التطبيق الأشدّ جلافةً وحَرْفيّة لتلك الأفكار المشار إليها.
لقد كان تدبير العلاقة بالمثقّفين من شواغل كارل كاوتسكي حين كان لا يزال «بابا الماركسيّة»، وبات لاحقاً من شواغل لينين. ذاك أنّ تحديد العلاقة بين المثقّف والطبقة العاملة والحزب هو ممّا لا يستغني عنه العمل النضاليّ، ولكي يكون المثقّف مقبولاً، بروليتاريّ الانحياز وطليعيّاً، فإنّ عليه نزع بعض ذاته الاجتماعيّة والثقافيّة التي صدر عنها والانضواء في حزب البروليتاريا ومصالحها.
لقد دافع كاوتسكي عن «احتراف» المثقّف الاشتراكيّ لأنّه هو ناقل الوعي إلى العمّال بامتلاكه الفكر النظريّ الذي يرفع سويّة ذاك الوعي. هكذا كتب منذ 1895 أنّ الاعتماد على «الغرائز الطبقيّة وحدها» يقود العمّال إلى الضلال، فيما مهمّة المثقّفين، «الذين يستخدمون القلم»، تزويد الحركة بـ«الوضوح ووعي الأهداف».Stanley Pierson, Marxist Intellectuals and the Working-Class Mentality in Germany, 1887-1912, Harvard, 1993, P. 61.
وفي كتابه ما العمل؟، استكمل لينين نظريّة استخدام الثقافيّ لخدمة السياسيّ، حيث ينكمش الأوّل إلى الحدّ الأدنى ويغدو مجرّد أداة، بينما يُطلَق الثاني «الاحترافيّ» إلى الحدّ الأقصى ليغدو وحده الغاية.
فالكتاب العائد إلى مطالع القرن العشرين، ساجَل ضدّ النزعة الاقتصاديّة (economism) التي تعطي الأولويّة للنضال المطلبيّ على سواه من أشكال النضال، وقد تفضي بها العفويّة إلى الإرهاب. ولئن دافع لينين عن فكرة الطليعة الحزبيّة والاحتراف الثوريّ، حيث للمثقّفين دور رائد، فإنّه من الأسطر الأولى يصفّي حسابه مع «حرّيّة النقد» التي يعتبرها حصان طروادة الذي تتسلّل عبره الليبرالية لتُضعف الحركة العمّاليّة وتسمّمها. فإذا كان «ما من حركة ثوريّة بلا نظريّة ثوريّة»، فحاملو النظريّة هذه ينبغي أن يكونوا مُطهّرين من كلّ انتقائيّة (eclecticism) تَطهُّرهم من «حرّيّة النقد» لأنّه لا وجود لإيديولوجيا ثالثة إلى جانب الإيديولوجيّتين البورجوازيّة والاشتراكيّة.
فالمثقّف، إذاً، بصيرورته ثوريّاً محترفاً، يغدو كائناً آحاديّاً وضيّقاً، كباشا أنتيبوف في رواية بوريس باسترناك دكتور جيفاغو، مُنكبّاً على فعل تنظيميّ وسياسيّ تآمريّ بالضرورة ونافياً لكلّ ما هو شخصيّ وخاصّ.
هكذا انطوى ما العمل؟، الذي تحوّل إلى أحد أناجيل الشيوعيّة والشيوعيّين، على إهانتين، واحدة تستهدف العمّال الذين تتولّى قيادة حزبيّة وثقافيّة توعيتهم بمصالحهم وتنظيمهم لبلوغها (وكان 11 من أصل 15 مفوّضاً في حكومة لينين الأولى مثقّفين)، وإهانة تستهدف الثقافة والمثقفّين بتلخيصهم إلى منفّذي مهامّ سياسيّة ملزمة لا تقبل النقاش، كثيرٌ منها قد ينحطّ إلى تكتيكات يوميّة.
أمّا الذين يبرّئون اللينينيّة من جرائم ستالين بحقّ المثقّفين، كما بحقّ سواهم، فيفوتهم ما أشرف عليه لينين في 1922، قبل عامين على رحيله، حيث انطلقت حملة القضاء على المثقّف العامّ في روسيا. فقد طُرد إلى الخارج، على متن ما بات يُعرف بـ«سفينتي الفلاسفة»، ما بين سبعين ومئتين من ألمع المثقّفين، إذ اعتُبروا «عبيداً إيديولوجيّين للبورجوازيّة». وإذ سمّاهم لينين «جواسيس عسكريّين»، فقد ترك لنا تروتسكي إحدى عباراته الذائعة بقوله: «طردنا هؤلاء الناس لأنّه لم تتوفّر ذريعة لقتلهم بالرصاص، كما لم تكن هناك إمكانيّة تسامُح معهم». وفي عداد المطرودين كان بيتيريم سوروكين الذي يُعدّ من مؤسّسي علم الاجتماع، والفيلسوف نيكولاي برديائيف، وفلاسفة وعلماء اغتنت بأبحاثهم الدول التي انتقلوا إليها.تميل أعمال التأريخ اليساريّ إلى التكتّم عن هذا الحدث، أو تخفيف حجمه. راجع كمجرّد مثل غير حصريّ عنه: STUART FINKEL, On the Ideological Front: THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA AND THE MAKING OF THE SOVIET PUBLIC SPHERE, Yale and New Haven, 2007, pp. 7-10.
ومن موقع آخر، عالمثالثيّ، اكتسب كتاب فرانز فانون معذّبو الأرض (1961) (الذي وضع مقدّمته سارتر) شهرة واسعة امتدّت على الستينيّات والسبعينيّات، وفي عداده الحربُ التي شنّها الكتاب على النُخب الوسيطة. ففانون أدان ما سمّاه النُخب المثقّفة في المستعمرات، والتي تسعى وراء المراكز والمواقع كما وراء قبول جلّادها بها ورضائه عنها. وهو أهابَ بالمثقّف الطليعيّ أن يحارب مع شعبه بدل الانصراف إلى تقديم إنتاج أدبيّ وثقافيّ وعلميّ هو من فضلات الاستعمار وثقافته. وقبل سنوات على الشعارات الماويّة عن «التعلّم من الشعب»، و«من الفلاّحين»، قلب فانون معادلة المعرفة والتعريف، حيث لا يملك المثقّف المقيم في المدينة، والذي خرّبته البورجوازيّة الكولونياليّة، ما يعطيه. وضدّاً على السرديّة الكاوتسكيّة اللينينيّة، حيث ينتقل الوعي من المثقّفين إلى البروليتاريا، ينتقل الوعي هنا في وجهة معاكسة، إذ «تبرهن التجربة أنّ الجماهير تفهم تماماً المشاكل الأكثر تعقيداً. ولسوف يكون أحد أعظم الخدمات التي تقدّمها الثورة الجزائريّة لمثقّفي الجزائر أن تتيح لهم رؤية الفقر الأقصى الذي لا يوصف لدى الشعب، فيما هي تتيح لهم أن يشاهدوا صحوة ذكاء الشعب وتطوّر وعيه إلى الأمام».Frantz Fanon, THE WRETCHED OF THE EARTH (Preface by JEAN-PAUL SARTRE), Grove Press, 1963, p. 188.
«المثقّف العضويّ» بالمرصاد
لقد راحت نظريّات الفيلسوف الشيوعيّ الإيطاليّ أنطونيو غرامشي تكسب مساحات عربيّة أوسع منذ السبعينيّات، فيما جعل مثقّفون ماركسيّون و«ما بعد» ماركسيّين يدافعون عنها بوصفها تسدّ فراغاً في الماركسيّة وفي اللينينيّة على السواء، إذ تولي دوراً أكبر للأفكار وللثقافة.
وتبقى نظريّة غرامشي في «المثقّف العضويّ»، وهي ما يعنينا هنا،عن مفهوم «المثقّف العضويّ» يُنظر خصوصاً:QUINTIN HOARE and GEOFFREY NOWELL SMITH (ed.), SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS OF ANTONIO GRAMSCI, INTERNATIONAL PUBLISHERS – New York, 11th ed., 1992. pp. 5-14 & 102-104. جزءاً من نظريّته في «الهيمنة» بوصفها وظيفة سياسيّة إيديولوجيّة في «السيطرة على القلوب والعقول»، يُفترض بالأدوار الثقافيّة، مهما علا شأنها، أن تخدمها.
ومثل هذه الهندسة الاجتماعيّة هي التي حاول الحزب الشيوعيّ الإيطاليّ تطبيقها منذ 1945، ابتداءً بتأثيره في الحياة الثقافيّة على نحو يُكسبه المثقّفين والفنّانين والمعلّمين والعاملين في الإعلام ودور النشر إلخ… وبالفعل حقّق الحزب المذكور نجاحات باهرة على هذا الصعيد إلى أن انهار هو نفسه بنتيجة ضربات في الاقتصاد والسياسة والثقافة كان من الصعب على أيّة «هيمنة» أن تضبطها، ناهيك عن أن تتفاداها.راجع: حازم صاغيّة، «انتحار» الحزب الشيوعيّ الإيطاليّ أم «انتحار» الحزب بإطلاق؟، في: موقع الجمهوريّة نت، 3/6/2022.
فغرامشي رفض أصلاً ثنائيّة الذهنيّ واليدويّ مجادلاً بأنّ هناك عنصراً ذهنيّاً في كلّ ما هو يدويّ، وأنّ بعض العمل اليدويّ أساسيّ في ما هو ذهنيّ. وهذا التصوّر الماحي للحدود، الذي أفقده زمننا الروبوتيّ والتخصّصيّ الراهن معظم جدواه، إنّما يراد له أن يعزّز افتراضاً شبه نضاليّ وشبه شعبويّ يُؤدلِج ويُضخِّم قدرة اليدويّ على إتيان الذهنيّ، وقابليّةَ الذهنيّ لممارسة ذاته في اليدويّ. فليس من وجود بالتالي لمن هم «غير مثقّفين» (non-intellectuals)، إذ «كلّ الناس مثقّفون» لأنّهم كلّهم ذوو رأي وتصوّر يتناولان حياتهم، وإن لم يكونوا كلّهم أصحاب وظيفة ثقافيّة أو يعملون كمثقّفين.
لكنّ تقليم أظافر الثقافة والمثقّف ليس العلاج الملائم لفرضيّات ومزاعم هاجمها غرامشي، ويدينها أيّ مجتمع مساواتيّ حديث، عن جوهريّة الثقافة أو أصليّتها أو ترفّعها، وعن الانتفاخ والعجرفة الّلذين قد يصاب بهما بعض المثقّفين. والغرامشيّة، من ناحيتها، لا تفوّت فرصة لممارسة هذا التقليم، حيث الجميع مثقّفون،الاستثناء النسبيّ الوحيد هو الفلاّحون. فمع أنّ دور الفلاّحين أساسيّ في الإنتاج فإنّهم لا ينتجون مثقّفيهم العضويّين ولا يستوعبون المثقّفين التقليديّين. وقد يحدث أن تستمدّ طبقات اجتماعيّة أخرى مثقّفيها من الفلاّحين، وهذا يعني إمكان أن يكون المثقّف فلاّحاً، إلاّ أنّ ذلك لا يتحقّق ويُستكمل إلاّ في أحضان طبقة أخرى. QUINTIN HOARE and GEOFFREY NOWELL SMITH (ed.), SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS…, pp. 6-7. فيما المثقّف لم يصبح ما أصبحه إلاّ بنتيجة كدح الكادحين.
وفي ما خصّ «المثقّف العضويّ»، فإنّه ذاك الذي تفرزه الطبقة الاجتماعيّة الثوريّة بوصفه من يصيغ، بأكثر الأشكال معرفة ورهافة، رؤية للعالم تنسجم مع منظورها الطبقيّ. ذاك أنّ كلّ طبقة تطرح مثقّفين أنجبتهم يبلورون، بالشعر والأدب والغناء والأفكار إلخ…، المشاعر والآراء والحاجات والرغبات المنجرّة عن تلك الطبقة.
وإذ يحضر لدى غرامشي تمييز حادّ بين المثقّفين «التقليديّين» والمثقّفين «العضويّين»، فعلّة التمييز أنّ الأوّلين، القدامى، يتخيّلون أنفسهم مجموعةً اجتماعيّة أرفع وأكثر استقلالاً وذات حضور يضعها فوق التاريخ، ويفصلها عن الصراع الطبقيّ ومجاريه. وهم، كهنةً ومعلّمين وموظّفين قدامى وريفيّين، تكراريّون يمضون في أداء العمل نفسه جيلاً بعد جيل. بيد أنّ هؤلاء «التقليديّين» مرتبطون ارتباطاً قويّاً بالإيديولوجيا السائدة والطبقة الحاكمة، فيما «العضويّون» هم الجدد الآتون من طبقات كادحة تفرزهم، أو المنحازون إليها.
فالمثقّفون العضويّون بالتالي متجذّرون بقوّة في جماعتهم، يهتمّون بأمر السكّان المحلّيّين وتجاربهم، وهم ذوو دور اجتماعيّ مهمّ لأنّ الوضع القائم على خريطة العلاقات بين الطبقات يعتمد عليهم وعلى نشاطهم. فهم سيكونون الحزب السياسيّ الذي يسعى إلى الهيمنة، ويربّي مثقّفين يُقنعون الناس بالفلسفة القائدة التي عبْرها وحدها يمكن إحلال الهيمنة تلك.
فالمثقّفون، عند غرامشي، وفق صياغة شانتال موف، هم «أولئك المعنيّون بتوسيع ونشر الإيديولوجيّات العضويّة»، والمنوط بهم «إدراك الإصلاح الأخلاقيّ والفكريّ».Chantal Mouffe, ‘Hegemony and ideology in Gramsci’, in: Chantal Mouffe (ed.), Gromsci and Marxist Theory, Routledge & Kegan Paul, 1979, P. 187. وعلى هؤلاء أن يكونوا قادرين على توجيه الآخرين وتنظيمهم، مُتنبّهين إلى مسؤوليّة مواقعهم ومهامّهم التنظيميّة والتواصليّة (connective) ومكرّسين لها النفوس والجهود. فـ«المثقّف الذي ينضمّ إلى الحزب السياسيّ لأيّة جماعة اجتماعيّة إنّما يندمج في المثقّفين العضويّين لهذه الجماعة نفسها، كما يُربَط بإحكام بهذه المجموعة».DAVID FORGACS (ed.), THE GRAMSCI READER: Selected Writings 1916-1935, NEW YORK UNIVERSITY PRESS, 2000, p. 310.تندرج في خانة الإلحاق الثقافيّ الملزم بالسياسة، وهي هنا السياسة الطبقيّة، حالة جورج لوكاتش، الفيلسوف والناقد الجماليّ والأدبيّ. فالشابّ الهيغليّ الذي كانه، المأخوذ بـ«الشكل»، والذي لم تحل ماركسيّته اللاحقة دون مطاردته طويلاً ب«تهمة» الهيغليّة، لم يكن، في النهاية، أكثر سخاء ورحابة حيال الثقافة من باقي رفاقه الماركسيّين. ففي عمله الشهير «التاريخ والوعي الطبقيّ» (1923)، والذي أثّر في المثقّفين اليساريّين العرب المشتغلين في الأدب والنقد الأدبيّ، تناول التعارض الصارم بين «الذات» و«الموضوع» تبعاً لـ«التشييء» (reification) الرأسماليّ، وكيفيّة جعل الواقع مُدرَكاً ذاتيّاً، ضدّاً على الفرضيّة الكانطيّة حول «الشيء بذاته» (noumenon)، والذي تستحيل معرفته إلاّ على نحو جزئيّ. لكنّ لوكاتش في حلّه هذا الإشكال رأى أن تكون للثقافة وظيفة أساسيّة هي المساهمة في تمكين الطبقة العاملة من وضع يدها على المحرّك الفعليّ للتاريخ. فالثقافة هي ما يساعد العمّال على أن يفهموا كيف حُوّلوا إلى مجرّد موضوع في نظام لا سيطرة لهم عليه. أمّا إسقاط هذا النظام فيرتّب عليهم اكتساب وعي طبقيّ هو ما يجعل الطبقة العاملة «بذاتها ولذاتها» معاً، فتكون هي نفسها موضوعاً لذاتها، تتأوّل نفسها كذات، وبالتالي تتجاوز كونها موضوعاً لرأس المال والرأسماليّين. هكذا تغدو وظيفة ناقد كلوكاتش اكتشاف أشكال التعبير الثقافيّ التي تساعد الطبقة العاملة على اكتساب وعي يستطيع أن يرى نفسه كموضوع ثمّ يحوّل ذاك الموضوع إلى ذات جديدة. فهو ممثّل أولئك الذين يمارسون وظائف الملحَقِين (أو التابعين أو الثانين=Subaltern)المفهوم الذي عمّمته ووسّعته لاحقاً أدبيّات «ما بعد الكولونياليّة» تدليلاً منها على السكّان الكولونياليّين الذين يُستبعَدون من مراتبيّات السلطة الإمبرياليّة ومن مواقع النفوذ المتروبوليّ للإمبرياليّة. في الهيمنة الاجتماعيّة والسلطة السياسيّة.
ولئن لم يكن هناك شكّ في وجود مثقّفين «عضويّين»، مهمومين بـ«الهيمنة» (التي غالباً ما تُسبغ عليها مواصفات المرونة، بل الرحابة الديمقراطيّة، إنّما قياساً بـ ‘السيطرة’ الجلفة!) أو معنيّين بأيّ مشروع سياسيّ وإيديولوجيّ آخر، بقي أنّ منظومة التفكير الغرامشيّة هذه سببٌ وجيه للقلق على الثقافة وعلى حرّيّاتها عند كلّ من يشاء من المثقّفين أن تكون ثقافته حرّة، وكلّ من يستشعر ضعفاً في همّته لفرض «الهيمنة»، أو عدم اكتراث بأمر السيطرة على «القلوب والعقول» جملةً وتفصيلاً.
فالعضويّ، في «المثقّف العضويّ»، يخنق الثقافيّ إذ يقيّده بمهمّات يصعب ردّها إلى الثقافة، ناهيك عن أنّ فكرة الانتساب «العضويّ» لطبقة، أو ما قد ينوب منابها من تشكيل اجتماعيّ، تبقى فكرةً نازعة لخيار المثقّف، ولدور الثقافة والثقافيّ (المدفوع، هنا، إلى الاصطفاف والعسكرة) قبل أيّ شيء آخر.
فالفرضيّة السائدة في بعض الأوساط الراديكاليّة من أنّ غرامشي أقرّ بدورٍ أكبر للمثقّفين، تتغافل عن أنّ هذا الإقرار إنّما حصل بالضبط في الحقل النافي لثقافيّتهم. فهو، بمعنى ما، وكما فعل لينين، «كرّم» المثقّفين بأن رفّعهم في أداء دورهم الخَدميّ للسياسة، وفي تثمين هذا الدور. وهذا إنّما يندرج في الوجهة التي استدخلَتْها، على نحو أو آخر، الاتّجاهات الماركسيّة الأبرز في القرن العشرين، والتي جمعت بينها قناعة مفادها أنّ الماركسيّة الاقتصاديّة والطبقيّة لم تعد كافية لإطاحة الرأسماليّة، وأنّه لا بدّ من إيلاء أدوار أكبر للأفكار والقناعات، وبالتالي لتوسّل الثقافة وتوظيفها. فنحن نقع على تلمّس تلك «الضرورة» في فكرة غرامشي عن «الهيمنة»، كما في نظريّات لوكاتش عن «التشييء»، وأدورنو وهوركهايمر وعموم مدرسة فرنكفورت عن «الصناعة الثقافيّة»، أو لدى لويس ألتوسير في «أجهزة الدولة الأيديولوجيّة»، أو نقد رايموند وليامز لما اعتبره تبسيطاً في نظريّة البُنيتين التحتيّة والفوقيّة… فهناك دائماً فرضيّة أنّ السكّان، في ظلّ الرأسماليّة، قابلون للانخداع جيلاً بعد جيل، يترقّبون الطرف العارف المالك للحقيقة والذي يجيد التسلّل إلى قلوبهم وعقولهم. فهذا وحده من يستطيع أن يفكّ اللغز عن قابليّة الرأسماليّة للصمود، ويردّ ذاك الشيطان الذي «يوسوس في صدور الناس» على أعقابه.ربّما كان أحد الأشكال الهزليّة لهذا الانقياد وراء الأفكار الغربيّة المناهضة للغرب تأثّر بعض مثقّفينا الراديكاليّين بمدرسة فرنكفورت، علماً بأنّ ما نعانيه ليس «البوب كلتشر» بل «الفولك كلتشر» الطائفيّ والزجليّ والهويّاتيّ، فيما لا تزال وطأة الهالة (aura) ثقيلة جدّاً على نتاجنا الثقافيّ (أمّ كلثوم، فيروز…).
أمّا جعل هذا الإشكال الإيديولوجيّ، المحصور بجماعة إيديولوجيّة بعينها، ومن ضمنها مثقّفوها، إشكالاً ثقافيّاً عامّاً وشاملاً ومُلزماً فلا يتأدّى عنه سوى مزيد من استضعاف الثقافة والتمهيد للمهانات والاضطهادات التي نزلت بالمثقّفين حيث قامت أنظمة إيديولوجيّة.

… إنّها الحرّيّة!
لا يفوت الانتباهَ ذاك الدورُ الذي لعبته الأدلجة الفائضة للثقافة، واستعارةُ مبرّراتها من بعض تيّارات الثقافة الغربيّة، في محاصرة مسألة الحرّيّة. وربّما كان حجب هذه القضيّة أو تغييبها، منذ إطباق الانقلاب العسكريّ والتسلّط الأمنيّ على الحياة العربيّة العامّة، السبب الأهمّ وراء التشريق والتغريب المجّانيّين اللذين ينساق وراءهما قطاع بالغ العرض، ومُتتالي الأجيال، من المثقّفين.
وكان الكاتب المغربيّ علي أومليل من القلّة التي أشارت إلى أنّ «حديث مثقّفينا اليوم عن ‘دور المثقّف’ و’رسالته’ حديث يخلط عادة بين الدور الذي يزعمونه لأنفسهم والرسالة التي يدّعون القيام بها، وبين وضعيّتهم الحقيقيّة في الواقع الفعليّ، وحصيلةُ هذا الخلط هي وعي شقيّ لديهم». وهو يمثّل على ذلك بتأثّر الكتّاب العرب بفكرة «الالتزام» السارتريّة، إذ «القول بالالتزام يفترض أنّ حرّيّة التعبير لم تعد مُشكلاً، وإنّما المُشكل هو قضيّة بعينها يدافع عنها الكاتب، وهي موضوع الالتزام. وليس هذا هو وضع الكاتب العربيّ الذي مشكلته هي حرّيّة التعبير». فالكاتب العربيّ الملتزم «أخطأ… في تحديد مشكلته. فلم يكن الالتزام هو قضيّته الحقيقيّة، بل الكتابة نفسها (…) وكان حَريّاً بكتّابنا أن تكون قضيّتهم الأولى ليس الالتزام، بل الديمقراطيّة، والتي أساسها الحرّيّات العامّة (…) وبعد ذلك فليكن ملتزماً أو لا يكون».
وإذ يشير أومليل إلى الفارق بين التزام سارتر، الذي اشترط الحرّيّة (ولو بمعناها الوجوديّ) للالتزام، والتزام الملتزمين العرب، فإنّه مضى خطوة أبعد هي تغليب المثقّفين العرب لقضايا أخرى «مثل ‘الوحدة العربيّة’ و’الاشتراكيّة’ مع التعويل على وسيلة أسرع تأتي بسلطة ‘ثوريّة’ تحقّق أهداف العرب الكبرى»، وهذا فيما اعتُبرت الديمقراطيّة «مجرّد لعبة شكليّة لبورجوازيّة مسيطرة».علي أومليل، السلطة الثقافيّة والسلطة السياسيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط 2، 1998، خصوصاً صفحات 225 و247 و251-252 و256.

لهذا لا عجب أن تتّسع في بيئات المثقّفين العرب مطالبات متواترة للدولة بأن تمارس أبوّة لطيفة وحنونة للمثقّفين، كأن ترعاهم مادّيّاً وتساعدهم، وتتدخّل عبر سياسات76y رقابيّة نشطة وحازمة في التصدّي لـ«الغزو الثقافيّ»، وفي مكافحة التطبيع، أو أيّ غرض آخر يوصف بالوطنيّة أو المقاومة أو الصمود وإن شكّلَ قيداً إضافيّاً يضبط الحرّيّة الثقافيّة بلجامٍ سياسيّ.
فضمناً في الغالب، ولكنْ علناً أيضاً، يصار إلى التعامل مع السلطة بوصفها الأب المرجوّ الذي قد تتراخى أبوّته أحياناً، وقد تضعف همّته بسبب التقدّم في العمر والاختلاف الجيليّ عن الأبناء، إلاّ أنّ حمايته لهم من «العدوّ» مرحّب بها دائماً، وهو قطعاً وتعريفاً ليس «العدوّ» الحقيقيّ. فالسلطة حين تتبنّى المواقف الراديكاليّة الملائمة في الصراع مع الأعداء الحقيقيّين، تغدو قابلة للمسامحة على موقفها من الحرّيّة. وهذا ما كانهُ موقف قطاع عريض من المثقّفين مع الناصريّة أو مع عبد الكريم قاسم، كما عبّر عنه مؤخّراً مثقّفون مناهضون لثورات «الربيع العربيّ»، خصوصاً منها الثورة السوريّة الموصوفة بمناوأة نظام «معادٍ للإمبرياليّة». أمّا الوجه الآخر للعملة ذاتها فكان قلّةَ الاكتراث الدائمة بلبنان ونموذجه كنافذة مفتوحة على الغرب وعلى الحرّيّة، إن لم يكن التحفّظ على ذاك النموذج بسبب «غربيّته» و«مسيحيّته».
وربّما كان للتأثيرات التي خلّفتها، هنا أيضا،ً أفكار إدوارد سعيد دورها في تبرير النأي بالثقافة عن مسألة الحرّيّة والسلطة التي تستبدّ ببلدٍ وشعبٍ ما، وموضعتِها في حيّز العلاقة التناحريّة مع الإمبرياليّة.
فبعد عقد ونصف العقد على كتابه الاستشراق (1978)، حيث حكم بالإعدام على مكتبة ضخمة اتّهمها بإساءة تمثيل الشعوب المغلوبة، عاد سعيد إلى مسائل الثقافة والمثقّفين في كتابه الثقافة والإمبرياليّة (1993). فإذا كان «الاستشراق» محصوراً بالشرق الأوسط، فـ«الثقافة والإمبرياليّة» يتناول نمط العلاقة بين الغرب الحديث وأراضي المستعمرات السابقة من خلال الأدب، وخصوصاً الرواية.
هكذا لم يُعنَ سعيد، على غرار المثقّفين الحزبيّين و/أو المندرجين مباشرة في العمل النضاليّ، بعلاقة السياسة والثقافة، والسياسيّ والمثقّف. لكنّ محطّ تركيزه كان موقع الإمبرياليّة، خصوصاً البريطانيّة، في تطوّر الرواية الأوروبيّة الحديثة. ذاك أنّه لولا الامبراطوريّة لما وُجدت الرواية الأوروبيّة كما نعرفها، بحيث بات يستحيل الفصل بين قراءتها وتناول الإمبرياليّة. ويجوز لنا هنا أن نفترض أنّ الرواية الغربيّة لو تجاهلت المستعمرات وشعوبَها لشكّل تجاهل كهذا مأخذاً لا يقلّ ضراوة عن المأخذ السعيديّ.
في الحالات جميعاً، لئن وقع موضوع كهذا خارج اهتمام الأسطر هذه، بقي أنّ إلحاق الرواية على هذا النحو بالإمبرياليّة يبقى أسير المبالغات وأسير لاتاريخيّة تميّز الفكر السعيديّ الذي يحاكم القرن التاسع عشر ومعارفه وقيمه بمعيار أواخر القرن العشرين. أهمّ من ذلك اندراج ذاك التناول في التضييق والاختزال نفسيهما اللذين لا يخفّف منهما إعلان الكاتب إعجابه ببعض تلك الروايات. فسعيد، في «الثقافة والإمبرياليّة»، أغفل بُعداً أساسيّاً من أبعاد ذاك المسار الذي سلكته الرواية، إمّا تجاهلاً متعمّداً أو لوقوع هذه العلاقة خارج موضوعه بالمعنى التقنيّ للكلمة. وما أُغفل، كائناً ما كان السبب، إنّما هو تحديداً انتقال الرواية الأوروبيّة، بالإمبرياليّ منها وغير الإمبرياليّ، إلى العالم العربيّ وباقي المستعمرات السابقة. ذاك أنّ هذه النقلة ترقى إلى محطّة أساسيّة لا يجوز أن يتجاهلها مسار العلاقة المعقّد، شأنها في ذلك شأن بناء مجتمعات تعدّديّة إثنيّاً وثقافيّاً في المتروبولات الاستعماريّة السابقة، أو التعميم الكونيّ لمعارف وظاهرات وحقول إبداعيّة لا يُحصى عددها سبق أن ظهرت في مختبر العلاقات الاستعماريّة.
تجاربُ مثقّفينا «العضويّين»
لا تعلن تجربة الصلة بين السياسة والثقافة، في المشرق العربيّ، سوى التضادّ ونموّ أحد العنصرين مقابل استتباع الثاني. وهذه التبعيّة التي يمارسها التاريخ الثقافيّ للتاريخ السياسيّ، والتي لا تني تنمو وتتمدّد، هي، في أغلب الظنّ، مصدر النقد المتواصل للثقافة العربيّة بوصفها رازحة تحت وطأة السلطويّة والمراتبيّة الهرمتين والمتهافتتين. فواقع تلك التبعية كثيراً ما يُضعف صدقيّة المزاعم الثقافيّة حول القطيعة مع السلطة على أنواعها، ويجعلها هذراً إنشائيّاً مرصّعاً ببضعة استشهادات فوكويّة.
أمّا تجارب المثقّف العربيّ الأقرب إلى «العضويّة»، والذي انضوى في أحزاب من طينة عقائديّة، وسعى إلى «هيمنة بديلة» من نوع أو آخر، فهي حصراً حيث بدا إلحاق السياسيّ للثقافيّ الأشدَّ إطباقاً وكثافةً، وحيث كادت تنعدم الوسائط. ومن هنا الغرابة القصوى التي تستدعيها تعابير غير ممكنة عمليّاً إلاّ افتعالاً، كـ«مثقّف ماركسيّ مستقلّ» (أو «إخوانيّ مستقلّ» أو «بعثيّ مستقلّ»…)، حيث يؤول اختفاء الكيفيّة الثقافيّة إلى ضعف الصوت الثقافيّ الخاصّ لدى تدخّله في السياسة، إن لم يكن إلى امّحائه، هو المسلوخ عن مرتكزه وخصوصيّته المهنيّين.
وعلى الضدّ من غرامشي والمدافعين عن «الممارسة» والعلاقة بين المثقّف والنضال الحزبيّ، يذهب مانهايم إلى أساس العلاقة الضدّيّة هذه، فيرى أنّ «الأحزاب السياسيّة، وبالضبط بسبب كونها منظّمةً، لا تستطيع الحفاظ على المرونة في منهج التفكير، كما لا تكون جاهزة لأن تتقبّل أيّ جواب قد يخرج عن تَقَصّيها. إنّها، بنيويّاً، شركات عامّة ومنظّمات قتاليّة. وهذا بذاته يُجبرها على الانقياد وراء توجّه دوغمائيّ».KARL MANNHEIM, Ideology and Utopia…, p. 34.
ولا يؤتى بجديد هنا حين يُشار إلى الظاهرة التي تلازم الأحزاب العقائديّة جميعاً، أي توتّر علاقتها بالمثقّفين، وكون التوتّر يتزايد كلّما كان الحزب أكثر تماسكاً وتشدّداً، أو كان المثقّف أكثر شعوراً بالفرديّة وتطلّباً للحرّيّة، أي لممارسة الكيفيّة الثقافيّة المستقلّة.
وفي العلاقة هذه تنطوي تجربتنا تحديداً على احتقان وعجز إضافيّين: فصِلة مثقّفينا بالأب الغربيّ، الذي أُريدَ الانفكاك عن أبوّته الكاملة، أنجزت هدفاً واحداً هو أنّنا نجحنا فعلاً في معانقة أب بديل أو أمّ مفترضة (السلطة المحلّيّة، الوعي الإمبراطوريّ، السياسة بمعناها السائد…). ذاك أنّنا، وفق عقدة أوديب، ننساق في لاوعينا، لأن ننشدّ إلى حبّ أحد الأبوين وكراهية الآخر.
لكنّها، من جهة أخرى، لم تكن علاقة أوديبيّة تماماً، وهنا مكمن الفشل الكبير: فمثقّفونا النضاليّون لم ينجحوا في إسقاط شعرة واحدة من رأس ذاك الأب (الثقافة الغربيّة) الذي لم يُقتل بل ازداد قوّة. وهذا علماً بأنّهم، على عكس أوديب الذي قتل بالخطأ أباه الملك لاوس، يدركون تمام الإدراك أنّهم يحاولون قتل أبيهم. لكنْ على عكسه أيضاً، هو الذي نام مع أمّه الملكة جوكاستا، ولو من غير إدراك أنّها أمّه، فإنّهم لم يناموا مع أحد، بل تعرّضوا لما يشبه الاغتصاب من تلك الأمّ المفترضة أو الأب البديل.
والحال أنّ أزمة العلاقة بالغرب إنّما زادتها احتداماً ثلاثة عناصر ضاغطة: معرفة مدى تشكيل الغرب للثقافة والمثقّفين، ومدى إنكار ذلك والرغبة في مكافحته ونفيه، وكون هذه العمليّة الصراعيّة ضدّه تمضي برمّتها بلا تأثير، كما لو كانت مجرّد فعل دونكيشوتيّ. فالآخر البديل الذي وقع الاختيار عليه، أباً كان أو أمّاً، أي السياسات السائدة وممثّلوها، إنّما عاملَ المثقّفين المقبلين عليه بأكبر قدر من الاحتقار والإيلام، على ما سنرى لاحقاً.
وبما أنّ التاريخين الثقافيّ والسياسيّ شديدا التباين، فإنّ الرغبة في توحيدهما بدافع نضاليّ لم تقتصر على تبنّي المثقّفين رواية السياسيّين، بل دفعتهم إلى المزايدة عليهم سياسيّاً ونضاليّاً كشرط لتجنّب النبذ وتحسين الموقع الذاتيّ.
وتجربة المثقّفين مع الأحزاب التي عرفها المشرق في القرن الماضي تقول كيف أنّ ذينك الامّحاء والعدم، تحت عناوين الحضور والالتزام والدور والتغيير إلخ…، لم تجلب عليهم سوى المهانة، وأحياناً الأذى المباشر الذي يبلغ حدّ القتل. ذاك أنّ المثقّف الحزبيّ إنّما قطع الشوط كاملاً في هندسته بيئاتٍ عقائديّة وحزبيّة شديدة البرم بالحرّيات الثقافيّة وبمناوأتها. وهذه البيئات شبه الدينيّة، التي تفانى المثقّف في هندستها، هي نفسها التي وجّهت شفرتها إليه بمجرّد استشعارها بعض القوّة والمنعة.
والأمثلة التي تقطع الشكّ باليقين لن تعوزنا. فقد أنّب أنطون سعادة، «زعيم» الحزب السوريّ القوميّ ومؤسّسه في 1932، مثقّفي حزبه بسبب «التكلّم المبعثر على فولتير وموليير ولنكلن وهيغل ووليم جايمس وكانت وشوبنهور… إلخ. وعلى مختلف المدارس الفكريّة بدون أن يكون لنا رأي وموقف واضح في تلك الأفكار وأولئك المفكّرين». فهذا، عند أنطون سعادة، لا يعني إلاّ «بلبلة وزيادة تخبّط». وقد أظهرت له «قضيّة» فايز صايغ وغسّان تويني ويوسف الخال «اشتراكات فكريّة توجب النظر في هذه الظاهرة». فصايغ «نزع عن الثقافة معناها وغرضها القوميّ الاجتماعيّ وجعلها أمراً ‘شخصيّاً حرّا’. وحين تكلّم تويني والخال في موضوع ‘حرّية الفكر’، ومن الطريقة التي تكلّما فيها، ظهر لي أنّهما يتكلّمان بأفكار وروحيّة وعقائد هي من خارج الحزب، لا من داخله». ولا يلبث «الزعيم» أن يهين مثقّفيه بجلافة أكبر: فـ«من أغرب الأمور أنّ الذين كانوا يسألون [أي المذكورين أعلاه] كانوا يظنّون أنّهم على مستوى فلسفيّ يؤهّلهم للبحث. ولكنّهم كانوا ينظرون إلى الأمور بالمقلوب وهم أبعد الناس عن النظر في القضايا الأساسيّة».أنطون سعادة، المحاضرات العشر، منشورات عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، 1970، ط 6 (الكتاب صدر أوّلاً في 1948)، المحاضرة الأولى، ص ص. 10-18.
وبدورهم أتى الشيوعيّون بالنموذج السوفييتيّ الذي أبلى أحسن بلاء في العلاقة بالمثقّفين. والحقّ أنّ طقوس التديين والإذعان والتطفيل والإهانة بدأت مبكراً في تأهيل المثقّف الشيوعيّ، على ما يروي نجاتي صدقي، الشيوعيّ الفلسطينيّ الذي دُرِّس الماركسيّة منذ مطالع العشرينيّات، في جامعة شعوب الشرق في موسكو. فمن برامج إعداد مثقّفي الغد الاشتراكيّ أنّ «اللجنة السياسيّة [في الجامعة] تعدّ يوماً في نهاية السنة الجامعيّة تطلق عليه اسم ‘يوم الحساب’ – وهو يوم متّبع في المعاهد والمؤسّسات السوفياتيّة – يعمد فيه الطلاّب إلى كشف عيوب بعضهم بعضاً والتنويه بما يتحلّون به من فضائل. فيقف أحدهم ويقول مثلاً: ‘عزيز شابّ طيّب يحبّ رفاقه مع أنّه أنانيّ… لكنّه ينحو في مسلكه العامّ منحى أبناء البورجوازيّة الصغيرة… تصوّروا أنّه يقف أمام المرآة نصف ساعة وهو يرتّب شعره… ويرشّ نفسه بالعطور… ويهدر الكثير من وقته في مداعبة الفتيات… فسلوك عزيز هذا لا بدّ وأن يؤثّر في معتقداته، فتلهيه النزوات المكتسبة من المجتمع البورجوازيّ عن تأدية واجباته السياسيّة’».
ويمضي الكاتب المتذكّر: «هكذا يكون نصّ الاتّهام… ثمّ يتوالى الطلاّب على الكلام تعليقاً، وتفنيداً، وإدانةً، وتبرئةً، فتتوتّر الأعصاب، وتضطرب النفوس، وتهيج الخواطر… وينتهي ‘يوم الحساب’ بوضع ‘كاراكتيريستيكا’ – أي التصنيف الخلقيّ والأخلاقيّ – لكلّ طالب، تتضمّن ما يتّصف به من محاسن ومساوىء، فيُمتدَح إذا استحقّ المديح، أو يوبَّخ إذا استحقّ التوبيخ، وما يتبعه من إنذار وتقريع. وهناك ‘الانتقاد الذاتيّ’ الذي يلازم الطالب طوال السنة. ففي كلّ اجتماع تعقده الفرقة [الحزبيّة] أو يعقده الصفّ في الجامعة، يقف الطالب وينتقد نفسه، أو يردّ عنه النقد، على أن يبدي ميلاً جليّاً إلى الاستجابة للنقد الموجّه إليه، واستعداداً واضحاً للاعتراف بأخطائه ونزواته، وقبولاً كلّيّاً للتمسّك بأهداب المبادئ الأدبيّة والمعنويّة التي يبشّر بها المجتمع [الاشتراكيّ] الجديد».
ويضرب صدقي بعض الأمثلة: فـ«أحد الطلاّب الفلسطينيّين لم ينس أن يُحضر معه من يافا سجّادة الصلاة… فقُبض عليه ‘متلبّساً بالجريمة’، وأحيل إلى محكمة ‘النقد الذاتيّ’، فجادل كثيراً ودافع عن نفسه مبرهناً أنّ الإسلام هو دين الاشتراكيّة، وأنّ الصلاة بوصفها رياضة روحيّة لا تتعارض مع فكرة تحطيم القيود والتخلّص من الاستثمار والاستعمار… فتساهل القوم معه لأنّه طالب مبتدئ…».مذكّرات نجاتي صدقي: حكايات اشتراكيّة، مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2001، ص. 46-47.
وفي أجواء الحزبيّين اللبنانيّين والسوريّين اشتُهرت المهانات التي نزلت برئيف خوري لاتّهامه بالانحياز إلى تيتو بعد خلافه مع ستالين، علماً بأنّ خوري كان «قد كتب الكثير عنه ونظم في تمجيده أجمل القصائد». وخوري، الذي كان صديقاً للشيوعيّين، مقرّباً جدّاً منهم، دون أن يكون حزبيّاً، مُنع من الكتابة في مجلّة الطريق الشيوعيّة التي شارك في تأسيسها، وشُهّر به على صفحاتها لوقوفه ضدّ تقسيم فلسطين في 1947 الذي وافقت عليه موسكو.

وفي هذه الغضون كانت محنة المثقّف والقائد الشيوعيّ فرج الله الحلو الذي كتب رسالة استعطاف وتذلّل للقيادة كي لا يُطرد من الحزب، وهي التي عُرفت بـ«رسالة سالم» (اسمه الحركيّ) وعُمّمت على المنظّمات الحزبيّة. ذاك أنّ القيادة اتّهمته بـ«أَخطاءٍ وانحرافات وميول كوسموبوليتيّة وقوميّة شوفينيّة». ويُرجّح أنّ الأمين العامّ خالد بكداش هو من كتب الرسالة التي «تضمّنت تحقيراً فظيعاً لكاتبها ومدحاً أفظع لبكداش».
وفي هذا كلّه كان القدوة والمثال المعمول بهما هما ستالين الذي، وفق وصف مكسيم رودنسون، «أزاح بداهةً المثقّفين ذوي القابليّات النظريّة والتحليليّة الذين كرههم دائماً»مكسيم رودنسون، الماركسيّة والعالم الإسلاميّ، دار الحقيقة، ط 2، 1982، ص. 277. وطهّر حزبه منهم.
وفضلاً عن الكيمياء الشخصيّة السيّئة بين بكداش والحلو، وتحفّظ الأخير على عبادة الشخصيّة التي أرساها الأوّل، جاء رفضه الموقفَ السوفييتيّ المؤيّد لتقسيم فلسطين ليشدّد الرغبة في عزله، فأُقصي «تماماً عن قيادة الحزب، وصار عاملَ مطبعة» عقاباً له. أبعد من ذلك أنّ بكداش، وبعد عقد على تلك التجربة، «أرسل ‘الحلو’ إلى حتفه في دمشق أَيّام الوحدة المصريّة – السوريّة، حيث عُذّب وقُطّعت جثّته»، بحسب كاتب معروف بقربه من الحزب الشيوعيّ.أنظر نصّ أحمد علبي، رئيف خوري المثقّف الشيوعيّ في الزمن الستالينيّ، المعاد نشره في مجلّة بدايات، العدد 5، ربيع 2013.
أمّا العنف الماديّ الذي لم يُنزله الشيوعيّون والقوميّون السوريّون مباشرة بمثقّفيهم، كونهم لم يصلوا إلى السلطة، فهو ما أقدم عليه البعثيّون ممّن استولوا على الحكم في سوريّا والعراق. وكان في عداد الضحايا مؤسّسو الحزب أنفسهم، إذ حُكم على ميشيل عفلق بالإعدام في 1966 في سوريّا، وقضى العقدين الأخيرين من حياته في العراق مروّجاً أفعال حاكمه صدّام حسين. أمّا المؤسّس الثاني صلاح الدين البيطار فاغتاله النظام السوريّ في باريس عام 1980، بينما قضى الأمين العامّ منيف الرزّاز في الإقامة الجبريّة في بغداد عام 1984، وسبق أن أُعدم في 1979 عبد الخالق السامرّائي، الذي شكّل قطباً بعثيّاً ثقافيّاً في مواجهة صدّام حسين، وجاء إعدامه بعد ستّ سنوات قضاها في الحبس الانفراديّ. أمّا وزير الثقافة البعثيّ السابق، الشاعر شفيق الكمالي، فتوفّي في 1984 بُعيد إخراجه من السجن ومقتل نجله الغامض. وبدوره اعتُقل عزيز السيّد جاسم الذي حاول الانتحار في سجنه، حتّى إذا أُطلق سراحه خُطف واختفى في 1991.
فهؤلاء، وبغضّ النظر عن التنازلات التي يقدّمونها للحزب وللقائد، بما فيها نحرُ المثقّف الذي فيهم، لا يستطيع الجسم الحزبيّ إلاّ أن يلفظهم، مثلما لفظ سامي الجندي أو سامي الدروبي أو سواهما.
وإذ يصيغ الكاتب المصريّ شريف يونس علاقة النظام الناصريّ بالمثقّفين فإنّه ينفي أن يكون المنع «جوهر العلاقة بين الدولة والفنّ والأدب»، إذ «الأمر كان أعقد من المنع والحظر بكثير»، يكمن مصدره في «تصاعد أهميّة الإيديولوجيا عموماً والدعاية خصوصاً في آليّات عمل النظام بسبب طبيعته الخاصّة للغاية».شريف يونس، عن الفنّ والأدب فى ظلّ الناصريّة: دراسة لدور المثقّف فى ظلّ حكم الزمرة، في: الحوار المتمدن، العدد 251، 19/9/2002.
فمع النظام الناصريّ في حاجته إلى أدوات إيديولوجيّة، شقّ المثقّفون المصريّون، الذين شاؤوا ألاّ يُحابوا السلطة، طريقهم إلى الهجرة، و«كُرّم» بعضهم بمنحهم مكاتب في جريدة الأهرام شريطة ألاّ يقولوا ما ينمّ عن أيّة معارضة. ثمّ بعد مصالحة 1964 الناصريّة السوفييتيّة، سُلّم أبرز مثقّفي اليسار مواقع في الإعلام «الطليعيّ» ودوائر «التثقيف» الرسميّ.

وبعد وفاة عبد الناصر، إثر هزيمة 1967، أصدر توفيق الحكيم كتابه الشهير عودة الوعي حيث راجع تلك الحقبة من الديكتاتوريّة والفساد والإفساد، متسائلاً عن صمت المثقّفين. لكنْ لئن حقّق الرئيسان اللاحقان أنور السادات وحسني مبارك بعض انفراجات جزئيّة، بات واضحاً أنّ الحرّيّات الثقافيّة التي عرفتها الحقبة الكولونياليّة ولّت نهائياً وغدت استعادتها أقرب إلى الاستحالة. فنظام الحزب الواحد المتفرّع عن انقلاب يوليو لم يتغيّر إلاّ في التفاصيل الصغرى. هكذا شهدت مصر في عهد السادات هجرة أخرى للمثقّفين فيما بات اعتقالهم رياضة وطنيّة للسلطة. بعد ذاك جاءت تجارب سعد الدين إبراهيم ومحمّد سعيد العشماوي وسواهما تقطع بأنّ العهد المباركيّ استئناف للعهد الساداتيّ الذي كان بدوره استئنافاً للعهد الناصريّ.
ونعرف أنّ معايير السيطرة والاحتواء التي باشرها انقلاب يوليو عربيّاً، متأثّراً بالتجارب الفاشيّة الآفلة ثمّ بالتجربة السوفييتيّة الصاعدة يومذاك، ما لبثت أن تبنّتها الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة في سوريّا والعراق. كذلك امتدّ عجز المثقّفين عن التشكّل كجماعة حرّة ذات صوت مستقلّ إلى منظّمة التحرير الفلسطينيّة، حيث تكفي مقارنة سريعة بين حضورهم الهزيل وحضور زملائهم في المجلس الوطنيّ الأفريقيّ منذ بداياته التأسيسيّة،من أجل فكرة حول هذا الدور، راجعMcebisi Ndletyana, ‘The early ANC: Leadership steeped in intellectual curiosity’, in: Mail and Guardian, 8 Jan 2022. وهذا رغم ارتفاع نسبة المتعلّمين والمثقّفين في أوساط الفلسطينيّين قياساً بأحوال معظم الشعوب العربيّة.
ويمتدّ خليط المهانة والأذى من أعمال كإجبار نجيب محفوظ، الكاره للسفر، على السفر إلى اليمن، كي يروّج للجيش المصريّ ودوره هناك، أو استقالة إدوارد سعيد من المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ لأنّ معارضته سياسة ياسر عرفات لا تترك له مكاناً في المجلس، إلى اغتيال أبرز رسّام كاريكاتير فلسطينيّ، وأحد أبرز رسّامي الكاريكاتير العربيّ، ناجي العلي، لأسباب لا علاقة لها البتّة بالسياسة أو بالثقافة.
ولم تكن السلطات السياسيّة المصدر الوحيد للعدوان على الثقافة والمثقّفين، بصنفيهم الناشط سياسيّاً وغير الناشط. ذاك أنّ المؤسّسات الدينيّة والتيّارات الأصوليّة لم تُقصّر على هذا الصعيد، إمّا بالاستقلال عن السلطة أو بالتكافل معها. ففي مصر مثلاً، واقتصاراً على أكثر الحالات شهرة فحسب، اغتيلَ الكاتب فرج فودة في 1992، وبعد سنوات قليلة حُكم على الأكاديميّ دارس الإسلاميّات نصر حامد أبو زيد بالكفر والارتداد وتطليق زوجته منه، واضطرّ للذهاب إلى المنفى الذي لم يعد منه إلى بلده إلاّ قبل أسبوعين من وفاته. وحتّى نجيب محفوظ نفسه لم يسلم من محاولة اغتيال إذ طعنه إسلاميّ متزمّت. وهذا معطوف على مداخلات الأزهر وغيره من المنابر الدينيّة في الأعمال السينمائيّة والفنّيّة بوصفها رقابة موازية لرقابة السلطة. وعرف لبنان أعمال اغتيال طالت كتّاباً ومثقّفين وصحافيّين، كان منهم في الثمانينيّات حسين مروّة ومهدي عامل، وفي العقد الأوّل من هذا القرن سمير قصير وجبران تويني، ثمّ في 2021، لقمان سليم. أمّا العراق فسجّل، منذ 2003، مقتل عدد معتبر من أساتذة الجامعات والمثقّفين، ككامل شيّاع في 2008، ناهيك عن أفواج سابقة ولاحقة من الصحافيّين.
وكانت القوى غير الدولتيّة التي مارست الاغتيالات، أو حرّضت عليها، أصوليّةً كلّها، سنّيّة أو شيعيّة، كارهةً للغرب.

السياسيّون هم… «المثقّفون»
لا تقتصر النتائج الكارثيّة هنا على إفقار الاستقلالات وأعمال التحرّر، بل إفقار القضايا التي توصف بأنّها عادلة، من مضامينها المفترضة، بل تمتدّ إلى تسليم المواقع الثقافيّة إلى السياسيّين أنفسهم. فالأخيرون، مَسوقين بعُظامهم المعهود، مستعدّون دوماً، إلى «ملء الفراغ» الذي يُحدثه انكفاء المثقّفين. يظهر هذا الانتهاك خصوصاً في الأنظمة الديكتاتوريّة والتوتاليتاريّة المفطورة على ابتلاع الحياة الثقافيّة، وابتلاع التعليم ومؤسّساته، كما يظهر في الحركات النضاليّة والحزبيّة التي تسعى بالعنف والقوّة إلى كسر وضع اجتماعيّ وسياسيّ ما.
فما عرفته الصين وكوريا الشماليّة لناحية الاحتفاء بالرياديّة الثقافيّة لماوتسي تونغ وكيم إيل سونغ، رأيناه مع صدّام حسين الذي نشر أربع روايات، فيما خلّف معمّر القذّافي رواية وعديد الكتب والكتيّبات «الفكريّة». وإذ أصدر علي ناصر محمّد، أحد رؤساء اليمن الجنوبيّ السابق، ديوان شعر، فقد أتحفنا مصطفى طلاس، وزير الدفاع السوريّ في معظم سنوات حكم حافظ الأسد، بدواوين شعر وبكتب في كلّ صنف كتابيّ. وفي أواسط 2022، وتتويجاً لوجهة باتت مألوفة، أنشئت في إيران «جائزة قاسم سليماني للأدب»…
على أنّ أحد الأشكال الأخرى المعروفة في العدوان على المثقّف والثقافيّ هو ما بات يُعرف، منذ الستينات الصينيّة، بـ«الثورة الثقافيّة». فهذه الأخيرة، وكما سوف نرى، تجمع بين غرضين ثابتين، أوّلهما وأهمّهما لا صلة له مطلقاً بالثقافة، مدارُه توطيد قبضة الزعيم والحؤول دون أيّة منافسة قد تواجهه. وما إدراج هذه المهمّة في «ثورة ثقافيّة» سوى إيحاء بقابليّة المثقّفين، في أنظمة كهذه، للتوسّل، وقابليّة الثقافة للاستخدام.
أمّا الثاني، وهو الغرض الأكثر «ثقافيّة»، فإطاحة الحياة الثقافيّة وطواقمها واستبدالها بطواقم تكون أشدّ تبعيّة للمعطيات السياسيّة، كما يكون أصحابها، كموظّفين إيديولوجيّين، أقلّ موهبةً وإبداعاً بالضرورة.
لقد عرفت ألمانيا في ظلّ بسمارك، إبّان سبعينيّات القرن التاسع عشر، تمريناً أوّليّاً على «الثورة الثقافيّة»، جاء متواضعاً جدّاً بقياس ما تلاه، وهو ما سُمّي بـ «النضال الثقافيّ» (Kulturkampf)، مستهدفاً الكنيسة الكاثوليكيّة وموقعها الوطيد في المجتمع. ثمّ غازلت روسيا البلشفيّة مفهوم «الثورة الثقافيّة»، وأشار إليه لينين إشارة عابرة في مقال كتبه مطلع 1923، علماً بأنّ الحركة التعاونيّة كانت الشاغل الأساسيّ للمقال الصغير هذا.Vladimir Ilyich Lenin, ‘On Cooperation’, in: Lenin’s Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 33, p. 467-75.
لكنّ عدم التوغّل البلشفيّ في هذا المفهوم لا يلغي «إنجازات» من النوع الذي تأتي به «الثورات الثقافيّة»، كإلغاء اللاهوت واليونانيّة القديمة من برامج التعليم، بنتيجة مرسوم فصل الدولة والمدرسة عن الكنيسة الصادر في 1918. وبطبيعة الحال أشرف الحزب على التعليم كما أمّم مؤسّساته ومعها دور النشر والمتاحف والصناعة السينمائيّة وألغى حرّيّة الصحافة.
ولئن لم يترك التحويلان الثقافيّان، الألمانيّ والإيطاليّ، في العهد الفاشيّ، أثراً يُذكر على العالم العربيّ لأسباب تفيض عن هذه الأسطر، فما عرفته الصين الماويّة كاد يحتكر تسمية «الثورة الثقافيّة» على نطاق عالميّ، كما بات النقلة النوعيّة والدمويّة الجبّارة التي خضّت المجتمع الصينيّ لعقود.
فـ«الثورة» تلك قُدّمت ردّاً على «خيانة» الاتّحاد السوفياتيّ للاشتراكيّة بنتيجة إدانة خروتشيف لستالين في المؤتمر العشرين للحزب السوفياتيّ (1956). هكذا زعم ماو أنّ المشكلة لم تعد في البورجوازيّة التي اندحرت ومُحقت، في 1917 في روسيا وفي 1949 في الصين، بل في ثقافة البورجوازيّة التي تعطّل الانتقال إلى الاشتراكيّة، والتي ينبغي استئصالها عبر النضال بلا هوادة ضدّها. على أنّ تلك الديباجات النظريّة بقيت الملحق الذي يتطلّبه الصراع على السلطة كهمٍّ حاكم. فـ«الثورة الثقافيّة» إنّما تتدرّج في مراحل وثيقة الارتباط، وحصراً، بالصراع المذكور: بين 1966 و1968 يطلق ماو «الشعب» كي يهاجم الحزب، خصوصاً «التحريفيّين» و«سالكي الطريق الرأسماليّ» ضمن القيادة، خصوصاً منافسه ليو تشاو تشي. وفي 1968 تبدأ المرحلة الثانية فيتحرّك الجيش ويفرض ديكتاتوريّة عسكريّة يقودها وزير الدفاع و«رفيق ماو في السلاح» لين بياو، وهي الديكتاتوريّة التي استمرّت حتّى 1971 وحوّلت البلد إلى ثكنة يتولّى فيها الجيش الإشراف على المعامل والمدارس والمؤسّسات الحكوميّة. لكنّ لين بياو لا يلبث أن يموت في حادث طائرة غامض، ربطَه بعض المحلّلين بمحاولة انقلابيّة فاشلة. وفي 1971 تبدأ مرحلة ثالثة، بعدما تصدّع الحزب وفشلت المهمّة العسكريّة وأعيد الجيش إلى الثكنات.
ولئن راج تقدير معتدل لضحايا «الثورة الثقافيّة» يضعهم في حدود المليونين، فيما سُجن عشرات الملايين، كان ما لا يقلّ أهميّةً استئصالُها الثقةَ والأمل، لا سيّما بالكائن الإنسانيّ والعلاقة بين السكّان. فالمواطنون، باسمِ التحويل الثقافيّ، وُضع واحدهم مقابل الآخر، ودُفعوا لإدانة أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم، وللعيش لاحقاً مُثقَلين بهذه الذنوب.
لقد اضطُهد المثقّفون الذين اعتُبروا «أعداء طبقيّين وإيديولوجيّين»، كما أُرسل 16 مليون شابّ متعلّم إلى الأرياف كي «يتعلّموا من الفلاّحين». لكنّ الأفدح أنّ الطلاّب الذين غدوا، مع ابتداء «الثورة الثقافيّة»، عناصر «الحرس الأحمر»، أطلقوا حملة لمحو «الأربعة القدامى»، أي الأفكار والثقافة والأعراف والعادات، ودمّروا الكثير من الآثار التاريخيّة والرموز الثقافيّة والتراثيّة.
وعلى العموم، كانت «الثورة الثقافيّة» ردّاً على ضعف شرعيّة النظام، وخصوصاً ضعف موقع القائد الذي كان قد اهتزّ بعد سياسة «القفزة الكبرى إلى الأمام» ومجاعتها التي أودت بـ45 مليون إنسان.ثمّة من يردّ السبب الحدثيّ المباشر لـ«الثورة الثقافيّة» إلى عرض مسرحيّ حمل عنوان «عزل هاي روي من المنصب»، وهو عن موظّف في عهد سلالة مينغ انتقد الإمبراطور. وقد اعتبر ماو أنّ المسرحيّة تهاجمه شخصيّاً وتدافع عن وزير دفاعه بِنغ ديهواي الذي سبق أن عُزل في 1959 لانتقاده سياسة «القفزة الكبرى إلى الأمام».في ما خصّ “الثورة الثقافيّة” الصينيّة، راجع:Frank Dikotter, The Cultural Revolution: A People’s History, 1962-1976, Bloomsbury, 2017. فمتى أضيفت علاقات خارجيّة ودوليّة مضطربة (التوتّر مع موسكو الذي انفجر حرباً في 1969) زادت حظوظ اعتماد علاج كهذا.
ثمّ ظهرت «ثورات ثقافيّة» موضعيّة الأثر وكاريكاتيريّة بقياس المثال الصينيّ، كتلك التي عرفتها ليبيا في (1973-1974) وإيران في (1980-1987). إلاّ أنّ المحفّزات كما التوجّهات العريضة التي دلّت إليها التجربة الصينيّة (تمتين قبضة السلطة والزعيم، مرحلة توتّر خارجيّ، توسّل الحدث لـ«تنظيف» الحياة الثقافيّة، أو بالأحرى «تنظيف» الحياة من الثقافة…) يمكن تلمّسها هنا أيضاً.في ليبيا، ترافقت «الثورة الثقافيّة» مع النزاعات المحتدمة داخل القيادة العسكريّة للنظام (منذ تصفية مجموعة آدم حوّاز وموسى أحمد، وزيري الداخليّة والدفاع، أواخر 1969 بعد اتّهامهما بمحاولة انقلابيّة) وبدايات التوتّر مع مصر الساداتيّة والسودان في عهد نميري، مثلما ترافقت تلك «الثورة»، في إيران، مع الحرب مع العراق بعد احتجاز موظّفي السفارة الأميركيّة في طهران وتصفية الرموز المدنيّة للثورة واحداً واحداً، سياسيّاً أو جسديّاً، توطيداً للسلطة الاحتكاريّة لرجال الدين.
أمّا عربيّاً، وفضلاً عمّا فعلته النزعات الاستبداليّة لدى الأنظمة الأمنيّة، لم تكفّ اتّحادات الكتّاب والأدباء والصحافيّين والأساتذة الجامعيّين عن تقديم الأمثلة الفاقعة عن عمليّات تقريب وتبعيد يقرّرها مدى الولاء للنظام، كما لم تتوقّف حملات مكارثيّة، غير رسميّة بالضرورة، طالت مثقّفين بسبب ما اعتُبر «تطبيعاً» مع إسرائيل. وفي المقابل، نُصّبت في السبعينيّات، وعلى مدى المشرق، قيادة ثقافيّة متصدّرة وصاحبة امتيازات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثين، يجمع بينها ذاك التقاطع بين الولاء للثورة الفلسطينيّة، أو الارتباط بها، وكونها غير مستفزّة للأنظمة العسكريّة والأمنيّة، وتردادها بعض الكليشيهات المناهضة للغرب التي تنسجم مع الأدبيّات السوفييتيّة الشائعة.
لكنّ تلك النزعات وجدت تعابير عنها من خارج الأنظمة وأجهزتها، نطق بها مثقّفون بارزون تحكّمت بهم معايير سياسيّة بشكل أو آخر.
وكان من أشهر تلك التعابير مقالة كتبها إدوارد سعيد في 1988 بعنوان «وداعاً نجيب محفوظ». فالأخير لم تكن قليلةً أسباب تحفّظ الراديكاليّين عليه: فهو وفديّ تقليديّاً، أيّدَ السلام المصريّ الإسرائيليّ أواخر السبعينيّات، وكان العربيّ الوحيد الذي ينال جائزة نوبل للآداب، سنة صدور مقالة سعيد، قبل ستّ سنوات على تعرّضه لمحاولة الذبح بسكّين.
لقد أثنى سعيد على الروائيّ المصريّ وعامله باحترام يصعب إنكاره عليه. فهو، في التجربة العربيّة، «ليس فقط هوغو وديكنز، بل أيضاً غاسورثي ومانّ وزولا وجول رومان». بعد ذاك أجرى مقارنات بين مصر «المستقرّة»، حيث يمارس محفوظ مواطنيّته، وكلّ من فلسطين ولبنان حيث كفّت الأولى عن الوجود ودخل الثاني في حرب مفتوحة، وحيث هويّة البلدين الوطنيّة مهدّدة، ما يجعل الرواية فيهما عملاً خطِراً وإشكاليّاً. ومن هذه المقدّمة انتقل سعيد إلى أدب الأديبين الفلسطينيّين إميل حبيبي وغسّان كنفاني والأديب اللبنانيّ إلياس خوري، وخصوصاً تجاربهم السياسيّة، بوصفهم مقابلاً لمحفوظ يتجاوزون تجربته في صدورهم عن هويّات جديدة مكسّرة وضعيفة الصلة بالدولة الوطنيّة الآفلة. هكذا غدا من الممكن توديع محفوظ في ظلّ سطوع تجارب الثلاثة المذكورين، خصوصاً منهم خوري.Edward Said, ‘Goodbye to Mahfouz’, in: London Review of Books, Vol. 10 No. 22 · 8 December 1988.في كتابه «الثقافة والإمبرياليّة»، يصيغ سعيد ما يصلح أن يكون معاييره البديلة على النحو التالي: «يبدو اليوم الكثير ممّا بقي مثيراً لعقود أربعة، في ما خصّ الحداثة الغربيّة وما تلاها، أي الاستراتيجيّات التأويليّة الموسّعة للنظريّة النقديّة أو الأشكال الواعية لذاتها أدبيّاً وموسيقيّاً، تجريديّاً ولطيفاً كما تُستلطف الأشياء القديمة، وذا تمركز أوروبيّ يائس. فما هو أشدّ مدعاة للثقة الآن هو التقارير من خطّ الجبهات الأماميّة حيث تُخاض الصراعات بين طغاة محلّيّين ومعارضات مثاليّة، وحيث الاختلاط الهجين بين الواقعيّة والفانتازيا، والأوصاف الخرائطيّة والأركيولوجيّة، والاستكشافات في أشكال مختلطة (المقالة والفيديو أو الفيلم والصورة والمذكّرات والقصّة والمأثور) لتجارب النفي التي لا دار لها».Edward W. Said, CULTURE AND IMPERIALISM, VINTAGE BOOKS, 1994, p. 330.
والاعتراض على الاستبدال السعيديّ هنا لا ينطوي على أيّ استبعاد لإمكانيّة تجاوز محفوظ، إذ هناك ضرورة لتجاوزٍ كهذا، ولأيّ تجاوزٍ يشي بتوسيع الحيّز المتاح أمام تجارب الأفراد الحميمة في الرواية العربيّة، خصوصاً أنّ عالم محفوظ، وككلّ عالم فنّيّ آخر، لا يحتفظ إلى ما لا نهاية بتمام راهنيّته كتمثيل واقعيّ للواقع. لكنّ الاعتراض ينهض، في المقابل، على رفض تسويغ هذا الاستبدال بمقدّمات تتراوح بين الأنثروبولوجيّ والسوسيولوجيّ والسياسيّ، إن لم يكن الحزبيّ أيضاً، حيث يختم سعيد مقالته بلقائه محمود درويش وإلياس خوري في الجزائر إبّان اجتماعات المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ، وبما دار بينهم على ضفاف كتابة درويش «إعلان الدولة».
كسر قيد الثقافة
لقد تأدّى عن هذا التذويب للثقافيّ في السياسيّ، واشتقاقه منه، جعل الأخلاق الثقافيّة أخلاقاً سياسيّة بالمعنى الرديء لـ«السياسة» كما صاغته لعقود الأنظمة الأمنيّة والأحزاب العقائديّة. ففي أواخر الخمسينات مثلاً، وفيما التنازع الشيوعيّ القوميّ في العراق على أشدّه، هدّد شاعر شيوعيّ يومذاك، هو عبد الوهاب البيّاتيّ، خصومَه القوميّين (ومعهم الروائيّ الروسيّ باسترناك وبطله جيفاغو) بـ«إنّا سنجعل من جماجمهم منافض للسجائر».أنظر عن تلك القصيدة وملابساتها: ماجد مكّي الجميل، جماجم عبد الوهاب البيّاتي متنوّعة ومتعدّدة الأغراض، موقع وضوح، 23/6/2022.
ومؤخّراً ذكّرنا الكاتب التونسيّ منصف الوهايبي بموقف الشاعر أدونيس حين أيّدَ عمليّة ميونيخ الإرهابيّة، التي استهدفت رياضيّين إسرائيليّين في 1972، ورأى أنّ هذا الموقف هو ما حَرَمه جائزة نوبل دون أن ينبس بكلمة نقديّة واحدة حول الموقف هذا.
ففي افتتاحيّته للعدد 22 من مجلّته مواقف (20 أيلول 1972)، بعنوان «العنف المحرِّر»، يهاجم أدونيس «الرأسمال الصهيونيّ» و«الرأي العامّ العالميّ» الذي «لا يمثّل غير الانحلال والتعفّن والوحشيّة واحتقار الإنسان والرغبة المَرَضيّة في استعماله وإذلاله واستغلاله». وإذ يصل إلى «عنف ميونيخ» تحديداً، يراه (متأثّراً على الأرجح بفانون) «جزءاً متميّزاً وفذّاً من العنف المحرِّر الشامل الذي لا يحرّر العرب من العدوّ وحسب، وإنّما يحرّرهم كذلك من عجزهم المَرَضيّ، ومن ممارسة العنف على الذات». فـ«عنف ميونيخ» بالتالي «ثوريّ حقّاً»، وهو «صحيح وفعّال حقّاً (…) ينقل العرب من اجترار الذات إلى القبض على الموضوع، من الدوار في الداخل إلى مواجهة الخارج. ينقلهم، بكلمة، من تدمير الذات إلى تدمير العدوّ».منصف الوهايبي، شهادة: أدونيس/نوبل/ ميونيخ، في جريدة القدس العربيّ، 14/10/2022.
وكان لانعدام الكيفيّة الثقافيّة أن جعل الموقفَ الثقافيّ، حين لا يقدم على الامّحاء الذاتيّ، يصفّح نفسه بهشاشة قد ينقلب معها، أمام أيّة صدمة أو رضّة، إلى موقف مضادّ للثقافة.
وكنّا قد شهدنا، في 1989، مع ذواء الحرب الباردة، محطّة مهرجانيّة بارزة في هذا المسار، حين اصطفّ عدد كبير من المثقّفين المصريّين (والعرب) مندّدين بذكرى انقضاء قرنين على الحملة الفرنسيّة، ومنكرين انطواءها على أيّ معنى يتعدّى النهب والتوسّع والإخضاع. وبعد انفجار غضب شامل تلا حرب الكويت وتحريرها في 1990-91، انفجرت موجة غضب أخرى، تحوّل بعضها إلى هستيريا، ما بين نهاية الحرب الباردة وحرب العراق في 2003. هكذا راحت مجدّداً تتتالى مواقف الارتداد عن كلّ ما يُفترض أنّه همٌّ ثقافيّ والتنصّل منه. يكفي هنا الاستشهاد بمؤرّخ مغربيّ وباقتصاديّ مصريّ، هما محمّد عابد الجابري وجلال أمين المرموقان في مجاليهما، والمتفرّعان عن خلفيّة ماركسيّة قبل أن يصالحاها، كلٌّ بطريقته، مع القوميّة والدين.وكان تأثير ماركس ولينين (بما في ذلك على الشيوعيّين أنفسهم) قد تراجع كثيراً بعد انهيار المعسكر الشرقيّ. ففي ظلّ عنوانين لا يتركان زيادةٍ لمستزيد (في نقد الحاجة إلى الإصلاح للجابري، والتنوير الزائف لأمين)، يذهب أوّلهما، مُستثاراً بالدعوة الأميركيّة إلى الإصلاح، إلى تناول فكرة الإصلاح «كما تتحدّد في مرجعيّتنا التراثيّة، منذ ظهر الإسلام إلى القرن الثامن عشر». وهو يبذل جهداً، سبقه إليه كثيرون، لإقناعنا بلا جدوى المطالبة بالعلمانيّة وبفصل الدين عن الدولة في تجربة تاريخيّة تختلف عن التجربة الأوروبيّة، مكرّراً ما سبق أن قيلَ آلاف المرّات من عدم وجود كنيسة في الإسلام، ومعلناً، بلغة شبه أدونيسيّة، أنّ أحد مقاصده انتشال مفهوم حقوق الإنسان «من ميدان النسبيّ والتفكير فيه إلى فضاء المطلق». وبعد استعراض ثقافيّ تاريخيّ موسّع للتاريخين الفكريّين الغربيّ والإسلاميّ، يخلص إلى نتيجة هزيلة ومكرّرة حول المساواة والعدالة والتنمية و«كبح جماح الأطماع الإمبرياليّة» كمضمون لإصلاحٍ هو وحده ما يستحقّ هذه التسمية.محمّد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2005، خصوصاً صفحات 17 و77-86 و137 و240.
أمّا جلال أمين فينعدم عنده أدنى اختلاف عن لغة السلطتين السياسيّة والثقافيّة. فهو أيضاً يزيح جانباً إشكاليّة الإصلاح كما طُرحت كي يعود على بدء قديم: «نعم، نحن فقراء، ولكنّ هذا لا يعني أنّنا متخلّفون. هم متقدّمون عنّا في التكنولوجيا، أي في فنّ إنتاج السلع والخدمات (…) ولكنْ في الحياة أشياء أخرى». وهو إذ ينعى تقدّم الغربيّين، خصوصاً تعاملهم مع «الشذوذ الجنسيّ»، يدافع عن العائلة والمقدّسات، متحفّظاً على «المساواة المطلقة بين الجنسين».
ولئن أجاز الكاتب احتمال مخالفة المرء «عقائد أمّته وعشيرته»، فهو لا يلبث أن يؤكّد «أنّ هناك دائماً حدوداً لهذه الإمكانيّة… هناك حدود لا يستطيع الفرد أن يتجاوزها في التعبير عمّا يعتقده مخالفاً لعقائد أمّته، فإذا لم يمنع نفسه منعتْه أمّته». ودائماً على حدود التهديد البوليسيّ، يهاجم «الحرّيّة المطلقة في التفكير» بوصفها خطراً على صاحبها أيضاً، كما يصحّ الشيء نفسه في «التسامح المطلق» مع الرأي المخالف. وإذ يشجب التنوير في تاريخه كما «في ظلّ النظام العالميّ الجديد»، ويشجب معه «ممثّليه» المصريّين، يبدو له الأخيرون كمن يسيء لـ«بعض من أغلى المقدّسات لدى المصريّين»، ويحاول «تصغير الكُبَراء». ويمتدّ هجوم أمين إلى «المتحمّسين لثورة المعلومات»، التي وإن احتَفَل بها لوهلة، استدرك معلناً أنّه قلِق بسببها «على مصير العرب، بل مصير العالم كلّه»، بسبب سيطرة الغرب على المعلومات، فضلاً عن كثرة تلك المعلومات التي قد تنتج «تبلّداً في الحسّ»، و«قهراً» تمارسه ثقافة الغرب للثقافات الأخرى، واستخداماً لها مقيّداً للحرّيّة. ويوسّع أمين تمثيليّته، فنراه ينطق بلسان «الثقافة العربيّة» بوصفها تنطوي على «رفض للموقف المحايد في العلم والفنّ والأدب». ذاك أنّ العلم «لا بدّ أن يكون نافعاً، والفنّ والأدب يجب أن يكونا أخلاقيّين، فلا يقبل الذوق العربيّ بسهولة مثلاً المسرحيّة التي تصوّر الشرّ والجريمة أو الابتذال بحجّة أنّها تصوّر الواقع (…) حتّى لو انتهت المسرحيّة بكلمة أو كلمتين في صالح الخير وضدّ الشرّ. فالذوق العربيّ ينفر، بطبعه، فيما أعتقد، من تصوير الرذيلة…». وإذ يعود إلى النماذج الكريهة فإنّه يجدها في كتاب طه حسين في الشعر الجاهليّ، فيما بعض فصول رواية سلمان رشدي «غاية في سوء الأدب»، ما يحمله على المطالبة بمعاقبة من ينشرون كتباً كهذه وفي عدادها رواية الصقّار للروائي المصريّ سمير غريب علي. ويروح أمين يجلد سينما يوسف شاهين بوصفها، بين أمور أخرى، مصنوعة لـ «الخواجات»، وتدعو إلى التطبيع، منهياً كتابه بخاتمة عنوانها «دليل الرجل الذكيّ إلى الإصلاح المنشود في مصر»، يعرض فيها عصارة آرائه في الاقتصاد والتنمية، غير مبتعد عمّا توصّل إليه الجابري.جلال أمين، التنوير الزائف، دار العين للنشر، القاهرة، ط 2، 2005 (صدر أصلاً في 1999)، خصوصاً صفحات 13-16 و30 و32 و33 و90 و100-108 و112 و115-117 و123-148 و166-189.

ولا يلتفت الجابري، وخصوصاً أمين، إلى أنّ ما يسمّى خصوصيّاتنا وتقاليدنا إلخ… إنّما سبق أن سمعناه حرفيّاً يتشدّق به رجعيّو ودينيّو أميركا وأوروبا، ولا إلى أنّ إحلال التنمية محلّ الإصلاح والتنوير هما بعض ما حاولته الأنظمة العسكريّة والأمنيّة لعقود. وهما لم يُجريا أيّة محاولة قابلة للتعاطي الجدّيّ مع المشكلة، كالتمييز بين إصلاح وتنوير قد يكونان مرفوضين أو غير ملائمين وإصلاح وتنوير مطلوبين. وهذا ما يمنح القارىء إحساساً بأنّ الكاتبين كانا يغتنمان الفرص السياسيّة التي تلوح (هزائم، احتلالات…) لإعلان كسر هذا القيد الثقافيّ الثقيل والتحرّر منه، ومن ثمّ «العودة إلى صفوف الجماهير». فهذا الإحساس بالثقافة كقيد إنّما يعبّر عن البَرم بمصدرها، أي برابطة الأبّوة التي يراد قتلها فيما يستحيل، مرّة بعد مرّة، هذا القتل.
فكما أنّ سوء الأب لا يصدر عنه إلاّ النتاج الثقافيّ السيّء الذي يوالي المثقّفون التطهّر منه، عبر النحر الذاتيّ لثقافيّتهم، فإنّ إسباغ الإطلاقيّة الرديئة على ذاك النتاج يعزّز إطلاقيّة السوء التي يتّصف بها مصدره الغربيّ.
وقد غذّى هذا الميلَ المُراجِع، بل المتنصّل، كتّاب غربيّون، يساريّون وغير يساريّين، هم أحفاد فكريّون للكتّاب الغربيّين الذين بكّروا في مناهضة الغرب جملةً وتفصيلاً. فهؤلاء، مثلاً، جدّدوا الاعتراض على الكيفيّة الثقافيّة كما مارسها بعض المثقّفين العرب في الحقبة الكولونياليّة، فحاكموا، من هذا الموقع، المقاربات التاريخيّة لمسائل القوميّة والاستقلال قبل 1948، كما صاغها الرموز الذين «ظهروا في سياق الإمبرياليّة الليبراليّة».أنظر: jens Hanssen, ‘Albert’s World: Historicism, Liberal Imperialism and the Struggle for Palestine, 1936–48’, in: Jens Hanssen & Max Weiss, Arabic Thought Beyond the Liberal Age: Towards an Intellectual History of the Nahda, Cambridge, 2016, p. 63.وتأخذ مساهمة أخرى للمؤرّخ البريطانيّ بايلي على حوراني أنّه «كان شديد الحرص على أن يجد في الفكر العربيّ أصداء للإيديولوجيا الأوروبيّة كما رآها في المفكّرين الذين درسهم، فيما كتب أقلّ عن أولئك الذين نأوا بأنفسهم عن التقليد الغربيّ الكلاسيكيّ عبر استدعائهم الأفكار الإسلاميّة».C.A. Bayly, ‘Indian and Arabic Thought in the Liberal Age’,نفس المصدر، ص. 326. والحقّ أنّ مساهمات الكتاب كلّها من جنس الحوار «التصحيحيّ» النصوح مع كتاب حوراني.
ذاك أنّ رفض اشتغال الجيل الأقدم بموجب الكيفيّة الثقافيّة يكمّل هذا الرفض في الحاضر وفي تناول ذاك الحاضر، ممّا نراه في نقد شعبويّ رائج للمثقّفين كنخبويّين يقيمون في «أبراج عاجيّة». ولا يكتم نقد كهذا رغبة أصحابه في أن لا يكون المثقّفون مثقّفين، وأن لا يلتزموا بالمعايير الفنّيّة والتقنيّة التي يُفترض أنّها تلازم الحقول والمجالات التي يعملون فيها، ودعوتهم، من ثمّ، إلى مزيد من الالتحاق بالبنية السياسيّة السائدة والامّحاء فيها، وهو ما تزداد حدّته وترتفع وتيرته في مراحل الاحتدام السياسيّ والنضاليّ.في لبنان مثلاً، ومع قيام الثورة الإيرانيّة في 1979، تأسّست فرقة مسرحيّة أسمت نفسها «الحكواتي»، وفي 1984 تأسّس «مسرح الحكواتي» في فلسطين. فالمؤدّى العمليّ لهذا النقيق الدائم حول انفصال المثقّف، أو انسلاخه، عن الشعب والسياسة، هو مطالبته بالتحوّل إلى جنديّ، أو، في ظلّ تفشّي الراديكاليّات الدينيّة المقاتلة، إلى شيخ.
وهذا إنّما عبّد، ويعبّد، الطريق أمام «أفكار» أقلّ حذلقة، إنّما أكثر شيوعاً، في قراءة تاريخنا الثقافيّ، تنتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ. ولئن كانت المواقع الأشدّ صلة بالإسلاميّين هي الأنشط على هذا الصعيد، فإنّ تلك «الأفكار» لا تقتصر بتاتاً عليها.
فنقرأ مثلاً تعريفاً بالفنّ التشكيليّ العربيّ يقول: «كان طبيعيّاً أن يحاول المستعمِر نشر ثقافته وفنّه؛ فانتشرت أساليب الفنّ الغربيّ في البلاد العربيّة، وأنشئت المدارس والكلّيّات لتدريس الفنون التشكيليّة بالطريقة الغربيّة. وعملت الدول الأوروبيّة على إرسال الفنّانين التشكيليّين البارزين في الأقطار العربيّة التي كانت تستعمرها، ليدرسوا الفنون هناك بتعمّق. وعاد هؤلاء ليقوموا بالتدريس في مدارس الفنون وكلّيّاتها وأكاديميّاتها».موقع المعرفة.
أمّا ما أُخذ على المنفلوطي وأدبه من «بكاء»، فله أيضاً تفسير «وطنيّ» يقول إنّ «عصر المنفلوطي كان يعاني الكثير على يد الاستعمار وأعوانه، وقد التأم في نفس المنفلوطي بؤس أمّته ببؤس نفسه، فتحوّل بوقًا لهذا البؤس يبكي في كتاباته ويئنّ».روضة علي، المنفلوطي أديب البؤساء والأشقياء، الجزيرة نت، 4/5/2020. مقابل هذه التأويلات في المادّة المكتوبة، يسود في التداول الشفويّ، الشعبيّ، ميل متصاعد إلى الترحّم على الاستعمار يشبه النكتة في النظريّة الفرويديّة، بمعنى أن نسخر من أمر رمزيّ، كالموت أو العمل أو الزواج، يستحيل تغييره أو زحزحته، بحيث تريحنا النكتة ممّا يقلقنا ولا نستطيع حياله شيئاً.
وهذا، في عمومه، عالم فقير، يطرد الثقافيّ والنقديّ ويسيّس، على نحو كاريكاتيريّ، كلّ ما تقع عليه اليد والعين. وهو لا يكتفي بنبذ الوسائط والكيفيّات، الثقافيّة وغير الثقافيّة، التي تحظى بدرجة من الاستقلاليّة، بل يقدّم الإنسان العربيّ نفسه كمجرّد آلة سياسيّة وحربيّة لا يردعها أيّ شرط إنسانيّ عن طلب «النصر» على «العدوّ».آخر صياغات هذه النزعة تعبير «المثقّف المشتبك»، وانتعاش استخدام فعل «اشتبك» و«يشتبك» كوصف للتحاور أو المناقشة أو التداول في الرأي إلخ… وهنا أيضاً تُستأنف مسيرة التخفيف من ثقافيّة المثقّف وضبطها، حيث سبق أن عرفنا «المثقّف الثوريّ» و”المثقّف الملتزم»، قبل أن نحتفل بـ «المثقّف المشتبك».
إلى الماضي دُر
تتجسّد إحدى نتائج سقوط الكيفيّة الثقافيّة، والنظر إلى الصراع مع الغرب كصراع إطلاقيّ عابر للأزمنة ومن جوهريّ الأمور، في التمركز حول الماضي، ومركَزة النقاش حوله. وهو ميل لا يخفي تفضيل البشر كما كانوا في الماضي، سكّاناً لا مواطنين، وتفضيل الأرض حين كانت سيبة وخلاء مفتوحاً، أقرب إلى الطبيعة من جهة، وإلى المدى الإمبراطوريّ من جهة أخرى، لكنّها حصراً لا تستقيم مع واقع الدولة – الأمّة.
والحال أنّه مع تعاظم الاستعانة بالفكر الغربيّ المناهض للغرب، لم يعد التمركز حول الماضي ما كانه قبلاً. فقد تراجع الافتخار بذاك الزمن المقدّس وبرجالاته عمّا كانت الحال مع المثقّف القديم، وهو غالباً إسلاميّ، فيما تقدّم البحث المحموم عن الاشتباك حول المسألة الاستعماريّة وتوسيع رقعة الاشتباك بلا نهاية أو حصر. ولم يعد المثقّف العربيّ بالتالي يردّ على «صانعه» الغربيّ بخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبيّ، بل بات أشدّ تعويلاً على العلوم التاريخيّة والنظريّات الفلسفيّة، وربّما الاكتشافات الأثريّة، للفوز بمعركة الماضي والتثبّت هناك.
وما دام الحاضر المحلّيّ، ممثّلاً بالسلطتين السياسيّة والدينيّة، يوالي طرد هذا المثقّف وامتهانه، زادت فوائد التثبّت على الماضي الصراعيّ الذي قد يرفع قيمة المثقّف وجدواه في نظر السلطتين المذكورتين.
ذاك أنّ إحدى الخِدع الكبرى التي خدعتها السياسة للثقافة، في عموم «العالم الثالث» وليس في العالم العربيّ فحسب، كانت تضخيم مسألة الماضي الاستعماريّ واستعادته بوصفه ماضياً لا يمضي.
فكلّما ارتفعت نسبة التركيز على المسألة هذه في بلدان كالجزائر أو الصين أو سواهما كان المغنم السلطويّ الاستبداديّ من ورائها أكبر وأثمن. مع هذا، فالمثقّفون أنفسهم، ممّن يدفعون بعض أثمان تلك الأولويّة الزائفة، هم الذين تعهَد الأنظمة إليهم بهندسة تلك المسألة حين لا يتبرّعون طوعيّاً للقيام بذلك.
وتنحطّ ثقافة المماحكة هذه بحيث تندلع مثلاً نقاشات ساخنة ودوريّة بين فرنسا والجزائر، كان آخرها حول جماجم المقاومين الجزائريّين إبّان الاستعمار الفرنسيّ التي استعيدت من فرنسا، ومدى مطابقتها «المعايير العلميّة».أنظر مثلاً لا حصراً، جريدة القدس العربيّ، 6/12/2022.
وما لا شكّ فيه أنّ مسائل الماضي الاستعماريّ تترك عدداً من المسائل والرضّات العالقة، خصوصاً متى ارتبطت بالاستيطان أو العمالة المهاجرة ممّا يساهم في ترهين الماضي. لكنّ من الواضح أيضاً أنّ مدى النجاح الإنجازيّ في الحاضر، الذي يحرزه المستعمَر السابق، يبقى العنصر الأهمّ في تقرير الحجم الذي تحتلّه المسائل تلك. فلا الهند ولا إيرلندا الجنوبيّة ولا فيتنام تساجل في موضوع الماضي الاستعماريّ وترسِّخه، بمعنى مفهوميّ وبإيقاع تكراريّ كما تفعل الجزائر، وهي كلّها بلدان أرفع إنجازيّةً من الأخيرة، فضلاً عن كونها عانت من القسوة الاستعماريّة ما لا يُستهان به، ولا تزال تربطها هموم الهجرة والعمالة مع المتروبولين السابقين الفرنسيّ والبريطانيّ، فيما الحالة الإيرلنديّة تحديداً بدأت على هيئة استيطان مبكر أطلقه، منذ أواسط القرن السابع عشر، كرومويل والبيوريتانيّون الإنكليز ولا يزال الشمال الإيرلنديّ حتّى اليوم يتخبّط في معالجة ذيوله ونتائجه.
ولا تفوت أيضاً ملاحظة ازدهار هذا السجال حيث الديمقراطيّة ضعيفة أو معدومة، وارتباط ذاك الازدهار بأزمات سياسيّة أو اقتصاديّة، لا صلة لها بتاتاً بالماضي، بين حكومتي المستعمِر السابق والمستعمَر السابق، فيما كثيراً ما يكون المحرّض على تلك الأزمات ضغط يمارسه الطرف الأوّل على الثاني في ما خصّ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.
بيد أنّ التمركز حول الماضي يمكنه، في زمن الهويّات المحتدمة كزمننا، أن يسحب كلّ شيء آخر نحو ذاك الماضي، وليس فقط العلاقة بالغرب. تندرج في هذا الإطار اليقظة المتواصلة منذ عقود على الخلاف السنّيّ الشيعيّ والموقف من الصحابة إلخ…، أو التنبّه المشحون بالحساسيّات إلى العلاقات القديمة بين مِلل منطقتنا ونِحلها (مسلمين ومسيحيّين، عرب وأكراد أو أتراك أو فرس…). ودائماً ما يترافق ذلك مع تطييف قطاع عريض من المثقّفين العرب أقلّه في المشرق، فيما تفترض النظرة النبيلة والتنويريّة للثقافة أنّها الفضاء الأشدّ تحصيناً حيال الطائفيّة وباقي النزعات الهويّاتيّة. فحصر سؤال العلاقة بالغرب في البعد الصراعيّ المغلق إنّما يساهم في إضعاف العناصر الذاتيّة التي كان يسعها أن تواجه العصبيّات المحلّيّة، خصوصاً وأنّ الغرب يخوض تجارب الانتقال إلى مجتمعات تعدّديّة بعد عقود مديدة على نزع الاستعمار. لكنْ فوق هذا، وضدّاً عليه، غالباً ما يتسلّح هذا التطييف المتعاظم بتولّي المثقّفين أنفسهم التخفيف من وزن الطائفيّة و/أو استنتاجها حصريّاً من تأثير غربيّ ما (الاحتلال، السوق الرأسماليّة، الثقافة الحديثة…).
والمسار هذا ليس عربيّاً فحسب، إذ بات يمكن الاستدلال عليه في أنحاء كثيرة من العالم، متفاوتة على أصعدة شتّى. لكنّ الانفجار الهويّاتيّ والماضويّ، كائناً ما كان مسرحه الجغرافيّ، إنّما ساهم ويساهم في تعزيز الوعي الأصوليّ بوصفه إحدى علامات الانسحاب من الحداثة ومن ثقافتها، ومن العالم والراهن بالتالي. وهو ميل يستند إلى مقدّمات قويّة في الثقافة السياسيّة العالمثالثيّة سابقة على الصحوة الدينيّة، أقلّه بدليل فكرة «البعث» وحزبه بوصفهما صياغة ماضويّة للسياسة والصراعات السياسيّة، لا سيّما مع الغرب.
ولأنّ قطاعاً عريضاً من الحداثيّين العرب آثرَ عدم تطوير كيفيّة ثقافيّة للتدخّل في الشأن العامّ، فهذا ما سهّل طريق الإسلاميّين وطريق الانقلابات العسكريّة القوميّة في آن، جاعلاً كسب معركة الماضي بديلاً عن الاندراج في تحدّيات الحاضر والمستقبل.
ومبكراً كان الاستظلال بالتراث والكتابات التراثية، ولو بصيغ وأشكال بليدة ورثّة، أحد تعابير التبرّوء من الإرث الثقافيّ الغربيّ والإشكالات التي يتعامل معها. فلم تكفّ الوجهة هذه عن التنامي في موازاة أحداث سياسيّة صاخبة كهزيمة 1967 أو عمليّة «القاعدة» الإرهابيّة في الولايات المتّحدة في 2001، ثمّ غزو الأميركيّين العراق في 2003. وهي وجهة لا تجد لدى الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة، الكارهة لضغط حقوق الإنسان الصادر عن الغرب «الإمبرياليّ»، غير المودّة والتشجيع.مرّة أخرى تجد هذه الوجهة ما يكمّلها في إيديولوجيّات الصواب السياسيّ القصوى في الجامعات الغربيّة، والتي تحفّزها أفكار «الهيمنة» الغرامشيّة مصحوبةً بالدفاع عن ديكتاتوريّة الفضيلة و”تنظيف” التاريخ من أحداثه ورموزه التي لا تلائم تصوّراتنا في الحاضر. إحدى هذه الجماعات المكافحة للاستحواذ على الماضي يسمّيها الفرنسيّون اليوم بالـWokism، أي التنبّه لمكافحة أشكال التمييز، العرقيّ والجنسيّ…، التي عرفها الماضي، ممّا يتلازم مع محو موادّ معرفيّة وإسكات أصوات مختلفة إلخ…
هذا الهوى الماضويّ الكاسح والمثقل بمناهضة الحداثة، بذريعة مناهضة السياسات الغربيّة، يجد أحد تعابيره المدهشة في تأثّر مثقّفين حديثين، مناهضين للإمبرياليّة، بمثقّف إسلاميّ كالجزائريّ مالك بن نبي. فالأخير، وبما يدغدغ النرجسيّة الجريح، أخرج التاريخ الإسلاميّ كلّيّاً من الاستعمار لأنّ العهد الإسلاميّ كان «في الواقع تجربة من نوع جديد في تاريخ علاقات الشعوب. فنحن لا نرى الحكم الإسلاميّ قد استَعمر، بما في هذه الكلمة من معنى مادّيّ منحطّ، بل كان فتحُه لبلاد كجنوب فرنسا وإسبانيا وأفريقيا الشماليّة، لا لاستغلالها، ولكنْ لضمّها لحضارة إسلاميّة في الشام أو العراق». وهكذا فالإسلام «لم يكن يعمّ البلاد كدين، بل كحضارة»، أمّا الاستعمار الغربيّ، في المقابل، فـ«يريد منّا أن نكون أفراداً تغمرهم الأوساخ، ويظهر في تصرّفاتهم الذوق القبيح، حتّى نكون قطيعاً محتَقراً يسلّم نفسه للأوساخ والمخازي». لكنّنا، مع هذا، نستجيب لما يريد أن يفعله بنا الاستعمار، وهذه هي «القابليّة للاستعمار» التي ضجّت بالاستشهاد بها كتابات المثقّفين العرب. وما المفهوم البائس هذا، الذي استحقّ كلّ ذلك الضجيج الاحتفاليّ، سوى مقالة في آخر كتابه لا يتعدّى عددُ صفحاتها عددَ أصابع اليد الواحدة، وفحواها أنّ «القضيّة عندنا منوطة أوّلاً بتخلّصنا ممّا يستغلّه الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته من حيث نشعر أو لا نشعر».مالك بن نبي، شروط النهضة، دار الفكر، 1986، الصفحات 148، 153، 154. على الغلاف يُذكر اسم عبد الصبور شاهين بوصفه مترجم الكتاب، وهو خطيب جامع عمرو بن العاص في القاهرة، والمعروف بترجماته لبن نبيّ وترويجه عربيّاً، كما أنّه صاحب التقرير الشهير الذي أوقع بنصر حامد أبو زيد. لكنْ في الصفحة 3 يضاف إليه اسم عمر كامل مسقاوي، وهو وزير وموظّف لبنانيّ سابق ونائب رئيس المجلس الإسلاميّ الأعلى. الكتاب صدر بالفرنسيّة في 1949.

قضايا وبشر، غائيّة وتجريب
ما يضاعف فداحة التمركز حول الماضي أنّ الفكر السياسيّ العربيّ السائد لم يبذل جهداً ملحوظاً حيال المسائل الحيويّة في العلاقة الراهنة مع الغرب، خصوصاً منها ظاهرة اللجوء والهجرة المليونيّة من بلدان العالم الإسلاميّ إليه. فالاكتراث بالظاهرة يكاد يقتصر على ناشطين ومتطوّعين يواجهون المشكلات اليوميّة، إلاّ أنّ الاشتغال النظريّ لم يلحظ، إلاّ في الحدّ الأدنى، تسهيل اندراج هؤلاء الضحايا في المجتمعات الأوروبيّة، هم الوافدون الجدد إليها، والتصدّي، في الوقت نفسه، لبعض الأفكار والعلاقات المحمولة معهم من البلدان الأصليّة والمعيقة لاندراجهم هذا، كما للأفكار والقوى الشعبويّة والشوفينيّة الكارهة للأجانب في أوروبا.
وأغلب الظنّ أنّ استراتيجيّات التحريك المتواصل للماضي، ونكء جراحه بسبب ولا سبب، تضرّ أكثر كثيراً ممّا تنفع على هذا الصعيد، ومعها تتبدّى «الذاكرة» تذكّراً كمّيّاً، علماً بأنّ التذكّر هو نفسه ذاتيّ ومتضارب المصادر والسرديّات، لكنّها حكماً لا تغدو تأمّلاً نوعيّاً في التاريخ، تأمّلاً يُخبرنا بحقيقة ما حصل ويحاول قطع الطريق على تكراره.
لقد أخذ المثقّف البريطانيّ الأميركيّ توني جدت على المؤرّخ الماركسيّ أريك هوبسباوم أنّه، رغم أهميّة تأريخه وألمعيّته، ظلّ عالقاً في الثلاثينيّات ولم ينجح في التخلّص من المقولات المانويّة القديمة التي ساوت الخير والشرّ بثنائيّات يسار/يمين وشيوعيّ/فاشيّ وتقدّميّ/رجعيّ، فمنعت هوبسباوم من رؤية حقائق وتحوّلات أخرى في عدادها حالات التشابه الممكنة بين الفاشيّة والشيوعيّة السوفياتيّة في ما خصّ علاقتهما بالمواطنين.TONY JUDT, REAPPRAISALS: REFLECTIONS ON THE FORGOTTEN TWENTIETH CENTURY, PENGUIN, 2008. pp. 125-126.
ويكمن أحد مصادر هذه النزعة في تفضيل الأفكار، التي يُفترض أنّها خيّرة، على البشر في حياتهم وتجاربهم ومصالحهم. فالأفكار عذراء ونقيّة، وينبغي أن تبقى هكذا، فيما البشر مشاع ووسائل، يُترك تدبّرهم للأقوياء على اختلافهم. وفي حالتنا تحديداً، يغدو الدفاع عن الإسلام وفلسطين أهمّ من الدفاع عن المسلمين والفلسطينيّين الذين لا تملك مآسيهم الوزن الذي يملكه التذكير بـ«قضاياهم»، وكثيراً ما يكون مطلوباً تأبيد المآسي بما يضمن تأبيد القضايا وتعزيز مصالح المستفيدين منها.دفع النظام الأمنيّ والعسكريّ في مصر الناصريّة وامتداداتها، وفي سوريّا الأسديّة خصوصاً، هذه الاستراتيجيّة خطوة أبعد، إذ بات ينفّذ بيده تدمير الإسلاميّين والفلسطينيّين والتشدّد في الدفاع عن الإسلام وفلسطين. وإذا كان «المسلمون» و«الفلسطينيّون» يلتقون في المشترك الإنسانيّ مع سائر البشر، فإنّ «الإسلام» و«فلسطين» يفصلانـ«نا» عن أديان وبلدان وقضايا، ويرفعان قضايا«نا» إلى سويّة الضدّيّة المثلى التي تتجوهر في ضدّيّتها. وبالمعنى نفسه لا تعود مهمّة العمل لتسهيل اندراج مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين في بلدانهم الجديدة في أهميّة التذكير بمعركة ميسلون، أو مذبحة دير ياسين، أو ربّما استعادة جماجم المجاهدين الجزائريّين من فرنسا.
أمّا كون المثقّف العربيّ أكثر انشداداً إلى القضايا وإلى السياسات المعبّرة عنها، ولو بتزويرها، أكثر ممّا إلى الكيفيّة الثقافيّة، فيجعله أشدّ تعلّقاً باليقين والثوابت وأقلّ ملاحظةً للتغيّرات والتحوّلات. ففكرة أن الحدث قد يقلب التعريف المسبق رأساً على عقب ضعيفة جدّاً في ثقافتنا السياسيّة التي ترتاح إلى ما نعرف ونعهد وتُقبل عليه، وهو ما يسمّيه علماء النفس «الانحياز التوكيديّ»(confirmation bias) الذي يصعب تذليله. هكذا نجد الدراسات الاجتماعيّة والميدانيّة قليلة وضئيلة التأثير، يُشَكّ بحجم ما تضيفه إلى معرفتنا. أمّا في البلدان التي تحكمها الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة فالخوف السلطويّ من هذه الدراسات ومنعها يقابلهما دائماً ترحيب بالكتابات النظريّة الفخيمة والكلّيّة، إن لم يكن تشجيعها.
وكان إيان ستيوارت، أحد دارسي الفيلسوف والسوسيولوجيّ الفرنسيّ ريمون أرون، قد لاحظ أنّ تعرّف الأخير إلى فكر ماكس فيبر زوّده حسّ الواقعيّة والمسؤوليّة، وساهم في نعيه على المثقّفين الفرنسيّين عجزهم عن التفكير كرجال دولة مسؤولين، أي التفكير «سياسيّاً» بدل التفكير «إيديولوجيّاً»، كما ندّد بافتقار أولئك المثقّفين (والسياسيّين) إلى الخبرات التقنيّة والاقتصاديّة.Iain Stewart, Raymond Aron and Liberal thought in the twentieth century, Cambridge, 2020, P. 24 & 40. ومعروف أنّ ليبراليّة أرون لم تكن مهجوسة ببناء المجتمع الجيّد، أي بناء الفردوس الأرضيّ (أو «الحرّيّة الإيجابيّة» بلغة أشعيا برلين)، بل وجدت دافعها في تجنّب الخطر التوتاليتاريّ على الديمقراطية من أعدائها الداخليّين والخارجيّين.
وإذ راجع الفيلسوف التشيكيّ البريطانيّ أرنست غيلنر مانيفستو الفرنسيّ جوليان بندا خيانة المثقّفين، حيث «الخيانة» هي تورّطهم في «الأهواء السياسيّة»، بدل انشدادهم إلى قيم كونيّة جامعة، فقد رأى أنّ بندا، ومملكته «ليست من هذا العالم»، كان ساذجاً في تعاليه على هويّات ومصالح وعواطف محدّدة باسم القيم الكونيّة. فغيلنر، وهو أحد أبرز رموز الدفاع عن القيم المذكورة، لا يرى أنّ تجاهل الواقع ومعطياته والتشبّث بنقاءٍ لا يخالط الأرضيَّ والمُعاش هما ما يقود إليها.أنظر: Daniele Conversi, Ernest Gellner as Critic of Social Thought: Nationalism, Closed Systems and the Central European Tradition, Nations and Nationalism 5 (4), 1999, 515-565. ©ASEN, 1999.
وبدوره يقترح علينا كارل بوبر، فيلسوف العلوم النمساويّ البريطانيّ، أن نفكّر في المسائل والصراعات ممّا لا بدّ أن يطرأ، والتي نستطيع حلّها تباعاً (الفقر، الظلم، المرض، البطالة، العنف، الحرب، البيئة…)، عبر أعمال صغرى، تدخّليّة وتصحيحيّة. وضدّاً على الهندسات الاجتماعيّة الكلّيّة والطوباويّة، يسمّي بوبر نهجه بالهندسة الاجتماعيّة بالتقسيط أو بالتجزئة (piecemeal social engineering). فهي هندسة تدريجيّة وغير منهجيّة أو متماسكة، وهي ليست تطبيقاً لنظام صارم، إذ يقوم نظامها على التجربة والخطأ ويتوسّطه أفراد أحرار يمسكون بكمٍّ من المعلومات والمعطيات التي تجمّعت لديهم. وهو يقارن هذا العمل بعمل المهندس الفيزيائيّ الذي يُحدث تعديلات صغيرة في الآلة ويحسّن طريقة اشتغالها تدريجاً، وبما يشبه نظام التجربة والخطأ الذي يُستخدم في العلوم. فالمهندس الاجتماعيّ بالمفرّق يبلغ أهدافه «عبر تعديلات وإعادة تعديلات صغرى قابلة للتحسين المستمرّ»، وهو «يشقّ طريقه خطوة خطوة (…) ولسوف يتجنّب القيام بإصلاحات ذات تعقيد ونطاق يجعلان من المستحيل عليه فكّ الأسباب عن النتائج».Karl Popper, The Poverty of Historicism, Routledge & Keagan Paul, 1957, pp. 66-7.
ومن دون أن تعني الاستنتاجات أعلاه تبنّياً لكلّ ما تنطوي عليه النُظم الفكريّة للمُستَشهَد بهم، يبقى أنّ هذا الخطّ في التفكير يعلّم التواضع في معرفة التاريخ ومقاربة الاجتماع. وهو ما تندر تعابيره في الفكر السياسيّ العربيّ شديد الانجذاب إلى أنماط الوعي الكلّيّ «المتماسك» وإلغائيّ. ولربّما صحّ افتراض الربط بين النزوع شبه الطاغي هذا وبين عنصرين يقيمان عميقاً في هذا المثقّف وعلاقاته بمحيطه وعالمه:
أوّل العنصرين أنّ التعصّب لإنكار أبوّة الغرب يقود إلى الانهجاس بالتأسيس من صفر، بحيث يعاد الاعتبار، من موقع حديث، لانهجاس المثقّفين القدامى باكتشاف الخصوصيّة والأصالة. وهو ما نراه أيضاً على نحو أكثر جلافة لدى الحركات الدينيّة الأصوليّة، خصوصاً داعش، عودةً على بدء «نظيف» أوّل. وأمّا الثاني فجرعة تعويض نبويّ عن الهامشيّة الفعليّة والاستهانة التي تُنزلها السلطة بالمثقّف. وهنا تندرج معرفة «قوانين التاريخ» والتعالي على التجريب الذي يحمل الأنا على التواضع، وعدم الإقرار بمرجعيّة الواقع بحجّة تعدّد النظرات إليه. والحال أنّه مهما تعدّدت النظرات وزوايا النظر، يبقى أنّ ظاهرات لا تُحصى تتكرّر تحت أنوفنا (انهيارات أنظمة اشتراكيّة، حروب أهليّة، مسارات مسدودة لقضيّة فلسطين إلخ…) وتناشد المثقّفين أن يستخلصوا منها معاني محدّدة يأبون أن يستخلصوها، مفضّلين التفكير نطحاً.
بالعودة إلى الإبداعيّ
لا يفسّر ذوبانُ البنية الثقافيّة العربيّة في البنية السياسيّة هامشيّة المثقّف العربيّ على مدى عقود فحسب، ولا ضعف جاذبيّة قضايا«نا»، وضعف البُعدين الثقافيّ والنقديّ اللذين تنطوي عليهما. فهو أيضاً يفسّر تراجع الإبداع لمصلحة التكرار، أو ما يحذّر منه، في إحدى محاضراته، توني جدت الذي سبقت الإشارة إليه. فنحن، والحال هذه، حيال ثقافة تقوم على ترداد العبارات والكليشيهات من نوع «ندعم جيشنا» و«مع الحريّة» إلخ…، وهي عبارات لا تقال لأنّها تحمل معنى بعينه، بل لأنّها تموضع قائلها في مكان مقبول (من سلطة أو أهل)، أي أنّها بمثابة رقابة ذاتيّة واستباقيّة تدلّ على ضعف الثقة بالنفس فيما تطرد سلفاً كلّ شكّ بحمل أفكار وآراء مغايرة. وهذا ما يسمّيه فاكلاف هافل «التواصل الطقوسيّ» وفقاً لنظام وثقافة معيّنين، أي العمل بالطريقة المقبولة التي تجري فيها الأمور.أنظر محاضرة جوت على يوتيوب.
كذلك يفسّر الذوبان في السياسة ظاهرة قد تكون أخطر، مفادها أنّ الضيق الثقافيّ الذي يقود إلى التعريف المُحكَم والملزِم، وإلى أحاديّة في السبب وفي الدلالات، إنّما يطرد أوجه الإبداع الكثيرة التي يُفترض بالحياة الثقافيّة أن تُسفر عنها.
فحتّى لو قبلنا وجهة النظر المتطرّفة التي تربط الإنتاج الثقافيّ ربطاً حصريّاً بالسياسة والاجتماع، وتنفي الثقافيّة عن كلّ إبداع فرديّ «معزول»، فما يصعب قبوله هو أن تنقلب الآية تماماً، فنغدو أمام معادلة مفادها أنّ البيئات الأكثر تشبّعاً بتسييس الثقافة وبـ«عضويّتها» هي إيّاها البيئات التي تسجّل، فضلاً عن تراجع الحرّيّات الثقافيّة، تراجعاً في أوجه الإبداع الثقافيّ. هكذا تصبح سياسيّة الثقافة وصفةً لضمور الأدب والفنّ التشكيليّ والموسيقى والسينما والعمارة إلخ… داخل البيئة المعنيّة.في لبنان مثلاً، وعلى يد «حزب الله» ولفيفه، ازدهرت «ثقافة المقاومة» التي هي خلاصة نقص فادح في كلّ الحقول الثقافيّة والإبداعيّة، إذ المقاومة هذه لم تنتج قصيدة أو رواية أو قطعة موسيقيّة أو فيلماً سينمائيّاً…
وكان الروائيّ المصريّ إبراهيم عبد المجيد قد تناول أثر هذه العلاقة على العمارة والتخطيط المدينيّ، متوقّفاً عند مدى التعبئة ضدّ «الاستعمار» التي تلقّاها أفراد جيله في الخمسينيّات، ليلاحظ أنّ المذبحة المتمادية والمستمرّة التي طالت العمارة والطرق والحدائق لم تكن من صنع الاستعمار، علماً بأنّها «الوجه الماديّ للثقافة في أيّ حضارة أو مجتمع». فالنهضة المعماريّة التي بدأت منذ القرن التاسع عشر كـ«نهضة متأثّرة بأوروبا بعد سفر البعثات للتعليم في فرنسا»، باتت تتعرّض «إلى عشوائيّة لم تحدث تحت حكم الاستعمار الذي تخلّصنا منه».إبراهيم عبد المجيد، هل كانت الأشجار والعمارة إرثاً ثقافياً للاستعمار؟، جريدة القدس العربيّ، 16/9/2022.
ولا بدّ في الختام من ملاحظاتٍ ثلاث تحاول أن توضح ما لم تنجح الأسطر أعلاه في إيضاحه، وأن تشير إلى ما لم تُتَح الفرصة للإشارة إليه:
فأوّلاً، ليس استخدام الحقبة الممتدّة من ثلث القرن التاسع عشر الثالث إلى نهاية النصف الأوّل من القرن العشرين زمناً للقياس مُطالَبةً بالعودة إلى ذاك الزمن. فما من مهجور يُعاد إليه، زماناً كان أم مكاناً. أمّا المطلوب فإقرار مزدوج: بأنّ ذاك الزمن (حيث سادت الإمبرياليّة ثمّ «الرجعيّة» المحلّيّة) شهد بدايات تطوير للكيفيّة الثقافيّة الخاصّة في التدخّل الثقافيّ بالشأن العامّ، وهو ما كان يمكن الافتراض بقابليّته للنماء والتطوّر لو لم يؤدّ الصعود الراديكاليّ إلى وأده.
وثانياً، أنّ الإيديولوجيّات الكبرى تراجعت فعلاً في العالم العربيّ، كما في سائر العالم، فيما نشأت تراكيب واهتمامات ثقافيّة مستجدّة. لكنّ هذا لا يعني أنّ العوارض القاتلة التي تحدّثنا عنها قد ولّت. ذاك أنّ التركة القديمة لم تغادر الساحة، وقد نجحت، في حالات كثيرة، في التسلّل إلى الأشكال والتعابير الجديدة. يكفي استرجاع مواقف أعداد هائلة من المثقّفين العرب، ومن سائر أجيالهم، من مباريات مونديال فيفا وقطر لكرة القدم (2022) للتأكّد من ذلك.
وثالثاً، تذهب هذه الأسطر إلى أنّ ما من تذليل لأزمة الثقافة والمثقّفين في المشرق العربيّ دون تذليل مشكلة العلاقة مع الغرب، وتالياً مع الذات ومع المهنة ممّا صاغتهما الثقافة الغربيّة، ووحدهم المثقّفون من يستطيعون أن يلعبوا دوراً مركزيّاً هنا، هو الوجه الآخر لدورهم المركزيّ المطلوب دفاعاً عن الحرّيّة، حرّيّتهم هم بالدرجة الأولى.







