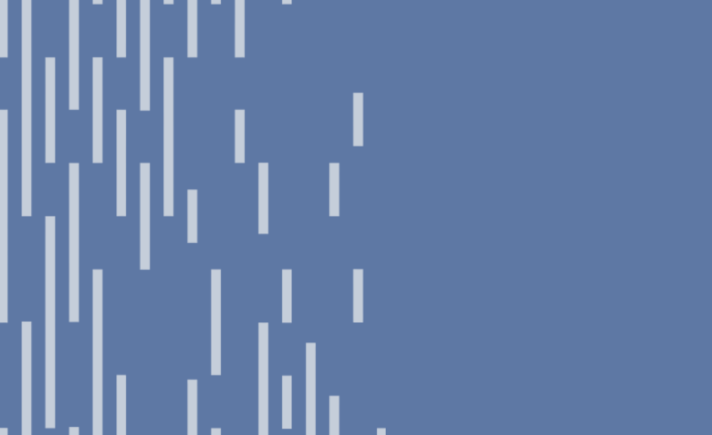عندما اعتلى الشيخ أسامة الرفاعي المنبر في مدينة أعزاز شمال سوريا، وحَذَّرَ جمهور المؤمنين من أخطار ما تجلبه المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، خصوصاً تلك المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، من ويلات على «أخلاقنا» و«عاداتنا»،«إن المنظمات والمشاريع التنموية يدعون إلى تمكين المرأة وحريتها وضلالها والتعري والجندرة». هكذا حرفياً قال الرجل! فإن الرجل لم يفعل إلا ما هو مُتوقَّع منه وممّن يحملون قناعته نفسها. أولئك الذين نصَّبوا أنفسهم «حرّاس فضيلة» يرون أن الحياة، لولا تدخلهم، كانت ستتحول إلى حفلٍ داعرٍ كبيراخترتُ استخدام كلمة أورجي في العنوان، والمقصود هو «Orgy»، أي حفلة للعربدة المتفلتة من كل قيود أو اعتبارات. تُمارس فيه كلّ أشكال الفسق والفجور بلا أي حسيب أو رقيب.
ليست المرة الأولى التي يوجه فيها «خطابٌ» كهذا إلى جمهور المؤمنين، وعبر منابر المساجد، في عموم سوريا والعالم الإسلامي. جرت العادة، بل ورُبّينا منذ نعومة أظفارنا (مسلمين مسيحيين أو يهوداً، أو أي شخص وُلد في وسط يخضع لدين أو عقيدة محددة بحيث كان عليه أن يمر عبر كامل تعاليم تلك العقيدة أو الدين)، على أن الحياة كانت لِتكونَ غابة لولا رحمة ربِّنا الذي منَّ علينا بنعمة دينٍ يهدينا سَواء السبيل. المشكلة أن الحياة نفسها في أماكن مختلفة من العالم، أخذت لاحقاً مناحٍ لا يطبعها التدين، ومع احتواء الدين نفسه بصفته جزءاً من حرية الاعتقاد المصونة لجميع الأفراد، فصارت أكثر إنسانيةً وازدهاراً، وبكثير، من الحياة في تلك الأماكن التي ما زالت تعيش في ظل تلك «النعمة» المرفوعة فوق رؤوس الجميع بصفتها خيار «النجاة» الوحيد المتاح أمامهم.
ولكن، نجاةٌ ممن؟! وهل كانت الحياة فعلاً ستتحول إلى غابة، أو حفلة «أورجي» كبيرة، لولا تلك «النعمة» وحُرَّاسها؟! وما هو الدافع الذاتي (الذي يأخذ حالة أشبه بالوسواس القهري في معظم الحالات) عند «حراس النعمة» للقيام بمهمتهم بهذا الحماس منقطع النظير؟! كل هذه الأسئلة تقفز إلى الذهن دفعة واحدة، ما أن يعتلي شخص… لنقل شديد الحماس، كَلَّفَ نفسه بـ «مهمة مقدسة»، منبراً ويبدأ بتحذير الناس من الهاوية التي يتجهون إليها دون أي دراية، ولا حتى وَجَل.
وحتى لا نَقع في شُبهة حصر وجهة النقد هذه باتجاه أتباع ديانة واحدة؛ الإسلام على وجه التخصيص، بل وبسكان منطقة جغرافية واحدة أيضاً؛ العالم الإسلامي، فإن هذه السمة: «حراسة الفضيلة» واضحة الانتشار بين أتباع الديانات التوحيدية كلها،الحديث هنا يتناول الديانات التوحيدية على وجه الخصوص، وهذا بسبب أن كاتب هذه السطور لم يتَّسنَ له الاطلاع على «النزعات المهيمنة» في ديانات أخرى غير توحيدية. وفي كل في العالم، بما فيها المناطق الموسومة بكونها «الأكثر تطوراً». لم يمض وقت طويل بعد «فِعلة» الشيخ الرفاعي، حتى فاجأتنا المحكمة العليا الأميركية، المتجهة يميناً بسبب تعيينات ترامب قبل رحيله عن الرئاسة، بـ «فِعلة» تقع ضمن مجال مهمة «الحراسة» نفسها بنزعتها الوصائية الطاغية: القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإبطال حكم أساسي في قضية حملت اسم (رو ضد وايد) بشأن الإجهاض.
ردة الفعل في الولايات المتحدة، التي أعقبت ذلك القرار، ومن جهة أنصاره بالذات، لم تَدَعْ مجالاً للشك لحظةً بأننا أمام «العقلية» ذاتها التي نَصَّبت نفسها «حارسة للفضيلة»، ولو أن «الفضيلة» قُدِّمت هنا بصفتها دفاعاً عن «حق الحياة» دفعة واحدة! حيث جوهر الوصاية، في كلا الحالتين أعلاه، أسامة الرفاعي ومايك بينس،نائب دونالد ترامب خلال فترة رئاسة الأخير، وأشدّ المتحمسين ضد تشريع الإجهاض. بل إن هذا الأمر يعتبر أحد البنود الأساسية في البرنامج السياسي الذي يتبناه التيار المتدين الذي يمثله السيد بينس. بقي واحداً.
الجدل الذي ثار هناك، بين مؤيد ومعارض، والجدل الذي أثارته تصريحات الشيخ الرفاعي، عندنا، والجدل الذي تثيره أية أفعال أو أحكام أو تصريحات مشابهة، في أي مكان في العالم، خصوصاً بعد دخولنا في عصر السوشَل ميديا، بما تعنيه من دمقرطة لوسائط التعبير، بدأ هذا الجدل يُلقي الضوء بوضوح وكثافة على تلك العقلية الوصائية التي باتت مُعرضة للمُساءلة أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، فإن عبارة «من أنتم؟!» هنا يمكن أن تنزل في موضعها الصحيح، عندما تكون موجهة إلى من يريد فرض تلك الوصاية، وليس من يريد التخلص منها. تدعي هذه السطور أنها تحاول الإجابة على هذا السؤال.
يمكن الافتراض، كمقدمة لمحاولة رسم بروفايل يمكن فهمه بشكل أو بآخر، أن ما يجمع مايك بينس بأسامة الرفاعي أكثر من أن يحصى. بل إن محاولة رسم هذا البروفايل الشخصي لكِلا الرجلين، قد تمر غالباً على عدة نقاط تقاطع وتشابه كثيرة.بينما توجد سيرة موثقة للمايك بينس وموضوعة بإشرافه، نفتقد كليا إلى سيرة مشابهة لأسامة الرفاعي. باستثناء ما ذكر عن والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي لا نكاد نعرف شيئا عن نشأة أسامة الرفاعي سوى أنه ربي في كنف رجل دين معروف في الأوساط المتدينة التقليدية في مدينة دمشق. ما يعنينا هنا هو تلك النزعة «الوصائية» الواضحة عند كلا الرجلين، وعند كل من حاول أن يلعب دور حارس للفضيلة أو مُنافح عنها من أي موقع كان.
بالاستناد إلى عيش بعضنا، ومنهم كاتب هذه السطور، في بيئات محافظة، أو قريبة منها، يمكننا محاولة تلَمُّس من أين يمكن أن يأتي المسعى الحثيث الذي يبذله شخص ما لفرض وصايته على محيطه المباشر، أو أبعد منه، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، مُسلّحاً، غالباً، بمرجعية فوق بشرية. الرغبة بالسيطرة، وهي غريزية عند الإنسان، يكون أحد أسبابها الرئيسية والأكثر إلحاحاً هو الافتقاد إلى الشعور بالأمان. هناك دائماً «تهديد» ما عليه أن يحاول إسكاته. عند البعض، هذا لا يمكن أن يتأتّى إلا بالمزيد من السيطرة. ولكن من أين يأتي هذا التهديد؟
في ظلِّ حالةٍ عامة من الإحساس بعدم الأمان، طَبعت الحياة المعاصرة للبشر في كوكبنا في الوقت الراهن، وفي ظل أزمات متتالية طرحتها طبيعة الأنظمة السياسية القائمة، بما فيها الأنظمة الديموقراطية الأكثر تطوراً وانفتاحاً، فإن الحديث عن مصادر التهديد يصبح من نافل القول هنا. القائمة في هذا الموضوع قد تطول. وهو، في كل الأحوال، ما حاول تغطيته ما ورد حتى في عشرات المقالات، والأبحاث، والكتب التي يمكن أن تتناول هذا الموضوع. وفي مثل هذه الحالة، يصبح من المطلوب، ومن الجميع، الانخراط في الشأن العام وإبداء الآراء وطرح ما يمكن تَصوُّره من حلول. هذا حق للجميع، بما فيهم الرفاعي وبينس. ولكن أن تُبدي الرأي في أمر تجد أن من حق الآخرين أن يكون لهم أراؤهم فيه، التي تختلف عن رأيك، شيء؛ وأن تتمسك بفكرة أن رأيك هو الأصح وهو الوحيد «المُنجي من الضلال»، مع استخدام هذا الإصرار لتعزيز مشروع هيمنة سياسية عبر تكريس سلطة محددة، فهذا شيء آخر تماماً. مصدر هذا التعنّت لا يعود فقط إلى الشعور بتهديد ما، أو افتقار للإحساس بالأمان. إنه ذلك الإحساس العميق بالعزلة عن الآخرين لِعلَّةٍ ما في شخصية المَعني، وبأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يُنصت الآخرون إليه من خلالها هو بفرض رأيه عليهم. إنها في حقيقتها افتقارٌ إلى الحد الأدنى من الثقة بالنفس، وبالتالي انعدام تلك الثقة عندما يتعلق الأمر بالآخرين. من هنا فإن التزود بـ «مرجعية فوق بشرية» يصبح مما لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق هذا المسعى.
المعزول، لا يمكن أن يرى العالم إلا من خلال زاويته الخاصة في القوقعة التي فُرضت عليه، أو فرضها على نفسه، لأسباب مختلفة. يمكن أحياناً للرؤية من خلال هذه الزاوية أن تشير إلى أمر في غاية الخطورة أو العمق يقود الجميع إلى رؤية مختلفة للنفس، أو للحالة البشرية في عمومها. هنا يمكن للعزلة أن تُولِّدَ إبداعاً،من الأمثلة كافكا في مجمل أعماله. ديستويفسكي من خلال تناوله لهكذا شخصيات: راسكولنيكوف في الجريمة والعقاب. كما يمكن للمعزول أن يرى العالم كله بصفته مكاناً معادياً بكل تفاصيله لا يستقيم العيش فيه، وبالتالي فإن الخيار سيكون إما المزيد من العزلة إلى درجة التلاشي والموت، أو الهجوم لتغيير هذا العام ولو بحد السيف. في هذه الحالة تقود العزلة إلى الكارثة، على صاحبها أو على العالم الذي يريد تغييره.
الفارق بين الحالتين، الإبداع والكارثة، هو أمر واحد فقط: القدرة على الحب. وهذا الحب لا يمكن أن يولد إلا من ذرة بسيطة، ولو ذرة واحدة، من الثقة بالنفس وبأن المعني يمكن أيضاً، بل ومن حقه، أن يُحَبّ.
ليس في نيَّة هذه السطور شنّ هجومٍ شخصي على الرفاعي وبينس، بقدر ما هي معنية بفهم بضع خلاصات يمكنها أن تُشير إلى حالة التهديد الفعلي الذي يُمثِّله «الفكر» الذي يحمله كِلا الشخصين تجاه العالم كله. هذا «الفكر» يرى العالم، بدون تدخل «مؤمنيه» لتقويم اعوجاجه، عبارة عن غابة يعيش الجميع فيها في حالة قصف وعربدة لا نهائية. ولأن المرأة بالذات، محجبة أو ممنوعة من تملُّك جسدها، تحتل مكانة مركزية في هذا الفكر، وهي بهذا مكمن الخطر الحقيقي عند «مؤمني» هذا الفكر، فإنه يصحُّ في هذه الحالة السؤال: أليس هذا الحرمان اللئيم، الذي فرضه «المؤمنون» على أنفسهم، هو منبع كل تلك التهيؤات؟! طبعا المقصود هنا هو الحرمان العاطفي، حيث كثيرٌ من «المؤمنين» لا يحرمون أنفسهم من تعدد الزوجات، حسب الشريعة الإسلامية، أو العرف المورموني مثلاً.طائفة المورمون المسيحية المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها. ولكن التعدد هنا يظهر بالدرجة الأولى بصفته جنساً، أو إشباعاً جنسياً، حيث الجنس ليس حباً بالضرورة، والحب ليس كله جنساً؛ إذ من المتعذر، جداً، افتراض وجود علاقة حب سوية في هذا الازدحام! حتى ولو كان التعدد، ذكوراً وإناثاً، مفتوحاً بالكامل، بمعنى عدم وجود ذكر وحيد،هناك أنماط جديدة من العلاقات الجنسية باتت منتشرة مؤخراً في أوساط واسعة، أوروبا وأمريكا بشكل رئيسي. الجنس الجماعي. وهذا له نشاطاته ومنظميه المعروفين، وقد تناوله الإعلام بشكل موسع مؤخراً وسلط عليه الكثير من الضوء. هناك من يسعى فعلاً للانخراط في هذا النوع من اللايف ستايل ولكن كبحث عن شيء جديد، دون وعود كبيرة. المثير أن كثر ممن انخرطوا في هذه الأجواء يصرون، من خلال مقابلات معهم، على أن الحب أمر آخر. هم انخرطوا في هذه التجربة من أجل المتعة أو تحفيز الجانب الجنسي من العلاقة بين حبيبين لا أكثر. إذ أنه في هذه الحالة، يعود الجنس ليطغى (نصبح أقرب إلى حالة الـ «أورجي») بعيداً عن شعور عميق بحاجة إلى خصوصية كاملة لينمو ويزدهر ويأخذ ملامحه التي تعطيه فرادته- بدون تلك الفرادة لا يعود حباً. الزواج المتعدد، إسلامياً كان أم مورمونياً، هو في حقيقته تشريع للإباحة الجنسية (أورجي شرعي) تحت سيف العقيدة، لا أكثر. يمكن أن يتزوج الواحد مئة امرأة، أو العكس بالمناسبة، إن وجدت شريعة تبيح هذا الخيار للنساء، ولكنه، رجلاً كان أو امرأة، يمكن أن يبقى محروماً عاطفياً بشكل كامل. ربما الاندفاع الشبقي عند البعض مردُّه، في أحد أسبابه، إلى حالة الحرمان العاطفي هذه والبحث عن تعويض ما. هذه ليست مجرّد فرضية، بل يمكن ملاحظة الأمر بوضوح، إن كان في محيطنا، أو حتى على أنفسنا.
الحقيقة أن الحياة شيء آخر يختلف تماماً عما يتوَهَّمه «حراس الفضيلة». الحياة، خصوصاً في جانبها العاطفي، وبما يتعلق بالجنس الآخر أو بالجنس نفسه حسب رغبة طرفي العلاقة وتفضيلاتهما، هي مشاركة. والمشاركة قبل أي شيء آخر، وأهم من أي شيء آخر ، هي مسؤولية. هل نحن جديرون بتحمل مسؤولية خياراتنا، وأهمها العاطفية والحميمية، والمضي فيها إلى النهاية؟ هنا السؤال. حارس الفضيلة أبعد شخص عن فكرة المسؤولية وما تُلقيه من تبعات على صاحبها، وما تفتحه أمامه من أفق. إنه «عبد»..المرجعية فوق البشرية التي يتبناها حارس الفضيلة (حتى بوتين نفسه يتبنى هذه المرجعية ويستند إليها عند الحاجة) تُحيل دائماً إلى عبودية يريد (حارس الفضيلة أو الجلاد، لا فرق) من الجميع مشاركته إياها. هو يقدم نفسه هكذا، بل ويتباهى بهذه الصفة. وعالم يقوده «عبيد»، لن يصل أبداً إلى بر أمان.