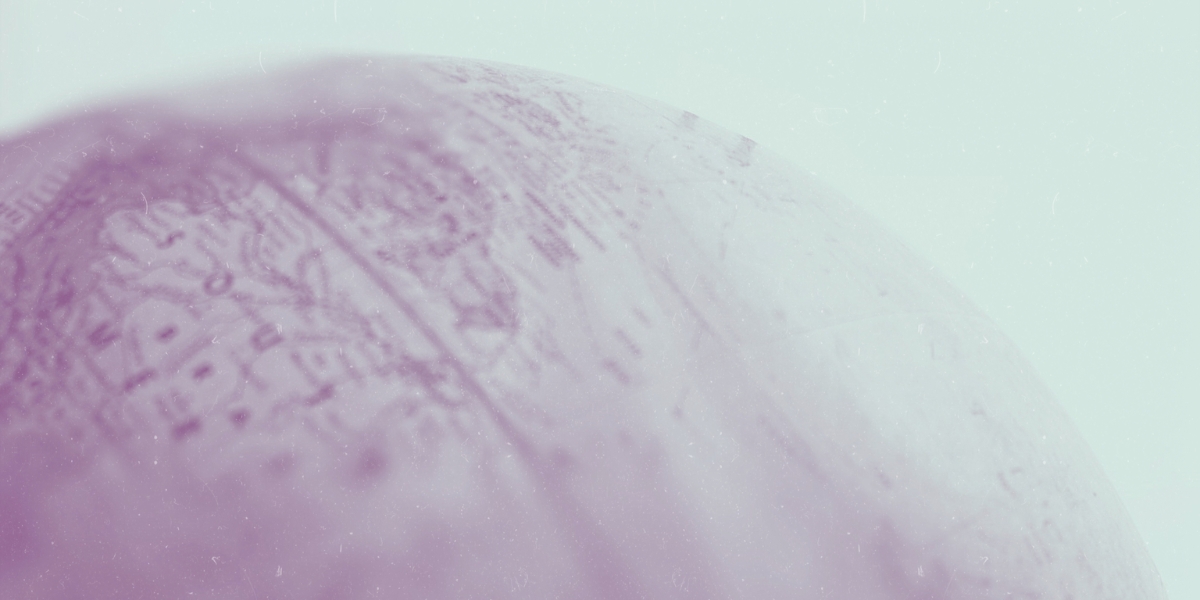في هذا التناول للإحساس وقلّة الإحساس بما يحدث لغيرنا، قد يتوجب البدء من الجهة التي أَنحدِرُ منها من العالم: الشرق الأوسط، قبل محاولة قول شيء عن الشأن نفسه من جهة أوروبا التي أعيش فيها منذ نحو خمس سنوات. العالم ليس إطارَ حساسية متكافئة، ليس جسماً يعمل كوحدةِ حساسية، وإن تكن ثورة وسائل الاتصال تَشدُّهُ إلى بعضه، على نحو ما سهّلت «رأسمالية الطباعة» تَخيُّلَ أمم أوروبا، بحسب نظرية بندكت أندرسون. معلومات أكثر لا تعني شعوراً أقوى بالضرورة، يحتاج الأمر إلى معرفة لا تتحصّل من المعلومات بحد ذاتها، وإلى معرفة شاعرة، مُوجَّهة نحو التضامن والشراكة، وليس معرفة سيادية مُوجَّهة نحو السيطرة والتحكم.
أوروبا مرئية أكثر وتَرى أكثر، تتكلم أكثر وتُسمَع أكثر، تجول في العالم أكثر وتفعل أكثر وتُؤثِّرُ أكثر، وتكتب أكثر وتقرأ أكثر، ويُثار السؤال عن إحساسها أكثر بفعل كونها رائية ومرئية أكثر من غيرها. هذا ينطبق بتفاوت على الغرب كلّه، على الولايات المتحدة أكثر حتى من أوروبا. ولشدة وطول أمد أُلفة الأوروبيين والغربيين بالقوة، بأنهم مرئيون ومؤثرون، فقد طوروا كذلك حسِّاً بالأُلفة حيال لومهم ونقدهم على ما يرون ولا يرون، على ما يقولون ولا يقولون، على انتقائية الإحساس والتضامن. صار هذا مكوناً للذات الأوروبية، يجري التعامل معه بتسامُح القوي الذي يعلَم أن تسامُحه لا يمسّ علاقة القوة بينه وبين من يتسامح باختلافهم معه ونقدهم له، بل هو في الواقع تعبيرٌ عن هذه العلاقة ونِتاج لها. يحرك هذه السطورَ طلبٌ للمساواة وليس التِماسُ التسامح الإمبراطوري.
لقد أخرجت الثورة السورية المُحطَّمة طلبَ المساواة من التجريد إلى نطاق التاريخ الفعلي، بقدر ما أسهمت كذلك في جعل عدد أكبر من السوريين مخاطبين للعالم المعاصر، محاورين وناقدين له.
1
في جهتنا من العالم (سورية، العالم العربي، الشرق الأوسط) نحن مرئيون أقلّ ونَرى أقل، نتكلم أقل ونُسمَع أقل، نكتب أقل ونقرأ أقل، حَواسُّنا أقل نمواً من تلك الحواس الصناعية التي تطورت في الغرب، أعني الصحف ووسائل الإعلام ودور النشر، والفضاءات العامة عموماً. يمكن التفكير في الفضاءات العامة بوصفها نوافذ للحساسية مثلما الحواس نوافذنا على العالم. وتُعززها حركيةٌ أوسعُ نطاقاً لنسبةٍ من الغربيين أعلى بكثير ممّا لدينا. يُعززها كذلك عالم تمثيل وأخيلة غنيّ، أدبي وفني وفكري، يساعد نسبة أعلى من الأوروبيين والغربيين عموماً على الشعور بأنهم في بيتهم في العالم اليوم. بفضاءات عامة ضيقة ومُراقَبة، وبحركية محدودة، وبعوالم خيالية محدودة بدورها، يشعر كثيرون منا، أكثرنا بالفعل، بأنهم غرباء في بلدانهم ذاتها.
لقد كان أحد أوجه النضال السوري خلال جيلين؛ الامتلاك النشط للفضاءات العامة، وأولها الشوارع، وقد أُحبِطَ هذا النضال بحربين أهليتين، الأخيرة منهما مستمرة منذ 11 عاماً ونيّف، وهناك سلفاً أدبيات لا بأس بها تتناول جوانب منها، لكن خيرَ من دَرَسَ الأولى هو ميشال سورا في كتابه الدولة المتوحشة.أحيل إلى الترجمة العربية الصادرة عن الشبكة العربية للأبحاث بترجمة أمل سارة ومارك بيالو، وتقديم برهان غليون، بيروت، 2017.
كيف نتفاعل والحال كهذه مع ما يُحتمَل حدوثه من كوارث في بلدان الغرب تُصيب أهلها؟
بقدر ما يمكن تَبيُّنه، هناك عاملان أساسيان في تحديد الحساسية من جهتنا بما يحدث للأوروبيين. أولهما حِسٌ كان منتشراً بتفاوت حتى وقت قريب بأن أوروبا وبلدان الغرب عموماً بعيدة، بدلالة للكلمة يلتقي فيها الجغرافي والنفسي والثقافي. البُعد يعني أنه لا تأثير لنا على ما يحدث هناك من أشياء سيئة، وليس لنا بالتالي أن نهتم، أي نحمِل همّ، معاناة الأوروبيين المحتملة.
بيدَ أن عامل البُعد الذي كان صحيحاً جغرافياً لنحو جيل أو أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد صحيحاً منذ عقود. فسواء بفعل ثورة وسائل الاتصال التي يُقال أحياناً إنها زامنت العالم فألغت تفاوت الأمكنة، أو ما سبقها من اتساع نطاق حركية أعداد متزايد من السوريين والشرق أوسطيين، أو حديثاً بفعل طفرة اللجوء التي حدثت بعد الثورة السورية وفي سياق سحقِها، صارت أوروبا أقرب من أي وقت سبق. هنا يتدخل العامل الآخَر: المظلومية النشطة في جهتنا من العالم حيال الغرب، وهي عامل تبعيد ثقافي ونفسي. الظلم والتمييز الذي عانى منه عربٌ ومسلمون على يد قوى غربية حقيقيٌ ومستمر بصور مختلفة، وإن لم يكن السبب الأهم، دعَ عنك أن يكون الأوحد، لبؤس الأحوال في حيِّزنا من العالم. لكن المظلومية ليست تقريراً موضوعياً عن الظلم، وإنما هي سردية تُضفي على الظلم طابعاً نسقياً ومستمراً، متصلاً على نحو وثيق بما يكون الغرب وما نكون نحن، وليس بعوارض التاريخ وصراعاته التي يمكن تَجنُّب بعضها وتخفيف وقع بعضها.
ومع النسقية، ثمة افتراض ضمني بأن ما نكون وما يكون الغرب هو ثابتٌ أو قليلُ التغير. وبفعل تكوينها هذا، ترسو المظلومية اليوم على أساس الهوية التي توفر نقطة التباعد الأقصى مع الخصم: الإسلام، وفي تأويله الأشد حصرية واستبعادية: السلفية. لم يكن الحال كذلك دوماً. قبل عقود فقط، فكرت القطاعات الأنشط من العرب بأنفسهم كعرب يتطلعون إلى التقدم والشراكة في الحضارة المعاصرة. هذا التطلع تحطّم عبر حروبٍ وأزماتٍ متكررة، وعبر تكوين استبداديّ وإمبراطوريّ للتعبيرات السياسية عن النحن العربية، مناقضة كلياً لواقع الحال التَبَعي والضعيف. التعبيرات الإسلامية مُماثلة في هذا الشأن، وهي سائرة نحو فشل أكيد بفعل التكوين الفُصامي ذاته.
المظلومية تدفع المظلوميين، أعني من يعرِّفون أنفسهم بموقع الضحية الدائمة، إلى الانعكاف على أنفسهم وتوقع أن ينالوا اهتمام ورعاية غيرهم، وليس أن يهتموا هم برعاية الغير. كأن ما يحدث في المظلومية المترسخة هو درجة الإشباع من الظلم الذي «يعمي القلب» على ما يقول تعبير شعبي سوري، فيفقد المرء كل إحساس بغيره. الهولوكوست كركيزة أساسية لوعي الذات الإسرائيلي مثالٌ ناطقٌ في شأن «عمى القلب» هذا. لا يَحول الإشباع بالظلم دون الانتباه لمعاناة الغير، بل يحدث أن يسوِّغ التسبب بمعاناتهم باسم ما سمّاه زغمونت باومان «مظلومية وراثية»Z. Baumann: Modernity and the Holocaust, Polity, 2015, P 236-240. لأجيال الإسرائيليين الحالية.
لدينا في الجهة العربية والإسلامية مظلومية وراثية تحمل في ثناياها خبرة الاستعمار، الذي يقوم هنا بما يقارب دور الهولوكوست في الوعي اليهودي الإسرائيلي، ويلقى التعزيزَ من استمرار الوضع التابع من الجهة العربية. ويَحول من وجه آخر دون التضامن مع الغير، أي دون تَشكُّل إطار حساسية مشترك، جسم من نوع ما. التخيُّل ينصرف هنا إلى خلق التباعد لا التقارب، عبر تغذية شتّى الصور التي تضفي عليـ«هم» خارجية تامة.
إلى جانب الوضع التابع، إسرائيل هي الوسيط الآخر الذي يُبقي خبرة الاستعمار حية، إن عبر استعمار فلسطين وعبر نيلها دعم المستعمرين الغربيين السابقين، أو عبر تمكُّنها بفضل هذا الدعم الاستثنائي من هزيمة العرب في أي مواجهة عسكرية تكون الدول أطرافاً فيها، ما حكم على دُوَلنا أن تكون منقوصة السيادة منذ حرب عام 1973. ثم أن احتلال إسرائيل لفلسطين ومقاومة الفلسطينيين لها هي ما يبدو أنها ترفع الطلب على سياسة الذاكرة المتمركزة حول الهولوكوست والمظلومية الوراثية من جهة عموم اليهود الإسرائيليين. هنا تظهر الحاجة إلى عدم الإحساس بمعاناة الغير عبر الاستحضار الدائم لمعاناة الذات. الإلحاح على فرادة الهولوكوست بمعنى جوهريّ يُمكن أن يُفهَم كمقاومة لاندراج الهولوكوست في التاريخ، والتفكير فيه علائقياً وسياقياً ومنظورياً كما يجري التفكير في كل ما هو تاريخي. الفرادة ترفع الهولوكوست فوق التاريخ وتجعل منه الجريمة المطلقة، أي «ديناً مدنياً»،حول الهولوكوست كدين مدني، انظر مقالتين ترجمتهما ونُشرتا في الجمهورية.نت في تموز من العام الماضي، الأولى مقالة إنزو ترافيرسو: لا، ألمانيا ما بعد النازية ليست مثالاً طيباً للتفكير عن الماضي. والثانية مقالة ديرك موسز: العقيدة الألمانية (وكان أنسب لو أني ترجمت العنوان: الديانة الألمانية). يُولِّدُ مثل كل دين الهراطقة والكفار و«الحرم». تديين الهولوكوست يمكن أن يُفهَم كاستراتيجية تصفيح للنفس بدرع ديني- هويتي سميك. والنفوس المُصفَّحة لا تتشارك ولا تتضامن. لقد حصلنا سلفاً على دين فتيّ، يَعِدُ منذ الآن بما لا يقل عمّا تسببت به الأديان التاريخية من مآس وآلام.
ومعلوم أنه كدين مدني، ثم كأساس لسياسة الذاكرة فيما يخص اليهود، وبالنتيجة الفلسطينيين، الهولوكوست هو العنصر الأساسي في تحديد موقف ألمانيا من إسرائيل، وبالنتيجة فلسطين. في مطلع شباط (فبراير) من عام 2011 قالت السيدة أنجيلا ميركل في جامعة تل أبيب إن إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية هي من علل وجود ألمانيا.هنا في هذا الرابط نسخة إنكليزية لكلمة ميركل. هذا يعني أن إسرائيل كنفي لفلسطين أو عدمٍ لها هي من علل وجود ألمانيا، أي أن ألمانيا تضع وجودها ذاته في علاقة عدم مع فلسطين، وستكون أي معاناة فلسطينية شيئاً مؤسفاً في أحسن الأحوال، وإلا فهي شيء طيبٌ من أجل جودة وجود ألمانيا المشروطة بأمن وسيادة إسرائيل.
2
يجري الكلام هنا سلفاً على محدِّدات قلة الحساسية في أوروبا لما يجري من معاناة سياسية في الشرق الأوسط. ليست أوروبا ألمانيا مُكبَّرة ولا المجالُ العربيُ هو فلسطينُ مُكبَّرة، لكن لا يبدو أن هناك ديناميات في العلاقة بين المجال العربي وأوروبا والغرب بعامة تُعاكِس الأثر المتراكم لذاكرة الاستعمار ولإسرائيل، الأثر الذي يلقى التعزيز بالعكس منذ نحو ثلاثة عقود من خبرة الحرب ضد الإرهاب. وخلافاً للتحليل السائد الذي يَشتَقُّ الإرهاب من الإسلام، أو من تكوين إسلامي ثابت في عدائه للغرب وللحداثة، أرى أن الإسلام ذاته يُنتَج على نحو يسوّغ العدمية النافية للعالم، عدمية تتغذى بالتأكيد من أوضاع جمعية متّسمة بالتمييز والمهانة والضعف واليأس.
أساس الإرهاب كترجمة سياسية للعدمية الإسلامية هو نقص سيادة الدولة كتحقق سياسي تاريخي للمجتمعات، أي عجزها عن الدفاع ضد معتدين أجانب، الأميركيين والإسرائيليين وشركاهم، علماً أن الاعتداء، وصولاً إلى الاحتلال الاستيطاني، هو من الوقائع المتواترة في خبرتنا التاريخية الحديثة والمعاصرة. الدين، الإسلام، ينهض بالعبء الذي لا تنهض به الدولة: الحرب ضد العدو وداعميه، لكن ليس قبل أن يُعاد تشكيله هو ذاته ليتهيأ بأمثل صورة للقيام بهذه المهمة. السلفية الجهادية هي إنتاج لإسلام الحرب بقدر ما هي حرب الإسلام. من أجل التكيُّف مع أوضاع حربية لا تستجيب لها الدولة يُستنفَر الإسلام الفاتح، إسلام مُؤمثَل ومؤسطَر انحدرَ إلينا من إطار إمبراطوري تَكوَّنَ بسرعة بعد ظهور الدعوة المحمدية.
الإسلاميون إمبرياليون بلا إمبراطورية، والإرهاب هو وليد هذا التناقض من جهة، والحاجة الدفاعية الحيوية من جهة ثانية. أو أن الحاجة الدفاعية تستدعي المخيلة والذاكرة الإمبراطوريتين، تستمد منهما النموذج. ما لدينا هنا هو التقاء مقاومة الكولونيالية والإمبريالية بتكوين لاهوتي إمبريالي هو ذاته، على نحو يلغي أولاً بأول المضمون التحرري المحتمل لمناهضة الإسلاميين للإمبريالية. ليست التكتيكات الإرهابية هي سبب الإلغاء إلا جزئياً، فهذه التكتيكات وليدة تلاقي الضعف بالشعور بالحق، بل السبب هو التكوين الإمبريالي للإسلامية المعاصرة.
ثمة تناقض آخر مكوِّن للإسلامية المعاصرة: النموذج الذي تُحيل إليه قديم، لكن الانفعال الذي تتغذى منه راهن جداً. السلفية الجهادية هي الصيغة الأكثر تصلباً وحرفية من التعاليم الإسلامية، ممزوجة بالغضب الأكثر راهنية وعصرية. التصلب بدوره يلغي الكوامن التحررية الممكنة للغضب.
العدوّ القريب المستهدف بالغضب هو الدولة المحلية المستبدة التي لا تقاوم عدواً ولا تترك أحداً يقاوم، ولا حتى يتشكل كفاعل سياسي مختلف. والدولة من جهتها تعوِّض عن عجزها، أي عن نقصها السيادي في المجال الدولي، بإظهار وجه سيادي في الداخل، أي تصريف طاقاتها الحربية في داخل مجتمعاتها. وعلى هذا النحو تظهر بوجهين مثل جانوس. وجه سياسي مُوجَّه نحو الخارج الدولي، تتعامل معه بالسياسة والتفاوض والمساومات المتنوعة، ووجه داخلي كوكالة عنف تمنع المحكومين من امتلاك السياسة، الكلام والاجتماع والتنظيم، أي من أن يصيروا مواطنين، وتعاملهم كأتباع بلا حقوق، ولن تلبث لتسويغ ذلك أن تتبنى خطاب الحرب ضد الإرهاب ذاته الذي طورته القوى الإمبريالية والمراكز الكولونيالية السابقة. وهي بذلك تنزع شرعية تمرِّد قطاعات متمردة من المجتمعات المحكومة، وتحرم جميع سكانها من الحقوق السياسية من جهة أولى، ومن جهة أخرى، وهنا وجهها الثاني، تنال شرعية مبدئية من مؤلفي الحرب ضد الإرهاب في الغرب.
الدولة العربية المعاصرة سيدة في الداخل وسياسية في الخارج، وهي بهذه الصورة استمرار للكولونيالية بوسائل أخرى، يغلب أن تكون أشد وحشية على ما رأينا في سورية منذ بداية الثورة، وعلى ما نرى اليوم في مصر منذ انقلاب السيسي في صيف 2013. وعلى ما نرى حتى بخصوص السلطة الفلسطينية التي تبدو بعد نحو ثلاثين عاماً من أوسلو أقرب إلى استمرار محلي لإسرائيل منها للكفاح الفلسطيني. وبهذا التكوين، الدولة العربية الشرق ـ أوسطية المعاصرة هي مقلوب نموذج الدولة- الأمة الحديثة، السيدة في المجال الدولي والسياسية في الداخل. هذا الواقع البنيوي للدولة يقود غريزياً إلى طلب الحماية الأجنبية وقت الأزمة. «سورية الأسد» هي أتم أشكال الاستمرار البنيوي للاستعمار: انتحال رسالة تحديثية تحاكي الرسالة التحضيرية للاستعمار الفرنسي، وترويج حماية الأقليات المهدَّدة إسلامياً مثل الاستعمار الفرنسي كذلك، وتَعامُل مع المحكومين بمنطق الحملات التأديبية، ثم تبنٍّ تام لمنطق الحرب ضد الإرهاب بعد الثورة. هذا التكوين قاد إلى تسليم البلد للإيرانيين والروس كي يدوم حكم العائلة.
والسيد لا يقتل فقط، وإنما يَنتخب كذلك. الشعب ينتخب سلطاته التنفيذية والتشريعية في الديمقراطية لأنه سيد، والسيد العسكري أو العائلي هو الذي ينتخب الشعب، فيقتل الشعب الفائض أو يُهجّره، ليحصل على مجتمعه المتجانس مثلما قال بشار الأسد في آب (أغسطس) 2017. يمكن التفكير في لجوء نحو سبعة ملايين سوري، أي ما يقترب من 30 بالمئة من السكان، كنتاج عملية الانتخاب التي قام بها السيد. بشار الأسد يوصف بالفعل من قبل إعلام نظامه، الإعلام الوحيد الموجود في سورية، بأنه «سيد الوطن».
التحول الكولونيالي للدولة بنيوي، وجذوره سابقة حتى للثورات العربية. وهي تمتد في تعثر تحويل الدولة الاستقلالية إلى دولة مواطنة وحقوق بين سبعينيَّات القرن العشرين وتسعينيَّاته، وقت بدأت بالظهور أولى الحركات والمنظمات المناضلة من أجل الديمقراطية، بعد جيل واحد من الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي. منذ ذلك الوقت تحولت دول عربية أساسية من دول غير ديمقراطية، تسلطية وقمعية بمقادير، إلى دول تُحكم بالمجازر والتعذيب والسجون، ويقوم عليها حكام لا يتغيرون. حين بدأت الثورات العربية كان القذافي يحكم ليبيا منذ 42 عاماً، والسلالة الأسدية في حكم سورية منذ 41 عاماً، وعلي عبدالله صالح في حكم اليمن منذ 33 عاماً، ومبارك يحكم مصر منذ 30 عاماً، وزين العابدين بنعلي يحكم تونس منذ 25 عاماً.
3
لكن ماذا يعني تحول الدولة إلى استمرار للكولونيالية بأيدٍ محلية؟ يعني أن التحرر الوطني، تقرير المصير، أي الاستقلال الأول، يضيع إن لم يتحقق الاستقلال الثاني، التحول نحو الديمقراطية وطَيُّ صفحة الطغيان. هذا ظاهر جداً في سورية، حيث طلبت السلطنة الأسدية حُماة أجانب كي تستمر في الحكم في مواجهة انتفاضة شعبية واسعة القاعدة، وَصَفتها منذ وقت مبكر بالإرهاب وفقاً لما هو متوقع. ثم إن تصاعد «استعمارية السلطة» بتعبير أنيبال كويجانو،تنظر مقالته الأساسية بهذا العنوان: Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. وتَعثُّر الاستقلال الثاني وضياع الاستقلال الأول ذاته، يشكلان الإطار لتراجع ما أسميه الاستقلال الثالث والأساسي: الاستقلال عن السماء، أو الإنسانية والدنيوية كأساسَين للعلمنة. فضلاً عن القيام بالوظيفة الحربية الدفاعية (وإن أخذت شكلاً هجومياً)، شكَّلت الإسلامية إطاراً للتحقق السياسي لقطاعات اجتماعية حُرمت من التحقق بأية أشكال أُخرى. وتدرجها صفتها الإسلامية في سياق تاريخي طويل، يتعارض كلياً مع نظم الأبد التي أشرت إليها للتو، وهي أنظمة لا يتطلع حكامها إلى ما يتجاوز دوام حكمهم «إلى الأبد»، أي العيش في سجن حاضر أبدي، ما يقتضي من أنظمة منقطعة عن أي عمق تاريخي خوض حرب مستمرة ضد المستقبل. لكن الإسلامية تغذي نموذج التبعية الإلهية المضاد للحرية. نحن اليوم في أوضاع أشد قسوة على مستوى الاستقلالات الثلاثة، فكأننا عُدنا قرناً كاملاً إلى الوراء.
ويعني ترابط الاستقلالات الثلاثة، على خلفية كولونيالية الدولة، أن قضايا الديمقراطية وتقرير المصير والعلمانية لا تُعالج دون إعادة نظر أوسع في البنى الجغرافية والثقافية والسياسية لتَوَزع الدول الراهن. سورية التي تتقاسم جغرافيتها إيران وتركيا وإسرائيل، ومعها روسيا وأميركا، فضلاً عن كونها مساحة لصعود الشيعية العالمية وأفول نظيرتها السنية، ليست إطاراً لا مناص منه للدمقرطة والعلمنة والاستقلال. قضايا الشرق الأوسط مترابطة، وتتعذر معالجة أي منها بمعزل عن إطار يشمل المشرق والجزيرة العربية والعراق ومصر وتركيا وإيران، وبالطبع فلسطين- إسرائيل.
ثم إن في كون الدولة استمرار محلي للكولونيالية ما يشرح تفضيل المؤسسات الغربية نمط الدولة القائم في منطقتنا، وليس الإسلاميين بطبيعة الحال، ولا المجموعات الديمقراطية التي تعرضت لتشتيت مديد، ونَدُرَ أن نالت دعماً وتعاطفاً من القوى التي تعرِّف نفسها عالمياً بالديمقراطية. القوى الغربية التي لم تعد علاقتها بالسكان في بلدانها تسير وفق نموذج السيادة مثلما بيّن ميشيل فوكو، صدَّرت ماضيها السيادي إلى خارجها الاستعماري الذي لم يهتم به فوكو. والسيد يَنتخب مثلما تقدم القول. لا نفهم النظم السياسية الشرق أوسطية دون التفكير في العلاقة بين انتخاب السيد الغربي، الأميركي بخاصة، للحكام الصحيحين، وانتخاب الحكام الصحيحين لشعبهم الصحيح. تنتج الدولة المتحولة كولونيالياً سلعة عزيزة في الغرب الذي يريد أن يحمي نمط حياة مُرفّه، ممتنع على التعميم العالمي: الاستقرار. هل يحصل الاستقرار بالإنتاج الواسع للخوف والموت؟ بانتخاب الشعب الصحيح وتهجير الشعب الخطأ وإبادة قسم منه؟ تفضيل الاستقرار قاد إلى الموافقة على التوسع الروسي في سورية، وهو ما قاد بدوره إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وخسارة الاستقرار العزيز. ليس أن هذه سياسة غير أخلاقية فقط، وإنما هي غير مثمرة.
4
مثل كل حرب، الحرب ضد الإرهاب تصنع العدوَّ الإرهابي والصديقَ المحارب للإرهاب، وقد كانت أساساً لتحالفات من أسوأ ما عرف التاريخ الحديث، تحالفات أقوياء جمعت مثلما نعلم الإدارة الأميركية والحكومات الغربية وروسيا بوتين ونظام بشار والسيسي، وإسرائيل طبعاً، ومودي في الهند والحكومة الصينية بمعسكرات التأهيل التي تحتجز مليوناً من المسلمين (مُنتجة طبعتها الصينية الخاصة من «المسلمان» الذي عرفته معسكرات الاعتقال النازية)، وحكومة ميانمار وتقريباً كل حكومات العالم. الدولة اليوم هي احتكار للحرب ضد الإرهاب، وهو احتكار شرعي في كل حال، ولو بُني على التعذيب والاغتصاب. نعوم تشومسكي نفسه ينكر الصفة الإمبريالية على التوسع العسكري الروسي في سورية لأنه جرى بدعوة من حكومة تعترف بها الأمم المتحدة.تنظر الدقائق الأخيرة من هذه المقابلة المصورة، وينظر نقدي لمجمل مقاربة تشومسكي في شأن سورية في هذا الرابط. الأناركي المعروف يضع شرعية يقررها نظام دولي تمييزي وغير ديمقراطي فوق شرعية يقررها سوريون عملوا على امتلاك السياسة في بلدهم. وكل عنف يمارَس في الحرب ضد الإرهاب شرعي بالنظر إلى أن المستهدفين به، الإرهابيون، «مقاتلون غير شرعيين» بحسب الشرع الإمبراطوري الأميركي. ونعلم أن التعذيب أُعيدت ممارسته في الولايات المتحدة، وإن تحت اسم «تقنيات التحقيق المعزز» في سياق هذه الحرب المزعومة. المقاتلون غير الشرعيين لا حق لهم بطبيعة الحال في العدالة ولا في السياسة، لا يقدَّمون إلى محاكمات، ولا يُنظر في معالجات سياسية لمشكلة الإرهاب. بالعكس، في مواجهة مقاتلين غير شرعيين يصير كل شيءٍ شرعياً، ويصير مرتكبو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شركاء في هذه الحرب.
وبما أن العدوّ هو القوة التي من الجيد أن تحدث لها أشياء سيئة، فإن الإرهاب والحرب ضد الإرهاب هما أكثر من دينامية تقليل متبادل من الحساسية حيال ما يُصيب العدو، هما بالأحرى إيذاء شرعي مرغوب.
هذا مُعطى أساسي في تصوري لتفسير المواقف الغربية الفاترة من التراجيديا السورية منذ 2013، وبصورة ما طوال الوقت. هناك طبقتان حديثتان في هذه المواقف. طبقة أقدم مرتبطة بتجارب الكولونيالية وإسرائيل والهولوكوست، وحروب تتكرر كل عشر سنوات في الشرق الأوسط من قبل قائدة المعسكر الغربي أميركا أو إسرائيل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى صعود سردية الحرب ضد الإرهاب منذ تسعينات القرن العشرين، وهيمنتها بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ثم طبقة أحدث تتصل ببدء ظهور تشكيلات عدمية إسلامية نافية للعالم، تعتمد تكتيكات إرهابية، انتشرت وبائياً في سورية في عام 2013 الذي شهد ظهور داعش وما بعده.
حين وقعت المجزرة الكيماوية الأكبر في آب (أغسطس) 2013، كانت الإدارة الأميركية تفكر سلفاً في سورية من منظور الحرب ضد الإرهاب الذي يشرِّع الدولة ولو كانت إبادية، وينزع الشرعية عن مقاومي الدولة، ولو لم يكونوا عدميين. استخدام الأسلحة الكيماوية أكثر من انتهاك للقانون الدولي، إنه ترجمة للمَنازع الإبادية للحكم الأسدي. بفضل الحرب ضد الإرهاب صار الجينوسايد سياسة ممكنة.
سهَّل من ذلك تحول جينوقراطي عالمي،تنظر مقالتي: الإرهاب والإبادة والمنعطف الجينوقراطي، في الجمهورية.نت، 19 أيلول 2019. أعني به صعود الجينوس، الشعب الأصلي أو الأكثرية الثقافية، والحركات التي ترفع الثقافة فوق المواطنة، وهو ما يتوافق مع تقويض الديموس على ما أظهرت وندي براون في كتاب لها بهذا العنوان، وإن كان كتابها يرتب التقويض على الليبرالية الجديدة،W. Brown: Undoing the Demos, Neoliberalism’s Stealth Revolution, Zone Books, New York, 2020. ولا ينشغل بصعود الجينوس. نرى ذلك في كل مكان، في اليمين الشعبوي في أوروبا والتفوقيّة البيضاء في أميركا وهندوتفا مودي والإسلامية في منطقتنا من العالم (وإن من خارج الحكم وضد «الدولة». سورية في هذا الشأن جينوقراطية من نوع خاص، تشغل فيه أقلية اجتماعية ثقافية موقعاً مسيطراً في الدولة) وروسيا المقدَّسة الأرثوذكسية والقيصرية الجديدة، والصهيونية الراهنة التي تطابق مناهضتها مع العداء للسامية. أي جميع الموصوفين بالإرهاب والمشاركين في الحرب ضده. الجينوقراطية ظهور عالمي لثقفَنة السياسة إن جاز التعبير، تحول السياسة نحو قطب الهوية و«الحضارة»، بعيداً عن المواطنة والمؤسسات الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتشترك الجينوقراطية والجينوسايد في التمركز حول الجينوس، على نحو يمكن أن يجعل من الجينوسايد استمرارا للجينوقراطية بوسائل أخرى. ذلك أنه إذا عرَّفنا إسرائيل بالصهيونية العنصرية والتوسعية، وماهيْنا بين الصهيونية والسامية، فستكون كل مقاومة لكيان توسعي وعنصري مجرد استمرار لمعاداة السامية واستحضاراً للهولوكست وتهديداً وجودياً. وإذا عرَّفنا روسيا بالمقدَّسة والأبدية، التي لا معنى لوجود العالم دون وجودها على ما قال بوتين، فسيكون الاعتراض على التوسعية البوتينية تهديداً وجودياً بدوره لروسيا، موجباً لاستخدام السلاح النووي على ما قال الرئيس الروسي بعيد غزوه لأوكرانيا. ينسى كثيرون، بالمناسبة، أن بوتين ألمح إلى احتمال استخدام السلاح النوويعبر بوتين عن أمله في ألا يضطر إلى استخدام السلاح النووي في سورية في كانون الأول من عام 2015، بعد ثلاثة شهور من بدء التدخل الروسي. من أجل تفاصيل أكثر، ينظر هذا الرابط. ضد الإرهاب منذ وقت مبكر من تدخله في سورية. وإذا عرَّفنا فرنسا تعريفاً زِمورياً أو لوبانياً فستنخفض عتبة الإخطار الوجودية، وصولاً ربما إلى ارتداء الحجاب وأسماء المواليد المسلمين، المنَّذرين بـ«إحلال كبير»، على نحو يجعل الجينوسايد مرتسماً في الأفق. وإذا عرَّفنا سورية تعريفاً أسدياً، نصل إلى «الأسد أو لا أحد»، الذي هو شعار لإبادةٍ مورست فعلاً، وقُتل بمحصلتها ما لا يقل عن نصف مليون، مع بقاء المُبيد في السلطة محمياً بقوة توسعية لا تكفّ عن مداعبة فكرة استخدام السلاح النووي. أما إذا عرَّفنا سورية تعريفاً إسلامياً سنياً مثلما يفعل الإسلاميون، فإننا نقوض أي حاجز يَحول دون إبادة غير المسلمين السنيين.
الجينوقراطيون في الغرب وفي الشرق الأوسط وفي كل مكان من العالم يفكرون في المخاطر والتحديات بلغة المناعة، أو وفق باراديغم مناعي بعبارة بيونغ- شول هان، الفيلسوف الألماني (من أصل كوري جنوبي).Byung-Chul Han: Topology of Violence, translated by Amanda Demarco, Massachusetts Institute of Technology, 2018, p 37- 48. الغريب والأجنبي والآخر هو هنا مصدر مرض تتعين مقاومته وطرده أو التخلص منه، وليس حساً مغايراً أو تجربة جديدة نغتني بها. إنه مصدر عدوى، طفيلي أو جرثومة أو فيروس خطر. وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لامَ الأجانب واللاجئين على انتشار فيروس كورونا في بلده. قال في وقت مبكر جداً من الجائحة، 13 آذار (مارس) 2020: «تجربتنا تفيد بأن الأجانب هم من جلبوا المرض، وأنه ينتشر بين الأجانب». لم يكن هذا صحيحاً، الصحيح فقط هو أن التفكير المناعي يناسب أغراض أوربان، القومي اليميني المعادي للاجئين. لكن حتى على أرضية هذا التفكير هناك لاجئون ولاجئون. استقبال اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي في شباط (فبراير) الماضي لا يندرج ضمن النموذج المناعي. زميل أوربان، رئيس وزراء بلغاريا كيريل بتكوف وصف اللاجئين الأوكرانيين بأنهم «أناس أوروبيون، أذكياء، متعلمون. ليسوا مثل اللاجئين الذين اعتدنا عليهم، أولئك الناس الذين لا نعرف شيئاً عن هويتهم، والذين يمكن أن يكونوا إرهابيين».من أجل تصريح بتكوف، ينظر هذا التقرير في القدس العربي. المرض والإرهاب يشغلان مواقع متكاملة في النموذج المناعي. الصحة والأمان كذلك.
نموذج المناعة يُعرِّف عالَماً شميتياً (نسبة إلى كارل شميت)، عالَمَ حدود وجبهات، حرب وصراعات وجودية، عالم البطولة والقتل، القرار لا المناقشة، والدكتاتورية لا البرلمان. السياسة هنا تذوب في الحرب، وليس في تجنب الحرب وفي الحلول السياسية. وهذا هو النموذج الذي ينجذب إليه جينوقراطيو الغرب، ولا يلحظ هان هذا الانجذاب، ويُعطي الانطباع بأن النموذج السيادي لشميت، ومعه نموذج المجتمع الانضباطي لفوكو، قد انطويا لمصلحة ما يسميه هو السايكوباور ومجتمع الإنجاز الذي يستغل الناس أنفسهم فيه، ويكون الواحد منهم السيّدَ والإنسانَ المُباح معاً.
في الواقع، الحرب ضد الإرهاب هي حبل حياة مستمر للجينوقراطية في الغرب. حين يتعلق الأمر بهذه الحرب التي لا بداية لها ولا نهاية ولا تعريف للنصر، وحين يكون كل شريك مقبول، تتجه الفوارق بين الجينوقراطيين وغيرهم إلى التضاؤل. تحالفات الجينوقراطيين الأوربيين مع بوتين لا تقول شيئاً مهماً فقط عن قوى أوروبية معادية للديمقراطية، وإنما هي كذلك، تكشف الأساس الحضاري المناعي لهذه التحالفات.
5
ليس الإرهاب والحرب ضد الإرهاب، وبالتالي إنتاج الأعداء، هي الديناميات الوحيدة الفاعلة في العلاقات بين المجالين الشرق أوسطي والغربي. صحيح أن المرء لا يكاد يلحظ اعتراضاً جبهياً جدياً على الحرب ضد الإرهاب بين المثقفين والنشطاء السياسيين في الغرب، وهذا مؤسف جداً، لكن ليسوا كثرة هم المتطوعون النشطون لترويج هذه الحرب. خارج هذه القلة النشطة يأخذ الأمر شكل لا مبالاة متولدة عن غياب الأفكار الواضحة، أو ضعف الاهتمام بتكوين أفكار واضحة وشاعرة عن منطقة قريبة من أوروبا، وعن العالم بعامة. هذه اللامبالاة تبدو بنيوية، اتساع مساحة اللاوضوح حول شؤون كثيرة، دون أن يكون هناك فاعلو وضوح يعملون على تضييق هذه المساحة. كان اسم فاعلِي الوضوح هؤلاء هو المثقفون، ويبدو هذا الدور في تلاشٍ عام في الغرب. هذا خطر، لأن ما يترتب على عدم الوضوح هو اللامبالاة وسوء تقدير المخاطر المنبثقة من الأوضاع القائمة. بل أسوأ من ذلك، هو القَدَرية. في الغرب يتجه إلى الانتشار ضرب خطر من القَدَرية السياسية، من عدم الثقة بالسياسة، يبدو في علاقة وثيقة مع أمراض الانتباه المنتشرة اليوم في عالم الشاشات والإنتاج غير المادي. ثمة إيقاع سريع، آني، للزمن في هذا العالم، يتوافق مع عدم تغيُّر أي شيء، وليس مع تغير الأشياء كلها كما يبدو للوهلة الأولى. أرى تقارباً بين نشاطية الإرهاب المحمومة والتواصل الاجتماعي المحموم بدوره؛ شكلان تدميريان للفرار من العالم ومن الذات، يؤولان إلى التسليم بالعالم وبالذات في شكلهما الدافع إلى الفرار في الأصل، أي إلى القَدَرية.
بخصوص سورية، أخذَ اللاوضوح شكل لازمة تتكرر طوال الوقت: الأوضاع معقدة هناك! الواقع أنها كذلك بالفعل. لكن يمكن أن نفهم وصف معقد بأنه دعوة إلى تطوير مهم في تفكيرنا والعمل على معرفة أفضل بجذور وبنية الوضع المعقد وعمليات التعقيد، أو يمكن أن يُفهم التعقيد كدعوة لعدم الاهتمام وترويض النفس على العيش في عالم بلا وضوح. لكن يمكن لهذا أن يرفع الطلب على أنبياء الوضوح الزائفين، أن نتبع مرشدين، أشخاصاً نثق بهم، بدل أن نَعرِفَ العالم الذي نعيش فيه بشكل أفضل. هذا خطر بدوره، لأن كل شيء يتجه في عالمنا اليوم لأن يكون معقداً، ولأنه أمكن للمرشدين أن يكونوا من أشباه إريك زمور أو فلاديمير بوتين أو دونالد ترامب.
ثم إنه يجري تطبيع أوضاع العنف والتمييز حين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، على الأقل عبر افتتان وسائل الإعلام بأخبار العنف والموت. وحين لا تكون لدينا نظرية، فإن الدرجة صفر من النظرية تكون جاهزة دوماً: التفسير الثقافوي للعالم. يستقر منطق ضمني يفيد أن الأمور هكذا هناك، عند العرب أو المسلمين، عنيفة دوماً. إن قتل حافظ الأسد لعشرات الألوف وابنه بشار لمئات الألوف فهو من طبائع الأمور. إنَّ ورث بشار أبيه وقلب الجمهورية إلى ملك وراثي في سورية فهو من الطبائع كذلك. بل إن على الغرب ذاته تقبل ذلك. من شأن اعتماد «قواعد حماة» مثلاً، أي قتل عشرين أو ثلاثين ألفاً خلال أقل من شهر في حماه 1982، أن يكون خياراً وجيهاً لتجنب صراع مديد مكلف، مثلما أفتى توماس فريدمان، الذي يشارك معجبيه الكثيرين الإعجابَ بنفسه. وبلغ نيكولاوس فان دام درجة من السادية أنه لا يكف عن الإحالة إلى هذا «المرجع» لدعم خيار مماثل ضد الثورة في سورية، يلوم القوى الغربية على أنها حالت دونه.في كتابه تدمير وطن، وكَرَّر ذلك في عدة مقابلات بالعربية. يقول إنه لولا القوى الغربية لكان نظام بشار قتل ربما 50 ألفاً من السوريين، وما كان ليسقط نصف مليون أو أكثر وتُدمَّر البلد. هذا ليس شخصاً سيكوباثياً، إنه مؤلف كتابين عن سورية، وسفير سابق فيها، ومبعوث خاص للحكومة الهولندية في سورية لبضعة أعوام بعد الثورة. حين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، الجينوقراطية معششة في الحكومات الغربية أياً تكن الأحزاب المشكلة للحكومات. ومعها الشر المبتذل الذي تكلمت عنه حنة آرنت في آيخمان في القدس، شر كبير دون أشرار كبار بالضرورة.
يتعلق الأمر في الواقع بتطبيع، أي بإنتاج ثقافي للطبيعة السياسية والحقوقية للأنظمة في المنطقة على نحو يستفيد منه أمثال السيسي، الذي قال لممثلين أوروبيين تحفظوا على إعدام تسعة مواطنين مصريين في شباط 2019، إن لدينا إنسانيتنا وقيمنا وأخلاقيتنا ولديكم إنسانيتكم وأخلاقيتكم، وطالبهم باحترام ثقافتنا التي لا يبدو أنها تجد بأساً في إعدام الناس خلافا لثقافة الأوروبيين. سيكون ترك علاء عبد الفتاح الذي قضى معظم سنوات السيسي التسعة في السجن، والمضرب عن الطعام منذ مطلع نيسان (أبريل) 2022،أُجبر علاء على فك إضرابه عن الطعام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو لا يزال معتقلاً. سيكون تركه للموت وفاءً لقيمنا وأخلاقيتنا، فيما ستكون حريته خيانة لقيم مصر وثقافتها! هذه إهانة لشعب مصر وللديمقراطيين المصريين، ليست جديدة أبداً على الدولة المتحولة كولونيالياً في منطقتنا. الطبائع المزعومة للاجتماع والسياسة في الشرق الأوسط تجعل أمثال علاء وعموم المناضلين من أجل الديمقراطية غير طبيعيين، أُناساً حالمين أو موهومين. يتراوح الموقف من أشباهنا من غير الطبيعيين بين إنكار فاعليتنا السياسية والمعرفية والأخلاقية، وبين إقرارها لنا كأفراد، مفصولين عن مجتمع وثقافة وتاريخ.
وفضلاً عن التعقيد والتطبيع، هناك البنية السياسية للعالم اليوم. أُطر الحساسية في العالم الراهن قوميةٌ أو حضارية، هذا بينما أُطر الحدوث عالمية. فما يحدث في أي مكان تقريباً اليوم ذو صفة عالمية؛ مشكلات البيئة والأمن والأوبئة والهجرة وتكنولوجيا المعلومات، هذا بينما إحساسنا به غير عالمي. تَكوَّنّا تطورياً في جماعات صغيرة، تضامنها داخلي. لزم إنتاج قصص كبيرة بتعبير يوفال هراري، أو مؤازرة المتخيَّل بفعل الطباعة والصحافة والتعليم، من أجل ظهور الأمم. أُطر التضامن مقترنة بأطر الحساسية، وهذه لا تزال ضيقة وغير عالمية. نواجه هذا التحدي اليوم: تطوير سياسة وتضامنات عالمية تستجيب للصفة العالمية للمشكلات. هذه ضرورة تطورية أو ضرورة بقاء. لكن ما يحدث هو عكس ذلك إلى اليوم. حواس الغرب الصناعية (أُذكِّر بأن هذا يعني وسائل الإعلام والفضاءات العامة التي يمكن فهمها كفضاءات لتطوير حساسية مشتركة) تمارس تحسيساً اصطفائياً، يتيح لأشياء أن تُرى ويُشعر بها ويُستجاب لها، بينما يُحال دون أشياء أخرى وبين أن تُرى ويجري التفاعل معها.
لقد ذُكِرَتْ حلب كثيراً في سياق الكلام على حصار وتدمير ماريوبول في أوكرانيا، وهو ما لم يجر وقت كانت حلب تُحاصر وتُدَّمر إلا على نطاق ضيق جداً. هناك تحسيس مُزامن بفداحة ما يجري في أوكرانيا، وتحسيس عاطل عن الفعل بخصوص حلب لأنه متأخر فوق خمس سنوات عمّا جرى. فكأن الأمر يتعلق بإغماض العين العامة، وإصمام الأذن العامة، وتكميم اللسان العام عن الكلام. نصير قروداً صينية كي نصون نمط حياة اعتدنا عليه، لكننا بذلك نؤذي بشدة قدرتنا على البقاء في عالم متغير. الحساسية للبيئة ومتغيراتها، والتصرف المناسب في الوقت المناسب، هو ما يمكن أن يحمي فرصنا في البقاء. علينا أن نتغير كي نستمر.
6
فرونتكس هي حرس الحدود والسواحل الأوروبي، ورغم أنها تشكلت عام 2004، فقد اكتسبت أهمية أكبر في مواجهة «أزمة اللاجئين» التي بلغت الذروة عام 2015 ومطلع 2016. لا يتعلق الأمر بغزو مسلّح للقارة الأوروبية، بل بتدفق أناس مُرتاعين من سورية والعراق وإيران وأفغانستان، ومن أفريقيا، يبحثون عن مستقبل. فرونتكس تحمي حدود أوروبا التي عقدت في شباط 2016 اتفاقاً مع الحكومة التركية لتحرس من جهتها حدود أوروبا. الحكومة التركية إلى اليوم تفرض إذناً خاصاً على السوريين للتحرك داخل تركيا نفسها، مما خبرته بنفسي غير مرة وقتَ كنتُ هناك حتى مطلع خريف 2017. هذا انتهاك برعاية أوروبية لأبسط حقوق الإنسان، الحق في الحركة والسفر. فرونتكس بالتالي جدارٌ مسلّح، جلدٌ إضافي لأوروبا القلعة؛ إقطاعيةُ فرونتكسيا. جلدٌ يساعدها على ألا تحس بما يجري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا عموماً. أي هي آلية إبعاد وتصفيح، تشبه فعل المظلومية من جهتنا من العالم. والواقع أن من أهم جلود أوروبا السميكة حسّ عميق بالتفوق والأفضلية حيال غير الأوروبيين، من أهالي الجنوب العالمي بخاصة، يحوز مفعولاً مماثلاً لدور المظلومية من جهتنا في الحيلولة دون التماهي وتطوير حسّ مشترك. في الولايات المتحدة يبنون جداراً على الحدود مع المكسيك، ووصلَ الأمر بترامب أن حظر منح الفيزا إلى أميركا لأي مواطنين من عدة بلدان إسلامية، منها سورية. واضحٌ أن نموذج العدوى والمناعة لم يَصِر وراءنا، وأن بلدان الغرب تُثابر على إنتاج أجسام مضادة وإجراءات وقائية ضد العدوى القادمة من الجنوب.
لكن إذا كان هذا النموذج القومي إطاراً للديمقراطية وقت كانت الطبقة العاملة أقلية سياسية مع كونها أكثرية اجتماعية، فإنه لم يعد كذلك منذ ثلاثين أو أربعين عاماً. الاستبعاد اليوم لا يطال اللاجئين والمهاجرين من الجنوب العالمي، بل كذلك المواطنين الأوروبيين من أصول مهاجرة. يتعارض النموذجُ القومي مع وضع مجتمعات الغرب أو الشمال كمجتمعات «ما بعد هجرة»، ويقود التمسك به إلى سياسات شعبوية يمينية وفاشيّة، تجسدت في مارين لوبان وإريك زمور في الانتخابات الأخيرة في فرنسا. لم يعد يمكن حل مشكلات الديمقراطية في أطر قومية أو «حضارية»، ولا بد من العمل في أطر عالمية.
نحتاج إلى تصور البشرية كجماعة مُتخيَّلة، كوحدةِ حساسية أو جسم، وإلى مقاومة إنتاج النفوس المَصفَّحة والمَنَازِع الجينوقراطية.
كوفيد 19 لم يعترف بشرق وغرب. مشكلات البيئة لم تعترف كذلك. ولا اللجوء الذي يتلاقى فيه السياسي والبيئي سلفاً. ولا الشمس التي تشرق وتغرب. نحن اللاجئون وبيئة الكوكب والفيروسات والشمس، جميعنا غاليليون نعرفُ أن الأرض كروية، فيما يبدو أنهم في فرونتكسيا يؤمنون بأرض بطليموس المنبسطة، يحرسون انبساطها بالمدافع.