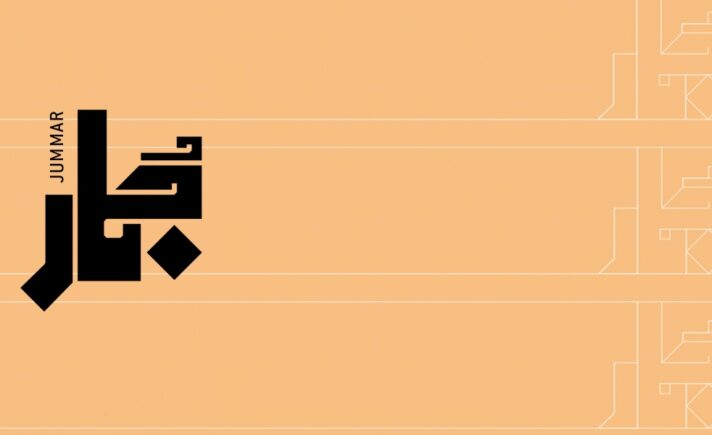عبد الله، صاحب بقالية من مئات البقاليات الصغيرة التي نصادف واحدة منها كل عدة أمتار في سورية. بدأ العملَ في التسعينات، لكنه منذ نهاية الصيف الماضي، وفي رأس كل شهر، يُجري حساباته ليجد نفسه خاسراً أكثر ويفكر بإغلاق المحل. تثنيه زوجته عن الأمر كونه لا يتقن أي مهنة أخرى، وتُصعِّبُ عليه خيار الهجرة، فيُقرران ضغط مصاريفهما والامتناع عن بيع كل ما يحتاج للتبريد، والإغلاق في أوقات الدوام الرسمي، وتثبيت أجر العامل الوحيد لديه -والذي يطالب بالزيادة باستمرار-، واختصار بعض العلامات التجارية قليلة الطلب، إضافة لإهمال تنظيف المحل؛ ليترك الغبارُ انطباعاً بقلة الحركة، ما يُثير تعاطف جُباة المالية فيُخمّنون ضرائب أقل.
يشترك عبد الله وأصحاب الأعمال الخاصة في سورية بهذا القدرة الإبداعية على ابتكار حلول تلتفّ على مُشكلات متطاولة، لكنها حلولٌ مُصمَّمة للحفاظ على أعمالهم أكثر ممّا هي حساسة لمحيط بالغ التعقيد.
يُثير عبد الله وغيره من المستثمرين الصغار والمتوسطين انطباعات متضاربة لدى عموم السوريين؛ فهم البراغماتيون الساعون لمصالحهم، والرأس الظاهر للتضخم الجشع. هم من يُنعتون استياءاً بالتجّار الفجّار، حتى أن التكهنات حول أي فوضى قد تحصل في سورية، تتمحور حول هجوم المفقرين عليهم لانتزاع الاحتياجات بالقوة. لكنهم أيضاً الحَمَلة الأساسيون لخسارات البلاد الاقتصادية، وبرهان تعافيها، وهم اليوم من يخوض مُعترك نزاع بارد في مواجهة السياسات المفترسة للنظام الحاكم. توليفة من العقوبات الخارجية وسياسات الجباية والاحتكار الداخلية، مترافقة مع فساد وفشل الدولة السياسي والإداري، وضعتهم في خضمّ مرحلة هي من الأقسى عملياً.
من ضد من؟
لا شك أن أشد ما في كرب سوريا الاقتصادي يقع على كاهل الموظفين والعمّال والفلاحين؛ المستهلكين تحت وطأة تضخم عنيف، الذين يحصلون على أجور مضمحلة القدرة تجعل استغلال وجشع أصحاب الأعمال الخاصة واضحاً جلياً أمامها، كونهم أصحاب القدرة على رفع الأسعار لمواكبة الأزمة الاقتصادية تاركين فُتات الربح لأُجرائهم. إلا أن ممارسات هؤلاء كلَّها لا تعدو كونها جزءاً من سلسلة مصالح يواجهون فيها هم أنفسهم تحديات لا تنتهي، يبدو معها الاستمرار في مزاولة مهنهم سعياً سيزيفياً بلا طائل، ولا يعلم به غالباً إلا من يتكبد شقاءه.
بعد انحسار العمليات العسكرية في محيط دمشق وريفها، وفي حمص وحلب، واستعادة السيطرة على أجزاء كبيرة منها، وفي الوقت الذي كان عموم العمال والموظفين يهبطون رويداً رويداً نحو أكثرية من المُفقَرين، دخلَ أصحاب العمل الخاص فترة وجيزة من الانتعاش واستعادة بعض الأعمال وافتتاح بعضها الآخر. عادت بعض الأسماء التي برزت في مناطق مدمرة للظهور في أماكن أخرى، وتشجع كثر لاستثمارات تناسب حاجات المرحلة، من مواد البناء والديكور، إلى الأغذية وسلع الرفاهية.
بدأت السلطة بتلميع صورتها عبر تجريم «التجّار» واستخدامهم كدريئة أمام فشلها الاقتصادي، وكمصدر تعويض غير مباشر لجهازها المتعطش للمال، بشكل أساسي عبر تسيير حملات جمركية لمكافحة التهريب، تأخذ شكل المحاسبة الميدانية في الأسواق، تصادر ما تشاء وقد توزع بعضه على الناس في ممارسة روبينهودية، تخفي حقيقة تكالبها على الأرزاق، إذ تعيد بيع المصادرات لأصحابها -حال مصادرتها أحياناً- أو تستفيد منها بشكل شخصي عبر استهلاكها أو بيعها لاحقاً. وتتجاهل بوقاحة محاسيبها من التجار في كل هذا.
تُسجل كاميرا بعض التلفزيونات المخالفات التي يأخذها جهاز الصحة أو التجارة الداخلية (التموين) بحق المحال التجارية، فتثير نزعتين؛ إحداهما شامتة لدى طبقة عاملة غالباً ما تتألف من موظفي الدولة، ذوي الدخل الأدنى، وكثيرون منهم مشبعون ببروباغندا سلطة تتهم التجار الصغار برفع الأسعار طمعاً في تحقيق الربح على حساب المستهلكين المعوزين. أما الأخرى فمُتعاطفة مُطعّمة بكراهية لعدائية الحكومة، تتبدى في الغالب لدى أبناء طبقة وسطى من أصحاب المهن والأعمال الخاصة.
يُذكّر الانقسام بتاريخية صراع طبقي تجلّى بوضوح إبان نشوء سوريا التي نعرفها: سلطة برجوازية أمام عمالة فقيرة، لكنه يزداد تعقيداً اليوم، ليتمظهر مشوشاً بين سلطة تضم توليفة من المضطهدين اقتصادياً ورأسماليي المحسوبيات، أمام فئة من أصحاب الدخول المتوسطة تدافع عن وجود وامتيازات في آن.
كلّ ما يأتينا
مع أزمة كورونا وارتفاع أجور الشحن في العالم تزداد كلف الاستيراد، وتنتقل هذه الزيادة بتراتبية من التجار إلى المهنيين إلى المستهلكين، ليصل سعر بعض المواد المستورَدة أضعاف قيمتها الحقيقية. كان المستوردون في سوريا يدفعون ما يوازي 2000 يورو لشحن الحاوية، ليدفعوا اليوم ما يزيد عن 6000 يورو.وصل هذا الرقم إلى 11000 يورو لنقل الحاوية الواحدة في بعض الأحيان. وبالرغم من أن هذا التضخم جاء كتحدٍ عالمي لسلاسل التوريد، لكنه في سوريا يتفاقم بالامتثال الزائد للعقوبات، وامتناع المصدرين في العالم عن التعامل مع التجار السوريين حتى فيما لا يشكل تجاوزاً قانونياً للحظر المفروض من مكتب أوفاك الأميركي.
ففي حال رغب مُصدّر أجنبي بالتعاون مع شركة محلية، فهو بحاجة لاستشارة قانونية تُكلّفه طاقة وتمويلاً باهظاً، لا يوازي الربح الذي قد يجنيه من تخديم سوق صغيرة كسورية، التي تبدو «وجعة راس كلها» حسب تعبير جوزيف، صاحب شركة شحن لبنانية توقفت عن التعامل مع سورية بعد صدور قانون قيصر.
لجأ المستوردون للالتفاف على هذا التجنب عبر استخدام شركات وكيلة في الإمارات أو لبنان،شبكة رجال الأعمال لتمويل النظام السوري والتحايل على العقوبات الدولية، منشورات مع العدالة. تلعب دور بؤرة تجميع للمستوردات الغربية، وإعادة تصديرها إلى سوريا، وكثيراً ما تكون شركات سورية بلبوس إقليمي، وُجِدت لا لشيء إلا بغية تسهيل الشحن إلى سوريا.
تزيد هذه العملية من حجم الأعمال الإدارية، وتُطيل طريق وزمن وصول البضائع، مما يساهم في رفع كلف المستوردات مرة أخرى، ناهيك عن الخسارة المحتملة لتلف البضاعة نتيجة أعمال الإنزال والتخليص المتعددة. يُحمّل المستوردون كل هذا على سعر المَبيع لتجار المفرّق، الذين يُضيفون بدورهم هامش الربح الضروري للقيام بالعمل من أساسه، ويطالبون المستهلك النهائي بكل هذا.
تزيد القوانين السورية التي تمنع استيراد بعض المواد، بالإضافة إلى مشقة تأمين القَطْع الأجنبي،أتى تعديل القرار 1070 لعام 2021 ليجعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة. فيقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته كي يسمح له بالحصول على كتاب يسمح له بتخليصها، الأمر الذي أوقف بعض المستوردين عن العمل، تجنباً لمكاشفة ضريبية تقتنص معظم ربحهم. من صعوبة المهمة أيضاً، فيلجأ التجار إلى جلب البضائع بالتهريب أو يُجبَرون على الأسوأ: التوقف عن الاستيراد بأنفسهم وشراء البضائع من بضعة محاسيب لا تواجههم عقبات في الاتجار بما شاؤوا.
منذ العام 2019 قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقليص فاتورة الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف، فمنعت استيراد عدد كبير من السلع التي اعتبرتها كمالية، تراوحت بين الهواتف النقالة والزبيب والكاجو.تعميم جديد بإيقاف استيراد توليفة من المواد والسلع، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية. في واقع الأمر لا زالت البضائع الممنوعة جمركياً متوفرة في الأسواق بأسعار مرتفعة، وفي حين يُجبَر المستوردون المستقلّون على الانصياع للقوانين، ولنسخة تنفيذية تتجاوزها صعوبةً لتشمل بضائعَ لم يُمنع استيرادها أصلاً،يدّعي تجار الالكترونيات عدم تمكنهم من استيراد الأجهزة الإلكترونية، تلك التي لم يَرد منعها في قوائم وزارة التجارة الخارجية. يستطيع حفنة من التجار المقربين للسلطة توفير ما شاؤوا من بضائع. يُعبر عامر، المخلص الجمركي، عن دهشة من حال السوق «ماحدا قدران يفوّت وتكة بدون تصريح! وكل شي ممنوع، وكل شي موجود، إفهم بقا».
يُكرّس هذا احتكار بعض القطاعات، و يؤدي إلى تحجيم المستوردين المستقلين وإنهاء دورهم كلاعبين اقتصاديين فاعلين، وتحويلهم إلى عملاء لدى حفنة من المقربين للنظام. تتجلى هذه الممارسات بعدة طرق، وتبدو أعمال خضر طاهر الملقب بأبو علي خضر مثالاً صارخاً لكلّ منها، فتارة تستبقُ شركته إيمّاتيل قرارات منع استيراد الهواتف المحمولة بتأمين أعداد كبيرة منها وفرض أسعارها على السوق، فيجد التجار والباعة أنفسهم مستهلكين لدى الشركة التي توفر البضائع وحدها، دون وضوح آلية تأمينها.حفل إطلاق هاتف آيفون 12 في إيماتيل. وتارة تعلن شركته الميرا نفسها كصاحبة الوكالات الحصرية لاستيراد المشروبات الكحولية، وتمنع إجازات الاستيراد عن كل التجار الآخرين، فيجدون أنفسهم دون أي إخطار مُسبَق تحت طائلة المحاسبة الجمركية إن احتوت محلاتهم على أي بضائع لا تحمل ملصقات الشركة. وحيناً أخرى تطرح شركة الميرا الغذائية بضائعها من الشاي وحليب الأطفال في الأسواق، في الوقت الذي يقوم جهاز التجارة الخارجية بعرقلة مُنافِساتها جمركياً، وتأخير عمليات التخليص في المرافئ بحجج مختلفة، مؤخرين وصول العلامات التجارية الأخرى، لتتمكن السلع الخاصة بشركة الميرا من اكتساح السوق.
وفي الوقت الذي يزيد التجار المستقلّون عن السلطة من ثمن البضائع مرة تلو أخرى، لتحقيق هامش ربح يتضاءل باستمرار تحت وطأة المشاركة غير المعلنة للمحاسيب الكبار، يستطيع المحاسيب الصغار والجُدد تخفيض أسعارهم ببيع المهربات دون الخضوع لسلطة الجمارك أو دفع الإتاوات، ما يُمكّنهم رويداً رويداً من استبعاد كل من عداهم من المنافسة. باعة في أحياء فرعية، مثل عبد الله، يفقدون زبائنهم يوماً بعد يوم في خضمّ مزاحمة غير شريفة مع هؤلاء.
تشكل الأكشاك المنتشرة في مدينة دمشق مثالاً جلياً لهذا: نقاط بيع في أماكن حيوية، خُصصت في الأصل لجرحى النظام، لكنها في الواقع تؤجَّر من أصحاب الرخص الأصليين لنافذين في الجيش، المخابرات أو حتى الشرطة، لتصنع حضوراً يشابه حضور النقاط الأمنية، وتُستخدَم كمنصات لبيع كل ما يُمنع استيراده، محمية بصلاتها. لا يدفع مشغلوها ضرائبَ أو خدمات كغيرهم من أصحاب المحلات المرخصة، وإنما رسوماً بسيطة لا توازي مداخيلهم التي تربو على ملايين الليرات يومياً، ولا تداهمهم دوريات الجمارك والمحافظة والصحة والتجارة الداخلية، فيُترَكون باستفزاز صارخ ليستقطبوا مستهلكين متلهفين للشوكولاتة والسجائر المستوردة، ولكل ما يتعذر تواجده في السوق. عند سؤالهم عن بضائع محلية، كثيراً مايعتذر صاحب الكشك ذي الإنارة الصارخة ومثبت الشعر اللامع من زبائنه بفخر: «ما بنجيب وطني»، في وقاحة محزنة إذ تُقارَن بواقع باقي التجار، ممن تحاسبهم دوريات الجمارك على كل منتج يحتوي كلمات بالإنكليزية، وإن كان استيراده مسموحاً.
يضاف إلى هذا كله تذبذب سعر الصرف الدائم، حيث تتغير نشرات الأسعار الخاصة بمبيع البضائع بالجملة يومياً، فيُثمّن الباعة والمصنعون ما يشترون بمبالغ أكبر تجنباً للخسارة. يُسعّر التجار اليوم بضائعهم بما يسمونه (دولار 8000)، أي أنهم يقسمون سعر الشراء بالليرة السورية على سعر الدولار اليوم: حوالي 6000 ليرة سورية، ثم يضربون الناتج بـ 8000، مفترضين أنه السعر المستقبلي لموادهم، فيبيعون منتجاتهم وفق ذلك، ليضمنوا ربحهم متسابقين مع سوق صرف متسارعة الارتفاع وتضخم عنيف. ينفي كثير من التجار والصناعيين قيامهم بهذا، وربما لا يُفشون طرقهم هذه إلا عندما تفشل حتى هذه المحاولات بالحفاظ على شيء من ربحهم. قد يتسلم صناعيٌّ طلبية تستهلك من الوقت ما يزيد عن سرعة تغير سعر الصرف والتضخم المرتبط به، فيخسر عند ذاك حتى لو منح نفسه أحقية زيادة هامش الربح غير المنطقي.
يزيد هذا أيضاً من تضخم لا يهدأ، يعيد إنتاج نفسه لهذا السبب أو ذاك، مفاضلاً بين تجار وآخرين، ومنهياً البعض لصالح غيرهم ممّن يمتلكون القدرة على تحمل بعض الخسارة أمام حجم تبادل تجاري كبير، وسرعة في تصريف السلع، مع توفر ضخامة في رأس المال أو موقع عمل استراتيجي أو قلّة في المنافسة، بينما يستكين أصحاب الأعمال الأضعف إلى محاولة التمسك بهامش الربح المُتاح ورفعه ما أمكن، ليفقدوا زبائنهم ومبيعاتهم للتجار الأقوى، وهكذا دواليك.
كلّ ما لدينا
آذنت إعادة انتخاب بشار الأسد في العام 2021 بثلاث مسائل: حرب شرسة لنيل الأموال من مقتدري البلاد، أي رجال أعمالها، وخدمات أقل، وفشل فيما يخص قطاع الطاقة تحديداً. تصاعدت الملاحقات الضريبية التي استهدفت -بما أصبح يُعرف بالتطهير- أصحاب المعامل والشركات الكبرى منذ ذلك الوقت،البقاء أم الرحيل؟ معضلة رجال الأعمال السوريين المستقلين، سنان حتاحت، 2021. وتولّى فرع أمن الدولة إدارة عمليات الاحتجاز والتحقيق مع رجال أعمال لا يخرجون منه إلا بعد دفع ضرائب بمفعول رجعي قد يصل إلى أكثر من عشر سنوات، مع فوائد مركّبة تبلغ مئات ملايين الليرات السورية.
بالنتيجة، ينقل بعض التجار والصناعيين أعمالهم إلى الخارج، ويعمل كثيرون في الخفاء. يقفل البعض نهائياً، ويبتكر آخرون أنظمة أرشفة وحسابات سرية لحماية أرباحهم ما أمكن. ويستمر النظام في محاصرتهم مُستثمِراً في تطوير نظام ربط ضريبي إلكتروني، وفي حوافز للعاملين في جهازه المالي تدفعهم للإبداع في إيجاد أساليب تصل بهم إلى الأرباح الحقيقية للأعمال الخاصة. يتبادل البعض في دمشق قصصاً ونوادر عن موظفين يتنكرون كزبائن، ويتابعون عمل بعض المحال خلال يوم عمل كامل عبر ملاحقة أرقام فواتيرهم وتقييم أرباحهم.
تستمر لعبة القط والفأر هذه حتى تشمل جميع مستويات النشاط الاقتصادي، ومعظم أصحاب العمل الذين درجوا على التهرب من نظام ضريبي يقتصر على الجباية دون تقديم خدمات بالمقابل، وقد يأكل حوالي 40% من الأرباح. نسبة الضرائب هذه هي من الأعلى بالمقارنة مع دول المنطقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار مشكلة الطاقة التي تُعقد النشاط الاقتصادي بما لا قبلَ للإنتاج الحقيقي به.
يؤدي انقطاع التيار شبه الدائم إلى تعطيل الأشغال، وإطالة أمد تسليم الطلبيات بشكل كبير. نتحدث هنا عن ساعة واحدة من التزويد بالطاقة الكهربائية خلال يوم العمل، ما يُحمّل المنتجات والخدمات أكلافاً كبيرة وإضافية لتوفير البدائل، من استخدام المولدات الخاصة التي تعتمد على وقود غالٍ يأتي من السوق السوداء، ويندر تَوفُّره في كثير من الأحيان، أو الاعتماد على المولدات المشتركة في بعض المناطق (الأمبيرات) التي تكلف مبالغ طائلة قد تصل الملايين شهرياً، إلى الاعتماد جزئياً على طاقة الشمس، التي تبلغ نفقة الاستثمار الأولّي فيها أرقاماً كبيرة، تحديداً عند الحاجة لتشغيل آلات ثقيلة، كما أنها تحتاج إلى تبديل بطاريات التخزين كل عامين أو ثلاثة، ما يجعلها أقل نفعاً على المدى الطويل.
أولئك الذين يعتمد عملهم على تجهيزات كهربائية، كالعاملين في صب وقص المعادن أو ورشات الخياطة، يخففون خسائرهم عادة بتقليل الخدمات المُقدًّمة وتخفيض جودتها، معتمدين على الاستعجال في الأداء وتخفيض النفقات ما أمكن للحفاظ على الربح.
أُصيبَ علاء ذو الخمسة وثلاثين عاماً بجلطة في القلب. يخبره الطبيب أن يتجنب التوتر والتدخين، وهو الذي يمضي نهاره على الهاتف معتذراً من الزبائن على التأخير في التسليم، ويمضي ساعة الكهرباء المتوفرة متعرقاً رغم البرد، في محاولة لاستعجال العمل والقيام بكل ما عليه.
ويؤدي التضخم المستمر إلى رفع إيجارات العقارات المُستثمرة، ويفرض رفع رواتب العمال -إن وجدوا- بمتتالية متواصلة تزيد من نفقات العمل دون أن تقدم الكثير للمرؤوسين. يعاني جميع أصحاب العمل من تقلص العمالة وقلة الخبرات المتاحة، وتقف أزمة المواصلات المتفاقمة حائلاً أمام التزام موظفيهم الكامل بمتطلبات العمل والإنتاج. الأمر الذي يهدد جدوى الأعمال الصغيرة، في أوقات كساد تهبط فيها القدرة الشرائية لعموم السوريين إلى حدودها الدنيا.
ويزداد استغلالُ الجهات الحكومية ليشاركَ التجارَ والصناعَ أرباحَهم، ولا يُبقي منها شيئاً أحياناً. زيارات دوريات التموين والصحة والبلدية شبه يومية لبعض الفعاليات التجارية، ما يدفع البعض لتحاشي العمل في أوقات الدوام الرسمي والاقتصار على بضع ساعات في أوقات متباعدة، وعرض حفنة من البضائع لا أكثر، الأمر الذي يوحي بحال عارمة من الخسارة والإغلاق في كثير من الأسواق، وتلك التي تبتعد عن مراكز المدن تحديداً. كثير من العاملين في الخدمات يستمرون في مزاولة عملهم ضمن دوائر ضيقة لزبائن قدامى، متخلين عن مقرات عملهم ويافطاتهم ما أمكن، ولا يستثني هذا أطباء ولا باعة معدات أو ورشات تصنيع غذائية.
يتعرض شحن البضائع وحده لتحديات فرض الترفيق عبر المحافظات، وإتاوات الحواجز العسكرية، فيما يُضاف إلى هذا ما يعانيه المصدرون من تبعات إغلاق الحدود وسمعة النظام السيئة في الاتجار بالمخدرات، فتُوصَد أمامهم عتبات الدول المستوردة، العراق والأردن غالباً، ويُترَكون ليرموا بضائعهم في المستودعات أحياناً، أو يبيعوها بأبخس الأثمان أحياناً أخرى.
اليوم، الأمس، وغداً
يرفع كل هذا من سعر البضائع مرة تلو أخرى مسبباً كساداً تضخمياً تتحمل تبعاته الأطراف الأضعف في السوق، ويؤدي إلى إغلاق أعمال بشكل نهائي، استبدالها بأخرى أو نقلها خارج البلاد. يدفع التجار الكثير من أجل الاستمرار في العمل، ويُحمّلون جل ما يدفعونه للمشترين، لكن هذه الدورة تقف عند حد لا يستطيعون معه المنافسة مع أسعار التجار المتنفّذين الكبار، ولا يجدون من يشتري بضائعهم فيتوقفون عن العمل. يذهب البعض إلى مشاركة رجال السلطة، والبقاء عبر الاستثمار بمالهم وتحت حمايتهم، ولكن حتى هذا الحل الوجودي الأكثر براغماتية غير مُتاح للجميع أساساً، وينحصر في قطاع التجارة والخدمات دون الصناعة.
يبدو التجار والصنّاع هنا خاسرين مهما ربحوا، يجنون أرباحاً أقل، ولا يحافظون على ما لديهم إلا بدعم شبكات الأمان التي قد تَصرِفُ على العمل بدل التكسّب منه، متمسكين بسمعتهم كأصحاب عمل، مقاومين في كثير من الأحيان لا لشيء إلا لإبقاء فرص التشغيل لموظفيهم وتخديماً للزبائن. يُمثّلون التضخم أمام الناس رغم كونهم أول من يدفع ثمنه، ويجدون للمستهلكين بدائل ممكنة وإن قلت جودة وحجماً. قد يجد بعضهم في هذا سلوى عن اليأس المطبق على البلاد، حيث يبدو الاستمرار في حد ذاته هدفاً قيّماً، ومقاومةً لتغول السلطة على القطاع الاقتصادي، فيما يذهب بعضهم الآخر لتشبيه أنفسهم بفلسطينيي الداخل، معتبرين أنفسهم خط المواجهة الأول مع جهاز الدولة الأدنى في غياب المواجهة السياسية على مستويات أعلى.
لكن عجلة الاقتصاد تدور بتباطؤ ينذر بالشؤم، يفيض باحتكار مافيوي من رجال السلطة وإكراه لغيرهم للعزوف عن أي استثمار. يُتوَقع أن البلاد ستغدو حظيرة لمحاسيب النظام، الذي سيعرض القطاعات العامة للبيع ليشتريها أعوانه، الذين سيستثمرون في قطاعات أصغر فأصغر، وسيفقد المستقلون بأمرهم أعمالهم رويداً رويداً. لكن هل حدث هذا من قبل؟ كانت البلاد تئن تحت وطأة المهربين وتجارتهم في الثمانينات، وطُرد الكثيرون خارج أعمالهم لأسباب تبدأ مع التأميم، ولا تنتهي بفتح استيراد أو منع آخر، ليبقى البعض دوماً. ففي حين يصبح الكثيرون خارج العمل تفتح قطاعات جديدة الأبواب لآخرين.
يغالي عبد الله في تاريخية الأزمات الاقتصادية، «لطالما كانت هذه البلاد ملعونة!»، لكنه يعترف أن هذه الأوقات هي الأقسى، وأن حاله في أفضلية ما دام ليس نازحاً أو مرتهناً لراتب محدد. لا ينفي استخدامه الرشوة لتخفيف المطالبات الضريبية، ولا سرقته للكهرباء أحياناً، وإحجامه عن زيادة أجر عماله كي لا يَطمعوا فيه، رغم تقديمه العون بلا تردد في أوقات الضرورة.
يُكرّسُ هذا دأبَ صنّاع المدن السورية وتجارها، فهُم لطالما اعتُبروا الملومين والمظلومين في آن، فهم مُستغِلون للفقراء، مستغَلون من الحكام، ينصرون الأولين و يجابهون الأخيرين تارة، ملتحمين بقضايا بلدهم، ثم لا يلبثون أن يفيدوا من صِلاتهم مُعلِين من مصالحهم تارة أخرى. في كل الأحوال، يبقون فعالية جوهرية في كل الأزمان، للانكفاء كانت أم للكفاح.