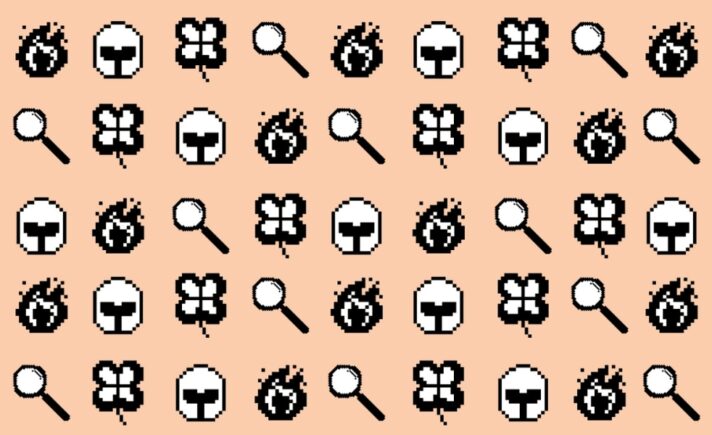1
في كأس العالم المكسيك (1986) احتسبَ الحكم هدفاً للأرجنتين سجّله مارادونا بيده. كان مارادونا وقتها لاعباً قصيراً ماكراً يقود منتخب بلاده في بطولة كأس العالم. عينه على الكأس يراها، بينما يداعبها بيد خياله. ذائع الصيت بمهاراته واندفاعه الشديد. كان قد تخطى مع فريقه الأدوار الأولى من البطولة ونزلوا لملاقاة الإنكليز، غريمهم السياسي والرياضي، في ملعب الأزتيك. بعد شوط أول من دون أهداف وعقب بداية الشوط الثاني، يقفز مارادونا، أسطورة الأرجنتين، بقصد نطح كرة عالية يبارزه عليها حارس إنكليزي عملاق، فتقوم قبضة يد مارادونا الخفيفة بتسجيل أكثر أهداف هذه اللعبة جدلاً في التاريخ.
الجدل كان ولا يزال حول احتساب هذا الهدف، على الرغم من الوضوح النسبي للمسة اليد من خلال إعادة اللقطات المسجّلة. ولكن دعونا نتذكّر أنه لم يكن لدى الحَكَم وقتها الكثير من الأدوات لتساعده في الحُكْم. فالهدف كان سريعاً جداً وهو كان بعيداً عن الكرة. ثمّ إنّ الأمور تطورت بسرعة، حيث بدأ مارادونا باحتفاليته مستغلاً حماسة الجمهور المتفجر في الملعب، يشجعه تردد الحكم الذي بدا وكأنه يحتسب الهدف. بعدها مباشرة، بدأ الكثير من لاعبي المنتخب الإنكليزي بالاعتراض عند الحكم يتوسلون إليه كي يعيد النظر. فالمدافع كان قريباً من اللقطة ورأى بأم عينه قبضة مارادونا وهي تلمس الكرة وتغيّر مسارها باتجاه المرمى. ولكن الحكم لم يرَ الشيء نفسه. حتى أنه قام باستشارة مساعده الذي لم يرَ شيئاً أيضاً، فما كان منه إلا أن سمح بالهدف كي تستمر المباراة. لم يكن بإمكانه العودة بالزمن إلى الوراء. كل ما يملكه هو انطباعات بصرية عن تلك اللحظة الزائلة، لحظة ارتفاع مارادونا في الهواء بكل جسمه، بما فيه رأسه وقبضته. إنّها طبيعة البشر – فنقطة مراقبتنا محدودة مهما كبرت، وطبيعة اللعبة كانت أقرب وقتها إلى طبيعة البشر – بكامل محدوديتها.
في اللحظة نفسها، وخارج أرضية الملعب، كانت شاشات التلفاز مستعينة بتقنيات العصر، تظهر للمعلقين بشكل أو بآخر قبضة مارادونا المرتفعة باتجاه الكرة، ولكن لم تستطع الكاميرا البعيدة أن تحسم الجدل كلياً. مما زاد من حدة انزعاج وقوّة نبرة المعلق الإنكليزي وهو يصرخ: «لقد احتسب الحكم الهدف للأرجنتين… ولكن إلى أي درجة كان هناك استخدام لليد… هو ما يعترض عليه الإنكليز». على أي حال، لم ينتظر مارادونا سوى دقائق معدودة حتى سجل هدفه الثاني ليقول إنه قادر على أن يسجل بقدمه أيضاً، وأيُّ هدف! بعد أن راوغ البارع لوحده نصف الفريق الإنكليزي، ومن ضمنهم الحارس، ليسجل ما سيُسمي لاحقاً «هدف القرن» فيهزم إنكلترا، ويتقدم مع فريقه في البطولة ويربحها في الأخير.
بقي هدف مارادونا الأول، هدف «يد الله» مَحلَّ جدل عظيم لسنوات بعد نهاية مونديال المكسيك. وطالبه الكثيرون بالاعتذار، ولكنه لم يعتذر عمّا فعله أبداً. كان يرى فيما فعله جزءاً من طبيعة اللعب. «لطالما استخدمتُ يدي لتسجيل أهداف عندما كنت ألعب في الأرجنتين»، كان يردد وكأنه يقول: من شبَّ على شيء، شابَ عليه. ما تعلّمه مارادونا منذ الصغر، أنّ من شطارة اللاعب أن يقوم بكل ما يمكن له في لحظة اللعب كي يكسب اللعبة. وإن حدث وسجل هدفاً بيده لم ينتبه له الحكم، فمن هو كي يرفض هدية القدر هذه؟ هل هناك أصلاً من لاعب في تاريخ كرة القدم رفض هدفاً كان يعرف أن الحكم قد احتسبه له بالخطأ؟ خاصة عندما تكون كأس العالم على المحكّ؟ بكل بساطة، مهمّة اللاعب في لعبة كرة القدم أن يسعى لتسجيل الأهداف أو منعها. فكم من لاعب استخدم يده بشكل تلقائي لمنع هدف متأملاً أن تغفل عنه عيون الحَكَم؟
2
يفكّر البعض في الحياة على أنها لعبة. أنا ألعب وأنتم تلعبون. نلعب في مجتمع أدواراً قليلاً ما نختارها وكثيراً ما تُفرض علينا. هي لعبة فيها لاعبون كثر. وأنا اللاعب الفرد أحاول المشاركة باللعب، بدل أن انسحب كلياً. الأهم في أصل أي لعبة هو أننا حين نلعب، نلعب بحرية. ليس هناك ما يرغمنا على الوجود. منذ فتحنا أعيننا على هذه الحياة، وجدنا أنفسنا أحياء في دنيا نمرّ عليها ونمضي كما عاش التجربة من قبلنا كثيرون. ولكن إذا كانت الحياة حقاً «لعبة»، فهناك على الأقل نوعان من اللاعبين كما يقترح جميس كارس، الكاتب الأميركي. هنالك اللاعب الذي ينظر للحياة على أنها «لعبة محدودة» فيها ربح وخسارة، ولها بداية ونهاية. فيكون جوهر وجوده أن يربح ويفوز – أن يراكم المال والسلطة والقوة والجاه. أن يكون سعيه وراء النجاح والكمال في كل شيء. وأي شيء عدا ذلك هو فشل. من جانب آخر هناك اللاعب الذي ينظر للحياة على أنها «لعبة لا-محدودة»، لا بداية لها ولا نهاية، لا رابح فيها ولا خاسر. هنالك فقط استمرارية اللعب والتواصل مع الآخرين. إذن، هدف اللاعب المحدود أن يربح اللعبة. هدف اللاعب اللامحدود أن تستمر اللعبة. وعلى الرغم من اختلاف أخلاقيات اللعبتين إلا أن الشيء المشترك بينهما هو الحرية. فكلا اللاعبين يلعب بكامل حريته، وإلا لما تحقق شرط اللعب. لا تستطيع أن تلعب بجدّية وهناك مسدس موجَّه إلى رأسك! أنت وقتها مُطالَب فقط بأن تقوم بحركات معينة لتحافظ على حياتك. «لا يستطيع أن يلعب من يتوجب عليه اللعب»، يؤكّد كارس.
دعوني أسألكم إذاً، ما الذي يجمع بين الحرب والانتخابات والشطرنج، والبوكر وكرة القدم؟ جميعها ألعاب محدودة. ألعاب تحصل في مكان له شروط معينة، كساحة الحرب، وصندوق الانتخابات، ورقعة الشطرنج وملعب كرة القدم، أو طاولة البوكر. يلعبها لاعبون مُحدَّدون، يتبارون عن رضا وقد قبلوا مسبقاً بمكان وزمان اللعبة، وهم على دراية وخبرة بكيفية وقوانين اللعب. وما يلعب عليه اللاعبون هو نتيجة نهائيةٌ للّعبة. رابحٌ وخاسر. تتحدد النتيجة بنهاية زمن اللعب أو انتهاء حركاته. طبعاً هذا هو الغرض النهائي من أي لعبة تنافسية. وبالنسبة لجيمس كارس، فإن النتيجة الفعلية لأي مباراة ليست ما يقرره الحكم ولكن ما يتفق عليه اللاعبون عندما يغادرون الملعب. مثل من يترك ليلة البوكر مع أصدقائه راضياً بالنتيجة النهائية للعبة على الرغم من محاولات البعض للغشّ. في عُرف كرة القدم، اعتراف اللاعبين برابح وخاسر في نهاية اللعبة هو الأساس، حتى ولو أحسّ الخاسر ومُشجّعوه بالغبن. هذا عُرف اللعبة، وإلا لما لعبها الناس.
طبعاً الشغف بلعبة محدودة وشعبية، بسيطة الروح معقدة القوانين، جذابة وواضحة مثل كرة القدم – من الطبيعي أن يولع التعصبات والتحزبات بين الناس، فيختلف التأويل والمذهب والهوى. حين تدخل اللعبة إلى حياة المتفرج، تتكوّن نسخة فردية عن اللعبة داخل كلّ فرد. هكذا يشارك المُتفرج في اللعبة وتصبح جزءاً منه ومن ذاكرته، مما يزيد من جاذبيتها ويترك أثاراً عديدة، منها المفيد مثل الرفقة الكروية ومنها المؤذي كالعنف الكروي. حيث تتقاطع اللعبة بالضرورة مع الحياة. فالمُتفرّجون جزء أساسي من اللعبة لأنهم يشهدون عليها، ويشاركون في تَذكُّرها، ويمكن لهم القول: «تفرَّجنا على مباراة خرج منها الفريق الفلاني رابحاً». لكن المتفرج على أي لعبة، لا يستطيع تغيير حركاتها أو نتيجتها. ودعواته للربّ قلّما تُدخِلُ أهدافاً. إلا أن مشاركته الآخرين عبر الفرجة تجعله جزءاً من شيء أكبر منه. وهو ما يبحث عنه الكثير منّا في حياتهم. وربما هذا ما يجذبنا أكثر نحو اللعبة. فعندما نأخذ المقعد، نسترخي ونتفرج، نحن نسلّم اللاعبين زمام السيطرة. نسلّمهم مهمّة اللعب. بينما نشتّتُ انتباهنا ولو مؤقتاً عن حياتنا، عن طريق التوقف عن كوننا لاعبين فيها، لنشاهد لعبة محدودة تكتمل أمام أعيننا، من بدايتها إلى نهايتها. وكما أن لكل مباراة خصوصية زمانية ومكانية ولاعبين مُحدَّدين، يصبح لكل لعبة محدودة تاريخ. لائحة طويلة بأسماء الفائزين على مرّ العصور، منقوشة على حائط تبنيه يد الزمن وتحفظه ذاكرة المتفرجين، فيتبارَى اللاعبون كي يكتبوا أسماءهم على هذا الحائط، أي أن يصلوا إلى الخلود.
«… يحلو لي أن أرى ما كان للحكم التونسي رؤيته من نقطة مراقبته في هدف مارادونا الأول…» ردَّدَ المعلق الإنكليزي على مدار بقية المباراة الشهيرة، وأُشارِكه التمنّي. ولكن لن يستطيع أحدٌ منّا أبداً أن يرى ما رآه شخص آخر في لحظة معينة، ولن يفلح أي منّا في الحلول مكانه. فقد كان على المسكين وحده أن يتخذ قراره بأدواته المُتَاحة وحسب طبيعة اللعبة وتطورها آنذاك. فلم تتوافر على زمانه تقنية حكم الفيديو المساعد «الڤار» الذي صار يخرط كالمنشار في أهداف ويمنعها. العالم البشري اليوم ليس نفسه لعام 1986. يزعم البعض أن البشر تطوّروا؛ ووَحده الزمن قادر على تقييم مدى صحة هذا الزعم، فالتغيير لا يعني بالضرورة التطور. تغيّرت طبيعة البشر مع التقدم التكنولوجي بلا شكّ، الأمر الذي غيّر طبيعة لعبتهم. تغييرات ليس آخرها دزينة الأهداف التي كشفتها عين التكنولوجيا العمياء، إذا ما فكّرنا فقط في التقانة التي تعتمد بشكل بحت على عنصر الذكاء الاصطناعي قبل تدخّل البشر، كما في التسلل نصف-الأوتوماتيكي الذي كان حاضراً في مونديال قطر 2022 بشكل واضح. حيث يوافق الكثيرون على أنه لو لم تكن هذه التكنولوجيا قيد التطبيق، لتَمَّ احتساب أغلب تلك الأهداف المُلغاة نتيجة عدم قدرة العين المجرّدة على مجاراة الآلة وضبط حالات التسلل شديدة التعقيد هذه، ولتَغيَّرَ شكل البطولة التي رأيناها بكل تأكيد. على كل حال، وبينما كنت أشاهد المونديال التاسع لي على سطح هذه الكرة، لاحظت كما لاحظ الكثيرون، وربما لأول مرة وبوضوح بالغ، كم تَغيَّرَ كأس العالم!
3
للضرورة أحكام. بعد قطيعة طويلة لها العديد من الأسباب رجعتُ لمتابعة كرة القدم بشغف يشبه شغفي الطفولي، مع اختلاف كبير بالدرجة والحماس. فأنا اليوم أدخل الأربعين بينما أتأقلم مع دوري الجديد كأب يريد التواجد في حياة ابنته الصغيرة التي لم تتجاوز بعد السنة والنصف من العمر. طاقتي المحدودة تُصرَفُ على مهام من شأنها الحفاظ على حياة هذه العفريتة الجميلة. فبينما أتعلَّمُ الأبوة، أعي تماماً مدى تواضع قدراتي وقلّة حيلتي. فلا قدرة لي على البحث عن الكمال، ولا غاية لي في «الفوز» في لعبة لا-محدودة كالأبوّة. ما أستطيعه هو أن أكرّس لها كامل اهتمامي في فترات، بينما أخوض حياتي وأعمل بتوازن قلق. فقد شقلبت هذه الصغيرة حياتنا رأساً على عقب، كما يفعل المولود الجديد بعائلته، بعد أن شقلبت الجائحة حياة سكان هذا الكوكب منذ عامين ونيّف.
في خضمّ البحث عن أدوات للتأقلم مع هذه التغييرات العظيمة، وجدتُ جذوة قديمة مخبّأة تحت رماد العمر السريع. اهتمامي القديم بكرة القدم التي كنت من متابعيها في سنيّ الصبا والشباب. دارت السنوات بيني وبينها، في هجر وقبول، شغف وفتور، إلى أن وجدتُ فيها ما يفيد، عندما أستخدمها كأداة للتفريغ وإلهاء العقل قليلاً عن ضغوطات الحياة. في شتاء الساحل الشمالي الشرقي لهذه القارة الباردة – أميركا الشمالية، مع درجات حرارة شديدة الانخفاض ويوم قصير ومُعتم لا قدرة لي فيه على القيام بأي نشاط خارج البيت من مشي أو تريّض، يصبح الاهتمام بكرة القدم ومشاهدة مبارياتها على التلفزيون تلهية مشروعة. أخرج ولو للحظات من تفاصيل لعبتي اللا-محدودة وأدخل في المباراة، كمُتفرّج حيادي في معظم الوقت. فُرجة مسليّة قليلة الانغماس أتأقلم بها مع العزلة التي تفرضها الأبوة. عزلة داخل عزلة المهجر الكبير. هكذا تابعت مونديال قطر من الولايات المتحدة الأميركية بنصف عقل، رغم متطلبات الحياة والعمل وفرق التوقيت.
ولكنه لم يكن السبب الوحيد الذي دفعني أنا وشريكتي كي نتابع مباريات المونديال بفضول واهتمام لا يشبه المونديالات الثلاثة الماضية التي قضيناها سوية، أنا وهي. كان مونديال قطر بلا شك مونديالاً فريداً وشخصياً بالنسبة لنا. فالحدث الرياضي الأكثر متابعة حول هذا الكوكب يحدث لأول مرة في بلد ناطق بلغتنا الأم. اللغة العربية. ولا تَستهِن بفعل اللغة، وسيط التعارف والتفاهم، ووسيلتنا الأولى لنفهم أنفسنا والعالم من حولنا. ما يصلنا بالآخرين. ما يُسهّل معاملات الناس وحياتهم، من بيع وشراء وسؤال عن الحال العام. فحتى أَوهَى خيوط اللغة مازال قادراً على ربط الناس وتوطيد العيش المشترك بينهم. حيث شاهدنا كيف استطاعت لغة أهل المغرب الدارجة الهجينة أن تُشعِر اللاعب المغربي وكأنه يلعب على أرضه. اللغة المشتركة، لا الدين بالضرورة. فلم يكن اللاعب الباكستاني المسلم ليلعب في «بيته الثقافي» كما فعل اللاعب المغربي في قطر. فاللُّغات البشرية حمّالة الثقافات. وبها نتشارك التجربة. وعلى مستوى آخر، خاض ملايين البشر تجربة مشتركة تحصل لهم كل أربع سنوات بفضل هذه اللعبة التي يتابعها الجميع. الكبير والصغير، الغني والفقير. حتى يمكن القول إنّ اللعبة الشعبية هي نوع من أنواع اللغات الشاملة التي تجمع البشر خارج حدود اللغات المحكية.
ولكن شعبية لعبة كرة القدم نعمة ونقمة. لأنها عندما تجمع الناس حولها، يصبح من السهل أن تتحول إلى أداة في أيدي ذوي السلطة ليمارسوا القوة. فكما استغلّت دول عديدة عبر التاريخ شعبية كرة القدم لتغسل صورتها وتُعيدَ خلقَ نفسها، فرضت قطر نفسها في مونديال 2022 كمركز سياحي يقدّم تجربة ثقافية استهلاكية عربية -إسلامية، بصورة مذهّبة وملمّعة، متجانسة ونظيفة، مغايرة للواقع المعقّد والمتناقض بالضرورة. وفعلت ذلك بكل الأدوات والوسائل المتاحة لديها في سبيل تحقيق هذه الغاية. فأتى المونديال مثل قطعة الذهب المشغولة بإتقان، والتي يعمد الصائغ إلى تلميعها وإخفاء المختلف فيها بالقوّة. وبغض النظر عن نجاح التنظيم، فإن تسليط الضوء على ثقافة ذلك الجزء من العالم قد عرّى بعض جوانب الواقع المؤلم الذي يعرفه كل من هاجر من بلادنا، من قمع واستغلال وعنصرية وهوموفوبيا. ولكن لطالما كان المال أداة في يدّ من يمارس القوّة. قلتُ هذا لجيراني وزملائي من الأميركان الذين يعرفون جيداً علاقة المال بالقوة، وفي تاريخهم الكثير من الاستغلال والعنصرية. وعندما أشاروا بإصبعهم إلى اتهامات الفساد والرشوة وحقوق المثليين والأقليات، وافقتهم في أحقية طرح القضايا، ولكن اقترحت عليهم وضع هذه الصورة المتجهّمة إلى جانب الصورة المشبعة بالثروة والمحافظة والتجانس التي قدّمتها قطر عن ثقافتها. فلا يمكن لصورة أن تلغي أخرى، ولطالما كان الواقع أكثر تعقيداً من أي قصة أو صورة واحدة. كما علينا أن نتذكّر أن نسخة قطر هذه، هي نسخة من نسخ عديدة متناقضة عن الثقافة العربية الإسلامية، فالعالم الذي تشمله هذه الثقافة اليوم واسع غير متجانس وحال ناسه وبلاده مختلف، وقضاياهم الوجودية تتباين كالليل والنهار. فشتّانَ بين قطر وسوريا والمغرب اليوم، على سبيل المثال لا الحصر.
4
شعبية اللعبة تعني الجدل حولها. والشغف الكروي يخلق متعصبين يحبون ويكرهون بشغف. فيحتدمُ النقاش والجدل. وتجد العنصرية جذوتها في حريق الشغف. فمنذ بداية المونديال، اصطفَّ الناس في مواقف متضاربة منه حتى آخر لحظة فعلية فيه، أي لحظة تسلّم الفائز للجائزة. حيث اختار حاكم قطر أن يُلبس الفائز بكأس العالم عباءة «البشت»، التي ترمز لعلوّ الشأن عند العرب. وانقسم الناس بين سعيد وكاره. خاصة من رأى في إلباس ميسي العباءة فرضاً غير مبرر للذات من قِبَل المضيف العربي. ولكن أليس هذا من طبيعة العرب؟ أن يُقحموا أنفسهم في حياة الآخرين، بمن فيهم الضيوف. فعادات العرب في الضيافة تتعمّد المبالغة والتكلُّف. هي إحدى نقاط ضعف العرب، وإحدى مفاخرهم بلا شكّ. فهم قومٌ مضياف، ومن السهل أن نتخيّل كبير شيوخ قبائل العرب وهو يُلبس ضيوفه المهمّين عباءات مذهّبة عند الاحتفاء بهم. فما بالك بالفائز في أكبر مسابقة عالمية على وجه الأرض! من الجيد أننا لم نشاهد خرافاً تذبح ودماءاً تسيل تحت أقدام ميسي تهليلاً بالكأس المرفوعة في قطر. طبعاً الحاكم الذكي لم يفعل ذلك، بل استغلَّ عين التاريخ التي تسكن في عدسات الكاميرات الموجّهة إلى الفائز، ليترك أثره في «عباءة الشيخ ميسي» ويقول أنا الفائز اليوم في «لعبة الدول».
ولكن جدلية هذا المونديال التي لا تنتهي لم تمنع المتعة الكروية بل أكّدت مدى تماهي لعبة كرة القدم مع الحياة التي نعيشها. فتصبح كرة القدم مرة أخرى محل اشتباك وحوار مجتمعي كبير. مدخلاً لناشطي مجتمع الميم، أو منصّة للهوموفوبيا. فرصة لملاحظة عنصرية الغرب المبطّنة، أو مناسبة للأمازيغ كي يدافعوا عن ثقافتهم المهمّشة. بوتقة لقضايا العصر، تماماً كما كانت دائماً مسرحاً لصراعات سياسية واجتماعية وثقافية أخرى، وملعباً لتصفية حسابات. فكما قارب كثيرٌ من العرب والمسلمين مباريات المغرب الطاحنة مع الفرق الأوروبية على أنها معارك لتصحيح هزائم التاريخ، لا ننسى أن مباراة الأرجنتين وإنكلترا في مكسيك 86، التي بدأنا بها المقال، كانت تحدث أيضاً على خلفية حرب جزر الفوكلاند بين الإمبراطورية الإنكليزية ودولة الأرجنتين. وما دخل مارادونا ورفاقه تلك المباراة إلا كمن يدخل حرباً حقيقية مع الإنكليز، ولديه فرصة للثأر منهم بعد الهزيمة العسكرية التي لحقت ببلاده والأرواح التي زهقت.
بالعودة مرة ثانية إلى تلك المباراة الخالدة، فلِمَن يشاهدها اليوم بعد الفرجة على مونديال قطر، أن يتفكَّرَ في فعل الزمن في لعبتنا الجميلة. فرياضيّو اليوم غير رياضيي الأمس من ناحية اللياقة البدنية، على سبيل المثال. فأين هو اللاعب ذو الكرش الصغير الذي كنّا نألفه في منتخبات الماضي؟ أين الرتم البطيء الذي كان كثيراً ما يكسر وقع اللعب ويدفع الجميع بمن فيهم المتفرجين والحكام لالتقاط أنفاسهم والتفكّر للحظة؟ بلا شك، ازدادت حديّة اللعبة ومفاجآتها بشكل يتناسب طرداً مع جدّيتها. فأصبحت اليوم أكثر سرعة، أعلى لياقة، أعقد قوانين، وأكثر استهلاكية. كل هذا بالإضافة لتسرّب التكنولوجيا من حياة البشر إلى لعبتهم المفضّلة. فعلى الرغم من احتمالات تطبيقها العادل، تغذّي التكنولوجيا وهماً دفيناً في مخيّلة البشر، وهو وهم قدرة الوصول إلى «الحقيقة المطلقة». فهل لمست الكرة حقاً خصلات شعر كريستيانو رونالدو في هدف البرتغال على الأوروغواي؟ – والذي أراد رونالدو أن يحتسبه لنفسه – أم هل خرج مسقط كرة اليابان كلّياً في مباراة إسبانيا؟ بكل جدّية يقترح كبير حكام الفيفا أنّ تقديم التكنولوجيا إلى اللعبة هدفه الوصول إلى اليقين الكامل الذي لا يقبل الشك. ليصير هدف التطور هو قتل الشك، ذلك الشكّ الجميل الذي يختصر كل جوانب تجربتنا في لعبة الحياة، كأفراد واعين نختبر محدودية «نقطة المراقبة» التي نلعب منها. فلا انطباعاتنا دقيقة، ولا أحاسيسنا تمثل الواقع، وما بأيدينا إلا قلّة حيلتنا في وجه حياة مستمرة لا يبدو أنها تبالي بأحد.
5
«كرة القدم هي الحياة» (Football is Life) عبارة شائعة جداً وشعار كل من يعشق هذه اللعبة، خاصة من ملايين المتفرجين. وعلى الرغم من أن اللعبة هي شغل الناس الشاغل، إلا أنها ليست الحياة التي يعيشونها بتفاصيلها اليومية، برتابتها وحلوها ومرّها، إنما هي تشتيت انتباه عن الحياة. تشتيت قلّما يؤذي برأيي. ولكن الخطير في الأمر، أن تبديلاً صغير في ترتيب الكلمات وجعلها «الحياة هي لعبة كرة قدم» يقلب الطاولة على المتفكر الذي يتساءل إذا ما كان من المفيد حقاً أن نقارب الحياة كما لو أننا في لعبة كرة القدم؟ فكيف نقارب الوجود الذي لم نختاره، بل رضينا به، أفراداً أحراراً مسؤولين عن أفعالنا؟ هل نلعب بهدف التفوّق بالثروة والقوّة والسلطة، نريد أن نربح على حساب خسارة الآخر؟ أم بهدف أن نتواصل مع غيرنا من اللاعبين، نلعب معهم ونتواجد في حياتهم للاستمرارية والبقاء، في لعبة لا رابح فيها ولا خاسر؟
وعلى ما يبدو، فقد صار التفكير في الحياة على أنها لعبة نقطة جوهرية مشتركة في محاولات كثيرين للتأقلم. أمرٌ ألاحظه كثيراً بحكم عملي كطبيب نفسي، فكثيرون اليوم صار يبحث عن «مدرب حياة» (Life Coach) دوره دور المدرّب الذي يُحضّر اللاعب للعبة، ولا يلعبها عنه. والتفكير باللعب ليس بالأمر الجديد كما رأينا من كتابات جميس كارس، فمنطق اللعبة يستخدمه كثيرون في مقاربة السياسة والحروب والعلاقات الفردية والاجتماعية. الأمر الذي يستحضر ماكيافيلّي والغاية التي تبرر الوسيلة، طالما لم يلاحظها الحكم.
ولكن هل هناك حقاً من حَكَم في الحياة؟ إذا تركنا افتراض وجود حياة آخرة، ببساطة لأنه لم يعد أحدٌ من الموت ليخبرنا عنها، يبدو أن الحياة الدنيا ليس فيها حَكَم. حتى الله يعلّق حكمه إلى ما بعد انتهاء اللعبة. إلى ما بعد انتهاء العالم، إلى يوم الحُكم. وإلا لما كان هناك معنى ليوم الحساب. ولكن الآن، على الأرض، ماذا نحن بفاعلين؟ على من تقع مهمّة الحَكَم في أن يضبط اللعبة؟ أن يحرص على أن اللعب ضمن ما يسمح به «القانون»، وضمن ما يمكن له بأدواته أن يراقبه. حسبي أن الطبيعة قد زوّدتنا بأدوات نطلق بها الأحكام، للتعويض عن غياب الحَكَم. العقل الذي نطلق به أحكامنا بالرفض أو القبول، بالسعي وراء شيء أو تجنّبه. فنحن من نضبط الحياة التي تسير داخلنا كما يضبط الحَكَمُ اللعبة. ابتُلينا بهذه المهمّة العجائبية في الحياة، أن نكون اللاعب والحكم. وعليها نقارب حياتنا، كبشر لدينا من ملكات الآلهة ما أعطانا إياه بروميثيوس في الأسطورة القديمة، عندما أشفق على ضعف البشر الجسدي وأعطاهم مَلَكَة العقل بديلاً.
6
استغرقني كتابة هذا المقال أسبوعين بينما كنت أتابع مونديال قطر باهتمام. عندما بدأت الكتابة لم تكن الأرجنتين قد تُوِّجَت بالكأس بعد. فكان اختياري لمارادونا كلاعب محض مصادفة لا أكثر، حيث لازمتني قصته منذ كنت صغيراً. ففي مونديال 1986 كنت في الرابعة من العمر. أي أنه عندما دخلت كرة القدم حياتي كان مارادونا في أوج عطائه، وسيرتُهُ كانت على كل لسان. ظاهرة عالمية يعرفها الكبير والصغير ممن عاصره على سطح هذا الكوكب. فعلاً عجيب أمر هذا الرجل، كيف أثّرَ في العالم كلاعب داخل الملعب وخارجه. واستمر أثره بعد أن مات. حتى أن هناك فيلماً وثائقياً من انتاج الفيفا اسمه ما بعد دييغو، يتتبع أثر مارادونا بين أهله وناسه وسكان المدن التي عاش فيها. ليس فقط كلاعب معجزة يريد الجميع أن يشاهده يلعب، ولكن كإنسان موجود في حياة مجتمعه، كشخص قريب من الناس ترك إرثاً متناقضاً، وسيرة عجيبة معقدة، متعددة التفسيرات، حمّالة أوجه. فهل هو إله نزل على هيئة بشر أم بشري ارتقى إلى مصاف الآلهة، أم مجرد إنسان موهوب وضعيف؟ تعتمد الإجابة على الشخص الذي نوجّه إليه السؤال.
ما زاد من عجبي هو قصة سمعتها في تغطيات مونديال قطر لمشجع أرجنتيني يزعم أنه شهد على حادثة عجيبة في استاد لوسيل، يوم 26 نوفمبر 2022 أثناء مباراة الأرجنتين والمكسيك. كان الظهور الثاني للأرجنتين في البطولة، بعد خسارتهم المفاجئة أمام السعودية في أول مباراة. لا أحد يريد أن يخسر مباراته الأولى. خاصة عندما تكون عينه على الكأس. ميسي الذي يقود الأرجنتين ويخلف مارادونا في سلسلة أساطير الكرة، لم يكن قد حمل كأس العالم بعد، وكانت هذه فرصته الأخيرة بحكم اقترابه من سن الاعتزال. التوتر كان مرتفعاً جداً قبل المباراة؛ فالخسارة الثانية تعني الخروج ونهاية الحلم.
بالنسبة لميسي كانت هذه مباراة نفسية أكثر منها بدنية. فهو لم يدخل بعد في جوّ البطولة، وكان لحظَتَها يعيش حالة عسر تسجيل رهيبة، وبدأ الشك باليقين ينخر رأسه. مضى النصف الأول من المباراة من دون أهداف. وصار الخوف يتسرب إلى قلوب المشجعين. بعد بداية الشوط الثاني، ومع استمرار عسر التهديف، تأتي ضربة حرة للأرجنتين قريبة من المرمى يتصدى ميسي لتسديدها. كل جماهير الأرجنتين تقف على قدميها بترقّب. ولكن ميسي يضيع الركلة، ليصرخ الجمهور على أثرها بحرقة. في تلك اللحظة بالذات، يدّعي المشجع الأرجنتيني المتواجد في الملعب أنه شاهد رجلاً أرجنتينياً يركع على ركبتيه وهو يتضرع بالصلاة صارخاً «يا دييغو… يا دييغو… إنزل وساعد ميسي…»، قصده التضرع إلى دييغو أرماندو مارادونا. لم تمر سوى دقائق معدودة حتى سجل ميسي هدف المباراة الأول وأشعل حماس الملعب وأعاد الثقة بالنفس، لتفوز الأرجنتين في نهاية المباراة وتجد نفسها في المنافسة من جديد، فتبدأ خطاها الحثيثة نحو اللقب وتنتزعه من يد فرنسا في نهائي سيتحدث التاريخ عنه لأزمان.
الطريف في هذه القصة هو حالة تأليه مارادونا عند عشّاقه. فلن يستطيع أحد اليوم أن يهزّ إيمان ذلك المشجّع بمارادونا الربّ الذي استجاب لدعوته، فنزل وساعد ميسي كي يعود في تلك المباراة، ويربح لاحقاً البطولة. حتى أنّني أجزم أن هذا المشجع هو من أتباع «الكنيسة المارادونيّة»، وهي كنيسة لدين جديد يعتنقه الآلاف اليوم حول العالم وخاصة في الأرجنتين. بالنسبة لأتباع هذه الكنيسة، مارادونا ليس مجرد لاعب. بل هو تجلٍّ إلهي يُقدَّس بشكل ديني، خاصة بعد وفاته المفاجأة وتحوّله الحتمي إلى أيقونة. وعلى الرغم من وجود أساطير كثيرة في تاريخ كرة القدم، إلا أنّ حالة التأليه هذه لمارادونا استثنائية بلا شكّ، ولا بد مردّها لكثير من العوامل، مثل وضع الأرجنتين الخاص كبلد وطبيعة تديّن أهله. ولكن الأهم برأيي هو الأثر الشخصي الذي تركه مارادونا الإنسان بين الناس الذين مرّ في حياتهم حتى يحدث رحيله فراغاً رهيباً بالنسبة للكثير من الأرجنتينيين. أقرب إلى فراغ الأمل. ذلك الأمل الذي استردّ بعضه ميسي اليوم، ولكن بمعيّة الرّب.
7
هناك فيديو على اليوتيوب يظهر فيه مارادونا كما لم نره من قبل، يقوم بتمارين الإحماء على إيقاع أغنية العيش هو الحياة قبل بداية مباراة في نهاية الثمانينات. على الأنغام يتمايل ويُرقِّصُ الكرة معه، يهزّ بخصره ويتلاعب بها، ينطنطها على رأسه ثم كتفيه وركبتيه كأنه ساحر يقوم بألعاب خفّة. يرقُص للجمهور بعفوية وبكل حرية على أنغام الموسيقى كمن يرتجل في فنّه ويُحلّي. حتى أن لاعبي الفريق المنافس، ممن كانوا يتدربون بجدية في فترة الإحماء تلك، توقفوا للفرجة على مارادونا.
كان مارادونا فنّاناً أيضاً. وربما ليس هناك في تاريخ اللعبة من حاكى الفنّ وحفّز الفنانين مثله. الرجل الذي حرّكَ القريحة الإبداعية لتحاكيه في لوحات، وأغانٍ، وقصص، وأساطير ما تزال بين عشاقه يتداولونها حتى اليوم. يحكي عشاق مارادونا أنه ساعد الكثيرين، وأدخل السعادة إلى قلوبهم، وانتقم للفقراء حتى عندما كان مهاجراً في نابولي. كان منفتحاً على الناس، وصوت الذي لا صوت له. مما يدفعني للتساؤل إذا ما كان من الممكن أن يأتي هكذا أثر من فراغ؟ حيث يبدو أن مارادونا كان حقاً «لاعب الناس»، بلا منازع. واستمدّ الألوهية والتخليد من أثره فيهم وشهادتهم عليه. حتى ولو كان هذا الأثر يحتمل أيضاً الأوجه الأخرى التي تملكها هذه الشخصية المعقدة للاعب طالما رقص على الخط الواهي الذي يفصل ما بين أخلاقيات اللعبة المحدودة وأخلاقيات اللعبة اللامحدودة.
بعد عقود طويلة من هدفه الجدلي سُئلَ مارادونا في مقابلة تلفزيونية مع البي بي سي: «هل كانت يدك أم يد الله؟» ليحفظ السجل إجابته الحقيقية، حين أجاب ببراءة طفل يعترف بمشاغبة قام بها؛ أنه فعلاً استخدم يده ليسجّل الهدف، وكان محظوظاً أن الحكم لم يلقطه. ولكنه دافع عن نفسه بالقول إنه كان يلعب في مباراة مصيرية، وشدّهُ الحماس لدرجة أنه لم يستطع مقاومة الدافع الداخلي للوصول إلى الكرة في تلك اللحظة. كانت الكرة قريبة وعصيّة في نفس الوقت. ما كان على يده إلا أن تتصرّف بما تعلّمت منذ صغرها، مثلَ الدافع الداخلي القوي لأن تحكَّ ظهرك أو تمدَّ ذراعيك لتفادي السقوط على وجهك. كان تصرّفاً أوتوماتيكياً لم يفكّر فيه لحظتها، فقد كان مجرد لاعب متحمّس في لعبة محدودة، أخذته اللحظة ودَقَّهُ الحماس كي يستخدم كل ما هو متاح بين يديه للفوز. وفاز.
منذ عامين مات مارادونا تاركاً وراءه أسطورة مثيرة ومعقّدة لعل أهمّ ما فيها هو الأثر الذي تركه في ذاكرة الناس العاديين. لاعب أعطى الأمل لشعب كامل، وأخذ على عاتقه مهمة أن يثأر لجروحاته ويصرخ بصوته. ثائر يتعاطى المخدرات. بطل قومي يسرق من السارق في مباراة إنكلترا ويسترجع الكرامة المسلوبة. وإن رحل تاركاً وراءه قميصاً ليس على مقاس أحد، تبقى لنا صوره وقصصه الكثيرة نضعها جنباً إلى جنب حتى لا تلغي إحداها الأخرى، من الطفولة الفقيرة وبداياته كمعجزة كروية عجائبية، إلى المرض والاكتئاب ومداواة النفس بالكوكايين والكحول التي كلّفته حياته، إلى قصص نشاطه الخيري والاجتماعي وعلاقته بالمافيا، إلى صورته وهو يحمل كأس العالم، أو تلك التي يُرقِّص فيها حبيبته الكرة على أنغام الموسيقى، أو حتى تلك اللحظة العابرة التي حفظتها له عدسة المصوّر وهو يخالف القانون. تلك الصورة الدامغة كدليل محكمة، والتي يظهر فيها اللاعب معلّقا في الهواء رافعاً رأسه مادّاً يده وفي ذهنه كأس العالم والحرب والفوز والخلود، فيلمس كرة اللعب بخفّة نشّال أو ساحر. تلك الخفّة التي كانت كافية ولازمة لمغافلة عين الحكم البعيد.