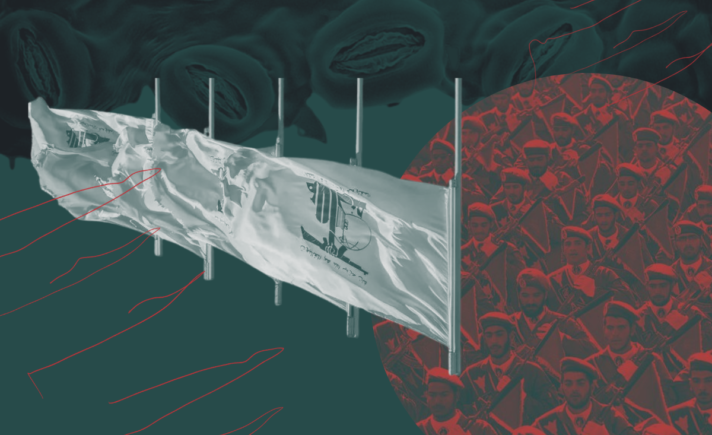أعلنت مديرية تربية دمشق قبل أيام عن البدء بإدخال «محتوىً خاص بالمفاهيم الجنسية» إلى المدارس السورية، في خطوةٍ اختلف عليها الشارع السوري بين مؤيدٍ ومعارض ومَن يراها متأخرةً قياساً بباقي الدول حول العالم. ولم يزل الحديث عن الجسد والجنس من بين التابوهات العديدة في المجتمع السوري وداخل الأسرة، مما يعرّض الكثير من الأطفال إلى تلقّي مفاهيم خاطئة حولهما من مصادر مختلفة غير موثوقة، لا سيما من زملاء وزميلات في المدارس والأحياء السكنية.
وتعاني البنات والأولاد على حدٍّ سواء من التحرش دون أن يكون لهم القدرة على تمييزه نظراً لعدم وجود توعية وتعليم جنسي سابق، وفي حال كان الطفل واعياً لما يحدث معه فقد كانت «أصول التربية» المتّبعة في مجتمعنا لا تتساهل في الحديث عن أمور كهذه، فيُفضّل السواد الأعظم من الأطفال كتم التجارب القاسية التي يعيشونها.
اليوم هناك عشرات آلاف الأسر السورية التي تعيش في أوروبا ويدرس أولادهم في مدارس تُقدّم التعليم الجنسي، والذي يبدأ في سنٍّ متفاوت بحسب الدولة، ويخوضون النقاشات عن محتواه ومدى مناسبته لأطفالهم القادمين من بيئةٍ مختلفة على صُعُد عديدة. ومع نية إدخال التعليم الجنسي إلى المدارس السورية، لا بد أن ينتقل هذا النقاش إلى داخل البلد، ولن يقف حينها عند حدود هل يجب أن يتلقى الأطفال التعليم الجنسي أم لا، بل سيصل إلى الخوض في محتواه وتفاصيله بشكلٍ أعمق.
سنركز في السطور الآتية على استعراض تجارب أهالي سوريين مع التعليم الجنسي في ألمانيا وفرنسا، وكيف انعكس ذلك على أطفالهم، وما هي الجهود التي بذلوها هم في المنازل لتحقيق التكامل مع التعليم الجنسي الرسمي في المدارس.
إرضاء شغف المعرفة دون انتظار المدرسة
لدى صبا طفلةٌ بعمر 8 سنوات، وهي تعيش في العاصمة الفرنسية باريس. لم تبدأ الطفلة بعد بتلقي حصص التعليم الجنسي في المدرسة، لكنّها تطرح الكثير من الأسئلة في البيت عن شكل الأعضاء «الحميمية»، ولديها كذلك فضولٌ للتعرف أكثر على عضوها. كانت بدايةً تطرح الأسئلة عن الكلمات المُستخدَمة لتوصيف الأعضاء الجنسية، وعن سبب وجود فتحاتٍ في جسدها، وإذا ما كان لكل الناس الفتحات نفسها؟ لم تكن لدى صبا إجاباتٌ واضحةٌ ومُثلى على تساؤلات ابنتها تالا، وبعد العودة إلى المستشارة النفسية للعائلة والبحث في الإنترنت، استعارت صبا كتاباً مخصصاً للتعليم الجنسي في سن 8 سنوات من المكتبة العامة في الحي الذي تسكنه، وكان أمامها خيارات عديدة، لكنها قرّرت اختيار كتابٍ وجدته الأكثر ملاءمةً لعمر تالا.
تعلّق صبا على هذه التجربة بالقول: «هناك ضرورة لوجود حالةٍ كاملةٍ من الانفتاح على الطفل لمناقشة كل المواضيع، ومن ضمنها الأسئلة الجنسية. أنا مع ما يُعرف بالتربية الإيجابية التي فيها الكثير من الاستماع والتّفهم، هذا يخلق علاقةً إيجابية مع طفلتي ويجعلها أكثر انفتاحاً على إخبارنا بما يحدث معها، بما في ذلك أشكال الإساءة المختلفة التي قد تتعرض لها». تعود صبا في ذكرياتها إلى أيام طفولتها، وتقول إن هذه الأشياء «لم نتعلّمها ولم نكن قادرين على الحديث عنها، لذا لم نكن نجيد التصرف عند تعرّضنا للتحرّش»، وتعترف أنه ما زال هناك بعض ما تسميه «الرواسب والعُقَد» العالقة في شخصيتها، والمتّصلة بكيفية تعامل المجتمع السوري مع الجنس والجسد، والتي تقوم أساساً على «التربية والحشمة»، وتحاول وسعها «ألّا تُمرّر هذا النهج لابنتها».
تحرص صبا على الكلام مع تالا عن وجود مناطق خاصة بها وحدها، وليس لأحدٍ الحق في لمسها: «الطفل-ة بعمر 8 سنوات يبدأ بلمس أعضائه ويشعر بها، ربما يعطيه ذلك إحساساً أشبه بالمسّاج الذي يُضفي نوعاً من التسلية والسرور. أخبرتها بوضوح أن بوسعها لمس نفسها في غرفتها أو في الحمام، ولكن ليس في الفضاء العام. قلت لها تستطيعين اكتشاف جسدك، ولكن مع الحفاظ على خصوصيتك».
لا يقف التعليم الجنسي الذي تحاول صبا تمريره لتالا عند هذا الحد، بل تدرك تماماً ضرورةَ تقديم إجاباتٍ تتناسب مع عمرها لجميع الأسئلة التي تطرحها، ومنها أسئلةٌ على غرار: مَن نستطيع أن نتزوج؟ ولماذا يستحي أحدنا؟ وما طبيعة علاقتنا مع أجسادنا؟ تضيف صبا: «أحبُّ أن تكون ابنتي مرتاحةً مع جسدها حيث تكون، ولكن لدي خوفٌ من البيدوفيليا، لذلك لا أحب أن تبدّل ملابسها إلا في مكانٍ مغلق. إحساسي وقناعتي يدفعني لفعل هذا رغم أنّه يهمّني جداً أن تكون مرتاحةً مع جسدها. أفعل هذا ريثما يكون بوسعها وضعُ شروطها وفهم محيطها، وعندها لها كامل الحرية في فعل ما ترتاح له».
يشغل موضوع تبديل الملابس خارج المنزل حيزاً من تفكير صبا، وهو بطبيعة الحال جزءٌ من منهجية المدارس الفرنسية لم يكن لدينا في سوريا ما يشابهها، لا سيما في دروس السباحة. تدعو صبا جميع الأهالي إلى تقديم التعليم الجنسي لأطفالهم في سنٍّ مبكرة بالاعتماد على الكتب: «هناك كتبٌ يمكن التعلّم منها بشكلٍ متدرّج ومتناسب مع عمر الطفل، وهي متوفرة في المكتبات العامة وبوسع الجميع استعارتها واستعراضها». شاركت معنا صبا صورة أحد الكتب التي استفادت منها في تقديم إجاباتٍ على الأسئلة التي طرحتها عليها تالا.

التعليم الجنسي المبكر في ألمانيا
يبدأ التعليم الجنسي في ألمانيا في سنٍّ مبكرة أكثر من فرنسا، فعندما وصلت ليا إليها كانت بعمر 6 سنوات، ودخلت مدرسةً ألمانية فور وصولها. كان من المفاجئ بالنسبة لأمها، لينا، أن تطلب المدرسة منها التوقيع على ورقةٍ تتيح لابنتها الالتحاق بحصص التعليم الجنسي: «ترددتُ قليلاً، ومردُّ ذلك التردّد أن ابنتي كانت قد طرحت عليّ مجموعةً من الأسئلة من نوع كيف أتيتُ إلى الدنيا؟ وكنت قد أجبتُها، مثل كثيرٍ من الأمهات، أنها أتت من وردةٍ بيضاء. اقتنعت ليا بالفكرة حينذاك، ولكنها تمنّت لو أنها أتت من وردةٍ زهرية. مع تذكّري لهذا المثال خشيتُ أن تتعرف على أشياء مختلفة في المدرسة، فتجد أني كنتُ أكذب عليها، مما سيؤثر على علاقتنا وطريقة تلقيها للمعلومات مني».
حاولت الأم لينا أن تفهمَ أكثر من إدارة المدرسة عن محتوى حصص التعليم الجنسي، فكان الرد بأن المعلومات في هذه السن تقتصر على الأوليّات؛ مثل التعرف إلى أعضاء جسد الإنسان. تستدرك لينا: «أنا لم أستنكر فكرة التعليم الجنسي، ولكنّي استغربتُها بعض الشيء لأني لم أكن متعودةً على الحديث مع الأطفال وتثقيفهم هذا المجال. أعجبتني الفكرة وبدأتُ أنا أيضاً بتعليم ليا من خلال أمثلةٍ على العصافير والحيوانات، وأُردّد أننا كبشر لدينا مواصفاتٌ وسلوكٌ مشابه. صرتُ أبحث عن الطرق الأمثل لتقديم المعلومات، وهَمّي أن يكون ما تتعلمه في البيت متناسقاً مع ما تتلقاه في المدرسة، وحرصتُ من خلال تقديم المعلومات على ألّا تكون ليا ساذجةً أمام زملائها».
باتت ليا اليوم مُراهِقةً في عمر الخامسة عشرة، ولا تدرس في مدرسةٍ حكومية ألمانية، وإنما في إحدى المدارس الدولية في العاصمة برلين، والتي تعتبرها الأم «مُحافِظةً مقارنةً بالمدارس الحكومية». تلاحظ الأم أثر التعليم الجنسي إيجابياً على حياة ابنتها: «علّموها منذ سنٍّ مبكرة عن التحرّش الجنسي، وعن وجوب منع أقرب الناس من الاقتراب من أماكننا الخاصة، كما عرّفوها على كيفية التصرّف في حال كان التحرّش داخل إطار العائلة، وزوّدوها بالرقم الهاتفي الذي يمكن الاتصال به في حال لم يتصرف الأم أو الأب عند تعرّضها للتحرّش، أو إذا كان أحدهما طرفاً في التحرّش».
تُشير لينا إلى أنّ بعض الأهالي السوريين في ألمانيا يعترضون على التعليم الجنسي في المدارس بدعوى أنه «يوعّي الأطفال بأمورٍ لا يجب أن يعوها في سن مبكرة. لا أوافقهم الرأي، وأجد أن الطفل يسعى بنفسه للمعرفة، ومن الأجدى أن تكون من مصادر موثوقة. في المدارس لا يوجّهون عيون الأطفال إلى أشياء لا يعرفونها، وإنما يقدّمون لهم فهماً لما يحدث معهم. أنا في مواقف عديدة من طفولتي تعرّضتُ للتحرش، ولكن لم أكن أدرك أنه تحرش، وإذا أدركت ذلك كنت أخاف الحديثَ عنه بسبب غياب التوعية الجنسية عن مجتمعنا. ابنتي تعرف هذه الأشياء بفضل التعليم الجنسي الذي تلقته، وتعرف كيف تضع الناس عند حدودهم إذا تعلّق الأمر بجسدها أو حين تشعر بالمضايقة، وهي قوية الشخصية».
التعليم الجنسي في ألمانيا، كما هو الحال تقريباً في فرنسا، متدرّجٌ بما يتناسب مع الشريحة العمرية للطفل، وكثيراً ما يكون من خلال أنشطة. تعرّفت ليا على الأعضاء الجنسية من خلال زيارة متحفٍ مخصصٍ لذلك في برلين، وقد تزور تالا مع مدرَستها الفرنسية أماكن مشابهة حين تكون أكبر سنّاً. تتّفق لينا مع صبا بأن الانفتاح على الطفل-ة وحالة النقاش الدائمة يجب أن يكونا أساس العلاقة، كما تتشارك معها الخوف من البيدوفيليا، ولذا كانت تمنعُ أيّ أحدٍ من وضع ليا في حضنه مذ كانت صغيرة. تكرّر لينا كلمات صبا نفسها بما يتعلق بالخصوصية: «أقول لها إنّ جسدك ملكك وليس ملك الآخرين، وأنتِ الوحيدة الحرة في التصرّف به».
اليوم صارت ليا في سن المراهقة، والتركيز بحسب ما تقوله والدتها منصبٌّ على أن تكون آمنةً في حال قررت أن تكون في علاقة، وهي تدرك ذلك تماماً: «قبل فترة قدّمت محاضرةً أمام زملائها وزميلاتها في المدرسة عن الأمراض المنقولة عبر الجنس وكيفية الوقاية منها. سعيدة بأن ابنتي بعمر 15 سنة تدرك هذا كله».
تقييم لتجربة التعليم الجنسي خارج سوريا
قبل 8 سنوات وصل رامي إلى فرنسا بصحبة عائلته، وكان آنذاك في عمر الحادية عشرة، ولم يكن قد تلقَّى وقتها أيّ نوعٍ من التعليم الجنسي في المدرسة. يعزو رامي ذلك إلى صغر سنه، ولا يدري إذا كان ذلك التعليم متوافراً في المدارس السورية، ولكنه يقول إنه وزملاءه كانوا يتبادلون بعض النكات الجنسية في المدرسة، ولكنها لم تكن مباشرةً وتسمّي الأعضاء بأسمائها، وتقوم أساساً على «التشفير». تفاجأ رامي، الذي صار اليوم طالباً جامعياً، باختلاف طريقة طرح النكات في فرنسا ومباشَرتها وتسميتها لكل شيءٍ كما هو. قال إنه كان مصدوماً في البداية، ولكن مع مرور الوقت تعوّد أن يكون مثل زملائه، وصار هو أيضاً يشارك في إلقاء النكات.
أما التعليم الجنسي بالنسبة لرامي، فلم يبدأ في المدرسة حتى سن الثالثة عشرة: «المرة الأولى كانت حين قَدِمتْ ممرضةٌ إلى المدرسة، وكان درساً قصيراً جداً، وكان لدى الطلاب أسئلةٌ كثيرةٌ وفضولٌ كبيرٌ لا تكفيه ساعةٌ واحدة. ركّزت الممرضة حينها على كيفية منع الحمل في سن المراهقة، وعلى دفعنا باتجاه استخدام الواقيات الذكرية. فَصَلت المَدرسة حينها الذكور عن الإناث حتى يكون الجميع مرتاحاً في طرح الأسئلة، ولكن حتى هذا الفصل لم يكن مريحاً بالنسبة للطلاب والطالبات مثليي الجنس، لا سيما أن مدرستي تقع في أحد أحياء باريس الشعبية، ويكاد يكون مستحيلاً على الطلاب والطالبات التصريح بميولهم وهويتهم الجنسية في حال لم تكن غيرية».
لا يرى رامي أن تلك الساعة كانت كافية، وبقي في داخله الكثير من الأسئلة المتصلة بالجنس والجسد، لكنّه لم يلجأ لأساتذته أو لعائلته. يُعلِّقُ على ذلك: «هم من جيلٍ مختلفٍ لا يُعنى بالأسئلة نفسها، وليس لديهم الإشكاليات الراهنة نفسها التي يعيشها جيلنا. بالنسبة لعائلتي، ورغم الانفتاح على الحوار، فهي قادمةٌ من بلدٍ آخر له سياقاته المختلفة بعض الشيء، ولذا كنت أفضّل البحث عن إجاباتٍ لأسئلتي على الإنترنت».
كان من اللافت عند سماع رامي أن التعليم الجنسي المباشر في مدرسته اقتصر فقط على ساعةٍ واحدةٍ مع الممرضة، وهذا يسلّط الضوء على تفاوتٍ في التعليم داخل البلد الواحد أو المدينة الواحدة تبعاً لموقع الحي والطبقة الاجتماعية التي تسكنه ومدى تنوّع خلفيات سُكّانه. يُفصِّلُ رامي في هذه النقطة بالقول: «هو حيٌّ شعبي له خصوصيته، وفي المدرسة بذلوا جهدهم، ولكنه لم يكن كافياً لأن الأسئلة في بدايات البلوغ والمراهقة وتشكّل الوعي الجنسي كثيرةٌ جداً. كنا أحياناً نجد إجاباتٍ لدى زملائنا الذين لديهم تجارب جنسية سابقة، فهناك التعليم الرسمي والتعليم عن طريق تبادل الخبرات بين الأصدقاء، كما يوجد الكثير من الشهادات المنشورة على الإنترنت ويمكن الإفادة منها».
يلفتُ رامي إلى أن الفرنسيين أيضاً ليسوا مرتاحين تماماً بالحديث عن الجسد والجنس مع عائلاتهم، ولكن «قد يكون ذلك أكثر صعوبةً داخل عائلات المهاجرين». ويستذكر أنه، في المرة الأولى التي شاهد فيها مقطعَ بورنو مصوّر، لم يكن هو الذي بحث عنه، وإنما كان زملاءٌ له في المدرسة قد عرضوه عليه في غرف تبديل الملابس: «كان هؤلاء الزملاء من الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الحديث مع أهاليهم بسبب القيود الاجتماعية والدينية، وكانوا الأكثر حديثاً عن الجنس من دون أيّ معرفةٍ عنه، وكانوا أكثر من يلقي النكات الجنسية».
تخوّفات أحمد وسارة
يعيش أحمد وسارة في فرنسا منذ أربع سنوات تقريباً، ابنتهم الكبيرة يُمنى بعمر الثامنة، ولديهم توأمٌ ذكور بعمر السادسة. لم يبدأ التوأم أيّ تعليمٍ جنسي في المدرسة أو البيت، في حين اقتصر ما تَعلّمته يمنى على أسماء أعضاء جسدها. تقول أمها إنها في الغالب تعلّمت أسماء الأعضاء من أقرانها في المدرسة وليس عن طريق المدرّسين-ات، وحتى الآن لا يبدو واضحاً للزوجين إذا كان الوقت المناسب لتقديم معلومات حول الجسد والجنس قد حان فعلاً، ولكنهم يحرصون، مثل جميع مَن قابلناهم-نّ، على التحدث مع أولادهم عن ضرورة منع أيّ أحدٍ من لمسهم. تقول سارة إن المدرسة علمتهم ذلك أيضاً، حتى أن المساعِدة التي ترافقهم في المدرسة لا تذهبُ معهم إلى الحمام «احتراماً لخصوصيتهم ولتجنيب الأطفال أن يكونوا عرضةً للتحرّش».
سألنا أباهم عن الأسئلة التي يطرحونها عليه حول أجسادهم وطبيعتها، فقال إنهم «كانوا أكثر فضولاً بين سن الثالثة والخامسة مما هم عليه اليوم، وأكثر رغبةً بالتعرف إلى أعضائهم، وكانوا يلاحظون الفروقات الفيزيولوجية بينهم وبين أختهم، كما كانوا أكثر جرأةً في طرح الأسئلة، فمع تقدّم عمرهم يبدو أنها صاروا يجدون حرجاً في الأمر». تُعلِّقُ الأم على كلام زوجها: «سألتني يُمنى مثلاً لماذا لدى والدي شعرٌ تحت إبطه، وحاولت أن أجيبها بما أعرف، ولكنّي عدتُ للاستعانة بيوتيوب وشاهدنا معاً درساً موجهاً للأطفال حول هذا الأمر. ليس بوسعي الإجابة عن جميع الأسئلة، لذا أَستعين كثيراً بالإنترنت».
يُصرّح الوالدان بأن سؤال التعليم الجنسي يراودهم دائماً، ولكنهم لا يعرفون تماماً إذا كان الأنسب أن يبادروا بأنفسهم أم أن ينتظروا حتى يطرح أطفالهم الأسئلة، لا سيما أنهم قد يتعلمون العديد من الأمور عن طريق زملائهم. يضيف أحمد: «لكل طفلٍّ خصوصية، وتختلف مدى رغبة كل منهم في النقاش حول هذه الأمور، لكنّي أعتقد بضرورة أن نبدأ معهم التعليم الجنسي منذ الآن، لأنّ المدرسة ستتأخر في ذلك حتى سن الثالثة عشرة تقريباً».
يرى أحمد أنه مهما قدَّمَ من معلومات لأطفاله، فإنهم سيكونون أكثر تأثّراً بمحيطهم خارج المنزل، ويعترف أنه يخشى من اكتساب أطفاله «بعض القيم الجنسية» التي لا تتوافق مع معتقداته ومعتقدات أُمهم، لكنه يعود للقول: «اخترنا الوجود في هذا المكان ذي القيم المختلفة، ودوري هو تعزيز القيم التي أراها صائبةً. سأفعل ذلك حتى مرحلة المراهقة، وحينها سيقررون ما سيرونه مناسباً لهم، غير أني أجهّز نفسي منذ الآن لقبول اختلاف أطفالي معي، ولأكون أكثر انفتاحاً وقدرةً على التواصل معهم».
موضوع المثلية الجنسية وكيفية تعامل أطفالهم معها من بين الأسئلة التي تشغل سارة وأحمد، لا سيما أنهم «يطرحون منذ الآن أسئلةً حول إمكانية وجود ‘أبوين’ أو ‘أمّين’». سألنا الأبوين عن الكيفية التي سيتصرفون وفقها، فقال الأب: «سأحاول إفهامهم أن هذا لا يتوافق مع معتقداتنا، ولكن سأركز كثيراً على أن يحترموا خيارات الآخرين، وسأسعى لزراعة قيمٍ عامة دون الدخول في التفاصيل. أنا لن أخالف ديني، ولكني لن أخالف حرية الآخرين أيضاً. سأتعامل مع الأمر تماماً كما فعلتُ حين سألوني عن لحم الخنزير، فكانت الإجابة بأننا مسلمون لا نأكل لحم الخنزير، ولكن لكل أتباعِ دينٍ قواعدُ يتبعونها، والكثير من الناس يأكلون لحم الخنزير. عندما يكبرون سيُحددون موقفهم من هذه القضايا دون قسرٍ من طرفي أو طرف والدتهم».
التعليم الجنسي في المدارس لا يكفي
بعد الاستماع إلى صبا ولينا ورامي وسارة وأحمد، توجهنا إلى فاطمة إبراهيم، وهي باحثة والمديرة التنفيذية لمبادرة ذا سكس توك بالعربي، ببعض الأسئلة المتعلقة بما ذكروه. سألناها كيف يمكن للأهالي القادمين حديثاً إلى أوروبا من سوريا التوفيق بين معتقداتهم الأخلاقية والقيمية والدينية وما يتلقاه أولادهم في حصص التعليم الجنسي. تقول فاطمة إبراهيم: «على الأهالي فهم أن التعليم الجنسي والمعرفة بشكلٍ عام لا يتعارضان أبداً مع الأخلاق أو المعتقدات الدينية أياً كانت. فالتعليم الجنسي في الأساس يتمحور حول المعرفة بحقوق الجسد من خصوصية وأمان، وطرق الاعتناء بصحة أجسادنا». وهي تُفكّك من خلال الأسئلة التي تُطرَح عليها عادةً بعضَ المفاهيم الخاطئة لدى الأهالي: «الكثير من الناس عندما يسمعون مصطلح تعليم جنسي يظنّون أنه دعوة لتعليم الأطفال والمراهقين فنون ممارسة الجنس، وهذا ليس صحيحاً. التعليم الجنسي يختلف حسب الفئة والمرحلة العمرية، لكن الأساس في كل المراحل هو تعليم الأفراد عن ملكيتهم لأجسادهم وحقهم في الخصوصية والحرية والأمان، وكيف يأخدون قراراتهم بشكلٍ واعٍ، ودون السماح لأيّ أحدٍ باستغلالهم أو ابتزازهم».
أشارت لينا في حديثها معنا أنها كانت تخشى، أولَ علمها بوجود تعليم جنسي في المدرسة، أن يحصل نوعٌ من التضارب في المعلومات بين ما سبق أن قالته لابنتها وبين ما ستتعلمه في المدرسة، فعمدتْ إلى تجسير هذه الاختلافات المحتملة عبر مزيدٍ من الاطلاع وأخذ استشارة المساعِدة النفسية التي تشرف على ليا. ولكن هذا قد يكون غائباً عن عديد العائلات التي تحاول زرع معتقداتٍ وقناعات اجتماعية ودينية في أولادها وبناتها، والتي قد تكون مختلفةً تماماً عما سيسمعونه في المدرسة، مما قد يخلق نوعاً من التشويش في أذهان الأطفال. تُعلِّقُ فاطمة على هذه النقطة بالقول: «الأطفال دائماً عرضةٌ لآراء وأفكار ومعتقدات مختلفة ومتصارعة، خاصةً أطفال المهاجرين بشكلٍ عام، ويزداد ذلك حالياً مع وجود وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تكسر حواجز جغرافية كثيرة وتفتح الباب لاستقبال أفكارٍ وثقافاتٍ متنوعة. دور الأهالي أن يفهموا هذا الواقع، وعليهم خلقُ مساحةٍ آمنة بينهم وبين أولادهم تجعل منهم مصدرَ المعلومة الموثوق. الحفاظ على أمان الأطفال يقتضي وجود مساحةٍ للتواصل المفتوح والحر، وأن يُدعَم الأطفال للحصول على معلومات من مصادر صحيّة وصحيحة».
تجد فاطمة إبراهيم، من خلال تواصل الأهالي معها والأسئلة التي تطرح عليها، أن موضوع التعليم الجنسي للأطفال والمراهقين صار يشغل حيزاً كبيراً من تفكير الأهالي، وأن الحديث عن أهمية التعليم الجنسي عبر الإنترنت يتّسع، كما أن حوادث الاعتداءات على الأطفال باتت منتشرةً جداً وهناك تقارير تتحدّث عنها وتوثّقها. تعلّق على هذه النقطة: «وضعَ هذا كثيراً من الأهالي أمام الأمر الواقع، وصار عليهم هم أنفسهم أن يتلقوا تعليماً جنسياً ويبدأوا بتعليم أطفالهم لحمايتهم. الكثير من الأهالي ما زالوا يرفضون التعليم الجنسي الإيجابي والشمولي، والذي يضمّ محادثاتٍ عن المتعة والتنوّع في الجنسانية والهويات والميول الجنسية. مع ذلك، فإن أغلب الأهالي الذين أعملُ معهم يدركون أهمية وجود مساحةٍ بينهم وبين أولادهم للحديث عن حقوقهم الجسدية وطرق الحماية. ورغم بطء العملية، إلا أن بعض الأهالي صاروا يدركون أهمية أن تستمر هذه المساحة من الطفولة وحتى البلوغ».
سألنا فاطمة عن كيفية المُكاملة بين التعليم الجنسي في المدارس والنصائح التي يقدمها الأهالي، فأوضحت أنه بالرغم من أن هذا النوع من التعليم متاحٌ في كثيرٍ من الدول الأوروبية، إلا إنه يظل تعليماً جنسياً بدائياً لا يمتد لأبعد من المعلومات التقليدية عن أسماء أعضاء الجسد والأمراض المنتقلة جنسياً وطرق الحماية منها، وهذا ما يتفق فعلياً مع ما سمعناه في المقابلات التي أجريناها، ولذا ترى أن «على الأهالي أن يأخذوا المهمة على عاتقهم من خلال تزويد أبنائهم وبناتهم بتعليمٍ جنسي أكثر شموليةً وإيجابيةً، لما لذلك من إيجابياتٍ مثبتةٍ علمياً».
زوّدتنا فاطمة إبراهيم ببعض الدراسات والإحصائيات التي توصّلت إلى أن التعليم الجنسي الإيجابي في مراحل الطفولة والمراهقة يقلّل بشكلٍ كبيرٍ من قرار ممارسة الجنس في سنٍّ مبكرة، كما يُقلّل من حالات الحمل غير المرغوب فيه بين المراهقات، وأيضاً من حالات عدوى الأمراض المنتقلة عبر ممارسة الجنس، كما أنه عنصرٌ أساسيُّ وفعّال في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ويساعدهم على بناء علاقةٍ أكثرَ صحيةً مع أجسادهم، وترى أن ذلك «مهمٌّ جداً في ظلّ انتشار ثقافة الدايت ومفاهيم الجمال الإقصائية والمُضرّة».