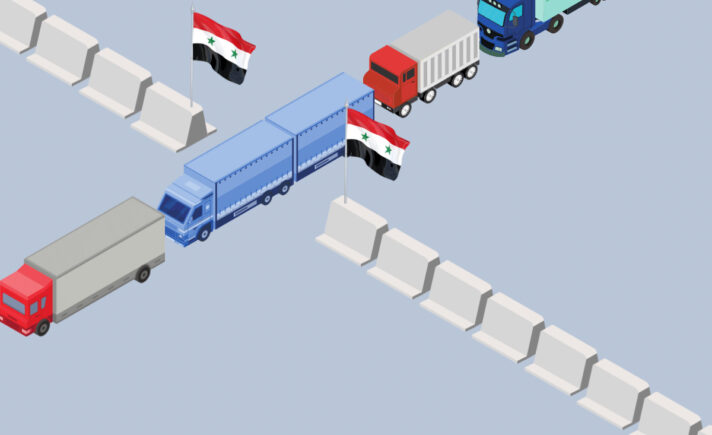يعيش السوريون اليوم في مناطق سيطرة النظام السوري أوضاعاً شديدة الصعوبة، حتى بالنسبة للذين يحققون دخلاً فوق المتوسط، إذ تضربُ البلادَ أزمةُ محروقات جديدة أدّت إلى شلل في قطاعات النقل والإنتاج الرئيسية. في قطاع الكهرباء تحوّل التقنين المُكثَّف إلى انقطاعات شبه دائمة في مناطق كثيرة، مع انهيار للخدمات البلدية والحكومية الأساسية، وعدم قدرة على تأمين أي من المتطلبات الرئيسية بشكل مستقرّ، مثل الخبز.
اقترح مسؤولون في النظام تعطيل الدوائر الرسمية والمدارس لتقليل استهلاك المحروقات، وعلى خلاف المرات السابقة التي أُطلِقت فيها وعود بوصول شحنات وقود جديدة ستنهي الأزمة الحاصلة، فإنّ التصريحات الحكومية الحالية بدأت ترفع عن نفسها المسؤولية، وتعطي صورة سوداء للوضع الذي لا تتحكم به، في غياب أي حديث عن أمل قريب بنهاية أزمات الوقود المتكررة.
الوضع مقلق للغاية في سوريا اليوم، وتُنبئ التصريحات الحكومية الأخيرة وطريقة التعامل مع الأزمة بمآلات كارثية، إذ إنّ الانهيار الحاصل في سعر صرف العملة السورية أمام العملات الأجنبية هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات سعر الوقود الأحفوري عالمياً إلى مستويات عالية جداً، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل اقتصادية وسياسية أخرى، أمورٌ أدَّت إلى أن يصبح العجز الكبير أصلاً في الميزانية الحكومية أكبر.
وفي غياب أي اقتراح من حكومة النظام يمكن التعويل عليه لوقف التدهور، فإنه من غير الواضح ما هو الحل الذي سينجح في وقف هذه الأزمات المتتالية المتفاقمة وتحسين الوضع القائم. هناك اقتراحات من جانب النظام ومسؤوليه تتركز حول رفع العقوبات، وحديث عن فرص استثمارية. لكن، هل سيكون ذلك مجدياً فعلاً؟
لنفترض أنّ النظام الدولي، وتحديداً الدول الغربية، قررت تجاهل النظام السوري تماماً، أي رفع العقوبات عنه ورفع قيود التجارة معه نهائياً، بالتزامن مع بقاء نظام الأسد كما هو دون تقديم أي خطوات نحو حلّ سياسي حقيقي. لنفترض أن العلاقات عادت بين النظام السوري ودول الخليج بما فيها السعودية، بالإضافة تركيا، بطريقة شبه طبيعية، باعتبار أن هناك مؤشرات اليوم في هذا الاتجاه على صعيد العلاقات الثنائية، فهل سيقود ذلك إلى عودة الاستثمارات الخارجية إلى سوريا؟
أفقٌ مغلق للاستثمارات الخارجية
بحسب بيانات البنك الدولي، شهدَ العام 2009 أعلى معدّلات للاستثمار الخارجي في سوريا منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقتها، حيث بلغت الاستثمارات الخارجية فيه 2.57 مليار دولار أميركي. تشير نظرة أكثر تفصيلية إلى أن جزءاً كبيراً من تلك الاستثمارات تركزَّ في قطاعي النفط والغاز والقطاع العقاري، فيما كانت القطاعات الصناعية والإنتاجية الرئيسية تعتمد على رأس المال المحلّي بشكل أساسي.
أُصيب قطاع النفط والغاز بضربات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة العمليات العسكرية والقصف المباشر وإهمال الآبار، ما أدّى إلى تراجع الإنتاج وتوقفه في بعضها. كان إنتاج سوريا من النفط عام 2011 لا يتجاوز 385 ألف برميل يومياً، فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي حالياً نتيجة الأضرار التي أصابت هذا القطاع نحو 85 ألف برميل يومياً، يصل منها إلى مناطق سيطرة النظام حسب تصريحات حكومية 16 ألف برميل يومياً، في حين تقع الحقول الأكبر خارج سيطرته العسكرية المباشرة. أما القطاع العقاري، فقد أُصيب بضربات هائلة نتيجة العمليات العسكرية ونتيجة القصف الممنهج من قبل قوات النظام السوري وحَليفيه الإيراني والروسي، فيما لا تجد مشاريع التطوير العقاري التي بدأها النظام منذ سنوات مستثمرين كبار راغبين بالاستثمار في مناطق تشهد مطالبات حقوقية للمالكين تتعارض مع ما فرضته الحكومة من أمر واقع، فضلاً عن العمل في ظل قوانين مشكوك في مصداقيتها، وقبل كل شيء في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة أو مصادر طاقة مستقرة بأسعار تنافسية.
لنفترض أنّ العقوبات توقفت، فهل ستصل الاستثمارات الخارجية بعد رفع العقوبات عن سوريا إلى 2.57 مليار دولار، وهو الرقم الأقصى الذي لم تتجاوزه مستويات الاستثمار الأجنبي في البلد قبل ذلك التاريخ ولا بعده. وحتى في حال حدوث ذلك، هل يمكن لمبلغ مليارين ونصف المليار أن يحلّ مشكلة بلد بلغت خسائره نتيجة الحرب 442 مليار دولار؟
إضافةً إلى ذلك، ما هي التنافسية التي يقدمها الاقتصاد في بلد مدمر حرفياً، لا توجد فيه مصادر طاقة رخيصة وتمّ نفي جزء كبير من الأيدي العاملة المدربة فيه كلاجئين حول العالم. لن تستطيع أي استثمارات في مجال الصناعة في سوريا أن تنافس الصناعات في المنطقة، أو في الأسواق الأوروبية التي كانت واحدة من أكبر أسواق التصدير السورية، أما الامتيازات التي حصل عليها الاقتصاد السوري نتيجة اتفاقات اقتصادية مع تركيا فقد انتهت مدتها الزمنية اليوم، ولا يمكن للصناعة في سوريا أن تنافس في السوق التركي الكبير.
أما بالنسبة للسوق المحلي، الذي يشهد عجزاً كبيراً في الطلب نتيجة انخفاض قيمة الأجور وانتشار الفقر، فإنه لن يكون مغرياً لأي مستثمر، إذ أين هي الأرباح من العمل في سوق بلد تعيش الغالبية العظمى من سكّانه تحت خط الفقر أو على مقربة منه. أما بخصوص الموارد الطبيعية، فإنّ سوريا بلد فقير بها أصلاً، إذ لا يوجد سوى مادة الفوسفات التي تسيطر عليها موسكو بالإضافة إلى النفط والغاز. وبالنسبة للموقع الجغرافي، فإنّه لا يقدم ميزة كافية أو حاسمة تجعل الاقتصاد السوري قادراً على المنافسة، عدا ربما على صعيد تجارة المخدرات.
في ظل مثل هذه الأوضاع، لن تُقدِّمَ الدول الغربية واليابان، وهي الدول المرشحة بشكل أساسي لتقديم منح إعادة الإعمار، أي مبالغ فوق تلك التي تدفعها حالياً لتمويل القطاع الإنساني، والتي تأثرت أصلاً بالأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 والأزمة التي خلقها الغزو الروسي لأوكرانيا. في حين أنّ الصين، وهي الدولة الأكثر قدرةً بين الدول العالمية على تنفيذ استثمارات كبيرة في سوريا بوجود النظام السوري، فهي لم تقم حتى اليوم بتوقيع عقود أو تنفيذ أي مشاريع كبرى، وكان استثمارٌ صينيٌ سوريٌ مُشترَك هو الاستثمار الوحيد خلال السنوات الماضية لشركات خاصة صينية، ولم تتجاوز قيمة هذا المشروع 660 ألف دولار حسب بيانات هيئة الاستثمار السورية في العام 2019.
مشاريع البنية التحتية ستكون بدورها خاسرةً في ظل استمرار الفقر وانخفاض قيمة الأجور، إذ إنّ مشروعاً للنقل العام في العاصمة دمشق على سبيل المثال سيكون خاسراً اليوم نتيجة عدم قدرة السكّان على دفع أجور تضمن هامشاً من الأرباح، ناهيك عن قدرة مثل تلك المشاريع على إعادة قيمة تكاليفها. لن تُقدِّمَ الصين مشاريع استثمارية كهبات أو هدايا اليوم، خاصةً أنّ اقتصادها يعاني من صعوبات قد تؤدي إلى الانكماش وأزمات في قطاعات رئيسية مثل قطاع التطوير العقاري، دون الحديث عن عدم رغبة الصين الواضحة في الاستثمار في بلد غير مستقر مثل سوريا.
أما بالنسبة لحلفاء النظام الأقرب في طهران وموسكو، فإن إيران تعاني من مشاكل سياسية واضطرابات نتيجة الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الحاكم بالإضافة إلى عقوبات أمريكية قاسية، في حين تعاني روسيا الأمرّين نتيجة العقوبات الاقتصادية القاسية التي تلت غزوها لأوكرانيا. الانقطاعات في توريدات الوقود القادمة من الدولتين، والتي تسببت بالأزمة الحالية وأزمات سابقة، مؤشرٌ على مدى قدرتهما على تقديم العون للنظام السوري اقتصادياً.
رجال الأعمال المحليون خائفون
قد يكون الخيار الأساسي بالنسبة لسوريا هو دفع الاستثمارات المحلية لتنمو بشكل مضطرد، في ظل جفاف الاستثمارات الخارجية أو عدم قدرتها على تحريك السوق السوري بشكل فعّال، لكن من أين ستأتي الاستثمارات المحلية؟
رجالُ الأعمال الكبار، الذين كانوا في الفترة بين 2000 و2010 أبرز المستثمرين في القطاعات الإنتاجية في البلد، مثل محمد كامل صباغ شرباتي وزهير غريواتي، خرجوا من سوريا بلا عودة ربما، إذ كيف ستقنع رجل أعمال بالعودة للعمل في سوريا المدمرة، حيث سيكون رأس ماله مهدداً بشكل دائم نتيجة وصول الفساد إلى مستويات غير مسبوقة في بلد كان يعاني أصلاً، في أوضاعه الأكثر استقراراً، من مستويات فساد عالية وسيطرة كبيرة من العائلة الحاكمة والمقربين منها على قطاعات الاقتصاد السوري. هذا بينما تحقق استثماراتهم أرباحاً مرتفعة في الخارج.
كذلك عانى قطاع المنتجين المتوسطين والصغار طوال السنوات الثلاث الماضية من عمليات ابتزاز واسعة ومن عدّة جهات، وأيضا ًمن ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد نتيجة فرض الحواجز الأمنية وتلك التابعة للفرقة الرابعة خوّات عالية عند نقل البضائع محلياً أو خارجياً، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الطاقة مؤخراً وارتفاع تكاليف المستوردات نتيجة تدهور سعر العملة المحلية وعدم وجود أسواق كافية للتصدير. كل ذلك أدّى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تراجع هذا القطاع. صورُ أسواق حلب القديمة، التي تمّ تجديدها وترميمها لكن دون عودة أصحاب المحال، مؤشرٌ على عدم رغبة التجار على العودة والاستثمار في البلد.
وفوق كل ذلك، لا يبدو أنّ عوائد تجارة وتصنيع المخدرات قد انتقلت كلّها أو بعضها إلى السوق السوري، وكانت التقديرات تتحدث عن عوائد بلغت 5.7 مليار دولار في العام الماضي 2021 لوحده كما أشار تحقيق لصحيفة دير شبيغل الألمانية، لكن تَحسُّناً في الاقتصاد السوري لم يحصل كانعكاس لتُوفُّرِ عوائد مالية كبيرة، وهو ما يعني انتقال معظم تلك العوائد إلى خارج البلاد وعدم مشاركتها في العملية الاقتصادية.
بلغ معدّل الاستثمار الأجنبي في سوريا عام 2019، وفق أسعار صرف العملة في ذلك العام، ما يقارب 52.5 مليون دولار حسب تقرير صادر عن هيئة الاستثمار الحكومية، ولا يبدو أنّ أحداً يريد أن يدفع أكثر من ذلك في بلد لم يستقطب في أحسن أحواله في ظل حكم نظام الأسد استثمارات أجنبية أو محلية كبيرة.
سياسات اقتصادية متعثرة
بالإضافة إلى كل تلك العوامل، فإنّ أسلوب إدارة البلاد الحالي لا يُنبئ أبداً عن أي تدابير صائبة أو دراسة حقيقية، فقد كانت القرارات الاقتصادية أحياناً تُنتِجُ أوضاع مضرة بنظام الأسد نفسه، مثل عمليات الابتزاز المالي المستمرة التي أخافت صناعيين وتجاراً استمروا في العمل في سوريا حتى سنوات قليلة مضت، وكذلك طريقة طرح المشاريع الاستثمارية في أُطُر قانونية غير واضحة وغير فعّالة، وتنجم عنها انتهاكات لحقوق الملكية على نطاق واسع كما في القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بتدوير الأنقاض، الذي عَمَّقَ انخفاضَ الثقة بالسوق السوري في ظل حكم النظام الحالي.
كما أدّت السياسات النقدية بشكل مباشر إلى زيادة التضخم بدل التحكّم به، وتغطية العجز بعجز أكبر منه، عدا عن ابتزاز رجال الأعمال الموجودين بمن فيهم المقربون من النظام في ظل انتشار غير مسبوق للفساد في الإدارات الحكومية، وانهيار الخدمات الأساسية دون أي اكتراث من الجهات الحكومية الفاعلة، وانتشار عصابات الخطف والسلب المدعومة من أجهزة أمنية ومراكز قوى في النظام.
ليس هناك حلّ ممكن في وجود النظام الحالي بالتركيبة وطريقة الحكم الحالية. لا يمكن للفساد المقترن بالدكتاتورية، بالإضافة إلى بلد مدمر بلا بنى تحتية وشعب يعيش تحت خط الفقر بعد أن هُجِّرَ أكثر من ربعه إلى الخارج، أن يُنتَجَ أي تحسن اقتصادي مهما كانت الظروف المحيطة. وحتى بوجود دعم دولي، فإنّ جزءاً غير قليل من تلك الأموال ستنتقل إلى الخارج مجدداً بسبب الفساد. في الحقيقة، إنّ الكشف المتكرر عن فساد كبير طال العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة النظام سيؤدي تدريجياً إلى تراجع الدعم الإنساني الدولي، لا إلى زيادته.
منذ أسابيع، طلبت وزارة الخارجية في حكومة النظام من الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تغطية تكاليف سفر وإقامة الوفد السوري من أجل حضور اجتماع دوري حول عملية إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا بموجب قرار مجلس الأمن 2118، وهددت بعدم الحضور في حال عدم تغطية تكاليف تنقُّل الدبلوماسيين التابعين لها. حكومة الأسد مفلسة منذ الآن حرفياً، وغير قادرة على دفع تكاليف سفر وفد تابع لها إلى بيروت.
ستشهد الأزمة الحالية انفراجاً نسبياً قريباً مع وصول سفن التي تحمل النفط إلى ميناء بانياس، لكن الأوضاع تتجه في العموم إلى التدهور، ولا تنبئ طريقة تعامل النظام السوري معها بأي فرصة لإيجاد حلّ يوقف هذا التدهور. لم يقم النظام السوري، وتحديداً بشار الأسد ومحيطه العائلي، بتنفيذ أي استثمارات إنتاجية كبيرة في البلد، بل اعتمدوا دوماً على التحكم بالقطاعات الخدمية التي تدّرُ عائدات مضمونة دون أن تتطلّبَ رأس مال كبيراً، مثل قطاعات الاتصالات أو الوقود الأحفوري، بينما تُرِك رجال الأعمال المحليون ليبنوا المصانع القادرة على تشغيل أعداد كبيرة من السوريين. لقد تُرك هؤلاء لمصيرهم تماماً عند الأزمات، من دون أي دعم كما حصل في أزمة معامل الألبسة التي تسببت بإفلاس الكثير من المعامل في بداية الألفية، أو أنهم تُركوا ليَستثمروا في مشاريع كبيرة ثم تمّت محاصصتُهم في أرباحهم لاحقاً.
اليوم، لا يملك أحد من السوريين أو من غير السوريين القدرة أو الرغبة في ضخ مبالغ كبيرة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية. يمكن لبشار الأسد وحده فعل ذلك، لكن التجارب عبر خمسين عاماً من حكم هذا النظام تقول بأنّه وعائلته فضّلوا دوماً الاحتفاظ بالأموال المنهوبة في الخارج، وتركوا السوريين يتدبرون أمرهم. في كثير من الأحيان، كانوا يمنعونهم حتى من تَدبُّرِ أمورهم.
لا يوجد أفقٌ واضح لأي حلّ سياسي في سوريا اليوم، وفي الوقت الذي تتالي فيه الأزمات الاقتصادية الخانقة، تُظهِر بنية الدولة انهيارات وفشلاً واضحاً عن أداء أبسط وظائفها. في العمق، فقدت هذه الدولة قدرتها على ذلك تدريجياً منذ وَجّهت أدوات العنف التي تمتلكها إلى صدور المتظاهرين العُزَّل، ومن ثمّ إلى بيوت ومدن السوريين ومعاشهم طوال العشر سنوات الماضية. لا يمكننا أن ننتظر تعافياً اقتصادياً إلى جانب ركام بيوت داريا وحلب ودوما ودير الزور وحمص. تقول لنا أبسط قواعد الاقتصاد إن نموذج الإدارة الحالي بكل ما فيه من فساد وديكتاتورية ودولة قائمة على جثث مواطنيها، لا يمكن أن يُنتِجَ ازدهاراً لا الآن ولا في وقت لاحق.
بالإمكان لوم العقوبات الدولية والقطيعة الدبلوماسية والاقتصادية من قبل أغلب دول العالم، بالإمكان الاستمرار في اجترار هذه الصيغة من الردود الجاهزة لسنوات، لكنّ هذه الردود لن تُوفِّرَ الوقود الذي ينقطع عن السوق المحلية كلّ بضعة أشهر، ولن تُوفِّرَ استقراراً في سعر صرف العملة المحلية. وحده التغيير السياسي الحقيقي في البلاد قد يفتح نافذة على أمل في تحسن الأوضاع، والأمر هنا لا يتعلّق بالآمال أو الرغبات السياسية، بل هي حقائق الاقتصاد والسياسة الصعبة التي تواجه السوريين اليوم، في حين لا يجد بشار الأسد نفسه معنياً بأيّ منها على الإطلاق.