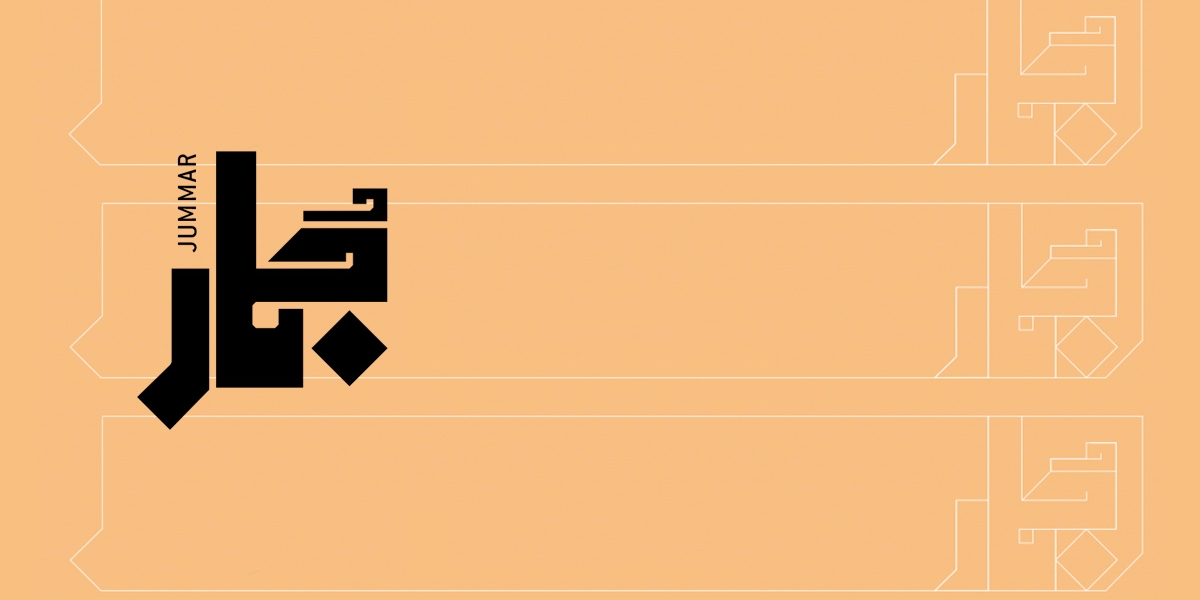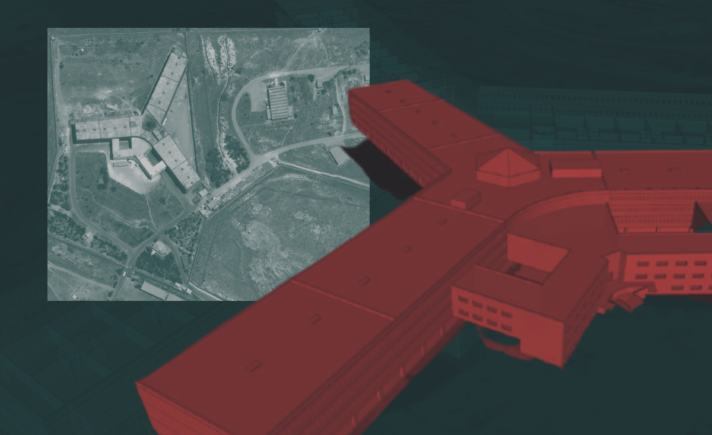أين لمستم الحاجة لمنبر مثل جُمّار في العراق؟ على أيّ سؤال تجيبون بإنشاء منبر إعلامي عراقي مستقلّ؟
عمر الجفّال: شخصياً بدأتُ العمل في الصحافة بين العامين 2008 و2009، ومنذ ذلك الحين كنتُ أشعر بوجود نقص كبير وحاجة لمنبر مفقود في الساحة. كنّا نعمل في منابر متنوعة، لبنانية وخليجية وأجنبيّة وغيرها، وكانت تُرفَضُ أغلب المقترحات الكتابية التي نقدّمها حول متن حياة المجتمع، وحول أسئلة الحياة الاجتماعية التي نبحث عن أجوبة لها بالعودة إلى الماضي أو التفكير في المستقبل. كان الاهتمام منصبّاً على مسائل قصيرة المدى، وخصوصاً الموضوعات السياسية النمطية المرتبطة في الأذهان بالمشهد العراقي، أي «السياسة» المجرّدة، مثل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن أو افتتاح مشروع أو أزمة برلمانية ما، وهي الموضوعات التي باتت منذ زمن منفصلة عن حياة الناس اليومية وشروط معاشهم. حياة الناس في العراق اليوم معزولة عن السلطة، وهناك مجتمعات تتكوّن، بل وحتى مدنٌ تتشكّل، حقيقةً بمعزل عن السلطة.
الاهتمام السوسيولوجي إذاً كان مفقوداً، يُضاف إلى ذلك انقياد الكتّاب والصحفيين العراقيين وراء اهتمامات وسياسات المنابر التي يعملون لصالحها، سواء كانت داخل العراق أو في الخليج أو في لبنان، وغالبية هذه المنابر غير منفتحة على محاور جديدة أو على استقبال أفكار مختلفة عن العراق. نحن مؤطرون بتفكير هذه المؤسسات، فإما أن تكتب عن الميليشيات، أو عن داعش، أو عن الأزمة مع إيران، أو أن يكون موضوعك غير مُرحَّب به لأنه يقع خارج توقعات هذه المنابر لما هو «عراقي». لكن العراق أكبر من هذا بكثير، إذ نتحدث عن بلد متنوع فيه 40 مليون نسمة ويمتد على مساحة كبيرة، ومشاكله أكبر من داعش وإيران وغيرها بكثير. بعض هذه المشاكل متراكم منذ عقود، منذ أيام الملكيّة، وهي لا تنال اهتمام الصحف ووسائل الإعلام المهمة في العالم العربي -ربما باستثناء السفير العربي، حيث كان هناك هامش ممتاز في الحقيقة للعمل عن العراق-.
هذا النقص والاحتياج القديم وجد لحظة فارقة في العام 2019 -الاحتجاجات، الثورة.. أياً يكن. ما زلنا نختلف على تسمية ما حصل- إذ اكتشفنا مدى فداحة وعمق هذا النقص: ليس للعراقيين صوت خارج مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديهم مكان للتفكير المشترك والنقاش وحتى الاختلاف والتصادم. لدينا صحافة شديدة الكلاسيكية، ومواقع الكترونية متحجّرة.
هناك جيلٌ جديدٌ ظهر بوضوح بعد 2019، لديه صوت مختلف حتى عنّي أنا الذي قد أكون قريباً منهم عمراً (عمري 34 وهم في العشرينات). يشدّني في صوت هذا الجيل بالضبط حسّ السخرية الحاضر دوماً، فمثلاً هناك صبية من أصول شيعية من جنوب العراق، وهي غير مؤمنة، تبدأ نهارها على السوشيال ميديا بكتابة: «صباح الخير سُنّة، بعدكم دمكم ثقيل؟»، وآخر من الأنبار يكتب أيام مُحرَّم «شبيكم يا شيعة؟ حتى القيمة قلّت!» بمعنى أن الطعام الذي يُصنع في استذكار الحسين أصبح أقلّ. يقصد أنه حتى هذا الجانب يتراجع، لا دبّرتم حكم ولا دبّرتم دولة، ولا حتى أكل. القصد هو أنهم حوّلوا ما هو «تابو» بالنسبة لأجيال سابقة إلى مادة ساخرة متداولة في الحياة اليومية. ليس لهذا الجيل منبرٌ غير فيسبوك، وهو مكان لا تتطوّر فيه القدرات الكتابية، ولا ينفع للتداول والاحتكاك المُساعدَين للتطور، ولا يسمح بتراكمات محسوسة. في عملنا في جمّار نحاول أن نكون ورشة مستمرة على مستوى التحرير والتطوير، ويمرّ النص بمراحل عديدة من التحرير والنقاش. لم نصل طبعاً إلى ما نريده، فنحن ما زلنا في أسابيعنا الأولى وهدفنا الأول حالياً هو الاستمرار، ولكن عبر هذه الورشة يتطوّر الكتّاب العاملون معنا ونتطور نحن.
حنين نعامنة: بالإضافة إلى ما ذكره عمر، أعتقد أنه حتى مواضيع معينة مثل الفساد، الذي صار موضوعاً مقترناً بالعراق وملتصقاً به وبات الحديث عنه راهناً دوماً، يتطلّب تفكيكاً أكثر مما يحصل الآن: كيف تتمظهر مفاعيله في مختلف طبقات المجتمع؟ ما هي ديناميكياته؟ ما هو تاريخه؟ هناك حاجة للربط ما بين التاريخ وحياة المجتمع عبر العمل الكتابي الصحفي المُعمّق.
يجدر أن يُشار أيضاً إلى مشكلة ضعف المصادر في العراق، وهذه مشكلة نجدها في الكثير من بلدان المنطقة: ما تجده هو أبحاث أكاديمية تعيش في عالمها الخاص، ولا تماسّ بينها وبين الشأن العام أو الصحافة. عدا أنه ثمة مشكلة كبرى تجدها حتى الجهود البحثية، وهي صعوبة الوصول إلى المعلومة أو الإحصائية الصحيحة. التفكير في هذه المعضلات هو أيضاً من أصول فكرة جمّار، فالفريق المؤسِّس عمل سوية قبل ذلك على مشروع بحثي عن العراق في جامعة بريطانية، وعايّنَ صعوبة العمل البحثي والوصول للمصادر والمعلومات. كانت محاولة رائدة من حيث أنها سعت لجسر الهوّة اللغوية والمعضلة المتعلقة باللغة الإنكليزية، والمرتبطة بشكل وثيق بالعلاقة بالأرض: كثيرون من الكتّاب العراقيين القادرين على الكتابة والتفكير بواقعهم لا يجيدون الإنكليزية، في حين أن كثير ممن يجيدون الكتابة الأكاديمية بالإنكليزية لا علاقة مباشرة لهم بالأرض والمعايشة العيانية، وهذا ما يتسبب بجهل وتجهيل متبادل. لقد كانت هذه التجربة البحثية غنية وملهمة، وجلبنا خلاصاتها من حيث طريقة العمل إلى جمّار، أي كيفية التعاطي مع طرائق مختلفة للبحث والتقصي والكتابة، وهي رحلة متواصلة عندنا، تبدأ من التعامل مع الكتّاب والتعاون معهم على التثبّت من المعلومات والوقائع لمواجهة التضليل والأخبار الكاذبة، وهي مشكلة كبيرة في عالم اليوم وفي العراق خصوصاً.
نرى أنفسنا اليوم كجهد لمحاولة وضع الصحافة والعمل البحثي في مكانٍ واحد، مضيفين إليهما أيضاً الأدب والفن.
ما هو شكل فريق عملكم؟ وكيف يتوزّع جغرافياً؟
ع.ج: كما ذكرنا فإن الفكرة انبثقت عن سنوات من العمل والنقص، ومن البحث عن مكان للنشر والقراءة عن العراق بصورة مختلفة عن الأنماط السائدة. ومن هنا، وبعد العمل سوية ضمن مشروع بحثي، طرحنا حنين وأنا فكرة إنشاء الموقع على عايدة القيسي، زميلتنا في المشروع، وشرعنا ثلاثتنا في مراحل التأسيس كلٌّ من موقعه خارج العراق. ثم بدأنا بتشكيل نواة الفريق، التحرير والتصميم والتدقيق والترجمة وإدارة السوشيال ميديا والإدارة المالية، وغالبيتهم العظمى موجودون في العراق.
ح.ن: شبكة جمّار الصحفية ممتدة نسبياً، إذ لدينا أكثر من عشرين صحفية وصحفي موزعين في مناطق مختلفة من العراق، وجهدنا في هذا الصدد لعدم إبقاء تركيزنا على المراكز الأساسية كبغداد والموصل والبصرة. لا يمكننا أن نقول إننا وصلنا إلى مرحلة تغطية كامل جغرافيا العراق بالكامل، فهناك مشاكل كثيرة تحول دون ذلك، ولكن لدينا توزيع معقول ومتوازن ما بين مراكزَ وأطراف. إلى جانب ذلك، ثمة عدد متزايد من الكاتبات والكتاب الموجودين خارج العراق، الذين ينتجون مواد لجمّار جزءٌ منها بالتعاون مع صحافيين موجودين داخل العراق، ما يبني نوعاً من جسر بين الطرفين ويَظهر جلياً في المواد المُنتَجة. كما أننا نتواصل مع باحثين يكتبون باللغة الإنكليزية لترجمة مقالاتهم وتقديمها للقارئ العراقي بالعربية.
ما هي ملامح المشهد الإعلامي في العراق اليوم؟
ع.ج: مرّت الصحافة بعدة مراحل في تاريخ العراق، وقد كانت فترة الانهيار والتحطم الأكبر في حقبة صدّام حسين. بعد 2003 عاشت الصحافة انفتاحاً غرائبياً، ذلك أن الأميركيين والأوروبيين، وأيضاً الأحزاب التي قدمت من الخارج بعد الاحتلال، أنفقوا كثيراً من المال على إنشاء منابر، دون أن يساعد ذلك على تشكيل ثقافة صحفية ما، أي أنه كان استمراراً للتدمير في الحقيقة. ليست الاحصائية بمتناول يدي الآن، لكن في لحظة ما كان هناك مئات الصحف التي تصدر، والتي لا تبيع في الحقيقة بل تُوزَّع مجاناً لخلق أرقام انتشار فحسب. تسبَّبَ هذا في تداعي سمعة واحترام الصحافة في العراق… «كلام جرايد» هو ما يُقال عادةً في منطقتنا عن الكلام الذي لا مصداقية له، لكن في حالة العراق «كلام جرايد» تعني أن عليك تصديق المعاكس تماماً لما يُنشر. منذ الاحتلال، جلّ الوسائل تابعة لأحزاب أو ميليشيات أو دول إقليمية أو غربيّة.
«الانفجار» الصحافي الذي حصل بُعيد الاحتلال بدأ في الخفوت اعتباراً من 2008 تقريباً، وبدأ المشهد يتغربل بعض الشيء، وإن مع بقاء الملامح الأساسية موجودة. ومن المثير للاستغراب مدى علنية صفقات الفضائيات والوسائل الكبرى مع السياسيين: السياسي نفسه الذي كان يُهاجَم في قناة ما سيصبح بطلاً فيها بعد أسابيع، وبالعكس، لأنه دفع لهذه القناة أو عقد معها صفقة ما، وهي صفقات غالباً معروفة وعلنية فعلياً، ليس فقط ضمن الوسط الصحفي، بل حتى لعموم الناس.
وطبعاً كل هذا ضمن مشهد سائلٍ ومتفاوتٍ على الدوام: القنوات والوسائل الأخرى تغلق وتفتح حسب ما تتلقاه من دعم، أو تصعد وتهبط حسب موقع الحزب أو الميليشيا التابعة لها على خريطة السلطة اليوم، وهل يسيطر داعموها على وزارة مدرّة للأموال أم لا، وغيرها من عوامل من هذا النوع، أي عوامل لا تتعلّق بالجودة الصحفية ولا بالعلاقة مع الجمهور.
هذه القوى دمّرت المشهد الإعلامي، لكنها دمّرت نفسها أيضاً، فالحرب فيما بينها تجري أمام الناس، والكل يَتّهم الكل بالفساد. في أجواء كهذه تكون أي عملية سياسية أمراً مستحيلاً، فوسط هذا المناخ لا يتوقع الناس وجود أي حزب أو أي شخصية نظيفة في الوسط السياسي، وأي أحد ضمن «السلطة» فهو فاسدٌ حكماً، وهو أمر لا أتفق معه تماماً، إذ هناك في جهاز الدولة البيروقراطي أشخاصٌ كُثُر يحاولون العمل بنزاهة وإخلاص، وهم خارج هذه الحرب تماماً.
إذاً، بدأت كثافة الوسائل الإعلامية التي فَرّخت بعيد الاحتلال، لنقل «الانفجار الأول»، بالخفوت اعتباراً من 2008. لكن أتى انفجار ثاني عام 2014، مع بسط داعش سيطرتها على مناطق واسعة من العراق، وظهور كمية كبيرة من الميليشيات المسلّحة -أكثر من 70 ميليشيا- في إطار محاربة داعش، أي ما سُمّي بالحشد الشعبي. عملت كل واحدةٍ من هذه الميليشيات على إبراز قوّتها، وهذا يحصل بطريقتين: في الشارع عبر القتل والترويع والهيمنة، وفي الإعلام عبر إنشاء فضائيات وجرائد ومواقع إلكترونية وغيرها.
وجيوش إلكترونية..
ع.ج: وجيوش إلكترونية، لكن هذه في الحقيقة هي المرحلة الحالية: مرحلة هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي. هنا لم نَعُد فقط أمام منافسة الفضائيات والمواقع وملايين الدولارات التي تُستثمر فيها، بل أيضاً في مواجهة مع قوة هائلة لمنشور على وسائل التواصل قد يُدعَم ترويجه بـ 200 أو 300 دولار فقط، وينتشر بشكل مريع بين الناس، وقد رأينا أمثلة مخيفة خلال الشهور الماضية مع احتدام الصدام بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وماذا عن الإعلام المستقل؟ أليس موجوداً؟
ع.ج: بعض التجارب وُجِدت، وكانت هناك محاولات عديدة، كنتُ أنا جزءاً من بعضها، ولكن دعنا نعترف بقصور هذه التجارب. لهذا أسباب عديدة، منها جهلنا بسياق عمل المنظمات غير الحكومية الداعمة للإعلام المستقلّ، ومنها ضعفٌ كبيرٌ بمعرفة اللغات الأجنبية الضرورية للتواصل والتشبيك في السياق العراقي. وهناك أيضاً ضعف كبير في التفكير المؤسساتي. ليس هناك مؤسسات في العراق منذ التسعينات، ولا حتى مؤسسات دولة، التي يتم التعامل معها حسب إن كان لديك فيها «عِرف» أم لا؛ والمؤسسات الإعلامية التي عملنا فيها بعد 2003 لم تكن مؤسسات في الحقيقة، بل عبارة عن تجمّع تحت إدارة مدير أو شيخ أو حجّي أو أستاذ، وهؤلاء هم كل شيء في هذه «المؤسسة» رغم أنه لا علاقة لهم غالباً بالإعلام، وهم الذين يقررون كل شيء، بِدءاً من من ثقل أو خفّة الشاي، وصولاً إلى المانشيت الرئيسي أو مدخل نشرة الأخبار في الفضائية.
يجعل هذا مهمةَ أي مشروع إعلامي جديد صعبة للغاية، فأنت بحاجة لجهد كبير لإثبات نفسك ومهنيتك أمام الناس، وللتغلّب على التشكُّك بخصوص من أنت؟ ومن وراءَك ومن يدعمك؟ وتثبيت أنك لست جزءاً من هذه المعركة الميليشياوية الفوضوية.
ح.ن: منذ العام 2019 حصلت محاولات كثيرة لإنشاء جهات إعلامية جديدة ومستقلة، وبعضها ولدَ في ساحة التحرير في بغداد نفسها. كان لدى المحتجّين توقٌ لأن يصنعوا شيئاً خاصاً بهم، وفي الساحة صنعوا جرائد وإذاعة، وهذا ليس في بغداد فقط، بل أيضاً في المحافظات. لكن للأسف لم تتحقق استمرارية لغالبية هذه التجارب، وبعضها عاد ليكون حبيس وسائل التواصل الاجتماعي.
المسألة ليست في نشوء تجارب بل في تحقيقها استمراريةٍ ونمواً ومراكمة، وهنا الأزمة الحقيقة في المشهد الإعلامي المستقلّ في العراق، وهذا موضوع جوهري ضمن تفكيرنا بجمّار كمشروع يطمح لاستدامة استقلاليته وتطوير محتواه.
لحظة 2019 كانت فرصة للمهتمين من خارج العراق ليروا مشهداً بدا جديداً، ليس فقط بمطالب متعلقة بكرامة الحياة اليومية لا نجدها عادةً في الحديث عن العراق، الذي بالكاد نسمع عنه ما يتجاوز إيران وداعش والميليشيات والأميركيين؛ بل أيضاً على مستوىً جيلي، شباب وشابات من أعمار صغيرة دخلوا الشوارع والساحات بلغة ومفاهيم واهتمامات ومنطق جديد. وعند تصفّح جمّار يتبين للقارئ سريعاً اهتمامكم بالموضوع الجيلي. ما هي العناوين الأساسية في اهتمام وانفعالات الأجيال الأصغر من العراقيين والعراقيات برأيكم؟
ع.ج: محاولات التعاطي مع اليأس السياسي ربما هي الأهم، سواء كان إذا فكرنا في مآلات انتفاضة 2019، أو حتى عند التفكير في مستقبل نهري دجلة والفرات مع تتالي الأخبار والإحصائيات المقلقة بشأنهما. السخرية وسيلةٌ من وسائل التعاطي مع اليأس. هناك نكتة شائعة هذه الأيام تقول إن العراق لا حلّ له لأن جلجامش قد بناه أصلاً بمال حرام.
هناك انهيار عام في كل مناحي الحياة. هذا نراه بوضوح في وجوه أهلنا.. بتنا نقول عن الخمسينيين أنهم «ختايرة» بسبب ثقل متطلبات العيش. هذا في بلد غني مقارنةً بمن حوله، ليس فقط بالثروات الطبيعية، بل البشرية أيضاً. نتحدث عن مجتمع كبير، أكثر من نصفه من الشباب، ولكنه متروك ليكون حطباً لليأس. هناك أيضاً استياء من تدني مستوى التعليم، وهذا نعاينه بشكل يومي في الإعلام مثلاً.. هناك كتبٌ من المناهج الجامعية لم تتغيّر منذ ستينات القرن الماضي.
ح.ن: من خلال التعاطي مع الكاتبات والكتاب، نلاحظ أن القضايا المُعاشة وعلى رأسها البطالة وغياب الأمان الاقتصادي موضوعات مُهمّة، تؤثّر على كثير من الموضوعات الأخرى، إلى جانب تدني مستوى الخدمات العامة. نلاحظ أيضاً أن موضوع الاستقلالية وإحراز هوامش حرية في مواجهة الأسرة والمجتمع موضوعٌ شاغلٌ للشباب والشابات في العراق، وهؤلاء هم عماد جُمّار سواءً كجمهور قارئ أوككُتّاب وكاتبات. موضوعات الأمان والعنف أساسية في اهتمامات الأجيال الأصغر، مثل كيفية التعايش مع مستويات عالية من العنف وانعدام الأمان بالمعنى الجسدي المباشر، وخصوصاً بالنسبة للنساء، أَكانَ في الجامعة أو في العمل أو في الشارع أو في المنزل. إلى ذلك، يُضاف موضوع ضعف المهارات الإلكترونية التقنية، الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام هذا الجيل في التعاطي مع الانفتاح التكنولوجي، ويُعقِّدُ موضوع الأمان الرقمي.
ع.ج: نعم هناك أمّية إلكترونية. الدولة نفسها أمّية إلكترونياً، وعديمة الوعي بأُسس التقانة وإدارة المعلومات وأمنها. قوائم مصابي كورونا بأكملها نُشرت على فيسبوك، وهناك مُخاطَبات بين المؤسسات يفترض أن تكون سرّية نجدها تُرسل عبر فيسبوك وواتس آب.
اليأس في ظل هكذا وضع ليس ترفاً، بل هو أمر طبيعي ومفهوم جداً. لكن من ناحية أخرى لدينا أيضاً شباب يقاومون هذا اليأس محاولين الحفاظ على نوع من أنواع الأمل عبر نوع من الثورة الاجتماعية، والتي وجدنا مشاهدها بوضوح خلال ثورة تشرين، وفيها كثيرٌ من ثورة الأبناء على الآباء، جيلٌ على أجيال. للمرة الأولى تجد شابات وشباب في الساحات نفسها، وصوت النساء حاضر. لا يعني هذا طبعاً أننا حققنا اليوتوبيا، وأن حقوق النساء وحرياتهنّ باتت محفوظة، لكن هناك خرقاً كبيراً، ثورياً، قامت به هذه الأجيال الجديدة خلال السنوات الماضية، وما زال هناك تمسّكٌ كبيرٌ به وبمكتسباته على أنه أملٌ ما.
هناك يأس من السلطة ومن محاولة إصلاحها. لكن كيف تعيش ضمن هذا الواقع؟ تجد أمثلة مثيرة للإعجاب عن محاولة الصمود ضمن هذا الواقع بمعزل عن السلطة. مثلاً، عملتُ منذ فترة مضت على شبكات التضامن بين مجموعات أرامل ومطلقات يعملنَ من بيوتهنّ في تجارات بسيطة، أو في منتجات يدوية أو مواد غذائية أو غيرها، وكيف يدعمنَ بعضهنّ ويتعاونّ لكسب زبائن مشتركين أو للبيع المشترك. هذا في رأيي مثالٌ عن سعي للنجاة بمعزل عن أجهزة الدولة المتهالكة، ففي شبكات تضامن من هذا النوع نجد استغناءً حتى عن الأنظمة المصرفية لتبادل القيمة، وأحياناً بشكل عابر للدول. قد نرى في هذا النمط من العلاقات شيئاً مُتقادِماً أو بِدائياً، لكن محاولة النجاة بمعزل عن السلطة هي المتاح أمامهم حالياً. لقد ثاروا، وسيثورون لاحقاً..
دعوني أقاطع هنا: هل هناك قناعة عامة بأنهم سيثورون مجدداً فعلاً؟ ليس قصد السؤال اليأس، لكن يبدو أن موجات احتجاج 2019، في العراق ولبنان خصوصاً، ولكن أيضاً في السودان والجزائر، قد أظهرت لنا حدود قدرات التظاهر والاحتجاج في وجه سلطات لا تشكّل لها هذه الاحتجاجات حَرَجاً سياسياً. أليس هناك تساؤل عن جدوى الاحتجاج في أوساط الشابات والشبان العراقيين؟
ع.ج: حتى لو فكرنا أن الدروس المستخلصة من 2019 تدفع أكثر نحو التقوقع حول الخلاصات الفردية، مثل الهجرة وغيرها، بدل محاولة التفكير في عمل جماعي لتحسين ظروف الحياة، إلا أن الواقع العراقي معقّدٌ إلى درجة أنه يستحيل التفكير في خلاص فردي بمعزل عن الأوضاع العامة. مهما حققتَ ملامح خلاص فردي، ستبقى الأوضاع العامة مسيطرة على جزء كبير من حياتك. هذا عدا عن المنظومات المتراكبة والمرتبطة بدورها بالسلطة، كالمنظومة العشائرية وسلطة رجال الدين. أتوقع أن الناس سيعودون إلى الشارع في مرحلة ما. سؤالك هو عن الفعل السياسي، عن التنظيم والعمل، وهو برأيي ليس سؤالاً يُوجَّه مباشرةً إلى عموم الناس، بل هو سؤال يجب أن يُوجَّه إلى نخب موجودة، ولكنها تثبت قصورها مرةً بعد مرة. عملياتُ تَشكُّل أحزاب جديدة في العراق تجري على شكل فوضى كارثية، والمؤسف أن تجد أن أي شيخ عشيرة هو أكثر تنظيماً منهم على صعيد مأسسة العمل.
أعتقد أن الناس سيعودون إلى الشارع، ليس بسبب قناعة مسبقة بجدوى الشارع، بل بسبب تدهور الأحوال إلى درجة استحالة الحياة اليومية. هكذا كان في تشرين، ورأينا استبسالاً يكاد يكون انتحارياً في وجه القمع. أعتقدُ أن هذه الشجاعة الانتحارية مرتبطةٌ بشكل واضح بمعدلات الانتحار الكارثية الموجودة حالياً بالعراق.
خلال السنتين الماضيين، كان للعراق موقع مركزي كمثال على تدهور الوضع البيئي على مستوى المنطقة، وعالمياً أيضاً، سواء كان مع درجات الحرارة القياسية التي سُجّلت في مناطق عراقية، أو بخصوص الوضع المتدهور لنهري دجلة والفرات، وأثر ذلك على العراقيين ومجتمعهم واقتصادهم. رأينا هذا الهمّ البيئي حاضراً في نشاط أسابيعكم الأولى على الموقع، ولكن كيف يُعاش هذا الوضع على مستوى الرأي العام العراقي؟ كيف تُقرَأ هذه الأوضاع المتدهورة؟
ع.ج: القراءة الأكثر حضوراً هي السياسية المباشرة: تركيا وإيران. تركيا تتسبب بتناقص منسوب النهرين باستخدام مشاريع السدود الكبرى، وإيران لها دور فيما يخصّ شط العرب وبعض الأنهار المرتبطة بالأهوار. أصلاً، هذا الموضوع هو الوحيد الذي ترتاح الحكومة العراقية للإشارة إلى إيران بشأنه، لأنه مَخرَجٌ سهل لتبرير انعدام أي تفكير تنموي مختلف ومتصالح مع الواقع الحالي. أنظمة الرّي وغيرها من التقانات الزراعية في العراق متخلّفةٌ جداً، وهي لم تكن ملائمة للبيئة العراقية حتى حين بدأ استخدامها أواسط القرن الماضي.
في الحقيقة، لا يبدو لي أن الموضوع، حتى بخصوص الأنهار -رغم أهميتها الحيوية للعراق- ينال الاهتمام اللازم، أقله في المدن. يبدو غريباً كم تعيش مدينة مثل بغداد بمعزل عن النهر الذي يشقّها. أيضاً، لا ننسى أن تتالي المصائب الآنية الكبرى يومياً على حياة العراقيين لا يترك مجالاً للتفكير بالبيئة والتنمية، وهي أشياء تبدو دائماً تَرَفاً، أو أنها تقع بعيداً جغرافياً، أو على الأقل هي شأن مستقبلي قابل للتأجيل. لكن هذا الأمر راهن وذو أثر مباشر على المجتمعات الريفية والزراعية والرعوية، التي تعاين أثر الجفاف على يومها هذا، وبتنا نرى بوضوح تدهور أوضاع الريف العراقي، وموجات الهجرة الهائلة نحو المدن.
تبعات التغيرات المناخية على العراق كارثية، وتؤثر بشكل مباشر وبالغ القسوة على حياة ملايين الناس، ولكن الوعي بذلك متدنٍ جداً أمام مصاعب أخرى تُعتبر أكثر «آنيّة»، وهذا الواقع يشغلنا على مستوى سياساتنا التحريرية جداً: كيف تُقدِّمُ محتوىً بيئياً يفهمه الناس على أنه مرتبط بشكل مباشر بمعاشهم، وليس مجرد كلام في الهواء يبدو أنه يخص المجتمعات المتقدّمة وليس العراق أو غيره من بلدان المنطقة.
ح.ن: أعتقد أيضاً أن هناك ضرورة لإبراز البُعد السياسي للشأن البيئي: أن هناك سياسات وقرارات تتخذها السلطة ولها تبعات كارثية على البيئة. نعم، هناك ضرورة لمزيد من نشر الوعي حول أثر سلوكيات فردية على البيئة، وأثر تردّي الوضع البيئي على حياة عموم الناس، ولكن هناك ضرورة لوضع هذا الجهد التوعوي في سياق واقعي: أحياناً ليس هناك بنية تحتية خدمية بالحدّ الأدنى للبدء بالتفكير في الموضوع.
ثمة أيضاً معضلةٌ تواجهنا كمنصة إعلامية مهتمة بالمواضيع البيئية، وهي كيفية تحقيق قدر معين من الاختصاص والخبرة في مقاربة الشؤون البيئية صحفياً، بشكل يلامس حياة الناس واهتماماتهم بشكل واضح. هي نفسها معضلة مؤسسات إعلامية كثيرة ناطقة باللغة العربية، ولعلّ الجمهورية أيضاً تعاني من هذه المعضلة: كيفية إنشاء هذا الاختصاص وهذه الخبرة، دون أن نكون فقط مترجمين لما كُتبَ بلغات أخرى. وليس صحيحاً أن الناس غير مهتمين بالموضوع البيئي بالتعريف. مثلاً، مع تضاعُف أثر العواصف الرملية في السنة الأخيرة على محيط بغداد -والعواصف الرملية ليست أمراً جديداً بالطبع، لكن حجم وأثر العواصف يتضاعف مؤخراً- برزت أحاديث كثيرة في أوساط أهل بغداد عن دور الغياب التقريبي للأشجار والمسطحات الخضراء في المدينة وفي محيطها القريب، فالمدينة تملؤها كُتلٌ إسمنتية هائلة.
خلال العقود الماضية، كان الوسط المُسيّس السوري عموماً شديد الاهتمام بتفاصيل الحياة الداخلية اللبنانية، مقابل إعطاء ظهره للعراق بالكامل. وهذا الوضع ما زال قائماً إلى اليوم: نعرف أسماء نوّاب لبنانيين سابقين وحاليين، ولكن ربما قلة من المسيّسين السوريين تعرف اسم رئيس العراق أو رئيس وزرائه. ماذا يعرف العراقيون عموماً عن سوريا؟
ع.ج: حين انتقلتُ للعيش في سوريا نهاية العام 2000 كنت طفلاً، كنت أتخيل سوريا وكأنها مكان يُعاش فيه مثل ترف الأفلام الأجنبية: أذهب إلى المدرسة بالدراجة ولديّ كلب وكل بيوت الناس خشبية جميلة بحدائق، وبقيت سعيداً بهذا التصور إلى أن وصلنا إلى منطقة السيدة زينب، التي كانت في تلك الفترة بالذات ليست مختلفة كثيراً عن الواقع الخدماتي لبغداد مثلاً.
أعتقد أن هناك قدراً لا بأس به من السُمّية يطبع علاقة طيف واسع من العراقيين بسوريا منذ 2011. بعد 2003 كانت سوريا «بلد إنقاذ» من حيث أنها البلد الوحيد الذي استقبل لاجئين فقراء وطبقة وسطى، في حين كانت الخيارات أمام المقتدرين أكثر، بدءاً من عَمّان وصولاً إلى الخليج وأوروبا. وكانت المعيشة في سوريا رخيصة حتى بالمقارنة مع العراق في الألفينات، وبالتالي كانوا قادرين على التعايش حتى مع حالات النصب التي تعرَّضَ لها بعضهم هناك. اليوم، كثيرون من العراقيين عاجزون عن فهم سوريا إلا من هذا الباب: كان بلدكم يُعاش به، فلماذا فعلتم هكذا ببلدكم؟ هناك عمىً عن طبيعة السلطة في سوريا، وعن كمية الظلم والحيف وانعدام المساواة والسطوة الأمنية وغيرها، وتركيزٌ فقط على أن اللاجئين العراقيين كانوا قادرين على العيش فحسب، رغم أنه كان هناك تمييز بحقهم، وعنصرية أحياناً، وكانوا يُستغلون مادياً وتُساء معاملتهم. هناك أيضاً تفكير سحري بعض الشيء بـ «أمان» ما كان موجوداً في سوريا، يضاف إلى هذا الأمان «حرية»، ليس بالمعنى السياسي -فهذا الشخص الفرِح بحرية في سوريا قادم من صدّام عبر الاحتلال الأميركي- بل حرّية بالمعنى الأولي الشخصي مقارنةً بالعراق: اللباس، الشرب، الترفيه. أيضاً، بالنسبة للمتدينين كانت الزيارات الدينية، في السيدة زينب مثلاً، مسموحة في سوريا بعد منع طويل في العراق.
أعتقدُ أن هذه السُمّية ازدادت بعد 2014-2015، بعد تدفق الميليشيات العراقية باتجاه سوريا بإشراف إيراني، والإحساس بأن هذه الميليشيات هي ما أعاد الأمان النسبي إلى دمشق ومحيطها. اعتباراً من ذلك الوقت، صارت سوريا مقصداً لنوع من السياحة الطبية الرخيصة، وخاصة طب الأسنان؛ وللسياحة الجنسية التي شغلَ فيها عراقيون موقع السيّاح الخليجيين في السابق، ويمارسون الممارسات نفسها من زواجات واستغلالات جنسية مبنية على مخيالات سخيفة عن المرأة السورية.
الشتات العراقي هائلٌ في حجمه، بِدءاً من سوريا والأردن وصولاً لأوروبا والولايات المتحدة وكندا. كيف ترون إمكانية عملكم ضمن هذا الشتات لتغطيته والاقتراب منه وفهمه ورصد فعاليته؟
ع.ج: نفكر في هذا الموضوع كثيراً. الشتات العراقي كبير فعلاً، وهو عدا ذلك قديم، وبُني عبر موجات عديدة متلاحقة، وآخرها موجة ما بعد 2019. طبعاً هناك فروقات جوهرية مع الشتات السوري، فشكل العنف مختلف، ويعني هذا مثلاً أن هناك معارضين معروفين بإمكانهم أن يزوروا العراق، في حين يستحيل ذلك في سوريا.
ح.ن: بات يلفت نظري رسوخ مصطلح «الداخل» حين يتم الحديث عن أحد مقيم في العراق، أو قادم منه. ما زلنا في جمّار طور التفكير في هذا الموضوع، لكننا نحاول تجاوز هذا الفصل ما بين الداخل والخارج، والتعامل مع الظروف المركّبة التي تُحيطه. ليس لدينا حصرٌ بالعمل في العراق، ولا تخسر كاتبة أو صحافي فرصته للكتابة معنا لمجرد أنهم مقيمون خارج العراق. بطبيعة الحال، هناك امتدادات واهتمامات وهموم مُتجاوزة للجغرافيا. لفت نظرنا أيضاً أن كثيرين من أبناء الأجيال الشابة في الخارج أعادوا اكتشاف صلتهم ببلدهم وذواتهم كعراقيين بعد احتجاجات تشرين 2019، ويعملون على إعادة الارتباط والتواصل بعد انقطاع، ويريدون معرفة بلدهم الأصل أكثر والتفاعل معه، وأن يساهموا ويكونوا مفيدين لبلدهم من موقعهم الحالي.. نوعٌ من «العودة المعنوية» إن صح القول.
الشتات العراقي قديم، وعاش موجات متعددة، ونودُّ في المرحلة المقبلة أن نركز عليه ونفهمه ونفهم تركيبته بشكل أوثق وأقرب. مثلاً، أن نتناول موضوع هجرة الكفاءات من العراق وأثر ذلك على البلد، أو دوائر الهجرة الكويرية من العراق بحثاً عن مساحات أمان وحرّية. وبطبيعة الحال سنحاول العمل على فهم علاقة الأطياف المتعددة من الشتات مع العراق اليوم: أنواع الشتات المختلفة، وأنواع العودة المختلفة أيضاً.