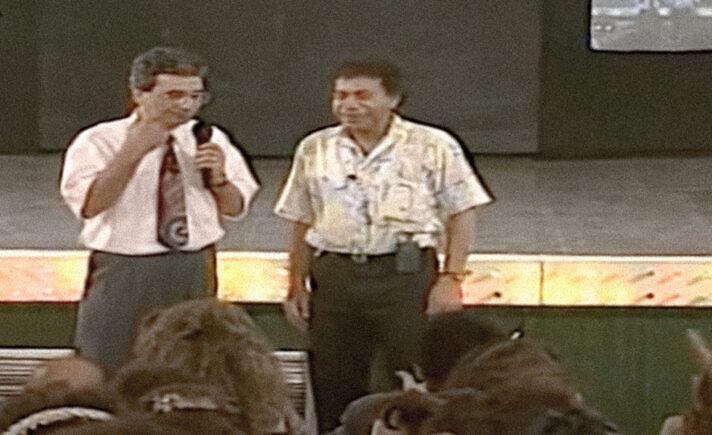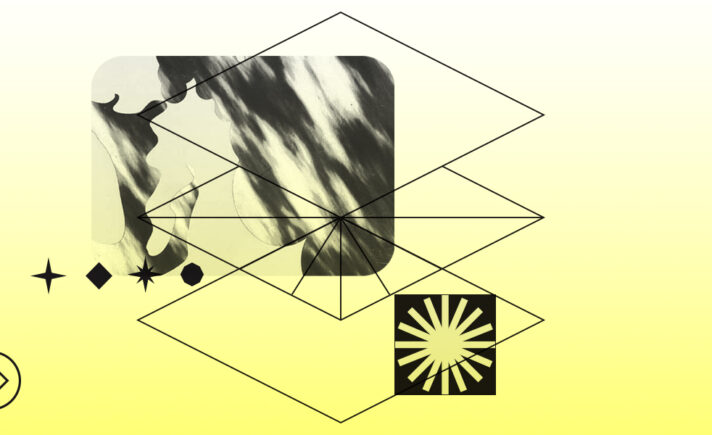مرحبا/ أهلاً/ كيف حالك/ أنت جميلة/ تروقين لي
- عمَّ تبحثين هنا؟
هو حوار بسيط و يتكرر فى تطبيق المواعدة الإلكترونية بامبل. نَصحتنى به إحدى صديقاتى حين أعلنتُ أنني قررت أخيراً الإنفتاح على المواعدة.
أنا امرأة فى الخامسة و الثلاثين. عزباء منذ سنة. انتبهتُ منذ طلاقى أنني لم أعش يوماً تجربة المواعدة بالشكل المُتعارف عليه، أننى لم أطور خلال مراهقتي الأولى أو حتى سنوات شبابي مهارات فى لعبة المواعدة والتعارف واختيار الشركاء وإدارة العلاقات.
كانت أغلب علاقاتى نتاج كيمياء عاطفية، صنعتُ منها سيناريوهات هي نسخ عن أفلام عاطفية مبتذلة تختزنها ذاكرتي المراهقة دون مراجعة أو تحيين.
أخبرتني المعالجة النفسية فيما بعد أن ما كنت أحسبه «كيمياء» أو شرارات سحر فى عالم باهت ومملّ، ليس سوى انعكاس تشوهات تعلّقى بوالدي، وأن «وقوعي» فى الحب سابقاً، لم يكن مصادفة كونية شاعرية، بل نِتاج عدم وعيي بنفسي وباحتياجاتي العاطفية والجنسية والعلاقاتية.
كما أدى اغترابي الفكري والقيمي الاستيطيقي عن النمط الاجتماعي السائد إلى سجن اختياري في دوائر اجتماعية ضيقة جداً، تكاد تكون معزولة، بدافع الانتماء والحماية. أدّى ذلك إلى جعل أفق خياراتي ضيقاًو وجعلنى أتنازل عن الكثير من احتياجاتي مقابل التوافق الفكري والسياسي ووهم الإحساس بالانتماء.
لكن العلاقات لن تعوض عدم إحساسي بالانتماء، كما أن التوافق الفكرى المُفترَض لن يُشبع احتياجاتي، والمفاجآت الكونية الساحرة لن تدير علاقاتى نيابة عني، حتى لو منحتني المصادفات لقاءات استثنائية، بقيت استثنائية وعابرة.
فى الخامسة والثلاثين، قرّرتُ تعلم مهارات المواعدة والاختيار الواعي للشركاء. أنا هنا لأتحدى توقعاتى وتصوراتي السابقة، وأكتشفَ رجالاً جُدداً خارج دائرتي.
تقول صديقتى مازحة: لنكتشف العرض فى السوق! تبدو هذه العبارة فى حد ذاتها صادمة، مُحبِطة للرومانسية الحالمة التي في داخلي، والتي أحاول إعادة تأهيلها ودمجها بالحياة الواقعية خارج أوهام الرومانسية.
الرجال كثيرون على هذا التطبيق. لم أقابل هذا العدد من الرجال من قبل. لم أعرف حتى أنهم موجودون. كل هذا العدد من الرجال المتألقين كنجوم في سهرة. جميعهم أبطال محتملون لقصص غرائبية، أَستمعُ إليها بفضول الكاتبة أكثر من اهتمام المرأة.
ثم ماذا؟؟
بعد بعض اللقاءات وبعض العلاقات السريعة العابرة، اكتشفتُ المنطق التجارى المربك لهذه التطبيقات التي تعمل فعلاً، لا مزاحاً، كسوق افتراضية للرجال و النساء.
أغلب الرجال يبحثون عن علاقات جنسية سريعة وغير مكلفة، بأخف التزام علاقاتي. مع ذلك يقدمون مؤشرات بالنجاح و«القدرة المادية» والتحقق والانطلاق.
أغلب النساء – بحسب رواية الرجال – تبحثن عن زوج و طفل وبيت، عن دعم مادي مقابل الرفقة أو الجنس. وقد تقدمّنَ كذلك مؤشرات على الانفتاح الجنسي، وصوراً لا تخلو من إغراء. بعض النساء تبحثنَ عن الجنس والرفقة وبعض الرجال يبحثون عن علاقة جادة، والبعض تائهون مثلي، يحاولون فهم احتياجاتهم.
صور جذّابة وبعض الأسئلة التقديمية، جمل قصيرة تُلخّصُ العرض الذى تتقدم به «رجلاً أو إمرأة»، وسطَ منافسة شديدة جداً.
على هذه المنصة، تبدو النساء جميلات ومثيرات ومتحررات.
يبدو الرجال متحققين ومسافرين ومغامرين واعدين بمكانة اجتماعية ومغامرات، وربما فرصة هجرة لمن يهمها الأمر.
الجميع ناجح، مبهر، سعيد، منطلق، و«خفيف». صورة اجتماعية مزودة بفلتر عن واقعية حياتنا، التي نعرف جميعاً ألوانها، مع ذلك نحب لو نصدق نسختها المثالية.
المشاركة مجانية للنساء ومدفوعة الأجر للرجال.
النساء تَقمنَ بالخطوة الأولى فى حال إعجاب متبادل.
يبدو مضحكاً، هذا التصور النمطىّ جداً عن العلاقات.
تصور ثقافي موحد يتجاوز الفوارق الحضارية والتكنولوجية، يقفز فوق الحركات الاجتماعية، وتطور الحركة النسوية، وأزمة الرأسمالية وثورة الهويات الجندرية.
مهما حدث، يتوقع من النساء أن تكن جميلات وخفيفات ومن الرجال أن يكونوا ناجحين اجتماعياً ومتحققين مادياً. يتقدم الذكر لنيل إعجاب الأنثى، لاستدراجها، وإقناعها، وعلى الرغم من كل القمع الذي تتعرض له النساء، تحتفظنَ بتلك السلطة الرهيبة للـ«قبول»، وبعضهنّ يبالغنَ فى استخدامها بتعجرف يقارب العنف، فى تأكيد للصورة النمطية عن الأنثى الجميلة صعبة المنال، التي يتقاتل لأجلها الذكور.
بالمقابل يملك الرجل سلطة الاتصال بعد اللقاء، لتحديد مستقبل العلاقة المحتملة. بعض الرجال يبدون دفاعية تقارب العنف كذلك في وصم احتياجات بعض النساء للوضوح والالتزام، معتمدين مجدداً على الصور النمطية التقليدية عن الرجل المُطارَد، المتمرد على مسؤوليات الارتباط والالتزام والمساءلة العاطفية.
منذ اللحظة الأولى، تبدأ لعبة نمطية جداً، لعبة السلطة المُغلَّفة بالغواية.
عمَّ تبحثين هنا؟
منذ طلاقي، لا أنجحُ في التعبير عن احتياجاتي العاطفية والعلاقاتية الجديدة. لقد عشتُ مغامرات عاطفية مارقة على الأطر المُتعارِف عليها، وجرّبتُ المساكنة كشكل علاقة بديل، ثم خضتُ الزواج كحل أخير لإنجاح العلاقة داخل المجتمع.
بعد المراجعة و التدقيق، لا فرق. كنت دائماً مدفوعة بالعاطفة والرغبة فى التحرر من نمطية العلاقات وحتمية الأدوار، ثم كنتُ أقع فيها أو يقع فيها شريكي مُكرَهين.
لم أنجح أبداً فى عيش علاقة حرة من الأطر التي بعد لحظة تبتلع العلاقة نفسها وتبتلعني. لم أنجح إلى اليوم في التحرر من لعبة السلطة.
عمَّ أَبحث؟
السؤال صعب، خارج الإجابات الجاهزة ثقافياً.
منذ سنّ صغيرة جداً، تحررت من هوس الارتباط بهدف التحقق الاجتماعي. أحارب رغبتي في الإنجاب لمجرد إشباع حاجة الأمومة.
تعلَّقَ طموحي بمشروع بدا لي أكثر ملائمة لأحلامي بالتحقق والتحرر كامرأة وإنسان: الشراكة الندية التبادلية الداعمة، خارج الأطر التقليدية.
لا أمثلة في محيطي عن بدائل، تُقدّمُ نفسها كنمط مرجعي معرّف ومشروع، و فشلت كل محاولاتي في الابتكار وبلورة هذا الطموح من خلال شراكة فعلية.
كنت أهرب من جدلية الحتمية الثقافية للعلاقات، وأتعلّق بأمل رومانسي ساذج: الحب هو الحلّ. ثم أسلمت بحقيقة أن الحب ذاته إجابة ثقافية، نجح السوق في استعمالها كحُجة بيع للجنس والعاطفة والعلاقة الاجتماعية.
الحب نفسه يعيش في بيئة ثقافية واقتصادية وسياسية سلطوية تفرض أدوارها، وتَصِمُ كل الوقحاء المتمردين وسيئي الحظ المختلفين. الحبّ هش جداً فى مواجهة الثقافة وحربِ التصورات والتوقعات. أحياناً يعيش، وأحياناً يموت.
نحن مُعَدّونَ بشكل خاطئ: التعليم والتربية، ثم القصص، الأفلام، الدعاية، الأفلام البورنوغرافية، نصائح التنمية البشرية وقواعد العلاقات كما يروج لها الطب النفسي التقويمي.
كل ذلك الخزّان الثقافي المادي واللامادي، كل تلك الرسائل التي نستقبلها بلا توقف، تشكل وتشترط أدوارنا المفترضة وتحدد إمكانياتنا للتعايش وتمثّلاتنا عن العلاقات والاحتياجات والنماذج المقبولة والصحية والناجحة.
نحن نتدرب بجهد ومثابرة لنكون «أدوارنا»، ولكننا لا نملك «الأدوات» لنتعرّف على ذواتنا ونتعرّف على الآخر، ولا مهارات تواصل أو مساحات تَقبُّلٍ تمنحنا فرصة احتمال بعضنا البعض خارج عقود من الضمانات.
ثم إن الوقت الذي يتطلبه بناءٌ مُبتكَر غير جاهز مرعبُ التكلفةِ لأي رجل وأي امرأة. الوقت أقصر عند النساء، وقت الأنوثة ووقت الأمومة. مع شروط كهذه تبدو الخيارات صعبة ومُجحِفة.
من خلال مراجعة سجلّي العاطفي، انتبهتُ أننى كلّما أحسست بالأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعى كلّما كنت أكثر قابلية للعلاقات غير المتوقعة، وأكثر انفتاحاً على شركاء لأجل أنفسهم لا لأجل ما يُمثلونه من احتمالات أمان. وكلّما كنت قلقة وخائفة، كلّما سعيتُ نحو شركاء «حمائيين» وكنت أكثر مثابرة فى «إنجاح» علاقة.
الخوف كان المُحفّزَ إذن، أكثر من الحب. أكثر من الالتزام.
ماذا عن الشراكة خارج الحمائية المهيمنة، الالتزام الخانق، ثنائية النجاح والظل والأدوار الهرمية؟
ممكنة طبعاً، ككل الاحتمالات اللامحدودة لديناميكيات العلاقات والحياة، لكننا حيوانات أليفة مثقفة، مدجنة، فقدت القدرة الفطرية على التعامل مع حواسها والانغماس فى حياتها الشعورية البرية مع كل الخطر والقلق والمفاجآت التي تحملها.
نحن حيوانات مُغيَّبة بآلاف الصور الوسيطة عن أنفسنا، تُفقِدُنا القدرة على التعرف والتواصل مع ذواتنا العميقة.
الصور الثقافية وحدها تحدد أدوارنا المُشتهاة وقصصنا المتوقعة، وتُعيدنا إلى السردية الجماعية، مهما ابتعدنا.
ثقافة السوق وقواعد الرأسمالية تزيد المسألة تعقيداً.
نحن نعيش باستمرار فى نوع من المضاربة، ملاحقة «الامكانيات الافتراضية» للعلاقات، في محاولة «إنجاح» استثماراتنا المادية والعاطفية والنفسية، في دعاية مستمرة لقصصنا الاجتماعية/العاطفية/الجنسية ليُصادَق عليها من حولنا ويزكيها المجتمع ونشعر بالقبول والاندماج والأمان.
الأمان! أليس هذا ما نبحث عنه؟؟
أَنظرُ للرجل الوسيم أمامي، عيناي لا تشبعان من جماله.
أخجل من كوني أهتمُّ لتأمل جسده أكثر من الاستماع إليه، ألم يكن هذا ما أَعيبه أكثر على شركائي!!
عقلي لا يتوقف عن إرسال صور ذهنية مستقبلية، بعلاقة وديمومة وبيت بمدفأة. مع أنني أسكن في شقة! أين سأضع المدفأة؟؟
ثم لماذا مدفأة ونحن فى عزّ الصيف؟؟
عقلي آلة لإنتاج قصص عاطفية غبية، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعقولية، لم أَعُد أصدقها أو آخذها على محمل الجد.
أتوقع الصور الذهنية التي يرسلها عقل رفيقي لوضعيات جنسية على الأغلب.
أضحكُ وحدي.
أقول له أنه جميل ويخجل.
يرتبك الرجال بشكل مثير للحنان.
يشرح لى عن «عنف» التوقعات الأنثوية وثقل الانتظارات للعلاقات، عن سوء الفهم وخدع الهويات الاجتماعية لرجل مهاجر.
استمعتُ إليه. لا لكلامه، تواصلتُ مع مشاعر الغضب والجرح فى صوته.
يصعب عليَّ كامرأة أن أفهم ما يختبره الرجال، لكن مشاعره كانت حقيقية، بشكل أثَّرَ بي.
-أنا آسفة، حقك عليّ.
تجاهلَ أسفي بكبرياء، وقال إنه ليس ذنبي.
كان زوجى السابق يستعمل تلك العبارة اعترافاً واعتذاراً لما يفعله غيره من الذكور، وكان ذلك يخفف من غضبي.
– أنا آسف لحزنك. حقك عليَّ أنا.
ذلك الحنان الشافى، المتعاطف مع ألم الآخرين، الرحمة! كان ما أبحث عنه قبل أن تقتل لعبة الأدوار العلاقة وإمكانياتها والتوقعات جميعها.
لكنه الحنان ذاته، الرحمة، باق ويعيش ويستمر، ينتقل أيضاً من شخص إلى شخص، كما الخيبة والغضب والحزن..
-أنا آسفة، امسحها فيَّ أنا. كَرّرتُها.
ابتسم.
لا يُعلِّمنا أحدٌ أن الحياة، حياةٌ لتحيا. ليست مشروعاً أو مجموعة أهداف، أن العلاقات ليس عملية تبادلية، بل عملية تمازجية يختلط فيها شخص بشخص.
يأخذان الكثير من أفكار بعضهما بعضاً ومشاعره وطاقته وعاداته. إنك حرفياً تختار ذاتاً داخل ذاتك سيعيش بعضها معك، حتى لو رحلت.
لا يُعلِّمنا أحد أن أُطُرَ العلاقات لا تعنى شيئاً فى الواقع، لأننا برغم المسميات، ما نتوقعه وما ندعيه، رجالاً ونساء، كائنات حسية وعاطفية واجتماعية نحتاج الجنس والعاطفة والأمان الاجتماعي بلا تمايز أو تفاضل.
لا أحد يُعلِّمنا أن مبدأ الإبتزاز على الحماية والمقايضة والمفاوضة المنفعية، أمورٌ تُسلّعُ حاجياتنا وتُعمّق إحساسنا بالمحدودية والقمع والضيق والظلم والرفض والجرح.
أننا كائنات متعددة وأن العلاقات معقدة ومركبة، تحتاج التعاطف والرفق والرحمة والتواصل، لا الإبهار ولا الادعاء ولا الأدائية الناجعة ولا الدفاعية الحاسمة.
الرجل الوسيم أمامي، يلملم غضبه وأنا ألملم حناني كي لا تثير أي رائحة للعاطفة رُعبه.
عقلي توقف عن إرسال الصور الرومانسية الواعدة بسبب عدم استجابتي. دفاعية رفيقي تهدأ، يمسك يدي ويضغط عليها.
أراه يضغط على يد شريكي السابق.
وأَبتسمْ.
أشعر بالحزن والونس فى آن واحد، بالمشاركة والعجز أمام محدودية تجاربنا وكل سردياتنا، أمام آلة صناعة الثقافة المتوحشة وانصياعنا إليها رغم شُبهة الوعي ورغم التجارب والخسائر.
من المحزن أن الخسارة لا تُعلّمُ شيئاً، سوى ربما التواضع والحد من التوقعات، أو انعدامها.
رحل رفيقي الوسيم ورحل معه طيف شريكي السابق.
هذا الصباح أفقت وحيدة وخفيفة. أطللتُ على رسالة جديدة:
هاي يا حلوة. عمَّ تبحثين هنا؟؟
لا أبحث عن شيء. أو ربما ما أبحث عنه لا يستجيب لمنطق هذه التطبيقات.
الإجابة بسيطة، حقيقية ومُربِكة.
ماتت توقعاتي كلها فى الخامسة والثلاثين، لا سائدَ أحاربه ولا بديل أسعى إليه. عالقة تماماً فى مكان ما بلا هدف بعينه. يبدو هذا وعداً بالحرية وضباباً مرعباً.
أزلتُ التطبيق وكتبتُ هذا المقال فى مدح العلاقات البرية والحضارية، التي تتخذ من الاحترام والتعاطف الإنساني أساساً لها، خارج الوهم اللطيف بالأمان داخل المدجنة والوفرة الاستهلاكية في المول.