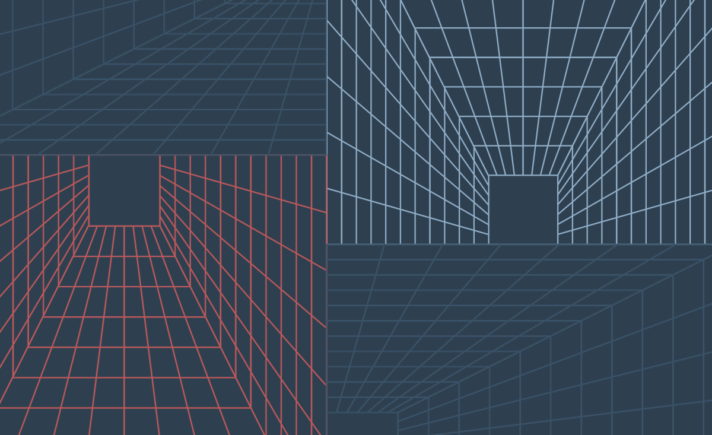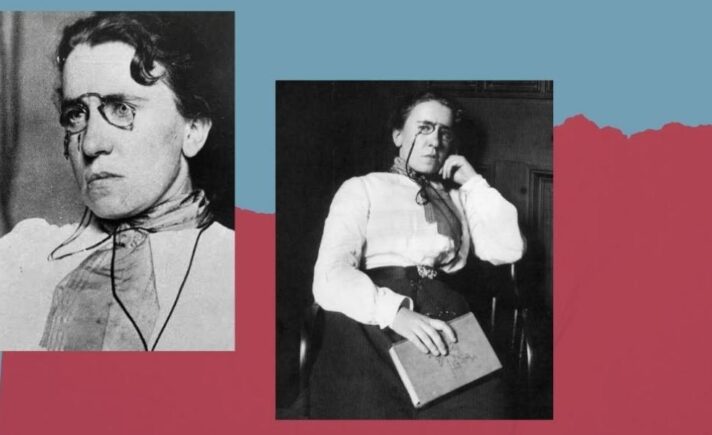إن كان ثمة نشاطٌ قد أَحنُّ إليه فهو الترجمة. ابتعدتُ عنها منذ عقود، عدا استثناءات صغيرة (قصيدة، أو قصّة، أو اقتباسات الكتّاب الإنكليز والفرنسيين المُستخدمة في رواياتي)، ولا شيء يقف مانعاً من عودتي إليها لولا انشغالي بكُتبي، وقلة المردود المادي لعملٍ ما زالت أهميته أساسية، بل إنه من أهم الأعمال في العالم، ليس فقط على صعيد الآداب، ولكن أيضاً الأخبار الواردة، والترجمات النصّية للأفلام والمسلسلات -والتي لا تحظى بالتقدير اللازم-؛ أو الدبلجة ابنة الحرام، أو التطورات الطبية والبحث العلمي، أو المحادثات ما بين الحُكّام..
لكن الترجمة التي أحنُّ أنا لها هي الأدبية، تلك التي سخّرتُ لها كل طاقاتي. لطالما اعتبرتُ أن الترجمة تشبه الكتابة إلى درجة أن محاولة الجمع بينهما مُرهِقة للغاية. الفرق «الوحيد» هو وجود نصّ أصلي ينبغي على المترجم أن يكون مخلصاً له، دون أن يعني ذلك أن عليه أن يدع ذلك النص يستعبده. لهذا النصّ الأصلي عيوب وفضائل، ومن بين العيوب أن المرء ليس حرّاً جداً -وإن كان حرّاً إلى حدٍّ كبير في الحقيقة- لأن عليه أن يُعيد تقديم ما كتبه كونراد أو جيمس، بروست أو فلوبير، برنهارد أو ريلكه، بأفضل شكل ممكن بلغته هو، ما يعني تَعذُّرَ الابتكار. يحظى كاتب رواية بإمكانية أن يخترع كلّ سطورها من أولها إلى آخرها، لدرجة أن المرء قد يحتار أحياناً بكيف يكمل الكتابة، ويتمنى حينها لو أن بين يديه «نص أصلي» يقوده ويملي عليه ما ينبغي أن يُكتَب. النص الأصلي، كالنوطة الموسيقية، موجودٌ وراسخ، ولكن للمترجم، كما لعازف البيانو، طيفٌ واسع من الخيارات. الفصاحة، وتفضيل تعبيرٍ ما أو الاستغناء عنه، والسرعة، والإيقاع، والوقفات، كلها مسؤوليات تقع على عاتقهما. ما يعني، أيضاً، احتمال أن يتسببا بتدمير تُحفة.
كثيراً ما أتذكر، بين قطرات عرق بارد ومتعة كبرى، تلك الشهور أو السنوات التي قضيتها في ترجمة النصوص الثلاثة الأصعب في حياتي: مرآة البحر، نص كتبه بولونييقصد جوزيف كونراد (1857- 1924). والكتاب مجموعة من نصوص السيرة الذاتية جعها كونراد في كتاب عام 1906، ونشر ماريّاس ترجمتها إلى اللغة الإسبانية عام 1981 (المترجم). بإنكليزيةٍ بديعة بقدر غرائبيتها؛ وتريسترام شاندي،حياة السيّد النبيل ترسترام شاندي وآراؤه للورنس ستيرن، والتي نُشرت مجلداتها التسعة بين 1759 و1767. وقد نشر خابيير ماريّاس ثالث ترجمة للإسبانية للعمل الضخم عام 1978، مضيفاً للمجلدات التسعة خُطَبَ لورنس ستيرن الشهيرة في ملحق. (المترجم). الصرح الأدبي من القرن الثامن عشر، والذي لا يقل دهاليزية عن عوليس لجيمس جويس، المهترئ لكثرة اللمس؛ وأيضاً، ديانة الطبيب والدفن في جرّات، للسير توماس براون، وهو علاّمة إنكليزي من القرن السابع عشر، ذو نثرٍ مَهيب بقدر عظمته وأيضاً بقدر شَربكته، نالَ إعجاباً شديداً ومستحقاً من بورخيس وبيوي؛ نثرٌ استسلمتُ قبالته في البدء، إذ لم أجد نفسي قادراً على الاستمرار، ولكنني فكرتُ بعد أشهر من التوقف أنه من المؤسف أن يبقى قرّاء الإسبانية جاهلين به، وعدتُ إلى العمل بهمّة متجددة وتمكنتُ من إنجازه. لماذا اهتممتُ بهذا القدر بتعريف القرّاء على هذا النص، رغم أن المهتمّين لن يكونوا كُثُراً على الأغلب؟ لا أعرف، قدّرتُ فحسب أن هذا النص البديع يجب أن يكون موجوداً بلغتي، حتى لو استمتعتْ قلّة قليلة من الفضوليين بوجوده واستفادتْ منه.
ثمة مترجمون لا يعتاشون من الترجمة، أما أولئك الذين يعيشون منها، ويا لهم من مساكين، فيضطرون لسَلسَلة أعمال سيئة، أو ربما متوسطة، أو حتى جيدة، وإنهائها بسرعة كبيرة. يحمل غير المُعتاشين من الترجمة إحساساً مسؤولاً وطافحاً بالإيثار تجاه مواطنيهم. لنفكر بالترجمة الأولى لدون كيشوت، التي قدّمها الدبليني توماس شلتون عام 1612، أي بعد سبع سنواتٍ فقط على صدور النص الإسباني، ونتساءل عن دافعه للعمل على رواية إسبانية طويلة وصعبة، كتبها كاتبٌ مجهولٌ آنذاك. لا أعرف الجواب، لكن يجدر تخيّل أن شيلتون قد تحلّى بكرمٍ جعله يقرر عدم حرمان غيره من الإيرلنديين، ولا الإنكليز، من المتعة التي عاشها حين قرأ النص بالإسبانية. إن كان لتعبير «العمل في سبيل الفن»تقصد العبارة هنا معناها الحرفي، بذل جهد في سبيل «الفن» بحد ذاته دون انتظار مقابل، لكن العبارة بالإسبانية الدارجة (Por amor al arte)، تُستخدم أيضاً لانتقاد انعدام الجدوى أو التهكّم من جهد مبذول سُدىً دون تخطيط أو ترتيب. من صحّة فهي بالذات حين تصف عملَ المترجمين. ففي المحصلة، يحمل الكاتب أملاً، حتى لو كان مجرد بصيص، بأن يبيع الكثير من الكتب وأن ينجح، ولكن ليس بحوزة المترجمين أن يترقبوا هكذا أمجاد، فحتى يومنا هذا ما زال هناك الكثير من الناشرين الممتنعين حتى عن وضع أسماء المترجمين على أغلفة الكتب، كما لو أن آلي سميث أو زادي سميث ليستا بحاجة لتدخّل للانتشار بلغات أخرى. أما لو تحدثنا عن المقابل المادي فلربما أَجهشنا بالبكاء. أيعقلُ أن يُستخدم معيار التسعير نفسه لتقدير ثمن ترجمة لديكنز وترجمة لكاتبٍ أميركي طاووسي رائجٍ ما؟ هذا ما يحصل، للأسف. ثمة ناشرون كدّسوا الذهب بفضل عمل المترجمين، ومع ذلك لا يجازونهم إلا بتعرِفات هزيلة تُقدَّر بعدد الصفحات، في حين تبيع العناوين التي يترجمونها مئات الآلاف من النسخ بالإسبانية.
لا أدري.. أجل: قد ترعى ابنةٌ أمها المسنّة في سبيل الحبّ الذي تكنّه لها، ولكن هذا لا يقف مانعاً في وجه أن تُجازى مادياً على تفانيها، أقلَّهُ كي لا تموت من الجوع بسبب تخليها عن عملها ذي المردود المالي من أجل العناية بأمها. من هذا الباب أرى أنه لا يمكنني أن أحنّ لسنوات عملي في الترجمة، إذ إن مردود رواياتي أفضل بكثير. لقد حالفني حظٌ وفيرٌ لا علاقة له بالكفاءة ولا بالموهبة. ولكن على الرغم من ذلك، رغم ذلك.. أتذكر كيف كنت أشعر بالرضى وأتأثر حين «أعيد كتابة» نصٍ بلغتي أفضل بكثير من أيّ شيء يمكن أن أكتبه أنا، كما هو حال ترجماتي الثلاثة التي أسلفتُ ذكرها. القراءة، فالتصحيح، ثم إعادة القراءة، وثم التفكير (دائماً مع احتمال الخطأ، فالمرء حَكَمٌ سيءٌ لما يفعله): «أجل، أجل، هكذا كان سيكتب كونراد أو ستيرن أو براون لو أنهم عبّروا باللغة الإسبانية».