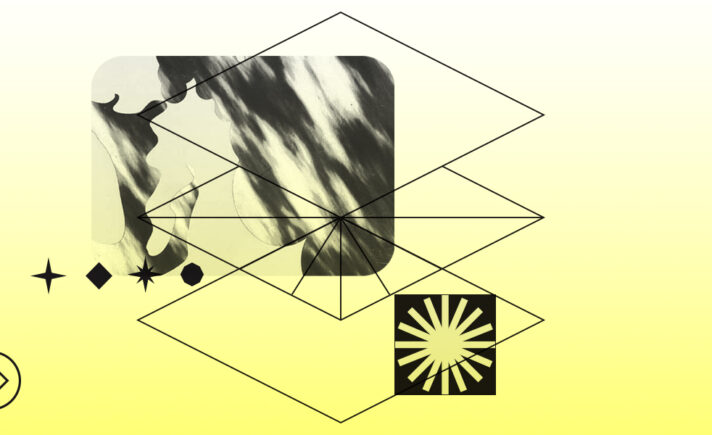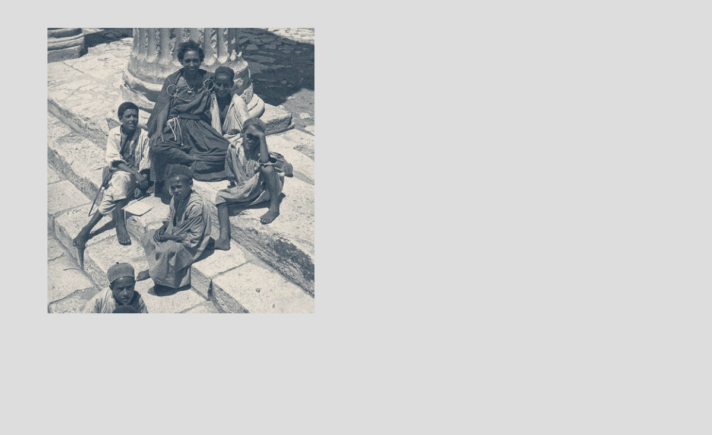يقول صديقي بأن الثورة عجينة رقيقة بإمكانك مدّها وتوسيع أطرافها لتتمطّط على مساحة أكبر ممّا تتوقعه، وقد تتمزق عند الدعك والدلك وتخرمها ثقوب كالجبنة. تكتفي حينها بكتلةٍ صغيرة، تمسكها وتحاذر في مدّها لتكتفي بما يسع راحة اليد. ذلك ما حصل معي. بعد أن فقدتُ أملي في استغلال لحظة الثورة لتأميم الأراضي الزراعية وإقناع الفلاحين التابعين لتعاونية إنتاج الحليب بالتسيير الذاتي، انحسرت معركتي الأخيرة إلى الإبقاء على مَعلمين: شجرتا السرو في مدخل المدرسة، واللافتة الجِبسية التي علّقت منذ تأسيس المدرسة سنة 1938 وكُتب عليها: (Ecole franco-arabe) . لطالما أسرتني تلك الشواهد المادية تلميذاً، وحركتني لكي أتخيلَ نشأة أقدم مَعلم في القرية، أي المدرسة، وأترصّدَ الأحرف والعلامات النزقة التي حُفِرَت بسكينِ جيبٍ على جذع شجرتي السرو. لم أفلح في ذلك حتى. تذكّرَ البعضُ أحقاد الماضي ضد الاستعمار وصبّوا غضبهم على كل ما هو فرانكفوني، ما عدا الطرقات وقنوات الرّي القديمة والمدرسة ذاتها، أي ثلاثة أرباع البنية التحتية برمّتها للقرية. طالَ ذلك اللافتةَ الجبسية المعلّقة على مدخل المدرسة، والتي غيّرتها الإدارة بلافتة رخامية تشبه مدخل الجامع الجديد في قريتنا، وطالَ واحدة من شجرتي السرو عند المدخل حتى لا تحجبَ اللافتة التي خُطَّت بأحرفٍ عربية قحّة. نفضتُ عن نفسي وهم إحداث أي تغييرٍ يذكر. تقلّصت كتلة العجين الرقيقة مرة أخرى وانحسرَ شغفي إلى استعادة ذاكرة القرية وقصصها.
كانت قريتنا ضمن المناطق التي احتلها الألمان من الفرنسيين وطالها قصف الحلفاء سنة 1943. حكايات كثيرة تدور في قريتنا عن قوات المحور خلال الحرب العالمية الثانية وخاصة الألمان، من تنصيب برج المراقبة في قرية سيدي مصرّة البحرية إلى حقول التكروري «حشيش محلي مُستخرَج من نبتة القنب الهندي» المنتشرة على الطريق المؤدية إلى البحر. أغوى الألمانُ الأهالي من خلال تسهيل زراعة واستهلاك التكروري بعد تشريعات متعددة منعت بيعه وتهريبه بين تونس والجزائر. سُمّي ذلك العام بِعام الألمان، ليُضاف إلى رصيدٍ طويل من سنوات طالتها أسماء النكبات: عام الروز،هي سنة 1918 وبعض المصادر تشير إلى أن الفترة امتدت إلى سنة 1919 أيضاً خلال الحرب العالمية الأولى، حينها تم توزيع الرز للحدّ من المجاعة التي نجمت عن الجفاف وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية في تونس، والتي تحتل الحبوب مثل القمح والشعير النسبة الأكبر منها. لم يكن الرز حينها من ضمن التقاليد المطبخية للتونسيين. وقتها تم توزيع الرز – أو الروز كما يلفظ بالدراجة التونسية – كهِبة خارجية لمساعدة تونس، وتم استهلاكه بكثافة في كل وصفات الأكل تقريباً. عام الجراد، عام الفيضانات. لدى البعض، كانت تلك أيضاً سنةَ انتصارِ آخرِ حُلفاءِ المحور في القرية: سحنون، ولعلّه الوحيدُ الذي انتصر من كل المحور في تلك الحرب.
*****
ذهبتُ مؤخراً إلى المدرسة بعد مرور عقد على تلك الانتكاسات لأبحث في أرشيفها عن الدفتر الإداري، الذي يحرّره مدير المدرسة ويضع فيه كل تفصيلٍ. كنت بحاجة إلى الدفتر الخاص بسنة 1943، سنة قصف الحلفاء للقرية أثناء الحرب العالمية الثانية. ذكر لي أحد المعلّمين القدامى أنه اطّلعَ على الدفتر الذي حوى يوميات المدرسة التي احتضنت الأهالي آنذاك، بعد أن تحولت إلى ملجأ وقتيّ للحماية من الغارات. ضمّ الدفتر أيضاً تفاصيل القصف وجرد العائلات والأفراد الذين هربوا من أكواخهم واحتموا في المدرسة، بالإضافة إلى أسماء القتلى وأماكن سقوطهم. صعقني المدير قائلاً بأن أحدهم أتلف الأرشيف بالخطأ بعد أن وضعه وسط كومة من الأوراق البالية التي طالها العفن والرطوبة لإحراقها، وتعلّلَ بِطيش بعض العاملين والتلاميذ. مرّت عليّ لحظات طويلة كتمتُ فيها الرغبة بالتفوه بكل معاجم البذاءة التي أحفظها في وجهه. طلبتُ منه أن يسلّمني مفاتيح غرفة الأرشيف لكي أنبش لوحدي، مع أملٍ ضئيل بأن الدفتر قد نجا من المحرقة. أخذ مني الأمر ثلاثة أيام من التنقيب في أكوام الورق المبعثرة، وسط تهافت الجرذان التي تذمّرت من اقتحامي لمضجعها. لم أجد طبعاً غير فواتير قديمة ووثائق طبية خاصة بالتلاميذ. أنهكتني الخسائر المتتالية. رميت بالمفاتيح على طاولة المدير وخرجت حانقاً ومحبطاً. كانت أمامي خيارات عدّة لتفريغ الحنق الذي تَملَّكني. اتجهتُ لسيارته المركونة وضربت إطار إحدى العجلات بسكينِ جيبٍ في حوزتي. بعث فيّ صوت تدفق الهواء القوي من الإطار شيئاً من الراحة.
أردت بشدة أن أجد الدفتر حتى أتلمّسَ دليلاً مادياً من وقت الحرب، وعلى نحوٍ خاص واقعة سحنون التي تقف على النقيض تماماً من سردية الهلع والقتلى. أردتُ أيضاً التحقّق من صحة الأسطورة التي تقول بأنه الوحيد الذي لم يلتحق بالمدرسة للحماية من القصف. يحضر الرجل بشكلٍ مريب في كل القصص التي سمعتها عن القرية زمن الحرب وبعد الاستقلال. تكمن فرادته في الجمع بين مجالات عدّة، كما تستحضره القصص كبطلٍ للملذات السائلة والهوائية التي أكسبته كِنًى مختلفة؛ فهو «إسفنجة» لأنه لا يرتوي من السُكْر ويظل مسلوب الوعي لأكثر من ثلث النهار بسبب إدمانه شربَ اللاقمي: «شراب مُسكِر يُقطَّرُ من جذع النخلة»، وهو «بَرّيمة» في إشارةٍ إلى طاحونة الهواء من فرط تدخين التكروري.
ترتبط كل القصص التي سمعتُها عن القرية خلال تلك الفترة تقريباً بمحاولاته المستمرة للظفر بالتفاتةٍ من زمردة ذات العينين الخضراوين واللكنة المدينية الأرستقراطية. لم تشهد القرية امرأة بجمالها. نالت حظوة بين الأهالي بعد أن صاروا يلقبونها بالقاورية.الأجنبية بالدارجة التونسية. ليس لأنها أجنبية آتية من وراء البحار، بل لأنها كانت بطلة أول زيجة تمّت بين أحد الرجال من القرية وامرأة قادمة من المدينة. تحركت ماكينة الخيال الجماعي لدى سكان القرية في توصيف زمردة على نحوٍ مثير حتى قبل رؤيتها. انخرط الشبّان والكهول والعجائز في تسابقٍ محموم للتفرّد بذكر تفاصيل لجسدها، كالوشم الذي يزين خاصرتها أو النمش الذي يرصّع صدرها، دون أن يكون قد لمحها أحدٌ أصلاً. يوم الزفاف، وقفت الجموع في الطريق الذي سيأتي منه الموكب، وتأهّبَ الكل بانتظار العروس القادمة من المدينة. تفرق البعض منهم على كيلومترات عدة لكي يظفر بأول نظرة إلى زمردة، حتى أن إمام الجامع الوحيد صلى منفرداً في فناء المسجد، وخرج مذعوراً إثر نهاية فرائضه ظناً بأنها إحدى علامات قيام الساعة. لم يلبث أن انضم إلى الجموع التي تنتظر الموكب، وغضَّ النظر عن معاتبة من اعترضه من رواد الجامع على غيابهم المفاجئ.
تلازم الحديث عن جمال زمردة مع الإشارة إلى حظ الصحبي، زوجها. تعرّفَ إليها صدفةً بعد أن التقى بأبيها، أحد أعيان المدينة. قامرَ الصحبي بكل ما لديه، واستثمر ثروة أبيه المنكوب لكي يظفر بقلب البنت. لعبت كل الصدف الطبقية دورها حتى يلتقي الصحبي بالحاج محمد، والد زمردة، في إحدى أسواق المدينة القريبة لبيع الحبوب. شهدت القرية وقتها صابةوفرة في المحاصيل الزراعية. حبوب وافرة. غَنِمَ الصحبي محاصيل الحقول التي تركها له والده المتوفي منذ أشهرٍ ليقتطع منها هبةً لسيدي عبد العزيز كما جرت العادة، حتى يباركَ له الصابة ويفتح أمامه أبواب الرزق الوفير في سوق المدينة. يتبرّك الأهالي بسيدي عبد العزيز الذي ينتصب مقامه وسط القرية بجانب الجامع، وينسبون إليه الخوارق واللعنات والكرامات. تحول الصحبي سريعاً إلى مُضاربٍ كبير في السوق، ونال حظوةً لدى الحاج الذي دأب على استدعائه إلى منزله. عدا عن أن تلك الدعوات رسخت لدى الصحبي قناعة مفادها أنه أصبح من الأعيان، فإنها كانت فاتحة لتعرّفه على زمردة، ابنة الحاج الكبرى. مرت الأيام وتحول الصحبي إلى نزيل دائم لدى الحاج. كان قد سلمه مقاليد المضاربة على منتوجات حقول أبيه دون أن يكلف نفسه عناء المرور بالسوق. بالمقابل، فاتح الصحبي الحاج برغبته في الارتباط بابنته الكبرى، وبدد ثروة طائلة في الأثناء أملاً في كسب ودّ زمردة التي رضخت لرغبة أبيها المصرّ على الزيجة. اتفق الصحبي والحاج على تحديد موعد الزواج والمراسم، وبات حديث القرية الشاغل اقترابُ عرس الصحبي بابنة أحد أعيان المدينة.
كان لزاماً لدى سكان القرية أن يتم أهل الميت عاماً من الحزن على فقيدهم حتى يشرعوا في مناسبة فرح. لكن إصرار الحاج محمد ورغبته بتسريع الزواج حالا دون الالتزام بتقاليد القرية، ما وضع الصحبي في مأزقٍ مع الإمام وأمه وأعمامه إذ لم تمر سنة على وفاة والده الشيخ لَزهَر. قايض الصحبي الإمام بدستة خرفان لقاء فتوى تبيح له التسريع بالزواج وكسر عادة الحداد لسنة، وتوسّطَ له مع الحاج محمد لكي يجد له زوجةً رابعة من المدينة. نجحت الفتوى بعد أن خصّص الإمام خطبة الجمعة لذلك، ثم نزل لدى عائلة الصحبي وأعمامه لإقناعهم بالتحضير للزفاف ومضاعفة الذبائح والولائم تكريماً لروح الفقيد واحتفالاً بالزفاف: «الله يرحمو كان ما يحبّش البكاء والنديب وديما يفركس عالضحكة». هكذا تكلّمَ الإمام في نعيه المتأثر للشيخ لَزهَر «عشيرو وخوه بالرضاعة» بحسب قوله، لكن «كبار الحومة» يعلمون على كل حال أن عداوة قديمة ترسخت بين الشيخ لَزهَر والإمام سببها زوجة الأخير التي رغب فيها غَريمُه.
*****
انطلقت التحضيرات لحفل الزفاف المشهود. جرت العادة أن يستنصر الأعيان بالفتوّات لدرء المشاغبين وغير المرغوب فيهم عن الحفل تجنباً للمشاكل وحفاظاً على هيبتهم. جعل الصحبي من شرّاد وزيراً له في عرسه: «يُشار بالوزير في العرس إلى الشخص المرافق للعريس، الحريص على سير الزفاف وفق الأصول والتقاليد، والمؤتمن على كل تفصيل. يكون في العادة من أقارب العريس أو أحد أصدقائه». لم تكن بينهما صداقة متينة، لكن شرّاد عُرِفَ بين الأهالي كبانديصاحب مشاكل وقد يكون مرتبطاً بعصابة في الدارجة التونسية. صاعد ونزق لا يهاب شيئاً. كسب صيته بعد أن قتل طيّاراً إيطالياً تحطمت طائرته في إحدى الضيعات النائية في القرية، ثم عاشَ مطارداً طيلة سنة إلى حين انتصار الحلفاء. عاد حينها إلى القرية متبجّحاً بالبطولات التي عاشها طيلة اختفائه، وصار الجميع يهابونه بعد أن صدّقوا بأنه أحد أبطال الحرب فعلاً.
تسيّدَ شرّاد ساحة العرس الذي استمر لأسبوع وفق العادة، وأطبق سيطرته على مجالس السكّيرين حتى لا يتسلل إليها سحنون الذي خانته الصدف وأطاحت به الحمى لعدة أيام. استدعى الصحبي جميع من في القرية باستثناء سحنون وزمرته بداعي «الحُڨرة»تعبيرٌ عن ازدراء بين طبقات اجتماعية متفاوتة في الدارجة التونسية. حسب الأخير. تمالكَ سحنون نفسه واستطاع أن يستنهض قواه تزامناً مع ليلة الدخلة؛ آخر أيام الاحتفال. مرّ على التيجاني بائع شراب اللاقمي. بدأ التحمية بشرب اللتر الأول، واستعاد قبساً من روحه المتوثبة. تناهى إلى مسمعه بداية الغناء القادم من زفاف الصحبي. تأبط شراً واستعرت شهيته للشرب أكثر مع تصاعد الزغاريد وصوت البارود المنطلق من بنادق الفرسان إيذاناً بقدوم موكب العروس من المدينة. شعر بأنه جاهز للحرب أخيراً واقتحام العرس. دسّ قنينة تحت إبطه ذخيرةً للسهرة وانطلق. وقف على مشارف الحفل من جهة حلبة الرقص، تيمّم بجرعتين طويلتين ومشى واثقاً نحو مجلس الصحبي.
اعترض سحنون الكرّوسة التي تحمل العروس زمردة. نفرت الأحصنة وحدثَت جلبة حول الموكب. أطلّت زمردة فَزِعةً وأزاحت الوشاح المرصّع عن وجهها. وقف سحنون أمامها مسحوراً وخاشعاً كما لم يفعل من قبل. انطفأت جذوة الشرّ في داخله. بدا وكأن سحابة مبهمة من السحر قد ابتلعته وأخرست لسانه. لم يلبث أن زمّ شفتيه حنقاً واستطرد قائلاً: «صحّة لربّو آكا الطحان».
انتبه شرّاد للجلبة حول الموكب ولمح سحنون. نطَّ من مكانه وارتمى نحوه دون مقدمات. جذبه جانباً وبدأ بكيل اللكمات. سقط سحنون أرضاً، لكنه نجح في التحامل على نفسه وتسديد خطافية موفّقة أَفقدتْ شرّاد توازنه وسط دهشة الجميع. كان نزالاً بين مرتزق نال حظوةَ أن يكون وزيراً في زفاف أحد الأعيان البخلاء، وسكّيرٍ مفتونٍ خانه حظه. لم يحمل سحنون أي ضغينة تجاه شرّاد، ففي أعراف الباندية «ولد المرا ياكل ويوكّل». لا ضير في خسارة نبيلة أمام فتوّة صاعد ما لم يغدر به، بل كانت مواجهة رجل لرجل. انسحب سحنون من الحفل دون مرارة. ضمّدت رؤيته لزمردة خسارته أمام شرّاد واستبعاده من العرس والولائم.
بقيَ الحفلُ والنزالُ بين شرّاد وسحنون حديثَ القرية لفترة طويلة، أنست الأهالي احتدام الحرب العالمية الثانية في العالم وتقلّب الأوضاع في البلاد. بالمقابل، بقي سحنون يقتنص أثر زمردة. يطاردها من سوقٍ إلى سوق ويقتفي أثرها، حتى أنه اشتغل كجامع قمامة علّه يظفر بخصلةٍ من شعرها أو عود سواك نديّ يحمل طراوة فمها ضمن القمامة التي تتخلّص منها. اضطر الصحبي إلى ملازمة المنزل لمراقبة سحنون بسبب تطفّله ومعاكساته التي لا تنتهي. بدأ سحنون بالتردد حول منزل الصحبي كل ليلة، إثرَ انتهائه من جولات الشرب والتحشيش الطويلة، ورفعِ صوته بالغناء أملاً في أن تسمعه زمردة. وضع الصحبي مجموعة كلاب في محيط المنزل حتى لا يقترب سحنون، لكن الأخير روّضها بسهولة وباتت تنتظره في كل مرة لتقتات على بعض الخبز المبلل بالشاي الذي يحمله معه. استمرت لعبة الاستحالة والتمنّع والرصد والمراقبة دون أن يغنم سحنون شيئاً. حتى إن زمردة باتت تشمئز من رؤيته وتشكوه في كل مرة إلى الشيخ وإمام القرية بعد أن عجز الصحبي عن ردعه.
*****
مرت أيام عصيبة مع اشتداد الحرب العالمية الثانية. احتلّ الألمان المستعمرات الفرنسية ووصلوا إلى القرية. تلخبط الكثير من الأهالي الذين كابدوا لحفظ بضعة كلمات فرنسية بغرض التملّق للجنود والمعمّرين، ووجدوا أنفسهم أمام لغةٍ معقدة وخشنة. بالمقابل، سعى الألمان إلى كسب ودّ الأهالي من خلال توزيع التكروري وتشجيع العامة على تدخينه. حتى إنهم استغلوا الأراضي البور التي تكاسل عنها الفلاحون، وزرعوا فيها حقولاً متفرقة من تلك النبتة العجيبة، كان أبرزها في الطريق المؤدية إلى البحر، ما جعل سحنون وزمرته يستوطنون المكان ويدخنون إلى مطلع الفجر. انضمّ سحنون طوعاً إلى صف الألمان وخلّد الواقعة برسم وشمٍ على ساعده على شكل صليبٍ معقوف. أراد التشفي من طحّانة فرنسا «جمع طحّان، وهي شتيمة تونسية تعني الواشي أو القوّاد. درج استعمالها منذ فترة الاستعمار بعد أن استعان الفرنسيون بوشاةٍ محليين أثناء المحاكمات، وألبسوهم أكياس الطحين مع ثقبين عند مستوى الأعين حتى لا تنكشف هوياتهم» حسب قوله، وعلى رأسهم الصحبي والإمام وشيخ القرية وكبير المالكين.
مع بداية حملة الحلفاء على تونس، استعرت الحرب على الخطوط الجنوبية للبلاد وبدأت بالزحف تدريجياً على بقية المناطق. شنّ الحلفاء سلسلة غارات على المدن والأرياف طالت قريتنا. شهد الأهالي لأول مرة طائرةً في السماء. مثّلَ الأمرُ سابقةً، حتى إن بعض الأغاني التصقت بالحدث. انتشرت بين الأهالي أغنية نسائية مطلعها: «طيّار جانا ويا ربي تكون معانا»، سرعان ما تحولت إلى تراث غنائي مشترك بين تونس والجزائر. تلوّنت الأغنية بإضافاتٍ متضاربة، أفقدت أحيانًا هوية الطيار وما إذا كان من الإنكليز والحلفاء أو إنه يقود طائرات الفيرماخت الألمانية.
أصاب الهلعُ الجميعَ في القرية. غادروا منازلهم ومواشيهم وهرعوا للاحتماء بالمدرسة. منهم من ترك الجامع أثناء الصلاة، إذ تزامن القصف مع وقت العصر تقريباً. في الأثناء، كان سحنون عائداً من حقول التكروري متأبطاً ذخيرته المعتادة من اللاقمي. وصل إلى وسط القرية غير مكترثٍ بالفوضى والقصف الذي تتالى مرةً أخرى وأطاح بإحدى المنازل القريبة من ثكنة الجنود الألمان. اعترضَهُ الحاج ممسكاً ببُلغته وجُبّته وهو يغادر الجامع ليلحق بِقشّة والصحبي، الذي ترك خلفه زوجته زمردة غير عابئٍ بتوسلاتها لكي يحميها. تعثرت زمردة في ركضها المذعور وسقطت على مقربةٍ من سحنون. ارتمت نحوه وهي تصرخ:
«يا سحنون إجريلي إيجا فوقي. ما تخليش القنبلة تطيح عليا».
وقف سحنون وهو يجول ببصره على طول المسافة الممتدة من الجامع إلى المدرسة وسرب المذعورين الذي يتصدّره الصحبي. داهمه شريط طويل من الصور بدءاً من حادثة الموكب، واستيقظت فكرة الثأر بداخله. خمّر كلماته جيداً في رأسه ثم التفت إلى زمردة قائلاً: «مالا قلتي نجي فوقك يا زمردة؟ خايفة مالقنابل وتحبني نجي فوقك توّا؟»
ردّت عليه المرأة مذعورة: «أيه أيه يا سحنون، برحمة بوك. حطني تحتك راني خايفة».
عدّل من وقفته وأمسك غليون السبسي بيده اليسرى، فيما أطبقت يمناه على قنينة اللاقمي. سحبة دخان، جرعتان أنهى بهما ما تبقى في القارورة التي اعتصرها تحت ذراعه، وإشارةٍ بإصبعه الأوسط: «آهوا»، ثم رفع رأسه إلى السماء وصرخ: «اضرب يا هتلر. نيكهم. الإمام والصحبي وعمر قشّة وزمردة، طحّانة فرانسا ولماريكان».
لَعِبَت السَكْرة في رأس سحنون الذي لم ينتبه أن القصف إنكليزي وليس منّةً من الرايخ الثالث كما تمنى. وقفت زمردة فزعةً وغير مصدقة لما يحدث. سحنون الذي طالما تمنى وصلها وغامر بحياته وسمعته للظفر بالتفاتة منها، هاهو يقف أمامها ناقماً شامتاً كضبعٍ مترصد فوق لبؤة جريحة. وسط كل الجلبة والهلع، مشى سحنون غير عابئٍ بنداءات الأهالي عليه لكي يلتحق بهم في فناء المدرسة، ولا بصراخ زمردة التي تخلصت فجأةً من لكنتها المدينية الناعمة وتشبّعت بالمعجم الحافي للقرية: «توا يشفع فيك هتلر يا ولد القحبة. هذوما الانكليز صناديد، برا انشالله ينيكوك أنت والألمان بجاه سيدي المغبي».
سيدي المغبي وليٌّ مجهولٌ لا أحد يعرف نسبه ولا قدراته، ولا سبب رفعه لمقام أصحاب الخوارق والهبات الربانية، لكنه زاحمَ الثالوث الأكبر الحامي للقرية: سيدي عبد العزيز وسيدي صالح وسيدي عبد الله، وانتصب مقامه وسط المقبرة كحارسٍ للأضرحة وملجأ للقطط والكلاب الشريدة. انتصر سحنون عليهم جميعاً، لم تطله لعنة سيدي المغبي، ولا قنابل الإنكليز التي نزلت حوله برداً وسلاماً ولم تمسه بسوءٍ على امتداد طريقه الطويلة الهادئة نحو منزله.
*****
«طيّار جانا» إلى القرية وأنهى معاناة سحنون وقصته البائسة مع زمردة. أخرجته من الشقاء كالسوسنة من بين الشوك. بدا وكأن الوهم الذي تلبّسه لحظتها بأن القصف ألماني وجاء ليحصد الطحّانة قد خلّصه من زمردة. ترسّخت لديه قناعة قوية بأن ما حدث ضربٌ من العدالة، حتى وإن كان وهماً، فإنه صنع انتصاره الوحيد في القرية وربح جميع خساراته.
حاورتُ عشرات العجائز في القرية وكسبتُ ودّهم. تطلّبَ مني الأمر أحياناً أسابيع طويلة من الزيارات المتكررة حتى أكسر الجليد مع بعضهم ليطلقوا لسانهم من أجل «تكسير الياجورة»، ليكون لهم حرية التلفّظ كي أتمكن من الإلمام بسيرة سحنون وتفاصيل قصته مع زمردة. لا أدري إن ضاع الدفتر أو حُرق وأُتلف، لكن قصة سحنون بقيت ملازمةً لقصف الحلفاء على القرية، تُخلّصها من وطأة السرد الدرامي في مجالس الندامى. مسحت ظرافة سحنون الأثر الوحيد للحرب في القرية، وألبستها انتصاراً لحظياً لسكّيرٍ شريد بائس أمام ابنة إقطاعي تزوجت وَغداً.