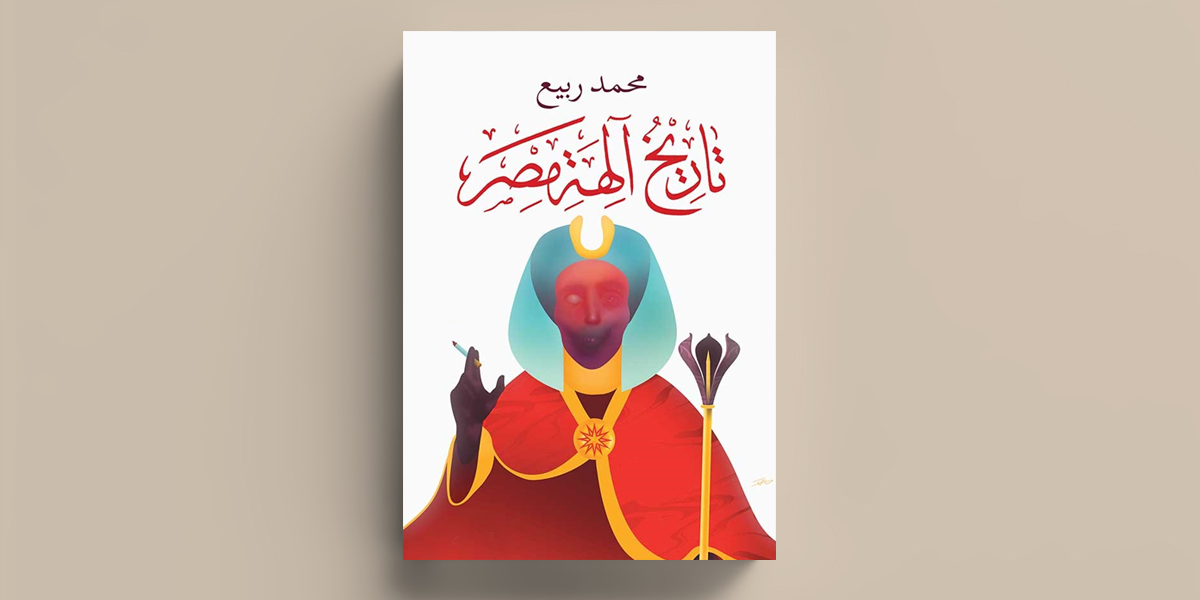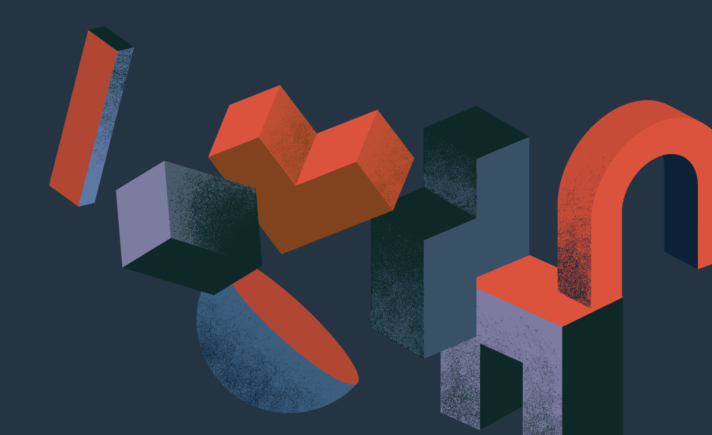كيف يمكن كتابة تاريخ مِصر؟ وكم هي مختلفة الطرق التي يُسرَد فيها تاريخ طويل ضارب في الجذور الأولى للحضارة البشرية؟ هل يمكن كتابة تاريخ مصر مرة واحدة، بكتاب واحد جامع لكل ما حدَث؟ ومن هو المؤرخ القادر على لملمة كل هذا التاريخ المنثور في الزمن المصري؟ ربما ليس بشراً، ملاك؟ أو ربما آلهة متخيّلة، تكتب تاريخ مصر منذ فجره، وتحفظه في «كتاب مصر». ذلك ما تقترحه رواية تاريخ آلهة مصر للروائي المصري محمد ربيع، الصادرة عن دار التنوير عام 2020.
موجز تاريخ آلهة مصر
«قد يظن المصري أن كل شيء يمضي على ما يرام، قد يظن أن الحال في تَحسُّن دائم، وأن مصير مصر إلى الأفضل، لكن حتى مع حكم الآلهة قد لا يتحقق ذلك، هذا شيء يدركه المصري بالتجربة». يكتب خربتو المُطلَق هذه الكلمات في «كتاب مصر». كتاب جليل يؤرخ لكل آلهة مصر، منذ فراعنة مصر الأوابد حتى آلهتها الآتية بعد آلاف السنين. يعمل خربتو المطلق، وهو إلهٌ بالطبع؛ على كتابة تاريخ مصر، مُقدِّماً سرداً كرونولوجياً لآلهة مصر من عصر خيزو الأول حتى عصره هو. أما عصور الظلام، تلك الأيام التي سبقت وجود آلهة مصر، فهي لا تحتاج لتأريخ، لأن رؤساء مصر حينها كانوا أنصاف آلهة.
«فكرة الكتاب جاءتنا عندما كنا لا نزال مؤرخاً إلهياً في القصر الإلهي». تلك كلمات خربتو الافتتاحية لكتابه، وهذا هو سرده:
خيزو الأول (صفر ـــ 123): ظن المصريون أنهم سيرون طقوساً سحرية مجنونة، طقوساً كالتي رأوها سابقاً وأطلقوا عليها اسم «’ترسيم الرئيس‘ أو ’حلف اليمين الرئاسي‘ وأسماء أخرى كلها تلخص مدى الكفر والجهل اللذين كانا يسيطران على مصر في ذلك الزمن البعيد» إلا أن خيزو الأول اكتفى بكلمة وحيدة، مكثفة، قال للملأ: «الآن صفر» وافتتح عصر آلهة مصر الجُدد.
خايرو الفلّاح (123 ــ 345): بعد أن حكم مصر مائة عام، تلاشى خيزو الأول، وتلاه خايرو الفلاح الذي رأى أن «النبات المصري أهم من المصريين شخصياً» لم يُعنَ المصريون ــ حسب المؤرخ ــ بالتغيير الحاصل في الكرسي الإلهي. تساءلوا بداية عن مصير خيزو الأول لكنهم انشغلوا بشؤونهم الخاصة، وكما هي العادة، فكر المصري أن لا ناقة له ولا جمل « فهؤلاء آلهة لا دخل له بهم، ثم كالمعتاد، أعلن كل مصري الخضوع للإله الجديد، وكالمعتاد تابع حياته السعيدة التافهة».
خخو الشاعر (345 ـــ 699): الإله خخو الشاعر أتى بعد الفلاح، وعرفه مصريو زمانه بأشعاره المكثفة والمحفورة في أذهانهم، لكن بقي إنجازه الأكبر هو تأليف «كتاب مصر» حيث أمر «بتسجيل كل ما قاله وكتبه وسيقوله وسيكتبه آلهة مصر، كل ما صدر عن أيّ منهم» ومنها بالطبع كتاب خربتو المطلق الذي بين أيدينا.
ما يتسمَّاش الكافر (699 ــ 712): حاول الإله «ما يتسماش الكافر» أن يعيد نموذج الديمقراطية لحكم مصر، ولو أن الآلهة قبله كانت قد مسحت كل الأديان والإيديولوجيات الدارجة في عصور الظلام إلا أنهم حرصوا على «ترك بعض التفاصيل الخاصة بِدين الديمقراطية، فقط ليعلم الجميع مدى الكفر الواضح في أديان عصر الظلام جميعاً». لا أحد يعرف اسم هذا الإله. كما كان مُنهمَّاً بكتابة اسمه على كل صفحات الجرائد والكتب، وذكره في كل المناسبات العامة والخاصة، لكن عندما تخلص المصريون منه ومن حكمه قرروا «أن ينسوا اسمه تماماً، بل قرروا أن يطلقوا عليه اسماً آخر، وهكذا اختاروا أن يسموه ما يتسمّاش».
خللو الأعظم …الإله الراقص (712 ــ 1725): «من دون أي كلمات أخرى، أزاح خللو الأعظم المايكروفون وأطلق الرصاص على كل أعضاء البرلمان» هكذا افتتح هذا الإله عصره. دمّر خللو الأعظم عصر الظلام الديمقراطي الذي بناه سلفه اللي ما يتسمّاش. وفرح المصريون بذلك فرحاً شديداً، ونزلوا إلى الشارع والساحات كالمعتاد وبدأوا بالرقص. لكن الرقص في عهد الإله الجديد لم يكن ترفيهاً، بل غدا واجباً إلهياً وصلاة، واعتمدت «الرقصة الارتجافية» بما هي رقصة رسمية للمصرين، وأصدرت الفرمانات والقوانين اللازمة للرقص، وصارت الرقصة فرضاً واجباً على كل المصريين، وعلى المصري أن يرقصها طيلة يومه، «عند الاستيقاظ وقبل النوم، وعند الخروج من المنزل». اعتاد خللو الأعظم التدمير والبناء، دمر مصر وبناها، أطلق فيضانات وحبسها واستمر في التدمير والبناء « أطلق عشر طوفانات خللية، وهدم مصر وبناها عشر مرات خلال ألف سنة».
خربتو المُطلَق (1725 ـــ ….): «ثم نأتي أيها القارئ لتاريخ وسيرة الإله كاتب هذه السطور» خربتو المطلق. عُرف هذا الإله بأنه إله مُحارب، أفنى المصريين بحروبه اللانهائية، وأرّخَ لهذه الحروب في الكتاب الذي بين أيدينا «كتاب مصر». منذ البداية آمن خربتو المطلق بالعنف، وجد أن الألوهية لا تنتقل بالسلاسة التي أُرخت فيها «الألوهية لا تنتقل من إله لآخر بشكل سلس، بل تنتزع انتزاعاً». لذلك رأيناه ينتزعها من خللو الأعظم ويفتتح عصره الخاص. كان همّ خربتو المطلق، قبل الكتابة التأريخية للآلهة، هو الحرب، وتحويل كل المصريين إلى مقاتلين، ينتصرون ويهزمون، «وهذا هو جوهر الإنسان المصري، فما هزيمة المصري ونصره إلا انعكاس لفرحنا وغضبنا». يفني خربتو المطلق المصريين في حروبه، ويجلس، مع حارسه الشخصي، يدخن سيجارة على باب قصره الفارغ.
الإله الراوي أم اسماعيل الصابئ؟
كل الكلام السالف عن الآلهة ومراتبها لم تكن إلا هذيانات الدكتور اسماعيل نوح، أستاذ في آداب القاهرة، قسم التاريخ. وقعَ اسماعيل في غيبوبة من الهذيان والهلاوس استمرت عشرين عاماً، من العام 2020 إلى العام 2040 حيث استيقظ ليجد نفسه كتبَ ما كتب من حكايا آلهة مستقبليين سيحكمون مصر، بعد أن ظن أن هو نفسه، إله المصريين وربّهم. صبأَ دكتور التاريخ وتاه في رطوبة هذياناته. تنقلب الرواية بعد هذا إلى تَحوُّل، كشف يأتي في منتصفها يقلب سريان الأحداث، ويخرجها من قالبها الديستوبي إلى مسار أكثر واقعية ولو أنه مستقبلي أيضاً. تتحول اللغة، تنزل من علياء الماورائي لتصبح لغة يومية. تظهر شخصيات حية، وليست آلهة. يتراجع السرد لمصلحة الحوار، منذ المطلع، حيث حوار الدكتور اسماعيل وطبيبه النفسي في المصحّ بعد أن استيقظ من غيبوبته أخيرا: «المشكلة أني لا أذكر شيئاً من العشرين عاماً السابقة، لا أذكر أني عشت هنا أصلاً».
«’عقدة الإله‘ حالة متطرفة من حب الذات» كذلك يوصف الدكتور النفسي حالة اسماعيل. حالة نفسية حادة تجعل صاحبها يظن نفسه إلهاً، في جو فصامي ينفصل فيه المريض تماماً عن محيطه. جنون اسماعيل موروث عن أبيه؛ نوح. يروي الكاتب سيرة الأب والابن، الأب الفنان الفاشل الصابئ، والابن المؤرخ المجنون. يتحول الأب، نوح، إلى الإسلام بعد انهيار فنه، أو انهيار إحساسه بعبقريته الفنية وتمايزه. جنَّ الرجل، وأصبح هدفه الأساسي «إزالة ما قد يؤدي للكفر في بيتهم الجميل» قبل أن يهيم على وجهه مردداً مفردة «كفريَّات» في وجه كل تصرّف يراه منافياً للأخلاق، حتى وَسَمه رجالات الحي بالممسوس. أما اسماعيل، الابن، هو الآخر فيه ما فيه منذ صغره، فمنذ أن كان بعدُ طفلاً، انكبَّ على تأليف ما أسماه بـ« الكتاب المقدّس الكبير». الابن الذي نشأ على منحوتات أبيه التصويرية للأديان، قرر أن يكتب كتاباً يجمع فيه التوراة والإنجيل والقرآن، سيكون أول مخطوطات جنونه. «آلمه كثيراً هذيان أبيه لكن هدوء أمه طمأنه». قتل اسماعيل أباه، رمزياً، بعد أن أطلعه على تحفته الأثيرة، «الكتاب المقدّس الكبير». هوى الأب بعدها في حفرة هذيانه العميق، ورحل.
لا تتوقف سلسلة الجنون عند اسماعيل وأبيه، بل نراها تتشابك مع سلاسل جنون أخرى. مريم، زوجة اسماعيل الأولى، أبوها هو الآخر على حافة الجنون «أجهزة الأمن تتجسس عليه وعلى العائلة، هناك أربعة بيوت على الجانب الآخر من الشارع ترسل إشعاعاتها إليه لتسيطر عليه بالسيكولوجي» وعند سؤال أبي مريم عن هذا السيكولوجي وطبيعته يحكي هامساً: «إنها طريقتهم في السيطرة على الناس». يتعاظم جنون أبي مريم، وتشاركه إياه أمها، إلى أن ينتهي الحال بهما في مستشفى الأمراض العقلية، بعد أن أصبحا يمثلان خطراً على ابنتهما، أخت مريم الصغيرة، منال.
لاحقاً، في علاقته مع سارة، زوجته الثانية، انشغل اسماعيل ببنية العقل المصري، ووجد أنه «بدلاً من العقل المصري القديم، الذي آمن بأن الحاكم هو الله، أصبح هناك إلهان، الله في السماء والحاكم على الأرض، وعلى العقل المصري أن يقدّسهما». من حقائق سوسيولوجية كهذه، انطلق اسماعيل إلى جنونه، ليقف أمام ابنه كريم وزوجته سارة عارياً تماماً، يرفع المقشة بيده عالياً «ويقول بغضب هائل: أنا إله مصر يا سارة، أنا إلهك يا سارة».
ألعاب الفانتازيا والزمن
يتحرك ربيع كثيراً بين طبقات الزمن في روايته. بعبارة أخرى، لا يفتأ يلعب بزمن السرد، بعد أن كان إلهياً ذا زمن سرمدي، تحول إلى زمن مستقبلي، ومن بعد ذلك عاد إلى الثمانينات. انطلق من المستقبل الأثير بعد آلاف السنين ومن ثم هبط إلى 2040 وعاد بعدها إلى الثمانينات والتسعينات .هذا اللعب مع الزمن ممتع لكنه خطير أحياناً. فلكل زمان، ماضٍ ومستقبل؛ أو حاضر، خصال وسمات، متخيلة في الحالة الفانتازية، ومؤرخة في الماضي، وعلى القارئ، والكاتب، أن يبقى متيقظاً ليعرف في أي زمن يجري السرد هنا وهناك. فالزمن في الرواية دائماً ما يَذَرّ ويتبدد ـ وتلك هي ميزته.
لا مراء في جنس النص، هو سرد تخييلي مستقبلي يقفز إلى ما وراء الزمن. سرد فانتازي يحطم دوماً أي اندماج واقعي وأي قراءة منطقية للأحداث. هناك أيضاً تركيز دائم على الجانب السيكولوجي للشخصيات، لا عبر سبر الكاتب لأغوار شخصياته ودواخلها، بل إن الحالة السيكولوجية تطفو على شكل أمراض نفسية. اكتئاب وهَوس وفصام، أمراض تطال جلّ شخصيات الرواية. أمراض ارتبطت بشكل وثيق بالانفجارات الثورية، وحال البلاد المجنون. هذه البنية الديستوبية للرواية ليست مقتصرة على نص ربيع فقط، ففي الرواية المصرية المعاصرة، والعربية أيضاً، هناك تيار متصاعد نحو سرد عوالِم موازية، وخلق مدن ومجتمعات فانتازية، وربما نحتاج إلى عمل بحثي واسع، يرصد هذا النوع من العمل الروائي، ويدرسه، ويميز فردانية كتّابه وتمايز نصوصهم.
يُفعّل ربيع المخيال حتى حدوده القصوى، ويُحسب ذلك للنص. قراءة الحدث التاريخي لا بوصفه حدثاً يجب أن يروى كما حدَث، أو كما نعتقد أنه حدَث. إنما روي التاريخ بلسان مجنون. وبأسلوب رشيق بسبب الفصول الكثيفة وتحولاتها الزمنية. نقرأ في تاريخ آلهة مصر محاولة لاستباق التأريخ، بمعنى محاولة تخيّل كيف سَيُكتب تاريخ مصر بعد عشرين وثلاثين عاماً من الآن، وكيف سيروي التاريخ، بتهكّم، فترة حكم حسني مبارك الذي «كُتب تاريخه ــ في كتاب تاريخ دولة يوليو ــ في خمس صفحات، واحدة لسيرته الذاتية، وواحدة لأحداث الأمن المركزي، وثالثة لثورة يناير. يسميه المؤرخون الآن: الرئيس البليد».
تنزلق بعض الآراء السياسية إلى صوت الراوي، المتكلم بضمير «هو» عن اسماعيل، هذه الآراء تخالها رأي الكاتب السياسي، لكنها سرعان ما تتبدد في فورة الثورة وجنونها. ديمومة تحطيم لكل الآراء السياسية الدارجة في الحال المصرية، ومحاولة تجاوز الثنائيات السياسية، عبر وضعها، ووضع كل المصريين، وتاريخهم المعاصر، في هيولى الجنون والهذيان. بعد خروجه من المصح العقلي، يسأل اسماعيل ناشره الجديد عن كتاباته التي كتبها قبل هيامه. يعدّ له الناشر كتباً مختلفة، منها ما كتبه قبل الوقوع في الجنون، ومنها تلك التي كتبها بعد أن كان قد أيقنَ أنَّ في ذاته إلهاً. كيف كتب تلك الكتب إذاً؟ وكيف نادى بالحريات الدستورية وهو «مؤرخ النظام حينها؟ ربما هناك لحظة وعي كامل عند أي مجنون، وربما كانت تلك لحظة وعيه».
هلوسات، ضلالات، كفريّات. انزياحات جديدة، رغبات مكبوتة، رغبات سياسية واجتماعية، وتراكمات فكرية وسياسية تدفع اسماعيل، مرة أخرى، إلى هجر زمن البشر اليومي، والتسامي في عليائه، مرة ثانية نحو الجنون، لا بما هو فرد مصري أفقدته الأحداث الجسام صوابه، بل بما هو إله مجنون، بما هو خربتو المطلق؛ يتمّم كتابه بقوله: «كانت جولة لطيفة بين المصريين. ما يشعرنا بالأسى أن هنالك الكثير من الآلام، والقليل من الأحلام، هنالك أيضاً الكثير من القلق والتوتر».