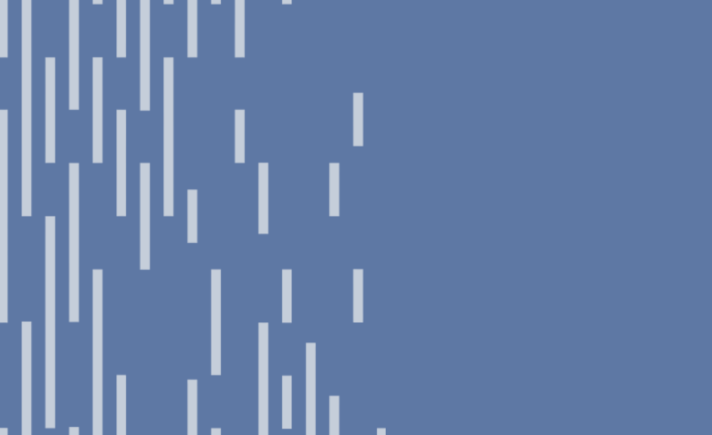درجت العادة طيلة سنوات ثورة السوريين ضد الاستبداد الأسدي، منذ انطلاقها قبل أحد عشر عاماً، على تصوير ما يحصل بصفته جريمة كبرى بحق فئة محددة من فئات الشعب السوري: العرب السنّة. والحق أنه لا يمكن إنكار أن من دفع الثمن الباهظ لقيام هذه الثورة هم بنات وأبناء هذه الفئة / الطائفة بالذات، شيوخاً وبالغين وأطفالاً، وفي مواجهة صنوف متنوعة من الاستبداد لم تقف عن حدود الاستبداد الأسدي الذي قام الجميع ضده في البداية. ولكن بالمقابل، فإن الاستجابة التي طورتها هذه الفئة «الضحية» في مواجهة كل التحديات التي فُرضت عليها، منذ لحظة الخروج إلى الشوارع للمطالبة بالحق في الحياة كبشر، هذه الاستجابة لم تختلف في المجمل عن استجابة سبقتها في ذروة المواجهة مع النظام نفسه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، الاستجابة التي قادت الجميع إلى الكارثة: تسليم مطلق بقيادة التيارات الإسلامية لمجمل حراك هذه الفئة.
وبالرغم من أن تلك التيارات لم تتوقف لحظة واحدة عن تقديم الدليل تلو الدليل على تبعيتها لقرار الممول الإقليمي أو الدولي، وبالتالي إعطاء الأولوية لمصالح هذا الممول على حساب مصالح الفئة أو الطائفة التي تدّعي تمثليها بشكل مطلق؛ بالإضافة إلى فشلها الكامل في تقديم أي برنامج حقيقي لمواجهة تحديات فُرضت على تلك الطائفة، بلغ بعضها درجة التهديد بالإبادة الجماعية، بل والمباشرة في تنفيذ هذا التهديد في أكثر من محطة خلال المواجهة الدموية المدمرة مع النظام بالذات؛ بالرغم من كل هذا فإن القبول بالدور القيادي لتلك التيارات، بل والدفاع عنها بشكل يكاد يكون طوعياً عند قطاع واسع، كان هو السمة الغالبة لردود أفعال شريحة واسعة من أبناء العرب السنّة في سوريا. الأمر الذي يطرح تساؤلات عدّة حول «الزاوية الضيقة» التي حشر الجميع أنفسهم فيها، وكأنّ الأمر في مجمله قدرٌ لا رادّ له. وهو أمر، في تاريخ الصراعات، لا يدلّ على شيء سوى استسلام قدري يائس وشلل تام في مواجهة خطر كان، وما يزال، من الممكن تداركُ كثيرٍ من تبعاته.
على المقلب الآخر، وعند قطاع لا بأس به من المهتمين بالشأن السوري العام من خارج الطيف الإسلامي، بالإضافة إلى أولئك المعترضين على الدور المهيمن لتلك التيارات من داخل الطيف نفسه، فإن الحديث عن التيارات الإسلامية يتناولها غالباً بصفتها «قوى أمر واقع» فرضت نفسها نتيجة ظروف محددة، وتمويل مُوجَّه من قبل قوى إقليمية. والحقّ أن التوقف عند هذا الحد في محاولة فهم دور التيارات الإسلامية في المجتمعات السنّيةوكذلك الشيعية طبعاً في لبنان والعراق واليمن مثلاً، وكل مجتمع خاضع لسيطرة قوى أصولية متشددة كائناً ما كان لونه الطائفي أو العرقي. لا يخدم محاولة الفهم هذه في شيء. على العكس، التوقف عند هذه النقطة يلعب دوراً معيقاً في فهم مدى تغلغل تلك التيارات في وعي تلك المجتمعات لذاتها ولدورها. ويمكن القول إن البحث في البنى والتراكيب والخطابات التي أكسبت تلك التيارات «مشروعية» ضمن سياقات محددة ما يزال بعيداً عن الدراسة والتمحيص، وهذه الدراسة أمرٌ مطلوبٌ بشدة، إذ إنها بقدر ما تساعد على عملية الفهم، بقدر ما تُخرج الجميع من الإحساس بأن تناول تلك المجتمعات بالنقد، وبما هي عليه فعلاً، ليس موجهاً ضد أبنائها كأفراد، إنما هو موجه ضد تلك البنى والتراكيب بالذات ليقوم أولئك الأفراد أنفسهم بتغييرها. أصلاً، لا يمكن لعميلة التغيير أن تحدث دون تدمير البنية الاجتماعية بالكامل (كما يسعى النظام الأسدي فعلاً في مواجهة الاجتماع السوري في عمومه)، إلّا إذا تم هذا التغيير من داخل البنية نفسها وليس من خارجها وبالإكراه.
العرب السنّة في سوريا هم «المتن العريض» للمجتمع السوري الذي عرفناه طيلة قرون طوال، منذ لحظة اكتسبت سوريا، الطبيعية، موقعها كجزء من عالم إسلامي مترامي الأطراف.هذه فرضية بحاجة إلى برهان، وبما أنه لا توجد مراجع وإحصاءات تقرر متى بالضبط أصبح الدين الإسلامي، بنسخته السنّية، هو دين الأغلبية في سوريا الطبيعية، فإن تلك الفرضية تعمد إلى الاستناد إلى ما هو «مُتعارف عليه»، دون الأخذ بعين الاعتبار لحقائق تاريخية مهمة وتحولات لا يمكن التقليل من دورها، ولكن لا توجد مراجع أو إحصائيات تثبت تأثيراتها أو تتقصى مدى دقتها. هذا التعقيب يُطرح بحذر شديد، وهو مبني على التكهنات لعدم توفر دراسات خاضت في هذا الجانب، أو أن كاتب هذه السطور لم يتسن له الاطلاع على دراسة وافية بهذا الشأن، لكن الآثار الديموغرافية للحروب الصليبية، وما تخللها وتلاها أيضاً من تغييرات سكانية، قادت إلى هجرات جماعية للبدو العرب وللتركمان والأكراد وسواهم من العرقيات المعروفة بإسلامها ومساهمتها في تلك الحروب من جانب المسلمين، ما أدى إلى استيطان أعداد كبيرة منهم في أماكن بعيدة عن مواطنهم الأصلية. هناك دلائل ذات طابع شخصي وعائلي، لا أكثر، يمكن الاستناد لها للتعرّف إلى أصول العائلات الفلاحية في جبال فلسطين مثلاً، حيث عدد كبير من عائلات ملاك الأراضي، حتى ضمن الفئة المتوسطة، ذات أصول بدوية وعلاقتها بالعمل الزراعي في حالات عدة تستند إلى تملّك الأراضي فقط. كذلك الأمر فيما يتعلق بالانتشار الكردي، أو التركماني، في مدن وبلدات محددة في سوريا وشمالي فلسطين وفي مواقع استراتيجية حول تلك المدن والبلدات كحاميات، في مواجهة سكان محليين لو كانوا مسلمين سنّة من الأساس (الدين الرسمي للسلطان) لما كانت هناك حاجة إلى توطين هؤلاء الوافدين في تلك الأماكن وإعطائهم أدواراً كبيرة للتحكم وإدارة شؤون المحيط المحلي. الغاية من هذا الهامش كله الإشارة إلى أن «الهوية» الطائفية أو حتى العرقية، ليست معطىً أزلياً ثابتاً غير قابل للنقاش أو التغيّر، بل هي أمر خاضع للكثير من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن سياق تاريخي عام هو بدوره «صناعةٌ» بشرية كاملة. وهم بموجب هذا (على الأقل في سوريا «الدولة حديثة الولادة») الفئةُ المنوطُ بها لعب دور محوري في التوجهات العامة لهذا المجتمع. وهذا دور لم ينكره أبناء تلك الفئة، بل إنهم اعتبروا أنفسهم المرجعية الجامعة لـ «الأمة»؛ ولكن هل كانوا مُدركين فعلاً لحجم وطبيعة الدور المنوط بهم من جهة؟! ومن جهة أخرى، ومن خلال تقديم أنفسهم كمرجعية لـ «الأمة»، أية «أمة» كانوا يقصدون؟! وهل كونهم يشكلون أغلبية عددية بين السكان يعطيهم الحق بافتراض أدوار، وبالتالي خيارات ينبغي على جميع مكونات تلك «الأمة» اتّباعُها- أو على الأقل احترامها بصفتها «خيارات مرجعية»- إن كانوا يريدون أن يصبحوا جزءاً من تلك «الأمة»؟!
ومنعاً لأي التباس، فإن الحديث عن «المتن العريض» لا يعني بأي حال من الأحوال أن الذين يشملهم هذا التصنيف هم أفراد متطابقون في كامل تفاصيلهم وردود أفعالهم (يذهب الشكّ في الحالات الفاشية إلى أن التطابق يمكن أن يشمل حتى الهيئة!). مجتمع العرب السنّة في سوريا، ككل مجتمع عربي سنّي (أو شيعي، علوي، درزي، كردي أو أية طائفة أو عرقية أخرى) في أي مكان في العالم الإسلامي، مجتمعٌ واسعٌ وشديد التنوع، أو على الأقل هو عصي على التصنيف الأحادي الشامل. وهو، ككل مجتمع بشري، يتضمن العديد من التيارات التي يمكن لبعضها ألّا يقبل حتى بأن يُعرَّف بأنه ينتمي إلى هذا «المتن» فقط. المقصود بالعبارة أعلاه هم أولئك الذين بقوا ينظرون إلى أنفسهم بصفتهم ينتمون إلى هذا «المتن» وليسوا خارجه، جزيئاً أو كلياً، فيما هناك من خرجَ من هذا «المتن» فعلياً بقرار فردي دون الاعتراف بأية مرجعية في شأن ما يخصه من قرارات. وبالتالي، فإن أولئك المنتمين بقرارهم «الواعي» إلى هذا المتن هم المقصودون بهذا التصنيف.
الاستثمار الأسدي الطويل في الانقسامات المجتمعية في سوريا، على المبدأ الاستعماري القديم «فرق تسد»، والذي كانت الغاية منه تثبيت سلطة النظام من خلال تكريس سلطة أفراد محددين منحدرين من طائفة العائلة الحاكمة، وإظهار هذا التكريس بصفته «انتصاراً» لهذه الطائفة بعمومها على بقية الطوائف في سوريا، هذا الاستثمار ما كان من الممكن له أن يتكرس بشكل كامل في مواجهة وضع كانت فيه الأغلبية العددية الكاسحة لطائفة أخرى. هذا التفاوت لعب دورَ التحدي الدائم وعلى طول الخط لما أراده الأسديّون لهم وحدهم. لقد كرّسَ مرجعيةً طائفيةً بقي فيها «الحضور العددي» للطائفة السنّية بارزاً بطريقة لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال. هذا الفارق «المجحف» بين «طائفة المحكومين» و«طائفة الحكام» (لعلّها تصل في بعض التقديرات إلى نسبة 7/1)يمكن المجادلة بشأن هذه النسبة طبعاً، حتى أن هناك من يرى أن العرب السنّة لا يشكلون أكثر من 45% من تعداد السكان في سوريا (حسب نظرية فيسبوكية كانت واسعة الانتشار خلال سنوات قليلة مضت) وهذا، في كل الأحوال، ليس صحيحاً وبالاستناد إلى مراجع متاحة للجميع؛ ومع ذلك، فإنه حتى التقديرات الأقل تشير إلى حضور وازن فعلاً لهذه الطائفة لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. بقي معضلة حقيقية، ما كان من الممكن تجاوزها إلا عبر المزيد من القمع للأغلبية الكاسحة من السكان بحيث تبقى دائماً في بيت الطاعة المُفترض. ولكن بالمقابل، وعلى الطرف الآخر من المواجهة، كانت هناك «مظلومية» لعبت دوراً كبيراً في تشكيل وعي طائفة «المتن العريض» لنفسها، بصفتها مضطهدة ومُبعَدَة عمّا هو «حقّ» لها، على الأقل من الناحية العددية. في ظل هكذا مواجهة، شهدت حربين أهليتين داخل المجتمع السوري خلال أقل من أربعين عاماً،الهروب المستمر من فكرة أن سوريا خاضت حرباً أهلية فعلية في مواجهتين مع النظام الطائفي الحاكم، ومن جهة الأغلبية الطائفية الكبرى، هذا الهروب يلعب دوراً معطلاً جداً في فهم آليات ومحركات التطور الاجتماعي في سوريا، ولن يفيد مطلقاً في تبني وجهة نظر واضحة تحاول تقصّي حقيقة ما حدث. ما كان من الممكن الحديث عن دور مرجعي جامع وشامل لكامل فئات المجتمع السوري، حتى ولو صرّحَ كثيرون من أبناء «المتن العريض» بأنهم الوحيدون القادرون على لعب هذا الدور. إذ لا يمكنك أن تلعب دوراً مرجعياً (جامعاً وشاملاً) وأنت تنظر إلى نفسك بالدرجة الأولى بصفتك «ضحية». ومع أن الحق يفترض القول بأن ممارسات النظام هي من لعب الدور المحوري في تكريس عقدة المظلومية عند هذا «المتن»، لكن في نهاية المطاف فإن النظام الأسدي، وكما كشفت ثورة السوريين الأخيرة على الأقل، هو عدو لئيم لعموم السوريين وليس لـ «متنهم العريض» فقط. والعدو، خصوصا عندما يكون وحشاً مفترساً، لا يتردد لحظة واحدة في الانقضاض وهو يشمّ رائحة ثغرة ما في دفاعات فريسته. وعقدة المظلومية ليست ثغرة فحسب، إنها آفة قائمة بذاتها كما جرّبنا في أرواح من فقدناهم، وفي جلود من بقوا أحياء منا.
حتى الخروج من الإطار الطائفي والالتقاء مع أفراد آخرين، من طوائف وأعراق أخرى، لتشكيل إطار جديد وطني جامع وشامل بحق، كان مستحيلاً في ظل نظام يَعُدُّ على الناس أنفاسهم. كانت «الأطر الوطنية الجديدة»، إن صحت التسمية، في معظمها ذات نشاط ثقافي نخبوي محدود التقى ضمنها أفراد معدودون كانوا في مجملهم «نجوماً» في مجالاتهم الثقافية المتنوعة، من سينما ومسرح وآداب.خارج إطار «التشكيلات الأهلية»، دينية وعشائرية، المُستثمَرة بشكل مباشر، والمُسيطَر عليها من قبل النظام، ما كان من الممكن الحديث عن أي شكل من أشكال «المجتمع المدني» المستقلّ في ظل نظام استبدادي حتى النخاع. الخروج عن هذه الأطر، المحددة سلفاً، أمر كان خاضعاً لقرار فردي، ولأشخاص لديهم بعض «الحصانة» الثقافية التي منحتها لهم أدوارهم ضمن مجالات إبداع بقيت محدودة وتعني فئة محددة من المتابعين. وفي كل الأحوال، وبين «الثورتين» السوريتين المتعاقبتين ضد النظام الأسدي، كان الحضور العام لهذه الفئة من المثقفين لا يتجاوز إصدار البيانات لتثبيت موقف ما تجاه قضية وطنية عامة. وخارج هكذا نوع من النشاط، وضمن شروط محددة سلفاً، ما كان من الممكن الالتقاء والتفاعل والحديث بحرية ولو نسبياً. في كل الأحوال، حتى أولئك «النجوم» استُثمِروا في حالات كثيرة لصالح إعطاء صورة أكثر انفتاحاً لنظام أكثر «تقدمية» من شعبه «الرجعي»- «المتن العريض» منه على الأقل.
بالنتيجة، بات من المستحيل الحديث عن «متن عريض» يلعب دوراً مرجعياً للجميع، والمتن نفسه يكاد يكون الجهة الرئيسية التي يستهدفها النظام بقمعه من جهة، ومن جهة أخرى كان الحديث عن «مرجعية جامعة وشاملة» أمراً لا يخرج عن إطار الأدبيات السطحية، أو حتى التعويض اللفظي عن أشياء مُفتقَدة فعلاً، دون أي بحث جدي في معنى هذا الإطار، ملامحه، إجماع جميع مكونات الشعب السوري عليه، إمكانيات تَشكُّلِهِ والمُعيقات التي يواجهها.
لكن بالمقابل، هناك من خرج ضد النظام، مرتين خلال ثلاثة عقود، مطالباً بحق طبيعي بالعيش بحرية وكرامة في وطنه، وهُزِمَ أمام النظام نفسه. كيف يمكن تفسير هذه الهزيمة، دون اللجوء إلى غيبيات آخر الزمان والقابضين على جَمره، أو غياهب نظرية المؤامرة؟!
في الحقيقة، لا يمكن الهروب هنا من فكرة أن «المتن العريض»، بقواه السياسية المهيمنة، يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية تجاه الهزيمتين في مواجهتين تم خوضهما بالعقلية نفسها التي أودت إلى الفشل نفسه، وبالوقوف تماماً على الأرضية نفسها التي يقف عليها النظام، على الرغم من انقضاء ثلاثين عاماً بينهما. أعوامٌ كانت حاسمة في كامل تفاصيلها، ليس على المستوى السوري فحسب، بل في العالم كله.
تحدَّثَ ياسين الحاج صالح عن «الوعي الإمبراطوري» عند عموم المسلمين،هذه الفكرة مبثوثة في أكثر من نصّ ومقابلة مع ياسين الحاج صالح. مما يلعب دوراً معيقاً في تموضعهم ضمن إطار صحيح لخوض النضال العالمي من أجل الحرية والمساواة في عالم متعدد يقبل الجميع. الحقيقة أنه، وعلى المستوى السوري، فإن هذا الوعي بالذات لعبَ دوراً معيقاً جداً ليس في موضعة نضالات «المتن العريض» من السوريين ضد نظام الاستبداد الأسدي ضمن إطاره الجامع الصحيح فحسب، بل أيضا كان عامل كبح في جعل هذا «المتن» يلعب دور المرجعية، أو على الأقل الحليف الموثوق، لأية فئة أو طائفة أخرى تضررت من استبداد النظام بشكل مباشر. إن أضفنا إلى هذا «الوعي الإمبراطوري» الإحساسَ العميق بالمظلومية المذكورة أعلاه، مما يشحذ مخيلة تآمرية ترى الجميع أعداء، فسنجد أنفسنا أمام حالة فصام تنوس بين حدين أقصيين في غاية التطرف: وعي إمبراطوري من جهة، وإحساس بالمظلومية من جهة أخرى. والمشكلة أن «نَوسَاناً» كهذا كان لا بدّ أن يطفو على السطح بطريقة أقرب إلى الفضيحة منها إلى أي شيء آخر، حيث «النماذج» التي قدمتها القوى السياسية المهيمنة لدى هذه الطائفة أمام عموم السوريين، بصفتها قيادات للنضال من أجل الحرية والكرامة، تبدأ بزهران علوش، لتنتهي بأبي محمد الجولاني، مروراً بـ «المعجزة» أبو عمشة. فكيف يمكن لبقية فئات المجتمع السوري وطوائفه أن تشعر بالاطمئنان إلى «متن» ينتج هكذا قيادات؟!من المفيد التذكير هنا بأن بروز هكذا نموذج من «القيادات» لم يتم عبر عملية «طبيعية» بدوره، بقدر ما نجم عن سلسلة طويلة من العنف والعنف المضاد والتصفيات والتصفيات المضادة التي ما تزال مستمرة إلى الساعة، والتي أدّت إلى هكذا نوع من «الاصطفاء» العجائبي.
لا يمكن أبداً بناء شيءٍ على أوهام، بينما الوعي الإمبراطوري وعقدة المظلومية لا يمكنهما الاستمرار إلا على هذه الأوهام. العيش على الأرض ومحاولة فهم العقبات الحقيقية، والممكنات الحقيقة في مواجهتها أيضاً، أمر آخر يتطلب عقلية مختلفة لا تعاني أي شكل من أشكال الفصام، أو على الأقل تقاومه حيث أصحاب هذه العقلية مدركون تماماً إلى أي مدى هم بحاجة إلى عون الجميع في مسعاهم الذي بذلوا من أجله تضحيات لا يمكن إنكارها أبداً. العمل بهذا الاتجاه ما كان وراداً في كلتا الحالتين.. الثورتين.. الهزيمتين بالنسبة لـ «المتن العريض» الذي نتحدث عنه، والمقصود مجدداً هو التوجه العام عند الغالبية الكبرى من التيارات والتوجهات التي تشكل هذا «المتن». ولدينا أيضاً حقيقةُ أننا نعيش في عالم بات يحسب حساباً لكثير من الحقوق التي كانت مغيبة، أو غير ذات قيمة، عبر قرون طويلة من التجربة البشرية؛ تلك الحقيقة، وبقدر ما هي مشجعة لكل ساعٍ نحو حق مشروع، بقدر ما تشترط على من يريد الانخراط في هذا المسعى أن يراعي حقوقاً لآخرين قد يختلفون معه في كثير الأمور التي تتطلب منه مراجعة شاملة لموقفه تجاه هذه الأمور بالذات.مثلاً: حقوق المثليين، حق اختيار الهوية الجندرية، الزواج المدني، الاعتراف بأن المحرقة اليهودية قد حصلت على الأقل، وكثيرٌ من القضايا التي لا ينظر إليها «المتن العربي السنّي العريض» بعين الارتياح أبداً.
ولكن، وحتى لا نمضي بعيداً، دعونا نفكر فيمن هم داخل هذا «المتن» ولم يغادروه أبداً، ورفضوا حتى فكرة المغادرة، مراهنين على إمكانية تطور تفكير هذا «المتن» باتجاه فهم العالم الذي يعيشون فيه بشكل أكثر انفتاحاً وكـ «سُنّة» بشرية لا بدّ آتية. الراحل جودت سعيد يخطر في البال ضمن هذا السياق.
ترك الراحل تراثاً هائلاً في محاولة «تبيئة» العلوم الإنسانية المعاصرة (مفاهيماً وطُرُقَ تفكير) ضمن الإطار الثقافي الإسلامي العام، مُراهِناً على أن ما انقطع خلال قرون ركود طويلة، على المستوى الفكري- سبقها قرون كان العالم الإسلامي خلالها منارة للفكر المنفتح والرائد في مختلف المجالات- يمكن أن يُوصَل من جديد، ليعود العالم الإسلامي إلى لعب دوره الريادي في الفضاء الثقافي الكوني العام. هذا التراث لم يُستفَد منه بشيء، ولم يتقدم أحدٌ ليتابع تلك «السُنّة» التي بدأها الراحل. بل إن فِكره بالكامل بقي ذا تأثير هامشي ومحدود في «المتن العريض»، مع أن بدايات الثورة السورية (المرحلة السلمية) كانت قد شهدت دوراً بارزاً لتلاميذ الراحل جودت سعيد (يُذكَر هنا الشهيدان غياث مطر ويحيى شوربجي)، إلا أن ما حصل في تلك البدايات كان أقرب إلى حلم سرعان ما انطفأ… ولكن ليس على أيدي النظام وحده فحسب.
هذا مثال يشي بالكثير حول تَقبُّل «المتن العريض» لأفكار تحمل بذور تغيير وانفتاح. وكأن هناك من بقي مُصرّاً على القول بأنهم ما قاموا بهذه الثورة من أجل وطن لجميع السوريين، إنما وطن لهم وحدهم! هذا في كل الأحوال ما كان يُقال في «نقد» و«مراجعة» تجربة الثمانينات المريرة، خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من نظام الأسد. خلال تلك الفترة لطالما سمعنا،هذه «الشهادة» هنا ذات طابع شفهي. كُثُرٌ ممن عاصروا تلك الفترة يذكرون تماماً طبيعة النقد الذي تم توجيهه لتصدر الإسلاميين مشهد المعارضة لنظام الأسد خلال حراك الثمانينات. ومن جهة من كانوا داخل الحراك وتركوه بعد سيطرة الإسلاميين عليه بشكل كامل، أن الانتفاضة ضد نظام الأسد في ذلك الوقت لم تكن لأنه نظام استبدادي، بل لأنه نظام علوي فقط!
يبدو، وللأسف الشديد، أن «المتن العريض» الذي لا حراك في سوريا بدون انخراطه الكامل في هذا الحراك، ما زال يقف عند هذه النقطة، وذلك عند غالبية كبيرة ممن ما زالوا ينضوون تحت هذا التصنيف، ويُعرّفون أنفسهم بهذه الصفة. وهذه ليست وصفة للفشل فحسب، بل أيضاً لتهمة فاشية معلنة بكل المقاييس، لا يمكن أن تُرفَع إلا بـ «ثورة» داخل هذا «المتن».
مع بداية الثورة السورية كانت هناك «مصالحة» حقيقية مع الذات.. بدايات.. كُنّا كمن خرج من سُبات عميق دام عقوداً، وبدأ بتحسُّس أطرافه ليتأكد من أنه ما يزال حياً وقادراً على الحركة. كانت هناك الكثير من الوعود التي أطلقتها تلك الرغبة الجامحة بالعيش كبقية عباد الله في أي مكان آخر في العالم، بعيداً عن المقبرة الأسدية. ولكن ما حدث لاحقاً جاء بعكس كل تلك الوعود. الارتكاسةُ فاقت الوصف، ومشهد العار بلغ ذروته مع قضية مختطفي دوما الأربعة. لم يمتلك ذلك «المتن» الجرأة حتى ليقول إن اختطاف ناشطي دوما الأربعة كان جريمة يجب أن يلاحق مرتبكها ويعاقب، ويجب أن يُعرف مصير المختطفين، إذ لم تُسمع أصوات كان يجب أن تكون مدوية، وهي بصفتها هذه كانت قادرة على وقف استمرار الممارسات الأسدية نفسها على أيدي التنظيمات الإسلامية المهيمنة. هكذا كان التفاؤل، أقل التفاؤل، مع بدايات الصدمة بخبر الاختطاف والتغييب… ما بقي فقط في الذاكرة هو ذلك العجوز الدوماني الذي علّقَ على القضية بأن، المناضلتين، رزان زيتونة وسميرة الخليل، كانتا سافرتين ولم تَحترما «خصوصية» المجتمع الدوماني!