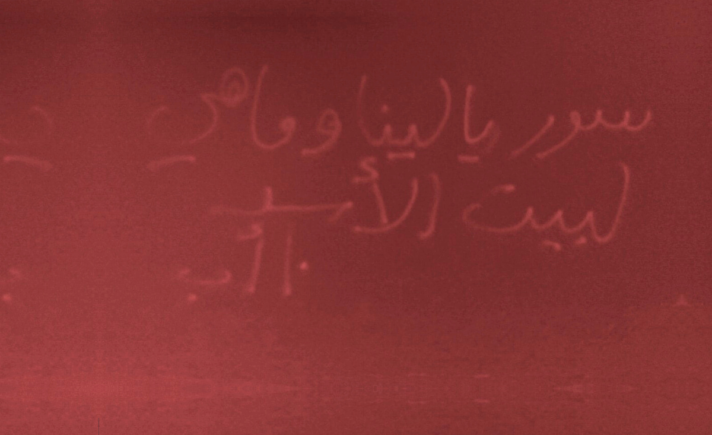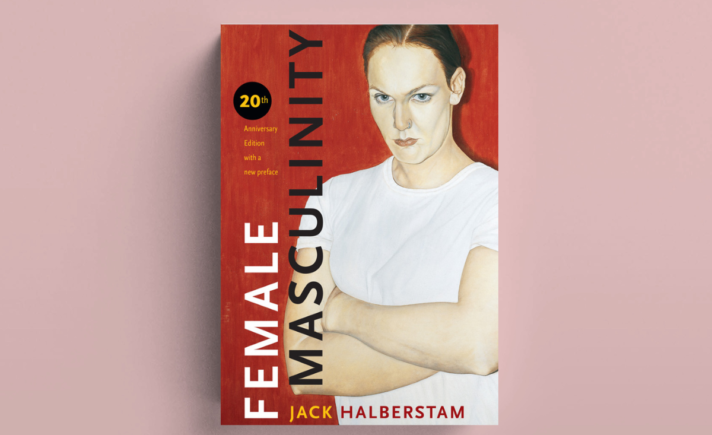«احركلك حركة!»، «انشالله بيقلب التراب ذهب بين إيديك»، «حرّك لبناتك بينباعو»، «أسعى يا عبدي وأنا بسعى معك»، «ما بينزل إلّا واقف».
تبدو الحركة، جامعُ هذه التعابير بشكل مباشر أو غير مباشر، وكأنها كذلك جامعٌ لتجارب صَوغِ الرجولة في مجتمعنا السوري. الحركة هي الخروج من البيت والفضاء الحميمي الخاص بالنساء والأمهات الحاضنات، أي عكس السكون والاستنقاع. والحركة والخروج هما طقسُ ولوجٍ للذكورة بوصفهما استكشافاً لعوالم جديدة، وبوصفهما كذلك ترياقاً أو مُعوِّضاً لانعدام الحريات في بلادنا المحكومة بموت السياسة، حتى لو كان الهدف المباشر الواعي منها هو الانتقال الاجتماعي صعوداً عبر إيجاد فرص عمل وترقٍّ في مجتمعاتنا، التي تضنيها معدلات البطالة وصعوبات الفرص الاقتصادية.
الهوس بالحركة قد يكون ترجمة لتقييدٍ قاهرٍ لا يمكن في بعض الظروف الالتفاف عليه إلّا عمودياً عبر السماء، كما بيّنت الباحثة إيمّا بولتنسكي في بحث لها حول الذكورة المكسورة وكشّاشي الحمام السوريين في لبنان، سجناء رقع صغيرة من الأرض، لا يمكن عبورها بسبب القيود الأمنية اللبنانية على السوريين ولا يمكن تجاوزها باتجاه سوريا، حيث العودة مستحيلة لأسباب تتعلق بالحياة أو الموت في أغلب الأحيان. تستحيل حركة هؤلاء الرجال فيُسقَط خيال الحركة عبر الحمام، القادر حتى على الدخول إلى السماء السورية دون قيود (انظر المراجع في آخر النصّ).
ولكن لماذا لا تكون رحلة اللجوء، التي كانت في حالات سوريين كثيرين منذ العام 2011 ملحميةً في طبيعتها وطبيعة المشاقّ والمخاطر المحيقة بها، لماذا لا تكون التتويج النهائي للرجولة؟ هل هناك شكٌّ بعد هكذا رحلة أن «الرجّال رجّال»؟
في الواقع، تُخضِعُ تجربة الهجرة، وخاصة في حال لم تكن اختيارية كما هي في حالة اللجوء، تُخضِعُ المهاجرين الرِجال لمحنٍ متعددة الأشكال، عليهم على إثرها أن يفاوضوا ويعيدوا تأسيس هوية رجولية وفق مرجعيات ومعايير مرتبطة، مرنة وحتى سائلة، بما تقتضيه الهجرة من مرونة وسيولة ودفعٍ للحدود بكل معاني الحدود، وفي الوقت عينه صلبة صلابة مرجعياتنا الأبوية حول الرجولة والهوية. هذه الرجولة ليست قيمة مطلقة خارجة عن التبادلات والعلاقات الاجتماعية، بل هي علائقية تتصل بعلاقات الرجال بين بعضهم وبتنافسهم وتكتيكات تمايز رأسمالهم الاجتماعي والرمزي بين بعضهم، حيث تكون الهيمنة على سائر الرجال عبر النجاح وإنجاز ما «ينبغي» إنجازه في سياق معين (اجتماعي، اقتصادي، تاريخي) هي التحقق الرجولي، وليس فقط العلاقة مع النساء جنسانياً.
الرجولة كما نَلحظُها في سياقنا السوري العام، قبل تجربة الشتات الجمعية، هي تجربة فردانية بحتة وليست تعاضدية. والتنشئة الاجتماعية للذكور واجتماعهم، وهنا لا أتحدث عن علاقات الصداقة الحميمة، ولكن عن اجتماعهم بمعنى تواجدهم في سياقات تنشئة اجتماعية مشتركة، تكون في أحيان كثيرة تجاوراً لذواتٍ تستند إلى بعضها في المقارنة، مقارنة يستند إليها الرجال ليعرفوا إن كانوا على الصراط المستقيم في مسار الرجولة.
تصبح إذن إعادة تعريف الهوية الجندرية الرجولية في الشتات، وخاصة في الفترة الأولى، شديدة الصعوبة. هل تُقاس على المقياس الأبوي السائد عندنا؟ مقياس الذكورة المهيمنة؟ ومن الذي يمسك بزمام المقياس؟ الرجال السوريون الآخرون في مجتمعات الهجرة، أم المجتمعات الأمّ عبر الواتس آب؟ أم الرجال والنساء في المجتمعات المُضيفة؟ كل هذه التعقيدات تتواجد ضمن عملية غير واضحة المعالم تماماً يُطلَق عليها «الاندماج».
إذن، تشكيل الهوية الجندرية سياقيٌ جغرافيٌ يتأثر حتماً بالمجتمع المُضيف ومعاييره وشروطه، حتى أنه يتأثر بالمجتمعات المحلية جداً، الأضيق من صبغة المجتمع المُضيف الوطني الأعم، كل ذلك في سيولة تتنازع وتتصارع مع ماكينة صلبة وحتمية وشبه إيديولوجية ورثناها في مجتمعنا الأبوي عن الرجولة. قد يكون ثمن هذا الصراع اغتراباً مضنياً لقيم جمالية أخلاقية، أو لِنَقُل أفكار جمالية وأخلاقية نحملها جميعاً عن الرجولة: الشهامة، الكرم والفزعة والحماية والإيثار، أفكارٌ قد يُدرِجها المجتمع المُضيف كقيم متقادمة «فرسانية»، أكثر منها «مواطنية» لها تسميات قانونية، حيث «الفزعة» و«نصرة المستضعف» ليست إلا «مساندة شخص في خطر».
في هذا النص، أحاول أن أُدرِجَ بعض الملاحظات، الانطباعية البحتة، عن تشكيل وإعادة تشكيل الرجولة السورية في الشتات، وفي فرنسا على وجه الخصوص، من معايشتي ومراقبتي لبعض المسارات الجندرية السورية خلال فترة السنوات الثماني الماضية. هي ملاحظاتٌ آملُ أن تشجع على مراكمة سلسلة لها علاقة بإعادة تشكل الهوية الجندرية السورية في الجغرافية مترامية الأطراف التي أضحى فيها السوريون، في محاولة لفهم «السوري» الذي بقي فينا.
وصل محمد إلى فرنسا في أواخر العام 2014 مع زوجته وولديه. انتقلت العائلة إلى مدن عديدة بحسب علاقات الأسرة وشبكاتها الاجتماعية الداعمة المستقبلة، ومن ثمّ بحسب مراكز استقبال اللاجئين وقراراتها الاعتباطية أحياناً حول إسكان العائلات الطالبة للّجوء في الفترة الأولى.
الفترة الأولى تعني إدارياً تقديم طلب اللجوء، وانتظار تقدّم المعاملة حتى الحصول على قرار قبول الطلب ومنح المتقدم صفة لاجئ. على مستوى الزمن هي اعتباطية بشكل كامل، قد تمتد من عدة أشهر حتى سنتين على سبيل المثال، بحسب المنطقة وضغط الأعداد على مراكز استقبال الطلبات. على المستوى النفسي المشاعري هي فترة مرادفة للإقامة الجبرية ضمن الزمن؛ انتظار. الانتظار الذي يعرفه السوريون ويميزونه من بعد آلاف الكيلومترات كتجربة وجودية «أبدية» في سوريا. إلا أن الانتظار تجربة مؤنَّثة تعريفاً أو تُؤنَّث، الأمهات ينتظرنَ الأولاد والمعتقلين وعودة الغائبين، الآباء يخرجون لخِداع الانتظار. في تجربة اللجوء الأولى يُضاف على الانتظار ثقلُ عائق اللغة الذي يمنع الحركة نوعاً ما، خاصة وأن سياسات الاستقبال اللغوية الفرنسية قد تكون من أسوأ السياسات الأوروبية على الإطلاق، من حيث الجودة ومن حيث الكمّ ولحظة بدء الدورات اللغوية في مسار طلب اللجوء الإداري. في حالة محمد كما كثيرين مثله، قام المجتمع المدني الفرنسي بشكل أساسي بهذه المهمة، تعليم اللغة وبشكل هاوٍ وغير متّسق أو مدروس تربوياً بالضرورة.
عدم التمكّن اللغوي فيه شيء من التطفيل للرجال والنساء، وخاصة الحاصلين منهم على تعليم عالٍ في سوريا، وفيه إخصاء معنوي للرجال، حيث اللغة جزءٌ من عدّة مفاوضات المكانة الجندرية والرجولة حتماً، إذ لا بدّ أن تكون اللغة جزءاً من إتقان شيفرات التداول بين مجتمعِ رجال.
محمد المعتاد على التفاوض والسعي لتحقيق رجولته في ظروف شديدة الصعوبة في سوريا، حيث «تدبير الراس» في سياق اقتصادي وسياسي بالغ العسر هو الطقس الأساسي لولوج عالم الرجال، بَدأَ أولاً بالسعي لتحويل مهارات الحركة الأبسط المتاحة إلى رأسمال رمزي. عدّلَ شهادة السياقة بأقصى سرعة ممكنة حيث شهادة السياقة لم تكن مرتبطة بالحصول على قرار حق اللجوء النهائي الذي يمنحه مكتب الهجرة. شهادة السياقة من أهم الأشياء التي حرص الرجال السوريون على الإسراع في تحصيلها، وكانت معاملتها سريعة وبسيطة في فرنسا ثم تعقدّت بعض الشيء بعد أن قرّرت الإدارة الفرنسية التحقق من عدم تزوير الشهادات السورية، على ما تم تداوله. قيادة السيارة أتاحت ثلاثة عناصر في تحقيق الرجولة كما يعرفها الرجل السوري، وكانت ترياقاً للانتظار المُقلِق الذي لم نعد نتحمّله نحن السوريون: أتاحت القدرة على تملّك المكان نظرياً وكان الـ «جي بي إس» الحليفَ الأساسي للرجل السوري في هذه الرحلة. تَملُّكُ المكان يعني التجوال في مناطق فرنسا إن كان لدى اللاجىء بعض المدّخرات التي جلبها معه، والتي تكفي لشراء سيارة مستعملة والتزود الدائم بالوقود. تَملُّكُ المكان الفرنسي والتعرف عليه، واستكشافُ مناطق جديدة لا يعرفها عموم الناس، و لا يعرفها عموم السوريين على وجه الخصوص، وكلّما زادت العناصر المعروفة عن تاريخ المناطق المستكشفة كلّما كان الامتلاك الرمزي للمكان أفضل. المعلومات وتحصيلها هي عملية شديدة المرونة تُستوحى من المقروء وممّا يُسمع من سوريين آخرين، ومن فرنسيين مُضيفين. امتلاكُ المكان وفكُّ شيفراته هو اختزالٌ لفترة الانتظار وللحالة الإدارية المندرجة تحت صفة «لاجئ»، وهو استعادةٌ لترسيمة قديمة في طقوس تَحقُّق الرجولة، أي السفر والابتعاد عن البيت العائلي، ولكن هذه المرة لم يعد السفر إلى فرنسا كافياً لهذا التحقق، أصبحت فرنسا «البيت»، أصبحت «عنّا في فرنسا» أو «عنّا في تولوز»، وينبغي أن يبتعد الرجل عن «عنّا» ليمتحنَ هذه المرونة الأساسية في الرجولة. الابتعاد هذا يؤمن كذلك الابتعاد عن ملاصقة الزوجة، وهي محنة مشتركة للكثير من الأزواج السوريين الذين لم يختبروا علاقاتهم وهم «وجههم بوجه بعض» ينتظرون. والسيارة تُؤمّن كذلك الانتقال عبر أوروبا كلّها للقاء العائلة المنتشرة في أوروبا، العائلة الكبيرة والأصدقاء ومجتمع الرجال الأقران المهمُّ على المستوى النفسي لكل إنسان اقتُلِعَ من أرضه، ولكنه مهم بشكل خاص للرجال لاستعادة البوصلة والمرآة التي تشكل مقياس الرجولة؛ الرجل الآخر. في التداول الاجتماعي بين الرجال السوريين، المقارنة المتبادلة شديدة الأهمية للتَحقُّق الرجولي، يستمد الشعورَ بالهوية الجندرية ليس عبر نظرة المرأة الجنسانية للرجل وحسب بل عبر المقارنة، بالمنجز وبالاندماج وبصعود رأسماله الرمزي. ومن يبارك هذا الصعود ويصادق عليه إلا عين الرجل الصنو؟ فالرجل السويدي أو الألماني أو الفرنسي غير مهتم بهذا المنجز، هو مندرج ضمن إيكو سيستم مختلف. والرحلات والتنقلات وزيارة الأصدقاء في أوروبا تتيح تفحُّصَ تغير الرأسمال الجسماني الجنساني، هل كبر الصديق أو القريب الرجل بعد هذه التجربة القاسية؟ هل صحته تمام؟ هل يمارس الرياضة؟ هل حظوظه كبيرة في إقامة علاقة مع امرأة أوروبية إن كان عازباً؟ والسيارة كذلك هي الحليف الأمثل في العمل غير الرسمي، توصيل، نقل، الحصول على بضائع بسعر أرخص، شراء دخان من بلجيكا وألمانيا إلخ. أو حتى «بلابلا كار» حيث التنقل والسفر قد يُجمَع مع التوصيل، إذ يُحصِّلُ السائق ثمن وقود سفرياته مع مسافرين آخرين لقاء توصيلهم ومشاركتهم سيارته. التنقل عبر الأماكن هو أيضاً بحثٌ عن إمكانيات مشروع أو الحصول على عمل، عدم الإذعان لضيق مكان الاستقبال وشروطه وربما بُعده عن ديناميات العمل. كان هذا أولَ ما فعله محمد، عدّل شهادة سياقته واشترى سيارة.
أثناء فترة انتظار الأوراق وقرار قبول طلب اللجوء، لم يتقبّل محمد فكرة تلقي المساعدة الاجتماعية للّذين في مثل وضعه، والتي لم يتجاوز مقدارها 11 يورو للشخص في اليوم الواحد (منذ تموز 2022 عُدّلت لتبلغ 12 يورو)، لا سيما وأن هذه المساعدة تحمل اسم المساعدة المؤقتة للانتظار (َAllocation temporaire d’attente). كان يجول في المنطقة الزراعية المحيطة بمركز استقبال العائلة ويتعرّف على المزارعين ويحاول أن يتفاهم معهم بما تيسر من لغة، لينتهي بعد فترة وجيزة مياوماً غير رسمي، وبحسب رغبته ومزاجه يقطف ما يرغب به من المنتج مباشرة مقابل أسعار بسيطة جداً لا تشكل سوى نسبة بسيطة من سعر سوق التوزيع في المدن. العلاقة المباشرة مع الأرض كانت تُشعِرُ محمد بالهدوء، لأنه يُعيد تحريك جسمه أولاً في مقاومة للكسل، ويعيد تحريك معرفة أساسية متعلّقة بالنباتات والأرض يستطيع تداولها وتثمينها مع مجتمعه الجديد، وفيها بعدٌ رمزي له علاقة بالثبات في الأرض الجديدة وبرهانٌ على أن جسده الرجولي لا يتحلل في استنقاع الانتظار. هذه الرغبة الحارّة والشاعرية ببذل القوة الجسدية الرجولية على معبد الأرض، دفعت محمد بعد سنوات قليلة لأن يستأجر أرضاً غير استراتيجية وغير موائمة تماماً للزراعة ويفلحها ويبسطها ويُزيل منها الأشجار المتداعية ويمهّدها بطريقة شبه هستيرية. رمزية الأرض كنقطة بدءٍ وتملُّكٍ للمكان والوطن الجديد، وإحساسُ الفقد للأرض الأم ومحاوله تعويضه مباشرة، هي معانٍ مشتركة لجميع المهاجرين رجالاً ونساء، ولكننا نزيد في حالة محمد كرجل أنها كانت مُختبراً لصلاحية جسده الرجولي كـ «فلّاح»، فلّاح ليس بالمعنى المهني البحت ولكن أيضاً بالمعنى الجندري كهوية بدئية لمن يفلح ويخصّب ويثمّر. الأرض هي «جيم» محمد، هيكل الجسد والعضلات لرجولته مضافاً إليها قيم حول الرجولة المُخصَّبة.
هذه الفترة المفتاحية في حياة أي طالب لجوء، فترةُ الانتظار الأولى، يَسِمُها حدثٌ أساسيٌ هو محنة أخرى للرجولة السورية في تصارعها العنيف بين المرونة والصلابة، بين مرونة التأقلم والفهم البراغماتي للواقع والمطلوب بحسب الموقف، أو لِنَقُل الذكاء الموقفي، وبين البأس والعزم وخفر الرجولة التي لا تُحبّذ الانكشاف النفسي والجسدي. هذا الحدث الأساسي هو المقابلة مع مكتب الهجرة و سرد «القصة»، القصة التي دفعت طالب اللجوء إلى الخروج من بلده وعدم العودة إليه. تُحضَّر «القصة» مسبقاً، قبل شهور، بمساعدة الجمعيات والأصدقاء ومتحدثي اللغة الفرنسية من المحيط. كان على محمد مهمة منهكة، وهي أن يُزودَّ من يكتبون له القصة بكل تفصيل من شأنه أن يُدعّم قصته أمام مكتب الهجرة، كل تفصيل حول الخطر الأمني في سوريا، الاعتقال، التعذيب، خطر التعبئة للجيش بما أنه ما زال شاباً وفي سنّ يسمح بتعبئته. في يوم المقابلة لم يستطع بسهولة أن يُخرِجَ هذه التفاصيل التي تحدَّثَ عنها في القصة أمام موظّف التحقيق في الأوفبرا (مكتب الهجرة الفرنسي)، إذ شعر للحظة أن رجولته مهانة ومكشوفة لأنه مضطر أن يتحدث عن كل هذه التفاصيل، ولكن رجولته تحتم عليه في الوقت نفسه أن يفعل الأفضل له ولأولاده ولعائلته ومستقبلها. جوهر رجولة محمد كان هذا التمدد وهذه المراوحة المضنية بين مرونة سائلة وصلابة قاسية.
وفي فترة الانتظار لم يتقبّل محمد بسهولة التعامل مع الجمعيات الأهلية التي تقدم مساعدات عينية للاجئين في مراكز الاستقبال، كان عليه أن يساهم معهم في أعمال الإغاثة، فتطوَّعَ للعمل ساعات محددة في الأسبوع في الجمعية نفسها. منحه هذا التطوع شعوراً بالكرامة والفاعلية، ولكن كان عليه أن يثبت مرونة من نوع آخر وهي قبول الدور الرعائي النسائي من توزيع طعام وبطانيات للمحتاجين. مرةً أخرى، صلابةٌ ومرونةٌ وتَحرّكٌ بينهما.
بدأ تفاعلُ محمد وعائلته مع المجتمع المُضيف يصبح أكثر غنىً بعد فترة، وخاصة بعد انتهاء فترة الانتظار. طبيعة التفاعلات تتغير بتغير المدينة، وبتغيّر الجمعية المرافقة للّاجئين والأشخاص المنخرطين في العمل الاجتماعي مع اللاجئين. كان يشعر براحة مع العاملين الاجتماعيين الأكثر شباباً وفتوّة ومن ذوي التوجه السياسي اليساري، أكثر من راحته مع المتقدمين في السن المتقاعدين ممّن كانوا يعملون في إطار إغاثي كنسي، ليس أبداً لأنه متدين أو متعصب دينياً، على العكس تماماً. هو كان صاحب اتجاهات يسارية غير منظمة في سوريا، ولكن ليس هذا وحسب. العلاقة مع الإغاثة التقليدية محددةُ القالب والهوية وغير ولّادة لتفاعلات وأفكار تُشعره بالأهلية والفاعلية، هي علاقة منتهية محددة الطابع، وكل ما كان يهرب منه هو هذه العلاقات المحددة جداً، التي تضعه في قالب اللاجئ المتلقي. إن تأملنا أكثر في هذه العلاقة مع البنى السياسية والأهلية المُرحِّبة باللاجئين سنجد أنها كانت مصدراً من بين المصادر المتاحة للمهاجرين، عُدّةً لأفكارٍ يتناقلها بمرونة بحتة ويعيد صياغتها لتمكين أهليته وهويته الجندرية، وهي مرونة غير متّسقة بالضرورة. فمثلاً، الحياة البديلة للكثير من بنى المجتمع المدني هذه وأفكارها البيئية المناهضة للرأسمالية والعولمة والامبريالية تمنحه أفكاراً تحصينية، يتداولها حين يحاول أن يجد معنى لِما حصل له كسوري وما حصل لسوريا. قد تتبلور الأفكار في النهاية بشكل مؤامراتيّ حول السياسة ودور أميركا والقوى الكبرى في تدميرنا. قد نقول هذا كلاسيكي، نعم. ولكن هذه العُدّة المرنة تجعل محمد وكثيرين من أمثاله يستمدّون تصوراً عن عدم سهولة حصولهم على عمل، وهو، أي عدم الحصول على عمل، من شأنه أن يمسّ هويتهم الجندرية بشدة، فيستمدون تصوراً مفاده أنهم هم الذين يقاومون أشكال الإنتاج الرأسمالية الاغترابية وغير الإنسانية، وهم من يريدون أن يكونوا أسياد أعمالهم وأسياد أنفسهم، وليس أنهم ملفوظون من سوق العمل بسبب وصولهم المتأخر إليه أو صعوبة إيجاد عمل على العموم في فرنسا، أو أن اللغة غير الكافية هي السبب الموضوعي العملي لعدم إيجاد عمل، وهذا عامل إقصاء شديد القسوة دون شك، إلا أنه السبب الحقيقي في كثير من الأحيان.
هذه التفاعلات الانتقائية مع عُدّة أفكارِ المجتمعِ المُضيف تستبعد دائماً الأفكار المتعلقة بالعائلة والحريات المجتمعية، وحتى بعض المقاييس الأبوية المتجذرة والمتقادمة في مجتمعنا للتحقُّقَ الرجولي. لم يقبل محمد الانغماس في دعم حرية المثليين، وهم جزءٌ من العاملين في المجتمع المدني الذي استقبله؛ لم يقبل ليس بالمعنى العدائي، ولكن لأنه لم يستطع أن يتخيل مثلاً أن ابنه يمكن أن يكون مثلياً. استطاع محمد أن يُنظِّرَ لفكرته المتحفظة على دعم المثليين من العُدّة النظرية المؤامرتية نفسها المُقاوِمَة للاستلاب وللقوى الخفية التي تلعب بحياتنا دون علمنا، التنظير نفسه الذي يتداوله بشكل سائل مع رفاق المجتمع المُضيف، ولكن استخدمه هذه المرة ليحمي نفسه من «الدين الجديد» الذي يحاولون «دحشه في أنوفنا غصباً»، أي المثلية. هي نفس العُدّة النقدية التي تجعله يحمي نفسه من الرأسمالية المتوحشة باختياره عدم العمل بشكل تقليدي، أي موظفاً براتب آخر الشهر، وهي نفسها تجعله لا يقبل بأخذ لقاح الكوفيد لأنها مؤامرة من شركات الأدوية الربحية، والتي تستهدف كبار السنّ للتخلص منهم وتخفيف أعبائهم. ولكن هذه العُدّة النظرية لحياة بديلة لا تجعله يستغني عن حلم تملُّكِ منزلٍ وأرضٍ كمعيار لتحقق رجولته. يُفلتر محمد الكثير من أفكار أصدقائه في المجتمع المُضيف، وينتقي منها ما يحتاجه في تثبيت هويتة الجندرية في المكان الجديد. الأجواء اليسارية البديلة، وأحياناً حتى اليسارية القصوى، تمنحه شعور المقاومة وعدم الجريان في تيار جارف، بوصفه رجلاً حقيقياً. تُحيله إلى ناقدٍ للكثير من أوجه المجتمع الجديد، وناقدٍ بإفراط يستحيلُ مؤامرتياً، ولكنها لم تمسّ الكثير من معايير الرجولة وخاصة معايير التمايز عن الرجال الآخرين. هو يعتقد أن التقدمية البحتة في خياراته، وخاصة عدم العمل وفق المسارات التقليدية للعمل، هي «جبران خاطره» أمام رجال آخرين في سياقٍ يصعب فيه العمل بشدّة، حتى على رجال المجتمع المُضيف. في كل مرة يقابل محمد رجلاً سورياً وجد عملاً بسيطاً، يسأله ضاحكاً: «وهل راتبك يفرق كثيراً عن المساعدة الاجتماعية بالمحصلة؟!».
الرجولة السورية ليست محددة المعالم وليست منتهية، تتشكل بحسب السياق الجغرافي، وهي مسار، مسارٌ من المرونة، كما يقول كثيرٌ من الباحثين (انظر المراجع في آخر النصّ)، ولكنها بلا شك تفاضلية وفردانية لا تتبلور ضمن جماعة الرجال إلا بالتفاضل بينهم، وهي مُرهِقة ومرتبطة بشدة بالعمل والصعود الاجتماعي إلى جانب تَعلُّقها بالجنسانية وبالرأسمال الجسدي كما حال كل الرجولات.
لم يتوقف محمد منذ لحظة وصولهم إلى فرنسا عن العمل، ولكن ليس بوصفه وظيفةً براتب. العمل، والكثير من العمل العضلي التأسيسي بأشكال عديدة. هو لا يتوقف عن الحركة والمراوحة بين الصلابة والمرونة التي تستهلكه جسدياً مع تقدمه بالعمر، دون أن يستطيع الإجابة حتى الآن عن سؤاله المتكرر منذ فترة: «لماذا لم تعد الصبايا ينظرنَ إليه كما قبل؟».