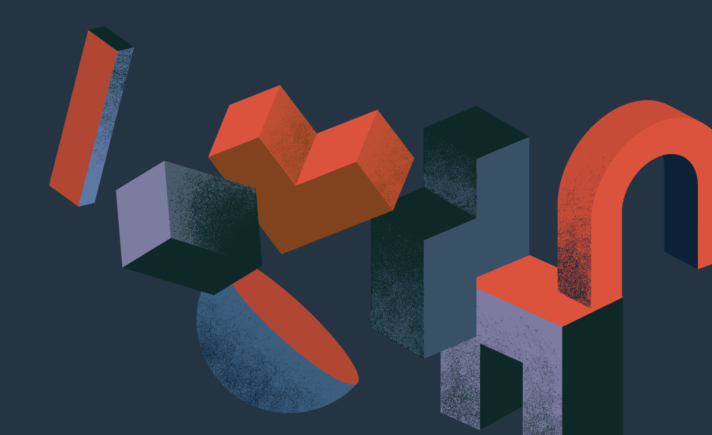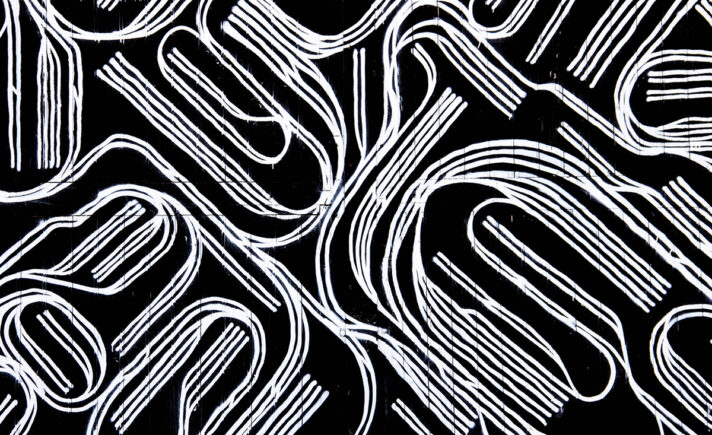الحداثة والتحديث والعالم الحديث
رغم تداخلها وتشابكها، تُحيل هذه المفاهيم إلى أشياء متباينة ومتمايزة. غير أن هذا التمايز يختفي أو يذبل في العديد من النقاشات والسجالات المعاصرة، التي تدمج هذه المفاهيم في بوتقة واحدة وكأنها تعبّر عن شيء واحد، هو الحداثة بشكل ضمني.
تتناول أدبيات نقد الحداثة العالمَ الحديث بنقدها وكأنّ الأخير تعبيرٌ عن الحداثة باعتبارها منظومة القيم والمعايير والتصورات التي وَسمت العصر الحديث، مثل العقلانية والعلمانية والاستقلال الذاتي والفردانية والتقدم، وذلك بشكل خاص منذ عصر التنوير. وبهذا، فإن التنوير والحداثة يمكن استخدامهما هنا بشكل تبادلي. كذلك، يشتبك نقد التحديث والاستراتيجيات السياسية للتحديث مع الحداثة مباشرة، وكأن التحديث ليس إﻻ تحقيقَ الحداثة. وهكذا يتحول النقد إلى نقد لمرجعية فكرية وإيديولوجية هي الحداثة، فيما تتحول كل مظاهر العالم الحديث واستراتيجيات التحديث إلى تعبيرات أو تمظهرات للحداثة نفسها، فتصير كل واقعة في العالم الحديث تعييناً وتَحقُّقاً للحداثة.
يعود هذا التداخل في جانب منه إلى الطبيعة الإيديولوجية للنقد نفسه وأغراضه. لكن هذا التداخلَ يُضفي قدراً كبيراً من الالتباس على النقاش، فتصير الحداثة فكرة غائمة، ويافطة تُفهَم بأشكال شديدة التباين والتعارض. وربما يُفسِّرُ هذا التباين في معنى الحداثة الاستنتاجات شديدة التنافر حولها، بين من يقول إن الحداثة مشروعٌ لم يكتمل بعد وإننا لسنا حداثيين كفاية أو حقاً، في مقابل من يجعل منها سبباً لكل ما حلّ بهذا العالم من مصائب وحروب.
تقوم إحدى استراتيجيات نقد الحداثة على الإحالة إلى ظواهر العالم الحديث بوصفها منجزات حداثية، كونها نتاجُ العالمِ الحديثِ وشرطِه التقني في أقل تقدير. مثلاً، الدولة الحديثة وما رافقها تاريخياً من حروب وصراعات وأنماط للتحكم والسيطرة، مثل الحرب العالمية الثانية والغولاغ والهولوكوست. بالمقابل، تُقدَّم المتخيلات السياسية «الرومانسية» في مواجهة هذا العالم الحديث البارد والمتجرّد عن الأخلاق، حيث تُحيل الرومانسية إلى التضامن العضوي للجماعة، إلى التجربة المُعاشة باستظلالِ ما هو أخلاقي، إلى لحظة ما قبل الانفصال عن الطبيعة. الحداثة الباردة والمنحلّة أخلاقياً (يمكن أن تتمثل بالعالم الرأسمالي أو التجربة الاستعمارية أو الدولة الوطنية وهلّم) في مواجهة الرومانسي (اللحظة السابقة والمرجعية، ويمكن أن تكون القرية أو الإسلام قبل الحداثة أو لحظة المدينة النبوية أو الخلافة الراشدة وهلّم).
تكمن المعضلة في أن العديد من ظواهر العالم الحديث التي تُقدَّم في سياق نقد الحداثة لا تتأسس إيديولوجياً على الحداثة، بل على المشروع المضاد لها، الرومانسية والعضوانية المتمردة على الحداثة نفسها. فالنازية ليست نتاجاً لتقليد فكري حداثي (التنوير)، وإنما لتقليد رومانسي مضاد ومعارض له. ينطبق هذا بدوره على تجارب الإسلاميين ومآلاتها، فهي الأخرى تقدم نفسها على أرضيةٍ معارضةٍ للحداثة.
عندها تبرز الحاجة للتأكيد على التمايز بين العالم الحديث والحداثة. فالعالم الحديث ليس مجرد تَحقُّقٍ للحداثة، بل هو أكثر تعقيداً من ربطه أو إحالته إلى تقليد فكري تأسيسي وحيد، سواء أسميناه الحداثة أو التنوير. العالم الحديث كواقع هو نتاجُ اشتباكٍ بين تصورات فكرية متباينة ومتنازعة، مثل تقاليد الثورة المضادة والثورة المحافظة والرومانسية مع تقاليد الثورة والتنوير والحداثة. وما يَظهر بوصفه لحظة مأساوية ومرعبة في «الدولة الحديثة» قد لا يكون نِتاج تقليد الحداثة، إنما نقيضها كما ظهر في ألمانيا النازية أو إيران الإسلامية. فليست تجارب العالم الحديث دليلاً أو حجة ضد الحداثة بذاتها، بل في كثير من الأحيان هي حجةٌ ضد التقاليد المعادية للحداثة باسم التقاليد والروحانيات والأخلاق، فهذه التقاليد كانت في أصل بعض هذه الظواهر الحديثة. هذا يجعل من شعار «الحداثة لم تكتمل بعد» ليورغن هابرماس شعاراً راهناً.
بمعزل عن البعد الدعوي لتعميق الحداثة أو نقدها، وهو ليس موضوعنا، تبقى هناك حاجةٌ ماسة لإجلاء التمايز بين العالم الحديث كعصر وواقعة من جهة والحداثة كنسق فكري من جهة أخرى، باعتبارها مفاهيم تحيل إلى أشياء متمايزة ومختلفة، وﻻ يمكن وضعها جميعاً في خانة واحدة والتصويب عليها.
الملحوظة الثانية تتعلق بفكرة «التقاليد» نفسها. تُحيل «التقاليد» إلى الماضي، أو إلى لحظة سابقة على الحداثة والعالم الحديث يُنظر إليها كلحظة معيارية ومثالية فُقدت تحت وطأة التحديث. وهذا النقد التقليدي يقدم نفسه ناطقاً باسم هذه اللحظة المرفوعة إلى معيارية تاريخية من جهة، وداعياً إلى استعادتها من جهة أخرى. هنا يمكن التساؤل فيما إذا كان تصور الماضي الذي يقدمه هذا النقد نفسه تقليدياً فعلاً بالقدر الذي يتخيله، أم إنه وليدُ العالم الحديث؟ أليست اللحظة المرفوعة باعتبارها لحظة تاريخية معيارية (وفعلياً مرفوعة خارجَ وفوقَ التاريخ) مجرّد مُتخيَّل حديث! بهذا المعنى، تنكشف الرومانسية بوصفها إيديولوجيا حديثة، هي ليست روح الجماعة القروية المندثرة، إنما التَخيُّلُ الحديث من طرف مجتمع مدني منشطر وممزق عن تلك «الجماعة القروية» وما يُعتقَد أنه روحها. الرومانسية هي التَخيُّل الحديث للماضي والتحدُّثُ باسمه، وليست الماضي نفسه. لا يتعلق هذا بمضمون الأفكار فحسب، إنما بكامل الشرط الاجتماعي والعملي لهذه الإيديولوجيا. تُقدِّم الدراسات الأنثربولوجية عدداً من الأمثلة عمّا يظهر بوصفه تقاليد ضاربة في القدم، ليتكشَّفَ لاحقاً عن كونها ممارسات حديثة لا تعود كثيراً إلى الوراء في الزمن، وإن قُدمت بوصفها جذوراً وطقوساً ضاربة في الماضي السحيق؛ إنها تقاليد مخترعة.
بطريقة مشابهة يمكن فهم الإحياء الإسلامي «السلفي» المعاصر، الذي يصوغ بشكل مؤثر فهمنا المعاصر للإسلام، بوصفه تقليداً مُخترَعاً. ففي دمشق، مثلاً، كانت أعمال ابن تيمية هامشية الأثر ولا تتجاوز حدود المذهب الحنبلي حتى نهاية القرن التاسع عشر، عندما تم إحياؤه على يد مجموعة من المصلحين الملتفين حول جمال الدين القاسمي وعبد الرزاق البيطار في سياق الإصلاح والتفاعل مع الحداثة الغربية في مواجهة مزدوجة مع الفكر التقليدي الإسلامي والتحدي الحداثي-الغربي. وقد أدى استدعاء ابن تيمية والدعوة إلى التحرر من التقليد إلى محنة أصابت المجموعة وعُرفت بحادثة المُجدِّدين 1896. محورية التراث كما نعايشها اليوم، والمحورية الراهنة لأئمة الفكر السلفي التراثيين مثل ابن تيمية، تفترض سلفاً معرفة جيدة بهذه الأعمال، وهي معرفة كانت ممتنعة خارج الدوائر العلمية لأسباب بسيطة تتمثل في غلبة الأمية وغياب الطباعة، ما جعل من الكتب سلعة نادرة. فكان التراث وقتها محدوداً بالكم الذي يؤمنه نسخ الكتب، وبالأسماء التي اجتمع العلماء التقليديون على تبنيها وتَدارُسها، العلماء الذين تولوا القيام بأمر الشريعة وتفسيرها لمجتمعاتهم المحلية.
ظهر الإصلاح الإسلامي في مواجهة أسئلة جديدة فرضتها الحداثة ولم يَعتدها هؤلاء العلماء، ومع انتشار الطباعة والتعليم وتَضاؤل الأمية بشكل كبير، خرج التراث من إطار العلماء التقليديين ومؤسساتهم إلى عالم الطبقة الوسطى الحديثة التي نشأت بفضل سياسات الدولة الحديثة. فصار التراث -الذي اتسع بدوره بشكل كبير مع القدرة المتزايدة على تحقيق الكتب والوصول إلى أسماء كانت مهمشة من قبل العلماء التقليديين- مفتوحاً لطبقة وسطى حديثة، من خارج حلقة المؤهلين والعلماء، تتناوله وتستعين به في تأسيس تصوراتها عمّا هو حقٌ وباطل وشرعيٌ وظالم في مواجهة تصورات أخرى، أي أنها عملية فهم للتراث في إطار نزاعات العالم الحديث الذي كان السبب في نشأة هذه الطبقة نفسها. وهكذا صار من غير الممكن فهم الإسلام دون الوقوف عند ابن تيمية المُعاد اكتشافه حديثاً في دمشق، لكنه ابن تيمية مقروءاً بأسئلة ومخيلة معاصرة. ابن تيمية والإحياء الإسلامي ليسوا أشياء قديمة وتقاليد ضاربةً في الماضي ومردودةً إلى لحظة سابقة ومرفوعة عن التاريخ، بل هم موجودون في صلب العالم الحديث ونزاعاته، هم «تَخيُّلٌ» حديثٌ للماضي في مواجهة الحداثة، ولكنهم بدورهم أشياء حديثة لا يمكن تخيلها إلا من داخل شرط العالم الحديث نفسه، عالم الكتاب المطبوع والطبقة الوسطى المتعلمة.
ضد التنوير
بالعودة إلى الملاحظة الأولى الخاصة بدور التقاليد الرومانسية في تشكيل العالم الحديث، يقدم زئيف شتيرنهل في عمله تقليد ضد-التنوير، تاريخاً ثقافياً لهذا التقليد الفكري تحت مسمى ضد-التنوير، وذلك على مدى يقارب القرنين من الزمن. يقوم الفكر السياسي الحديث على تقليدين فكريين مركزيين هما «التنوير» و«ضد-التنوير». وهذه القسمة لا تتعلق بالمنهج أو بتفصيل ما، إنما هي قسمة بين تصورين كُلّيين للعالم، تَصورَين مختلفَين بشكل جذري حول الفرضيات الأساسية والأفكار الكبرى حول الإنسان والعقل والعالم، وما يرافقها ويترتب عليها من مفاهيم وقيم تتعلق بها وتنبثق عنها.
كل تصورٍ منهما بشكل تقليداً بالمعنى الواسع للكلمة، من حيث الاشتراك في المرجعيات والأعمال التأسيسية والإحالة إليها، والأسئلة وخطوط النقد التي تشكل حدوداً للتفكير لدى منتسبي كل تقليد. هذه هي الخطوط العامة للصورة العامة التي تجمع منتسبي أي تقليد، رغم التباين الفكري الكبير الذي قد يفرق أعضاء التقليد.
انطلاقاً من مركزية هذه القسمة، فإن كل تقليد يمكن تعريفه بوصفه نفياً للآخر، وإن كانت الأسبقية تاريخياً للتنوير من حيث التبلور في إطار تقليد فكري متّسق مع عصر التنوير ولاحقاً مع الثورة الفرنسية. فضد-التنوير تأسّسَ لاحقاً كردّ فعل مضاد للتنوير والثورة الفرنسية، وإن أحالَ بطريقة أو بأخرى إلى خبرات مفرطة في القِدَم. فإذا كان التنوير يعني العقلانية والفردانية والديمقراطية وكونية حقوق الإنسان، فإن ضد-التنوير يعني ضد-العقلانية وضد الفردانية وضد كونية قيم حقوق الإنسان، هو النزعة الرومانسية والتاريخانية (في تجليها الرومانسي تحديداً)، حيث الجماعة العضوية السابقة على الفرد والعاطفة الجياشة والإرادة الفاعلة بما يتجاوز صرامة العقل وقواعده الحوسبية الجامدة والمقيدة، هو الخصوصية الحضارية والتقاليد المستعصية ضد عمومية كونية وقوانينها الشكلية الجافة والخالية من الروح.
يقف تاريخ شتيرنهل لهذا التقليد، الذي يبدأ مع فيكو وهردر وبيرك ويمتد ليضم كارليل وشبنجلر ونيتشه وغيرهم، بمثابة تاريخ مضاد لتاريخ أشعيا برلين للنزعة الرومانسية، وهو ما يظهر في السجال المطوَّل الذي خاضه شتيرنهل مع برلين في كتابه. الكتابان، وإن اشتركا في موضوع واحد يتمثل بالتأريخ للتقليد الفكري ذاته، إلا أنهما متباينان تماماً في النظرة إلى هذا التقليد وتقييمه ومكانته.
تناول برلين النزعة الرومانسية بشكل إيجابي إلى حد كبير، من حيث تأكيدها على الحرية والعاطفة والتنوع، وذلك في مواجهة العقلانية والحتمية والقانون ونزعة تَمثُّل العلم التي امتدت إلى الفلسفة والعلوم الإنسانية. كانت النزعة الرومانسية لدى برلين بمثابة قوة مقاومة في مواجهة تطرف التنوير كما تمثَّلَ في الشيوعية، حيث تحول التاريخ إلى مجموعة قوانين يخضع الناس لها. شتيرنهل يقلب المسألة تماماً، فشتيرنهل المنحاز بالكلية إلى التنوير، يرى أن ضد-التنوير هو التقليد الذي انبثقت عنه النازية والفاشية والتيارات القومية وما نتج عنها من كوارث. إنهما تاريخان متضادان، حيث يكمن وراء تاريخ شتيرنهل رهانٌ سياسي مضاد ومغاير تماماً عن ذاك الرهان الكامن وراء تاريخ برلين.
إن رفض العقل وحقوق الإنسان باسم الإرادة والجماعة وتقاليدها التي تشكل عقلها أو روحها الخاصة التي تدرك من خلالها العالم، وأولوية الجماعة على الفرد الذي لا يكون إنسان حقاً إلا بفضل عضويته فيها، هي الجذور الفكرية للدعاوى القومية والخصوصيات الثقافية التي أنتجت في القرن العشرين النازية والفاشية، والعديد من الحروب والنزعات القومية، وهي التي تكمن اليوم خلف سياسات الهوية والخصوصيات الحضارية والنزعات القومية والإثنية والدينية، وهو ما يتتبّعهُ شتيرنهل. فالمسؤولية السياسية للمثقف من هذا التقليد، وأثره السياسي، ليس سؤالاً يخص الماضي فحسب، بل هو مهمة معاصرة ومستقبلية.
تتمثل المهمة المركزية لتاريخ شتيرنهل في الكشف عن البنية القارّة أو الخيارات الاستراتيجية التي تمثل جوهر هذا التقليد، واستمراريتها لدى ممثليه، وما يترتب عليها سياسياً لجهة مسؤولية هذا التقليد عن النازية والفاشية في القرن العشرين. هذا بدوره جعل من الصورة التي يقدمها شتيرنهل لهذا التقليد صورة صلدة، فرغم عودة شتيرنهل إلى الأعمال الأمهات لبيرك وهردر مثلاً لتدعيم الصورة التي يقدمها لهم، تخفّ تماماً أصداء قراءات أخرى لأعمالهم تُظهِر بيرك الليبرالي وهردر المتنوع والمتسامح بنزعة إنسية. بالطبع، يمكن تَفهُّمُ الصورة الصلدة، وحتى المبتسرة التي يقدمها شتيرنهل لهؤلاء، من باب تجذير الأطروحة وما يفرضه هذا من صرامة لجعل التفكير أكثر وضوحاً، الأمر الذي يفرض إزاحة التباينات الداخلية إلى الهامش من أجل تقديم الافتراق بين التقليدين بشكل راديكالي. وبالتالي فإن وجود بعد ليبرالي لدى بيرك أو نزعة إنسية متسامحة لدى هيردر لا يلغي الأطروحة نفسها، ولكنه يعكس تعقيد الواقع، تماماً مثل علاقة النظرية بالواقع. لكن إن غضضنا النظر، ولو قليلاً، عن هذه الصورة الصلدة التي يقدمها شتيرنهل وتحديداً للمفكرين الأفراد، باعتبارها أكثر تعلقاً بشواغل التأريخ وخاصة تأريخ الأفكار، عندها يمكن لنا الاهتمام تماماً بالمسألة المركزية التي تشغل شتيرنهل لجهة الكشف عن البنية القارّة للتقليد وأثره السياسي.
يمكن فهم جزء من التباين بين تقييمَيّ شتيرنهل وبرلين اعتماداً على التباين بين السياقين التاريخيين لكل منهما. ففي حين يفكر برلين وهو ينظر إلى الشمولية (خاصة في شكلها الشيوعي) بوصفها التهديد الأكبر، ينظر شتيرنهل إلى القوميات (وتحديداً في أشكالها الأكثر تطرفاً، النازية والفاشية) بوصفها التهديد المباشر والحيّ. وهكذا تصبح الرومانسية عند برلين هي الحرية المرتبطة بالتنوع في مواجهة ادعاءات الحقيقة الكلّية للتنوير، فيما تصبح هي الخصوصية واللاعقلانية في مواجهة كونية الإنسان والديمقراطية لدى شتيرنهل.
لكن المسألة الملحّة أكثر عند المقارنة بين برلين وشتيرنهل، بما يتجاوز اختلاف السياق التاريخي والاجتماعي بينهما، هو ما يترتب من نتائج سياسية على المقدمات الفلسفية للرومانسية عند كليهما. فالاثنان لا يبدو أنهما يختلفان كثيراً في تصورهما العام للتقليد الرومانسي (ضد-التنوير)، لكنهما يتباينان كثيراً فيما يترتب على هذا التقليد سياسياً. هل الفاشية والنازية هي نتائج ضرورية لهذا التقليد المناهض للتنوير، المناهض للحقيقة والعقلانية وحتمية القوانين؟السؤال يمكن قلبه تماماً مع برلين، هل الغولاغ هو نتيجة حتمية للحداثة، التقدم والنزعة العلمية الحتمية في التعاطي مع التاريخ والمجتمع؟ نعم، إنه بدوره إمكانية. هنا ربما يمكن استدعاء الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو بوصفه تعبيراً عن خيار مضاد لما يقدمه تاريخ شتيرنهل. ففاتيمو، السائر على خطى نيتشه وهايدغر، يرفض الادعاءات الكونية للحقيقة والعقلانية، طارحاً تصوراً تأويلياً عدمياً عوضاً عنها، يؤكد على نسبية تصورات الحقيقة وانغراسها في سياقات الخاصة، فلكلٍّ حقيقته، أو تأويله للحقيقة. يشارك فاتيمو التقليد الرومانسي (ضد-التنوير) في مركزية التاريخ والسياق في تحديد المعنى والحقيقة، ورفضه لادعاءات متعالية وشكلية وكونية عنهما مثَّلَت لبّ تصور التنوير. وانطلاقاً من هذه العدمية التأويلية، يدافع فاتيمو سياسياً عن ليبرالية وشيوعية، فإذا كانت كل ادعاءاتنا حول الحقيقة ليست سوى تأويل، عندها لا يمكن لأحد أن يفرض على الآخرين ما لا يريدونه باسم مبدأ أعلى، سواء أكان هذا المبدأ هو الحقيقة أو الهوية (الجماعة). فاتيمو يظهر إمكانية لتأسيس ليبرالية جذرية انطلاقاً من موقف عدمي فلسفياً، وهو ما يتفق كثيراً مع الإمكانية التي نظر إليها برلين لدى تأريخه للتيار الرومانسي.
إن المسألة هنا أن افتراض لزوم موقف سياسي عن موقف فلسفي، وهو ما يقوم به شتيرنهل هنا، لا يبدو أنه افتراضٌ صحيحٌ يمكن إثباته. الانتقال من الموقف الفلسفي إلى السياسي لا يتم بشكل مباشر وملزم كلزوم القضايا المنطقية عن بعضها بعضاً، بل تتداخل عوامل مختلفة لإنجاز هذه النقلة، وهذا يعني أن ما يترتب على تقليد فلسفي ما قد يتباين إلى حد كبير على المستوى السياسي، فمناهضة التنوير قد تفتح الباب أمام النازية، لكن أيضاً أمام ليبرالية جذرية.
غير أن هذا الاعتراض النظري -المستند بدوره إلى لحظات فلسفية فريدة- على تأريخ شتيرنهل لا يلغي واقع التجربة التاريخية العامة، التي تدعم الخط العام لمحاججة شتيرنهل، والمتمثل بأن الفاشية والنازية جاءتا من قلب تقليد ضد-التنوير، ومن ناحية أخرى أن هذا التقليد نفسه يشكل المتن الذي تستند إليه التيارات المحافظة الجديدة وخطابات الهوية والخصوصية وسياساتها الرجعية والمعادية للحريات والديمقراطية. وفي سياقنا العربي، يظهر الإسلام السياسي، بالمعنى الواسع، بوصفه النظير المحلي للفاشية والتيار المحافظ الجديد، وتأكيده على الهوية والخصوصية والأمّة في مواجهة الفردانية والديمقراطية والعقلانية.
يمكن هنا أيضاً تقديم ملاحظة شبيهة بتلك الخاصة بفاتيمو عن الانتقال من المستوى المجرد للنظر إلى التمثّل السياسي للفكر النظري، فالإسلام الذي يتم تمثيله سياسياً في إطار هوياتي وأخلاقي وجماعاتي يمكن -أقلّه من الناحية النظرية- أن يتم تمثّله سياسياً في سياسة ديمقراطية وعقلانية وكونية -تقليد التنوير-، من ناحية كونه خطاب الله إلى الناس كافة بما يلزم أن الله -خالق العالم والناس جميعاً، بما يعني خالق القوانين والعقل/العقول- يضمن التوافق بين عقولنا والعالم من ناحية، ووحدانية القيم الانسانية وإمكانية إدراكها من قبل الجميع من ناحية ثانية. وهي قراءةٌ يمكن أيضاً التدليل عليها كإمكانية من داخل السياق الإسلامي تاريخياً، كما في رواية ابن يقظان التي عاد إليها الفلاسفة المسلمون مرات ومرات.
تأريخ شتيرنهل يفيدنا في استكشاف إمكانية تاريخية راجحة في التقليد الرومانسي (وإن افترضها شتيرنهل بوصفها إلزاماً تاريخياً لهذا التقليد، وليست الإمكانية الأكثر ترجيحاً وبالتالي تحققاً في الواقع)، وبالتالي الحاجة إلى إدراك أكبر للرهانات التي ينطوي عليها هذا التقليد فكرياً، وهي مسؤولية سياسية للمثقف (ومرة أخرى بالإحالة إلى فاتيمو، يمكن القول إن فرقاً مركزياً بينه وبين رومانسيين كثر هو فردانيته، أو لاجماعيته).
المسألة الأخرى التي لا تقلّ أهمية في تأريخ شتيرنهل، هي إظهار أنَّ الكوارث السياسية الكبرى التي عرفناها في القرن العشرين، النازية والفاشية والحروب القومية وما رافقها من إبادات وتطهير عرقي، نتاجٌ لتقليد فكري مضاد للتنوير، فالعالم الحديث ليس نتاجاً حصرياً للتنوير، إنما كانت تلك الكوارث نتاجاً لتقليد مضاد، تقليد ناهضَ العقلانية والكونية باسم الخصوصية والجماعة وما يرافقها من ادعاءات أخلاقية وغيرها. واليوم، نشهد ردة كبيرة في هذا الاتجاه مرة أخرى، فنقدُ الحداثة والعالم الحديث يقوم على الخلط بينهما من ناحية، ورفع شعارات الرومانسية نفسها، وتحديداً في شكلها الجماعاتي كما في حالة النقد الإسلامي للحداثة. إنها الخمرة القديمة في جرارها القديمة مرة أخرى.