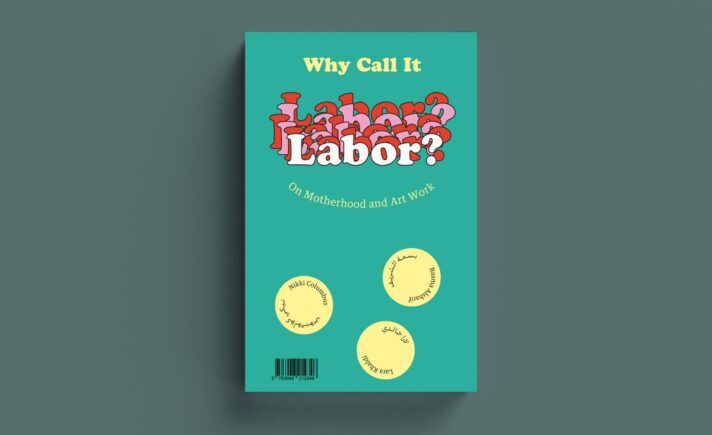عن دار موزاييك للطباعة والنشر في إسطنبول، صدرت رواية الوَشْم للكاتبة السورية منهل السَّراج في مطلع عام 2022. تشكّل الرواية في هيكليتها، وعبر 246 صفحة، زوبعات بحرية متلاحقة ومضنية، إذ لا تقلُّ المشقات التي تعاني منها بطلة الرواية والتي تنغمس فيها الواحدة تلو الأخرى عن المشقَّات التي نكابدها نحن القرَّاء، وإن كانت التجربة الحيَّة تحمل لذعة مرارتها الخاصة. تنقلنا الرواية إلى عوالم سوريا السفلية، عوالم الاستبداد والظلم والقهر داخل السجون، عوالم الجوع والتشرد والضياع في مجتمع تحوَّل فيه الإنسان نتيجة قسوة الحرب إلى لا – إنسانيته، مجتمع منقسم الطبقات، فاقد الهوية والانتماء، سقطت فيه المبادئ جميعها ولم تتبلور بعدئذٍ أي قيم جديدة محلَّها، فغدا قانون الغاب هو القانون المشرْعَن.
نبدأ أولاً من عتبة العنوان الوشم، كعتبة نصية تشكِّل مفتاحاً مهمَّاً يساعد في تأويل السرد ويساهم في حلِّ تشابكاته، فالرواية تستمد أحداثها من السيرة الذاتية للمعتقلة السابقة في سجون سورية لولا الآغا، والوشم هو رسم للحروف الأولى من أسماء أبنائها الأربعة (N H و M S)، حفرتها لولا على ظاهر كفِّها وهي تقبع في السجن ظلماً وبهتاناً بعد وشاية شقيق زوجها بها، لئلا تَنْسى أو تُنْسى. على الرغم من أنَّ الكاتبة لم تأتِ على ذِكْر الوشم إلا مرة واحدة في الرواية، باستثناء العنوان طبعاً، إلا أنَّه سيكون المحور الدلالي الذي تدور حوله معظم أحداث الرواية، إذ يحيل الوشم على العلاقة المتجذِّرة بين الأم وأبنائها، وإلى الفاعلية الكبرى التي ستظهرها البطلة الأم لحمايتهم؛ بدءاً من رفضها لطلب شقيق زوجها بتبني طفلتها الصغيرة «أولادي ليسوا للتبنِّي» وتبليغه عنها انتقاماً منها لفرع المخابرات الجويَّة بحجة مشاركتها بالمظاهرات المطالبة بالحرية، ومروراً بما عانته في السجن من لوعة الأم الثكلى التي حرمت من أبنائها، ووصولاً إلى هربها بهم من حكم الإعدام ثمَّ إلى خارج سورية لينعموا بطفولة حرموا منها وهم في بلادهم وبين ذويهم.
تعالج الرواية والتي تبدأ من نوستالجيا الطفولة والصبا جزءاً من المنظومة الاجتماعية السائدة في سورية، وتعرض لجملة من الاستبدادات المتلاحقة التي كانت تُمارس باسم العادات والتقاليد تارةً، وباسم الدين تارةً، وتحت مظلة القانون تارةً أخرى، أولها استبداد المعلمات في المدارس وسطوة أبنائهم المدللين، مشيرة إلى تدني أداء المنظومة التربوية وعدم تمكنها من ضبط سلوكيات المعلمين في تعاملهم مع الطلاب، ولاسيما الأطفال منهم، ثانيهما استبداد الأبوين في المنزل من خلال تكريس الأحكام المسبقة على حياة الفتيات خاصة، وتحطيم أحلامهن بمقولات ترسم لهن مستقبلهن من دون إرادة منهن، كقول الأم «البنت للزواج» وقول الجدة «الله يبعت نصيبك» ولولا لا تزال ابنة أربعة عشر ربيعاً، ومن ثم استبداد الزوج بزوجته التي لم تبلغ سن الرشد بعد، وفرضه قوانين والدته بدون تفكير أو مناقشة، مما تسبب في زعزعة زواجهما، وهو لا يزال في سنته الأولى.
بناءً على ذلك، تحكي الكاتبة قصة الخوف الذي تجذَّر في نفوس السوريين، الخوف الذي تمَّت رعايته في نفوس الأجيال المتلاحقة في سورية حتَّى «كبرنا وتعلمنا أن نسكت»، وكأنَّ القاعدة الثابتة هي أن يقبل الإنسان بالظلم ويرضى به، وما عدا ذلك استثناء وخروج عن المألوف، كما تسلِّط الرواية الضوء على رحلة المتاهات التي عاشها السوريون رجالاً ونساء، أطفالاً وشيوخاً، نزحوا من بيوتهم إلى غرف لا تقيهم ذلَّ السؤال، ولا تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية، الرعب يلاحقهم أنَّى ذهبوا، والموت يمطرهم قنابل وقذائف لا تتوقف، أمَّا الجوع الكافر فلا يرحم.
تملأ الكاتبة بياض النص بالكثير من قصص المسجونات فيخيِّم سوادها على كل بياض، قصص التعذيب في السجون التي تسردها الكاتبة على لسان بطلتها تبدأ ولا تنتهي، إذ تبقى المخيلة مشحونة بالتفكير ببشاعتها، سبَاب وشتائم، جَلْد وشَبْح، تعرية واغتصاب، والكثير ممَّا تغص به الرواية، لتلامس تابوهات ما كان السرد ليقاربها بمثل هذه الجرأة، ذلك لأنَّ «كلَّ المرأة إثمٌ، جسداً وروحاً، وكلَّها موضوع مناسب لممارسة السادية والانتهاك» داخل جدران السجن وخارجه. ولا تنسى الكاتبة في إطار الحديث عن السجون أن تتطرَّق إلى الكلام على الفساد والمحسوبيات والرشاوي المتفشية داخل مجتمع السجن، حيث ينقسم السجن إلى طبقتين، فيه الأغنياء والفقراء، فيه المتحكِّم والمتحكَّم به، فيه القاهر والمقهور، ممَّا يدلل على شيء واحد وهو غياب العدالة في حيِّز تنفيذ العدالة.
بخلاف معظم الروايات التي كُتبت عن أدب السجون تسلِّط الكاتبة الضوء على السجينة الأم من جهة، والمرأة الأم من جهة أخرى، تصوِّر استماتة لولا لتحمي أولادها من شرور المجتمع وفساده، رافضة السقوط والاستسلام، وربَّما كان النكران الذي سيرافقها في ذروة عذاباتها أحد أمضى أسلحتها لاستيعاب الواقع؛ نكران اعتقالها وتعذيبها، نكران الاعتداء عليها وموت زوجها أمام عينيها، نكران مرضها داخل السجن، نكران حكمها بالإعدام، ولأنَّها لم تعد تفكِّر سوى بكيفية خروجها من السجن لتعمل وتطعم أطفالها بعد أن تجمعهم حولها نسيت القضية والثورة، فالمعتقلون «لا يتمنَّون شيئاً إلَّا أن ينتهي تعذيبهم»، إذ لا يوجد وقت لرفاهية الانهيار، فهناك حقيقة غريزية واحدة فحسب، هي المحافظة على البقاء من أجل أولادها.
تتعرَّض لولا التي تطالعنا في أوَّل الرواية بوصفها فتاة صغيرة غير ناضجة اجتماعياً وفكرياً لسلسلة من التحولات التي تصقل شخصيتها وتجربتها، لتكون تجربة السجن التي قاربت فيها انكسارها الأكبر حين تمَّ الاعتداء عليها أمام زوجها الذي لفظ أنفاسه من هول الموقف المستفِزِّ، هي المحرِّك والدافع فتنطلق بعد هروبها من سوريا النظام لتدافع عن المظلومين وتقف في وجه الظالم، فعملت في المكتب الإعلامي في كفر نبل، ووثقت أسماء المعتقلات، ساهمت في توزيع الإعانات، وشاركت باحتجاجات سلمية تطالب بحرية المعتقلات، حضرت دورات تدريبية وتثقيفية، وروت ما حدث معها في مؤتمر دولي في تركيا، وعبر برنامج تلفزيوني تحدثت عن كلِّ شيء «آمنت أنَّني بهذه المواجهة مع المجتمع والعادات والأعراف أرفع رأسي وأحرِّر عنقي من مشنقة العيب»، وضمن سلسلة من اللاءات التي ستشكِّل كلُّ واحدة منها جسراً لتعبر من خلاله لولا إلى الضفة الأخرى نشهد تحولات البطلة التي استذأبت لتكون أمَّاً مثالية على الرغم من خسارتها لصغيرتها هاجر التي بقيت في بيت عمِّها.
نحن إذاً أمام رواية تعالج قضايا جندرية، من منظور الكاتبة/ الساردة/ الحدث/ الشخصيات، وعلى الرغم من الغصة التي تصاحبنا طيلة الرواية إلا أنَّها تفتح نافذة واسعة للتأملات، إذ تدفعنا للتفكير بالتحولات التي فرضتها الحرب على المرأة حين وضعتها ضمن تجربة غير طبيعية في ظروف شديدة القسوة، فربَّما تكون هذه الرواية دعوة للتفكير في ضرورة العمل على صياغة منظومة اجتماعية جديدة تنال فيها المرأة حقوقها بعد أن تبيَّن لها ضعف جميع المقولات الاجتماعية وسقوطها أمام أوَّل عاصفة استطاعت أن تقتلعها من جذورها وتترك وراءها قحطاً وبوراً.