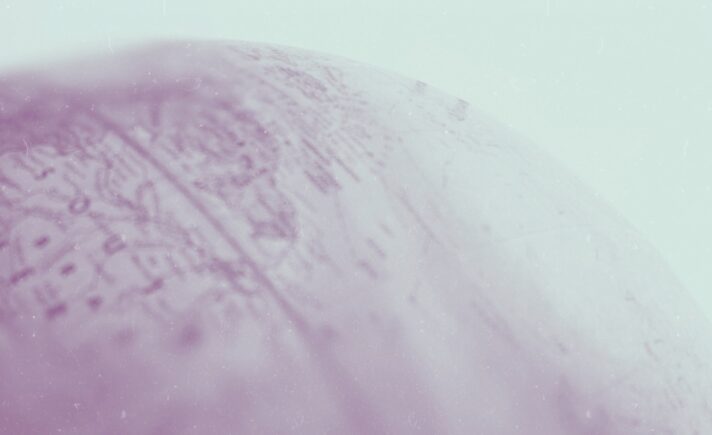من المعروف أن الفيلسوف «العَلَم» الأساسي الذي ارتكز عليه اليسارُ طيلة القرن العشرين وصولاً إلى يومنا هذا هو كارل ماركس، فماركس هو المُنظِّر الأهم والأشهر في التاريخ الحديث لكل فكر يساري في العالم. ومن المعروف أيضاً أن أفكار ماركس الفلسفية والسياسية تشظّت كثيراً في الماركسيات التي جاءت بعده وأخذت عنه خلال قرن ونصف منذ وفاته، إلا أن منهج ماركس الفلسفي في قراءة التاريخ، ومنهجه الاقتصادي في فهم وتحليل ميكانيزمات النظام الرأسمالي، والسياسي في مسألة الصراع الطبقي والدولة، ما زال يشكل الباراديغم المسيطر يسارياً، يتم التعديل عليه والبناء فوقه ومساجلته أحياناً مع كل نسخة ماركسية جديدة، لكن لا يتم تقويضه ولا تظهر قدرة على تجاوزه بالكامل.
وإن كانت التجارب اليسارية الكبرى التي نقلت النظرية الماركسية إلى التطبيق السياسي (من لينين إلى ماو إلى كاسترو، وخلفائهم) لم تُنتِج أينما حلّت سوى الدول المركزية والديكتاتوريات الشمولية، فإن الأحزاب اليسارية في الغرب والشرق ما زالت تنهل من مَعين الأيديولوجية الماركسية بالمعنيين الفلسفي والسياسي، ومازالت تسبح في المياه الآنتي- رأسمالية ذاتها التي أسّسها ماركس، وما زالت مشكلة اليسار تدور حول السوق الحرّة بينما ترى الحل في الدولة،حتى لو كانت الدولة معبراً إلى اللا دولة «الشيوعية» إلا أننا لا نحتاج هنا إلى نقاش تلك الخرافة الأشبه بالجنّة عند المؤمنين. خلاف اليسار مع غيره اليوم يقوم على شكل الدولة. عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فإن اليسار بالعموم يمجّد سيطرة الدولة ويشيطن السوق الحرة. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة فإن اليسار عموماً يمجّد السيادة الوطنية ويشيطن التدخل الخارجي، وعندما يتعلق الأمر بالاجتماع سترى اليسار يمجّد المساواة ليشيطن التفاوت والاختلاف الاجتماعي. المشكلة في التفاوت الطبقي والحل بإزالته، المشكلة في نمط الإنتاج الرأسمالي والحل يكون إما بالانتقال إلى نمط إنتاج اشتراكي أو بانتظار لانهائي لانهيار الرأسمالية من الداخل من خلال التناقض الذي تحمله في طيّاتها.
سيقوم النقاش في هذه الورقة على فكرة مركزية هي أنه لا يمكن خلق يسار جديد دون خلق فلسفة جديدة لليسار، فلسفة، هي بمعنى ما، آنتي ماركسية. فلسفة تُقوّضُ الفهم الماركسي للاقتصاد السياسي للرأسمالية، للتاريخ والمجتمع، وتنبني نقدياً على مفكرين ساجلوا ماركس من موقع ماركسي أو مفكرين يساريين من خارج الماركسية كما سنبرز لاحقاً. أي أنه لا بدّ من الخروج من عباءة ماركس بشكل نهائي. ولا يمكن الخروج من عباءة ماركس دون تفنيد الأسس النظرية والفلسفية التي أقام عليها فهمه للاقتصاد السياسي للرأسمالية. ولكن بالقياس إلى وساعة النظرية الماركسية وكثرة تفاصيلها، وبالنظر إلى أن الإحاطة بجميع الثغرات التي تركها ماركس تحتاج إلى مجلّد وليس ورقة بحث، سنقوم هنا بالتركيز فقط على نقطتين محوريتين قادتا تحليل ماركس الفلسفي للاقتصاد الرأسمالي، ثم نحاول تبيان مدى تأثير ذلك على الفكر السياسي لليسار.
النقطة الأولى هي نظرية قيمة العمل (Labor theory of value)، وهي النظرية التي أقامها ماركس على أفكار آدم سميث وبنى عليها فهمه للعمل المأجور وفائض القيمة بوصفهما محرك ووقود النظام الرأسمالي. وتكمن أهمية هذه النظرية في أنها شكّلت العمود الفقري الذي أقام عليه ماركس ما سيدعوه لاحقاً «القانون» الأساسي للرأسمالية، القانون الذي سيقودها إلى نهايتها الحتمية.
والنقطة الثانية هي فكرة الاغتراب (Alienation)، وهي الفكرة التي أخذها ماركس عن هيغل ورفع عنها قشرتها المثالية كما قال، ثم استبدل اغتراب الروح عن العالم عند هيغل باغتراب العمال عن ناتج عملهم في النظام الرأسمالي. وتأتي أهمية هذه النقطة أيضاً من أنها ستقود تحليله السياسي فيما يتعلق بثورة البروليتاريا والتحول نحو نمط إنتاج اشتراكي.
نظرية قيمة العمل
كما قلنا أعلاه، أخذ ماركس أفكاره الأولية في الموضوع عن الاقتصادي الإنكليزي آدم سميث، لكن أفكار سميث لم تكن تشكّل نظرية بل مجرد فرضيات أولية، ولم تتحول تلك الأفكار إلى نظرية متكاملة إلا على يدي ماركس. وهذه النظرية تقوم على أن «العمل هو الماهية الخالقة للقيمة»،كارل ماركس: رأس المال (نقد الاقتصاد السياسي)، المجلّد الأول، ترجمة، الدكتور فهد كم نقش، طباعة دار التقدم، موسكو 1985، ص61. والعمل هو «ضرورة طبيعية أبدية، فبدونه يستحيل التفاعل بين البشر والطبيعة، أي تستحيل الحياة البشرية ذاتها»،ذاته، ص65. كما أن «العمل هو المقياس النهائي والواقعي الذي نستطيع بواسطته تقدير قيم كافة البضائع ومقارنتها ببعضها في جميع الأزمان».ذاته، ص72. لكن قيمة العمل التي يتحدث عنها ماركس لا ينتجها إلا العمّال وحدهم، ولا شيء آخر سوى العمال، فمن دون العمال لن يكون هناك عمل منتج ولا قيمة؛ ولا فائض قيمة بكل تأكيد، فالعمال هم من ينتجون القيمة عبر عملهم ذاته. وبالتالي فإن ما يُحدِّدُ سعرَ مُنتَج معيّن، أو قيمة شيء ما، هو أساساً حجم العمل الموضوع فيه، والذي يقوم به العمال. وهذا العمل هو بالضبط ما يستخرجه ويستغله الرأسمالي ويبني ثروته على أساسه ضمن النظام الرأسمالي «فالإنتاج الرأسمالي إذن، لا ينمي التكنيك وتركيب عملية الإنتاج الاجتماعية إلا عن طريق أنه يقوض في الوقت ذاته المصدرين الإثنين لأية ثروة: الأرض والعامل».رأس المال، ص 728. لكن الأرض هي مكون ثابت وجامد ولا تخلق قيمة إلا من خلال العمل الذي يقوم به العامل، فكما قلنا سابقاً: العمّال وحدهم ينتجون القيمة.
بالنسبة لماركس الماكينات لا تنتج قيمة، والعلم القائم خلف صناعة الماكينات لا ينتج قيمة (الثيرموديناميك القائم خلف صناعة المحرك البخاري الذي كان في زمن ماركس على سبيل المثال)، الهندسة والتصميم والتخطيط التي تقف خلف اختراع هذا الشيء أو ذاك لا تنتج قيمة فعلية للشيء، فقط العمّال ينتجون القيمة. يقول ماركس بوضوح في هذا الشأن: «الماكينات، شأنها شأن أي قسم آخر مكون للرأسمال الثابت، لا تخلق أية قيمة».رأس المال، ص 557. وإذا كان كلام ماركس صحيحاً فمعناه أن كل قرش تربحه الشركات المنتجة يعود إلى العمّال، لأنهم وحدهم من ينتج القيمة. وبالتالي فإن كل فائض القيمة مُستخرَج من العمال؛ المستغَلّين بغض النظر عن أجورهم أو مهما كانت أجورهم. وفائض القيمة الذي يُنتِجه العمال يذهب بالكامل للرأسمالي ليشكّل ثروته وأرباحه ويراكم رأس المال.
وبالنسبة لماركس فإن العمل المأجور هو المصدر الذي يُستخرَج منه فائض القيمة في النظام الرأسمالي، بالأحرى يمكن تلخيص تعريف ماركس للنظام الرأسمالي بأنه «نمط إنتاج يقوم على استخراج فائض القيمة من العمل المأجور». وبالتالي فإن العمل المأجور هو مصدر الاستغلال المتأصّل في ذلك النظام، حيث إنه «في الصناعة الكبيرة فقط إنما يتعلم الإنسان إرغام ناتج عمله الماضي، الذي أصبح متجسّماً، على العمل مجاناً وعلى نطاق واسع كقوى الطبيعة».رأس المال، ص558. واستخراج القيمة عبر العمل المأجور في النظام الرأسمالي يوازي تماماً ما كانه الاسترقاق والعبودية في النظامين الإقطاعي والعبودي، حيث شكّلت أعمال العبيد والرق والفلاحين مصادر استخراج القيمة، تلك القيمة التي كان يتم استخراجها عبر العمل المجاني الإجباري للعبيد أو العمل بالسخرة مقابل الحماية للفلاحين. وبالنسبة لماركس فإن العمل المأجور يقوم على استغلال متأصّل وجوهري ولا خلاص منه، بمعنى أنه لا يوجد ما يُدعى أجراً عادلاً على الإطلاق في النظام الرأسمالي. فمهما كان أجر العامل، فهو لن يساوي أبداً قيمة عمله ولن يعوضه إطلاقاً عمّا يساوي تلك القيمة. والعمل المأجور لا يشكّل مصدر فائض القيمة surplus-value التي تذهب بالكامل للرأسمالي فحسب، بل يراكم القيمة المضافة added-value، حيث يضيف العمّال في كل مرحلة من مراحل صناعة مُنتَج معين قيمة أكبر لهذا المُنتَج. هذا واضحٌ جداً اليوم في عصر الشركات متعددة الجنسية، حيث تعبر عملية الإنتاج أكثر من بلد وأكثر من موقع عمل (الكمبيوتر أو السيارات مثلاً)، ويضيف العمال قيمة جديدة على المنتج في كل مرحلة من مراحل صناعته.
يمكن وضع العواقب التي تنتج عن تلك الآلية في التفكير على الشكل التالي: على اعتبار الماكينات لا تنتج قيمة، والعلم الذي يقف خلف صناعتها لا ينتج قيمة، والعمّال وحدهم ينتجون القيمة، فهذا سيؤدي حتماً إلى ما يسميه ماركس «ميل معدل الربح إلى التهاوي أو السقوط». بكلام آخر، الاتجاه المتصاعد لمعدلات الربح نحو السقوط. وهذا الميل كان بمثابة قانون بالنسبة لماركس، «القانون الأساسي للرأسمالية». في الواقع، يعبّر هذا القانون عن التناقض الرئيس الذي يحكم الرأسمالية بوصفه ضرورة ديالكتيكية ستقودها إلى الانهيار حتمياً. وذلك التناقض ينتج عن ميل الشركات الرأسمالية إلى زيادة الاعتماد على الآلات وطرد المزيد من العمال، وبالتالي تهاوي معدل أرباحهم، لأن المبدأ يقوم أساساً، كما قلنا، على أن الآلات لا تنتج قيمة في ذاتها، بل العمال هم من يخلق القيمة، ومع زيادة المكننة وقلّة الاعتماد على العمّال، ستنخفض معدلات الربح وتنتهي بالسقوط الكامل، حيث إنه لن يكون هناك من يضيف قيمة ولا فائض قيمة. وبتلك المعاني ستحفر الرأسمالية قبرها بيدها وستنتهي حتماً بالاشتراكية. يقول ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي: «البرجوازية تنتج، قبل كل شيء، حفاري قبرها. فانهيارها وانتصار البروليتاريا، أمران حتميان».ماركس- انجلز: البيان الشيوعي، تقديم سلامة كيلة، دار روافد للنشر والتوزيع، طبعة الكترونية، عام 2014، ص38.
في الواقع، يُعَدّ المنطق الذي فكّر فيه ماركس صحيحاً تماماً بالمعنى القَبْلي أو المتعالي ولكن ليس بالمعنى البَعدي أو التجريبي، فبالمعنى المنطقي يقوم «البرجوازيون» دائماً باستبدال العمال بالآلات، أو هذا بالفعل ما يريدونه، حيث إن الآلات أسرع وأكثر تحمّلاً وأكثر دقّة من العمّال، كما أن العمال يُضرِبون، والآلات لا تقوم بإضرابات ولا تطالب بزيادة أجور، ولهذا فإن الميل «البرجوازي» لمكننة الإنتاج يعني أنهم سيمضون ببطء، ولكن حتماً، نحو استبدال البشر بالآلات. ولأن الماكينات لا تُنتِج قيمة على الإطلاق، بل فقط العمال من ينتج القيمة، فإن هذا معناه أن الأرباح ستبدأ بالانخفاض، وفي النهاية، الشركات الممكننة بالكامل لن تنتج أي مرابح إطلاقاً، وعند تلك اللحظة، كما يعتقد ماركس، فإن الرأسمالية ستدمر نفسها.
لقد أعمت سلطة ماركس وقوة أفكاره العديدَ من مؤرخي الاقتصاد الماركسيين المعاصرين عن رؤية تلك الفجوة الهائلة والخطأ الكبير في تحليله لنظرية قيمة العمل، فالآلات ليست مجرد شيء خامل وإنما هي مُنتِج حقيقي للقيمة (مثلاً الشركات الممكننة بالكامل في اليابان اليوم تنتج أرباحاً هائلة). العلم والمعرفة والأفكار و«الخيال» هي مُنتِجات للقيمة؛ الروّاد ومصممو البرامج والعباقرة من أمثال ستيف جوبز أو إيلون ماسك ينتجون رؤى ويخاطرون بكل ما لديهم لتحقيق تلك الرؤى، وهؤلاء لا ينتجون قيمة فحسب، بل أكثر أنواع القيمة ربحاً. وبكلام آخر، البنية الفوقية ليست مجرّد نتيجة أو انعكاس أو تمثيل للبنية التحتية، بل إنها تتفاعل مع البنية التحتية وتُعيد تشكليها وصناعتها، بل تخلقها أحياناً. والسياسة ليست مجرد صورة للاقتصاد، بل هي تخلق الاقتصاد أو تعيد خلقه، والتشابك ذاته يحصل فيما يخص تأثير الدين والعلم والفن والفلسفة. وبالتضاد مع كل ما تم ذكره، يصرّ ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي على أن «سلطة الدولة الحديثة ليست سوى هيئة تدير المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية بأسرها».ماركس/انجلز، البيان الشيوعي، ص22. ولكن لأن هذا المنطق الاقتصادي الاختزالي انتهى إلى كونه منطقاً قاصراً تماماً وغير دقيق واقعياً، وعلى اعتبار أن التجربة قد أوضحت أن القانون الأساسي للرأسمالية؛ الذي سيمضي بها ديالكتيكياً نحو نهايتها، هو قانون خاطئ كلياً، فقد تبيّن أن نظرية ماركس للعمل والقيمة هي نظرية خاطئة تكوينياً، ولا يمكن الارتكاز عليها وانتظار انهيار الرأسمالية لحلول الاشتراكية مكانها.
يمكننا القول بالتأكيد إن كارل ماركس هو أول من خطى خطوة عملاقة في فهم النظام الرأسمالي يسارياً ومادياً، ولكنه أول من أغلق السيستم على ذاته متحدثاً عمّا يعادل «نهاية التاريخ» الشيوعية. وذلك نتيجة وقوعه في منطق الجدل الهيغلي، أي ذلك التناقض السلبي الهيغلي الذي يقود التاريخ والقائم على السلب (النفي ثم نفي النفي). وسلطة ماركس أو قوة أفكاره كما قلنا أغلقت الباب على أي مجال لفهم الرأسمالية بطريقة مختلفة. لكن أيضاً في تاريخ الأفكار ليس مهماً إن كنت مخطئاً أو مصيباً، بل المهم هو مدى أصالتك، وماركس كان أصيلاً (ضمن حدود زمنه) بكل معنى الكلمة.
المسألة الهامة الثانية التي يجدر نقاشها في نظرية العمل والقيمة هي مسألة يمكن طرحها على الشكل التالي: إذا كان حجم العمل الموجود في مُنتَج معين هو ما يحدد قيمته الذاتية، أو القيمة الداخلية فيه، أو تلك القيمة التي سمّاها ماركس «المقياس النهائي والواقعي الذي نستطيع بواسطته تقدير قيم كافة البضائع ومقارنتها ببعضها في جميع الأزمان». فإن ما يحدد قيمته الخارجية أو الموضوعية هو السوق، أي العرض والطلب. لكن السوق لا يقوم على مُجرِّد العرض والطلب الصرف كما نظّر له آدم سميث ميكروياً ورفعه ماركس نظرياً إلى حدود ماكروية، بل يقوم على الاحتكارات الكبرى. وهذه مسألة في غاية الأهمية مازالت تنتج أكبر أنواع سوء الفهم للنظام الرأسمالي بشكل عام. حيث يعادي اليسار ما تمّ اعتباره مبدأً ليبرالياً، أي اقتصاد السوق الحرّة القائم على التنافس، أو ما تم التعبير عنه بالعبارة الفرنسية الشهيرة لفنسنت دي غورناي 1751 «دعه يعمل، دعه يمر». وكما قلنا أعلاه، فإن اقتصاد السوق لم يقم يوماً واحداً في التاريخ على العرض والطلب الصافي والتنافس الحر دون تدخّل أصحاب السلطة وأصحاب الاحتكارات الكبرى في مسألتي العرض والطلب. وهنا لا بدّ من الاستعانة بأهم مؤرخ اقتصادي في القرن العشرين، فيرنان بروديل، لكي نفهم هذا الأمر. حيث صاغ بروديل ما يسميه آنتي-ماركِت Anti-Market ليُخبرنا أن الرأسمالية كانت دائماً بالمعنى الموضوعي ضد السوق والتنافس الحر القائم على العرض والطلب، وهذا يعارض كل التاريخ اليساري، فمن ماركس إلى رونالد ريغان كانت كلمة رأسمالية تعني اقتصاد السوق دون أي تمييز،انظر الرابط ، وهو ورقة بحث مهمة للفيلسوف المكسيكي/الأميركي مانويل ديلاندا، منشورة تحت عنوان Markets and Antimarkets in the world economy . وديلاندا هو مهندس معماري ومبرمج وفيلسوف دولوزي معاصر له العديد من الكتب غير المترجمة، ويعد أهمها فيما يخص خلفية بحثنا A thousand years of nonlinear history أو ألف سنة من التاريخ غير الخطي. بل إن لينين مثلاً كان يعتقد بكل ثقة عمياء «إن الإنتاج التجاري الصغير هو الذي يولّد كل يوم وكل لحظة الرأسمالية والبرجوازية بصورة تلقائية {..} فالرأسمالية تظهر حيث يكون الاستغلال الصغير والتبادل التجاري الحر قائمين {بل..} إن الرأسمالية تبدأ في سوق القرية».فرنان بروديل، الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية (من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر)، الجزء الثالث، زمن العالم، ترجمة، مصطفى ماهر، المركز القومي للترجمة، 2013، ص 783.
ضداً على هذا التقليد الماركسي يقول بروديل: «لا بدّ من التمييز بين الرأسمالية بكافة أشكالها واقتصاد السوق، وهو تمييز أُصُِ عليه كل الإصرار، ويتخذ معناه الكامل على المستوى السياسي خاصة».بروديل، ذاته، ص780. ثم يضيف بروديل إن الاعتراف بأن «اقتصاد السوق شيء والرأسمالية شيء آخر يجنبنا موقف الاختيار بين (كل شيء أو لا شيء) الذي يضعنا فيه رجال السياسة الذين يصورون لنا الأمور وكأنما لم يكن هناك سبيل للحفاظ على اقتصاد السوق إلا بأن نطلق يد الاحتكارات على هواها. أو من جهة أخرى كأنما تخليصنا من الاحتكارات لا يتم إلا عن طريق التأميم الصارم». والنتيجة هي أن الحل الذي اقترحه اليسار تاريخياً هو «إحلال احتكار الدولة محل احتكار رأس المال، وبالتالي جمع عيوب الإثنين معاً. فلماذا نُدهَش عندما نجد أن حلول اليسار الكلاسيكية لا تلقى استجابة جمهور الناخبين وحماسهم؟».فرنان بروديل، ذاته، ص784.
يعتبر بروديل أنه لطالما وُجِدَ في التاريخ القديم والحديث أشخاص أو أصحاب رؤوس أموال أو محتكرون أو أصحاب بنوك أو شركات كبرى يقوم الإمبراطور أو الملك أو الدولة المعاصرة بكفالتهم وحمايتهم ومنع فشلهم أو إسقاطهم، بكلام آخر، كان هؤلاء دائماً وما زالوا أكبر من أن يُسمَح بسقوطهم، وشكّلوا ظاهرة مازالت مستمرة حتى اليوم، وهي أنهم too big to fail، وذلك لم يكن لأنهم يملكون مؤهلات ذاتية تمنعهم من الفشل والسقوط بل لأن هناك سلطة تقوم برعايتهم وكفالتهم في الأزمات. وعندما تقوم الدولة بكفالة هؤلاء، مثلما فعلت أميركا مثلاً خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 عبر كفالة جنرال موتورز أو البنوك الكبرى، فهي تسمح لهم بالقيام بخصخصة الأرباح وتعميم الخسائر. أي يمكنهم دائماً الاحتفاظ بأرباحهم، لكن عند الخسارة فإن المجتمع هو من يدفع. أرباحهم لهم والخسائر يدفعها الناس.ليس لدينا معرفة كافية بالتفاصيل، ولكن قد تفيد تلك الآلية في التحليل لفهم ما حصل وما زال يحصل في لبنان في أزمة البنوك والودائع. وتلك العملية، ناهيك عن كونها عملية لا أخلاقية بالكامل، فإنها عملية لا علاقة لها إطلاقاً باقتصاد السوق والتنافس الحر أو بعمليات العرض والطلب التي يُفترض أنها تحدد الأسعار.
يرفض بروديل، مستعيناً بالبيانات الصارمة، كل عملية التحقيب الماركسي للتاريخ (مشاعية، عبودية، إقطاعية، رأسمالية ومن ثم تأتي الشيوعية)، كما يرفض تحقيب الرأسمالية ذاتها إلى مراحل متعاقبة،نُشير أيضاً أنه بالنسبة لمانويل ديلاندا، فهو يضيف على بروديل؛ مستخدماً فلسفة دولوز، أنه يرفض كل مفهوم كلّي وعام ومجرد مثل «الرأسمالية» بأل ولام التعريف أو «النظام الرأسمالي»، فليس هناك رأسمالية واحدة، بل رأسماليات بالجمع، ويجب دراسة كل رأسمالية على حدة ضمن شروطها، فقد تكون هناك شروط رأسمالية في دولة صغيرة ومتخلّفة مثل سوريا، مختلفة عن كل ما عداها من تعددات الأنظمة الرأسمالية في الدول المتقدمة، أو الدول المحيطة. والتي يبدأها الماركسيون عادة بالرأسمالية التجارية ثم الصناعية ثم المالية. ويخبرنا بروديل أن الرأسمالية التجارية لم تولد أصلاً في أوروبا، بل أخذها الأوروبيون عن العالم الإسلامي وعن الصين، كما أن الرأسمالية المالية، «رأس المال المالي»، لم تأتِ متأخرة عن الصناعية كما يظن الماركسيون المعاصرين، بل بدأت في إيطاليا القرن الرابع عشر ثم أمستردام القرن السادس عشر. وأخيراً فإن الرأسمالية الصناعية لم تولد في القرن التاسع عشر مع هنري فورد كما أخبرنا مايكل هاردت وانطونيو نيغري في كتابهما الضخم الامبراطورية،مايكل هادرت وأنطونيو نيغري، الإمبراطورية، إمبراطورية العولمة الجديدة، تعريب، فاضل جتكر، مراجعة، رضوان السيد، دار العبيكان 2002، انظر ص 100 وما بعدها. حيث يطلقان إسم Fordism أو الفوردية على الصناعات الكبرى mass production. على العكس من ادّعائهما، فإن تلك الصناعات بدأت في المستودعات والقواعد العسكرية في فرنسا ثم الولايات المتحدة قبل مئة سنة من تبنّي هنري فورد لتلك الصناعة. في الواقع، ساهم تبني الدولة الأميركية لتلك الصناعة بشكل حاسم في انتصارها على بريطانيا في الحرب التي دارت بينهما عام 1812. وبالتالي لم يكن للصناعات الكبرى أي علاقة بأي رأسمالي فرد أو «طبقة» برجوازية عند نشأتها، بل بالدولة والسلطة قبل كل شيء آخر.
الاغتراب
النقطة الثانية في نقاشنا لأفكار ماركس هي فكرته عن الاغتراب Alienation: تقوم المادية دائماً على التركيب synthesis، لكن مشكلة ماركس أنه أخذ تركيبه، كما قلنا سابقاً، من نفي النفي الهيغلي. وظن ماركس أن كل ما عليه فعله هو إيقاف هيغل على قدميه، فهيغل هو مثالي يعتقد أن الاغتراب هو اغتراب الروح عن العالم الواقعي؛ واغتراب الروح هو مصدر «الوعي الشقي» عنده، ولكن في النهاية سينتهي الاغتراب بعودة الروح إلى ذاتها واتحادها مع العالم في ظل الدولة. وأما مع ماركس فالاغتراب الهيغلي ذاته أصبح، بعد إيقافه على قدميه، هو اغتراب العمال عما ينتجونه وعن فائض القيمة الذي يؤخذ منهم بشكل غير شرعي وغير قانوني عبر الرأسماليين، ولكن في النهاية سينتهي هذا الاغتراب بسيطرة البروليتاريا على قيمة عملهم عبر الثورة الشيوعية التي ستقوم بإسقاط الرأسمالية. وبهذا الصدد يقول ماركس: «إن الطابع الصنمي لعالم البضائع ينجم عن الطابع الاجتماعي المتميز للعمل المنتج للبضائع.. {ولذلك}.. تبدو العلاقات الاجتماعية للمنتجين كما هي في الواقع، ليست علاقات بين المنتجين أنفسهم أو في عملهم، بل على العكس، علاقات شيئية بين الأشخاص وعلاقات اجتماعية بين الأشياء».رأس المال، المرجع ذاته، ص110.
سوف نتحدث عن الاغتراب هنا بأكثر من معنى كي نحيط بالفكرة أولاً، ولكي نختبر مدى صوابية فكرة ماركس والماركسيين الذين تناولوا موضوع الاغتراب بعده، ثانياً. ولذلك سنتناول الاغتراب بمعانيه المتعددة، فلسفياً ونفسياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بشكل مختصر قدر الإمكان.
أولاً، الاغتراب بالمعنى الاقتصادي: يربط ماركس الاغتراب بتقسيم العمل، ولكن ليس المقصود تقسيم العمل بالمعنى التقليدي؛ ذلك الذي حصل عند تقسيمه إلى حِرف ومِهَن مختلفة عن بعضها في مراحل متأخرة من التاريخ، بل تقسيم العمل الذي ارتبط بالثورة الصناعية. وللتحديد أكثر، تقسيم العمل الذي جاء مع الصناعات الكبرى،من الضروري التأكيد على أن الـmass production هي عملية الإنتاج الضخم للمُنتج ذاته أو للأجزاء ذاتها من المنتج. قطع متماثلة تماماً identical parts تنتجها الآلات (سبطانة المدفع أو البندقية على سبيل المثال)، وهذا الشكل للإنتاج لم يكن ممكناً على الإطلاق في زمن الحرفة، حيث إن كل قطعة ينتجها الحِرفي تختلف عن غيرها ولا يمكن استبدالها لأنها غير متطابقة. وهذا ما جعل الصناعات الكبرى نقلة نوعية هائلة في نمط الانتاج. حيث يتم تجزئة مُنتَج واحد إلى عدة أجزاء، ويقوم العامل بشكل دوري بصناعة جزء واحد من ذلك المنتج وليس المنتج كاملاً (المدفع أو الحذاء أو الساعة أو الكمبيوتر.. إلخ). ذلك التقسيم الذي يجعل العمل أسرع بالتأكيد، لكنه يُفقد العمال حِرَفهم (deskilling)، ويجعلهم مغتربين عن منتجاتهم بحيث يصبحون مجرد آلات تعمل ضمن ماكينة كبرى هي المصنع أو الشركة التي يمتلكها الرأسمالي. إذن، هناك اغتراب ثنائي يعانيه العمال بالمعنى الاقتصادي، اغترابهم عن طبيعة ما ينتجونه أولاً، واغترابهم عن ناتج ما ينتجونه؛ أرباحه وفائض قيمته، ثانياً. ولكن عندما نفكر بالأسلوب الماركسي ذاته في تحقيب التاريخ، ونأخذ نمط الإنتاج الرأسمالي، يمكننا أن نسأل: هل كانت شروط العمل في الأنماط السابقة على الرأسمالية أفضل حالاً بالنسبة للعمال وأقلّ اغتراباً؟ هل كان الفلاحون أو العبيد أكثر اندماجاً بأعمالهم وبناتج عملهم، وهل كانوا يحصّلون حقوقهم التي يستغلّها الرأسمالي اليوم، وهل كانت حياتهم أكثر إنسانية وأقل تشيّئاً مما هي عليه في النظام الرأسمالي؟ سيتطلب الأمر الكثير من البلاهة السعيدة والنوستالجيا البليدة لكي تكون الإجابة نعم. فبالنسبة للعبيد، لم يتم اعتبارهم بشراً بالأصل لكي يصبح الحديث عن اغتراب وتشيؤ ذي مغزى ومعنى، بل كانت حياتهم بالكامل ملكاً لمالكيهم. أما بالنسبة للفلاحين، فإن كان يبدو نظرياً و«أدبياً» أن علاقة الفلاح بأرضه هي علاقة اندماجية أو أكثر حميمية وأقل تشيؤاً من علاقة العامل بالآلات في المصنع، إلا أنه عملياً وواقعياً يمكننا التساؤل إن كان الفلاح يحصل على ناتج وقيمة عمله في الأرض ضمن نمط الانتاج الاقطاعي بأكثر مما يحصّله العامل في النظام الرأسمالي؟ وهل العمل بالسخرة مقابل فتات الطعام والحماية أقل اغتراباً من العمل المأجور؟ ماذا عن القدرة على تغيير العمل ونمط الحياة التي لم تكن متاحة للعبيد والفلاحين إطلاقاً؟ وماذا عن وضع المرأة في العائلة الفلاحية في زمن الإقطاع، هل هي أقل اغتراباً وتشيؤاً من حالها في الزمن الرأسمالي؟ وهل المرأة التي يزوجها أبوها أو أخوها لمن يريد؛ ويقتلها ببساطة إن أساءت لشرف العائلة، هي إمرأة أقل سِلعيّة وتشيؤاً من المرأة «السلعة» أو حتى «المومس» في المدن الصناعية؟ إذا كانت الحرية تُقاس بتعدد الخيارات الموضوعية، وإذا كانت الإنسانية تُقاس بمدى تحقيق الإنسان لقدراته الكامنة فيه والتعرُّف على جوانب وجوده غير المُجرَّبة سابقاً فيه كإنسان، فإنه يمكننا القول ببساطة أنه لم يوجد عصر أكثر حرية وإنسانية من العصر الرأسمالي. يقول صادق جلال العظم في لفتة نادرة (ومع أنه كان ماركسياً بعمق) في سياق نقده لجورج لوكاش ودفاعه عن المادية والتاريخ:
لم يحدث أن عاش الإنسان في أية مرحلة من مراحل تاريخه على سطح الكرة الأرضية في بيئة إنسانية هي من صنعه المباشر، أو هي نتيجة لتراكم عمله وجهده التاريخيين كما هو الأمر في العصر الصناعي. مكّنَ العصر الصناعي البشرية من أن تعيش حياتها أكثر من أي وقت مضى في محيط هو من صنعها كلياً وفي عالم هو من إبداعها تماماً بدلاً من عيشها السابق في محيط صنعته الطبيعة العمياء وفي عالم أنتجته قوانين الفيزياء والكيمياء الصماء. بهذا المعنى أنسَنَت الحضارة الصناعية كلاً من الطبيعة وبيئة الإنسان إلى درجة لم تعرفها أية حضارة سابقة وما كان يمكن أن تعرفها بطبيعة الحال.صادق جلال العظم: ثلاث محاورات فلسفية، دفاعاً عن المادية والتاريخ، (مداخلة نقدية مقاربة في تاريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة)، دار الفكر الجديد، بيروت، لبنان، ط1 1990، ص294.
وهنا لا بدّ من إضافة التوضيح الثنائي التالي: أولاً، إذا كان الكلام السابق يأخذ صِحّته من المقارنة مع الماضي ما قبل الرأسمالي، فإنه ينطبق أيضاً على الشيوعية كما تم تطبيقها بوصفها نظاماً «ما بعد رأسمالي». وثانياً، لا يجب أن يُفهم ذلك الكلام على أنه مدحٌ للنظام الرأسمالي أو نقص في رؤية عيوبه والظن بخلوّه من الاغتراب، ولا دفعنا من جهة أخرى لاعتبار النظام الرأسمالي «نهاية التاريخ» على طريقة فوكوياما وأصحاب النهايات؛ الذين يعدُّ ماركس ذاته أبرزهم فيما يخص النهاية الشيوعية.
ثانياً، الاغترب بالمعنى السياسي/الاجتماعي: لقد فرض العصر الصناعي «الرأسمالي» انتقال المجتمعات من الحالة الجماعوية إلى الحالة الفردية، وهذا أدّى بدوره، حسب ماكس فيبر، إلى التغيير المتتالي لنمط التمثيل السياسي وشكل الشرعية السياسية لنظام الحكم، حيث تم الانتقال من «شرعية الكاريزما» التي يُحكَم فيها المجتمع بناء على كاريزما القائد وقوته وسيطرته المطلقة. ثم «شرعية العادات والتقاليد» التي يُحكَم فيها المجتمع بناء على العادات والتقاليد الموروثة كما هو الأمر في المَلَكيات. والوصول أخيراً إلى الشرعية المؤسسية أو ما يسميه فيبر العقلانية القانونية (Rational-legal authority). وهي شرعية تقوم على قواعد حكم عقلانية وكفاءة مبنية على التزام السلطة والمجتمع بواجبات وحقوق مكتوبة ومحددة قانونياً. يربط ماكس فيبر هذا النمط من الشرعية بصعود البيروقراطية، «حكم المكتب». وعلى الرغم من السمعة السيئة لكلمة بيروقراطية اليوم، إلا أن المعنى الإيجابي الذي وفّرته البيروقراطية هو أنه لم يعد مهماً من هو الإنسان أو الشخص الذي يحكم، ولا يعني شيئاً أصله أو فصله أو كاريزمته، بل المهم هو المكتب، أو المنصب، أو الموقع الذي يتم تحديده بالقانون، ويبقى ثابتاً أمام تَغيُّر الأشخاص الذين يجلسون خلفه. المكتب/الشيء هو المهم وليس الشخص، (البرقرطة ذاتها إذاً هي تشييّء واغتراب من جهة لكنها تحرير من جهة أخرى). والترجمة السياسية لتلك الخطوة هي أنه لم يعد مهماً أيضاً من هو البديل السياسي للحاكم (وهي المشكلة؛ أو السؤال الزائف، الذي طالما شغل السوريين) بل المهم هو المكتب أو المنصب الذي يحدد معاييره القانون وقد يشغله أي شخص يتمتع بالكفاءة المطلوبة طبقاً لمعايير العقد الاجتماعي/السياسي المكتوبة في الدستور. لقد أدى هذا النمط من الشرعية البيروقراطية؛ عند تجذّره في المجتمع وانتقاله من القاعدة إلى الهرم، إلى انتقال المجتمعات الصناعية الرأسمالية إلى نظام الحكم الديمقراطي المؤسسي. وهذا يوصلنا إلى الاغتراب بمعناه السياسي، حيث لا يمكننا، بأي شكل كان، مقارنة اغتراب المجتمعات الديمقراطية «المكبّلة ببيروقراطيتها» عن تمثيلها السياسي وإرادتها السياسية، بحالة الاغتراب الكامل التي تعيشها المجتمعات ما قبل الرأسمالية؛ أو حتى المجتمعات الشيوعية، حيث لا صوت ولا قيمة للأفراد في تحديد من يحكمهم، سواء كان قائداً مُلهَماً أو مَلِكاً أو «وارثاً للجمهورية» أو لجنة مركزية. يغترب الناس عن ناتج حكمهم السياسي في تلك المجتمعات، ولا تضيف أصواتهم «الانتخابية» أي ناتج أو قيمة سياسية على الحاكم أو على نمط الحكم.
أخيراً، الاغتراب بالمعنى الفسلجي (فلسفة/علم نفس): ما نخلص إليه تركيبياً وفلسفياً من النقاط السابقة هو أنه إذا وافقنا على أن الاغتراب في المجتمعات الصناعية/البيروقراطية/ الديمقراطية هو أشدّ قسوة منه في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، فذلك يصحّ فقط في حال كان المعيار بدائياً؛ أو أُخروياً، بمعنى أن حلّ الاغتراب يكون إما بعودة الإنسان إلى الطبيعة؛ عودته إلى العالم الحيواني حيث لا يوجد اغتراب عند أسلافنا في العالم الحيواني، أو سيكون حلّه في الآخرة؛ الجنّة أو الشيوعية. وفي الحالين سيكون المنظور للاغتراب سلبي/هيغلي/ماركسي، حيث هناك مثال أعلى في الماضي أو في المستقبل، يسلب الواقع الموجود وجوده وينفيه قياساً بذلك المثل الأعلى. أما من ناحية المنظور الإيجابي الواقعي الذي نراه في الاغتراب، فسوف ينقلب ذلك المعيار المتعالي إلى معيار جوانيّ وصيروري، لتصبح كل خطوة كان يخطوها الإنسان نحو التقدم أو التطور أو التعقيد، هي خطوة جديدة في اغترابه، فالاغتراب عن «الطبيعة» أو «الحالة الطبيعية»، بدأ منذ خروج الإنسان من الغابة، أي منذ جلجامش وأنكيدو في الأسطورة المشرقية الآشورية، وحسب فيلسوف وعالم نفس ماركسي/فرويدي مثل إريك فروم فإنه لا مَخرَج من ذلك الاغتراب في أي عصر كان إلا عن طريق الحب، فالحب هو وحده القادر على إعادة وصل الإنسان بذاته وبالطبيعة. وإن كان هذا الكلام مثالياً؛ رغم حمله لشيء من الحقيقة، فإن الأمر عند فيلسوف يتكلم «بضربات المطرقة» مثل نيتشه، هو أن الاغتراب هو الشرط الأول والأهم للإبداع الإنساني، سواء تعلَّقَ الأمر بالفلسفة أم بعلوم الذرة. بكلام آخر، ليس هناك فرق بين الاغتراب و«العيش في خطر» الذي طالبَ به نيتشه. ويمكننا أخيراً أن نستخدم المصطلحات الدولوزية بعد إخراجها من سياقها لنقول إن الاغتراب هو صيرورة مستمرة في حياة الأفراد والمجتمعات، صيرورة تنقلهم على نحو دائم، وضمن سرعات وكثافات مختلفة تبعاً للزمن والعصر الذي يعيشون فيه، من التوطّن (territorialization) إلى نزع التوطين (deterritorialization) إلى إعادة التوطين (reterritorialization)، وليس الزمن الرأسمالي إلا تكثيفاً لتلك السرعات التي يمر عبرها الاغتراب.
بعض العواقب السياسية للتحليل الماركسي على اليسار
إن المشكلة التي خَلَقها ماركس عند حديثه عن حلّ الاغتراب الذي أوجدته الرأسمالية عبر الثورة الشيوعية هي أنه خلق ما يمكن تسميته ببذور الحرب الأهلية في كل المجتمعات التي اعتنقت الماركسية، أو التي قادتها أحزاب اعتنقت الماركسية وحولتها إلى ما يشبه «دين الدولة». بمعنى أنه، مع اعتماد فكرة الصراع الطبقي كآلية تحليل اجتماعي/سياسي/اقتصادي، لم تعد مشكلة النظام الرأسمالي تكمن في الدولة ولا في جهاز السلطة بالنسبة للماركسيين، بل في الطبقة البرجوازية، الأغنياء. وبالتالي ما يجب أن يثور عليه وضده البروليتاريا هم أولئك البرجوازيون بوصفهم طبقة، وبوصفهم هم ذاتهم الحائزين على السلطة، دون حتى تمييز بين جهاز السلطة وطبقة الأغنياء، فالصراع هو أصلاً صراع طبقي، والصراع الطبقي هو محرك التاريخ. يوجز جيل دولوز تلك الآلية بالقول: «نتعرّف بشكل عام على مفكر ماركسي بقوله إن المجتمع يتناقض ويتحدد بتناقضاته، وبالخصوص بتناقض الطبقات».جيل دلوز- كلير بارني، حوارات في الفلسفة والأدب والتحليل النفسي والسياسة، ترجمة، عبد الحي أزرقان وأحمد العلمي، دار أفريقيا الشرق، بيروت لبنان، عام 1999، ص172. بل إن ماركس وإنجلز يفتتحان البيان الشيوعي بالعبارة التالية: «إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية».البيان الشيوعي، ص19. وهذا التحليل الماركسي أدى إلى كوارث واقعية نوجزها على النحو التالي:
أولاً: بات قادة الثورات جميعهم بروليتاريا، حتى لو لم يكونوا فعلياً من أصول بروليتارية، فكل الديكتاتوريات العسكرية منذ الثورة البلشفية جاءت ناطقة باسم البروليتاريا، «الشعب»، ضد طبقة الأغنياء أو الملوك أو الارستقراط الذين كانوا في السلطة سابقاً.
ثانياً: بات عدو الشعب ليس السلطة المفروضة عليهم والمستفيدة منهم، بل طبقة الأغنياء، الرأسماليون الأفراد وطبقتهم، وهذا التحليل هو بذرة إيديولوجية لتشريع الحرب بين الطبقات، وإزاحة المسؤولية والرؤية عن السلطة الحاكمة للجميع. يمكننا ضمن هذا السياق مقارنة الاختزالية الكامنة في التحليل على أساس الصراع الطبقي بالاختزالية الكامنة في تحليل المشكلة السورية على أساس الصراع الطائفي، فعندما يتم صهر الأفراد ضمن جماعات كبرى بهذا الشكل لمجرّد حادثة الولادة الطبقية أو الطائفية، سيُقاد التحليل إلى الاختزالية حتماً، وسوف يتبادل التحليل الطائفي والتحليل الطبقي المواقع دون مشكلة منهجية. وفي هذا ما قد يفسر تحوّل الكثير من الماركسيين السوريين إلى طائفيين أو اعتماد آلية تحليل قائمة على الطائفية برمشة عين دون التخلي عن ماركسيتهم، لأن ما سطحه صراع طبقي، عمقه صراع طائفي وديني (كليّات هيغلية/ماركسية). بل إن هذا ما قد يفسر حال جزء معتبر من اليسار العالمي الذي يبدو منقسماً، بين «الجلوس في نفس الخندق» مع نظام الممانعة عندما يتعلق الأمر بالتدخل الإمبريالي الغربي، أو اختزال المشكلة السورية بالحرب الدينية والطائفية ومكافحة الإرهاب. ففلسفياً لا يُعتَد أبداً بمواقف أمثال نعوم تشومسكي وسلافوي جيجيك الساطعة يسارياً. وسياسياً لا يُعتَد أبداً بمواقف ديمقراطيي أميركا الذين كان آخر ممثليهم بيرني ساندر في الانتخابات الأخيرة، أو اشتراكيي فرنسا وحركة «فرنسا الأبية» التي قادها ميلانشون، أو حركة بوديموس واليسار الإجتماعي في إسبانيا، على سبيل المثال لا الحصر.
ثالثاً: باتت مشكلة الناس تبعاً للتحليل الماركسي تكمن في السوق وتكمن في الاقتصاد وليس في السياسة، بل إن السياسة لم تعد إلا اقتصاداً مُسلطناً؛ ذا سلطة، أي اقتصاداً حاملاً للسلطة. باتت السياسة مُختزلة في الاقتصاد. (ومن هنا نرى أيضاً مدى عدم الفهم الواسع والمنتشر في الغرب والشرق للسلطة وللأنظمة السلطوية، مثلاً عندما يريد أحدهم أن يفهم نظام الأسد، أو نظام بوتين على أساس اقتصادي، لا يمكن أن ينطق إلا بالحماقات، وسوف نرى عدم فهم كامل لتلك الأنظمة، ونرى غشّاً وسوء إفهام للناس وتزويراً متواصلاً).
تتحدد إحدى جوانب مشكلة اليسار، باعتقادنا، في أنه ينتقل ببساطة من رفض الشروط إلى رفض الوجود. أي من رفض الشروط السياسية الاقتصادية للنظام الرأسمالي على سبيل المثال، إلى رفض وجود النظام الرأسمالي. وهذا ما يساهم في نقل اليسار ببساطة من يسار مادي وتاريخي إلى يسار مثالي وغير تاريخي، لأن رفض الشروط قد يدعم فهمها ومحاولة تغييرها من الداخل، بينما رفض الوجود يقوم على تصور لنظام متعالٍ خارج النظام الرأسمالي لا بدّ من السعي إليه عبر إزالة النظام الرأسمالي ذاته. وهذا الرفض الوجودي هو رفض سلبي، يقوم على النفي الهيغلي، وبذلك هو نفي معادٍ للحياة، ينفي الحياة قياساً إلى مثال أعلى مُتصوَّر من خارج النظام الرأسمالي ذاته. هذا هو مصدر عدمية اليسار، وضعف تأثيره في السياسة الفعلية. ومن هنا أيضاً نلاحظ وجود نوع من التشابه الذي يجمع العقيدة اليسارية «المثالية» مع العقيدة الدينية، فالأساس الذي يقوم عليه الدين هو رفض الوجود كما هو، مهما كانت طبيعته، بالقياس على عالم أُخروي مُتصوَّر وغير موجود. لكن، كما يعلم الجميع، لا يحلّ الإنكار والنفي المشاكل بل يضاعفها. لم يحل الإنكار الديني أو النفي اليساري للواقع من خارجه أي مشكلة عبر التاريخ، بل كان فقط يعطي مهدئات ومسكنات وجودية ريثما تمضي الحياة وتتفاقم مشاكلها، مع بقاء الأمل هو الحامل السلبي للوجود، أو الأمل السلبي الحامل للوجود الضعيف.
ليس غريباً أن أصبح ماركس والفكر الماركسي اليوم عقيدة متعالية، مثلها مثل الإسلام بالنسبة للإسلاميين، حيث لا يمكن أن تناقش إسلامياً حول الإسلام إلا ويخبرك أن «هذا ليس هو الإسلام»، ولا يمكن أن تذكر اسم فقيه أو مُنظّر أو مفكر إسلامي، أو حركة سياسية إسلامية متطرفة أو معتدلة، إلا ويخبرك محدّثك أن «هؤلاء لا يمثّلون الإسلام». الجميع يتفق على أن هناك مشكلة، والجميع يعتقد أن الآخرين لا يمثلون الحل. المشكلة في الفروع وليس في الأصل، حيث يبدو أن تلك الخلافات والاختلافات تعقدت لدرجة أنه لم يعد أحد يعرف ما هو الأصل، رغم اتفاق الجميع على بداهته ووضوحه. ينطبق ذلك على الإسلام والإسلامات الناتجة عنه بطريقة موازية؛ وربما مماثلة لما هو عليه الأمر مع ماركس والماركسيات التي أخذت عنه وردّت نفسها إليه.
الآن، لِمَ الحاجة إلى يسار آنتي-ماركسي؟ لقد شكّلت الماركسية، وما زالت تشكل إلى اليوم، التيار العام لليسار، وأصبحت المعيار العام لكل تفكير أو توجّه يساري في العالم. وعندما تتحول أي فلسفة أو أي إيديولوجيا إلى معيار عام تصبح فارغة من المعنى نتيجة السلطة الكاسحة التي تحملها المعايير العامة، والقدرة الهائلة التي تملكها على إلغاء الاختلاف. فعندما تتحول أي سلطة إلى معيار عام وأكثري بهذا الشكل، تفقد القدرة على تمثيل الغنى والاختلاف الموجود في الواقع. يختصر جيل دولوز هذا الأمر عندما يتحدث عن رأيه في معنى أن يكون المرء يسارياً ضمن حواره مع كلير بارنيت ببلاغة شديدة حيث يقول: «إن الأغلبية هي لا أحد، بينما الأقلية هي كل شيء». وهو لا يقصد الوجود أقلياتياً، بل الصيرورة أقلياتياً من ناحية الفكر والعمل والفعل السياسي لا من حيث الطبقة والدين والطائفة بكل تأكيد. لقد كان فيرنان بروديل يسارياً، ولكنه لم يكن ماركسياً، وعلى الرغم من الغنى النقدي والتأويلي والتفسيري لأفكاره وكتبه حول الرأسمالية إلا أنه بقي مهمشاً وبدوياً وأقلياً في تاريخ الأفكار، كونه لم ينخرط في المعيار العام الذي وّلدته الماركسية وسيطرت من خلاله على الفكر اليساري في العالم.
لا تقدم الفلسفة وصفاتٍ جاهزةً للواقع بقدر ما تُؤشكِل الواقع، وفقط عندما تُؤشكِل الواقع تصبح الفلسفة ثورية. والماركسية بمجمل أطيافها فقدت قدرتها التفسيرية للواقع، ناهيك عن قدرتها على أشكَلَتَه وطرح المشكلات الصائبة حوله، وبهذا المعنى فقدت ثوريتها وباتت تقليداً مملاً من المقولات العقائدية الزائفة. وعندما تفقد الفلسفة قدرتها التفسيرية تصبح عقبة أمام طرح المشكلات الواقعية وفهمها بطريقة صحيحة. لقد تحولت الماركسية إلى إيديولوجيا مغلقة بمبادئها ومفاهيمها الكبرى وعقائدها بالذات. لم يعد التحليل الطبقي قاصراً عن فهم الواقع فحسب، بل عقبة في فهم التعقيد الواقعي للمجتمعات والدول المعاصرة، ولم تعد معاداة الرأسمالية أكثر من شعار شبه ديني للمفلسين أخلاقياً، كما لم يعد التحقيب الماركسي للتاريخ أكثر من أداة تعمي وتحجب أكثر مما توضح الرؤية.
وكمقدمة نقدية نحو رؤية فلسفية وسياسية مغايرة تخصّنا، نجد أن أداتين معرفيتين ستَلزَمان كل تفكير يساري جديد:
الأولى هي التركيب: لا بدّ أن يتجاوز أي يسار مادي جديد كل أنواع الاختزالية ليرى التركيب القائم في الأشياء والمجتمعات، فليست هناك مشكلة معاصرة ذات «بُعد واحد» على الإطلاق. بل إن «الإنسان ذو البعد الواحد» الذي تحدث عنه هربرت ماكوزه لكي يصف المجتمعات المعاصرة في الدول الرأسمالية لم يكن في أي يوم ذا بعد واحد، لا هو ولا النظام الرأسمالي الذي يعيش في ظلّه، بالأحرى لم تكن الحياة متعددة الأبعاد ومعقدة في أي مجتمع عبر التاريخ مثلما هو حالها في المجتمعات الرأسمالية.
والثانية هي الاعتراف بالتعدد والاختلاف: وهنا لا بدّ من التأكيد على الكلمتين معاً «تعدد واختلاف»، أي ليس التعدد الكمي فحسب بل الاختلاف النوعي بين الأحزاب والحركات. وبتطبيق ذلك على الواقع السياسي السوري، الذي يعنينا بشكل خاص، سنجد أنه بَعد الثورة السورية، على وجه التحديد، ظهر التعدد الهائل في المجتمع السوري، وظهر العديد من الأحزاب والحركات السياسية إلى العلن والفعل السياسي المعارض بعد أن كانوا مهمشين ومقموعين بالقوة والبطش سابقاً.ينطبق ذلك على هيئة التنسيق ومعظم أحزابها، مثلما ينطبق على إعلان دمشق وأحزابه، أو المنبر الديمقراطي وتيار الدولة أو «هيئة التغيير والتحرير».. والقائمة طويلة. لكن ذلك التَعدُّدَ لم يُترَجَم إلى اعتراف بالاختلاف السياسي. ولذلك رأينا كيف تمظهرت تلك الحركات والأحزاب بوصفها نافية كلٌّ منها للأخرى، بل رأينا كيف قامت بالضبط على إقصاء الآخرين والمنافسة الوجودية/السلطوية معهم، وهذا ما جعل التَعدُّدَ يُفاقم المشكلة بدل أن يحلها، وجعل منه تشرذماً بدل التجميع، وجعل من كل واحدة من تلك الحركات تظهر كأنها ديكتاتورية مصغرّة تقوم بالكامل على الإقصاء. ولذلك لا بدّ من التركيز على أن الاعتراف بالاختلاف لا يقوم على تعدد المتشابهين و«أولاد العم الإيديولوجيين» فحسب، بل الاعتراف بالمختلف نوعياً، سواء كان ذلك المختلف إسلامياً أو علمانياً، نسوياً أو ذكورياً، يسارياً أو يمينياً أو ما بينهما، طالما أن الطرف المختلف يحتكم لشروط اللعبة السياسية ذاتها، قانونياً وسياسياً، وليس أخلاقياً. الشيء الذي يستبعد بدوره كل محاكمة أخلاقية أو محاسبة على النوايا الموروثة من زمن حافظ الأسد، والتي تم تطبيقها وتكرارها لدى المعارضة.
يُشكّل الاختلاف، أو الاعتراف بالاختلاف، نقطة جوهرية في بناء فلسفة لليسار المادي الجديد، وذلك من مبدأ أنه لا تطور بلا اختلاف. لا ينطبق ذلك على المجتمع والتحليل الاجتماعي وحسب، بل ينطبق على الطبيعة والاقتصاد والسياسة والسلطة بالقدر ذاته. وإذا أخذنا تحليلات فوكو حول السلطة بعين الاعتبار، سنجد أن الديمقراطية ليست أفضل من الديكتاتورية لأنها خالية من السلطة والسيطرة، بل لأنها تفتح باباً للاختلاف والاعتراف بالاختلاف لا يحتمله النظام الديكتاتوري. فليست السلطة جيدة في الغرب وسيئة في الشرق، بل هي سيئة ويجب مقاومتها هنا وهناك، لكن وحده النظام الديمقراطي ما يمكن فيه الاختلاف دون دفع الحياة ثمناً لذلك الاختلاف، ووحده الاختلاف ما يوازن السلطات المتعاكسة ويمنع سيطرة واحدة منها للأبد، ووحده الاختلاف ما يجعل السلطات المتباينة قابلة للتعايش في النظام الديمقراطي. يمكن تلخيص ذلك بالقول إنه كلما زاد الاختلاف النوعي، كلما زادت قابلية التطور، وبالمقابل، كلما انمحى الاختلاف عبر الهيمنة الأُحادية كلما قَلَّت فرص التطور.
أخيراً، لا يقدم هذا المبحث أي وصفة مطبخية عامة ومجردة (ومزوّرة مثل كل الوصفات العامة والمجردة)، ولكنه مقدمةٌ لمعاينة التخوم التي نعيشها من مواقع يسارية ونقدية حتى لو كانت تلك المواقع ذاتها آنتي-ماركسية. ولذلك لا نجد كلاماً نختم به أفضل من الكلام الذي صاغه جيل دولوز مرة، ونعيد صياغته هنا على النحو التالي:
لا وجود لأي وصفة عامة، لقد قطعنا مع كل المفاهيم الشمولية. إن المفاهيم ذاتها إنّيات وأحداث، لا تأخذ قيمتها إلا من خلال متغيراتها، ومن خلال أكبر عدد من المتغيرات التي تسمح بها. لسنا هنا من أجل السهر على إحصاء أموات وضحايا التاريخ، ولكي نستخلص أن الثورة مستحيلة، غير أنه يتوجب علينا، نحن المفكرين، أن نفكر في المستحيل، ما دام هذا المستحيل لا يستقي وجوده إلا من فكرنا.جيل دولوز، حوارات، ص183-184.